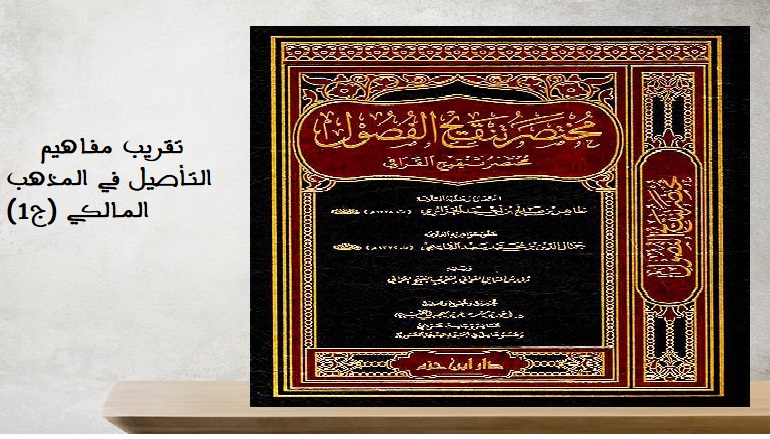أسست الحداثة لضياع وجهة الفهم، فأشاعت حالات من القلق المعرفي، وهيأت المجال لإحداث نكسة مفاهيمية؛ ذلك أن المعرفة الغربية غداة حرق لوثر (Luther) للكنيسة (10 دجنبر 1520)، ومنذ عصر التحديث، تحركت بدافع انفعالي غاضب، ليس ضدا على وساطة متسلطة بين الإنسان والله، ولكن ضدا على الله نفسه، يحركها ألم الانخداع بالكنيسة، التي بالغ كثير من أحبارها ورهبانها في أكل ﴿أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ (التوبة: 34) وفي تعطيل حركية الفهم خارج أسوارها.
هكذا تحددت ملامح لوحة الرؤية المفاهيمية الحداثية للعالم (la vision conceptuel du monde) من خلال وجهة تصور العالم التي أنشاها الانفصال عن الكنيسة (الله)، لتبنى من ثمة معرفة ترسي قواعد "ثقافة السؤال المعرفي"؛ غير أن السؤال المعرفي الحداثي، وهو يتحرك بموجهات منفصلة عن الله بداية (حيث تغيب الحركة الموجَّهة ببسم الله) وعن الله في النهاية (في غياب لقبلة الحركة: إنا لله وإنا إليه راجعون) حصر منهج النظر في الكون من موقع منحسر في الذات، ليكون عصر الحداثة "عصر الذاتية" بامتياز، بتعبير هايدغر، ولينتقل العقل في الفلسفة الغربية من "كونية" العقل إلى "ذاتيته"، بدءاً من كوجتو (Cogito) ديكارت الذي يعتبر أبا للحداثة، ومرورا بتجريبية بيكون (bicon)" في تأكيد الوثوقية البشرية، وهي تتحرك في اتجاه "تسييد" الإنسان على الطبيعة، وسيطرته عليها، واستغلالها بما يسهل عليه استغلال منافعها.
لقد تحددت معالم النكسة المفاهيمية في لوحة المعرفة الحداثية، باعتبار أنها ملقى لكل أشكال الأسئلة القلقة، ولصور الانفصال عن الكون، والمقدس، والتاريخ.. فكان الانقطاع المعرفي، والدوران حول الذات "عقلا" و"تجربة"، مجرد ردة فعل مَرضّية ضدا على الاستلاب المعرفي زمن تأله الكنيسة، ليسكت عن الغرب غضبه، فينساب سيل المراجعات النقدية، بعد ذلك، ضدا على الوثوقية الذاتية التي تؤله تارة العقل، وتارة أخرى الحس؛ ثم تندلع أزمة الفهم بحلول ما بعد الحداثة التي أعلنت ضديتها ومعاداتها للإنسان، ساحبة منه مركزيته من خلال سلب أصوله، ووجهته، وقبلته، فتحولت الحركة في الكون في لوحة العالم المفاهيمية ما بعد الحداثية، إلى عدمية لا أصل لها ولا مسكن.
إن تفكيك الإنسان والكون في ما بعد الحداثة وفصلهما عن المركز، أدى إلى تفعيل الرؤية الواحدية إلى العالم التي تدعم للأخلاق واللاقيم، حيث يتساوى فيها الحيوان والإنسان، الشذوذ الجنسي والاستقامة التعبدية ليقعد، بذلك، لفوضى العلاقات والمفاهيم واللامعنى.
وبالرغم من احتفائها باللغة، إلا أن الخطاب في "ما بعد الحداثة"، مؤسس للقوة الموجهة للفهوم، والتي بها يعاد إنتاج الإنسان، لإعادة توجيهه بما يتلاءم مع رغباته الجنسية والاستهلاكية، قصد الاستمتاع بالحرية الجسدية ضدا على كل قوة لغوية موجّهة نحو الكليات الثابتة، والمعايير القيمية، والأخلاق، وهي بذلك تنتصر للانفصال والاستهلاك لا للانتفاع.
كل الفلسفات السياسية المعاصرة تعتبر الأزمة كتطور في التاريخ؛ حيث يخرج "الخير" من بطانة "الشر"، فيستعار للعنف وللتناقض والتضاد المفضين إلى الكاووس (chaos)، فضل صناعة الإيجابية والنظام، بما أن الكاووس هو صناعة اللامفاهيم واللامعنى، وذلك كتدبير لبناء معنى جديدا به تنظف الفوضى فتستقر المصالح. هكذا تدل الأزمة كمفهوم إشكالي في المعرفة الغربية المادية، على لحظة الفوضى والانقطاع داخل المسار التطوري للتاريخ؛ "إنها أبدا بلا وزن ولا قياس، فهي العدم، إنها نقطة رمادية لا بيضاء ولا سوداء، لا هي ساخنة ولا باردة، لا هي فوق ولا تحت إنها نقطة بدون بعد، تائهة بين الأبعاد"[1]. لهذا أصبح مطلوب التخلي عن المعنى وعن ملاحقة المعنى، بل والتخلي عن كل ما يخلق حنينا للمعنى لأن" البشر اليوم قد سلموا لحاضر أبدي منفصل لا يحده شيء، فلم يبق سوى العيش في العالم المحروم من الله والتاريخ والعدالة"[2].
وإذا كان زمن الحداثة زمن الوصل بين الأزمة والتطور، فإن ما بعد الحداثة قد ضيقت المفاهيم لتكرس أزمة الفلسفة، متجلية في: ضياع الوجهة، نهاية الميتافيزيقا، وأزمة الدين والفن والاقتصاد والثقافة والإنسان؛ فالإنسان في التصور الغربي، الذي أنشأه البراديغم الفلسفي المادي، والرؤية الغربية إلى العالم في ظل الموجهات المفهومية التي ولدتها الصناعة المعرفية، وفي منأى عن قيم التعارف والاعتراف، ليس كائنا بشريا خلق: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: 4)، ولكنه ذئب يحركه الانفعال، وتنتظم كينونته البشرية بردود فعله، ليبتلعه الخوف من الكون والغير رغم وعيه بتشاركه مع الآخر والكون والبيئة من حوله، في أكثر من قاسم، وبالرغم من كون هذا الغير (أنا) إلا أنه "أنا عدو" ففي كتاب (Thomas Hobbes) 1588-1679 (التنين) الليفيتان (Léviathan)، وهو الكتاب الذي وصف الإنسان بـ"أمير جهنم"، الإنسان مدمر وأن الحالة الطبيعة حالة حرب دائمة، يخضع منها الإنسان لرغباته وهو ما يشكل خطرا يهدد الإنسانية، بما أن الطبيعة البشرية عنده، محكومة بثلاث رغبات أساسية هي: الخوف من الموت، واشتهاء القوة أو السلطة، ثم الحذر من الآخر.
ثم إن إرادة الحياة التي تسكن الإنسان، والتي تدفعه حسب هوبس (Hobbes) إلى بذل الجهد لحيازتها وحمايتها، هو ما يؤجج ذئبيته؛ إذ هو "ذئب بالنسبة إلى الغير" حيث؟ إن "هوبس" الذي أثر في الفلسفات السياسية الغربية المعاصرة، يعتقد أن الإنسان هو تلك الحالة من الطبيعة، التي تنفر من القانون، ولا يحد من هيجان التنافس والعدوان فيها إلا الخوف.
ثم إن فردا نية البشر، في نظره، وابتهاجهم بالتقدم المتنامي لرغباتهم من هدف إلى هدف، ليكون الهدف السابق مسلكا لتحقيق الهدف اللاحق، إنما هو تقدم محكوم بالضرورة إما بالاشتهاء وهو حركة في اتجاه الأشياء، أو النفور وهو حركة في اتجاه بعيد وناء عن الأشياء، وهما حركتان مسؤولتان عن تحديد إطار لإنتاج المفاهيم المنظمة للسلوك مع الموجودات المحيطة بالذات، حينما تشكل "السلطة" و"الهيمنة" سلوكا يلغي قوة الحق، ليحل محله حق القوة، الشيء الذي يؤدي إلى فوضى مفاهيمية متآكلة الأطراف تجعل من الإنسان" كائنا محدودا بحواجز ذاته تمنعه من الانفتاح إلا انفتاحه على عجزه"[3] (mattei, P24) ولا يكون انفتاحه ذاك، إلا مقودا في اتجاه الاتصال به، وليس في اتجاه التفاعل معه، بما أن الموجهات المصلحية هي التي توجهه.
هكذا أصبح الوجود الإنساني، الذي جرد من المعنى، مجزءًا إلى "أقليات صغيرة جدا غير قابلة للاختزال"[4] خاصة مع عدمية نيتشه التي هي عدمية "اللاجدوى" "الملحدة" والتي آل إليها الوضع البشري بعد أن استنزف المعنى فتحول السؤال الموجه للصناعة المفاهيمية: "ما الجدوى من السعي الإنساني"[5] "ما الجدوى من الذهاب إلى المدرسة عند البعض، وما الجدوى من العيش عند آخرين"[6] خاصة بعد اتساع براديغم "موت الإله".
ومعلوم أن اشتهاء السلطة أسس للشرخ بين مصالح الذات ومصالح الغير، وهو ما أنبت الانفصال عن الآخر والبيئة والكون، وحصر السعي البشري في المصلحة الخاصة الذي جًر القوة الصلبة إلى تحويل الكون لفضاء تتحقق به الرغبة المهووسة بحب الهيمنة والبقاء؛ فتصير، إثر ذلك، إمكانية الامتداد في الآخر والانفتاح عليه غير ممكنة، ولتتسع ما أسماها ماتيي بـ(la barbarie interne) الوحشية الداخلية"؛ أي العيش في ذاتية مغرقة في الأنا تقوم على معاداة المرجعيات الإتيقية (ethiques) المقبولة عند الجميع، انتصارا لواحدية معرفية تتوهم القدرة على تصحيح مسار الفهم وإنتاج المفاهيم الحاكمة[7]. هكذا كان فقد الموجهات وانحسار المقدس، السبب في طرح سؤال غياب المعنى ومشكلة العيش في عالم قاحلة مفاهيمه ليسير الإنسان اليوم في وجهة " مضادة لنفسها تفضي به إلى العمى [8](blanc. mattei) وحينها يتم إنتاج المعنى في مجال ضيق ترتد فيه الأنا العارفة إلى الذات، وكل انكفاء في الذات إنما يتم في سهو عن الموجهات التعارفية والاعترافية، وهذه مسكنها خارج الذات وليس في داخلها، حيث يؤدي تغييبها إلى تضخم "الأنا"، وتنامي ثقافة التحيز المعرفي المسكونة بالتعالي والمؤدية إلى توارث الخلاف الصدامي، والذي يتحول، في أغلب الأحوال، إلى عداء وعدوان، وذلك حينما يجري التحيز لمفاهيم تشكل المجال الحيوي لسيطرة السرديات المؤيدة للمصالح الخاصة، والتي أضاعت فسحة العثور على ما يخلق التشارك وليس التضاد، بسبب هذه النمذجة العولمية للعالم، حيث الهيمنة للنماذج بدلا من القيم..
وهو أخطر مهدد لضياع الوجهة، خاصة حينما تتعارض وظيفية الكون (التسخير) مع وظيفية الإنسان(الاستخلاف)، فيغدو لكل منهما وجهته، حينها، يبالغ الإنسان في الاعتداء على البيئة الكونية التي تأويه، فينمحي التساكن بينه وبين هذا البيت الكبير: الأرض والسماء: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ (البقرة: 21) ليحدث الانفصال بين الإنسان والأرض، ويصبح لكل منهما وجهته، مع أن الله الخالق صنع الدوائر المشتركة بين الإنسان والكون، لتيسير التآلف بينهما وفق قانون التسخير والتمكين، وبوجهة مفاهيمية مشتركة: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: 155) مستمدة من التلازم الأبدي بين الإنسان والأرض تكوينا، وسعيا: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ (الأعراف: 24) سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحتها، ولا يكون الانفصال إلا ساعة التخلي: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ (الانشقاق: 4)؛ كتخلي الأم عن وليدها، والأخ عن أخيه والأب عن بنيه، وذلك زمن الرجوع الأبدي إلى الله حينما: "تقيئ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة...[9]".
إن الاشتراك في وجهة السير والاشتراك في قبلته: "الرجوع إلى الله"، يحكمه التكوين الطيني المشترك بين الأرض والإنسان؛ ولقد عزز التراب إمكان التصالح والتآلف بينهما حتى لا خوف للأرض من الإنسان ولا خوف للإنسان من الأرض، طالما هي الأصل التكويني للبشر، وهي المأوى الإعدادي للخروج الأكبر للإنسان إلى دار البقاء.
والخوف والحذر من الغير، والرغبة في السلطة، إن هي إلا مفاهيم متحيزة للتصور المادي للوجود الإنساني، ابتدع لتبرير الميل إلى الاستهلاك، وجعله طبيعة في الإنسان؛ بينما جعله القرآن الكريم خطيئة أفقدت البشرية مقامها في الجنة، بسبب انزلاق مفهومي دبّر حدوثه الشيطان من مدخل الخوف البشري من الفناء حتى يخرج الإنسان مما كان فيه: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (الأعراف: 19).
هكذا تنامت في الفكر الغربي مفاهيم مثل مفهوم "السيطرة على الطبيعة" "وقهر الطبيعة"؛ بينما قعد في القرآن المجيد لكل من الحركة الكونية والحركة البشرية، في تعاضد واتصال بينهما، بما أن كلا من الوظيفتين موجهتان وجهة حفظ النظام، لضمان دوام صلاحية الإنسان لعمارة الكون، ودوام صلاحية الكون كمستقر لائق بالبشر، ويتساءل ماتيي: في مداخلة له بالندوة المنعقدة في المركز الثقافي [10](Bagnols/ceze) قائلا: كأننا على متن باخرة فإلى أين تسير هذه الباخرة وهل نركب جميعنا الباخرة نفسها؟[11].
ثم يؤكد أنه حينما تقحم الخصوصيات البشرية، المتسمة بتعددها واختلافها، في جرة واحدة تنمحي إمكانية "الاشتراك" حيث يهيمن المفهوم الغربي لتحجب المفاهيم الشرقية وغيرها، فلا توجد إنسانية صينية أو إنسانية مسلمة مع أنه يوجد إنسان صيني وإنسان مسلم ذلك لأننا لا نملك القيم نفسها[12]".
إن السعي العولمي لإيجاد إنسان كوني إنما ينطلق من محددات مفاهيمية أنشأها التصور الغربي للإنسان والكون، والذي يحدده الثالوث: الخوف من الموت والرغبة في السيطرة والحذر من الآخر وهو الثالوت الذي ورط البشرية في الأزمات منذ آدم وحواء: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِين﴾ (الأعراف: 19)؛ فالرغبة في الخلود خوف من الموت، والتّوق إلى منزلة الملائكة حب للسلطة، والرغبتان معا تقويان الحذر من الآخر، فتخرب بذلك قيمتي التعارف والاعتراف المسؤولتان عن صناعة عالمية تشاركية بدلا من عولمة حاكمة ومهيمنة.
ولذلك يؤكد ماتيي أن الإنسانية كمفهوم، صناعة غربية، كما أن الحربين العالميتين والإيديولوجيات الماركسية والفاشية والعنصرية.. اختراع غربي تدثر بـ"الإنسانية" التي جعلها الغرب واجهة دعائية لحماية بقائه؛ حيث يقول نعوم شومسكي (CHOMSKY)[13]: "جاء في الصياغة الرسمية لإستراتيجية الأمن القومي أن قوتنا يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية لثني الخصوم المحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية بأمل مضاهاة القوة الأمريكية أو تجاوزها". ويؤكد الخبير الأمريكي في الشؤون الدولية جون أيكنبرّي أنها إستراتيجية كبرى، تنطلق من الالتزام الجوهري بالحفاظ على عالم أحادي القطب، غير مزاحم للولايات المتحدة"[14]. وهكذا لا تكون الواجهات الإنسانية في الخطابات الغربية المصالحية، إلا مدونات مفاهيمية دعائية مضللة للفهوم من أجل إقبار المعنى، يقول اكنبريّ": ومن شأن هذه المقاربة أن تجعل المعايير الدولية الخاصة بالدفاع عن النفس، المكرسة في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، عديمة المعنى"[15].
أزمة المفاهيم في العالم الإسلامي المعاصر وتدمير عالم الوجهة
يواجه الجهاز المفاهيمي في العالم الإسلامي تسلطا عجيبا هو سلطة المفهوم غير القرآني، الذي استطاع أن ينشئ لنفسه موقعا، أتاح له التحكم في إنتاج مفاهيم غريبة عن التصور والمنظور والرؤية إلى العالم في القرآن المجيد، ومضاد علنا للوجهة القيمية البانية للحركة العمرانية البشرية العالمية، والتي رسمت معمار السعي الإنساني فوق الأرض في اتجاه الرجوع إلى الله في آيات لا تحصى، إن لم نقل أن الدلالة الخطابية في القرآن الكريم كله، تصميم هندسي محكم للحركة البشرية المستقيمة في الكون.
وقد تمكن المفهوم غير القرآني، مع شدة غرابته وعدائيته لقبلة قرآنية المنشأ، أن يتجزأ بذكاء وأن يغيب مصدريته كي لا تضيع قوة توسعه في عقل مستهلكيه ومن ثمة، الهيمنة عليه كما في السياسة التسويقية للمنتجات الاقتصادية المعلبة، التي يغيب صانعوها ولا تعرف إلا برموز وأرقام.. حتى لا تتجمع جزئياتها فيصيبها الوهن، وهي السلطة التي لا تقبل إلا أن تكون قوية، خشية مقاطعتها لأسباب سياسية أو دينية؛ كالمنتوج الصهيوني غير المرحب به عند المستهلك العربي والمسلم
والواقع أن ما يضمن انتشار وهيمنة المفاهيم الغريبة المعادية وجهتها لوجهة المفهوم القرآني، هو قابليتها للتفتت والتشتت والتبعثر، متمكنة بذلك من التخفي في شعارات مستعارة، لأجل التضلـيل وتصنيع اللامعنى، في غياب للقيم البانية للتصالح المعرفي بسبب المعرفة التي أنتجتها الأخطاء والإنكارات "حسب فوكو (Foucault)[16] كانت المفاهيم في نظره: "لا مركزية رغم مركزيتها" لأن المفاهيم سلطة تجيد بتبعثرها الاختباء، وفي قوة اختبائها تكمن القدرة على التسلل بدون رقابة؛ لأنها سيرورة بلا ذات، ولا عقل، ولا فاعل؛ ومن ثمة فهي غير ثابتة، وغير مستقرة، لتكون بذلك قادرة على التجول في كل مكان، والتحول من فضاء إلى فضاء بكل حرية.
إن السلطة المفاهيمية المتحركة في أوصال الفكر والفهم العربيين المسلمين، خلاقة لأنها تتسلل إلى العقول وهي متفتتة، حيث يصعب القبض على نواياها، أو الوعي بقدرتها المهولة على استدعائها لجزئياتها المبعثرة، بما يمكنها من التشكل من جديد بداخل العقل المستهلك، وليس خارج حصونه، حيث لا رقيب أو مانع فتتمكن آنذاك من ممارسة وظيفة "إدارة الفهم" بليونة فائقة وفق ما يخدم مصلحة الهيمنة والإزاحة لأجل البقاء.
لذلك كان أخطر ما في السلطة المفاهيمية أنها ليست قمعا شديدا، ولكنها ناعمة خلاقة، تبعثر الفكر والعقل المستهلكين لمفاهيمها ومنتجاتها المعرفية والاقتصادية، لتصنع الفوضى التي تهيئ لها المجال للتدخل لترتيبها بآلية مفاهيمية، تنتج مفاهيم جديدة توليها مهمة إدارة الفهوم حسب ما يمليه عليه تحيزها المصلحي؛
وهي بذلك قد تمكنت من رج الثابت من المفاهيم في عقول أصحابها، وخلخلته للانزياح به عن جادة وجهته الأصلية، بل نجحت في إقصاء أو إقبار، بيد مالكيها، المفاهيم المانعة للاختراق، لأنها تهدف إلى إعادة تشكيل المواقف من الذات ومن الآخر، لتكون قنينة الكوكا كولا، مثلا، مؤسسا في الإشهار للمحبة الأسرية المسلمة، لأنه شكل الرغبة المشتركة على أرض الواقع بين كل أفراد الأسرة صغارا وكبارا، ولتكون الفوضى (chaos) في العراق غداة سقوط بغداد خلاقة (creative) على لسان وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس "في 2005 لأنها متعمدة من قبل من نسجوا قصتها بإتقان، ليشخصها ضحاياها، فتتحول إلى مرجع للحركة في الكون لدى الذين تبنوها كاستراتيجية بديلة للرؤية إلى العالم؛ ولتكون داعش اليوم نموذجا أخر، لمن اختل عندهم الوعي بخطورة المفهوم؛
فبالرغم من العداء القائم بين داعش وأمريكا، فإن هذه ترافق مديري التنظيم الذي يحمل التسمية المذكورة، في أقصى سريتهم، ليس اعتمادا على آليات تجسس فائقة الذكاء (وهو غير مستبعد كإستراتيجية أمنية أمريكية)، ولكن من خلال جزئيات مفاهيمية تبذل داعش قصارى جهدها في إقحامه في فكرها، واستنباته في حقلها المعرفي عن طواعية، مصرة على تحويل وجهة المفهوم القرآني بما يمكن من إحلال المفهوم الغريب، وضمان مقبوليته في مدونتها المعرفية الجديدة، الشيء الذي انزلق بداعش في مغبة تنميطها لذاتها، والتوقيع على تحيزها المضاد لهوية انتمائها، لتوقع من ثمة بلا إكراه على تدمير معارفها الأصلية فتصنع حقيقتها على الطريقة الفوكوية التي أكد فيها فوكو أن الحقيقة لا وجود لها وأنها تصنع تصنيعا" عبر استراتيجيات متعددة تصنع بها قصتها الخاصة بتعبير (Paul Ricoeur) في خاتمة كتاب (Temps et recit)[17].
ورغم أن داعش تصنع قصتها الخاصة، إلا أن ورطتها يعلنها ادعاؤها امتلاك هوية إسلامية، الشيء الذي يوهن هذه القصة ويفضح أسطوريتها، لتولد هوية سردية ترتق الفجوة بين التاريخ والمتخيل، بما أنها تعجز عن إثبات الأصالة القرآنية في وجهة أفعالها الوحشية في الكون، بل تستند إلى المدونة السردية في كتاب إدارة التوحش لأبي بكر ناجي، المعتمد في صياغاته البيانات التدميرية على الفلسفة السياسية المعاصرة المستقاة من مفاهيم مادية عدمية عادمة في كتاب (Le Leviathan) الذي يعتبر الإنسان وحشا؛ حيث يهيمن في إدارة التوحش، جهاز مفاهيمي في خدمة التوحش، الذي قعد له كتاب "التنين" محددا به ملامح الذئبية البشرية المتوحشة.
والإستراتيجية في الفلسفة السياسية المعاصرة كما في التنظيم الداعشي، ذات وجهة متحيزة تنبت الأحقاد، وتؤجج نيران الكراهية من حيث احتفاؤها بالعداء كمخرج لاستعادة النظام، وتطهير المجال الكوني من الفوضى يقول صاحب كتاب إدارة التوحش:
إدارة التوحش هي المرحلة التي تستمر بها الأمة، وتعد أخطر مرحلة؛ فإذا نجحنا في إدارة التوحش ستكون تلك المرحلة دولة الإسلام المنتظرة، وإذا أخفقنا، أعاذنا الله من ذلك، لا يعني ذلك انتهاء الأمر؛ ولكن هذا الإخفاق سيؤدي لمزيد من التوحش"[18].
كانت وإذا الفوضى على الطريقة الأمريكية دينامية، ترسم ملامح وجهة كون يعترف بسيادتها؛ فإن الفوضى على طريقة داعش، متوحشة تخلق الفوضى باسم الإسلام، لتغرق العالم الإسلامي في تيه مفاهيمي يدعم الخطة الأمريكية لإبادة القوة الإسلامية الموحدة الوحيدة للشعوب المسلمة، ضمن إستراتيجية إضعاف الاعتراف الدولي بالإسلام والمسلمين، على أيدي من يدعون حمايته بسبب هذه الغيبوبة المفاهيمية التي غيبت قاعدة دفع المفسدة، فيقوم مفهوم التضليل الفكري على ما أساه المسمِِى أبو بكر ناجي بـ"مصلحة العمل الجهادي" يقول في الصفحة 7 من كتاب إدارة التوحش: "لذا فكما حذرناك أخي المجاهد من استهداف فئات تبعا لفتاوى أنصاف العلماء، فنحذرك أيضا من الكف والتورع عمن يجب استئصالهم رحمة بالمومنين ورفعة وانتصارا للدين تبعا لفتاوى أنصاف العلماء أو أقاويل أهل الإرجاف والجهل"[19].
هكذا ركنت الداعشية مفاهيمها في حقل أفسدتها اللوثة المفاهيمية، الأمر الذي يثبت كونها صناعة الذين يديرون ويدبرون أمور سياسة الفوضى الخلاقة، فكان النجاح منقطع النظير في التعريف المشوه للإسلام وتخريبي معابر التعارف والاعتراف بين المسلمين وغير المسلمين دعمها الانجراف وراء الخدعة التشويهية العالمية للإسلام من خلال تلويث التاريخ والفهم تارة بالزيادة والنقصان في القرآن المجيد وتغيير اسمه، وتارة أخرى بالاعتداء على النبي محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تسليما، بغاية ترسيخ العداء العالمي للإسلام والمسلمين، في غياب إستراتيجية فاضحة للمكر والماكرين؛ بينما شكل التعريف بالصهيونية حتى وهي في حلل مؤسطرة، عبر الخلط بين التاريخ والتخييل والنكهات المصلحية، جهودا جادة مبذولة في كل الواجهات، لتجميل صورة اليهود في مخيلة العالم.
والمؤسف أن أزمة الحضارة إنما انبثقت من أفول المقدس القيمي الذي صنع أنماطا من الواحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وهو خلل حصر الفعل الحضاري الإنساني في التحيز المفاهيمي الذي أجج الأزمة وزاد من احترارها، حتى تفجرت سيولا من التصادمات داخل النسق المعرفي الواحد وبين الأنساق المعرفية المختلفة بعضها ضدا على بعض.
والمفاهيم الغربية المصالحية، سلطة معرفية تهدف إلى صياغة القوالب والنماذج الضروري تبنيها كونيا لحفظ مصالح القوى الكبرى، وهي لا تعنى بصياغة القيم إلا بداخل هذه النماذج؛ إذ هي نسق فكري منسجم غير اعتباطي بل قصدي يخضع لتصميم هندسي محكم تتدخل في بنائه التصورات والتوقعات معا لذلك يحرص على تلقيها وتبنيها ليسهل تنفيذ برامج عمل وتحقيق من ثمة، الغايات الكبرى التي تتخفى وراء المفاهيم وهي لا تتشكل من الألفاظ والمقولات فحسب، بل تكون أحيانا كلمة واحدة أو إيماءة أو حركة أو شيء أو صورة... متصلة بالدفق الشعوري والرغبات والمخاوف في منتجيها بغاية تأجيج موقد الحماس في وعي الآخر لتلقيها وحفظها كمؤطر لرؤيتها إلى العالم بل لبناء لوحات جاهزة لرؤية الغير إلى العالم .
وللتحيز المفاهيمي بناء خطابي لا تتبين معالمه إلا حينما تنتهي اللغة أو حينما تنتهي السينما بتعبير رولان بارت (Barthes)، بسبب بنائيته التخييلية التي تتحايل بها على الفهوم لضمان إضعاف قوتها المعرفية وتقويض مشاعر الانتماء عندها لتتلقى، بلا مقاومة، أشكال السلوك المخطط لها فلسفيا وسياسيا واجتماعيا... لذلك تمعن البنايات المفاهيمية على تلميع واجهتها كي لا ينفضح نقصها من حيث اختلال منطلقاتها النفسية والفكرية وخلل وجهاتها إذ لا تعنيها سوى" حكايتها"الخاصة التي نسجت فصولها بداخل مفهوم مؤطر للمفاهيم الجزئية الأخرى في شرائط سينمائية متخصصة في الصناعة الفيلمية الغربية ذات انتماء صهيوني في تلميع صورة اليهودي في أقصى قرارات نفس وعقل الإنسان في العالم كله حتى في العالم العربي والإسلامي من خلال حياكتها لواحد من أهم القضايا في الحلم الصهيوني كمفهوم العودة في فيلم " هذه هي الأرض" 1935، ليتأسس في 1954 قانون سينمائي يعنى بالحركة السينمائية اليهودية كواجهة دعائية تدعم انتشار المفاهيم الصهيونية، بعد تقوية الجبهة العسكرية والاقتصادية كمفهوم العودة، ومفهوم أرض الميعاد.
كل ذلك لإيقاظ حلم "البداية" الذي سارعت الصناعة الفيلمية في السينما الإسرائيلية إلى إتقان إخراجه، من أجل استقطاب اليهود وتحفيز الهجرة إلى الفردوس "المعثور عليه" من خلال فيلم التلة 24 لا تجيب الذي يختمه مخرجه بكلمة واحدة هي كلمة "البداية" التي "تتحول إلى مفهوم يناصر الصهيونية، حيث رافقتها مصاحبات خطابية رافدة لمشهد "الموت بقبضة انتماء" التي حسم في شرعيتها من خلال بعض الموجهات الخطابية المملوءة كالطفولة، والموت، والعلم الإسرائيلي، والشهود وهم: جنود من الهاجاناه، وضابط القوات الدولية، وضابط أردني..
وجميعها مولدات لمفهوم الصهيونية الشرعية، حيث شكلت كلمة "بداية" في خاتمة الفيلم حمولة مفاهيمية تتناسل في رحمها معاني الأولوية والبقاء، ليكون المشهد السينمائي الأخير في الفيلم المذكور (المتضمن لمشهد الطفلة التي أحكمت قبضتها على العلم الإسرائيلي لحظة مفارقتها للحياة على تلة، 24 والشهود العرب واليهود والقوة الدولية) آلية خطابية قوية للانحراف بوجهة التاريخ، نحو قبلة مقصودة تستدعي كفاية أسطرة المفهوم، وجودة الحبك، وتوقد الوعي بقبلة المشروع الصهيوني كي ينير بضوء ناره، وجهة الفعل السينمائي الإسرائيلي، ولتصبح السينما في الرؤية السياسية الصهيونية، بعد ذلك، استراتيجية تحويلية للمفاهيم حيث سيوجه فيلم إيكسودوس (exodus) الرؤية السياسية وجهة جديدة، اعتبرت فيها الصورة الفيلمية استراتيجية قوية لتعديل الفهوم، وكسب الدعم العالمي..
ثم تحولت السينما بعد ذلك إلى مفهوم "الهولوكست" الذي شكل، كبؤرة سردية، موجها خطابيا، لإنشاء سلطة معرفية دائمة، تحكم القبض على الوعي العالمي، فكانت السينما بوابة مثالية لكسب السند الدولي، ومن ثمة إنتاج مزيد من المفاهيم الداعمة للتوسع الصهيوني من خلال براديغم "الهلوكست"؛
ففي 1960 وغداة النجاح الساحق الذي كسبه فيلم إكسوديوس تأكد للسياسة الصهيونية قوة السينما التأثيرية في تدبير الفهوم، خاصة مع ما حصدته من تبرعات لصالح القضية الصهيونية؛ ولم تخب جذوة التأثير التي أحدثها فيلم (Schinndlers liste) للمخرج (Spielberg) في الرأي العالمي والذي كان قد استوحاه من القصة الحقيقية للمسيحي الألماني (Schinndlers 1908-19) الذي أنقذ 1100 يهودي ويهودية من الهولوكست، وهو الفيلم والحائز على سبع جوائز الأوسكار وغيرها، بالإضافة إلى إحلاله المرتبة التاسعة في أحسن مائة فيلم ضمن قائمة المعهد السينمائي الأمريكي؛
ومع أن الإنجاز الذي أداه الرجل كان إنسانيا، إلا أن الصورة الفيلمية كانت ذات سلطة قوية ولكنها ناعمة لضمان التحيز الدولي للقضية الصهيونية، ضدا على القضية الفلسطينية؛ ومثله الفيلم الحائز على جائزة (cannes 2015) ابن شاؤول (the son of saul) لـ(laszlo nemes) تستعيد حكاية "المحرقة" لبناء، وبعين دامعة، التحيز الذي ينصر الصهيونية عالميا، منشئة بذلك إطارا معرفيا لتقبل الغير لمفهوم الصهيونية، حينما يصور الفيلم شاوول الأب الذي كان سجين النازية، ومكلف إلى جانب ثلة من المساجين اليهود بإحراق بني جلدتهم، ليعثر على جثة ابنه الصغير فيقرر، إنقاذها من نيران الهلوكست مصورا الحدث كمعاناة إنسانية تستدعي تحرك العالم من أجل إنصاف الشعب الإسرائيلي المقهور والمسالم أبدا؛
في حين عجز العرب والمسلمون عن نحث مفاهيم عبر الصورة الفيلمية لتحويلها إلى استراتيجية بصرية تقود العالم إلى الاعتراف بالظلم الصهيوني للعرب وللمسلمين، وتعرض الإسلام لمكر لتخريب قوته وإضعافه في نفوس المسلمين وغير المسلمين، وإتقان عرض العديد من الوسائل التخريبية التي دبرتها السياسات العالمية لإبادة الإسلام والمسلمين والعرب لصالح المد الصهيوني والمصلحة الغربية، بل وما زالت السينما العربية محبوسة في قضايا جزئية تدعم أسطرة الواقع، وتتغيى إمتاع المتلقي، أو تهيئته لتقبل الهيمنة المفاهيمية الغربية والأمريكية والتحيز لها.
ولا يخفى ما للصورة من تأثير في بناء التصورات وتصنيع المفاهيم؛ فالمشهد أو اللقطة لا يحبسها صانعها في تشكيلها المعنوي المسطح، بل يجعلها مساحة مسكونة بالثقوب، مفتوحة على آفاق دلالية تستدعي من المتلقي قوة لاختراق تلك الثقوب والبحث عن الاحتمالات الدلالية القابعة في قعر الأسناخ الدلالية، أو التحليق حول المعاني في كل الاتجاهات للقبض على الغائب المسكوت عنه في النص الإبداعي وفي محيطه.
ولعل ما دعم البعد التحويلي للصورة في الفيلم الصهيوني هو من جهة، بنائيته التي تعاضد فيها التخييل والتوثيق؛ ومن جهة ثانية، تراكميته التي ملأت المساحة الزمنية الممتدة من 1932 إلى اليوم بشرائط سينمائية لأسر الوعي العالمي وربطه أبدا بالقضية اليهودية والصهيونية، لضمان استمرار حياة المفهوم الصهيوني الذي ترعرع مع الحلم اليهودي بالهيمنة لأجل البقاء.
ولا يمكن للكلمة أو للصورة أن تتلقيان في معزل عن صانعهما، ليس من أجل تبجيل الصانع، ولكن وعيا بمنظومية المفهوم، وترامي، مما يستدعي عدم التغافل عن دور صاحبه في نسجه وحياكته، بما توافر لديه من معارف وتصورات، وخطوط، وجهات، ومسافات...
إن للكلمة والصورة وظيفيتهما في تأثيث مخيلة المتلقي بمفاهيم لها قوة إزاحة غيرها وإحلال ما يسهم في تحويل الفهوم عن جهتها وتعديل وجهتها حين ترج تراكميتها المعرفية مفتشة عن مراكز التحكم في مواقع التفكير والشعور لتدبير التحكم في مفاهيمه حتى حينما يطبع العداء العلاقة بين الصانع والمستهلك.
لقد بات من الآكد أن صناعة المفاهيم لا تتم في معزل عن موجهات الفهم، ومن ثمة كان التحرر المفاهيمي مدخل لتملك هوية معرفية قادرة على حماية الأمن الوجودي للذات في الكون لذلك كانت دعوة بكالي (yves paccalet) كحل للخروج من "الأزمة الدائمة" إلى نبذ ثقافة الاستهلاك داعيا إلى اعتناق ما يسميه: "فلسفة القليل" (la philosophie du peu) القادرة على إعادة تدبير أنانية البشر من أجل استعادة سعادته التي ينبغي أن يبنيها في غياب الاستهلاك الذي يؤجج الشعور بالحاجية المتنامية والمتجددة أبدا (ص74) معلنا عدائيته الفكرية ضدا على ما أحدثته الصناعة من تدمير لإنسانية الإنسان ساخرا من "مفاهيم النمو والتطور "التي تقرع الليبرالية الجديدة بها أسماع الناس[20].
ويخلص هذا البحث إلى:
ـ أنه قد تم التأسيس للعبث في العالم، ليستمد كثير من المسلمين فهمهم للكون وللذات، وللكتاب الموجّه من كوّة فهم الآخر، بناء على لوحة العالم المفاهيمية الغربية، المتحولة باستمرار، غير المستقرة معرفيا، فتحولت بذلك فهومهم عن وجهتها، وعن قبلة وعيها بحسيس الكون من حولهم؛ فأصبح النص من ثمة، مفتوحا ينتج معارف حرة تتلاءم مع الرغبة، والانعتاق، والحرية، في معزل عن كل موجه أو مقصد.
ـ إن الأمن الفكري في المعرفة الإسلامية قد رأى في ظل هذه الواحدية، الغارقة في الانفصال والفوضى، بلا ضابط معرفي ثابت، معتمدة على ما رسم في لوحة المفاهيم الغربية، ليتم تهجيره بتعسف وبلا حذر، في غياب وعي تسييقي، يصل معرفة الآخر بمحددات وعيه في بيئته الرؤيوية.
ـ إن الإسلام اليوم في حاجة إلى فهوم حرة تعمل في اتجاه إنشاء مدارات فهمية قوية تصل الحق بالحق، لا الباطل بالحق، تستمد قوتها من رقي الهدي النبوي، عندما لم يردّ أخلاقا تشترك مع الإسلام في انتصارها للحق، حتى وإن كانت ملكا للمشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "جئت لأتمم مكارم الأخلاق" ليظهر بجلاء انفتاح الخطاب الشرعي، وبنائيته، واتصاله بالأصول، بما يحفظ للحق منظوميته من حين بدأ السعي الإنساني فوق الأرض، إلى أن يرث الله أرضه وما عليها، فتنشئ بذلك قاعدة من قواعد المنهج التعارفي الذي لا يلغي الآخر بل يدعمه ليكتمل تحقق الحق في الكون رؤية وسلوكا.
وتبقى قضية الختم في هذا البحث؛ هو كيف نبني لوحة مفاهيمية توجه وجهة بناء الشهود الحضاري، حيث يتعاون لتشييده كل من الوجهة السليمة، والقبلة الحق؟
الهوامش
[1]. henri maldiney: REGARD/parole/ESPACE ed. l age Homme P.151.
[2]. Jean-François Mattéi, la crise du sens, nantes Éditions Cecile Defaut, 2006.
[3]. Thomas HOBBES, Léviathan : Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, Traduction originale de M. Philippe Folliot, 2002.
[4]. F.MATTEI- la crise du sens, op.cit, P 24.
[5]. Ibid, p107.
[6]. Ibid, p105.
[7]. Ibid, p107.
[8]. Ibid.
[9] . مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، رقم الحديث: 1689.
[10]. la gouvernance mondiale: utopique ou ineluctable?
وذلك يوم الثلاثاء 24 نونبر 2009.
[11]. F.MATTEI- la crise du sens, op.cit, P 24.
[12]. MATTEI, la gouvernance mondiale, mardi 13 novembre 2009.
[13] . نعوم شومسكي، الهيمنة أم البقاء: السعي الأمريكي للسيطرة على العالم، ترجمة: سامي الكعكي، بيروت: دار الكتاب العربي، د. ط، 2004، ص19.
[14] . المرجع نفسه.
[15] . المرجع نفسه.
[16] . ميشال فوكو، إرادة المعرفة، ترجمة: جورج أبو صالح، بيروت: مركز القومي، 1990، ص35.
[17]. Paul Ricoeur, Temps et récit, Tomes 1, 2 et 3, Paris, Éditions du Seuil, 1983, 1984 et 1985.
[18] . أبو بكر ناجي، إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة، مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، ص4.
[19] . المرجع نفسه، ص7.
[20]. YVES paccalet, Sortie De Secours.. Les Solutions Pour Sauver L'Humanite, JAI LU, PARIS, 2007, P. 74.