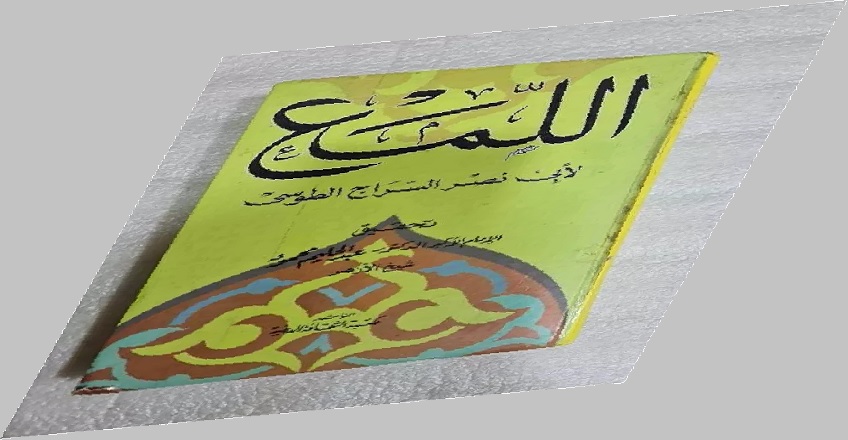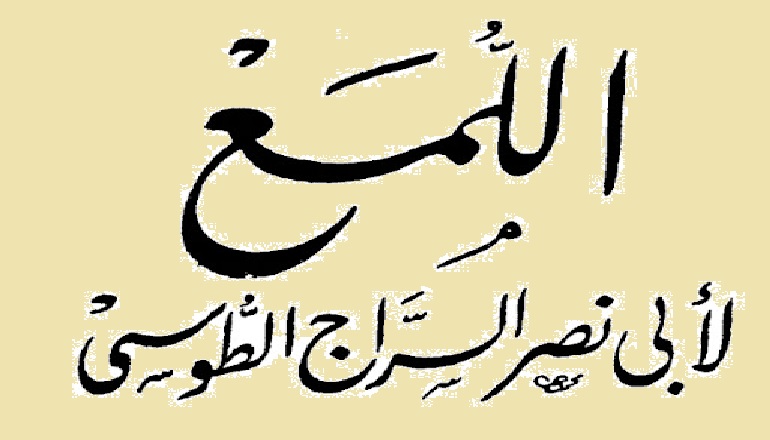يعتبر عدد كبير من الباحثين الغربيين أن المجال التراثي الإسلامي مليء بالإيحاءات الفنية والجمالية، توزعت بين اللغة والهندسة النباتية والزخرفة والعمارة والبستنة... وغيرها. لكن الملاحظ هو جنوح عديد الدراسات نحو حصر الإبداع الجمالي في التراث الصوفي؛ بناء على قناعة نابعة مما يعرف عندهم أن الإبداع الفني لم يكن في المجال الإسلامي سوى بإشراق الروح؛ وقد تجسدت خصوصا في الشعر، وطرق الشفاء والتداوي، والحرف اليدوية المتنوعة، وقد تطورت المملكة الأولى في نظرهم في رحاب الحب الإلهي وانتقلت من فن الشعر إلى تجسيد التغني والعشق في لمسات معمارية جمالية على الأرض؛ تمثّلت في الانسجام بين الممالك الثلاث؛ حيث التغني بالأشجار النادرة وقدرتها على الشفاء وارتباطها بسكنى ومقام السالك، ليكون في ملكوت بديع يضاعف جرعات حبه لمعبوده.
هذا الإيحاء الإبداعي الجمالي منتشر في الكثير من مناحي التراث الإسلامي؛ سواء تعلق بالظاهرة الجمالية في لغة القرآن أو في الخط العربي الذي كتبت به المصاحف العثمانية أو في العمارة الإسلامية ومظاهرها المتنوعة في كل بيئة من البيئات المتعددة في العالم الإسلامي.
لكن قناعة المستشرقين تنحصر في أن المسار الذي يسلكه المريد الصوفي والمحكوم برؤية أخلاقية وقيمية؛ هي التي فسحت المجال للمسات فنية جمالية شفافة؛ إنسانية في صميمها، تجلّت خصوصا في ثلاثية الأبعاد المؤسسة على المقامات والأحوال.
وهذه الورقة قراءة نقدية مفتوحة في "دفاتر المستشرقين" الذين تتبعوا ودرسوا فكرة ثلاثية الأبعاد الصوفية وآثارها الفنية والمعمارية؛ منهم "روبرت ديفز" و"ريتشارد بيرتون" و"هايدن" صاحب "قاموس التاريخ" الذي ينقل عن مؤرخين غربيين قولهم إن المعماريين المحمدين القادمين من الساحل الإفريقي هم الذين جاؤوا بفكرة "الدرجات المتعاقبة" إلى إسبانيا في القرن التاسع[1]، ويقصد بالدرجات المتعاقبة المسالك الروحية التي يمر بها السالك والصادرة عن تصور معماري فني.
وهو الكتاب الذي يعد شبيها في نمطه بكتاب العالم الباكستاني"إدريس شاه"؛ من حيث الطابع المعلوماتي الموسوعي الشامل، ومن حيث الإحاطة بظاهرة التصوف وتأثيراتها في الدين والحياة والإنسان، ممزوجا بمشاهد ثرية ومتنوعة حول تجليات الظاهرة الصوفية؛ شرقا وغربا وعبر الأزمنة، بما يولّد لدى المتلقي والقارئ من جميع المستويات صورة واضحة وفنية مدعومة بزخم معرفي غني من الأفكار والأسماء والعلاقات والرموز والحكايات والدلالات. وبذلك نرصد التطور الحاصل في بنية المعرفة الجمالية الإسلامية بعد مسيرة قرون، وقيمتها التطبيقية في الفن القديم والمعاصر، متلمسين الجذور والآثار والرصيد المستفاد، مناقشين بعض الشبه الحداثية التي ترهن الجمال بالحداثة؛ فالحداثة معمار جمالي يلبس الكون كما قال الفيلسوف "هايدغر"[2] ومن سلك طريقه، مستكثرين على الحضارة الإسلامية الإبداع الفني والجمالي الذي أصبح يوثق لعقلية التحضّر اليوم.
ولا يسعنا في هذا البحث إلاّ محاولة استقصاء وقراءة ما جاء في "دفاتر المستشرقين" الذين تتبعوا ودرسوا فكرة ثلاثية الأبعاد الصوفية وغيرها من الأبعاد الجمالية الإسلامية وآثارها الفنية والمعمارية، انطلاقات رؤية نقدية لحصر البعد والمجالي في السياق الصوفي.
أولا: الجذور الفكرية للجمال في التراث الإسلامي
هناك مبدأ مشهور يحكم الصوفية عموما في نظر جل المستشرقين؛ هو البحث المستمر عن الكمال المؤدي إلى العرفان التام؛ باعتبارهم أهل عطش إلى الحقيقة؛ حيث الغوص في البحار بحثا عن الكنوز؛ يقول بشر الحافي: "الصوفي هو من صفا قلبه لله"[3]، ويقول معروف الكرخي عن التصوف: "هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق"[4]؛ فلذلك اُعتُبر بأنه تجربة روحية سعيا للوصول إلى الله، قد تسفر عن تأملات عقلية أو رؤى فنية بالغة العمق أو كمال ديني وخلقي شديد التعلق بالأصول.
من هنا انبثق مفهوم السير من الحسي إلى المجرد؛ حيث التجرد التام من العلائق الدنيوية للوصول إلى مقامات العارفين؛ وهذه الرحلة تستغرق وقتا وجهدا وأطوارا. وقد عدّ بعض الباحثين التصوف فاعلية تقوم بها حاسة كونية متعالية؛ فهو كالفن لا وجود له من دون عاطفة جامحة؛ لأن الفن ينبع من أعماق النفس؛ ويتحوّل عبر الخيال الخلاق إلى واقعة شعرية أو لمسة معمارية أو صورة معبّرة؛ فهو ارتقاء نحو الأسمى والأجمل في النفس.
ولكي لا نقع في التعميم المفرط؛ لابد لنا هنا أن نؤكد وجود اختلافات فكرية ومعرفية ومنهجية بين مجموعة الاتجاهات الصوفية؛ رغم انقياد معظمهم وتحاكمهم إلى المبدأ الذي سقناه؛ وهو البحث عن الكمال؛ فهذه الرغبة لم تلزم طريقا واحدا عبر الزمن الصوفي؛ بل شهدت تناقضات كبيرة بين الاتجاهات الصوفية في طريق العرفان، لذلك اختلفت مقاربات تحديد مصطلح التصوف ذاته حسب المنهل المعرفي؛ فمنهم من يعتبره "حب المطلق"[5] كي يميّزه عن طقوس الزهد الأخرى ويجعل من هذه الصفة الميزة الرئيسة بين التصوف الحقيقي والتصوف المزيّف؛ لأن حب الإله يجعل المريد يتحمّل كل الآلام والمصائب؛ بل ويتلذّد بها، وهو الحب الذي يمكّن قلب المحب من الوصل والاتصال بالحبيب.
وهذه الصفة لم تلبث أن انقلبت بعدا ونمطا لماهية الشخصية الصوفية وبُعدا في بنية نظرية المعرفة الصوفية؛ فالخبرة الصوفية كما فسّرها أصحاب الحب المطلق على ثلاثة أنماط[6]:
النمط الأول؛ البحث المتواصل عن الله؛ ويرمز له بصورة طريق يجب على السائح أن يسلكه صعودا؛ واصطلح عليه بطريق التدرج أو الارتقاء أو معراج الروح.
الثاني؛ ما يعبّر عنه بتربية النفس بالابتلاءات وتنقيتها بأنواع الكلام.
الثالث؛ إشارات اقتُبست من الحب الإنساني؛ عُبّر بها عن لوعة المحب وشوقه إلى التوحّد. وذاك ما أنتج خليطا من المذاهب؛ تأرجحت بين وحدة ابن عربي وحلولية الحلاج.
على أننا في هذه الدراسة نَفصِل بين نمطين:
- صوفية اللاحدود.
- صوفية استبطان الذات.
فقد كان التأسيس الفكري للنمط الأول خليطا بين الأفلاطونية ومصادر خارجية أخرى؛ كالنصوص الدينية الفيدانتية الهندوسية؛ وخاصة فلسفة "شان كرا"؛ حيث تلتقي مع وحدة الوجود الصوفية في تعريفهم الإله؛ بأنه وجود كل الوجود[7]، وأحيانا بأنه العدم[8]؛ لأنه لا يمكن وصفه من خلال أيّ نوع من التفكير المحدود؛ فالذات الإلهية لا متناهية وبلا زمان وبلا مكان؛ وذاك هو الوجود المطلق.
وقد كان هذا النمط ولا يزال موضع هجوم من جمهور المسلمين؛ لاعتبارات عقدية ومعرفية تتعلق بمنهج البحث عن الحقيقة ذاتها؛ حيث تم الخلط ما بين عالم الشهود وعالم الغيب؛ مع أن العقل كأداة للمعرفة يؤكد هذا التمايز والانفصال.
أما النمط الثاني والذي ستنصب دراستنا عليه؛ وهو علاقة استبطان الذات في التصوف؛ وهي العلاقة التي تكون بين الإنسان وبين الله؛ وهي علاقة خالق بمخلوق؛ أساسها حب ولهفة العبد لحبيبه وسيّده، وهذا النمط عرف أيضا باتجاه "الإرادية"؛ من حيث سلوك الصوفي الطريق الذي يوصِل إلى "التخلّق بصفات الله"، واستمداد إرادته من إرادة الله استمدادا كليا لا اعتماد على أحد سواه.
وفي ظلال هذا الاتجاه تشكّلت العقلية العملية لدى الصوفية؛ بحيث انبثقت المقامات والأبعاد والأحوال والمراتب. وقد جعل الصوفي الكبير الهجويري (توفي465ﻫ) مقامين للوصول إلى مرتبة المشاهدة؛ الأول: القرب، والثاني؛ التبجيل؛ ويقصد بالقرب الدوام على الطاعات والقربات؛ حيث يبتغي التقرب إلى الله بالأفعال. بينما يقوم التبجيل على التأمل والتفكّر والتدبّر وقوة التضرع: "ففرق بين مَن يتفكّر في الأفعال، وبين من تحَيّر في الجلال؛ فواحد من هذين يكون رديف الخلّة، والآخر قرين المحبّة"[9].
وقد كان لجهود الجهويري مُضافة إلى ما قام به أبو القاسم المحاسبي الأثر المهم في إعادة التصوّف إلى سيرته الأولى والتخلص مما علق به من بدع وشوائب أبعدته عن هدفه السامي المتمثل أساسا في التزكية النفسية المثلى؛ وهي نبراس التجربة الصوفية كلها، ولعل أهم ما يشتركان فيه الربط بين الشريعة والحقيقة؛ حيث بيّنا أن الشريعة دون الحقيقة ليست إلاّ رياء، وأن الحقيقة دون الشريعة ليست إلاّ نفاقا.
وقد تطوّرت مراحل الطريق عند الصوفية لتصل إلى مرحلة من النضج اتضحت فيها المقامات والأبعاد والتجليات. ففي باب المقامات؛ تأتي التوبة كمقام أول يمر به العارف الصوفي، ويقوم مفهومه على جانب عملي مهم؛ وهو الإقلاع عن الذنب وعن كل ما يتعلّق بالدنيا، لذلك فهو بوابة العرفان ومفتتح الطريق. وقد برع المتصوفة في التمهيد لهذا المقام؛ واستعيرت أبلغ العبارات والأساليب في ذم الدنيا والحط منها والترغيب في الآخرة، واستثيرت الحاسة الشعرية لترسم مملكة فنية في توبة العارف الصوفي؛ ومن بين ما قيل في هذا المجال في التوبة؛ ما جاء في المثنوي: "التوبة دابة عجيبة، تقفز في لحظة من أدنى موضع إلى السماء"[10].
لقد اعتُبر التعلق بالدنيا عند الصوفية من أكبر أسباب صوارف القلوب، وتشويش الأفكار، ومعكر صفاء ونقاء السرائر والخواطر، وقد شُبّهت الدنيا ببيت الخلاء الذي لا يطلبه المرء إلاّ في حالات الضرورة[11].
لذا كان المقام الثاني والذي يأتي بعد التوبة؛ مقام الورع، بُغية البُعد قدر المستطاع والمُكنة عن مرحلة ما قبل التوبة، وسد الأبواب بإحكام لدخول الفتنة مجددا، وعليه فرّ المريدون من المدن واستقروا بالبراري[12]، أو اخترعوا لأنفسهم أحياء وفق أنماط معمارية خاصة تتيح للصوفي الخلوة والتبتل وتفصله عن العالم الخارجي، وتلبس السترة على أهله وآل بيته[13]، وهذا ما نجده في الأحياء الدمشقية القديمة ومناطق من الفسطاط في مصر، وكان للإرادة والعزيمة المستنبتة من عمق الذات الأثر في الخيال الواسع الذي مكّن الصوفية من تشييد هذه المدائن الجديدة الاستثنائية.
بل إن الخروج إلى البراري زهداً وورعاً كان في غاية التناسق مع ما هو موجود داخل هذه المدن الاستثنائية؛ من حيث آلية استبطان الذات والكشف، فقد أصبحت في قناعة الصوفية كل زهرة في البراري لدى العارف الزاهد لسانا يسبّح بحمد الله، وكل ورقة فيها أو في نويرها بمثابة كتاب يمكن للمرء أن يقرأ حكمة الله فيه؛ فالله قد وضع آياته في الآفاق وفي النفس البشرية، وما على الإنسان إلاّ أن يتعرف عليها، وذاك سبيل العارفين؛ فزهرة الزنبق تسبّح للّه في صمت بعشرة ألسنة، والبنفسج يجلس متواضعا في ثوبه الصوفي ذي اللون الأزرق القاتم؛ واضعا رأسه على رُكبة التأمّل، والسواسن الحمراء ذات النقط السوداء في القلب يمكن أن تنمو في الفؤاد المحترق لدى المحبـوب، أو يمكن أن تذكّر الصوفي بقلوب المنافقين السوداء، والنرجس ينظر بعينيه الرطبة المشدوهة إلى الخالق، أو يجعل المحب يفكّر في عيني المحب الناعستين، كما أن العيسلان المجعّد القاتم يشبه تجاعيد المحبوب المفارَق من الأهل والآل[14].
وهكذا فإن الفضاء الطبيعي المفتوح لم يكن لدى الصوفي هربا من الحياة، أو تعبيرا عن الفشل الاجتماعي وعدم المكنة على مقاومة الفتنة المدينية، بل الذات المحبة الشاعرة هي التي سعت لهذا الملكوت، لتجوب في بدائعه وتُحوّله عبر الخيال الخلاق إلى جنات مصطفة منتصبة أمام البيوت التي شيّدوها وفقا لشخصيتهم المعمارية الاستثنائية، والتي تثير فيهم التسبيح بعمق وذوبان لخالق هذا الجمال ومن ذات شفافة مليئة بالحب لكل مظاهر الوجود؛
يشرح ذلك المفكر امبرتو إيكو بقوله: "يعد الإنسانُ جزءًا من كلّ، نُطلق نحن عليه اسم"الكون"، وهو جزء محدود في الزمن والمكان، إلاّ أننا نراه يضع نفسه وأفكاره ومشاعره موضع التجريب؛ كأشياء منفصلة عن الآخرين من بني جنسه، وهو ما يهبط به إلى نوع من الخداع البصري لوعيه، وهذا الخداع أو التوهّم ليس سوى نوع من أنواع السجون بالنسبة إلينا؛ حيث يقلص وجودنا إلى رغبات شخصية وقدر محدود من الحب لعدد محدود من الأشخاص الأكثر قربا منه. وتتلخص مهمتنا في تحرير أنفسنا من هذا السجن عن طريق توسيع دائرة حبنا حتى نحتضن كل الكائنات الحيّة ومجمل مظاهر الطبيعة في جمالها الفتّان"[15].
إن هذا التناغم الخلاق بين الذات الباطنة للصوفي والطبيعة الغناء لم يُحصر في الفيافي والقفار والبراري والغابات؛ بل نقله الصوفي معه أينما حلّ وارتحل، وأدت تأملاته ومبثوثاته في محاكاة هذا الجمال إلى تأثر قطاعات واسعة من المجتمعات الإسلامية به وبالتصاميم الخيالية التي صوّرها الزهاد من الصوفية، ثم نقلت هذه التصاميم من التصور إلى التطبيق؛ في الدور والمنازل والأحياء التي سكنها هؤلاء العارفون؛ بل انعكس ذلك أيضا على زخرفة المساجد؛ ولذا كان القرن الرابع والخامس والسادس انعكاسا لشخصية الأبعاد الصوفية في التفكير ونمط الحياة؛ حتى أن معمار الآستانة وقونية وغيرهما من البلاد التركية المتأثرة بعرفانية جلال الدين الرومي تعد تجسيدا لنمط التأمل العرفاني الصوفي الناتج عن بُعد ومقام الورع.
ويذكر المستشرقون استخلاصا من مصادر الفن الإسلامي أن المسجد الكبير في وسط مدينة "قونيا" وأمثاله في الأندلس؛ يحاط بها في الغالب العديد من المساجد الصغيرة والمدارس؛ وإلى جانبها البلاط الرائع ذي اللون الأزرق الفاتح والأخضر في قبّة ذلك البناء المزخرف؛ فمن المثلثات التركية والمغربية على شكل خمسة في أربعة؛ والتي تحمل اسم النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، والخلفاء الأربعة وأسماء أنبياء آخرين ترتفع قاعدة القبّة، تتخلّلها النوافذ؛ مزيّنة بآيات من القرآن بخط كوفي منقوط شديد التعقيد، والقبّة ذاتها مغطّاة بنجوم متشابكة في مهارة مرسومة بقطع البلاط ذات اللون التركوازي الأخضر واللون الأزرق والأسود والأبيض؛ حيث تشكّل كل واحدة منها نموذجا منفردا بذاته، غير أنها مرتبطة بالقطع الأخرى بطريقة تفوق كل وصف، وقمة القبّة مفتوحة كي ينعكس شكل السماء وشكل النجوم باللّيل في حوض الماء الصغير الموجود في وسط المدرسة[16].
وهنا لا تكتمل الصورة دون المرور على المقام الثالث لدى الصوفية وهو "التوكّل" وصلته الفكرية بالموضوع المطروح للنقاش والتحليل. فمع التوبة ثم الورع الذي جعل الصوفية يقيمون في أحياء خاصة ووفق أنماط خاصة، وكذا خروجهم إلى البراري والفيافي للتأمل والتسبيح والاستغفار، وزهدا في دنيا هي عندهم مزبلة يتكالب عليها الكلاب، فإنهم لم يكِلون أمرهم إلى الله دون تقديم الأسباب وتحصيل الطرق المؤدية إلى استغنائهم عن مد اليد وطلب العون من الخلق؛ كما قال الشبلي: "الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق"[17]، بل أخذوا بمفهوم التوكل القرآني في الكد وطلب الكسب والاجتهاد وترك النتائج لمسيّر الأحوال والأسباب، وعليه فقد ابتكروا في مجال الطب العلاج بالأعشاب، وفي القوت أصناف من النبات لم تكن معروفة على عهدهم، ثم انتبهوا إلى الفخار والحرف اليدوية المختلفة التي نسجت أبهى السجاد وأجمل أنواع الأفرشة من الخيوط المستخرجة من النبات.
ولعل في هذا المقام تأكيدا للفكرة التي آمن بها المتصوفة من أن الزهد والورع المؤديين إلى التطهّر والتجرّد من الدنيا؛ لا يعنيان المفارقة والاعتزال التام؛ بل المعنى يكمن في ضرورة التمييز بين الحقيقة والجوهر؛ وأيضا إمكانية الجمع بين ضرورات الجسد المادية ومتطلّبات الروح وتطلعاتها الأخلاقية: "فليس الرجل الذي يعرف تفريق الدنيا فيُفرِّقها؛ وإنما الرجل الذي يعرف كيف يمسكها فيُمسكها"[18].
وهكذا فإنهم يعتبرون الصوفي الحق لا يصير كاملا إلاّ بعد خروجه من مقام الزهد والتطهر من الدنيا إلى مقام البقاء والتمكين في واقع العالم الإنساني المعيش، وهنا يُفرّق بين الرهبنة والزهد في مغزى قصة وقعت بين الصوفي أحمد بن الحواري (توفي 230ﻫ) وبين أحد رهبان النصارى المنقطعين؛ حين سأل ابن الحواري ذلك الراهب: "أما كان يستقيم أن تذهب معنا، هاهنا، في الأرض وتجيء، وتمنع نفسك الشهوات؟ فردّ الراهب: هيهات!هذا الذي تصف أنت قوّة؛ وأنا في ضعف"[19] وهو نص مهم يثبت ابن الحواري الصوفي من خلاله أهمية وقيمة الزهد والتطهر والتجرّد من الدنيا، واعتراف في الآن نفسه بقيمة النزول إلى العالم والعيش في وسطه. ومن هنا برز ما يصطلح عليه بـ"مشكلة المسؤولية الإنسانية"[20] عند الصوفية ومفكري الإسلام عموما، وتمظهر اتجاه الإرادية داخل الإطار الصوفي من خلال مقام التوكل؛ حيث الكد والاجتهاد في تحصيل سبل المعيشة لتحقيق الكفاف؛ والذي به فقط يتحقق الاستغناء عن الخلق..
وهو ما أدى كما رأينا إلى نشوء الحرف اليدوية وصناعة الفخار والطب التقليدي النباتي، وعند ذاك اكتملت ثلاثية الأبعاد الصوفية؛ وتمحورت حولها المنهجية الروحية والعملية، حيث تم المسير في نطاقها من خلال ثلاثية أخرى؛ مع حال المحبة، وحال الخوف، وحال الرجاء؛ بل إن المقامات والأحوال لتتجسد في مملكة واحدة حسب تحليل الدارسين للوعي الصوفي[21]؛ ألهمت العارفين والسالكين تدفقا عاطفيا وخياليا رهيبا في الشعر والعمارة والزخرفة؛ ألا وهي مملكة الحب، فلقد كان موضوع المحبة معينا لا ينضب؛ جعل الصوفية يبتكرون مراحل متفاوتة وأقوالا متعدّدة؛ لتُضاف إلى المصطلحات المميّزة في عالم استبطان الذات؛ كالود والمودة، والأنس والقرب والشوق... إلخ.
وحسب العديد من المستشرقين؛ فإن هذه الممالك الفنية وقبلها المقامات والأحوال والمصطلحات، ثم في مرحلة لاحقة الرموز والإشارات والصور؛ تساعد في تطور المعجم الصوفي وإتاحة الفرصة لرفع الستار عن بنية التفكير العميقة لدى الصوفية، وتمكّن الدارسين من تمهيد الطريق أمام أبحاث ونظريات تؤسّس علميا للدور الذي لعبه الصوفية من خلال فكرة ثلاثية الأبعاد "مقامات وأحوال" في تطوّر اللغات والآداب والفنون الإسلامية.
ثانيا: الإطار المعرفي للجمال الإسلامي في نظر المستشرقين
بعد أن حدّدنا الإطار الفكري الذي نشأت فيه فكرة الجمال ونظرية ثلاثية الأبعاد الصوفية التي يعتبرها جمهرة من المستشرقين أساس الفن والأبعاد الجمالية المجسدة في التاريخ الإسلامي، لابد من إعمال النظر في المستند المعرفي الذي انبثقت عنه وتبلورت كلمسة شعرية أو لمحة فنية أو نمط معماري. فكيف لنهج عرفاني أن يتحول إلى تجربة فنية جمالية؛ كان من المنطقي أن ينتهي في رحاب التعبد والتنسّك؟ كما أن التصوف معراج روحي وفق مقامات يستهدف غاية مخصوصة؛ فهل هذه الرحلة بأبعاد المقامات تنتهي إلى إدراك اليقين أو مكاشفته؟
فمن المعلوم أن نظرية المعرفة الإسلامية تتوفر على مميّزات غير متاحة لغيرها؛ فهي تأخذ بالطاقات الإنسانية مجتمعة؛ من عقل و روح وحس؛ مضافة إلى الأصل وهو الوحي الرباني؛ فهي ليست تجريبية، ولا عقلية خالصة، ولا باطنية، أو مثالية، ولا نقلية خالصة، بل تتّسم بالشمول والجمع بين المصادر؛ حيث تدفع التناقض وتحقّق اليقين، كما أنها تعالج الموضوعات جميعا بمناهج متفاوتة؛ ولذلك تتكرّر وتظهر مصطلحات معرفية جديدة في إطارها العام؛ كالشعور والإدراك والتصوّر والفهم والفقه والحكمة والرأي والفراسة والبديهة والتأمل والنظر والخبرة والكشف والتجلي...إلخ.
ويمكن أن تُرد المعرفة الإسلامية من حيث موضوعها إلى مصدرين مختلفين[22]؛ أحدهما يذهب نحو الأسفل: "تجربة حسية، إحساسات، ذاكرة، مخيِّلة"، والمصدر الآخر يتجه نحو الأعلى: "مبادئ العقل الخالص والمفاهيم العامة"، وتكون المعرفة تبعا لهذين المصدرين؛ إمّا أرضية (مادية)، أو ماورائية (غيبية). ولو شرحنا أكثر فإننا نأخذ بأداتي المعرفة وهما: الحِسّ مِن سمع، وبصر، وغيرهما، والعقل بدلالاته المتنوعة مِن: ملكات الإدراك، والفهم في الدماغ، والقلب، واللب، والفؤاد..
ومن ثمّ فإنّ معرفة المسلم حول موضوع معين، تأتي عن طريق الجمع بين القراءتين أو القراءة في المصدرين: الوحي والكون، ونتيجةٌ للجمع بين وظيفة كل من الأداتين (الحس والعقل)، ويتعاون مصدرا المعرفة، كما تتعاون أداتا المعرفة، في تزويد المسلم بالمعرفة.
لكن معرفة المسلم سوف تبقى على أية حال معرفةً بشريةً، تُنسب إلى الإنسان، وهو يتصف بها. وهي أمر مختلف عن عِلْم الله سبحانه، وعِلْم الملائكة، وعِلْم الكائنات الأخرى. فعلمُ الله مطلقٌ، وعلمُ الإنسانِ نسبيٌ يزيد وينقص، ويصح ويخطئ، وعندما يُعطِي اللهُ الإنسانَ شيئاً من علمِهِ، ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 151)، فإنّ ما يكتسبه الإنسانُ من هذا العلمِ يصبحُ جزءاً من العلم البشري، ويبقى محدوداً بدلالاته ومعانية بحدود الإدراك البشري[23].
وبتفاعل المصدرين تتولد أحكام ورؤى وتصورات؛ تتألّف من:
ـ أحكام متعالية عن الوجود الحسي للإنسان ومرتبطة بعالم الغيب.
ـ أحكام قيمية توجّه الفعل البشري في دائرة الحياة الاجتماعية.
ـ أحكام تجريبية مستمدة من استبطان العقل للمبادئ أو القوانين الطبيعية.
ـ أحكام جمالية وفنية مستمدة من استبطان الذات للوجود، أو من استنباط العقل طبقا لحاسة الوجدان المنفعلة.
وفي المنظور الصوفي تُستبعد التجربتان العقلية والحسية؛ ليس بوصفهما أداتين غير صالحتين لتحقيق المعرفة أو الوصول إلى الحقيقة؛ ولكن لأنهما لا تلبيان الغاية الصوفية المتمثلة في تلمس الحقيقة وتذوقها ومكاشفتها، فمن حيث المبدأ الحس ليس موضع شك عند الصوفية لكنه لا يحقق الكفاية المعرفية التي تنشدها النفس الصوفية؛ وخاصة معرفة الله سبحانه، كما أنهم لم يرفضوا وسيلة العقل؛ ولكنهم أكدوا على ضرورة أن يستضيء العقل بنور القلب؛ كي لا يفقد العقل توازنه ويتخطى حدوده.
فمع أن العقل قد يحقق الإقناع المنطقي إلا أنه لا يستطيع أن يحقق الذوق الإيماني، والشعور المرهف، والرغبة الجامحة في الحب التي يحققها الطريق الصوفي. فالغاية التي تنشدها المعرفة الصوفية، ليست مجرد الإثبات المنطقي للقيم والأفكار والمنظومات؛ بل ملامسة جمالية القيم والأفكار والمنظومات هو المبتغى؛ ولذلك اعتبر الغزالي أن طريقهم في المعرفة هو المورث والموصل لليقين يقول: "فعلمتُ يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة... وطريقهم أصوب الطرق[24]"، كما أن سيرهم يعد بمثابة "السير في الطريق إلى ينبوع الينابيع كلّها؛ فهي وثبة جوانية تستهدف تجاوز الوقائع باتجاه غاية عليا ليست من نسيج الوقائع ولا من فصيلتها، الأمر الذي يترتب عليه أن يكون الموقف الصوفي دربا أو سلوكا على درب لا ينتهي إلا ّفي النبع الحقيقي؛ وهو الحق"[25].
ويُنظر إلى المعرفة الصوفية على أنها محكومة بالغاية؛ والغاية هي التي تحدّد ماهية الشعور وتوجّه السلوك وترتّب الوسائل التي تخدمها؛ وهي عكس التوجهات المنطقية المحكومة بمركزية المقدمة أو الواقع وليس الغاية؛ فحتى وإن بدى لنا التناقض والاضطراب من منظور منهجي في الرؤية الصوفية للمعرفة؛ فإن المتصوفة يتمسكون بكون الغاية هي الضوء الذي ينير المنهج وبغيرها فليس ثمة منهجا أصلا؛ لأن كل سير إنما هو باتجاه هدف.
فإذا كان فلاسفة الإسلام يعتبرون البرهان المنطقي الصوري قمة المعقولية البشرية، فيحاولون تأسيس الإلهيات الإسلامية على البرهان المنطقي والاستدلال النظري؛ فإن الصوفية بحكم تأسيسهم "الحقيقة الدينية" في "الفطرة البشرية" وتأكيدهم على المعاناة يرجّحون العمل على النظر؛ فيسلكون مسالك أغنى وأوسع من مسالك البرهان الصوري، إنها مسالك الذوق أو الكشف؛ من حيث شموليته لجميع الاستعدادات الإنسانية[26].
وهنا يعتبر بعض الباحثين أن الذوق الصوفي وغاية التطهر والتجرد للوصول إلى الشعور الصافي العميق في أبهى صوره: "هو رد فعل ذاتي أو وجداني على مدن أصابها "التخمّج"؛ فما عادت تصلح لاستضافة الروح لأنها منخورة بالفساد الاجتماعي، فليس من المصادفة في شيء أن يسرح رجال التصوّف في البراري والقِفار، أو أن يعتكفوا في بيوتهم أو في زواياهم متوارين عن الناس، ففي المدن الكبرى يتكالب الناس على الثروات تكالبا ينتقص من إنسانيتهم، فضلا عن أنه يحيلهم جميعا إلى عبيد"[27].
لقد بدى للغزالي عقم المقدمات الكلامية والفلسفية في ملامسة اليقين "وظهر له أنّ أَخَصَّ خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلّم، بل بالذوق والحال وتبدّل الصفات"[28].
تعد مقولتا الذوق والحال من أبرز مقولات الصوفية كما يتضح من خلال ثلاثية المقام وثلاثية الحال؛ إذ الشخصية الصوفية تتحدّد طبقا لأبعادهما ومحتوياتهما الوجدانية؛ فالتوبة والزهد والتوكل "ومن ثم الحب والخوف والرجاء" تنتج غريزة تفكير أصيلة في الإنسان يمكن تسميتها "غريزة الحقيقة" "غريزة الولع بالمجهول والحنين إلى النائيات والأعالي"[29]، ذلك أن البشر مزوّدون بغريزة علوّ أصلي لا يُسبر لها غور، ولا محتوى لها سوى الحميم الدافئ، أو سوى الشوق الراعش، الجامح صوب الأوج، وما هذه الغريزة سوى قوة البحث عن الوجود الأصلي الذي يُشرط ويؤصّل كل وجود جزئي. وهذا يعني أن الصوفية لا يسعها إلاّ أن تكون حركة نزوح من الخارج إلى الداخل، أو من الكثافة إلى اللطافة"[30].
ولعل هذه المميّزات الداخلية الكاشفة هي التي دفعت الغزالي لتفضيله التصوف على علم الكلام في إدراك الحقيقة؛ مع أنه لم يعب طرق المتكلمين؛ بل قال عنها: "فوجدتها وافية بمقصودها؛ أي (الأدلة الكلامية)، غير وافية بمقصودي"[31]. وقد حصّل الغزالي التجربة الصوفية من تحصيله لعلم المتقدمين وكتبهم؛ كقوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرّقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي، ثم حصل ما لم يستطعه بالتعلم وبالسماع، وجزم بالنتيجة التي توصّل إليها وهي أن من أخص خصائصهم أن ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم أو السماع؛ بل بالذوق والحال وتبدّل الصفات[32].
وعليه فإن ظاهرة الجمال في ثلاثية الأبعاد مؤسسة من منظور معرفي مقابلٍ لمناهج ونظريات المعرفة الأخرى؛ وهو (المنظور المعرفي) ليس رصًّا للمقدمات وإعمالا في المحسوس للخروج بقانون يوافق المحسوس، وإنما هو كما عبّر أبو بكر الكتاني:"صفاء ومشاهدة"، وقد أعجب الدكتور عبد الحليم محمود بهذه العبارة[33]، ورأى فيها، على إيجازها، التعريف الشامل لثلاثية المقامات وثلاثية الأحوال؛ المختصرتين للتصوف؛ هذا التعريف المؤَسس على مذهب في المعرفة له وسيلته وله غايته؛ ووسيلته الصفاء وغايته المكاشفة، وهذا بالضبط الذي جعل المستشرقين يربطون بين التصوف والفن، ويجعلونه رديفا له، ويُرمز لكل علم ذي صبغة روحانية أو جمالية بأنه ذو جذر صوفي[34]؛ وهو ما جعل بعض الباحثين في الشأن الصوفي يقف على ما يشير إلى أن ثمة جوانب مشرقة في التجربة الصوفية تمس قوام التجربة الفنية بمفهومها المعاصر، على خلاف ما قد يتصور للبعض من أن نزوع التجربة الصوفية إلى ما وراء الصورة الظاهرة لهذا العالم يجعلها على وفاق مع بعض الفلسفات الجمالية القديمة؛ من حيث ارتباط هذه الأخير ة بالميتافيزيقا؛ وبخاصة فلسفة أفلاطون التي يتصور البعض أن اقتران القيمة الجمالية فيها بفكرة المثال، وارتباط الشاعر بفكرة الإلهام؛ هو مما يقع على النحو ذاته في التجربة الصوفية. ويؤكد أن المفارقة موجودة وجلية بين القيمتين؛ من حيث نزوع القيمة الجمالية الأفلاطونية نحو المثالية ومن ثم خروجها عن فكرة الإلهام والكشف والشعور الدافق، ونزوع القيمة الجمالية الصوفية نحو الإلهام الذي يختمر في أعماق النفس الإنسانية ويتشكل من ارتباط عمق الذات بالخيال الخلاق؛ فهو يُولَدُ في أعماق الإنسان وليس في الشيء ذاته؛ ففكرة الصوفية الأساسية وغايتهم العليا: الحق وليس الخير؛ أما أفلاطون فالخير هو محور جمالياته؛ لذا فالمثال الجمالي لا يكون صحيحا إلاّ إذا تلمّس فيما يحاكيه الواقع الخارجي (المجتمع أو الطبيعة)المحكوم بقيم محدّدة تضع كل شيء في موقعه المناسب[35].
لقد بحثت التجربة الصوفية عن الحقيقة بدل الخير لأسباب متعلقة بمنهج الالتزام الذي يحكمها؛ فهي طريقة محكومة في نظر أصحابها بالقانون الشرعي والعرف الصوفي المؤسس من شيوخها، ولذا كان التخيّل أو المحاكاة أو الاستبطان متّسما بصفة الواقع النفسي أو الحسي أو الغيبي، وكانت العاطفة مضبوطة بسمة العقل؛ وكل ما سبق يدور في إطار رؤية كلية وعامة للعاطفة والفن والجمال؛ ولا يجوز أن ينفلت ويتذرع بالمعيار والثمرة. ولذلك كانت عملية التخيّل مستوحاة من ذات وأعماق الصوفي العارف وكان التجسيد الفني في عالم الواقع يحاكي مبادئ التجربة وأبعادها من مبتدأ السير إلى مرحلة المكاشفة، ولذا علينا أن نؤكد ثلاثة عناصر أساسية في الصورة الفنية عند المتصوفة:
- الذات؛ وهي العنصر الرئيس في الصورة الفنية؛ عبر الوصول إلى الصفاء التام لينعكس عبر تأملات عميقة في الخيال؛ ويكون هذا الصفاء بعمليتي التصفية والتحلية؛ التصفية عبر ثلاثية مقامات التوبة والزهد والتوكّل، والتحلية عبر ثلاثية أحوال الحب والخوف والرجاء. وتكون الذات بعد الصفاء والاستبطان؛ هي مصدر الإلهام. عكس النظرية الأفلاطونية التي تُسلّط العنصر الخارجي على الذات؛ فقد ألغى أفلاطون الذات الإنسانية في جوهرها الباطن الحر، فهدّ بذلك نظريته في الجمال المطلق من أساسها، وكان أول نصير لفن واقعي موجّه توجيها اجتماعيا؛ أي براغماتيا خاضعا للمصلحة واللذة دون النظر لالتزام أو مبدأ حاكم، عكس النظرة الصوفية التي ترى أن علاقتنا النفعية بالأشياء تحول دون إدراكنا لحقائقها الجوهرية، وأن الاتصال بالمعاني الجوهرية في الأشياء وتجاوز حجبها الظاهرية يقترن في الوقت نفسه بالاتجاه إلى أعماق الذات.
- الخيال؛ وهو تلك الصور الرمزية التي تعكسها الخطابات والنصوص والوقائع والتأملات، في العقل، لترسم العالم الذي ينبغي أن تعيشه الذات، ولذلك وجب الاهتمام ببنية الخطابات والمقولات والصور والوقائع...، وطريقة اشتغالها الوظائفية.
ويندرج مع الخيال في العملية الجمالية؛ المتخيل (الوعي) وهو المادة المتحولة، عندما يشتغل الخيال، فكثيراً ما يذهب؛ أي (الخيال) بعيداً عن النص والواقع وروحه إلى أوهام وأساطير لا تمت للعلم بصلة، لذلك فمن الضرورة إحاطة هذا المتخيل أو المخيال بضوابط لكي لا ينفلت عن موضوعية التأمل الذاتي، ويدخلنا في متاهات الحلول والوحدة والفيض كما حدث مع التيارات المتطرفة في التصوف.
- الواقع المحسوس؛ أو الوجود، فلا يمكن أن يتحقق الاستبطان والتأمل والتماس القيمة الجمالية بمعزل تام عن الوجود الحسي؛ لأن ذلك يدخلنا في وحدة متطرفة، وينقلب العالم المشاهد إلى صور مجازية؛ وذلك مرفوض في الرؤية الصوفية المعتدلة، فالوجود له قيمة في التمثّل؛ والجمال يلتمس في إدراك الحقيقة الجوهرية الكامنة وراء هذا الوجود الشاخص، وعكسنا لخيال جديد يبرز وعينا و شعورنا وإيماننا الداخلي؛ فننفذ من الظاهر إلى الخفي، ومن المحسوس إلى المجرّد. وهذه رؤية تتعاضد في إثبات صدقيتها وموضوعيتها معظم الرؤى الجمالية المعاصرة[36]، خاصة في حيوية التواصل بين الذات والعالم خارج القيمة النفعية؛ ويتحول المحسوس فيها إلى أبعد من حدود الجسد والمادة والمألوف.
ثالثا: رؤية نقدية في الأبعاد الفنية والجمالية في التراث الإسلامي في فكر المستشرقين
يمكن القول إن بروز اهتمام المستشرقين بالظاهرة الجمالية والفنية في الإسلام، ترجع إلى دراساتهم الواسعة حول أسرار التصوف، ومحاولة المقابلة بينه وبين ما هو موجود في البيئة الغربية أو ما كان موجودا منذ العهود الأولى للحضارة الغربية والمسيحية. ويرجع اهتمامهم بالتصوف عموما إلى المحاولات التأسيسية لوضع تعريف سوسيوثقافي، ومقاربتهم الأولى لتعريفه؛ حيث اتفق جمهورهم على حدّه من خلال الكلمة الأجنبية (Mystik) وجذورها؛ والتي تعود حسبهم إلى شيء مفعم بالأسرار لا يمكن بلوغه بالوسائل العادية أو بالمجهود العقلي[37].
وهو ما يُعَدُّ وضعا وتأسيسا للمنطلق الفني والجمالي في رؤية المستشرقين للتراث الصوفي عموما. وما يزيد تأكيد هذا الأمر أن الكلمتين (Mystisch) و(Mysterium) مشتقتان من الكلمة اليونانية (mycim)؛ بمعنى إغلاق العينين[38]. وأهم المستشرقين المولعين بربط التصوف بالأسرار؛ المستشرقة الألمانية "إيفلين أندرهيل" (Evelyn Underhill) في كتاب لها ترجم إلى الألمانية عن الهيلينية سنة 1911[39].
ورغم ما يشوب هذا الميل والاشتقاق من الاستنتاجات الحدسية والتغليفات المدرسية التي أدّت إلى تفضيل غالبية المستشرقين مُرادفة التصوف للاتجاه الغنوصي الهادف حسبهم لبناء تجربة وجودية فلسفية عميقة عنوانها: "تجربة استغراق الحب"، فإن جزءًا من دراساتهم لم يغفل ربط هذا الاشتقاق بالاتجاه الذي تأسّس فكريا ومعرفيا في المبحث السابق، وقد أبان المستشرق الفرنسي "هنري كوربان" عن الفوارق بين النمط النبوي في الإسلام والنمط الغنوصي في التجربة الصوفية، وسارت مع هذا الاتجاه المستشرقة الألمانية "آنا ماري شيمل" من خلال تأكيدها على سهولة فهم الصوفية من خلال بنيتها والبنية اللغوية ثلاثية التركيب، وتقصد الأسس الأولى التي قامت عليها التجربة الصوفية قبل تركيبة النظام الفلسفي والغنوصي[40].
ويمكنني إيجاز بعض المآخذ العلمية والتاريخية على القراءة الاستشراقية لظاهرة الجمال في السياق الإسلامي؛ من خلال النقاط الآتية:
1. ربط الوعي بالتجربة الروحية حصرا
تؤكد نخبة من المستشرقين أن التجربة الروحية؛ هي السبب الرئيس في تأسيس الوعي الصوفي المحكوم بأبعاد ثلاثية؛ مقامات وأحوال، ثم تجسّدت هذه التجربة في هيئة التعبير والشغف المنظوم شعرا، والشفاء من الشهوات الحيوانية والعلائق الدنيوية ومن ثم يستتبعها الشفاء من الأمراض العضوية[41].
وقد اعتنى بعض المستشرقين وافتتن بهذه الثلاثية إلى حد أن صرّح بأن فن الإشراق الصوفي ينطوي على "أرابيسك " شديد التركيب عرفته إيرلندا في العصور الوسيطة، يقول روبرت ديفز: "مما قد ينطوي على أهمية أكبر أن الفن الإسلامي الأسمى؛ أي المعمار هو صوفي"[42].
ويساعدنا تطور المعجم الصوفي عند المستشرقَيْن "لويس ماسينيون" و"بولص نويا" على رسم عملية تطوّر الفكر الصوفي أو التجربة الصوفية؛ وتحوّلها من حالة تَعبُّد إلى حالة فنية وجمالية عميقة. كما يساعد في كشف دلالات الرموز والصور التي يستخدمها الصوفيون؛ وتداخل بعض تلك الرموز والصور مع بعضها البعض وعلاقتها بالبنية العامة للتفكير الصوفي؛ تقول المستشرقة المعروفة آنا شيمل: "تمهّد تلك الدراسات الطريق أمام أبحاث أخرى عن إسهام التصوّف في تطوّر اللغات والآداب والفنون الإسلامية"[43].
ثم أضاف السويسري "فرتسماير" (Fritz Maier) بجهوده المركّزة حول علمية الدراسات الصوفية فتحا في ميدان مقاربة التصوف وفق مناهج التربية الروحانية وعلم النفس وعلم الاجتماع والعمارة والرياضيات... وغيرها؛ حيث سمحت هذه المناهج بفهم عميق لدلالة مصطلح "الذوق" عند الصوفية؛ الذي يعد محور التجربة الصوفية كلها؛ تعبدية أو جمالية.
وقد حفل القرن التاسع عشر بنشر العديد من أعمال المستشرقين التي تدور حول تاريخ الحضارة الإسلامية وتراثها وفنونها؛ نشأة وجذورا وبنية؛ مما مكّن العلماء تدريجيا من الحصول على تصوّر أفضل مقارنة بالنزعة التشويهية التي سادت في معظم أعمال السابقين من المستشرقين. وفي قراءة لما عرضناه في المبحثين السابقين وأعمال الكثير من المستشرقين فيما ألمحنا إليه منذ حين حول تصنيفاتهم في القرن التاسع عشر، فإن الملاحظة الأولى الجديرة بالاهتمام هي الاعتقاد السائد في الأوساط الاستشراقية أن العرب أمة ميتافيزيقية بالدرجة الأولى يتشكل وعيهم من الغيبي المطلق مقابل الكوني المشكل لوعي الغربي عموما[44].
ومن ثم فالأعمال الفنية خاضعة للوعي الباطني والسريرة الداخلية المحكومة بهذه الميتافيزيقا، ولذلك فليس المعمار أو الفن نابعا من تدبر عقلي وخيال محسوس ممتزج بروح شفافة وثابة، وإنما هو تجاوب مع هذا الوعي سواء أنتج حسنا أو قبيحا؛ وإذا كان هناك لمسات فنية بالمعنى العلمي فإنها من تأثير أجنبي، كما يعبر عن ذلك المستشرق الإسباني "باسيليو بابون مالدونادو" في كتابه "الفن الإسلامي في الأندلس" بعد أن تحدث بانسياب وتفصيل عن معمار مدينة الزهراء: "غير أن الأمر الذي لا جدال فيه هو الوجود المكثف لعناصر الفن الكلاسيكي بصفة عامة حتى عصر الخلافة القرطبية، وهي كلاسيكية مصدرها الكتل الحجرية الباقية من الآثار التي كانت على أرض الأندلس، والتأثيرات البزنطية، وقد أدت كل تلك العناصر إلى عصر نهضة إسباني يتسم بالغرابة والإثارة والتفرد"[45].
وقد تحدث في نص سابق قائلا: "واتسمت العناصر الزخرفية بكثرتها لدرجة يمكن معها القول بأن العمارة ما هي إلاّ ذريعة لتبلغ الزخرفة شأنا غير مسبوق في طريق التطور والنضج، وإذا كان معلوما لنا أن ذلك يحدث في أساليب فنية أخرى، فإن الفن العربي يبزّها جميعا بتنوع الأشكال والوحدات الزخرفية النباتية؛ إنه الثراء الذي ينجم عندما يتّصل الإسلام بالثقافة المتوسطية وهو ثراء لم يرثه الإسلام"[46] مع ضرورة الإشارة إنصافا أن المؤلف أشاد بالفن الإسلامي في الأندلس وتأثيره على الفن الإسباني ودوره في نهضته، لكنه أغفل جانب الأصالة فيه، وعادة يمزجه بعناصر أخرى يطلق على ذلك الفن "بالفن المدجّن".
كما أن النظرة التي تجعل من الأبعاد الجمالية في التراث الإسلامي عديمة التأمل العقلي؛ ينقصها الشمول والدقة، كون التراث الإسلامي في جانبه الإبداعي الفني متنوع وخصب، فالظاهرة الجمالية والفنية في لغة القرآن، مثلا، لا تخضع للوعي الباطني بقدر ما تلامس حدود العقل وإن كان التأثير يتعلق بالباطن... ومن جهة أخرى فإن المعجم الصوفي لا يتأسس على نمط واحد من الوعي، بل يتعدّد بحسب الوحدات المعنوية التي لا تنشأ نشأة أفقية بقدر ما تنشأ تبعا للظروف والسياقات، فالحارث المحاسبي في تعريف له للتصوف مخالفا ما درج عليه الأغلب، يصفه بأنه: "علوم الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات"[47].
وهناك دراسات متخصصة في المعجم الدلالي الصوفي تتبعت المصطلحات المختلفة الواردة في تاريخ الصوفية، وخلصت إلى أن مضامين هذا المعجم قامت على العناصر الآتية[48]:
ـ اللفظ المفرد، حيث يدل على حقيقة واحدة فقط، وبذلك لا يمكن أن يحمل مضمونا آخر يمكن أن نفسر به امتداد الوعي الصوفي إلى أشكال أخرى.
ـ الدلالات المشتركة، عن طريق ترادفات تجمل فيها المعاني بعضها بعضا؛ كمصطلح "الفناء" والذي يتضمن معاني عديدة مشتركة وهي المحو والمحق والصعق والطمس.
ـ مصطلحات خاصة بالطريق الصوفي؛ مثل: السفر، الرحلة، السلوك، السالك، المقامات، الأحوال، المجاهدة، الوصول، الواصل، الغاية...
ـ مصطلحات تخص التجربة الصوفية؛ مثل: الرؤيا، الكشف، المشاهدة، الوارد، الفقر، الهواجم، الهواجس...
ـ مصطلحات تخص المذهب؛ مثل: الإحسان، الإرادة، الحضرة، الفيض، الجذبة، الولاية، حقيقة الحقائق، أمهات الأسماء، الشيخ، المريد...
وكل ذلك يوضح حقائق بالغة في الوعي الصوفي والمعجم اللفظي للصوفية؛ تتمثل خصوصا في أن ترجمة السلوكيات إلى مصطلحات تختلف صيغها بين الاسم والمصدر، كما أن الاستفادة من الفروق الموجودة بين الألفاظ المترادفة جد مهم في إبراز علاقات اشتقاق المصطلحات ونحتها؛ كالشهود والمشاهدة، والمسامرة والمناجاة، والمخاطبة والمحادثة[49]...
ولم تكن الدراسات الاستشراقية على نمط واحد في تحليل المعرفة الصوفية وضبط الوعي الصوفي، فقد شهدت هذه الدراسات مع المستشرق الشهير هنري كوربان مسارا مغايرا حين أدمج الفينومينولوجيا في تجميع المقاصد الضمنية لكل أفعال الشعور واللاشعور الصوفي دون اختزال السمة الموضوعية للمعطيات في الإدراك الحسي، أو حصر مجال المعرفة الحق والدالة في عمليات الفهم العقلي وحدها[50].
والتجربة الروحية في الإسلام، كانت في الإطار القانوني الشرعي تارة، وغريبة بعيدة عن حقائق الإسلام تارة أخرى، وأجزاء من دائرة هذه التجربة ميدانٌ رحبٌ واسعٌ يزخر بعناصر وألوان شتى من الثقافات، امتزجت في ساحته الأفكار والعقائد والأديان التي وُجدت في الشرق القديم، وقد أثّرت فيه بما كانت تتميز به من صور وخبرات في الرياضات الروحية والتجارب والمواجيد واللغة السرية الرمزية الغامضة، حتى خيل للكثيرين أن العبادة والزهد والتزكية في الإسلام، ماهي إلا صور لأشكال التجارب الروحية القديمة.
2. الخلط بين الذوق الصوفي والذوق الفني
إن تأسيس الوعي وهو ما يرادف الذوق لدى الصوفية؛ لا يكون إلاّ من عمق الذات حين الصفاء التام؛ وهو ما تشير إليه المستشرقة الألمانية وتصطلح عليه بمصطلح "استبطان الذات"؛ فهذا الاستبطان أو الاكتشاف الجلي للذات في أعماقها؛ لا يكون عند أصحاب هذا الاتجاه؛ إلاّ بالسير من الحسي إلى المجرد والتخلص التام من العلائق التي تشوب الوصول إلى الحقيقة عبر الذوق والحب الذي يصله العارف.
ويلتقي هذا الموقف، بقدر ما، مع موقف أفلاطون؛ حيث يرى أفلاطون أن الجمال هو تجلي الحقيقة؛ وأن الذوق الفني هبة مقدسة من الله للإنسان[51]. ولكنه يختلف معه في الغاية والهدف والنهاية؛ فبينما يكون الحسي الهدف الأسمى لأفلاطون؛ يكون التجرد من الحسي وإدراك المجرد هو الأسمى عند الصوفية، ففيما تهدف التجربة الأفلاطونية إلى المتعة الجمالية والثمرة الوظيفية، تقصد التجربة الصوفية إلى تحقيق المهمة العبادية؛ ولذلك فكل ما يقترن بها من وسائل وأدوات يكون قرين مذهب الالتزام.
لقد جعل المستشرقون أساس التجربة الصوفية مبنيا على مبدأ الذوق؛ لذلك كانت الجوانب العملية ومناهج التربية الروحية ودرجات الترقي مرتبطة ومتناسقة مع المبدأ الذي يرجع في حقيقته إلى المحبة التي تضمن صفاء السريرة والباطن؛ ولا يتأتى الحب والذوق إلاّ بمطابقة الشريعة والطريقة والحقيقة لبعضها بعضا؛ لأن المراد هو الصفاء في شتى المستويات: أولها؛ التطهّر من السمات الدنيئة ومن دنس الروح. وثانيها؛ محو آثار البشرية؛ (أي النزعة الجسدية في الإنسان). وثالثها؛ تطهير الصفات واصطفائها[52].
وقد حاول المستشرقون الربط بين الأبعاد الروحية التي حصّلها الصوفية في البراري مع الأنماط المعمارية التي انتشرت في عدد من الحواضر الإسلامية المشهورة، بل ينقل هؤلاء المستشرقون أن السلاطين كانوا يأمرون بنمط معيّن من المعمار انسجاما مع عرفانية السالكين.
إن التجربة الصوفية تقتضي، من وجهة نظرهم، القول بوجود "ملكة خاصة غير "العقل الطبيعي" وهي التي يتم بها الاتصال؛ وفيها تتحد الذات بالموضوع"[53]. ويتوسعون في التوضيح حين يشيرون إلى قيام اللمحات واللّمع والإشراقات مقام التصوّرات والأحكام والقضايا في المنطق العقلي، بحيث أن المعرفة فيها معاشة وُجدانيا، ويغمر صاحبها شعور عارم بقوى تضطرم فيه وتغمره كفيض من النور.
يقول علي الحضرمي في التنبيه على أهمية تحرر الذات العارفة من القيود في عملية التأمل: "في حال التأمل الجمالي؛ فإن الذات تتحرّر من الإرادة؛ فتختفي الأنا الفردية فيها، وتصبح ذاتا عارفة خالصة، تدخل مع الأشياء والموضوعات في هوية واحدة، وتستغرق فيها في وحدة صوفية، وعندئذ يختفي العالم بوصفه تمثّلا"[54].
لكنهم أغفلوا إلى حد ما الإرادة واتجاه الإرادية الموجود عموما عند الزهاد والسالكين؛ فسلطة الإرادة ينبغي توفرها في عملية استبطان الذات؛ ولا يمكن للمريد أو السالك بلوغ المحبة أو العرفان، ولا إدراك الحقيقة دون تحرر الذات من الأغلال، وفك الإرادة من أسر الهوى والملذات، وذاك شرط عام في التربية الروحية في الإسلام، وليس عند الصوفية حصرا.
كما أن التطهر من شوائب المحسوس عملية مطلوبة عموما في التأمل العقلي والشعوري، بل إن المدارس الفنية بتنوعاتها عبر التاريخ، متفقة على التحرر من الأغلال وعلائق الذات في عملية الإبداع.
وقد ربط المتصوفة بين المعرفة والمشاهدة وبين رؤية القلب وانفتاح البصيرة، من خلال أكثر الاتجاهات روحية، وأكثرها مساسا بالتجربة النفسية ذاتها. لكن من جهة أخرى عبّر الصوفية أنفسهم عن صعوبة تحديد أو وصف ما يشعرون به في مواجيدهم ومشاهداتهم، وبيّنوا بأن التجربة الصوفية بما فيها من مشاهدات ومواجيد، باعتبارها ثمرة لمعرفة مباشرة من غير وسائط من مقدمات وقضايا وبراهين أو تجريب؛ تعبر عن إدراك ذاتي (فردي) لا يمكن تعميمه، وتعدية معرفته للغير[55].
3. سطوة المركزية الغربية في القراءة الاستشراقية
تعامل جلّ المستشرقين مع التراث الجمالي الإسلامي عموما بمنطق القولبة العقلانية الأداتية التي كان يذمها أشد الذم ماكس فيبر؛ حيث تعامل العقل الاستشراقي بتعال معرفي أخرج هذا التراث من فضاءات الممارسة الإنسانية المعرفية ذات الطابع العقلاني العلمي وليس التجريبي الأداتي، وبذلك أدخلها في دراسات الأسطورة والخيال والتي عادة ما تخصص للشعوب البدائية كما فعل ليفي ستراوش مع قبائل البورورو في البرازيل.
والحاصل أن الدراسات التي أنجزها المستشرقون، ورغم الطابع الإبداعي الخلاّق للعديد منها؛ خاصة دراسات الكبار من أمثال (نيكلسون، كوربان، ماسينيون، آن ماري شيمل وغيرهم) من الرعيل الأول، "إلاّ أنها لا تخلو من ممارسات معرفية ذات طابع قمعي تمارسه الذات الباحثة على النصوص المدروسة، وتتعدّد تجليات القمع البحثي لنصوص الصوفية؛ ما بين البحث عن المصادر الأساسية للتصوف الإسلامي ونظريات التأثّر والتأثير ذات الطابع الميكانيكي الذي يكتفي برصد نقل الأفكار وكيفيته مكانيا وزمانيا، دون التوقف عند الطبيعة المعقّدة لظاهرة التلاقح الثقافي بين الحضارات وممارسات الدمج المعرفي وأشكال الاحتواء والتناص... إلخ وبالطبع تنطوي هذه التصورات على نزعة مركزية حادّة للفكر الغربي والحضارة الغربية، ناهيك عن المركزية العقيدية للمسيحية وحضورها الجلي الساطع في التجربة الصوفية كما بلور ماسينيون تجربة الحلاج الشهيد عبر مرايا الخلاص المسيحي"[56].
كما أن إطلاق مصطلح "الميستيسزم" على التصوف الإسلامي هو قولبة كلية لمناهج دراسة التصوف الغربي، وهذا ما يُعد وضعا وتأسيسا للمنطلق الفني والجمالي المسيحي والغربي في رؤية المستشرقين للتراث الصوفي عموما، خاصة وأن الغالبية تفضل تعريفه بالعلم المفعم بالأسرار، وذاك سر انبهار أكثرهم به وبسحر الشرق، نلاحظ ذلك في كتابات آنا ماري شيمل؛ خاصة في دراساتها المتنوعة والمستفيضة حول الشعر الصوفي الفارسي، وخصوصا "جلال الدين الرومي".
وتعلق الدكتورة هالة فؤاد: "لا أعتقد أن هذا الانبهار الغربي بهؤلاء المتصوفة يقل قمعا عن نقيضه الباحث عن مصادر هؤلاء في الحضارة الغربية والعقيدة المسيحية، خاصة أنه يندرج أحيانا في إطار أكثر اتساعا حيث الانبهار الغربي بالصورة المتخيّلة الغامضة للشرق الساحر الجميل الذي يصيب زواره الغربيين بالوُجد، ويستلبهم في مدارات الإغواء والافتتان الطاغية، ناهيك عما يمكن أن تنطوي عليه هذه النظرة من خيالات وتصورات تستلب النصوص الصوفية ذاتها خارج مداراتها الخاصة، وتحملها أحيانا توقّعات وهواجس الباحث الغربي أسيرَ السحر والافتتان[57]".
الخاتمة
يمكن أن نخلص إلى عدة نتائج جد مهمة من خلال هذا البحث المركز؛ لعل من أهمها أن جانبا من الفكر الاستشراقي حاول توظيف الوعي الجمالي في التراث لخلق حالة من التجزئة في بنية التراث أو العقل المسلم وفي تحليل المعرفة الصوفية وضبط الوعي الصوفي، وذاك ما يعبر عن حالة عاشتها المنظومة الاستشراقية فيما يسمى بمنطق القولبة العقلانية الأداتية أخرج هذا التراث من فضاءات الممارسة الإنسانية المعرفية ذات الطابع العقلاني العلمي إلى ميدان الأسطورة والميثولوجيا والتي لها علاقة بدراسات الاستعمار في بدايات القرن التاسع عشر والعشرين..
حيث إن جل هذه الدراسات تُغفل إلى حد ما الإرادة واتجاه الإرادية الموجود عموما عند من يصنف في المنطق الأسطوري؛ والاعتقاد السائد في الأوساط الاستشراقية أن العرب أمة ميتافيزيقية بالدرجة الأولى يتشكل وعيهم من الغيبي المطلق مقابل الكوني المشكل لوعي الغربي عموما، وبذلك فهي ملكات للعقل الباطن يهذبه العقل الأداتي العلمي، ولتهيئة الشخصية القابلة للتحضر وفقا لمرجعية هذا العقل.
وكل ذلك يحتاج إلى مزيد دراسات لفك الالتباس وتبيان الأسطوري من العلمي، فالنظرة التي تجعل من الأبعاد الجمالية في التراث الإسلامي عديمة التأمل العقلي؛ ينقصها الشمول والدقة، لأن التراث الإسلامي في جانبه الإبداعي الفني متنوع وخصب، فالظاهرة الجمالية والفنية في لغة القرآن، مثلا، لا تخضع للوعي الباطني بقدر ما تلامس حدود العقل وإن كان التأثير يتعلق بالباطن.
لكن من جهة أخرى هناك دراسات استشراقية منصفة حتى وإن لم تسلم نهائيا من تحيز العقل المركزي الغربي، وظفت خبرتها وتحقيقاتها الدقيقة في اكتشاف الأبعاد الثلاثية المولّدة للفن والإبداع بما ينطوي على"أرابيسك" شديد التركيب عرفته إيرلندا في العصور الوسيطة، حيث يمنح ذاك التركيب الفردَ المتفاني "جنينة سرية" لتنمية قدراته على الفهم والاستيعاب، ومهّدت تلك الدراسات الطريق أمام أبحاث أخرى عن إسهام التراث الإسلامي في تطوّر اللغات والآداب والفنون الإسلامية.
ومن أهم النتائج أيضا؛ تقرير أن التجربة الروحية في الإسلام، كانت في الإطار القانوني الشرعي تارة، وغريبة بعيدة عن حقائق الإسلام تارة أخرى وأجزاء من الدائرة الثانية ميدانٌ رحبٌ واسعٌ يزخر بعناصر وألوان شتى من الثقافات، امتزجت في ساحته الأفكار والعقائد والأديان التي وُجدت في الشرق القديم، وقد أثّرت فيه بما كانت تتميز به من صور وخبرات في الرياضات الروحية والتجارب والمواجيد واللغة السرية الرمزية الغامضة، حتى خيل للكثيرين أن العبادة والزهد والتزكية في الإسلام، ما هي إلا صور لأشكال التجارب الروحية القديمة، والحقيقة غير ذلك، وقد حاول العقل الاستشراقي الاستعماري رهن الإبداع بالدائرة الثانية، والحقيقة التاريخية التي أثبتناها تقول بتأثير شفافية الروح عبر أصالة التجربة الروحية والتزامها بالإطار الشرعي في موهبة الخيال والتأمل، بما خلّف تراثا زاخرا في شتى الميادين التي تتسم بالتفكير والنظر العميق، وهو ما يلقي تبعة ثقيلة على الباحثين المسلمين في ضرورة تتبع نواحي التحيز الاستشراقي الذي اختطف كثيرا من العلوم والفنون الإسلامية الأصيلة ليصلها بمؤثرات أجنبية نزعت عن الفكر الإسلامي صفة الابتكار والإبداع.
الهوامش
[1]. إدريس شاه، الصوفيون، ترجمة بيومي قنديل، القاهرة: المركز القومي للترجمة، ط2، ص31.
[2]. انظر: مراد وهبة، المعجم الفلسفي، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ط3، 1979، ص376.
[3]. أبوبكر الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط2، 1994، ص25.
[4]. أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، بيروت: دار الكتب العلمية، 2001، ص313.
[5]. إحسان إلهي ظهير، التصوف: المنشأ والمصدر، لاهور: إدارة ترجمان السنة/باكستان، ط1، 1986، ص49.
[6]. انظر: آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، ترجمة: محمد إسماعيل السيد ورضا حامد قطب، منشورات الجمل، كولونيا/ألمانيا، ط1، بغداد، 2006، ص08.
[7]. انظر: ولتر ستيس، التصوف والفلسفة، ترجمة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة: مكتبة مدبولي، ط1، 1999، ص221-222.
[8]. المرجع نفسه.
[9]. الهجويري، كشف المحجوب، دراسة وترجمة وتعليق: إسعاد عبد الهادي قنديل، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط1، (1415ﻫ/1994م)، 1/373.
[10]. جلال الدين الرومي، المثنوي، ترجمة وتقديم: إبراهيم الدسوقي، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2002، 6/464.
[11]. أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2009، 1/244
[12]. انظر: إحسان إلهي ظهير، التصوف: المنشأ والمصدر، م، س، ص21.
[13]. المرجع نفسه.
[14]. انظر: إدريس شاه، الصوفيون، م، س، ص29-30.
[15]. مقدمة المفكر والمستشرق إمبرتو إيكو، كتاب "الصوفيون"، إدريس شاه، م، س، ص19.
[16]. انظر: باسيليو بابون مالدونادو، الفن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباتية، ترجمة علي إبراهيم علي منوفي، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2002، ص15-28.
[17]. أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية في التصوف، م، س، ص314.
[18]. عبد المجيد الصغير، التصوف كوعي وممارسة: دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة، الشركة الجديدة الرباط: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 1999، ص87
[19]. أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء، بيروت: دار الفكر للنشر والطباعة، باب: ذكر طوائف من جماهير النساك والعبّاد، في ترجمة أحمد ابن أبي الحواري رقم الترجمة 457.
[20]. انظر: محمد أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط1، 2000، ص224، وص228.
[21]. انظر: عبد المجيد الصغير، التصوف كوعي وممارسة، مرجع سابق، ص87.
[22]. انظر: محمود زيدان، نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين، الدمام: مكتبة المتنبي/المملكة العربية السعودية، ط1، 2012، ص177.
[23]. انظر: المرجع نفسه، ص179.
[24]. أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقيق: محمود بيجو، مراجعة: محمد سعيد رمضان البوطي وعبد القادر الأرناؤوط، دمشق: دار التقوى للطباعة والنشر والتوزيع، والأردن: دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، ص68-69.
[25]. يوسف سامي اليوسف، ماهية الوعي الصوفي، جلة معابر، آب 2003، موقع:
http://maaber. 50megs. com/issue_august03/editorial. htm
[26]. عبد المجيد الصغير، قيمة الجمال في تداولها الإسلامي، مجلة عوارف، العدد1، 2007، طنجة، المغرب، ص22
[27]. يوسف سامي اليوسف، ماهية الوعي الصوفي، مجلة معابر، م، س.
[28]. الغزالي، المنقذ من الضلال، م، س، ص65.
[29]. يوسف سامي اليوسف، م، س.
[30]. المرجع نفسه.
[31]. الغزالي، م، س، ص39.
[32]. المصدر نفسه، ص65.
[33]. عبد الحليم محمود، قضية التصوف، م، س، ص348.
[34]. انظر: روبرت ديفز، مقدمة كتاب "الصوفيون"، م، س، ص27.
[35]. علي الحضرمي، الرؤية الصوفية في الموقف الفني المعاصر، م، س، مجلة غيمان، العدد الخامس، موقع:
www. ghaiman. net/derasat/issue
[36]. انظر: علي الحضرمي، م، س.
[37]. انظر: آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام، م، س، ص06.
[38]. المرجع نفسه، ص07.
[39]. انظر: المرجع نفسه، ص07.
[40]. انظر: كمال جعفر، الإنسان والأديان، آنّا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، م، س، ص17.
[41]. روبرت ديفز، مقدمة كتاب" الصوفيون"، م، س، ص31.
[42]. انظر: آنّا ماري شيمل، م، س.
[43]. آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام، م، س، ص11.
[44]. انظر: توشيهيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، ترجمة: هلال محمد الجهاد، طبعة المنظمة العربية للترجمة، ط1، 2007، ص119.
[45]. باسيليو بابون مالدونادو، الفن الإسلامي في الأندلس، م، س، ص24.
[46]. المرجع نفسه، ص24.
[47]. أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998، ص52.
[48]. ياسين بن عبيد، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر: المفاهيم والإنجازات، الجزائر: وزارة الثقافة الجزائرية بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، ط1، 2007، ص53.
[49]. المرجع نفسه، ص53.
[50]. انظر: خالد بلقاسم، الكتابة والتصوف عند ابن عربي، الدار البيضاء: دار توبقال للنشر/المملكة المغربية، ط1، ص20.
[51]. أفلاطون، المأدبة: محاورة المائدة، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، 1994، ص20.
[52]. انظر: عبد الحليم محمود، قضية التصوف: المدرسة االشاذلية، القاهرة: دار المعارف، ط2، ص348.
[53]. علي الحضرمي، الرؤية الصوفية في الموقف الفني المعاصر، مجلة غيمان، العدد الخامس، موقع:
www. :ghaiman. net/derasat/issue
[54]. المرجع نفسه.
[55]. انظر: عبد المجيد الصغيّر، التصوف كوعي وممارسة، م، س.
[56]. هالة أحمد فؤاد، مقدمة كتاب "الصوفيون"، م، س، ص10.
[57]. المرجع نفسه، ص10.