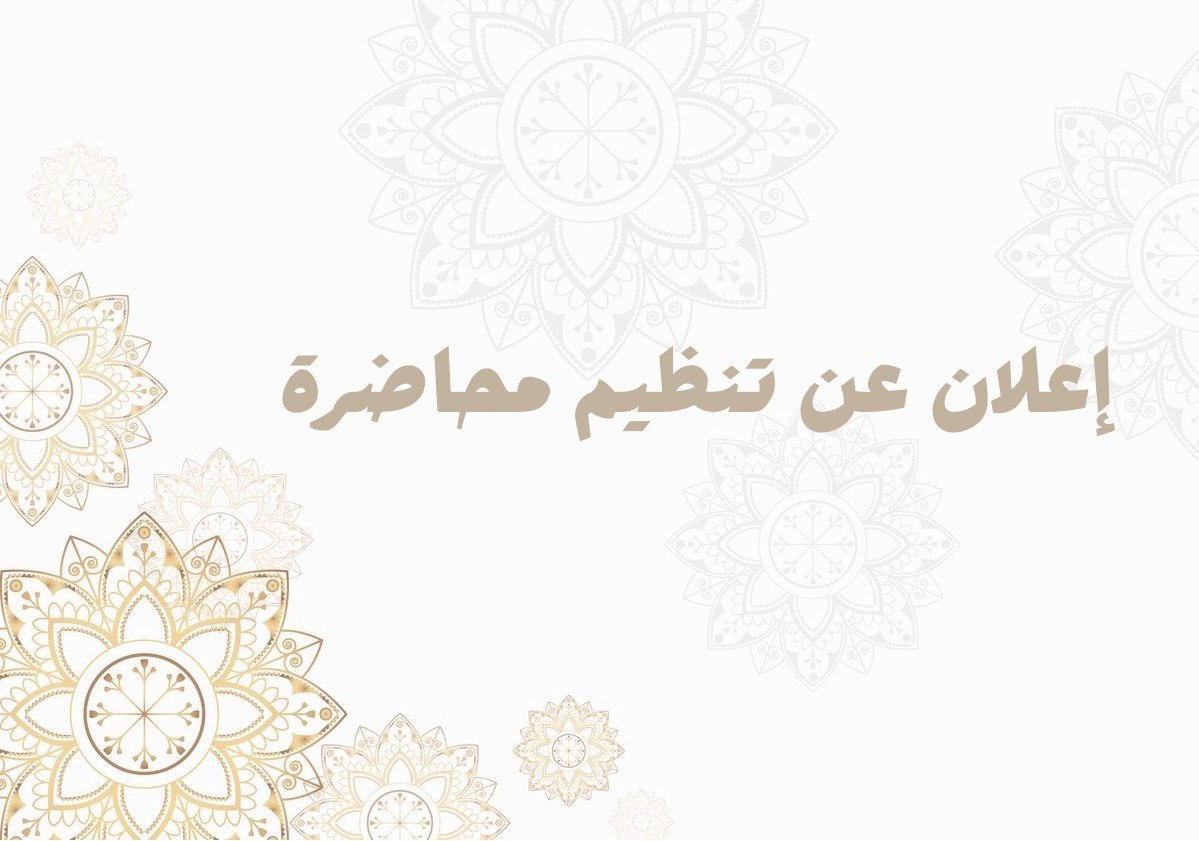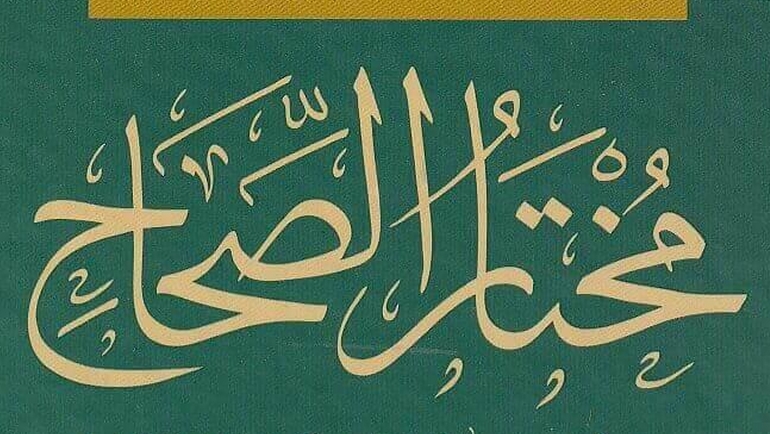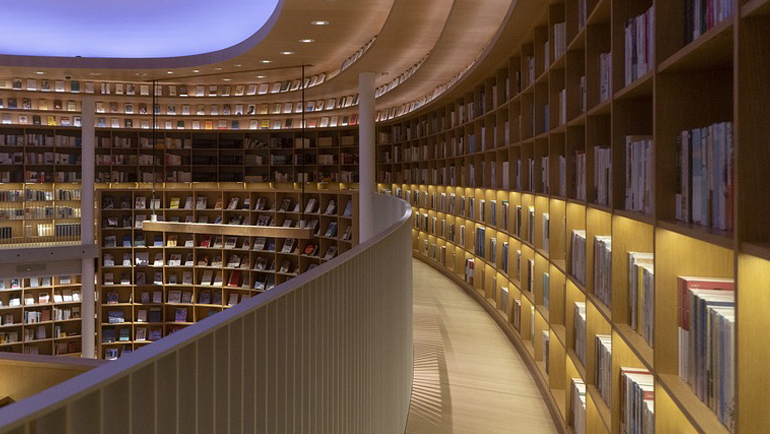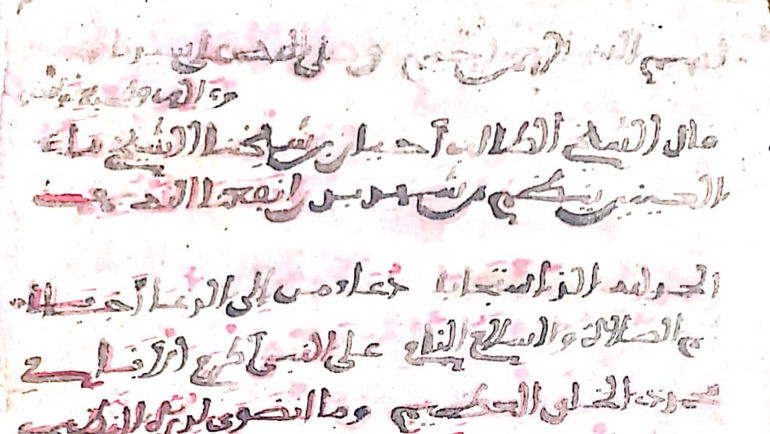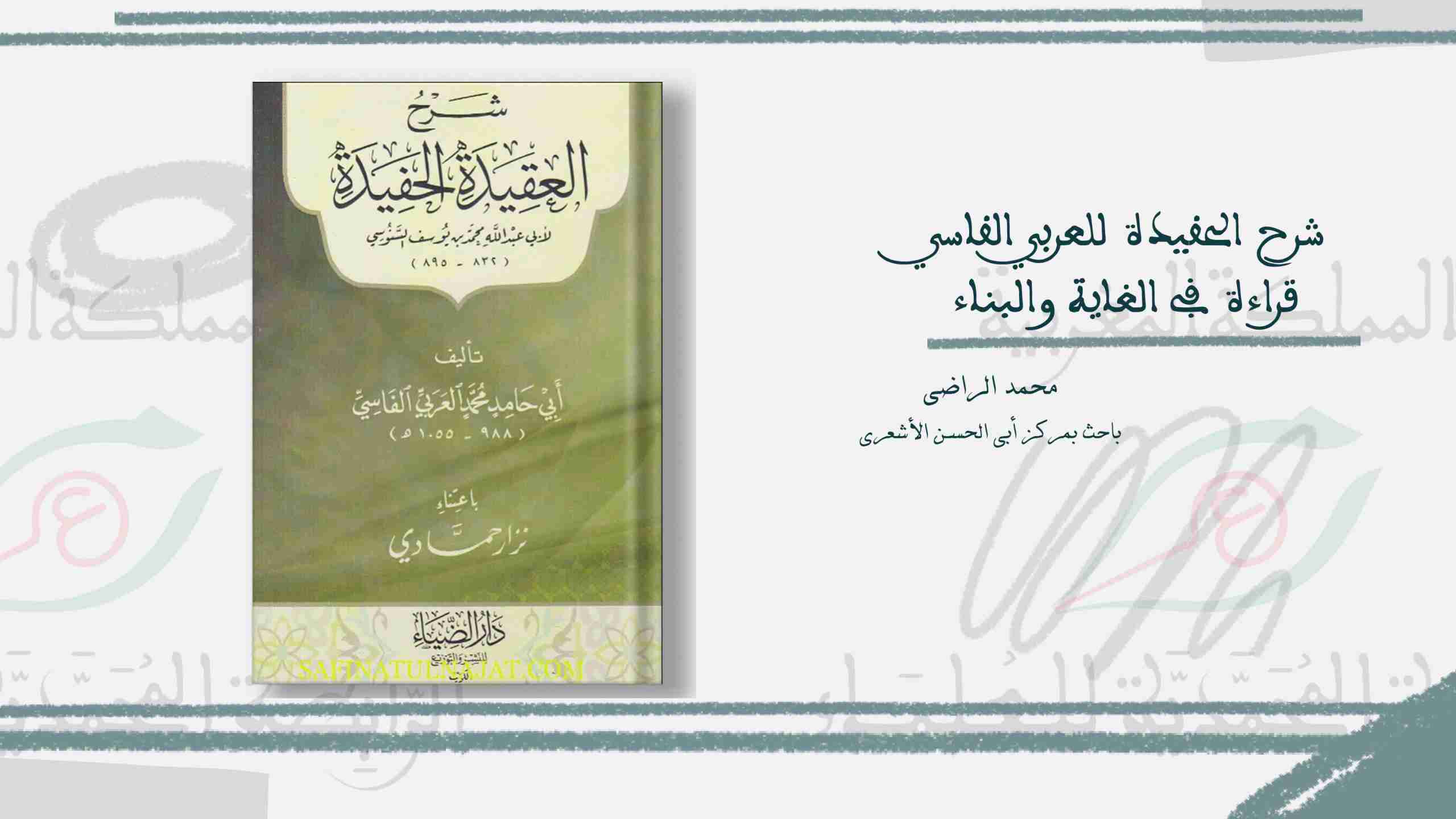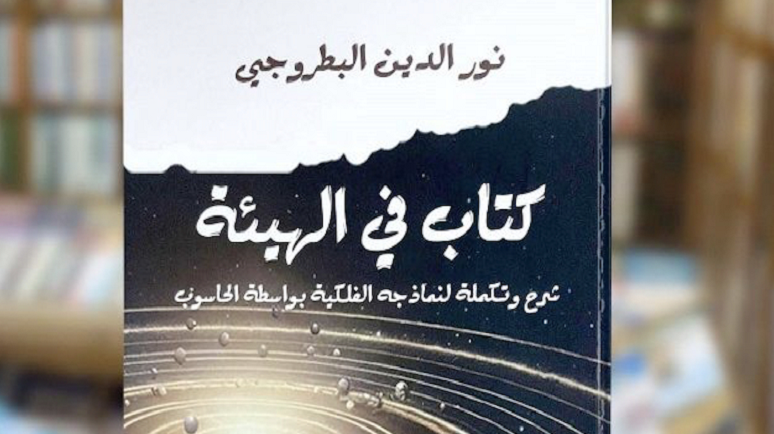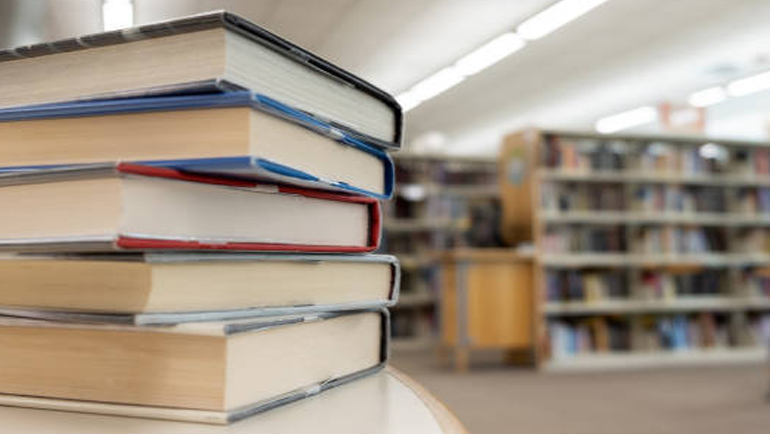علاقة علم العقيدة بعلوم اللغة العربية -1- قراءة في كتاب: «أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي»

بسم الله الرحمن الرحيم
نقدم بين يدي القارئ قراءة في كتاب «أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» للدكتور مصطفى أحمد عبد العليم بخيت[1]، وهو كتاب عني فيه المؤلف بتتبع أثر العقيدة الإسلامية وعلم الكلام في جوانب نحوية متعددة، ويقع الكتاب في 646 صفحة، وأصله رسالة تقدم بها الباحث لنيل شهادة الماجستير.
وهذه ليست قراءة نقدية بل قراءة وصفية تفتح شهية القراء المتخصصين، في العقيدة واللغة بصفة خاصة، والقارئ العربي بصفة عامة لقراءة هذا الكتاب، وتنطلق من أربعة مداخل أساسية وهي: [العنوان – المنهج – المضمون - الأبواب].
مدخل العنوان:
يقدم عنوان هذا الكتاب صورة دقيقة عن مضمونه، ولهذا كان المؤلف دقيقا في اختيار مفاهيمه الاصطلاحية، فقد اختار كلمة «أثر» وليس تأثير، ويعلل اختياره بقوله: «إن الأثر هو النتيجة النهائية المترتبة على التأثير العقدي والكلامي، وهو أمر محسوس أكثر من التأثير، وقد كانت الدراسة معنية برصد هذه النتيجة النهائية غالبا لا بتتبع أصولها التاريخية البعيدة».
كما فَصَلَ في العنوان بين «العقيدة» و«علم الكلام»؛ فهو يقصد بالعقيدة القضايا التي يلزم أن يعتقدها المسلم مما يتعلق بالإلهيات والنبوات والسمعيات ونحوها، وهذه القضايا قديمة منذ مجيء الإسلام وسابقة على علم الكلام، وهناك قضايا عقدية تتفق عليها جميع الفرق الإسلامية، ويقصد بعلم الكلام العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، وموضوعه البحث في الإلهيات والسمعيات والنبوات وما يتعلق بها، وهو يرتبط أكثر ما يرتبط باتجاهات الفرق الإسلامية التي اختلفت آراؤها حول هذه القضايا، وهذا وجه الفصل بين العقيدة وعلم الكلام في العنوان؛ فلئن اقتصر على العقيدة فقط لكان في ذلك طمس للكثير من القضايا التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية، وفي ذلك ضياع علم غزير. واستمر هذا الفصل حتى في عناوين الأبواب الثلاثة؛ فهو يتتبع أثرهما في الأصول النحوية في الباب الأول، وفي ثاني الأبواب في صياغة الفكر النحوي وأخيرا في التوجيه النحوي لنصوص العقيدة من قرآن وحديث ومنظوم ومنثور.
ويقصد بالنحو العربي الفكر النحوي سواء كان موجودا في كتب نحوية أم غير نحوية، حيث استمدت هذه الرسالة مادتها من مصادر متنوعة نحوية وكلامية وأصولية وتفسيرية وحديثية وأدبية.
ويظهر من خلال عنوان الكتاب أن المؤلف يقبل التأثير العقدي والكلامي في النحو العربي، علما بأن هناك اتجاهات رفضت هذا التأثير، فأي منهج اتبعه في الدفاع عن هذه القضية؟
مدخل المنهج:
لا جرم أن اتباع منهج مناسب في الدفاع عن قضية معينة هو أحد أسباب نجاحها، ولأن أصل الكتاب بحث أكاديمي؛ فالمؤلف يتبع منهجا أكاديميا دقيقا، ويعتمد خطة للبحث عامة تشمل: تمهيدا، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
منذ مقدمة الكتاب، حرص المؤلف على إثبات قضيته، حيث يقول: «وإذا وجدنا النحاة قد تأثروا بهذين المجالين [المنطق والكلام] فليس لنا أن نؤاخذهم لمجرد أنهم تأثروا، فإن الشأن بين هذه العلوم والمعارف والأفكار التأثير والتأثر، لا سيما إذا كان بين هذه العلوم والمعارف والأفكار ألوان من المناسبات ومحاور الالتقاء»[2].
كما يستعين في سبيل الدفاع عن هذه القضية بمنهج يقوم على الانتقال من العام إلى الخاص، ومن الكلي إلى الجزئي؛ حيث بدأ الباب الأول بدراسة القضايا العامة المتعلقة بالأصول النحوية، ثم درس في الباب الثاني القضايا العامة المتعلقة بالمصطلحات ولغة التأليف والتقسيمات، ثم خصص الباب الثالث لدراسة المسائل الجزئية التي ظهر فيها الأثر العقدي والكلامي[3]، وما كان هذا سبيله يطلق عليه: المنهج الاستنباطي؛ إذ ينطلق من قاعدة كلية ليستنبط منها قواعد جزئية مفرعة عنها، فهو يجعل قارئ الكتاب متواطئا مع مؤلفه قابلا لفكرته وقضيته منذ البداية، ومن ثم يصحبه في صفحات الكتاب؛ مستدلا وممثلا ومعللا لهذه القضية.
أما تناول المسائل الجزئية فقد كان يقوم على الابتداء بالقضية عند المتكلمين، ثم يعقبها بكلام النحويين عنها، ثم يحاول أن يلتمس الأثر الكلامي في القضية النحوية، أما إذا كان النحاة أنفسهم قد ضمنوا حديثهم في قضية ما شيئا من المادة الكلامية فحينئذ تبدأ الدراسة بأقوال النحاة، ثم تحاول أن تربطها بأقوال المتكلمين، وقد يخفى جانب التأثير في معالجة هذه القضايا، فتعالج في إطار التشابه بين العلمين أو التأثير غير المباشر[4].
مدخل المضمون:
حددت هذه الدراسة معالم أثر علم الكلام في النحو العربي؛ حيث درس المؤلف نشأته ومظاهره في المستويات النحوية المختلفة: مستوى المضمون من خلال دراسة هذا الأثر في الأصول النحوية، ومستوى الشكل من خلال تتبع هذا الأثر في المصطلحات ولغة التأليف والتقسيمات، ومستوى التطبيق عن طريق عرض المسائل النحوية الكلامية التي تتضمنها نصوص العقيدة من القرآن والحديث النبوي والأمثلة اللغوية الأخرى. وفي المدخل الآتي تفصيل لكيفية تفريع هذه المستويات على هذه الأبواب.
مدخل الأبواب:
بني البحث على ثلاثة أبواب كبرى، عناوينها هي الشق الأول من عنوان الكتاب نفسه، والشق الثاني منها مخصوص بجزئية من جزئيات النحو العربي؛ فهو في الباب الأول يعنى بأثر العقيدة وعلم الكلام في الأصول النحوية، ويفرع الحديث عنها في أربعة فصول كبرى أولها: في السماع النحوي، وثانيها في القياس النحوي، وثالثها في التعليل النحوي، ورابعها في العامل النحوي:
|
الباب الأول: أثر العقيدة وعلم الكلام في الأصول النحوية |
|
| في السماع النحوي |
يمكن تلخيص الآثار العقدية والكلامية في السماع النحوي في الأمور الآتية: 1- تأثر السماع النحوي ببعض القضايا الكلامية العامة ومن أهمها: قضية اللغة بين التوقيف والاصطلاح، وقضية التواتر والآحاد وقاعدة تقديم العقل على النقل. 2- ظهور التأثير الكلامي في موقف النحويين من القراءات في جانبين؛ أولهما: معارضة القراءات بالرفض أو التخطئة أو التشذيذ، والثاني: في ترجيح قراءة غير متواترة على قراءة متواترة خدمة للمذهب الكلامي. 3- تمثل التأثير الكلامي في موقفهم من الحديث النبوي من جهتين؛ الأولى: تحفظهم في الاستشهاد به عملا بقاعدة أن العقل أصل النقل، وأن خبر الآحاد لا يفيد العلم، والثانية: في تحريف رواية الحديث. 4- ظهور التأثير الكلامي في الموقف من كلام العرب من حيث رفض الروايات الشعرية وتخطئة الشعراء، وكذلك التوسع الزماني في الاستشهاد بشعر المولدين، إضافة إلى التوسع في مصادر الاستشهاد في الاحتجاج بكلام أهل البيت لدى بعض النحاة، وكذا من حيث الوضع والانتحال في الشعر ورواية المنكر والمجهول والتصحيف والتحريف في الرواية الشعرية. |
| في القياس النحوي | من أهم الآثار التي نجدها في القياس النحوي من الأفكار النحوية والاتجاهات الكلامية، وهي تكشف عن مدى حظ القياس النحوي من المنهج العلمي الذي يتمثل في اعتماده على بعض الطرق الاستقرائية؛ كالانتقال من الجزئيات إلى الكليات، واستخدام طرق الطرد والعكس والدوران، وقياس الشبه، وانتفاء المدلول لانتفاء دليله، وغير ذلك من طرق الاستدلال التي هي ألصق بمباحث أرباب الكلام والنظر منه بكلام النحاة واللغويين، لكن النحاة احتاجوا إلى استخدام هذه الطرق على أنها من أسس منهج البحث العلمي التي يعم استخدامها في سائر العلوم. |
| في التعليل النحوي |
ظهر التأثير الكلامي أكثر ما ظهر في العلل الصناعية التي جردها النحاة؛ كالبحث في العلل البسيطة والمركبة، والموجبة والمجوزة، وبحث التعليل بعلتين، ونحو ذلك. ومن أهم القواعد الكلامية التي أثرت في دراسة العلة والتعليل عند النحاة: أن كل حادثة ممكنة الوجود، وأن كل ماهية ممكنة بذاتها لا توجد ما لم يجب وجودها، وأن المعلول الواحد يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان، وأن الشيء لا يكون علة لنفسه. |
| في العامل النحوي | من أهم الآثار العقدية والكلامية التي نجدها في العامل النحوي، سواء ما كان منه متعلقا بتصور حقيقة هذا العامل أو بأحكامه وقواعده: صلة العامل عند النحويين بالعلة الفاعلة أو الموجد عند المتكلمين، ومن جهة الأحكام يظهر هذا الأثر في مرتبة العامل قبل المعمول وفي عدم جواز الفصل بين العامل والمعمول، وفي اختصاص العامل بالمعمول، وفي عدم اجتماع عاملين على معمول واحد، وفي كون اللفظ عاملا ومعمولا، وفي العامل العدمي، وفي الشيء لا يعمل في نفسه. |
وينتقل في الباب الثاني إلى دراسة الأثر العقدي والكلامي في الجوانب الشكلية على مستوى صياغة الفكر النحوي، ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول؛ أولها: في المصطلحات النحوية، والثاني: في لغة التأليف النحوي، والثالث: في التقسيمات النحوية.
|
الباب الثاني: أثر العقيدة وعلم الكلام في صياغة الفكر النحوي |
||
| في المصطلحات النحوية | في لغة التأليف النحوي | في التقسيمات النحوية |
| من أهم المصطلحات التي نلمح فيها آثارا كلامية واعتقادية، سواء ما كان منها مشتركا بين النحو والكلام أم كان كلاميا خالصا، وهي تشترك جميعها في تضمنها معنى ذهنيا عقليا. فمثال الأولى المشتركة بين النحو والكلام: الشـرط والحركة والسكون والصفة والوصف والنعت والبداء والمحل والتقدير والتعلق والحيز والجنس والتأليف وغير ذلك، ومثال الثانية وهي المصطلحات الكلامية في الدرس النحوي: الاستقراء والجوهر والعرض والماهية والذات والذاتي والمطلق والمقيد والتصور والتصديق والسلب والإيجاب والوجود والعدم. | إن هذه التعبيرات الكلامية والمحترزات الاعتقادية التي ظهر فيها التأثير الكلامي والعقدي، تكشف عن ارتباط النحويين بالمنهج الإسلامي في البحث والدراسة والتأليف. فمثال التعبيرات الكلامية: ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره، والمفتقر إلى غيره وغير المفتقر إليه، وهو هو/ هي هي، وبالقوة وبالفعل. ومثال المحترزات الاعتقادية: إطلاق كلمة «مذكر» على اسم الجلالة دون الذات، وقولهم «فعل دعاء» في الأمر المسند إلى الله سبحانه وتعالى، وإطلاق لفظ «الذات» على الله سبحانه وتعالى. | من أهم الآثار الكلامية في مجال التقسيمات النحوية، سواء ما كان منها معتمدا على أسس كلامية وما كان آخذا صورة التقسيمات العقلية والجدلية. فمثال الأولى: التقسيم إلى أصل وفرع، وكذا تقسيم الألفاظ بحسب التأثير والتأثر وبحسب الوجود والعدم، ومثال الثانية: التقسيم العقلي الفرضي وتقسيم صورة الصفة المشبهة، وتقسيم معمولي «لا» النافية للجنس. |
أما الباب الثالث من أبواب الكتاب فقد خصه المؤلف بدراسة الأثر العقدي والكلامي على المستوى التطبيقي وهو التوجيه النحوي للنصوص المرتبطة بالعقيدة على ثلاثة مستويات كبرى تمثل فصول هذا الباب؛ أولها: على مستوى حروف المعاني، والثاني: على مستوى الأبواب النحوية، والثالث: على مستوى الأساليب النحوية.
|
الباب الثالث: أثر العقيدة وعلم الكلام في التوجيه النحوي لنصوص العقيدة |
||
| على مستوى حروف المعاني | على مستوى الأبواب النحوية | على مستوى الأساليب النحوية |
| أثر المذهب الكلامي في اختيار بعض التوجيهات النحوية دون بعض على مستوى حروف المعاني، كما يلاحظ أن هذه المسائل النحوية الكلامية قد تضمنت بعض التوجيهات المستحدثة في الدراسة النحوية كالقول بأن السين للتوكيد، وأن «على» تفيد الوجوب... إلى غير ذلك، وقد ظهرت في هذه المسائل آراء لفرق كلامية مختلفة؛ كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة والسلفية، إلى جانب آراء لبعض ذوي الديانات الأخرى. | يستخلص من هذه المسائل مجموعة من الأمور؛ أولها: أن الخلاف المذهبي حول التوجيه النحوي لهذه المسائل لا يقتصر على الفرق الإسلامية، بل يشمل أيضا بعض أهل الديانات الأخرى. والثانية: أن بعض الفرق الدينية قد تخيرت الأوجه البعيدة في اللغة من أجل تأييد المذهب الكلامي. والثالثة: أن بعض النحاة قد بالغ في الاعتداد ببعض القضايا اللغوية تأثرا بمذهبه الاعتقادي. والرابعة: استخدام النحاة بعض الاحترازات الاعتقادية. | ظهر التأثير العقدي والكلامي في المسائل التي تتعلق بالتوجيه النحوي على مستوى الأساليب النحوية، وكان للتأثير العقدي النصيب الأكبر، ويتضح ذلك من خلال القواعد التوجيهية المبثوثة في هذه المسائل والتي من أهمها؛ أولا: الاستفهام من الله سبحانه وتعالى لا يكون على حقيقته، وثانيا: لا يجوز التعجب على الله سبحانه وتعالى؛ إذ لا يخفى عليه شيء، ثالثا: لا يجوز تقييد قسم الله سبحانه وتعالى بزمان معين؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى سابق على الزمان، رابعا: وصف الله سبحانه وتعالى بأفعال التفضيل هو على غير بابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا مشارك له في صفة من الصفات، خامسا: خبر الله سبحانه وتعالى يجل عن الخلف. |
ويلاحظ أن تتبع الأثر العقدي والكلامي في النحو العربي لم يقتصر على مستوى الشكل والأسلوب فقط، ولكن على مستوى المضمون والأفكار أيضا، كما احتوى البحث على عدد من القواعد العقلية العامة التي استخدمها النحاة في التوجيه والتعليل للظواهر والأحكام النحوية، أو أثرت في تناولهم للمسائل النحوية عموما. كذلك تضمن البحث عددا من الأفكار والنظريات الكلامية التي أثرت في الفكر النحوي، وهذا كله يكشف عن ارتباط المنهج النحوي بالمنهج الإسلامي العام في البحث والتفكير.
***
[1] الأستاذ المساعد بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة، والأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية ـ جامعة الإمارات العربية المتحدة.
[2] مصطفى بخيت، أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي ص: 12.
[3] نفسه، ص: 16.
[4] نفسه، ص: 16.