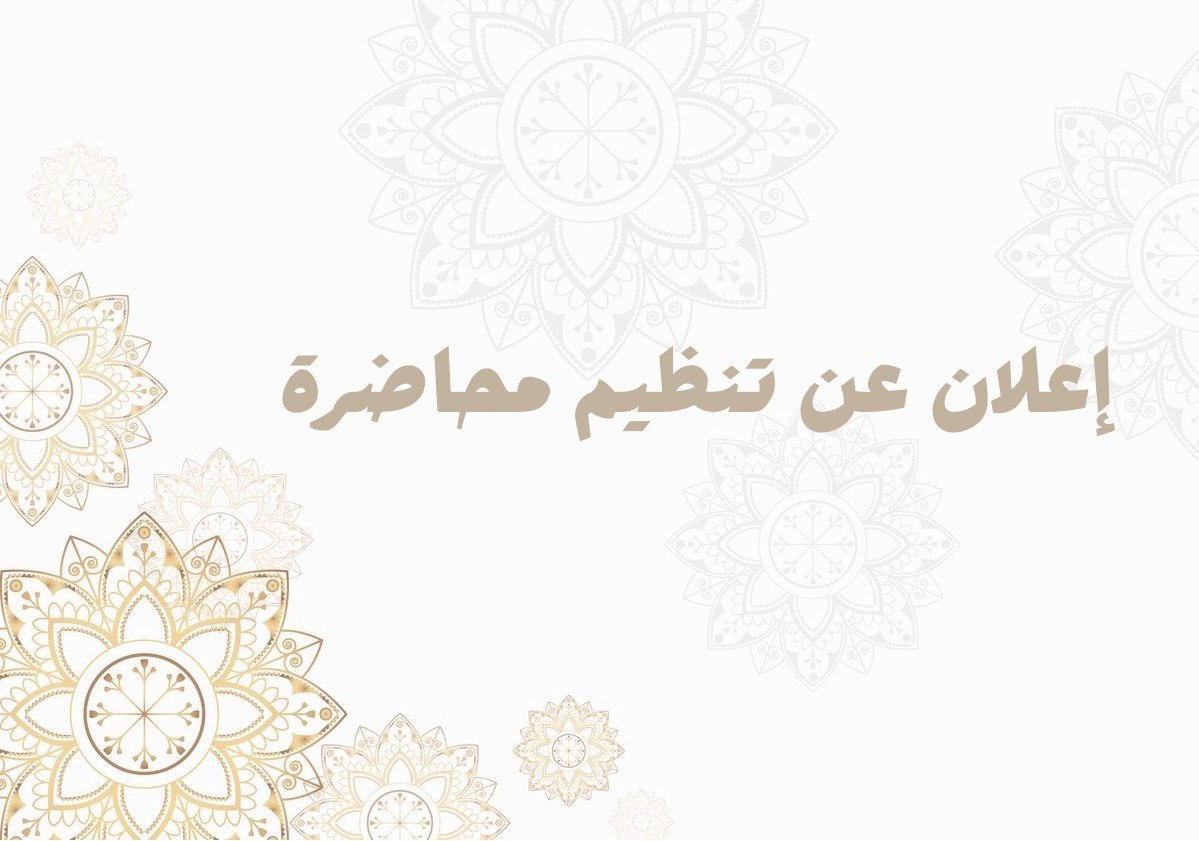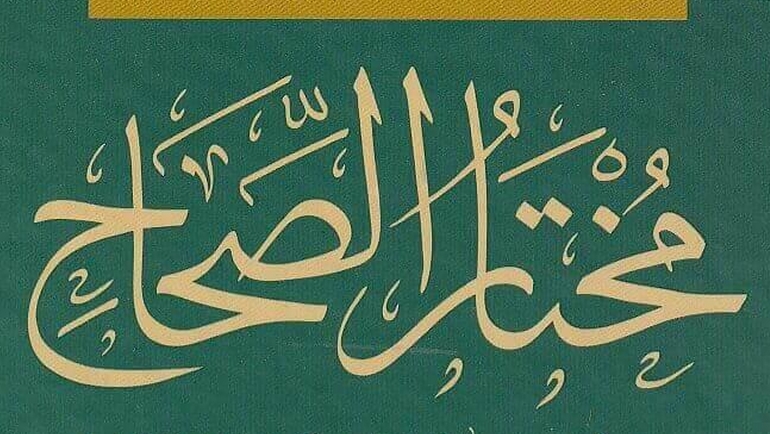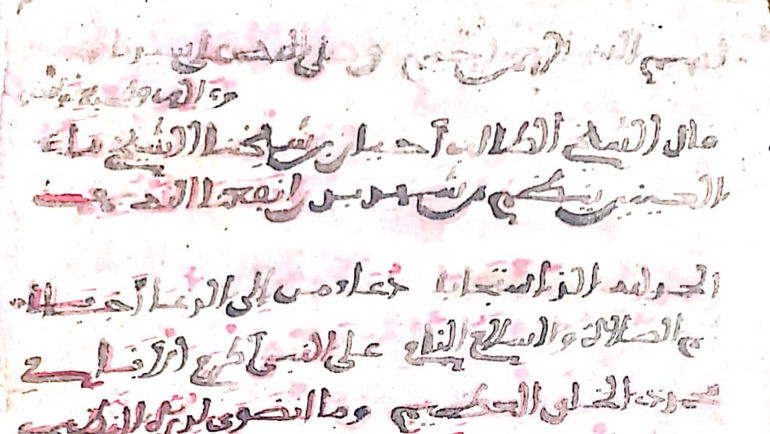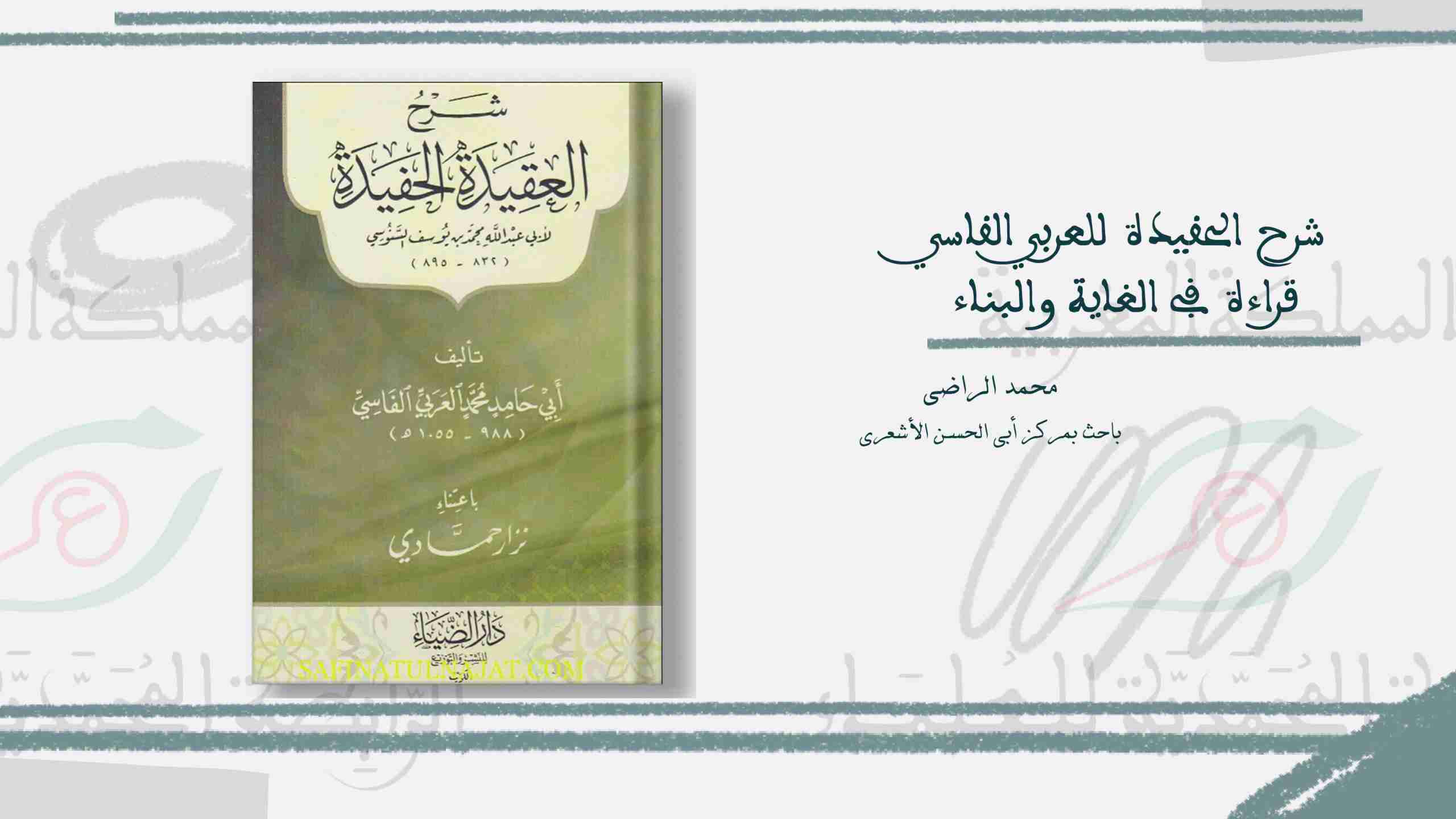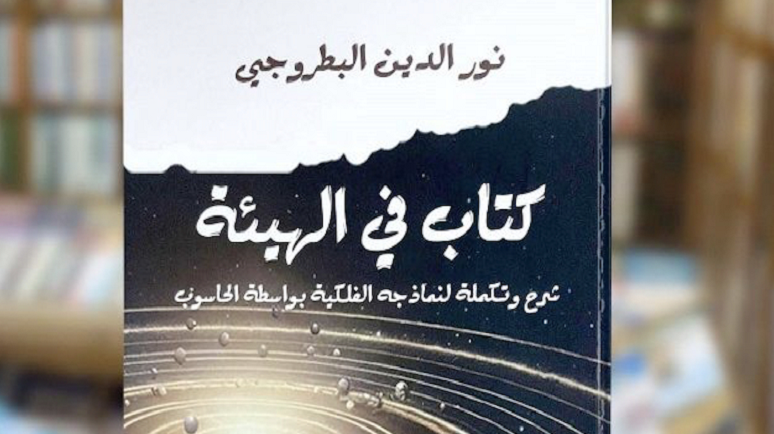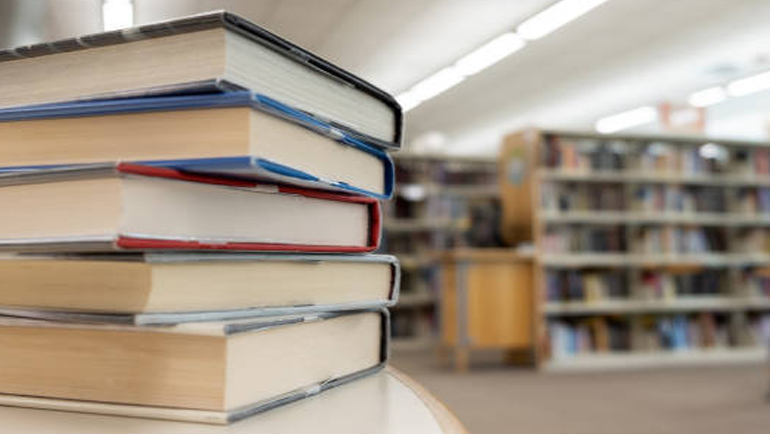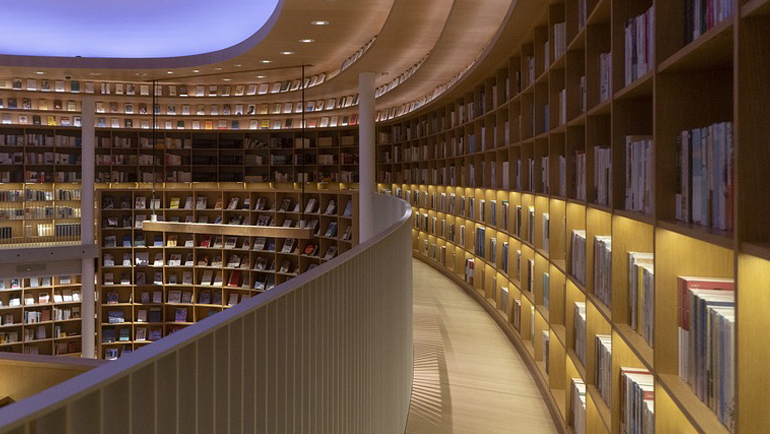
حينما أتمَّ المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد تحرير كتابه "الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق" سنة 1977م لم يكن ليخطرَ بباله ما سيحظى به من حفاوة هائلة وإقبال منقطع النظير؛ فلقد وجد في البداية صعوبة في إثارة اهتمام دار نشر جادة تعنى بنشر مشروعه؛ إذ كان يبدو ضئيلا لا يرهص بأمل كبير[2].
ولكن ما إن نشر في أمريكا وإنجلترا حتى اجتذب الكتاب إليه الأنظار، ما بين غالٍ في العداوة مسرف في الخصومة، ومن لم يهتد لفهم أبعاد الكتاب، ومرحب به مستبشر بظهوره، وكان المتحمسون له أعظم عددا[3]. ومنذ 1980 عامِ ظهور الترجمة الفرنسية تواترت ترجماته باللغات اليابانية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والبولندية والإسبانية والكاتالونية والتركية والصربية الكرواتية والسويدية ولغات أخرى.
إن هذا الفيض من الترجمات والاستثارات البالغة التي حركها في مختلف جهات المعمور حمل إدوارد سعيد على أن يعد كتابه كتابا جماعيا يتجاوز ذاته بدرجة فاقت كل مستويات توقعه وانتظاراته[4].
لقد نكأ سعيد جرحا غائراً اجترحته الدراسات الاستشراقية بوصفها نسقا معرفيا تماهى مع الرؤيا الغربية ومركزيتها المتعالية. وكانت محاولته تفكيك نسيج هذه الرؤيا وتعمُّقِ أبعادها وغاياتها مثار إزعاج وقلق في بنيات الاستشراق ومؤسساته. ذلك أن سعيد رام خلخلة المفاهيم والرؤية السكونية للممارسة الاستشراقية التي حرصت على تقمص ثوب العلم المبرء من شوب المصالح والمعصوم من الارتهان للسياسات الاستعمارية. لكن هذا الدثار لم يكن ليصمد أمام الفحص والتحليل وسبر القرائن والسياقات ودخائل الممارسات لتتكشف الخبيئات الثاوية وراء الحماس الاستشراقي ونشاطاته المحمومة لخدمة الأغراض الاستعمارية.
لقد تمثل الاستشراق عبر التجربة التاريخية بوصفه نشاطا بحثيا حول الشرق عامة والعالم العربي والإسلامي خاصة. وهذا النشاط مارسته أوروبا حتى قبل ظهور كلمة الاستشراق لأول مرة بالإنجليزية عام 1779م ثم بالفرنسية في 1838م. والمستشرق حسب تعريف أولي متداول هو العالم المتخصص في معرفة الشرق ولغاته وآدابه[5].
لكن هذه المعرفة لم تكن قط معزولة عن فضائها وبيئتها. فلقد شكلت تلك المعرفة مصدر قوة للمصالح الغربية ووهبت لها الصور الضرورية لتيسير الانسياب داخل الشرق واختراق جسمه المشروخ وفتق رتقه الجريح أصلا.
لئن كان الاستشراق قد استمد معلوماته من الرحلات إلى الشرق واغتذى بمعرفة ثرَّة جرى تحويلها إلى أوروبا عبر الإرساليات التبشيرية والتجار والمدراء فهو في "جوهره" حسب سعيد "عالم نص وبنية أوروبية" اختلقها أصحابها لخدمة متطلبات خطط أوروبية محددة. والثمرة المرجوة من خطابات الاستشراق هي بناء "آخر ذي دلالة" يحدد الغرب عبره هويته الذاتية بناءً يمهِّد ويشيد تفوقه واستعلاءه ومشروعية حكمه وهيمنته. وتستند هذه المقاربة إلى دراسة فوكو التي تقرر أن المعرفة دالَّةُ سلطة[6].
ملخص باراديم فوكو هو ما أثبته في عدد من مؤلفاته، ولاسيما في كتابه "أركيولوجيا المعرفة"، من أن العلوم الإنسانية كما ارتهنت منذ نشأتها لفلسفة الأنوار التي اتخذت من الإنسان "إيديولوجيتها العظمى"؛ فقد كانت أيضا رجع صدى لمصالح اجتماعية محددة. وهو ما من شأنه أن يجردها مما تتباهى به من حياد وموضوعية.
إن علم الاجتماع، مثلا، في أصل نشأته جسد "سلطة معرفية" أخذت بزمامها البورجوازية الصاعدة ابتغاء التحكم في التركيبة الاجتماعية وتكريسها. كما أن علم النفس كان آلية وظفها أرباب المصانع بغية مضاعفة المردودية الإنتاجية لدى العمال من خلال ضبط بواعثهم النفسية والسلوكية[7].
لقد اعترف الباحث "جي جي كلارك" أن "الاستشراق، حتى في أقصى مُسوحه إغراقا في الأكاديمية، ارتبط بقوة وعلى نحو لا انفصام له بالاهتمامات والمشكلات الغربية، ومن ثم لا يمكن تصوره إلا في نطاق محدود جدا، باعتباره بحثا عن المعرفة المنزهة عن الغرض[8]". كما اعترف أن أهم هجوم مؤثر ومتسق فكريا عرَّى هذا التشابك بين المعرفة الاستشراقية والمصالح الاستعمارية هو النقد الذي قدمه سعيد[9].
لقد غدا الباراديم الذي نحته سعيد بخصوص الخطابات الاستشراقية كما يقول كلارك عقيدة وأنموذجا لا يكاد يخرج عنهما أحد من الباحثين والدارسين، ومحرضا لأكثر السجالات إثارة وأوسعها نطاقا خلال السنوات الأخيرة[10].
وكمثال بارز على تمثل باراديم سعيد يذكر كلارك مثال الباحث برنارد فاور في بحثه عن بوذية شان Chan budhismإذ يؤكد هذا الأخير أن دراسة سعيد تنطبق على الشرق الأقصى، ذلك أن الهند والصين غدتا موضوعا لخطاب شرقي مماثل. واستدل بقول الباحث فيليب ألموند: "إن الخطاب الفيكتوري عن البوذية إنما هو جزء أعم وأشمل عن الشرق على النحو الذي أوضحه سعيد في كتابه الاستشراق[11]."
وما يزال كتاب سعيد يتردد صداه في الدراسات والقراءات الحديثة، نذكر منها؛
كتاب "قراءة في كتاب الاستشراق: إدوارد سعيد والمسكوت عنه" 2007 لديفيد فاريسكو. كتاب "شغف المعرفة: المستشرقون وأعداء المستشرقين" 2006 للمستشرق والمؤرخ البريطاني روبرت أوروين[12].
في هذا السياق السجالي يأتي الكتاب الحالي موضوع الدراسة "ما بعد الاستشراق: الشرق كما يصنعه الشرق" قصد مراجعة خطابات نقدِ الاستشراق، وتشخيص وضعية هذا الأخير، وفحص درجات تقبله وتأثيره في البيئات الاستشراقية، وتفسير مقاومة وممانعة بعض البؤر دون بعض، واستشراف آفاق ما بعد التجربة الاستشراقية.
لبسط هذه الموضوعات ستتمحور هذه القراءة حول العناصر التالية:
العنصر الأول: نبذة عن الكتاب
العنصر الثاني: أطروحة أفول الاستشراق.
العنصر الثالث: نقد باراديم سعيد والخطابات الشرقية حول الشرق.
العنصر الرابع: مستويات التأثير والتلقي.
العنصر الخامس: حول آفاق الاستشراق.
العنصر الأول: نبذة عن الكتاب
يضم هذا الكتاب بين دفتيه جانبا كبيرا من إسهامات ندوة "الاستشراق وبعد؟ وساطات وتملكات ومنازعات[13]" التي جرت وقائعها في باريس في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS وفي معهد العالم العربي IMA أيام 15 و16 و17 يونيه 2011.
والكتاب الحالي من إصدار مؤسسة الملك عبد العزيز تحت إشراف فرانسوا بوييون[14] وجان كلود فاتان[15] سنة 2012 في إطار سلسلة حوار الضفتين. ويأتي تتميما وخاتمة تركيبية لمعجم المستشرقين الناطقين باللغة الفرنسية khartala, 2008[16] الذي حاول فيه مؤلفوه من خلال عدد كبير من الملاحظات الترجمية مسحَ الميدان الرحب للاستشراق عبر مقاربة مشتتة لفاعليه ومؤسساته وشبكاته. فكان لزاما أن يتلوه كتاب عاقبٌ يروم بلورةَ حصيلة تاريخية للسجالات التي أثارها الاستشراق، وجردَ الآثار التي خلفها في المجتمعات الحالية.
ومن أجل الفصل في الاتهامات وعمليات التفكيك التي كان الاستشراق غرضا لها بدءا من زوال الاستعمار إلى الدراسات ما بعد الاستعمار جهِد المؤلفون في التنقيب عن وثائق مقنعة في تضاعيف الاستشراق الكلاسيكي كما في تجلياته الأكثر حداثة[17].
يقع الكتاب في ستة وسبعين وخمسمائة صفحة، وتتوزع موضوعاته على مقدمة وأربعة أقسام كالتالي:
المقدمة: تضمنت المقدمة افتتاحية للباحث جان كلود فاتان بعنوان: ما بعد الاستشراق: شرقُ الشرقيين. ومقالة بعنوان: موت الاستشراق وبعثه.
القسم الأول: مراجعات حول الاستشراق Retours sur l’Orientalisme
قسمه المؤلفون إلى مبحثين:
المبحث الأول: حوصلة Récapitulation
وقد اشتمل على خمسة بحوث على النحو التالي:
- "الخطابات الحقيقية للاستشراق" لروبرت إيروين.
- "عابر- فوق- ما بعد: من أجل استعمال منضبط للاستشراق الداخلي" لإيمانويل زوريك.
- "إسهام الشرقيين في الجدل والخبرة العالمة القرن 17" لبرنارد هيبرجر.
- "ابتكار القانون الإسلامي. نشأة الوضعية التشريعية وانتشارها في السياق الإسلامي المعياري normative" للباحثين ليون بوسكنس وبودوين ديبري.
- "الوعي التاريخي و تحدي التاريخية في السياقات الإسلامية» للباحث عبدو فيلالي أنصاري.
المبحث الثاني: فحوصات نقدية
اشتمل على أربعة بحوث كالتالي:
- "قراءة شرقية لروايات السفر إلى الشرق" للباحث كاي بارتلمي.
- "لماذا سعيد؟ قراءة سوسيوتاريخية جديدة لنشأة كتاب" لطوماس بريسون.
- "لا تقرب شرقي! الإغرابية واللاأنثروبولوجية عند بعض الباحثين المغاربة المعاصرين" لزكريا الرهاني Rhani
- "علم الإسلاميات عند الجامعيين المسلمين بفرنسا. بين التفسير القرآني والمنهجية النقدية" لفرانسوا زبَّال.
القسم الثاني: ألوان متعددة من الشرق
تضمن ثمانية عشرة بحثا تناولت الاستشراق الياباني والصيني والعثماني والروسي تُهِمنا منها مقالتان:
الأولى؛ "كيف أفلت اليابان من الاستشراق الغربي؟" للباحث باتريك بايفار.
الثانية؛ "الخطاب الديني الإسلامي والاستشراق اليهودي" للباحث محمد حاتمي.
القسم الثالث: قراءات جديدة
تضمن هذا القسم سبعة بحوث تناولت نشأة الفلكلور المصري و أعمال محمد جلال بوصفه مؤسساً للأنثروبولوجيا بمصر، ودراسة مقارنة بين المعرفة الاستعمارية الإيطالية وبناء الهوية الليبية، وأسطورة اللاتينية في الجزائر فترة الاستعمار وما بعده، وإشكالية كتابة ماضٍ غير استعماري ولا كلاسيكي حالة توات الجزائرية نموذجا ويهمنا في هذا القسم مقالة: "الإنتاج الاستشراقي معرباً، هل هو عودة إلى الأصل؟" للباحث ريتشارد جاكموند.
القسم الرابع والأخير: إراثات Patrimonialisations
اشتمل هذا القسم على مقالات حول الاستشراق الفني تناولت بالدرس والتحليل موقع قصص "ألف ليلة وليلة" عند العرب بين الرفض والقبول، ومتحف الفن العربي بالقاهرة ودراسة عن التحول من الخزف إلى السيراميك بتونس، وأخرى عن ابتكار الزربية المغربية ومقالة عن سوق النُّسَخ الاستشراقية بلبنان...
ولا يسعني في هذا العرض الموجز أن أعرج بالتفصيل على كل مناحي الكتاب لاتساعها وتشعبها وغرقها أحيانا في الجزئيات التفصيلية، وهو ما سيغرقنا في التفاصيل الدقيقة ويصرفنا عن جوهر الكتاب ومقاصده الأصيلة المستبطنة والظاهرة. ولذلك سأركِّز على الأطروحة الأساسية للكتاب، وغاياته الأساس عبر المطالب التالية.
العنصر الثاني: أطروحة أفول الاستشراق
هل استنفد الاستشراق أغراضه وآل حاله إلى أفول؟ وهل ركدت ريحه لتهب مكانها ريح أقوى بوسائل وأدوات لم تكن ميسورة للاستشراق في صوره التقليدية؟ هل يمكنه لملمة جهوده المتعثرة، فينبعثَ بعد خمود وموات قويا هادرا كما كان من ذي قبل؟
تلك أسئلة رام الكتاب صياغة أجوبة حاسمة عنها، وهو ما سأتناوله في الفقرتين التاليتين:
أولا: تأكيد أطروحة نهاية الاستشراق الكلاسيكي
لقد تغيَّا الكتاب تشخيص الوضعية الراهنة للاستشراق تشريحا لأسباب الانحباس، ونقدا لجذور التفكك والانحلال، وبحثا عن سبل الخروج من الأزمة والانسداد، واستشرافا لآفاق المعرفة الاستشراقية. والقصد من وراء ذلك إعادة هيكلة المؤسسة الاستشراقية واستئناف مشروعية جديدة لمشاريعها البحثية والمعرفية.
ينطلق التشخيص، بادئ ذي بدء، من مراجعة مفهوم الاستشراق وتحديده تحديدا اصطلاحيا دقيقا يخرج به من حالة الهلامية والانمياع.
ذلك أن إحدى المعضلات التي تجثم في طريق تشريح الوضع الراهن للاستشراق تكمنُ في تحديد كنه الاستشراق، ومن الصعوبات البالغة بلورة تعريف جامع مانع بتعبير المنطقيين يحصر نطاقات الاهتمامات الاستشراقية وينفي عنها مالا يمُتُّ إليها بصلة[18].
والتعريف الذي اختاره الكتاب هو ما بسطه "فرانسوا بوييون" في سياق تأريخي موضحا أنه في أتون الحرب العالمية الصامتة الملتهبة اليوم تحت دثار صدام الحضارات، نجد أسئلةَ الهوية والتراث في قلب القضايا الإستراتيجية، وإلى جنبها ظواهر التحكم في القوة الرهيبة للصور، صورِ الذات وصور الآخر، ومعارك تثار هنا وهناك بسبب من صورة ساخرة أو صورة امرأة محجبة، وسجالات لاذعة حول النشاطات الإعلامية.. كل ذلك يدل على أننا نمس حقلاً هُوِّل بشدة إلى درجة انحباس الحوار السياسي. والحال أنه كان ثمة تخصص انكب طيلة قرون على معالجة هذه الأسئلة بوصفها موضوعات علمية وسياسية. هذا ما نطلق عليه الاستشراق، تلك الباقة من الفروع المتخصصة والتواصلية التي عنيت بمعرفة اللغات والثقافات والحضارات الواقعة غرب وجنوب أوروبا، وبث علومها وتمثلاتها[19].
ومع أن هذا التعريف لا يفي بالشروط المنطقية للتعريفات، إلا أنه يجسد جانبا مهما من حقيقة الاستشراق بغض النظر عن خلفياته الدفينة وإكراهاته أو التزاماته السياسية.
هذه الصورة البريئة التي يقدمها التعريف ما لبثت أن عرتها هزة عنيفة من التشكيك في بواعثها وطويتها المضمرة.
يقول بوييون: "بعد أن شكل هذا الحقل المعرفي ميداناً رحيبا من التواصل العلمي والتعميم خلال حقبة التفوق الأوروبي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين؛ فإنه أضحى منذ بضعة عشريات هدفا لنقد جذري، حيث رُمي بتهمة أنه منذ نشأته وخلافا لواجهته البريئة التي يرائي بها فإنه كان يمزج العلم بالسياسة، والفضول بنزعات التحكم[20]."
لقد تواترت الشهادات من داخل الكتاب مسلِّمة بأطروحة اضمحلال الاستشراق الكلاسيكي مدلية ببضع مؤشرات على هذا الاضمحلال وشارحة أحيانا العواملَ والأسباب، وداعية أحيانا إلى الإسراع بالمراجعات الضرورية لاستنقاذ الاستشراق من مصيره البائس الذي آل إليه.
إحدى هذه الشهادات نلتقطها من فرانسوا زبَّال؛ إذ يتحدث عن "أزمة الاستشراق"La crise de l’orientalisme [21]. وتعبير الأزمة ذو مغزى؛ فهو ينبئ عن مخاض عسير وتحول في البنيات والغايات، ولا يعني التوقف والخمود. فإذا كان الاستشراق قد قرر انحلاله خلال انعقاد آخر مؤتمر له في باريس سنة 1973؛ فإن المدرسة الفكرية التي ألهمها ما تزال على قيد الحياة بسادتها ومناهجها لائذة بأروقة المعاهد ومحتمية بالسلسلات والمجلات [22].
وحسب "فرانسوا زبَّال" فإنه بينما آثر برنارد لويس الاستقرار منذ سنة 1975م بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن المستشرقين الفرنسيين لم يكن لهم من ملاذ سوى لزوم أجنحة الجامعات التي تؤَمِّن لهم إلى حد ما بعض الحماية. ويُعدُّ شارل بلاط Charles pellat آخرَ المستشرقين الفرنسيين المحتمين بأسوار الجامعات[23].
ونجد عبارة "نهاية الاستشراق القديم" صريحة عند طوماس بريسون[24]. وأقوى منها دلالةً عبارة "موت الاستشراق" التي استعملها بوييون في مقاله المُلمع إليه سابقا. كما نصادف عبارة "ما بعد الاستشراق" Au delà de l’Orientalisme عند جان كلود فاتان[25].
ثانيا: مظاهر أزمة الاستشراق
من أبرز محطات الكتاب سعيه نحو تشخيص معالم العطب في الدرس الاستشراقي الكلاسيكي. من هذه المعالم المنبئة عن تأزمه نذكر ما يلي:
المظهر الأول: غياب رؤية منسجمة
إحدى تجليات هذا التآكل والانحلال ما آل إليه الاستشراق الكلاسيكي من تشرذم مدارسه وتضارب رؤاه. لم يعد الاستشراق القديم كتلة واحدة مندمجة، بل استشراقات لكل واحد منها شرقه الخاص[26]. فلا نكاد نظفر بتصور مندمج حول الشرق لدى أجيال المستشرقين من البحارة والمكتشفين والسياسيين والعسكريين والصحفيين والباحثين والمهاجرين... لقد صبغ كل واحد منهم الشرق برؤيته الخاصة، فنيةً أحيانا وعلمية أحيانا أخرى، ومستمدة عند آخرين من معين الخيالات الخصيبة[27].
المظهر الثاني: ضمور الدرس العلمي
من تجليات أزمة الاستشراق أيضا ما سجله "جان كلود فاتان" من افتتان المستشرقين بالميدان السياسي وزهدهم أو انصرافهم عن أعباء الدرس العلمي ومقتضياته[28].
إن ضمور الدرس العلمي وإيثار الحقل السياسي مردُّه إلى الضعف الذي عرى الأجيال المتأخرة للاستشراق. فما عاد لهم الصبر والجَلَد الذين كان لأعلامهم البارزين الذين أفنوا أعمارهم في التحقيق والبحث والتنقيب. وما عاد لهم قوة ملكاتهم وصرامة مناهجهم. ولذلك اقتحموا لجج السياسة والصحافة إيثارا للسهولة.
ثالثا: عوامل الأزمة
كان وراء تصدع أركان الاستشراق الكلاسيكي عدة عوامل أسهمت مندمجة في الإسراع به إلى التهاوي والانحلال:
العامل الأول؛ ارتهان الاستشراق الكلاسيكي للمصالح الاستعمارية، ولاسيما في فرنسا وبريطانيا[29].
العامل الثاني؛ تعاظم نقد الاستشراق، ورفض صور الغرب عن الشرق، لاسيما بعد انكشاف انحيازات الاستشراق الكلاسيكي للسياسات الاستعمارية. وهي الانحيازات التي بدت سافرة مستفزة للضمائر الحية بين صفوف المستشرقين قبل غيرهم. يشير إلى ذلك "طوماس بريسون" بتأكيده على أن انطلاق النقاش في فرنسا حول الاستشراق جاء عُقيب اضطرابات الحرب الجزائرية[30].
العنصر الثالث: نقد باراديم سعيد والخطابات الشرقية حول الشرق
أولا: بدايات نقد الاستشراق
توارد النقد على الاستشراق من الداخل والخارج. كانت الأزمة تعتمل في باحات الاستشراق وبين مؤسساته، وزادها اضطرابا سهام الاتهام من الشرقيين المفجوعين مرتين. مرة باحتلال بلدانهم وغصب خيراتهم. ومرة بالمخيالات الجانحة والصور الزائفة التي كان يرسمها الاستشراق عن أبناء الشرق وهويتهم وتاريخهم.
ربط بوييون بدء السجال حول الاستشراق بحقبة زوال الهيمنات الاستعمارية والتي انطلقت منذ حوالي نصف قرن[31]. وفي خضم حركة المراجعة الكبيرة التي عبرت حقول العلوم الاجتماعية وعلم السلالات البشرية الإثنولوجيا والتاريخ بدرجة أولى؛ فإن صيحة سعيد حسب بوييون لم تكن هي النذير الأول ولا هي الأكثر تأثيرا في فترة معينة. ودون الرجوع إلى تحذير كتاب "L’orient vu de l’Occident" الذي قامت بنشره مكتبة المستشرق "بول غوتنر" (Paul geuthner) سنة 1922م، والذي يندرج بالأحرى في نطاق السجالات بين الأديان[32]؛ فإن الذين تولوا بصفة خاصة إذكاءَ فتيل الخصومات هم المثقفون العلمانيون المدججون بثقافة مزدوجة، والمنخرطون في الحركة الوطنية لشعوبهم[33]. من بين هذه الإسهامات نجد:
ـ مقالة بالفرنسية تحت عنوان: "الاستشراق في أزمة" لعالم الاجتماع أنور عبد المالك سنة 1963م. وقد كان لهذه المقالة وقعها الكبير، حتى إن المؤرخ الفرنسي المعروف "كلود كاهين هب"، على زهده في خوض المعارك الفكرية، ليرد على ما جاء فيها؛ إذ شعر أنها تعصف بمشروعية العمل الذي يضطلع به. وأرسل من ثم رسالة إلى رئيس تحرير مجلة "ديوجين" قائلا: "وقد وجدت نفسي مضطرا للرد عليها أو إثبات الملاحظات والتعليقات التالية حولها [34]."
ومعلوم أن أنور عبد المالك يرفض حيادية العلوم الاجتماعية والرؤى الفلسفية، معتبرا أن المناهج الغربية تعكس الهيمنة الغربية والنزعات المركزية الأوروبية[35].
ـ الدراسة الموسومة "إزالة احتلال التاريخ" "Décoloniser l’histoire" لمحمد شريف الساهلي سنة 1965م. صدرت عن دار ماسبيرو Maspero بباريس.
ـ في سنة 1976م أصدر عبد الكبير الخطيبي مقالة نقدية ضد "جاك بيرك" أسماها فيما بعد "الاستشراق التائه" "l’orientalisme désorienté". ولم ينتبه الخطيبي، حسب بوييون، إلى أن جاك بيرك كان قد أطلق النار داخليا على ممارسات الاستشراق خلال مؤتمر استشراقي عقد ببريكسل، ونشر مقالته الغاضبة تحت عنوان "من أجل دراسة المجتمعات الشرقية المعاصرة" سنة 1961م. وحيث إن بيرك كان يعتبر لفظتي "مستشرق" و"أنثروبولوجي" شائختين ومتجاوزتين؛ فإنه رغِبَ عنهما إلى تسمية بديلة، حيث سمى كرسيه بكوليج دي فرانس "التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر[36]."
حقا لقد كان المشروع التفكيكي رحب المدى، ومتجاوزا للاستشراق بوصفه دراسة عالمة للغات والحضارات، حيث انهال النقد والمراجعة خاصة على البعد السياسي للعلوم الاجتماعية وعلى تشابكها مع المشروع الكولونيالي[37].
ـ ويزعم بوييون أن فرنسيي فرنسا "المتجردين من كل مشروع نضالي والمعترف بهم من قبل المؤسسة الجامعية" هم الذين أصروا خلال هذه الفترة على أن يراجعوا رأسا على عقب ما أسماه شارل روبرت أَجِرون "المدونة الكولونيالية"[38].
انضم إلى هذه الأصوات الناقمة على الاستشراق ناشئة من الباحثين المشبعين بقناعات ما بعد استعمارية Anti-coloniales ارتبطت ارتباطا واسعا بحقبة التعاوناتles coopérations التي تلت الاستقلال. ذكر بوييون عدة نماذج منها:
ـ "جزائر الأنثروبولوجيين" لفيليبس لوكاس وجان كلود فاتان. نشر ماسبرسو بباريس 1975.
ـ أعمال الأيام التي نظمتها جامعة جوسيو Jussieu مارس 1968م والتي طبعت مذيلة بعنوان فرعي صريح جدا بخصوص ما نحن بصدده: "الاستشراق والإثنولوجيا: سياسة وابستيمولوجيا، نقد ونقد ذاتي".
ـ مجموعة وثائق "الأنثروبولوجيا والامبريالية" التي تدين اشتباك العلماء في المشروع الإمبريالي الأمريكي، خاصة في آسيا الجنوب شرقية. نشرت هذه الوثائق تحت إشراف جان كوبانس من قبل دار النشر ماسبرسو بباريس سنة 1975[39].
إن بوييون حينما يستعرض هذه المكتبة التي سبقت التاريخ المقدر لخروج كتاب سعيد يرسل رسالة خفية تستضمر التهوين من شأن سعيد ومن لف لفه من الشرقيين؛ إذ يلح على أن استباقات الشرقيين إلى نقد الاستشراق لم تكن إلا شرارة سرعان ما تلقفتها أيدي الباحثين الفرنسيين المدججين بالمنهجيات الحديثة لتجعل منها حركة قائمة على أصولها، تنهض بها المؤسسات وتقوم لها الندوات.
وكأنه يستكثر على الشرقيين المجروحين أن يرافعوا ضد من تواطأ مع الاستعمار وأسدى له خدمات جسيمة، فهناك من سينوب عنهم في معركة الدفاع عن شرقهم المشروخ بالصور الاستشراقية الزائفة.
بل إنه كما لاحظنا يذهب إلى تخطئة استباقات الشرقيين بتغليط زمانها، فالخطيبي لم يكن في الموعد الصحيح حينما صب جام نقده على بيرك، ولم يفته أن يفتش في ثنايا أعمالهم النقدية. فالجزائري مالك ألولاMalek Alloula حينما أصدر كتابه "الحريم الكولونيالي" إنما كان يستلهم نقده من "رونالد بارث" ومن التحليل النفسي[40].
إلى جانب هذا نجد تركيزا لدى بوييون كما لدى غيره على الشرقيين الذين يكتبون بالفرنسية أو الإنجليزية في تغييب كامل للشرقيين الذين قدموا إسهامات جليلة في نقد الاستشراق باللغة العربية. وهو ما مرده في الغالب إلى الجهل بالعربية وبالمنتوج العربي.
ويكفي أن أشير، هاهنا، إلى رواد الفكر العربي الذين ناهضوا الاستشراق وفطنوا إلى بواعثه الدفينة من أمثال أحمد فارس الشدياق 1804-1887م والأمير شكيب أرسلان 1869-1887م وهؤلاء سبقوا سعيد بزمن غير يسير، فضلا عن لائحة طويلة من الناقدين العرب الذين عالجوا موضوعة الاستشراق معالجة نقدية، نذكر منهم مالك بن نبي 1905-1973م ومحمد البهي 1905-1982م وعمر فروخ 1906-1987م وغيرهم[41].
ثانيا: حول أثر كتاب سعيد
شكل نقد كتاب إدوارد سعيد محورا لا تكاد تتفلت منه أبحاث الكتاب، إما تصريحا أو من طرف خفي باستلهام النموذج المعرفي الذي أرساه وأيده.
وتتردد المقاربات النقدية بين الاعتراف بالنجاحات الباهرة التي حظي بها الكتاب وبين غصة ومضاضة وامتعاض من آرائه ونقده الحاد لتاريخ الاستشراق وصوره المصنوعة عن الشرق.
1. أسرار نجاحِ سعيد
سعت بعض أبحاث الكتاب إلى الوقوف على أسرار الدينامية التي بعثها كتاب سعيد، وقدرته الفائقة على تحريك المياه الراكدة التي كانت تحيط الاستشراق بهالة من الهيبة والتمجيد.
لقد توقف "طوماس بريسون" عند حدث ترجمة كتاب سعيد، واعتبر ترجمته إلى ما يربو على ستة وثلاثين لغة علامة واضحة على النجاح الباهر الذي حققه كتابه، لاسيما إذا استحضرنا أن الموضوع الذي طرقه سعيد كان من الدقة والتخصص بحيث لا يكاد يلفت إليه إلا طبقة خاصة من القراء[42].
كما أشاد بريسون بالدينامية الجديدة التي بعث سعيد و بأثره الواسع في أجيال من الدارسين[43].
وسر هذا النجاح الباهر يتمثل في عدة عوامل:
أ. قدرته التوفيقية بين مصادر متضاربة[44].
ب. قدرته على توليد اتجاهات متباينة حول موضوعة الاستشراق[45].
ج. استيعابه للإنتاج الأمريكي العَالِمْ[46].
د لغته الانجليزية الأنيقة، وأسلوبه الذي يتحكم فيه بشكل كامل[47].
ﻫ. دفاعاته المستميتة عن المقصيين متوسلا بكل الجماليات البيانية التي تتيحها لغة الأقوياء[48].
و. قدرة سعيد على خلق لحظات جديدة لم تكن من قبله[49].
ز. قدرة سعيد التوفيقية، وهو ما يميزه مثلا عن الباحثة المغربية فاطمة المرنيسي. فبينما سعى سعيد مستثمرا موهبته وأسلوبه لردم الحواجز التي تفصل الشرق المزعوم عن الغرب المزعوم، كانت المرنيسي تصر على نصب الحواجز عالية معضدة لها بخيالها الجامح [50].
2. قراءة في مسار
حاول "طوماس بريسون" تحليل سياقات ولادة كتاب سعيد حيث اقترح قراءة نشأته في ضوء تقاطع ثلاثة أحداث مستقلة عن بعضها نسبيا، لكنها ائتلفت فيما بينها لتشكل سنة 1970 مظهرا حاسما:
أ. مسار شخصي لسعيد مطبوع بطابع "ارتحالي"؛ إذ اضطر سعيد أن يتنقل من موطنه في فلسطين ليعبر إلى الولايات المتحدة. وهو التنقل الذي أورثه شعورا بالنفي والهجرة الثقافية وإحساسا داخليا بأنه لم يكن قط في موضعه[51].
وهذا البعد الترحلي الذي وشم مسيرة سعيد اعتبره بريسون المفتاح الطبيعي جدا لاستجاشة طاقة الدأب والاستمرار في الكتابة ضد الجميع، واستصحاب الشعور بالهيمنة قصد تعزيز الممانعة[52].
ب. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتداعياته على السياسة الأمريكية التي جرَّت سلسلة من التطورات في البنيات الجامعية الأمريكية.
ج. تطورات شملت جملة من القضايا السياسية قلبت أنماط الخطاب الشرعي حول العالم العربي[53].
إن الباراديم الذي نحته بريسون لقراءة سياقات تشَكل كتاب سعيد يصور لوحة قلقة مضطربة يرتسم فيها سعيد ثائرا مستشيطا نقمة على الظروف الموضوعية التي زجت به بعيدا عن موطنه وعرضت وطنه للتشريد والاغتراب. والظلال التي ترخيها هذه اللوحة قد لا تكون بريئة؛ إذ تستضمر أن الكتاب الذي تشكلت أمشاجه في هذه السياقات الاضطهادية لن يسلم من الحدة والشراسة في الهجوم، والتجافي عن القصد والإنصاف.
3. الهجوم على سعيد
لا نستطيع فهم أسباب الهجوم على سعيد ما لم نقف على حقيقة موقفه من الاستشراق كما صرح به في كتابه الاستشراق، وبين أيدينا نص نفيس يلقي الضوء على هذه الحقيقة:
يقول سعيد: "وأنا أعتقد شخصيا أن القيمة الكبرى للاستشراق تكمن في كونه دليلا على السيطرة الأوروبية الأمريكية على الشرق أكثر من كونه "خطابا" صادقا حول الشرق، [وهو ما يزعمه الاستشراق في صورته الأكاديمية أو البحثية]، ومع ذلك فعلينا أن نحترم ونحاول أن ندرك ما يتسم به "خطاب" الاستشراق من قوة متماسكة متلاحمة الوشائج، والروابط الوثيقة إلى أبعد حد بينه وبين المؤسسات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي تمنحه القوة، وقدرته الفائقة على الاستمرار[54]."
يضاف هذا إلى تصريحه في تذييل طبعة 1995م بأنه "على الرغم من محاولات رصد الفروق الدقيقة بين الاستشراق باعتباره جهدا علميا بريئا، وبين الاستشراق باعتباره متواطئا مع الامبريالية، فمن المحال فصل هذه المصالح من طرف واحد عن السياق الامبريالي العام الذي بدأ مرحلته الحديثة بغزو نابليون لمصر في 1798م[55]."
وهذان النصان كافيان لاستيعاب باراديم سعيد الذي جر عليه عاصفة نقدية لم يخبُ أوارها إلى الآن.
وبالعودة إلى الكتاب موضوع الدراسة سنلاحظ عبر فصوله تواتر سهام لاذعة سُددت لأطروحة سعيد وصلت إلى مدرج المفاصلة الجذرية. فهذا بوييون أحد المشرفين على الكتاب يصرح بمناقضته المبدئية لسعيد وأنه لا يمكنه أن يسير على خطاه، مع إقراره بأنه ليس من الميسور اليوم استرجاع علم استشراقي خالص. ذلك أنه قد بُرهن على التباس العلم بالسياسة، على نسبيته، بما فيه الكفاية للتخلي عن هذا المتغير. لكن الالتباس لا يرادف التجييش والتطويع. والأنسب حسب بريسون هو معْلَمة تطويق السياسة للعلم دون السقوط في القول بالحتمية. وبذلك يبقى مكان للاستثناء والاختلاف اللَّذين يعيدان للفكري جدارته واستحقاقه[56].
الاستشراق عند سعيد لا يخرج عن كونه إيديولوجية؛ أي عالماً من الأفكار المتناسقة والمشتبكة مع بنية سياسية، هي بنية الإمبريالية. وبوييون يدعو إلى إجراء عمل نقدي واسع حول مفهوم الإيديولوجية الذي ينتسب إلى أفلاطون وماركس، والذي استعاره سعيد حقا من ماركسيٍّ رفيع هو كرامشي Gramsci[57].
كما أبدى بيفارBeillevaire تململه من الآثار السيئة التي نسبها سعيد دون تمييز إلى الاستشراق، وذلك في كتابه الذي غدا مؤلفا جماعيا[58].
وفي هذا إقرار ضمني بهذه المثالب الاستشراقية لولا أنه يلقي باللائمة على سعيد لجنوحه إلى التعميم.
ومن النقد الموجه إلى سعيد نقف على هذا النص المطول لروبرت إيروين يوضح فيه مؤاخذاته وملاحظاته:
"إذا كان قد ثبت منذ زمن بعيد أن كتاب سعيد "الاستشراق" المنشور سنة 1978م قد انطوى على أخطاء حقيقية وأخطاء تأويلية؛ فإنه غالبا ما يذكر على وجه الدفاع عنه إسهامه في فتح حقول جديدة من البحث وتنشيطِ النقاش في هذا الميدان. من جهتي أعتقد أن هذا الكتاب وكُتُب الذين حذوا حذوه قد أوصدوا بالعكس آفاق البحث. وأن النقاش المحموم الذي حثَّه لم يبرح حدوداً ضيقة جدا.
إن علينا إعادة كتابة تاريخ الاستشراق الأكاديمي والفني، ولكي نكون دقيقين فإنه ينبغي لنا تجاوز الحدود الكرونولوجية والطوبوغرافية التعسفية تماما التي أقامها سعيد وأنصاره. إنه من الغرابة تماما أن سعيدا، مثلا، اختار ألا يعير بالا للوجود الفرنسي بإفريقيا الشمالية ولا للتواطؤ الملحوظ بين الإداريين الاستعماريين والجامعيين والفنانين. وهو ما يحط من شأن الرواية الكبرى التي اقترحها سعيد حول الاستشراق الفرنسي الذي انحصر سعيد أثناء تحليله في بعض أعمال الكتاب الرومانسيين[59]."
وهو نص يشي بالتبرم الشديد الذي أثاره سعيد ومن سار على شاكلته بين ظهراني المستشرقين.
بلغ هذا التبرم عند البعض أن سعوا إلى تجريد سعيد من هويته الفلسطينية، والدفع بعدم التخصص[60]؛ لأنه كان أستاذ أدب مقارن ولم يكن أستاذ علوم اجتماعية مطبقة على العالم العربي[61].
أما التهمة الأولى فما ينبغي لأحد أن يزايد على هوية من نذر نفسه للدفاع عن القضية الفلسطينية. اكتوى بها شخصيا وكرس لها حياته عالما علم اليقين أنها قضية لا يجد من يمدها بالدعم مثلما تجد قضايا النضال في أنحاء أخرى في العالم[62].
وأما التهمة الثانية، فيكفي أن نشير إلى أن أستاذ علم الاجتماع في جامعة إيسيكس "جون سكوت" John Scott عدَّ إدوارد سعيد ضمن لائحة العلماء الذين تضمنهم كتابه: "خمسون عالما اجتماعيا أساسيا: المنظرون الأساسيون[63]".
في هذا الكتاب يؤكد سكوت أنه مع كل العاصفة النقدية التي هبت في وجه سعيد فإن كتاب سعيد ما يزال الأقوى أثرا في تفسير الصراع بين الغرب والشرق. وللنقل هنا نصه بطوله في نهاية ترجمته لسعيد: "في عالم طغت عليه أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001م أو "الحرب العالمية على الإرهاب"، حيث قامت قوى غربية كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة بغزو أفغانستان والعراق لضمان إحداث تغيير في النظام، وهو العالم الذي لم يبدِ أي دلائل لحل الصراع بين اليهود والفلسطينيين. في ظل هذا العالم؛ فإنه من المسلم به أنه لا يوجد كتاب في النظرية الاجتماعية المعاصرة أهم من كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. وبالرغم من الجدل بشأن مقولاته ومضامينه السياسية؛ فإن هذا الكتاب رسخ الوجود العلمي لمؤلفه باعتباره أحد المفكرين الرئيسين في الفترة الحديثة[64]."
وهي شهادة بليغة من أهلها.
العنصر الرابع: مستويات التأثير والتلقي
من جملة الغايات التي استأثرت باهتمام مؤلفي الكتاب دراسة أثر االاستشراق في البلاد الشرقية، بحثا عن مفاتيح القابليات ومكامن الممانعات والرفض، وسعيا نحو تذليل مهام الاستشراق، والوقوف على مداخل تيسير ولوجه ونفوذه إلى العوالم المستهدفة.
في هذا السياق نقف على ثلاث محطات مهمة:
أولا: الاستشراق اليهودي في الديار المسلمة
تناول الباحث محمد حاتمي في مقاله: "الخطاب الديني الإسلامي" و"الاستشراق اليهودي" حادثة مهمة غنية بالتفاصيل المثيرة. تلقي هذه الحادثة الضوء على أسباب التصدي للاستشراق اليهودي، واتساع جبهة المقاومة ضد اختراقاته الفكرية.
افتتح حاتمي مقاله بالإشارة إلى الضجة التي اندلعت على إثر نشر كتاب "محمد" Mahomet للماركسي اليهودي ماكسيم رودنسون. وقد نشرت الصحيفة الأسبوعية الأهرام بتاريخ 21-27 ماي 1998م مقالا مفصلا عن النقاشات التي هزت جانبا من الرأي المصري طيلة الفصل الثاني من سنة 1998م، والتي أفضت في النهاية إلى حظر الكتاب، وسحبه من مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC، ومنع بيعه في مصر. كان هذا المخرج "السعيد"، على حد تعبير صاحب المقال في الأهرام، بفضل صرامة السلطات السياسية، وأريحية المسؤولين التربويين وطلبة الجامعة المذكورة آنفا[65].
بدأت الخيوط الأولى لهذه القضية عندما قرر الأستاذ المتعاقد ديدييه مونسيودDidier Monciaud كتاب رودنسون على طلبته في شعبة العلوم السياسية. كان الأستاذ ديدييه مشهودا له بالكفاءة، ولم يكن كتاب رودنسون هو مقرره الوحيد عليهم، وقد نبههم إلى أن صاحبه مستشرق، وأن الكتاب ثرٌّ منهجا ومضمونا، وأنه لم يخل من هجوم لاذع قد يصدمهم، وأن إليهم المنتهى في تنمية عقلهم النقدي على ضوء القراءات المتعددة للكتاب[66].
ظل الكتاب يُدَرس طيلة سنوات دون أن يثير أي اعتراض إلى أن جاءت سنة 1998م حين تقدم عدد من الطلبة بعريضة تحمل ستة وأربعين توقيعا لدى رئيس الجامعة مطالبة بحظر الكتاب. كان من بين ما شجبته هذه العريضة ما جاء في الكتاب من إخلال بالاحترام الواجب لشخص الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولدعوته. وعمد الطلاب إلى إرسال نسخة من العريضة إلى جريدة الأهرام، تلقفها الصحفي صلاح منتصر بقوة محررا في نشرة 1-3، 1998م مقالا غاضبا أسماه "كتاب للحظر" استعرض فيه المآخذ الستة على الكتاب، وحرض على منعه بسبب تطاوله وتجديفه في حق الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفي حق الإسلام. وذهب إلى أنه لا ينبغي التعلل بشعارات حرية التعليم والتعلم لتلقين طلبة المسلمين ما يطعن في دينهم وكتابهم المجيد، ولا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الأمر[67].
خلف المقال قلقا وإرباكا سريعا في الأوساط السياسية التي رأت أنه لا يمكن حمل هذا الإنذار على محمل التساهل، لاسيما والذاكرة لا تزال غضة بذكريات 1988م عن "الآيات الشيطانية". وتفويتا للفرصة على الإخوان المسلمين فتتحول بين أيديهم إلى وسيلة للضغط على الحكومة؛ فإن وزير التعليم مفيد شهاب استبق الأحداث وتقدم لدى الجامعة المذكورة بطلب إلغاء تدريس الكتاب. وسرعان ما استكان رئيس الجامعة لطلب الوزير معتذرا عن خطأ شخصي غير مقصود سببه سوء تقدير أحد المدرسين. وما كان منه إلا شكر الأستاذ والاستغناء عن خدماته [68].
في ظل هذه الأحداث قام مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر الشريف محمد سيد طنطاوي بنشر مقال في مجلة "عقيدتي" يحمل فيه على كتاب رودنسون ويدحض شبهاته وتجديفاته واحدة واحدة. ودعا إلى ضرورة إصدار قانون يقضي بإخضاع الكتب للمراقبة، لاسيما ما تعلق منها بالإسلام، وردع ما انطوى منها على شتيمة أو طعن في حق الإسلام ورموزه. لم يكن هذا التعرض هو الأول من مؤسسة الأزهر، فهي لا تفتأ ترفع عقيرتها بحجب الإصدارات التي تشم منها رائحة التهجم على الإسلام أو الأخلاق. وغالبا ما تنتهي بكسب القضية[69].
قامت من بعده دار الإفتاء بإطلاق نداء تحذر فيه من عواقب هذه التجديفات وما يمكن أن تستتبعه من شقاق بين المسلمين ومؤمني الديانات الأخرى، واضطراب في المجتمع، وحملت جميع الأطراف مسؤولية ما يقع[70].
لم تنته المعركة هنا، فقد انطلقت عاصفة من التعليقات والردود عليها. انبرى بعض المثقفين للدفاع عن رودنسون وكتابه، غير أن عددهم الضئيل وأصواتهم الفزِعة لم تلبث أن غمرتها موجة عارمة من الأصوات الناقمة على رودنسون وكتابه، غير مفرقة بين استشراق ولا استعمار ولا مادية ولا امبريالية ولا شعب يهودي ولا صهيونية[71].
من بين هذه الأصوات الغاضبة قام الأستاذ محمد أبو ليلة بجامعة الأزهر بنشر كتاب[72] في الموضوع في 166 صفحة ينقض فيه كتاب رودنسون منتهيا إلى خلاصة مفادها أنه لا يمكن بأي حال عد كتاب رودنسون كتابا في التاريخ، وكيف يسوغ ذلك وهو لم يستند إلى أي التراث التاريخي للمسلمين؟ ولا يجوز عده كتابا في علم النفس وهو لم يرعَ قواعد التحليل النفسي المعاصر، لاسيما وهو يتناول شخصية فذة هي شخصية الرسول العظيم، صلى الله عليه وسلم، إن الكتاب ليس إلا حطْباً بائسا لآراء ناشزة، وتركيبات مادية خاطئة، القصد منها رسم صورة شائنة عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، والطعن في الإسلام[73].
كان من بين أبرز التهم الموجهة للمؤلف استخفافه بمصادر السيرة القديمة، وتصميمه المعلن منذ البدء على مراجعة عدة مسلمات من مثل درجة إلمام النبي، صلى الله عليه وسلم، بالموروث المسيحي واليهودي، وتماسك القبائل العربية التي أسندته، وأشد من هذا زعمه أن الإسلام ليس إلا إيديولوجية تجاوزت إطارها الأصلي لتأخذ حجما أكبر مما ترجاه مؤسسوه الأوائل[74].
ذهب الباحث حاتمي إلى أن معظم الردود على رودنسون كانت تلح من أجل فهم أمثل لكتاب رودنسون ولغاياته على نقطتين أساسيتين: الطابع الاستشراقي للكتاب والانتماء اليهودي لمؤلفه[75].
لكن الباحث غلا عندما زعم أن الاستشراق لم يحظ قط بسمعة حسنة بين ظهراني النخب المسلمة العالمة. فالاستشراق عندهم رديف الاستعمار والشيوعية وكل تيارات الفكر المصنوعة في الغرب. ولم يزل الاستشراق مثار نقمة وغرضا للرد والاعتراض[76].
وفي رأينا أن هذا بعد عن الحقيقة وتعميم لا مستند له، فلم يزل من بين العلماء المسلمين من يشتط في امتداح الاستشراق، ومنهم من ينصفه فيذكر محاسنه كما يذكر مثالبه. يكفي أن نذكر منهم صلاح الدين المنجد 1928-2010م وبنت الشاطئ عائشة عبد الرحمان 1912-1998م ومحمود حمدي زقزوق في تقديمه لكتاب الاستشراق الألماني: تاريخه ووقائعه وتوجهاته المستقبلية،لأحمد محمود هريدي، وأيضا جواد علي ومصطفى السباعي وسامي الصقار ورضوان السيد ومحمد خليفة حسن وعبد المحسن عبد الراضي ومحسن محمد حسين[77].
يقول محمد عوني عبد الرؤوف: "والحق أن المستشرقين ليسوا جميعا منصفين، وليسوا جميعا متعصبين ضد العروبة والإسلام. وهناك؛ [أي من العلماء] من يقف منهم موقفا وسطا، فيقوم بدراسة كل ما يقدمه المستشرقون من دراسات وآراء وأعمال، فينصف من يستحق الإنصاف، ويضعه في المكان الذي يستحقه، وينقد من يستحق أن تستنكر آراؤه ويعلق عليها[78]."
وقد شهد الاستشراق اليهودي فترة تألقه، وتعمق في النقد الدقيق للنصوص الأساسية في اللحظة التي كانت فيها القوى الأوروبية، خاصة فرنسا وبريطانيا العظمى تُحكِم القبضة على شؤون الشرق الأوسط، وتعكف على السرقة المنهجية لكنوز الثقافة الإسلامية[79].
يرجع هذا التفوق إلى ما عُرف به المستشرقون اليهود من براعة في تعلم اللغات القديمة، وتداول للمخطوط. ولم يكن هذا الأمر مفاجئاً، فإن هذه البراعة كانت هي السبيل الذي استمسكوا به لتطوير الاستشراق اليهودي تطويرا مباشرا. وقد أفاد المشروع الصهيوني، حسب المؤلف، من أبحاث الحفريات ومقارنة الأديان واللسانيات[80].
أما منهجية ردود المسلمين على الاستشراق اليهودي، فقد اختزلها حاتمي في صورة بائسة؛ إذ هي عنده لا تخرج عن الطرق التقليدية في العرض والتحليل والبلاغة والنقد والتركيب. ونيتها المعلنة دوما هي اجتذاب القارئ من خلال حشر عدد هائل من الآيات والأحاديث والنقول. وحمل المؤلف على هذه الردود واصفا إياها بالمعيارية شكلا ومضمونا. فهي تنظر إلى الاستشراق اليهودي كلا مندمجا تكمل فيه الحلقات الجديدة ما قصرت عنه سابقاتها. والقصد عندها جميعا تفجير الإسلام من الداخل عبر نزع القداسة عن نصوصه الأساسية[81].
والحق أن هذا الوصف على وجاهة بعض نواحيه قاصر دون استيعاب متغيرات الخطاب العربي الإسلامي، وتحولاته المنهجية العميقة التي صارت تسترفد أحدث المنهجيات وتقارع الدليل بالدليل. وكان ينبغي الاستدلال بنماذج معبرة تمثل مختلف أجيال الخطاب الإسلامي، بدل الانخراط في تقريرات عامة ينقصها الاستقراء والتدليل.
ثانيا: اليابان وسر الممانعة
مثلت اليابان حالة قمينة بالدراسة لاستعصائها وتمنعها على الدرس الاستشراقي، ومن ثم كان تفكيك عوامل الممانعة ثم كشف أسرار الانفتاح بعد الانسداد مقصدا مهما من مقاصد الكتاب تجلى في مقالة كاملة بعنوان: كيف أفلت اليابان من الاستشراق؟
أكد "باتريك بيفار" أن اليابان استطاع أن يفلت من الاستشراق من خلال استعصائه على القبضة الغربية[82]. وتوقف عند ثلاث مراحل في التاريخ الياباني.
المرحلة الأولى: مرحلة الانغلاق
وهي مرحلة مثيرة للاستغراب تبدأ سنة 1630م عندما أوصدت اليابان، الأبواب أمام العالم إذا استثنينا صلات سرية مع كوريا والصين[83].
ومهما تباينت المواقف بخصوص هذا الخيار الاستراتيجي للأمة اليابانية فإن من المؤكد أنه السبب الثاوي وراء تأخر الاستشراق الياباني إلى منتصف القرن التاسع عشر.
ولم تنسرب أخبار اليابان إلا عبر بعض الهولنديين الذين كانوا بدورهم ينقلون عن مصادر رسمية[84].
المرحلة الثانية: مرحلة الانفتاح
استمر انغلاق اليابان عن العالم الخارجي أزيد من مائتي سنة، فلم تخرج من عزلتها العتيدة إلا سنة 1850م، مقتنعة باستراتيجية مغايرة تقوم على إعداد القوة لتحصين الذات ضد الأطماع الأجنبية[85].
لقد أدركت اليابان أن سر قوتها ليس في انغلاقها وصرم حبال الصلات مع العالم من حولها، ولكن في اكتشاف مكامن قوتها وتعزيز قدراتها الذاتية استعصاما من الامبريالية الغربية.
ولم تخل البدايات على قِصرها من مشاعر توجس ورفض أثناء التصادم الثقافي مع الغرب، أفضت إلى مراجعة نقدية للثقافة والعادات اليابانية. كما وضعت إجراءات لمنع الشعور بعقدة النقص تجاه الأجنبي. على أن هذه المرحلة كانت سببا في اختمار تبلورات جديدة لخصوصية الشعب الياباني[86].
المرحلة الثالثة: مرحلة النهضة
وهي المرحلة التي تمتد من سنة 1868م إلى سنة 1911م، حيث عرفت اليابان نهضة شاملة وفريدة[87].
لقد شكل الانقلاب الهائل في صيرورة التقدم الياباني لحظة فاصلة ومدهشة. وكان حجر أساسها متمثلا في ركنين أساسيين: قيم بانية وإقلاع اقتصادي[88].
حافظ اليابانيون على خصوصية رؤيتهم وانسجامهم وتنافسيتهم. وفي ذلك تقرير لمعنى بديع، وهو أنه عندما يجد المواطنون جميعهم نقطة توازن وارتكاز في خضم التدافع التاريخي فإن هويتهم الوطنية تزداد قوة وتجذرا[89].
وأضحت اليابان بفضل انصهار هذين المرتكزين قوة جديدة في الساحة الدولية، وكان مسار ترقيها الاقتصادي يتلخص في ثلاث طرائق:
- استضافة الخبراء والأساتذة الأجانب، ومنحهم راتبا ماديا مغريا مقابل نقل خبراتهم بجدٍّ إلى تلاميذ ينعمون بالحافزية والمثابرة.
- ابتعاث طلبة نجباء بناء على معدلاتهم العالية إلى البلدان الغربية الكبرى قصد التكوين في كل التخصصات.
- ترجمة العديد من الأعمال الغربية.
وهكذا قامت مؤسسات من إنشاء الحكومة أو بمبادرات خاصة ما لبثت أن تحولت إلى جامعات تضاهي الجامعات الألمانية والبريطانية والأمريكية. وكانت طليعة الطلبة المتخرجين قادرة على نقل الخبرة بكفاءة عالية[90].
أما جانب القيم والأخلاق فكان يستمد جذوره من المبادئ الكونفوشية وقواعد الشينتو. وهي القيم التي منحت للحضارة اليابانية تميزها و تفردها[91].
إذا كان انغلاق اليابان في لحظة تاريخية حاجزا دون تسرب الاستشراق الأوروبي إلى حياضه؛ فإن سر مقاومته وممانعته بعد انفتاحه يكمن في صعوده وقوته.
تفتح هذه الدراسة التاريخية آفاقا لاستشراف الموقف العربي من الاستشراق. فأما الانغلاق فما إليه من سبيل، ولكن الطريق الأمثل لردء الآثار الضارة للاستشراق الغربي لا يخرج عن تحصين الذات بأسباب القوة متمثلة في تشييد تعليم راق مندمج مع منظومة قيم أصيلة، تنضوي تحتها الأحاسيس الوطنية، وتلتحم الجهود لصوغ نموذج حضاري فريد.
لم يملك بيفار نفسه عن الإعجاب بشغف اليابانيين بتشييد نهضتهم، ولئن دشنت بداياتهم عبر آليات التقمص والتقليد؛ فإنها لم تكن عنده إلا مرحلة عابرة ضرورية نحو بناء نهضة أصيلة، كان للحضارة والقيم اليابانية دور كبير في صقلها ونحت خصوصيتها[92].
العنصر الخامس: حول آفاق الاستشراق
إن الأزمة التي عصفت بالاستشراق الكلاسيكي لم تكن، كما أسلفنا، إلا مخاضا عسيرا من المراجعات لأسباب انتكاسة الاستشراق، وإن عبارات "الموت" و"النهاية" لم تكن تعني قبْر الاستشراق، بل ولادة مرحلة جديدة على ضوء النقد الموجه. مرحلة جديدة تبلورت من خلال التفاعل مع التحولات الحديثة التي مست العلوم الإنسانية ومناهج البحث والتأويل.
لقد أفاق الاستشراق الكلاسيكي على وقع عاصفة قوية من المنهجيات الوليدة في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية تُفاصل ما كان ديدنه خلال أحقاب متطاولة من البحث والتنقيب والدرس والتركيب. وألفى الاستشراق نفسه لا يعدو في الغالب امتدادا بسيطا للخطابات الدينية التي كانت تنافح عن العقائد النصرانية. وبين هذا الاكتشاف ومطارق المنهجيات الجديدة كان لابد له أن يتحول إلى المقاربات العلمية الحديثة أخذا بالتخصصات والقواعد التي تستضمرها طوائف الباحثين في العلوم الاجتماعية[93].
أدرك الاستشراق، إذن، أن عليه أن ينأى عن اهتماماته القديمة لكي ينخرط في ممارسات علمية منتشرة عبر العالم[94].
لعل أثر هذه المنهجيات وما أحدثته من رجة في بنية الاستشراق كان أبعد مدى من النقد الذي صبه سعيد وغيره على الاستشراق وذويه. بل يذهب رضوان السيد إلى أن "المشكلة مع الاستشراق ما عادت آتية بالدرجة الأولى من جانب إدوارد سعيد ونقاد الأدبيات الكولونيالية، بل من ثورة العلوم الاجتماعية، والمنهجيات الجديدة وتفكيكيات ما بعد الحداثة التي مات رائدها جاك دريدا ...، وأعمال المراجعين الجدد من الأوروبيين والأمريكيين والذين يحملون أول ما يحملون على "التاريخانية الاستشراقية" الألمانية، بسبب الثبات الباقي فيها، والكلاسيكية العريقة الصامدة بصعوبة ...، وفي مواجهة تحديات تخريبات ما بعد الحداثة، كما سبق القول، أكثر مما هو بسبب سوء ظن العرب والمسلمين، ومنذ ما قبل إدوارد سعيد "بالاستشراق والتبشير ودعاتهما" كما قال عمر فروخ ومحمد البهي في الخمسينات من القرن الماضي [95]."
لكن هذا التحول لا يعني القطيعة، فلا يسوغ بأي حال إنكار النسب الموصول بين استشراق الأزمنة المنصرمة واستشراق العلوم الإنسانية الحديثة[96]. فلا يبعد أن نجد بين المستشرقين الجدد أخلاقيات تذكر بالعهد البائد للاستشراق. ومن جهة أخرى فقد بات واضحا أن الأعمال المخصصة لأحداث الإسلام تقاد غالبا وسط فروع أو أقسام متخصصة على صعيد الجهاز المؤسسي، و في أحايين كثيرة نجدها بمعزل عن المناهج العلمية والنقاشات النظرية المهيمنة في المقتربات المطبقة على المجتمعات الغربية وموروثها[97].
إن المهمة المعروضة اليوم أمام ورثة الاستشراق الكلاسيكي تبدو اليوم متعددة الأبعاد:
أولا: ضرورة تحديد إستراتيجية التعامل مع التراث الاستشراقي الضخم
فهل يطرح الاستشراق بالمرة أم ما يزال فيه ما لا يمكن الاستغناء عنه؟ وقد عبر بوييون عن هذا الهاجس المقلق، وهو يستعرض ضروب الإنتاج الفني والأدبي والفكري الذي أورثه الاستشراق. يقر بوييون أنه لا يمكن استرجاع الاستشراق بالصورة التي تمثل عبرها تاريخيا؛ أي لا يمكن استعادة بواعثه الكولونيالية ولا أوهامه[98].
لكنه عاد ليتساءل عن مصير ما سوى ذلك، عن شهادات الماضي التي لم يدون السكان المحليون عنها أي صورة، وعن السلسلات المرتبة بدقة بالغة، وعن مستخرجات الحفريات والمتاحف المتخصصة، والأرشيفات والتركيبات العلمية التي أنتجتها. إنها مما ينبغي استعادته حسب بوييون. وإذا كان سكان المستعمرات يشمئزون من كلمة "استعادة" فإن بوييون لا يعني به ما تنصرف إليه أذهانهم، بل المقصود طريقة من الطرق لاستخراج شيء جديد من بين أنقاض المعالم الأثرية والنفايات. هذا البحث في مسارب التاريخ هو ما يشكل تراثا[99].
ثانيا: ضخامة الانتظارات الملقاة على عاتق الاستشراق الجديد
فمن جهة يرى بوييون أنه يجب استئناف مرحلة جديدة من استقلالية البحث الاستشراقي عن الارتهان لأي سلطة سياسية. إن الدور المنوط بالعلوم الاجتماعية حسب بوييون ليس الدفاع عن أي قضية مهما كانت عادلة، ولا إسداء المسوغات العلمية للآراء القبلية[100].
ومن جهة أخرى يدعو كلود فاتان إلى ضرورة مراجعة الاستشراق لفرضياته، واستنقاذه من تشرذمه، وإعادة لملمة صفوفه، وصهر اتجاهاته ودمجها[101].
كما يدعو فاتان إلى ملائمة مناهجه وتحيينها قائلا: "نحن في أمس الحاجة إلى أدوات مفاهيمية جديدة، ومناهج تحليلية أكثر ملاءمة، وإلى نحوٍ جديد، ولم لا إلى باراديم جديد[102]."
إنها، إذن، صرخة ونداء من أجل التصويب والمراجعة العميقة للرؤى والباراديمات والتحيزات والمنهجيات حتى يبرأ الاستشراق من أعطابه، ويترقى إلى أفق معانقة قضايا البحث العلمي الخالصة، وتعود له عافيته الموؤودة.
ثالثا: رد الاعتبار للشرقيين
فلا يجوز أن يستهتر الاستشراق بإسهامات الشرقيين، ولا برؤاهم وتصوراتهم التي ينسجونها عن شرقهم. وقد تردد هذا المطلب عبر فصول الكتاب. يقول فاتان: "لابد لنا من الرجوع إلى الصانعين المحليين للمعرفة القديمة بالمجالات الشرقية[103]". كما يؤكد بوييون أنه لا محيد عن إنصاف الشرقيين، "فهم أحق بشرقهم[104]."
لكن الباحث زكريا الرهاني يستدرك على هذا المطلب بحثا عن مشروعية قراءة الشرق خارج فضاء الشرقيين، بل يذهب إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى إعادة تفكيك رؤى الشرقيين عن شرقهم، متهما إياهم بالتوسل بالخطابات العاطفية أثناء نقدهم للمنتوج الاستشراقي[105].
كما دعا بوييون إلى ضرورة إنجاز مصالحة تاريخية بين الشرق والغرب، والخروج من الصدام سعيا نحو مقاربة الظواهر بلغة السيرورة والتعالق بين المركز والهامش، بين الكوني والمحلي وبين الجواهر والبناءات التاريخية. وذلك عبر جسر الشروخ والقطائع، وإعادة التأمل في شروط حوار اجتماعي على المستوى الكوني[106].
إن على المستشرقين أن يسهموا في إثراء متبادل يخول للحضارات أن تفيد من بعضها البعض سعيا وراء تكاملية حضارية و معرفة علمية متبادلة[107]، تبنى على أساساتها حضارة إنسانية قوامها الحرار لا التشنج، والتعاون لا الخصومة.
خاتمة
لا يزعم الباحث وهو يدلف إلى خاتمة هذا العرض الموجز أنه قد أحاط بكل مباحث الكتاب، ولكنه يرجو أن يكون قد وقف على أهم لحظاته ومفاصله. تلك التي صورت لحظة قلق، واختناق مأزوم، وسعي محموم نحو استرجاع البوصلة، واستعادة سلامة الرؤية والمنهج، والتبرؤ من المآزق التي وشمت صيرورة البحث الاستشراقي.
ودون متاخمة الآفاق التي استشرفها الباحثون، تتبدى ضخامة الجهد الذي على الاستشراق الجديد الاضطلاع به، سعيا نحو حوار حقيقي بين الضفتين. حوار تكون سمته الإنصاف ورد الفضل لأهله وعدم غمط الشرقيين في حقهم التاريخي في صنع هويتهم وصورهم.
الهوامش
[1]. Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient.
.[2] إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة: محمد عناني، القاهرة: نشر رؤية، ط1، 2006م، ص501. وهي الترجمة العربية الكاملة لكتاب: Edward Said: Western Conceptions of the Orient,1995. الصادرة عن دار بنجوين العالمية عام 1995م.
[3]. المرجع نفسه، ص501.
[4]. المرجع نفسه، ص503.
[5]. بنسالم حميش، العرب والإسلام في مرايا الاستشراق، دار الشروق، ط1، 2011م، ص17.
[6]. جي. جي. كلارك: التنوير الآتي من الشرق، اللقاء بين الفكر الأسيوي والفكر الغربي، سلسلة عالم المعرفة، عدد 346، دسمبر 2007، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص45-46.
[7]. رفيق عبد السلام، مآزق الحداثة والخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة، في مجلة إسلامية عالم المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة الثانية، العدد السادس، ص122.
[8]. جي. جي. كلارك، التنوير الآتي من الشرق، م، س، ص43.
[9]. المرجع نفسه، ص43.
[10]. المرجع نفسه، ص44.
[11]. المرجع نفسه، ص44-45.
[12]. محمد الجواي، كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد وأثره في العالم العربي والغربي، في ترجمة الاستشراق إلى العربية، الدار البيضاء: مؤسسة الملك عبد العزيز، سلسلة حوار الضفتين، 2012، ص30.
[13]. L’orientalisme et après? Médiations, appropriations, contestations.
[14]. François Pouillon عالم أنثروبولوجيا ومدير الدراسات بمدرسة HESS.
[15]. Jean-Claude Vatin عالم سياسة و مدير شرفي للدراسات بالمركز الوطني للبحث العلمي.
[16]. Dictionnaire des orientalistes de langue française.
[17]. أنظر غلاف الكتاب.
[18]. علي إبراهيم النملة، الاستشراق بين منحيين: النقد الجذري أو الإدانة، الرياض: كتاب المجلة العربية، 1434ﻫ، العدد 201، ص20.
[19].François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.13.
[20]. op.cit.,p.13.
[21]. François Zabbal, L’islamologie des universitaires musulmans en France, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.188.
[22]. Ibid, p.179-180.
[23]. Ibid, p.185-186.
[24]. Thomas Brisson, Pourquoi Said? in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient, op.cit, p.155
[25]. Jean Claude vatin, Prologue, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.7
[26]. Ibid.cit. p.7
[27]. Ibid.cit. p.7
[28]. Ibid.cit. p.9
[29]. François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.31.
[30]. Thomas Brisson, Pourquoi Said? in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient, op.cit., p.155
[31]. François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.14.
[32]. المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب هو المستشرق دينيه إيتيان Etienne Dinet الذي كان مستشرقا رساما مستقرا في صحراء الجزائر، وقد توج اهتداءه إلى الإسلام بإخراج كتاب نقدي يدحض به الاتهامات الصادرة في تلك الآونة عن أهم المرجعيات الاستشراقية المسؤولة عن مطبوعات حول النبي ﷺ وبدايات الإسلام: بول كازانوفا 1861-1926م الذي كان حينئذ مدرسا بمؤسسة Collège de France والأب اليسوعي هنري لامنس 1862-1937 أحد أقطاب جامعة القديس يوسف في بيروت. أنظر:
François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit.,p.14.
[33]. Ibid, p.14.
[34]. الاستشراق بين دعاته ومعارضيه: محمد أركون، مكسيم رودنسون، آلان روسيون، بيرنارد لويس، فرانسيسكو غابرييلي، كلود كاهين، ترجمة وإعداد هاشم صالح، دار الساقي،ط1، 1994.ص:31،35.
[35]. الدكتور سيد ولد أباه، إعلام الفكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط2، 2013، ص27.
[36]. Ibid, p.14.
[37]. Ibid, p.14.
[38]. Ibid, p.15.
[39]. Ibid, p.15.
[40]. Ibid, p.16.
[41]. أنظر: علي إبراهيم النملة: الاستشراق بين منحيين، النقد الجذري أو الإدانة، مرجع سابق،ص: 27-28.
[42].Thomas Brisson, Pourquoi Said ?,in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.135.
[43]. Ibid, p.152.
[44] .Ibid, p.151.
[45]. Ibid, p.151.
[46]. Ibid. p. 138.
[47] .Ibid, p. 138.
[48] .Ibid, p. 138.
[49].Ibid, p. 151.
[50]. Zakaria Rhani ,Ne touche pas à mon orient, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit.,p. 163
[51]. Thomas Brisson, Pourquoi Said? in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient,op.cit, p. 136
[52]. Ibid, p. 137
[53]. Ibid, p. 136
[54]. إدوارد سعيد، الاستشراق، م، س، ص50.
[55]. المرجع نفسه، ص507.
[56]. François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.25.
[57]. Ibid.,p.26.
[58].Patrick Beillevaire, Comment le Japon a échappé à l’Orientalisme de l’Occident, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.212.
[59].Robert Irwin, les vrais discours de l’Orientalisme, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit.,p.40.
[60].Thomas Brisson, Pourquoi Said? in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient, op.cit, p.152
[61]. Ibid, p.137
[62]. إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، حاوره ديفيد بارساميان، ترجمة: علاء الدين أبو زينة، مراجعة محمد شاهين، دار الآداب بيروت بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2007م، ص10.
[63]. جون سكوت، خمسون عالما اجتماعيا أساسيا: المنظرون الأساسيون، ترجمة: محمود محمد حلمي، مراجعة: جبور سمعان، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، 2013م.
[64]. المرجع نفسه، ص205-206.
[65] .Mohamed hatimi, Discours religieux islamique et "Orientalisme juif", in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit, p.325.
[66] . Ibid, p.325.
[67].Ibid, p.326.
[68] .Ibid, p.326.
[69] .Ibid, p.326.
[70]. Ibid, p.326.
[71] .Ibid, p.327.
[72]. الكتاب هو: محمد صلى الله عليه وسلم بين الحقيقة والافتراء في الرد على الكاتب اليهودي الفرنسي الماركسي ماكسيم رودنسون-القاهرة.دار النشر للجامعات.ط1، 1999م.
[73]. Mohamed hatimi, Discours religieux islamique et ‘‘Orientalisme juif’’, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient, op.cit, p.327.
[74]. Ibid, p.328.
[75]. Ibid, p.328.
[76]. Ibid, p.328.
[77]. علي إبراهيم النملة، الاستشراق بين منحيين، م، س، ص31-34.
[78]. المرجع السابق، ص33.
[79] .Ibid, p.329.
[80] .Ibid, p.329.
[81] .Ibid, p.331.
[82].Patrick Beillevaire, Comment le Japon a échappé à l’Orientalisme de l’Occident, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit.,p.195.
[83].Ibid, p.196.
[84] .Ibid, p.202.
[85] .Ibid, p.197.
[86] .Ibid, p.200.
[87] .Patrick Beillevaire, op.cit. p.197-198.
[88] .Ibid, p.201.
[89] .Ibid, p.213.
[90] .Ibid, p.198.
[91] .Ibid, p.199.
[92] .Ibid, p.200.
[93]. Abdou Filali-Ansari, Conscience historique et défi de l’historicisme en contextes musulmans, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit.,p.95.
[94] .Ibid, p.95.
[95]. رضوان السيد: المستشرقون الألمان، النشوء والتأثير والمصائر، دار المدار الإسلامي، ط1، 2007م، ص6.
[96] .Abdou Filali-Ansari, Conscience historique et défi de l’historicisme en contextes musulmans, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient,op.cit, p.95.
[97].Ibid, p.95.
[98].François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient ,op.cit.,p.33.
[99] .Ibid, p.13.
[100] .Ibid, p.34, 22.
[101] .Jean Claude vatin, Prologue, in Apres l’orientalisme: l’Orient crée par l’Orient, op.cit, p.7.
[102] .Ibid, p.11.
[103] .Ibid, p.12.
[104] .François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, op.cit, p. 27.
[105] .Zakaria Rhani, Ne touche pas à mon orient, op.cit, p. 169.
[106].François Pouillon, Mort et résurrection de l’Orientalisme, op.cit, p. 14.
[107] .Orientalism, Past and Présent EDITURA UNIVERSITIIăDINăBUCUREŞTI, 2005, p: 39.