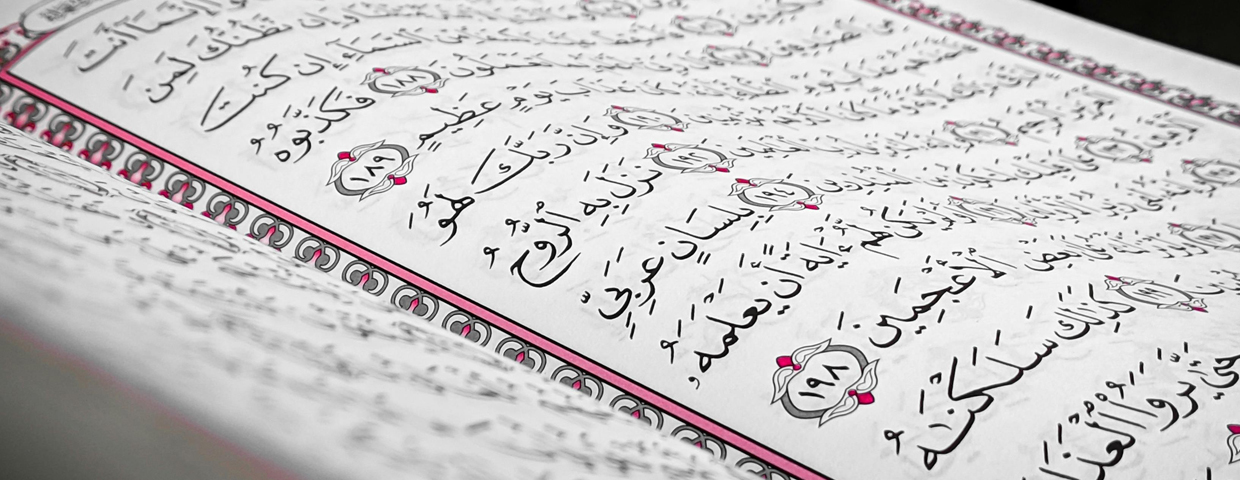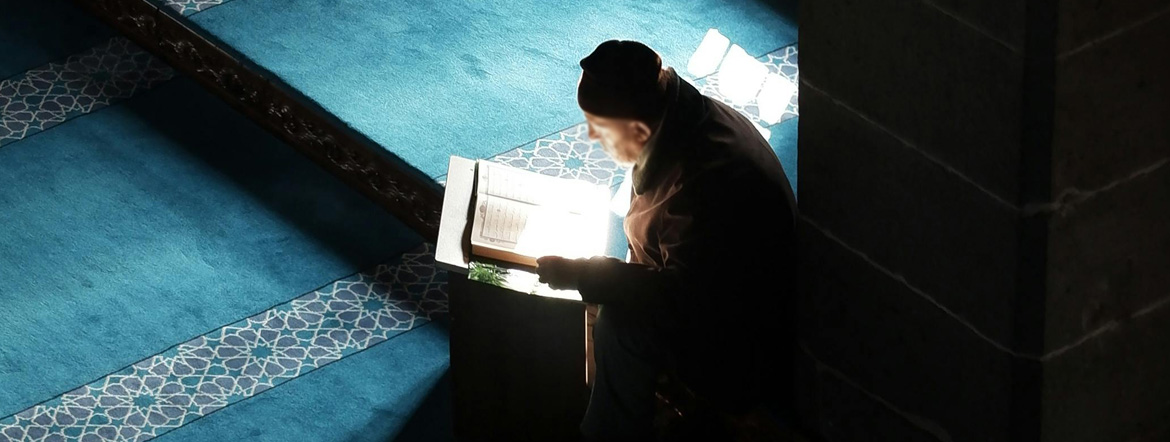من جهود علماء الغرب الإسلامي في توجيه متشابه الكتاب توجيه قوله تعالى: “لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ” [هود:22] وقوله تعالى: “لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ” [النحل:109]

بسم الله الرحمن الرحيم
من جهود علماء الغرب الإسلامي في توجيه متشابه الكتاب
توجيه قوله تعالى: "لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ" [هود:22]
وقوله تعالى: "لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ " [النحل:109]
المطالع للكتاب والناظر فيه نظر متدبر مستكنه للأسرار يلفيه يحذر من الخسارة، ويخوف من مغبتها، وجر أذيال خيبتها، والتحذير منها لا يقصد به الخسارة الدنيوية؛ فتلك خسارة يمكن استعاضها بربح من جهة أخرى يستعيض به المرء ما خسر من دنياه، أو فاته في صفقة عابرة أو تجارة بائرة.. ولكن المراد الخسارة الأخروية؛ تلك الخسارة التي لا يمكن استعاضتها ولا تداركها، في يوم يمتاز فيه الفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد تعددت مساقات هذه التحذيرات، وتباينت مخارجها تبعا للموضوع الذي تتناوله آي التنزيل، ففي سورة الزمر يقول المولى سبحانه: "قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ" [الآية:15] وجاء في سورة الشورى: "َقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ أَلآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ فِي عَذَابٖ مُّقِيمٖ " [الآية:45] فالأولى أمر من المولى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن طبيعة الخسارة الأخروية، وأنها خسارة بيِّن ضيعةُ أصحابها، أعاذنا الله منها ومن أحوال أهلها، وفي الثانية إخبار عن مقول المؤمنين لما يروا مآل المتنكبين شرعه، وكيف حق عليهم القول عدلا منه وحكمة، و تطالع التاليَ آي الذكر مواضعُ أخرى من الكتاب ورد فيها الإخبار عن هذه الخسارة بصيغ التفضيل، كقوله سبحانه "لَا جَرَمَ أَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡأَخۡسَرُونَ" [هود:22] وشبيهتها آية النحل "لَا جَرَمَ أَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ "[الآية:109] وورد في هذه الإخبار عنها بصيغة اسم الفاعل، مما ينقدح معه في ذهن التالي تساؤل مفاده؛ هل هناك مفاضلة في الخسران الأخروي؟ بمعنى هل تكون خسارة البعض أشد من خسارة الآخر؟ فمعلوم أن أحب شيء إلى الإنسان نفسُه، قد يحب الخير للغير، لكن عند التعارض يؤثر نفسه به ولا تطاوعه بمشاركة الآخر له فيه، جبلة جبل عليها الإنسان، ولا يتغلب عليها إلا بمجاهدة خارجية جاء بها الشرع اسمها الإيثار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما جاءه يخبره بمحبته له، وأنه أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك.. ففي الكلام الأول لعمر دليل على أن الفطرة التي فطر عليها الإنسان حب الاستئثار بالمحامد والفضائل، سيما عند التعارض، فالجهنميون مشتركون في الخسارة، أي سُوِّي بينهم في خسارة النفس التي هي أنفس ما يملك المرء، فكلٌّ خاسر، وكل يظن أنه لا يعذب عذابه أحد، فكيف تُوجَّه المفاضلة في ذلك؟ هذا من حيث الدلالة المعنوية، أما من حيث ضبط المتلو فهي مما يشكل على الحافظ؛ في أي الموضعين ورد الخسران بصيغة التفضيل؟ وفي أيها ورد الإخبار عنه بزنة اسم الفاعل، من العلماء الذين أذكوا قرائحهم للإجابة عن هذا التساؤل ابن الزبير الغرناطي، قال رحمه الله:
"الآية الثالثة منها قوله تعالى: "لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ "[هود: 22]، وفي سورة النحل: "لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ " [النحل: 109]، للسائل أن يسأل عن وجه تخصيص آية هود بقوله: "الأَخْسَرُونَ " وآية النحل بقوله: "الْخَاسِرُونَ " ؟ وهل كان يمكن العكس؟
والجواب: أن آية هود تقدمها ما يفهم المفاضلة، ألا ترى أن قوله تعالى: "أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ "[هود: 17]، الآية يفهم من سياقها أن المراد: أفمن كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد وكذب الرسل؟ ثم أتبع هذا بقوله: "َمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً " [هود: 18]، فهذا صريح مفاضلة، ثم استمرت الآي في وصف مَن ذُكر وعرضهم على ربهم وقول الأشهاد: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" [هود: 19، 18]، إلى ذكر مضاعفة العذاب لهم، واستمر ذكرهم إلى قوله: "لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ" [هود: 22]، فناسب لفظ الأخسرين بصيغة التفاضل، ومقصود التفاوت ما تقدم مما يفهم ذلك من قوله تعالى: "أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ " [هود: 17]، وأفعل من كذا في قوله: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى " [هود: 18]، فالآيات من لدن قوله: "أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ" إلى قوله: "هُمْ الأَخْسَرُونَ" مبنيات على ما ذكرناه غير خارجة عن هذا المقصود، ولو ورد هنا "لخاسرون" مكان "الأخسرين" لتنافى النظم وتباين السياق ولم يتناسب.
وأما آية النحل فلم يقع قبلها أفعل التي للمفاضلة والتفاوت، ولا ما يفهمهما، وإنما قبلها: "إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ" [النحل: 105، 104]، وبعد هذا؛ "وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" [النحل: 107]، وبعد هذا "وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ" ، فتأمل هذه الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل المجموع جمع السلامة في قوم متفقي الأحوال في كفرهم، إلى أن ختم وصفهم وما قصد من ذكرهم بقوله: "لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ" ، فتناسبت الآي في السياق والفواصل، وختمت بمثل ما به بدأت، ولم يكن ليناسب ما ورد هنا لفظ المفاضلة، إذ ليس في الكلام ما يستدعي ذلك لا من لفظه ولا معناه، ووضح اختصاص كل من العبارتين بمكانه، وأن العكس لا يلائم، والله أعلم.[1]"
فظهر بهذا التتبع لمساقات الذكر، أن المفاضلة في المخبر عنها في آية هود غير مقصود بها دلالتها، وإنا جيء بها مناسبة للفواصل، ورعيا للسبك الأول لما خرج مخرج التفضيل، ويرشح ذلك تصدير الآيتين بقوله تعالى "لا جرم" في كل، ولأهل العربية فيها كلام طويل ومن أجمع مَن أوجز الكلام فيها السمين الحلبي في الدر المصون، وجماعه ما أودعه الطاهر ابن عاشور في معلمته التفسيرية قال رحمه الله: "لا جرم كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل، وأحسب أن (جرم) مشتق مما تنوسي، وقد اختلف أئمة العربية في تركيبها، وأظهر أقوالهم أن تكون (لا) من أول الجملة و (جرم) اسم بمعنى محالة أي: لا محالة، أو بمعنى بد، أي: لا بد، ثم يجيء بعدها أن واسمها وخبرها فتكون (أن) معمولة لحرف جر محذوف، والتقدير: لا جرم من أن الأمر كذا، ولما فيها من معنى التحقيق والتوثيق وتعامل معاملة القسم فيجيء بعدها ما يصلح لجواب قسم نحو: لا جرم لأفعلن...وعبر عما لحقهم من الضر بالخسارة استعارة؛ لأنه ضرٌّ أصابهم من حيث كانوا يرجون المنفعة، فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح، إنما كانوا أخسرين، أي: شديدي الخسارة؛ لأنهم قد اجتمع لهم من أسباب الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة، ولأنهم شقوا من حيث كانوا يحسبونه سعادة، قال تعالى: "قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا" [الكهف: 103، 104] فكانوا أخسرين لأنهم اجتمعت لهم خسارة الدنيا والآخرة.".[2]
قال الرازي:"وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضي بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة. ثم لما كان هذا الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن يهلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة الخسارة، فلهذا قال: "لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون "[3]
فكل تيقن الخسران، بل ويكابد الخسران، وتشتد لوعته به أنه يرى أهله يشاركونه الهوان، فلا تفاضل بل كل مشترك في الخزي و الخسران، دون أن يجدي بعض عن بعض المشاركة في العذاب، كما قال سبحانه: "وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلۡيَوۡمَ إِذ ظَّلَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ".
قال الرازي:"وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضي بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة، ثم لما كان هذا الخسيس بحيث لا يبقى، بل لا بد و أن يهلك ويفنى، انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة الخسارة، فلهذا قال: "لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ " [4]
جنبنا الله سبل الخسران، وهدانا مسلك الرضوان.
[1]1 1 ملاك التأويل، القاطع ب\وزي الإلحاد والتعطيل، 2/255.
[2]التحرير والتنوير، 12/39.
[3] مفاتيح الغيب، 17/334.
[4] مفاتيح الغيب، 17/334.