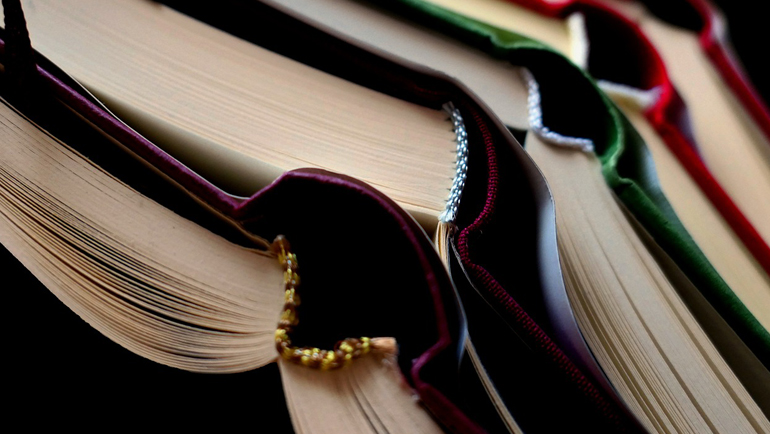من التقعيد الفقهي إلى التقعيد الأخلاقي 3/1
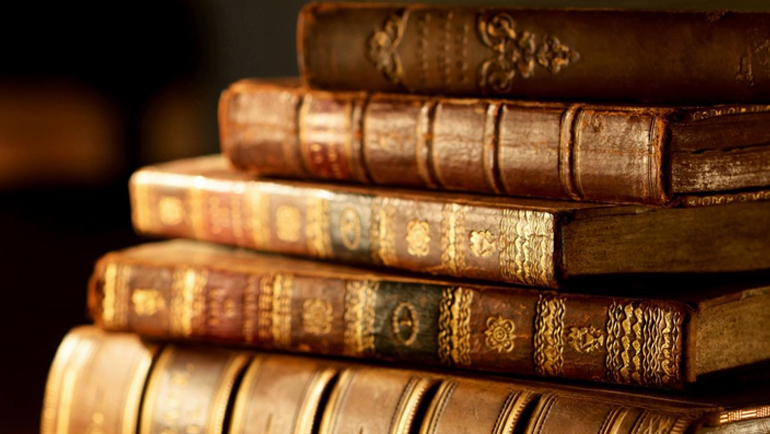
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
أما بعد.
من المعلوم ما للتقعيد الفقهي والأخلاقي من أهمية في ضبط سلوك الفرد وجعله يتناغم مع التوجيهات الالهية المقررة. وطريقة التقعيد الفقهي التي ظهرت بوضوح في القرن الرابع الهجري لخدمة الفقه، وطريقة التقعيد الأخلاقي، لجديرة بالنظر والتوقف عند آلياتها، ومحاولة الاستفادة من هذا كله في دراسة عقلية المجتهد في الفقه الاسلامي من ناحية، وكيفية تشغيل هذه القواعد على هذه المستجدات من ناحية أخرى[1]وربطها بالمعاني الأخلاقية أثناء تنزيلها على مستجدات العصر.
والقاعدة في أصل اللغة: الأساس، وتجمع على قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله: حسيا كان ذلك الشيء؛ كقواعد البيت، أو معنويا؛ كقواعد الدين، أي: دعائمه[2].
أما في الاصطلاح: فقد ميزها المقَّري بقوله: " هي كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة "[3] فالمقَّرِي لم يقصد في قواعده القواعد الأصولية العامة، ككون الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس حجة، وكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم وغيرها، ولا القواعد الفقهية الخاصة، ككل ماء لم تتغير أوصافه طهور، وكل طير مباح الأكل، وكل عبادة بنية، ونحو ذلك، وإنما المراد ما توسط بين هذين مما هو أصل لأمهات مسائل الخلاف. فهو أخص من الأول وأعم من الثاني[4].
أو بتعريف أوضح، هي: "حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"[5]؛ فهذه القواعد أغلبية في معظمها غير مطردة، وترد عليها استثناءات في فروع الأحكام التطبيقية، طبقا للقاعدة القائلة إن أكثر قواعد الفقه أغلبية، ومن القواعد: عدم اطراد القواعد. إلا أن هذه الاستثناءات التي ترد عليها لا تضيرها ولا تقدح في قيمتها وأثرها، فقد أفادت الفقه الاسلامي فائدة عظمى[6].
ولإبراز العلاقة بين الفقه والأخلاق لا بد من إعطاء لمحة عن الأدوار التاريخية التي مر بها الفقه الإسلامي.
فأدوار الفقه التي يكاد يتفق عليها الباحثون هي أربعة أدوار[7]
الدور الأول:عصر الصحابة والتابعين حيث بدأت الحركة الفقهية بالظهور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة والتابعون باستنباط أحكام المسائل والقضايا الفقهية من المصادر الشرعية، لاعتقادهم أن لكل قضية أو أمر من أمور الدنيا حكما لله تعالى، وأنهم المكلفون ببيان هذه الأحكام، فإذا حدث أمر، أو طرأت حادثة، أو استجد بحث، نظروا في كتاب الله تعالى، فإن وجدوا فيه نصا صريحا، بينوه للناس، وإن لم يجدوا، رجعوا إلى السنة دراسة وبحثا وسؤالا، وإن لم يجدوا فيها نصا، شرعوا في الاجتهاد وبذل الجهد والنظر في الكتاب والسنة وما يتضمنان من قواعد مجملة ومبادئ عامة.
إن هذا الدور الذي شمل الصحابة والتابعين في التماسهم لحكم الله تعالى في النازلة كانوا ينهجون المنهج الذي سطره النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون بكتاب الله تعالى ثم بسنته ثم برأيهم ولا أدل على ذلك من حديث سيدنا معاذ بن جبل عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لينشر تعاليم الإسلام، ولا نغفل الجانب الأخلاقي الذي كان يساير أحكامهم المستنبطة.
فإذا كان هذا الدور يعتبر أسمى الأدوار فقها، لكونه شمل عصر الصحابة والتابعين، فإنه كذلك أسمى الأدوار أخلاقا، لقرب عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشيء الذي لا يمكن إغفاله.يقول ابن القيم: "ثم قام بالفتوى جند الرحمن أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة قلوبا، وأعمقها علما وأصدقها إيمانا وأقربها إلى الله وسيلة[8].فقد أورد قضية القلوب وأتبعها قضية العقول، ولا انفكاك بينهما.
الدور الثاني (عصر المجتهدين) الذي بدأ من أوائل القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الرابع الهجري.
الدور الثالث (عصر التقليد) الذي بدأ من منتصف القرن الرابع الهجري إلى سقوط بغداد سنة (656هـ).
ثم إذا انتقلنا من دور إلى آخر، نلحظ معه تراجع بريق وازدهار الفقه، بتراجع وجنوح الفقهاء إلى التقليد، مع أن الأصل في الفقيه أن يكون مجتهدا، وبالموازاة مع ذلك نلحظ ضعف وتراجع الوازع الأخلاقي الذي ولد العصبية المذهبية والتشنيع على المخالف.
الدور الرابع الذي بدأ بسقوط بغداد في القرن السابع الهجري إلى وقتنا الحاضر، فإن الفقه لم ينهض بعد من كبوته وكذلك الأخلاق، ولم يغير الفقهاء نهجهم.
هذه لمحة وجيزة لأطوار الفقه التي قرنت بالأخلاق. فما هي إذن مكانة الأخلاق في الفقه؟