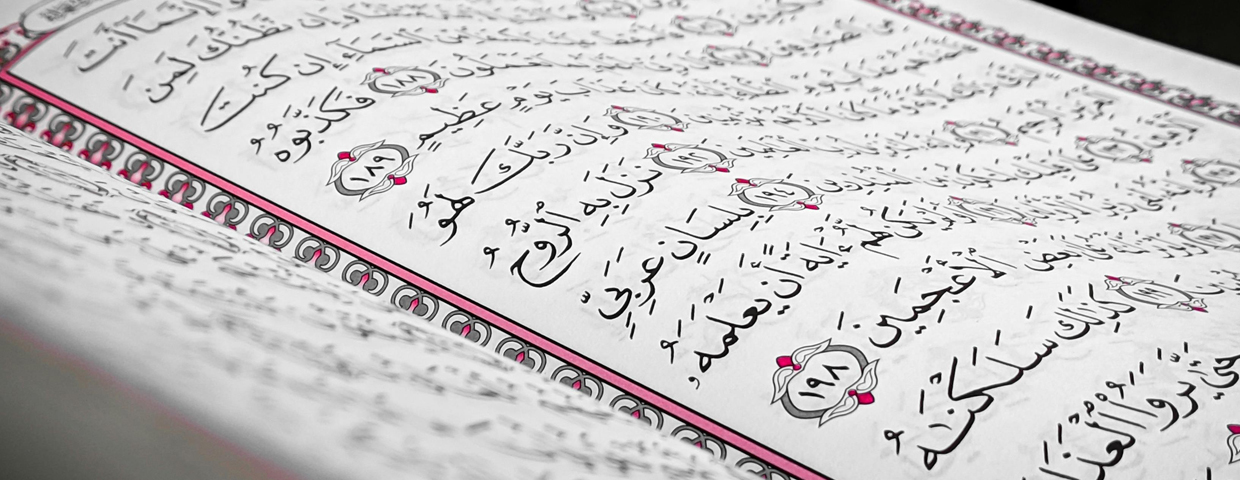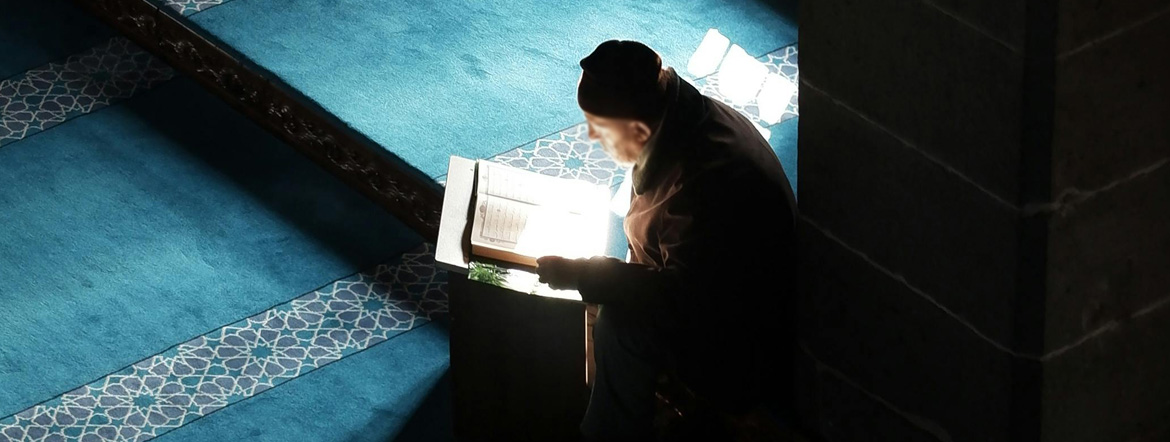أبادر إلى رفع لبس قد يسببه مصطلحا "التنزيه" و"التعطيل"، فالمصطلحان مستعاران من علم الكلام، لكن الدلالة التي يسعى البحث إلى تقديمها لهما لا تعلق لها بتنزيه الذات والصفات أو تعطيلها مما تداولته أدبيات العقيدة وعلم الكلام بخصوص أسماء الله تعالى وصفاته.
إن التنزيه والتعطيل متصل، في سياق البحث، ببلاغة الإعجاز، وهما موظفان في سياق أطروحة سأبرز ملامحها في متن العرض.
وجوهر التوظيف مرتبط برؤية مفادها، بحسب بعض الدارسين المعاصرين، أن المشتغلين ببلاغة الإعجاز وقعوا في إشكال وهو: التهوين من المكون الإيقاعي الموسيقي، ولم يعطوه القيمة التي منحوها لمكونات بلاغية أخرى، والسب هو أن المكون الإيقاعي الموسيقي، كميا، موجود في الخطاب الشعري بقوة، بل لا يتصور وجود للشعر إلا من خلال المكون الإيقاعي، وبالتالي فإن أي بلاغي يحاول أن يقيم مقارنة بين خطاب الشعر وخطاب القرآن في هذا المستوى، ستكون المقارنة محسومة سلفا لصالح خطاب الشعر.
ومن أجل أن لا يقع بلاغيو الإعجاز في هذا الشرك، فقد حرصوا، نظريا، على التهوين من المكون الإيقاعي. وهذا يعني أن بلاغيي الإعجاز "عطلوا" قيمة الشعر في مكونه الإيقاعي لصالح خطاب القرآن الذي "يتنزه" عن ذلك الإيقاع.
إن هذه الرؤية التي نجدها عند د. محمد العمري ود. نصر حامد أبو زيد تكشف عن أن الدارسين المعاصرين تأثروا بالعطاء التراثي المتأثر، هو نفسه، بسياقات معينة، فوقعوا في ما انتقدوه على بلاغيي الإعجاز، فإذا كان القدامى "عطلوا" قيمة الشعر بـ"تنزيه" الخطاب القرآني، فانتهوا إلى تأويل إيديولوجي للظواهر البلاغية، فإن المحدثين سعوا، بوعي أو بدون وعي، إلى "تنزيه" الخطاب الشعري بـ"تعطيل" بلاغة الإعجاز من خلال الاحتفاء بالبعد الكمي للإيقاع الشعري الموجود بكثافة في الشعر، والمنعدم في الخطاب القرآني. فوقعوا، هم كذلك، في مغبة التأويل الإيديولوجي للظواهر البلاغية.
وهذا يقتضي مراجعة منهجية للتراث النقدي القديم والحديث على حد سواء، وقد أعجبني تعليق د. عبد المجيد الصغير في مداخلته "المرجعية والسياق وصراع التأويلات: مراجعات نقدية في الفكر الإسلامي" حين أشار إلى أن في متن علومنا الإسلامية تظهر بذور الأزمة، وآخر ما ختمت به كتابي: "دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية" التذكير بأن المشكل الذي يواجه الدارسين هو أن بعض علومنا الإسلامية تحمل في طياتها بذور العديد من الإشكالات، مما يمنح مهمة المراجعة قوتها الاستعجالية والمنهجية والمعرفية على حد سواء.
تحرير الإشكال
فقد ذهب بعض الدارسين المهتمين بقضايا البلاغة وإشكالاتها إلى أن "بلاغيي الإعجاز" غيبوا "المكون الإيقاعي" من مجال دراستهم وبحوثهم، ولم يهتموا بدراسته باعتباره واحدا من أهم مكونات الخطاب الأدبي، وكانت النتيجة أنهم، وفق هذه الدعوى، لم يرفعوا قواعده، ولم يفردوا أنواعه، ولم يذكروا جائزه وممنوعه.
يقول أحد الدارسين: "يجب الاعتراف بأن الجرجاني كان ينظر إلى بلاغة الإعجاز، البلاغة التي تضمن تفوق القرآن، وهي بلاغة تقصي كل العناصر التي جلى فيها الخطاب البشري، أو ظهرت له فيه أنساق متميزة مثل "الوزن([1])".
هذا الحكم الصادر في حق جهود الجرجاني، والذي تم تعميمه على "بلاغة الإعجاز" بمختلف روادها وعطاءاتها، جاء نتيجة قراءة نصوص عبد القاهر وغيره من بلاغي الإعجاز، وصرفها جهة تأكيد الملاحظة السالفة.
فعندما ينفي الباقلاني، مثلا، وجود السجع في القرآن، ويدافع، بحماس شديد، من أجل إرساء دعائم أطروحته، فإن ذلك يرجع في نظر هؤلاء الدارسين المعاصرين، إلى: "بروز هذا المقوم؛ أي مقوم السجع والوزن، كقيمة فنية كبيرة في التراث الأدبي العربي القديم، شعرا كان أم سجعا أم خطبا وأمثالا بالقياس إلى النص القرآني، فإذا ما نظر إلى البنية نظرة كمية شكلية، وكذلك كانت نظرة الباقلاني، بدا أوفر حظا في النص الأدبي منه في النص الديني، وهذا محرج بالنسبة لبلاغيي الإعجاز ([2])".
ومن نتائج هذا التحليل أن عبد القاهر الجرجاني، يقول دارس آخر في نفس الاتجاه، "يهون من قدر الشعر، وينزل به إلى أن يصبح مجرد دلالة وشاهد على إعجاز القرآن، كما يمكن أن نقول: إن "علم الشعر" عنده مجرد علم "ثانوي" يخدم علما آخر دينيا هو علم "إعجاز القرآن ([3])".
وبما أن أصحاب هذه الدعوى يؤكدون، ويلحون في التأكيد، على أن ملاحظاتهم تنطلق من نصوص الباقلاني والجرجاني خاصة، وعلماء البلاغة والتفسير عامة، فإن ذلك يفرض على الدارس الاحتكام إلى النصوص نفسها، واستقراء مذاهبهم في الموضوع، ووضعها ضمن سياقها النصي والثقافي، لمعرفة حدود إعمالهم للمكون الصوتي الإيقاعي أو إهمالهم له، بغية بناء إطار بديل لمعالجة قضية البلاغة القرآنية كما بسطها الأولون.
لقد دفع التأويل الإيديولوجي هذا النوع من الدراسة إلى أن تقع في مجموعة من الآفات، لعل أهمها:
1. آفة الادعاء
فهم يدعون أن بلاغيي الإعجاز لم يهتموا بالمكون الإيقاعي، ولم يقيموا على دعواهم هاته أدلة علمية، وإنما اقتنصوا نصوصا من هنا وهناك لينطلقوا منها في تأكيد دعواهم، وهذا الاقتناص أوقعهم في الآفة الثانية: آفة الانتقاء والاجتزاء، كما أوقعهم في الآفة الثالثة: فصل كلام بلاغيي الإعجاز عن السياق، وهي آفات نفصل القول فيها لاحقا.
إن واقع المدونة البلاغية الممتدة في الزمان والمكان يشهد بأن بلاغيي الإعجاز أولوا عناية خاصة لمختلف الجوانب الإيقاعية والجمالية الصوتية في الخطاب القرآني، ويمكن تقديم نماذج مجتزأة في هذا السياق.
وأمام غياب جرد مفصل لجميع النصوص التي يمكن أن تكون فد توفرت قبل بداية التفسير الكامل للقرآن، نرجح أن يكون "الفراء" هو أول من انتبه، تأليفا، إلى ظاهرة مراعاة الفواصل؛ لأن من شأن تلك الرعاية أن تحقق نسقا صوتيا وإيقاعيا متناسبا.
حقيقة أن "أبا عبيدة" أحس بالظاهرة، لكنه لم يعللها تعليل الفراء، فقد وقف عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (ص: 5) فقال: "مجازه مجاز عجيب، وقد تحول العرب "فعيلا" إلى "فعال"([4]).
وإذا لاحظ القارئ حذف الياء في قوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ (الفجر: 4)؛ فالسبب في ذلك عند أبي عبيدة أن "العرب تحذف هذه الياء في هذه، وفي موضع الرفع([5])".
ولكن أبا عبيدة لم يشر إلى التناسب الحاصل، إيقاعيا، بين فواصل الآيات في سورة (ص) وسورة (الفجر) والذي شكل محددا للتغيير المذكور في الصيغة من "فعيل" إلى "فعال"، ولحذف الياء من فعل "يسر (ي)". فـ"عجاب" تناسب، صوتيا "كذاب" و"وهاب" و"الأسباب" و"الأحزاب" مناسبة تماثل وتناسب "شقاق" و"مناص" و"يراد" مناسبة تقارب. و"يسر" بحذف "الياء"، تتلاءم مع "الفجر والعشر والوتر وحجر".
ويظهر تفرد الفراء في كونه يعلل مثل هذه الظواهر تعليلا إيقاعيا، فقد سئل عن قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾، فأجاب: "أهمزه في كل القرآن إلا في سورة الرحمن؛ لأنه مع آيات غير مهموزات([6])".
ويبرز وعيه بالظاهرة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ (الرحمن: 45)؛ إذ ذكر أن المفسرين يذهبون إلى أنهما بستانان من بساتين الجنة، ثم أضاف: "وقد تكون في العربية جنة تثنيها العرب في أشعارها، وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان، فيحتمل ما لا يحتمله الكلام([7])"، لكن ابن قتيبة لم يطمئن إلى هذا التعليل، وأنكر وأغلظ في النكير، على حد تعبير الزركشي، وضيق من حدود الخرق الذي يأتي مراعاة للفواصل، وحصره في حدود زيادة حرف هاء السكت أو الألف، أو حذف همزة أو حرف([8]).
ويعترف الزركشي بأن مذهب الفراء لا يمكن أن يحتج له بصورة كاملة، خاصة وأن الأوصاف اللاحقة تدل على أنهما جنتان([9]).
ويورد السيوطي نصا لابن الصائغ، يحاول فيه التأكيد أن الفراء أراد "جنات" فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة، وعلق على ذلك بأنه غير بعيد، وتأول التثنية الواردة في أوصاف الجنتين بأن ذلك أعيد مراعة للفظ([10])".
والذي نخلص إليه، بعد هذا الجرد، أن جميع المهتمين ببلاغة الخطاب القرآني متفقون على أن هناك "عدولا" أو "خرقا" يشمل بنية الكلمة في اشتقاقها أو صياغتها أو حروفها مراعاة لأبعاد إيقاعية استوعبها مصطلح الفواصل، وينحصر الخلاف بينهم في حدود هذا العدول ومجالات ذلك الخرق، وهنا يقف ابن قتيبة موقف التضييق، في حين يميل الفراء ومن تبعه، مثل الزركشي وابن الصائغ والسيوطي، إلى توسيع الدائرة، وإدراج مظاهر أسلوبية أخرى ترد، في رأيهم، مراعاة للفواصل، تتجاوز حدود الخرق القياسي إلى أساليب مغايرة مثل الحذف والتقديم والتأخير([11]).
ويشكل موقف الزركشي توازنا في التعامل مع مستويات التحليل النصي للخطاب الإلهي، فهو يؤكد بأن "إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا، ومؤثر في اعتدال نسق الكلام، وحسن موقعه في النفس تأثيرا عظيما([12])". ففي هذا النص شعور قوي بأن لتناسب الفواصل أثرا في إيقاع الخطاب، يؤثر بدوره، في نفسية المتلقي.
ثم يورد المواضع التي تخرق فيها الفاصلة القياس الأصلي للكلام وهذه نماذج منها([13]):
أ. ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ (الأحزاب: 10)، يلاحظ في هذه الآية زيادة حرف؛ لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع، وتناسب نهايات الفواصل.
ب. ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ (الإسراء: 69)، في هذه الآية، حصل جمع بين مجرورات، والأرجح: الفصل بين المجرورات المتوالية، لكنها وصلت هنا لإيقاع المناسبة بين رؤوس الآي كي تتناسق على إيقاع واحد
ج. ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (طه: 66)، يلاحظ في هذه الآية تأخير ما أصله أن يقدم؛ إذ أصل الكلام أن يتصل الفعل بفاعله، وأخر، هنا، لأجل رعاية الفاصلة.
د. ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ (إبراهيم: 33)، فالأصل إفراد خلال لتكون "خلة" عطفا للمفرد على المفرد، لكن جمعت لإيقاع المناسبة بين الفواصل.
وفي باب "الخروج على خلاف الأصل وأسبابه"، اعتبر الزركشي مراعاة التجنيس أحد أسباب العدول عن الأصل، فالأصل في الأسماء، مثلا، أن تكون ظاهرة، وأصل المحدث عنه كذلك، وإذا ذكر ثانيا، وجب أن يذكر مضمرا للاستغناء عنه بالظاهر السابق، لكن الملاحظ أن سورة "الناس" اشتملت على اسم "الناس" الذي تكرر ذكره، ولم يضمر أبدا، وكان الأصل أن يقال: "قل أعوذ برب الناس، ملكهم إلههم من شر الوسواس الذي يوسوس في صدورهم، من الجنة ومنهم..."، إلا أن ذلك لم يحصل، مراعاة للتجنيس([14])".
ولا يعني تعليل الزركشي أنه يفسر الظواهر تفسيرا أحاديا، متعلقا بالمناسبة فقط، بل إنه كثيرا ما يكشف عن وجوه أخرى للظواهر المدروسة، كما فعل مع التقديم والتأخير، إذ يذهب إلى أن للتأخير في قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ حكمة أخرى، وهي أن النفس تتشوق لفاعل "أوجس"، فإذا جاء بعد أن أخر وقع بموقع([15]).
وانسجاما مع تعددية احتمالات التعليل والتخريج، نبه على القاعدة الأساسية الآتية. "قد يكون في كل واحد مما ذكرنا من الأمثلة سببان فأكثر للتقديم، فإما أن يعتقد إعادة الكل، أو يرجح بعضها لكونها أهم في ذلك، وإن كانت الأخرى أهم في محل آخر، وإذا تعارضت الأسباب روعي أقواها، فإن تساوت كان المتكلم بالخيار في تقديم أي الأمرين شاء([16])".
وإذا كان هذا الكلام يتعلق بظاهرة التقديم والتأخير، إما مراعاة للفواصل أو غيرها من الاعتبارات كالاختصاص، فإنه قابل لأن يعمم على مختلف التعليلات الواردة بخصوص رؤوس الآي، وكأن الزركشي يدخل السياق كمحدد للتعليل، وموجه له.
ولكنه في جميع الأحوال، لا يغيب الوجه البارز في المسألة، وهو حرص الآيات على أن تأتي في أتم نسق إيقاعي، ليشترك اللفظ والمعنى والإيقاع في خدمة الدلالة المقصودة من الخطاب.
وهذا الأمر في غاية الأهمية، فالذين يقولون بمراعاة الفواصل، لا يجردون الأمر من بعده الدلالي، وكأن الزمخشري كان يحس بهذا الاعتراض عندما أكد بأنه "لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها، إلا مع بقاء المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والقوافي، فأما أن تهمل المعاني، ويهتم بتحسين اللفظ وحده، غير منظور فيه إلى مؤداه، فليس من قبيل البلاغة([17])".
ونتيجة ذلك، فقد جاوز بالتقديم والتأخير في قوله تعالى: ﴿بِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (البقرة: 3) حدود مراعاة الفاصلة، وذهب إلى أن تقديم الآخرة إنما ورد رعاية للاختصاص.
ولم تخرج تعليلات البلاغيين والمفسرين عن هذا الإطار الذي استوعب جهود الزركشي، ففي معرض حديثه عن أنواع الفواصل القرآنية، توقف "ابن سنان" عند الفواصل المتماثلة، ومثل له بقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ (الفجر: 1-10)، ثم أضاف: "وحذف الياء من يسري والوادي، طلبا للموافقة في الفواصل، وهذا جائز أن يسمى سجعا؛ لأن فيه معنى السجع، ولا مانع في الشرع يمنع من ذلك([18])."
وهو يستثمر هذا التحليل لتأكيد مشروعية إضافة السجع إلى الفواصل القرآنية تأكيدا لقيمتها الصوتية وجماليتها الإيقاعية، وتأثيرها في نفوس المتلقين، ولم يكن كتابه "سر الفصاحة" إلا تبيينا لهذا المستوى الجمالي من الخطاب الأدبي.
ويحرص الرازي على إعطاء البعد الإيقاعي مكانته في التحليل، ففي معرض تفسيره لسورة "الضحى" لاحظ استغناء السياق عن ضمير الكاف في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (الضحى: 3)، وذكر مختلف الأوجه الواردة في تعليل حذف ضمير الخطاب، وكان مما ورد في كلامه: "وفي حذف الكاف وجوه؛ أحدها حذفت الكاف اكتفاء بالكاف الأولى في "ودعك" ولأن رؤوس الآيات بالياء، فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف...([19])".
وذهب أبو حيان في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ (الزلزلة: 4-5) إلى أن فعل "أوحى" عدي باللام، وإن كان المشهور تعديته بإلي، مراعاة للفاصلة([20])."
فهذه النصوص دالة، بمنطوقها ومفهومها، على اعتبار بلاغيي الإعجاز للمكون الصوتي الإيقاعي في القرآن، وهو الملحظ الذي فات أصحاب الدعوى المعاصرة، دعوى إهمال البلاغة الإعجازية للمقومات الصوتية أثناء تفسيرها للخطاب القرآني.
ومما يلاحظ، في هذا السياق، أن الجهود السابقة جاءت محكومة بطبيعة التأليف عند القوم، فلم تتجاوز حدود الإشارات المتناثرة هنا وهناك، ولم ترق إلى أن تشكل إطارا تحليليا يوازي دراسة القرآن في مستواه الدلالي، ولكن، رغم طبيعتها تلك، فإنها مؤهلة لأن تتوحد في اتجاه تأكيد إعمال البلاغيين للمكون الإيقاعي، وليس إهمالهم له.
2. آفة الانتقاء والاجتزاء
ويقصد بها أن أصحاب دعوى "تعطيل" بلاغيي الإعجاز للمكون الإيقاعي لأجل "تنزيه" الخطاب القرآني حرصوا على إيراد نصوص وشواهد مجتزأة من البناء الممتد للبلاغة العربية، ومنتقاة بشكل يوهم بعلمية الادعاء.
فعلى امتداد مدونة بلاغة الإعجاز في الزمان والمكان، حرص أصحاب تلك الدعوى على الاستدلال بنصوص للباقلاني والجرجاني، مع أن هذين الناقدين لا يمثلان سوى محطات نوعية في تاريخ البلاغة العربية، ناهيك عن أن النصوص المستدل بها فصلت عن سياقها كما سنراه بين يدي الحديث عن الآفة الثالثة.
ـ موقف الباقلاني
ويعتبر موقف الباقلاني من السجع أبرز فكرة تثير الانتباه في دراسته للإعجاز القرآني، فهو يرفض تسمية فواصل القرآن سجعا، معللا رفضه بأنه "لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز([21])".
ويضيف إلى هذا الدليل المنطقي دليلا آخر ينصب على الجوانب الإيقاعية، من سجع وجناس وطباق وغيرها... باعتبارها مسلكا مألوفا "يمكن استدراكه بالتعلم والتصنع له... وله طريق يسلك، ووجه يقصد، وسلم يرتقى فيه إليه، ومثال قد يقع طالبه عليه، فأما شأن نظم القرآن، فليس له مثال يحتذى عليه، ولا إمام يقتدى به([22])"؛ أي إن نهج المحسنات البديعية أمر معلوم ومحدود، يستدرك أخذه ويتهيأ تلقنه، ويتعمل له([23]). فلا ينبغي، نتيجة ذلك، ربط الإعجاز به، أما "ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات، وفي مقدمتها علم البيان والمعاني، فذلك هو الذي يدل على إعجازه([24])."
إن الباقلاني يبحث، هنا، عن ضابط مطرد في تحقيق أمر الإعجاز، وقد تبين له، بعد البحث، أنه لا يمكن قصره على الأمور التي تنضبط ويتعلم فيها تعلما وتلقينا؛ لأن من شأن ذلك أن يوقع فكرة الإعجاز في شرك القياس والمقارنة، بخلاف المجالات التي تعرف بداياتها، لكن مدارك الكمال فيها لا يصلها المبدعون مهما صقلوا مواهبهم، أو أجمعوا أمر طاقاتهم الوجدانية والتخييلة. وبهذا يقف القرآن في سدرة الكمال، لا يجرؤ نص أدبي أن يتعلق، افتراضا، بادعاء الاقتراب منه. واحتكاما لهذا المعيار، فسر ابن خلدون، مثلا، ولع المغاربة بعلم البديع خاصة؛ "حيث جعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية، وفرعوا له ألقابا، وعددوا أبوابا، ونوعوا أنواعا، وزعموا أنهم أحصوها من "لسان العرب" وإنما حملهم على ذلك الولوع بتزيين الألفاظ، وأن "علم البديع" سهل المأخذ، وصعبت عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما، وغموض معانيهما، فتجافوا عنها([25])."
ولا يهمنا الآن مناقشة هذا التفسير، خاصة حين يفصل، بدون وعي بين مختلف المكونات العملية الإبداعية، فيعزل المكون الصوتي، مثل الإيقاع والجناس والطباق... عن باقي المكونات التركيبية الدلالية، ويعتبره كيانا مستقلا ينضاف إلى جسم النص إضافة ميكانيكية... وإنما نلفت النظر إلى الضابط الذي اختاره "الباقلاني" وهو أن أي عنصر ينضبط ويقاس ويحد، لا يمكن الاعتماد عليه في الوقوف على حقيقة الإعجاز. وإذا انضافت هذه الأدلة إلى الحديث النبوي الشريف، الوارد في القوم الذين جاء الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكلموه في شأن الجنين: "كيف ندي من لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل، أليس دمه قد يطل؟ فقال عليه السلام: "أسجعا كسجع الكهان الجاهلية؟" وفي رواية: "أسجعا كسجع الكهان([26])"، فقد استقام للباقلاني بناء حجته القاطعة بإنكار السجع ورفض إسناده إلى خطاب الوحي. بهذا، يتبين السياق العام الذي أصدر فيه الباقلاني آراءه في بعض المكونات الإيقاعية، تلك الآراء التي استندت إليها الدعوة المعاصرة، دعوى تغييب بلاغيي الإعجاز للمكون الصوتي.
وسينصب نقدنا على ثلاثة جوانب أساسية:
أ. جانب نقد تعميم موقف الباقلاني على خريطة بلاغة الإعجاز
إن المدونة البلاغية تنقض محاولة تعميم موقف الباقلاني من السجع، باعتباره مكونا صوتيا فعالا، على جهود مختلف الدارسين.
حقيقة إننا نجد رفض تسمية فواصل القرآن أسجاعا عند الفراء والرماني والغزالي، لكن ما يلاحظ على هذه الآراء أنها تستند في رفضها للسجع، إلى الحديث المروي في الموضوع، وكلما وسعنا الدائرة زمنيا، يمكن أن نلاحظ تفهما أصوليا لذلك الحديث، وترحابا مرنا بمشروعية ظاهرة السجع.
وهكذا نجد مواقف كل من الجاحظ وأبي هلال العسكري، وابن وهب والعلوي اليمني، وابن سنان الخفاجي وآخرين، تسير في تأكيد قيمة السجع وصواب إسناده إلى خطاب الوحي، مفسرين حديث سجع الكهان تفسيرا أصوليا،كما سنرى في الجانب الثاني.
ب. جانب نقد موقف الباقلاني بخصوص الاستدلال النبوي السالف
استدل "الباقلاني" على رفضه للسجع في القرآن بالحديث الذي أوردنا سالفا، لكن يبدو أن تحليل صاحب "إعجاز القرآن" وتعليله قد تما في ظل انطباعات ذاتية([27])، ومواقف شخصية، لم يتأسسا على قواعد أصولية محكمة، وإنما خضع لهما خضوعا فرض عليه التهوين من قيمة معلقة امرئ القيس لصالح الخطاب القرآني، فأنشأ، بهذا المنهج، اتجاها في دراسة الإعجاز يقوم على المقارنة بين الخطاب القرآني وغيره من الخطابات البشرية، وأضعف، بذلك، اتجاها كان يمكن أن يثمر نتائج طيبة، وهو اتجاه البحث في إعجاز القرآن من داخل الخطاب القرآني نفسه؛ لأنه "من أعظم أدلة مصدريته الربانية، وأنه وحي من الله تعالى... إن في القرآن من دلائل العظمة الداخلية ما لا يصح أن يبقى أسير النفحات الإيمانية فقط، بل لابد لمن استشعرها أن يتحف التفاسير بتقييدها فيها([28])"، وتحويلها إلى بناء نظري متكامل.
وكان من نتائج ذلك أن "عطل" الباقلاني قيمة الشعر وفنية قصيدة امرئ القيس لصالح "تنزيه" الخطاب القرآني، ولم يكن في حاجة إلى ذلك، وقد فاته الانتباه إلى أن القرآن نفسه، ومع ذكره للشعر والشعراء، لا يقيم مقارنة بين قولين، وإنما يقيم مقارنة بين متكلمين: المتكلم بالقرآن والمتكلم بالشعر.
ومن هنا، جاز القول إن القرآن بريء من تلك الثنائية المقارنة؛ ثنائية القرآن والشعر، كما هو بريء من "تعطيل" القيم الفنية الشعرية لصالح بلاغة الإعجاز، أوّ "تنزيهه" للأولى على حساب الثانية.
وبمقتضى ذلك، يصير من العبث أن يحتفظ التراث العربي بنصوص للباقلاني تحمل هاجس نقض شعر امرئ القيس لفائدة إثبات بلاغة الإعجاز، من مثل قوله: "ونظم القرآن جنس متميز، وأسلوب متخصص، وقبيل عن النظير متخلص، فإذا شئت أن تعرف عظم شأنه، فتأمل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاره، وما نبين لك من عواره على التفصيل([29])".
ونحن نشير في هذه الفقرة إلى قراءة مغايرة للحديث المعول عليه في نفي السجع والتهوين منه، أنجزها علماء مهتمون بقضايا البلاغة والإعجاز، وهي تقدم تطبيقا وفيا لبعض القواعد الأصولية المعتبرة عند أهلها.
يقول الجاحظ: "وكان الذي كره الأسجاع بعينها، وإن كان دون الشعر في التكلف والصنعة، أن كهان العرب الذين كان أكثر أهل الجاهلية، يتحاكمون إليهم، وكانوا يدعون الكهانة... كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع([30])".
وبعد هذا الرصد الوصفي للحالة التي كان عليها كهان العرب، توقف عند مسألة النهي الوارد في الحديث، ودرسه دراسة أصولية، مطبقا فيها القاعدة التي تنص على أن "الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، تحليلا وتحريما([31])"، فاستنتج بأن النهي وقع "في ذلك لقرب عهدهم بالجاهلية، ولبقيتها فيهم، وفي صدور كثير منهم، فلما زالت العلة زال التحريم([32])"، وهو استنتاج أقوم طريقة وأقوى انضباطا.
وبهذه العقلية، عالج صاحب "الطراز" نفس الإشكالية، منطلقا من القاعدة التي تنص على أن "ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، وتوقف عند النهي الذي يشمله نص الحديث، وحمله على الوجه اللائق به، دون الاقتصار على ظاهره، يقول: "والجواب أن نقول: إنه لم ينكر السجع مطلقا، وإنما أنكر سجعا مخصوصا، وهو التنزيل... فلا يمكن ترك هذا الأسلوب من الكلام لقصة عارضة من جهة الرسول، يمكن حملها على وجه لائق، كما أشرنا([33])".
بل يجب حملها على الوجه اللائق ما دام النص قد تطرقت إليه احتمالات عدة، وفي مقدمتها الحالة المخصوصة التي شكلت السبب المباشر لصدور قول الرسول عليه السلام.
وقبل العلوي اليمني، سعى أبو هلال العسكري إلى قراءة نص الحديث في ضوء الممارسة النبوية، باعتبارها تفسيرا للنص، وتقييدا لمطلقه، وتخصيصا لعمومه، وبيانا لمراده، فتساءل مستنكرا: وكيف يذمه ويكرهه، وهو إذا أسلم من التكلف وبرئ من التعسف، لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه، وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه الصلاة والسلام([34])".
واعتمادا على هذا التفسير الأصولي، لا يبقى للباقلاني ومن معه أي مستند علمي في الاستدلال بالحديث في موضوع السجع، فالإباحة واردة، ولا أحد يستطيع أن ينكر قيمة أسلوب السجع الفنية والجمالية والتأثيرية. وفي هذا الإطار، نستحضر نقد السيد أحمد صقر محقق كتاب: "إعجاز القرآن" يقول فيه: "والذي حدا بالأشاعرة إلى نفي السجع من القرآن، أنهم ظنوا، بل تيقنوا، أن النبي قد ذم السجع في حديث الجنين، ولا شك أنهم واهمون في ذلك، ولو كان النبي أراد إلى ذمه لقال: "أسجعا" فقط([35])، وإنما أراد النبي بقوله هذا، كما يتضح من سياق الحديث، إنكار تشادق الساجع في دفعه حقا وجب عليه وعلى عاقلته، وقعقعته بالسجع على طريق الكهان في الجاهلية"([36]). ثم يضيف: "ولئن قال الباقلاني إن السجع عيب يجب نفيه عن القرآن، فإني أقول، إن السجع من الميزات البلاغية التي يجدر بنا أن ننزه القرآن عن خلوه منها([37])".
وإذا تبث ذلك، أمكننا إبراز جوانب النقص في الدعوى المعاصرة التي تعمم موقف رفض السجع وإنكاره على خريطة بلاغيي الإعجاز، وهو نقص محقق، تشهد به نصوص بلاغيي الإعجاز أنفسهم.
والغريب أن بعض الدارسين المعاصرين يتجاوزون هذه المعطيات عن وعي أو بدون وعي، فيصدرون أحكاما مباينة للصواب، فقد ذهب أحدهم إلى أن موقف القرآن من السجع يخفي موقفا من الثقافة الجاهلية، ابتدأ بالقبول، ثم انتهى إلى التحريم، هذا ما يفسر، عنده، الحضور الكمي لظاهرة الفواصل في القرآن المكي، بالقياس إلى القرآن المدني، وبالتالي، فإن "موقف الإسلام من الكهانة مماثل لموقف النص من السجع أو الفاصلة، موقف القبول أولا، ثم الرفض بعد ذلك، وتلك هي جدلية القرآن مع الواقع، وجدلية النص مع النصوص الأخرى في الثقافة([38])".
وقد اتضح، من خلال أقوال البلاغيين أنفسهم، أن الإسلام لم يحرم السجع، والقائلون بخلاف ذلك قلة، يتزعمهم الباقلاني في موقفه الذاتي، وهو النموذج الوحيد الذي استدل به صاحب هذه الدعوى، ثم إن القرآن المدني لم يتخل عن ظاهرة الفواصل، وإنما نوع فيها، وأضاف إليها عنصرا جديدا يتمثل في طول المسافة بين الفواصل في هيئة تناسب مقام العرض والتفصيل، عرض الأحكام وتفصيل الشرائع([39]).
ج. جانب دعم موقف الباقلاني بخصوص المستوى الكمي القياسي للظواهر البديعية
إذا كان الدارس لا يتفق مع الباقلاني في موقفه من السجع، استنادا إلى مذاهب علماء أجلاء، فإن ما ذهب إليه بخصوص قابلية المحسنات البديعية للتعلم والتعمل لها، يعتبر تحليلا سليما، منظورا إليه في ضوء الامتداد التاريخي لأسلوب النثر العربي منذ العصر الأموي إلى ما سمي، عادة، بعصر الانحطاط، فقد برزت ظاهرة التكلف والتصنع، وأصبح بمقدار المرء أن يلاحظ تفنن المتأدبين والمترسلين في حشد أكبر قدر من السجع في جملهم وفقراتهم، وهم الذين عناهم ابن وهب بقوله، وهو بصدد الحديث عن السجع الذي يأتي عفوا دون تمحل أو استكراه؛ "فأما ولسنا واجدين فيما بين أيدينا من كلامهم استعمال السجع والغريب إلا في المواضع اليسيرة، فهم أولى بأن يقتدى بهم ويحتذى عنها بهم مما قد نبت في هذا الوقت من هؤلاء الذين ليس معهم من البلاغة إلا ادعاءها، ولا من الخطابة إلا التحلي باسمها([40])".
وهم الذين أشار إليهم ابن خلدون في نصه السابق، كما أن ابن الأثير كان يتحدث عنهم في قوله: "ومما رأيت من المدعين لهذا الفن، الذين حصلوا منه على القشور، وقصروا معرفتهم على الألفاظ المسجوعة الغثة التي لا حاصل وراءها، أنهم إذا أنكرت هذه الحال عليهم، وقيل لهم: إن الكلام المسجوع ليس عبارة عن تواطؤ الفقر، على حرف واحد فقط؛ إذ لو كان عبارة واحدة لأمكن أكثر الناس أن يأتوا به من غير كلفة، إنما هو أمر وراء هذا، وله شروط متعددة، فإذا سمعوا ذلك أنكروه لخلوهم عن معرفته([41])". وقد وصفهم من قبل وصفا قدحيا، فقال: "وإذا نظر إلى كتاب زماننا، وجدوا كذلك، فقاتل الله القلم الذي يمشي في أيدي الجهال الأغمار، ولا يعلم أنه كجواد يمشي تحت حمار([42])".
ونحن نلاحظ، اليوم، في تلاميذنا وطلابنا قدرة على تمثل ومحاكاة أساليب السجع والطباق، وما إلى ذلك من المحسنات البديعية، وقد يصعب عليهم، في المقابل، تمثل الأساليب البيانية؛ كالاستعارة والمجاز والكناية والفصل والوصل، فضلا عن محاكاتها، وذلك كله يدل على أن تعليل الباقلاني يحظى بغير قليل من الصواب، الذي تدعمه التجربة التاريخية، وتسنده الممارسة التربوية.
ـ موقف الجرجاني
سبقت الإشارة إلى أن الدعوى المعاصرة تستدل بكلام للجرجاني، لتؤكد أمر تغييب بلاغيي الإعجاز للمكون الصوتي الإيقاعي من العملية التحليلية والنقدية، وتستنتج معطيات في غاية الخطورة، يقول د. محمد العمري: "إن كلام الجرجاني لو انصرف إلى البحث عن بلاغة الإعجاز بعيدا عن بلاغة النص البشري لكان كلامه منسجما، ولما كان علينا من اعتراض، غير أن المؤلف التزم التهوين، كما سلف، من شأن المكونات التي يبدو للنص البشري فيها تميز، وقاس الفصاحة على الإعجاز.
إن السؤال هناك كبير جدا: فهل كان القرآن في تحديه لفصحاء العرب، يضع شرعة جديدة، ويعطي نموذجا بديلا للفصاحة؟ لقد استقر في الأذهان أن الإسلام ثورة على كل القيم (الجاهلية) فهل نظر إلى فصاحة المسموع من موزون وكلام مسجوع باعتبارها فصاحة حضارة ولت لتحل محلها حضارة قائمة على التركيب لا على الإفراد؟([43])".
ـ آفة فصل الكلام عن سياقه
ولمعرفة حدود الفهم والتأويل، في مثل هذه الأحكام، يتعين العودة إلى نصوص الجرجاني في الموضوع، إذ لعل سياقها العام يكشف عن أمور اختفت خلف صناعة الكلام، والإكثار من الاستفهام. ولكن لابد من التوقف ابتداء، عند بعض الأفكار الواردة في النص السابق؛ لأنها تحتاج إلى فضل بيان.
إن اعتبار الإسلام ثورة على القيم (الجاهلية) تصور غير علمي، ويكفي العودة إلى أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، وسلوكات الصحابة الإبداعية والفنية، لندرك بأن الإسلام، في الوقت الذي هاجم الجاهلية، وحطم العديد من قيمها الشوهاء، فإنه حافظ، في الوقت ذاته، على بعض القيم، وفي مقدمتها موروث الشعر العربي، حيث تعامل معه، ونظم شعراء الصحابة أشعارهم على منواله، متبعين جائزه، ومنتهين عن ممنوعه، دون أن يحسوا، مجرد إحساس، بأنهم يستعينون بأداة ترتد إلى العصر الجاهلي، بل إن العلماء اعتمدوا خريطة الشعر الجاهلي في تدوين اللغة، وخدمة القرآن فهما وتفسيرا. وجعلوه في مرتبة أساسية من حيث الاحتجاج اللغوي والنحوي، فكيف يجوز تعميم الحكم في هذا المجال؟
ثم إن وصف العصر الجاهلي بأنه كان حضارة إفراد في مقابل الحضارة الإسلامية، التي تنعت بأنها حضارة تركيب، إن هذه الأوصاف لا تعدو أن تكون لعبا بالألفاظ، وإلا فإن الشعر الموزون الذي ينتمي إلى العصر الجاهلي، لم يكن مرتبطا باللفظ المفرد فقط، إنه لم يحز صفة الشعرية إلا بعد عملية التركيب، تركيب الحروف والألفاظ والمقاطع والأوزان، وتركيب ذلك إلى جانب الدلالة بغية إنتاج خطاب أدبي ذي أفق شعري وتواصلي.
ثم إن الإيقاع نفسه الذي ينتمي إلى العصر الجاهلي لم يكن إفرادا، بل هو تركيب لحركات وسكنات وتوليف فني موسيقي لأسباب وأوتاد.
بعد هذا نعود إلى نصوص الجرجاني وسياقاتها لنختبر مدى سلامة دعوى تغييبه "للمكون الصوتي الإيقاعي" في الخطاب الأدبي.
لقد أورد "الجرجاني" كلامه حول فصاحة اللفظ والمفردات في سياق دعم نظريته في النظم، ومن البدهي، ألا يحصر الإعجاز في الألفاظ، سواء تعلق الأمر بفصاحتها أم بأصواتها؛ لأنه بصدد تأسيس معالجة جديدة، تتجاوز المفردات إلى التأليف والتركيب، يقول: "واعلم أنا لا نأبى أن تكون مذاقة الحروف وسلامتها، مما يثقل على اللسان، داخلا فيما يوجب الفضيلة، وأن تكون مما يؤكد أمر الإعجاز، وإنما الذي نكرهه ونفيل رأي من يذهب إليه أن يجعله معجزا به وحده، ويجعله الأصل والعمدة، فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات([44])".
إن الجرجاني بصدد وضع إطار جديد لمعالجة العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهو لا ينظر إلى المسألة من زاوية تهوين أمر الإيقاع أو المعنى، وإنما يحلل بمنظار تركيبي يدخل الوزن في صلب عملية النظم، باعتباره تأليفا للحروف والمقاطع والمعاني على حد سواء.
وهو مدرك لمحاسن الجناس وغيره من المحسنات البديعية، لكن على أساس كونها مجرد عناصر وأجزاء تنضاف إلى سياق مكثف لإنتاج المعنى، و"القول فيما يحسن وما لا يحسن من التجنيس والسجع يطول، ولم يكن غرضنا من ذكره شرح أمرهما، ولكن توكيد ما انتهى لنا القول إليه من استحالة أن يكون الإعجاز في مجرد السهولة وسلامة الألفاظ مما يثقل على اللسان([45])".
وحين شرع في رد الشبهة الواردة حول الشعر والاشتغال بروايته وحفظه، اقتضى منه منطق الإحاطة والتقصي أن يورد مجموع الأساليب الكامنة خلف هذا التصور السلبي تجاه الشعر، فذكر، فيما ذكر، الرأي الذي يذهب إلى رفض الشعر والزهد فيه، منظورا إليه من زاوية وزنه وقوافيه.
ودافع عن موقف الإباحة من الشعر إبداعا ورواية، وطالب الذين يرفضونه ويزهدون في الاشتغال به بسبب أوزانه وتقفيته، متكئين في ذلك الرفض والزهد على بعض الآثار الواردة عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، في الشعر، وهي آثار لم تتم قراءتها في ضوء القواعد الأصولية([46])، طالبهم بأن ينفتحوا على الشعر في مستوى بيانه وبلاغته ونظمه، وألا يقتصروا على الجانب الموسيقي الذي تعلقت به، في نظرهم، شبهة الكراهة.
وبعدما أورد بعض الأحاديث، علق عليها قائلا:"وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى حتى كان الوزن عيبا، وحتى إذا كان الكلام إذا نظم نظم الشعر اتضع في نفسه وتغيرت حاله، فقد أبعد، وقال قولا لا يعرف له معنى([47])".
ثم أضاف في نوع من التخصيص: "فإن زعم أنه إنما كره الوزن لأنه سبب لأن يغنى في الشعر ويتلهى به، فإنا إذا كنا لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل والقول الفصل، والمنطق الحسن، والكلام البين، وإلى حسن التمثيل والاستعارة، وإلى التلويح والإشارة، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر علينا فيما أنكر، فليقل في الوزن ما شاء، وليضعه حيث أراد، فليس يعنينا أمره، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه([48])".
فبان، بهذا، أن لا متعلق لمن يحشر الجرجاني في دائرة تغييب أو إقصاء المقوم الصوتي الموسيقي من إجراءات التحليل النصي، وهذه نصوص الجرجاني ناطقة بـ:
ـ إيمانه بتوفر الحروف والألفاظ على جوانب إيقاعية يفضل بها الكلام.
ـ اعترافه بالجوانب الحسنة في الجناس والسجع وما إلى ذلك.
ـ رفضه تعلق الإعجاز بالجانب اللفظي الإيقاعي مفردا عن جوانب النظم والتأليف.
ولا يبقى، بعد هذا الإقرار؛ أي مسوغ للقول إن الجرجاني التزم التهوين من شأن المكونات التي يبدو للنص البشري فيها تميز ملحوظ([49])، مما يوقع أصل الدعوى في شرك التأويل الذي آل مصيره إلى الاضطراب بين "التعطيل" و"التنزيه"، ولم يقدم خدمة منهجية أو معرفية للبحث البلاغي، مثلما انتهت سلطة الثنائيات عند "الباقلاني" إلى اضطراب ملحوظ في " تعطيل" القيم الشعرية لفائدة مظنونة في "تنزيه" بلاغة الإعجاز.
الهوامش
([1]) محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية، البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ط1، 1991، ص83-84.
([3]) نصر حامد أبو زيد، مقال: مفهوم النظم عند الجرجاني: قراءة في ضوء الأسلوبية، مجلة "فصول" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، م: 5، ع:1،1984، ص14.
([4]) أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق: فؤاد سزكين، القاهرة: مكتبة الخانجي، ج2، ص177.
([6]) الفراء، معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، بيروت: دارالسرور، د. ت، ج3، ص116.
([7]) معاني القرآن، م، س، ج3، ص118.
([8]) ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1978، ص440.
([9]) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط 1980، ج1، ص65.
([10]) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: المكتبة العصرية، ط 1988، ج3، ص299.
([11]) رصد أحد الدارسين المعاصرين المواضع القرآنية التي حصل فيها تقديم أو تأخير مراعاة للفاصلة، ووصل في ذلك إلى نتائج طيبة. انظر: محمد السيد سليمان العبد، مقال: من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، مجلة "المجلة العربية للعلوم الإنسانية" جامعة الكويت، ع 36، 1989 ص88-89.
([12]) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م، س، ج1، ص60.
وانظر المبحث الذي عقده أستاذنا د. أحمد أبو زيد لإبراز تناسب الفواصل في النظم القرآني، فقد عرض فيه لآراء الأقدمين، ومثل لها بما فيه الكفاية، وخلص إلى تأكيد علاقة الوفاء الاطرادية بين المعنى والصياغة، وختم تحليله بقوله: "من أهم الخصائص التي تميز القرآن من كل كلام بليغ أنه يجمع في كل معنى يطرقه بين الوفاء بحق المعنى، وحق الصياغة وتناسب الفواصل، ولم يخل بحق أي من العنصرين ولو مرة واحدة... ولا يجوز أن يقال إن القرآن يختار الكلمة أو الأسلوب أو العبارة مراعاة لتناسب الفواصل وحده، ولا لبلاغة المعنى وحده، بل الذي يليق بكماله وجلاله أن يقال: إنه يختار ما يختار من ذلك لأنه الأبلغ في موضعه، والأوفق في نسقه". التناسب البياني في القرآن: دراسة في النظم المعنوي والصوتي، الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ط1، 1992. ص349- 372.
([14]). الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م، س، ص469.
([17]). السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق: أحمد شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية.
([18]). ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص165-166.
([19]) الرازي، التفسير الكبير، ج8، ص420.
([20]) أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج8، ص480.
([21]) الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، مصر: دار المعارف، ط 1978، ص57.
([22]) المرجع نفسه، ص111– 112.
([25]) ابن خلدون، المقدمة، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، مصر: دار نهضة/القاهرة، ط3، 1979، ج3، ص1276.
([26]) هذا الحديث يروى بألفاظ مختلفة، ففي رواية مسلم نجد فقال رسول الله:"إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع". وفي رواية أخرى: "أسجع كسجع الأعراب". انظر: "صحيح مسلم بشرح الإمام النووي"، "كتاب القسامة"، باب 12، مراجعة الشيخ خليل، بيروت: دار القلم، ط1، 1967، ج11، ص 188-189. وانظر "سنن النسائي بشرح السيوطي"، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1979، ج8، ص48-49. وانظر: أبو الطيب آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، باب دية الجنين، م 12، بيروت: دار الفكر، ط3، 1979، ص311. وانظر "مسند الإمام أحمد"، ج4، ص245-246.
والجدير بالذكر أن علماء الحديث قرأوا هذه النصوص قراءة مغايرة للتصور المقترح من قبل الباقلاني. فالنووي يقول معلقا: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، وفي الرواية الأخرى أسجع كسجع الأعراب، فقال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: أحدهما؛ أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، والثاني؛ أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان، وأما السجع الذي كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث، فليس من هذا لأنه لا يعارض به من حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهي فيه، بل هو حسن. (صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص191).
ويقول السيوطي: "وقال الخطابي: لم يعنه بمجرد السجع، بل لما تضمنه سجعه من الباطل، وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب ليميلوا إليها، وإلا فالسجع في موضع الحق جاء كثيرا، قلت: والظاهر أن ما جاء جاء عفوا، والقصد إليه غير لائق مطلقا والله تعالى أعلم". (سنن النسائي بشرح السيوطي ج8، ص48-49). وفي السياق نفسه، نستحضر كلام أبي الطيب آبادي في شرحه للحديث فهو يقول: "وإنما أنكره وذمه، صلى الله عليه وسلم، لأنه عارض به حكم الشرع، ورام إبطاله، ولأنه تكلفه في مخاطبته".
ومن عجب أن هذه الرؤية الأصولية تظهر عند علماء الحديث أكثر من ظهورها عند النقاد، مما يقدم ملحظا منهجيا ومعرفيا، وهو أن النتائج الطيبة في علم من العلوم قد تظهر عند غير المختصين في ذلك العلم، مما يعني أن التخصص ليس شرطا في التوصل إلى ملاحظ دقيقة في علم من العلوم.
([27]) يمثل الباقلاني الموقف الانطباعي الذاتي؛ لأن حرصه على تفرد القرآني فرض عليه نفي كل ما من شأنه أن يوقع شبها بينه وبين النصوص الأخرى، بالإضافة إلى أنه كان متأثرا بالطعون الموجهة للقرآن تأثيرا بليغا، وقد برز هذا في استجابته لضعيف الذوق الذي لم يحترم نفسه، ولا عقله، عندما فضل الشعر الجاهلي على القرآن، فراح يدمر قصيدة امرئ القيس تدميرا لم يكن في حاجة إليه. انظر: إعجاز القرآن، م، س، ص160 وما بعدها.
([28]). الشريف حاتم بن عارف العوني، تكوين ملكة التفسير، الرياض: مركز نماء للبحوث والدراسات، ط1، 2013، ص50-51.
([29]) الباقلاني، إعجاز القرآن، ص 159.
([30]) الجاحظ، البيان والتبيين، بيروت: دار الكتب العلمية، ج1، ص159.
([31]) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، ط 1981، ج3، ص18 وما بعدها. وانظر، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، لصاحبه: عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، 1985، ص211.
([32]) البيان والتبيين، م، س، ص159.
([33]) العلوي اليمني، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1982، ج3، ص19-20.
([34]) أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: مفيد قميحة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1981، ص286-287. وانظر: ابن وهب، نقد النثر، المنسوب لقدامة بن جفر، ص197-199، وابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقيق: علي فودة، مصر: المطبعة الرحمانية، ط 1932، ص165-166. وانظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طيانة، القاهرة: دار نهضة مصر، د. ت،، فهو يقول: "وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة، ولا أرى لذلك وجها سوى عجزهم أن يأتوا به وإلا فلو كان مذموما لما ورد في القرآن الكريم، فإنه قد أتى منه بالكثير، حتى إنه ليأتي بالسورة جميعا مسجوعة كسورة "الرحمن" وسورة "القمر" وغيرهما، وبالجملة، فلم تخل منه سورة من السور"،ج1، ص210. والملاحظ أن ابن الأثير يوجه النهي في حديث الجنين إلى الحكم المتضمن في حكم الكاهن "فالسجع الذي أتى به ذلك الرجل لا بأس به، وليس بمنكر لنفسه، وأما المنكر هو الحكم الذي تضمنه في امتناع الكاهن أن يدي الجنين بغرة أو أمة"، ج1، ص212. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه "عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي" انظر: البيان والتبيين، م، س، ج1، ص158.
([35]) وهو نفس اعتراض أبي هلال العسكري، الصناعتين، ص286-287. وابن الأثير، المثل السائر، ج1، ص211.
([36]) من مقدمة السيد أحمد صقر لتحقيق كتاب: إعجاز القرآن، م، س، ص75.
([38]) نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 1991، ص144-145.
([39]) محمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن"، بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1986، ص197-198.
([40]) ابن وهب، نقد النثر، المنسوب لقدامة بن جعفر، دار الكتب العلمية، ص107-109.
([41]) ابن الأثير، المثل السائر، ج:2، ص 64-65.
([43]) محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية، م، س، ص85.
([44]) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تصحيح: محمد رشيد رضا، بيروت: دار المعرفة، ط 1978، ص401.
([46]) نقصد بالقراءة الأصولية دراسة الأحاديث وتفسيرها في ضوء القواعد المعتبرة عند الأصوليين، دون الاقتصار على ظاهر اللفظ الذي قد لا يكون مقصودا أو قد يكون في حاجة إلى تقييد مطلقه، أو تخصيص عمومه،أو بيان مجمله، وللتمثيل، نقدم قراءة أصولية لحديث يروى في كراهية الشعر، قام بها الإمام النووي، وهي نموذج لما يتعين القيام به تجاه مختلف الأحاديث الواردة في موضوع الفنون السمعية والبصرية.
فأما الحديث، فهو الذي يرويه أبو سعيد الخدري قال: بينما نحن نسير مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالعرج؛ إذ عرض شاعر ينشد، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قبحا خيرا له من أن يمتلئ شعراء"، وأما قراءة الإمام النووي فهي كالتالي: يقول: "واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا، قليله وكثيره، وإن كان لا فحش فيه... وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشده شيطانا، فلعله كان كافرا، أو كان الشعر هو الغالب عليه، أو كان شعره هذا من المذموم، وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها، ولا عموم لها، فلا يحتج بها والله أعلم، مطبقا في ذلك القاعدة التي تنص على أنه ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. انظر: صحيح مسلم النووي، بيروت: دار الفكر، ط3، 1978. م8، ج15، ص14-15.
([47]) دلائل الإعجاز، م، س، ص20.
([49]) محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية، م، س، ص85.