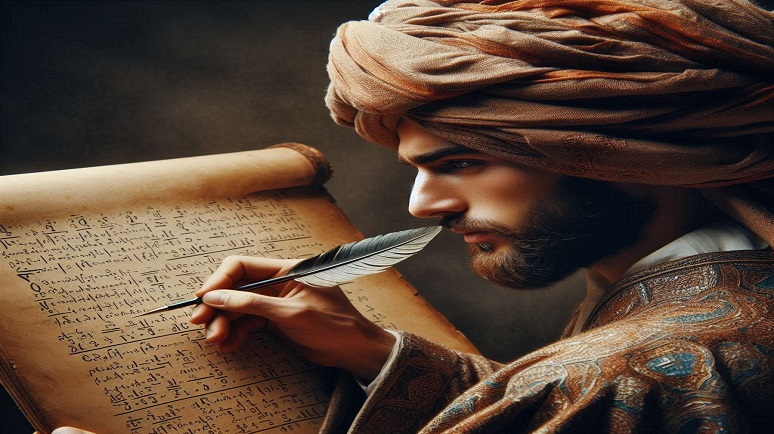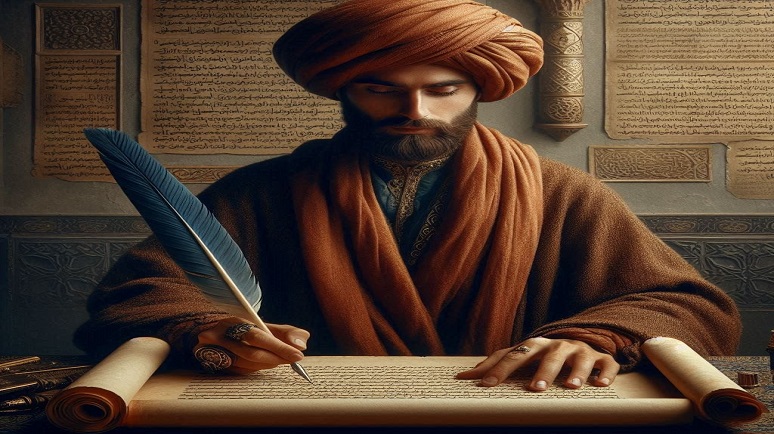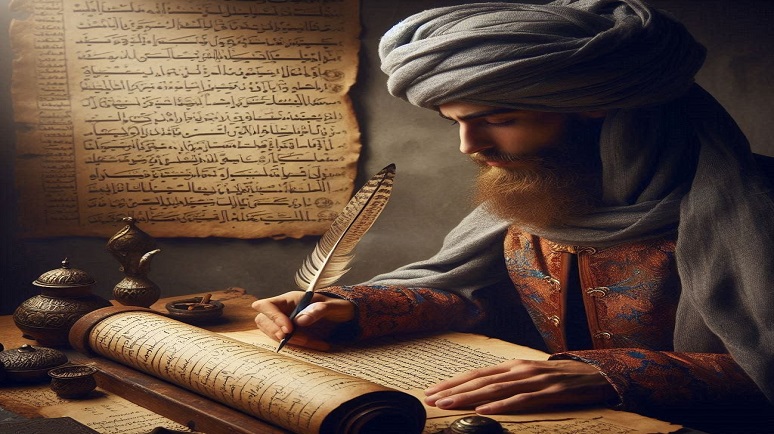محطات من تاريخ الطب في المغرب الأقصى (الحلقة الأولى)

الدكتور جمال بامي
رئيس مركز ابن البنا المراكشي
إن العلاج الطبي العلمي بالمغرب قد أسس في مجمله على مبادئ ومناهج وتقنيات علمية، كان للنهضة العلمية الأندلسية في مجالي الطب والفلاحة أثر كبير فيها. ولعل في إقدام الحكم المستنصر على إقامة خزانة متخصصة بالقصر للطب لم يكن قط مثلها، ما يكشف ليس فقط على غزارة ما وضعه الأندلسيون من مصنفات في الطب، بل وكذلك عن حجم ما تراكم لديهم مما جمعوه من كتب في هذا الميدان، دون ذكر ما يند عن الحصر من المصنفات والتقاييد التي يحتفظ بها الطبيب في خزانة كتبه الخاصة.
ومن خلال إخضاع عينة من الإرث الطبي المحفوظ للدرس والتحليل، يتجلى تعدد المواضيع وتنوع المستويات التي طالها الاهتمام، فبصرف النظر عما يتعلق بفصول المعالجة يذكر فيها السبب والعلامات والعلاج لما يتعلق بظاهر البدن وباطنه من أمراض، وما كتب في مجال الوقاية “لحفظ الصحة في الفصول“، وفي الفصد والحجامة، والجراحة والتشريح والتخدير، تجردت المصنفات الطبية العامة للبحث في خصائص الجسم عموما وفي الاختلافات حسب السن، كما وجه الاهتمام للبحث في تنوع الأجناس، وفي قوى الجسم الطبيعية والنفسية، وتأثير الاختلافات المناخية والإقليمية، وفي أثر الأغذية والأشربة، والمحيط البيئي العام. وأفردت مصنفات لذكر مختلف أعضاء البدن، وبتحديد أنواع الأمراض الخاصة بكل عضو على حدة، ووصف أشكال العلاج المتاحة في الحالات العادية والمستعصية، وكذا حصر إمكانات ووسائل الوقاية مما يند عن الحصر من الأمراض، إضافة إلى تتبع “العلل المعروفة من رأس الإنسان إلى قدميه” بالدراسة والتفصيل”[1].
وبرغم استمرار الخلاف بين الأطباء المغاربة حول إدراج المستوى النفسي في التطبيب، فسرعان ما تأكد -وإن بشكل تدريجي- كتخصص مستقل ضمن الممارسة الطبية، بالمشرق والمغرب على السواء. وهو الفرع الذي نعث حينا باسم “الطب الروحاني“، وحينا باسم “الطب الحسي والمعنوي“، وأحيانا باسم “طب النفس ومداواة الأخلاق”[2].
إن الدول التي تعاقبت على حكم المغرب قد اهتمت بتوفير نوع من العلاج مؤسس على العلم والتجربة، وذلك عن طريق تأسيس المارستانات وتنظيم التعليم الطبي؛ يقول عبد الواحد المراكشي متحدثا عن المارستان الذي أسسه يعقوب المنصور بمراكش: “لم يقصره على الفقراء دون الأغنياء، بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو يموت”[3].
بجانب هذه المؤسسات الاستشفائية نجد أيضا أطباء كانوا يعملون لحسابهم الخاص، ويبدو أن أجرة هؤلاء كانت مرتفعة، فمثلا بلغت أجرة الطبيب ابن أفلاطون بفاس مائة ألف دينار[4]. وكان أغلبهم يستقر بالمدن الكبرى، كفاس ومراكش، وسبتة، كما كان أغلب ممتهني هذه الحرفة من أهل الذمة[5]، لهذا دعى العبدري “طلبة العلم ومن فيه أهلية للفهم والمعرفة أن يشتغل به من المسلمين“[6].
وازدهر علم الأغذية بشكل ملفت للنظر، فهذا ابن زهر –طبيب البلاط الموحدي- في كتابه “الأغذية” يقول أن من خاصية لحم الدجاج “أن أمراقها متى شربت تفايا عدلت المزاج وكذلك تسقيها لمن ظهر عليه الجذام، وهذه اللحوم كلها نافعة[7]، أما العصافير (..) فكلها نافعة من الفالج واللقوة وللبصابص قوة في تفتيت الحصى، والخرنوب يجب أن يأكله من به إسهال في أول طعامه[8]. وحظيت الأعشاب والنباتات البرية بمكانة بارزة في هذا الصنف من العلاج، واعتبرت المصدر الرئيسي في صناعة الدواء، ويذكر صاحب كتاب “الاستبصار” أن في جبل فازاز “أنواع النباتات من العقاقير التي تنصرف في العلاجات الرفيعة“[9].
وقد انتشرت كثير من المحلات المتخصصة في بيعها، إلا أن بعض العطارين أساءوا استخدام هذه الأعشاب، مما أثار حفيظة بعض المحتسبين، كالسقطي الذي طالب بضرورة مراقبتهم والتشدد معهم[10]. وأعطى العبدري أمثلة لبعض أنواع الغش، التي كانت تطال صناعة الأدوية والعقاقير، من ذلك أنه “إذا أفتى الطبيب مثلا بأوقية من شراب الورد أعطاه الشرابي شرابا عقد منه بالماء شرابا لا طعم للورد فيه، وكذلك يفعلون بشراب الأسطوخودس وغيره (..) فلا ينفع المريض بشيء[11].
ويبدو أن إقبال الناس على هذا النوع من العلاج كان ضعيفا لارتفاع تكلفته[12]، من جهة، وتحفظ الناس من التداوي عند الذمي؛ لأن دواء اليهودي أو النصراني مضنون“[13]. وقد حظي الطب بقسط وافر من اهتمام جامعة القرويين بالعلوم التطبيقية باعتبار أن للطب نوعا من القداسة جعلت منه طرفا من العلوم الإسلامية[14].
إن إسهام جامعة القرويين النوعي في الطب قد أتاح للثقافة المغربية ممارسات عملية وعلمية ضمنت حضورا مزدهرا منذ وقت مبكر بدءا من القرن العاشر الميلادي / الرابع الهجري، وقد لاحظ لوكلير Leclerc في هذا الصدد أن المغرب أشد بلاد الإسلام عمقا من الناحية العلمية[15]..
لقد كان للطب في العصر الموحدي مكانة كبرى في الدولة والمجتمع، وقد اهتم به الموحدون، وبخاصة يوسف ويعقوب، اهتماما كبيرا، فقد بنوا المستشفيات ونظموا هذه المهنة وجعلوا لها رؤساء، منهم أبو جعفر الذهبي الذي كان مزوارا للأطباء”[16]، وكان الطب يدرس على عهدهم بالمغرب، ومن أساتذته أبو الحجاج يوسف المريبطري[17]، أما فن الصيدلة فكان له هو الآخر ازدهار على هذا العهد، وكان موظفا بمستشفى مراكش وببلاطات الخلفاء عدد من الصيادلة[18]..
من رجالات الطب والصيدلة خلال العهد الموحدي الطبيب السبتي أبو الحسن علي بن يقظان[19]، وأبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمان بن بقي السلوي تـ 563هـ، اشتغل بالطب وظهر فيه[20]، والشريف الإدريسي مؤلف كتاب “الجامع لصفات أشتات النبات“، وهو أحد الكتب التي اعتمدها ابن البيطار في كتابه “الجامع“، كما ألف كتابا في الأقراباذين “الصيدلة“[21]، والطبيب سعيد الغماري، وأبو الحجاج يوسف بن فتوح القرشي المري، توفي 561هـ، له معرفة بالنبات كان يجلبه ويتجر فيه[22].
زيادة على هؤلاء فقد كان بالمغرب في هذا العهد عدد وفير من الأطباء، والصيادلة برسم خدمة خلفاء الموحدين، وبرسم خدمة المارستانات، منهم أبو مروان عبد الملك بن زهر الاشبيلي تـ 557هـ، ألف لعبد المؤمن بن علي الترياق السبعيني، كما ألف له كتابا في الأغذية[23]. وقد أثر ابن زهر هذا أثرا بليغا في الطب الأوربي، وظل هذا التأثير إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي، وذلك بفضل ترجمة كتبه إلى العبرية واللاتينية[24].
من الأطباء أيضا الوزير أبو بكر ابن طفيل القيسي الودآشي تـ 581هـ، وأبو الوليد ابن رشد استدعاه يوسف الموحدي إلى سكنى مراكش سنة 578هـ برسم الطب[25]، وأبو جعفر أحمد بن حسان القضاعي البلنسي تـ 598هـ، الذي ألف كتاب”تدبير الصحة”[26] وأبو جعفر بن الغزال المري، كان المنصور يعتمد عليه في الأدوية المركبة والمعاجين، ويتناولها منه[27]، وأبو بكر محمد بن الحفيد أبي بكر ابن زهر 577-602هـ[28] وأبو محمد عبد الله بن أبي الوليد ابن رشد الحفيد[29]. واختص حريم الخلفاء بطبيبات لأنفسهن، ومن هؤلاء أخت الحفيد أبي بكر ابن زهر وبنتها، كانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة ولهما خبرة جيدة بما يتعلق بمداواة النساء..”[30].
وقد عرف خلال العصر الموحدي مرفق يعرف باسم “بيت الأشربة والمعاجين الطبية“، وقد كان خاصا بخلفاء الموحدين، وهو من مظاهر تنظيم الطب في عهدهم، وقد تولاه أيام يوسف، أبو محمد قاسم الإشبيلي، وتولاه أيام يعقوب، أبو يحيى بن قاسم المذكور، وبقي في وظيفته هذه إلى أن توفي أيام المستنصر، فجعل ولده في موضعه عوضا عنه[31].
واهتم الموحدون بشكل كبير بالمستشفيات، فقد أسس يعقوب المنصور مارستانات للمرضى والمجانين وأجرى الإنفاق على أهلها[32]؛ قال عبد الواحد المراكشي وبنى -يعقوب المنصور- بمدينة مراكش البيمارستان ما أظن أن في الدنيا مثله وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه، فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح، وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات، وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوت، زيادة على أربع برك في وسطه إحداها رخام أبيض، ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بما يزيد على الوصف ويأتي فوق النعت، وأجرى ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة، خارجا عما جلب إليه من الأدوية. وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال، وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء.
فإذا برئ المريض فإن كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل، وإن كان غنيا دفع إليه ماله وتركته وسببه ولم يقصر على الفقراء دون الأغنياء بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولج، على أن يستريح أو يموت، وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله ويعود المرضى ويسأل عن أهل بيت أهل بيت يقول كيف حالكم وكيف القومة عليكم؟ إلى غير ذلك من السؤال ثم يخرج، ولم يزل مستمرا على هذا إلى أن مات رحمه الله[33].
جاء في روض القرطاس[34] أنه في سنة 571هـ كان الطاعون الشديد بمراكش وأحوازها، فكان الرجل لا يخرج من منزله حتى يكتب اسمه ونسبه وموضعه في براءة ويجعلها في جيبه، فإن مات حمل إلى موضعه وأهله، وهذا النوع من “الكارني” الذي سبق الموحدون إلى استعماله كاف في الإعراب على عظمة الموحدين في ميداني الابتكار والنظام في مجال الطب[35].
إننا بلا شك إزاء نهضة طبية وصيدلية ملموسة المقاصد والأبعاد، يشهد على ذلك عدد الأطباء وقيمة مؤلفاتهم وعدد المستشفيات والمارستانات المنظمة وفق تنظيم دقيق، وليس غريبا أن يوازي هذا التقدم في الطب تشجيع الحركة العلمية بشكل عام خصوصا في العلوم الكونية والعلوم الفلسفية..
في ذروة هذا الازدهار الموحدي في مجال الطب ظهر مؤلف تصنيفي للمادة النباتية كتبه عالم إشبيلي قام بعمل ميداني في الغرب الإسلامي، هو أبو الخير الإشبيلي صاحب “عمدة الطبيب في معرفة النبات“؛ وهو الكتاب الذي خصصته بدراسة منشورة حول منهجه ومادته العلمية وقيمته المضافة[36].
يتبع في العدد المقبل..
—————————————-
- أحمد الطاهري. الطب والفلاحة في الأندلس بين الحكمة والتجريب. مطبعة النجاح الجديدة. 1997. ص: 41-42.
- نفس المرجع. ص: 43-44.
- عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: 412.
- ابن الزيات التادلي، التشوف إلى رجال التصوف ص: 269.
- عبد الرحمن البشير، اليهود في المغرب العربي (22 – 462 هـ / 642 – 1070 م) دار تارنيت للطباعة مصر، 2001، ص: 98.
- ابن الحاج العبدري المالكي الفاسي، المدخل. مكتبة دار التراث، القاهرة، ج: 4، ص: 140.
- الأغذية، ص: 17.
- نفسه. ص: 54.
- الاستبصار، ص: 187.
- أدب الحسبة، ص: 45.
- المدخل، ج: 4، ص: 143.
- أحمد المحمودي: عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي. جامة المولى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، 2001، ص: 106.
- ابن الزيات، التشوف، ص: 123؛ إبراهيم القادري بوتشيش الجاليات المسيحية بالمغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين، دار الطليعة، بيروت، 1994، ص: 102.
- تعليم الطب بالمغرب والعالم الإسلامي، عبد العزيز بنعبد الله، مجلة أكاديمية المملكة المغربية، ع 15، دجنبر 1988، ص: 25.
- L. Leclerc, l’histoire de la médecine arabe وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط 1980، وانظر: م.س، ص: 31.
- طبقات الأطباء، “2” 77.
- المصدر المذكور، “2” 81.
- المنوني، محمد.العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، الطبعة الثانية الرباط 1397 هـ.
- جمال الدين أبي الحسن علي بن القفطي. أخبار العلماء بأخبار الحكماء، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى. 1326هـ. “3”، 160.
- الضبي في البغية 1464، والتكملة 2782.
- أحمد المقري، نفح الطيب، “2” 44 و 138.
- ابن الأبار القضاعي البلنسي، التكملة لكتاب الصلة، المحقق: عبد السلام الهراس، الناشر: دار الفكر للطباعة لبنان، 1995 – 2079، ابن بشكوال، بن عبد الملك. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، عني بنشره وصححه وراجع أصله، السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: مكتبة الخانجي، الطبعة: الثانية، 1955- 410.
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، “2” 66؛ التكملة 1717.
- دائرة المعارف الإسلامية، مجلد، “1” ع “3”.
- ابن أبي زرع، روض القرطاس، 131 و 137 طبقات ط “2” 76.
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، “2” 79.
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، “2” 80.
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، “2” 74.
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، “2” 78
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، “2” 70.
- محمد المنوني، مرجع سابق.
- القرطاس، 138.
- المعجب، 190 – 191.
- روض القرطاس، ص: 171- 172.
- العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، لمحمد المنوني، الطبعة الثانية الرباط، 1397هـ/ 1977م.
- جمال بامي: دراسة في كتابي عمدة الطبيب لأبي الخير الإشبيلي وحديقة الأزهار للوزير الغساني. هاديات من التراث لتطوير علم النبات الطبي بالمغرب. الرابطة المحمدية للعلماء. دار أبي رقراق، 2012.