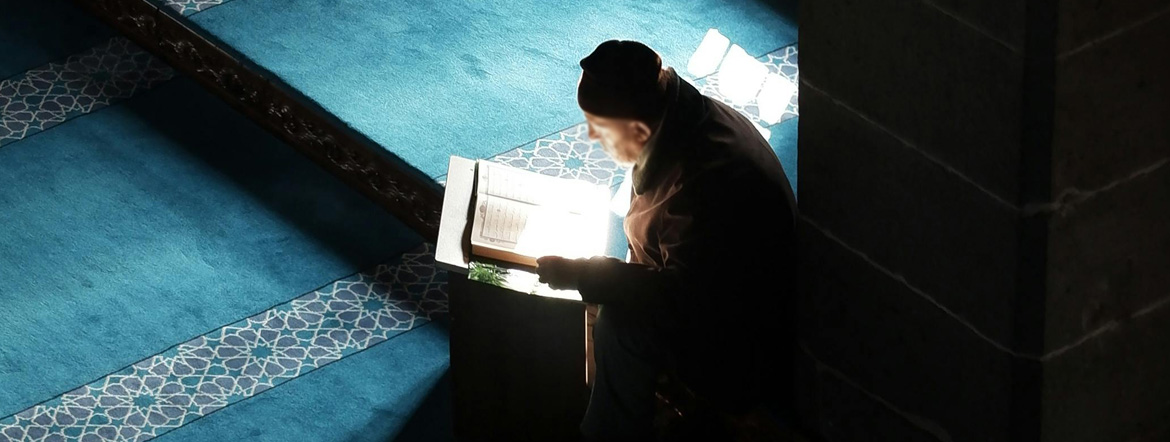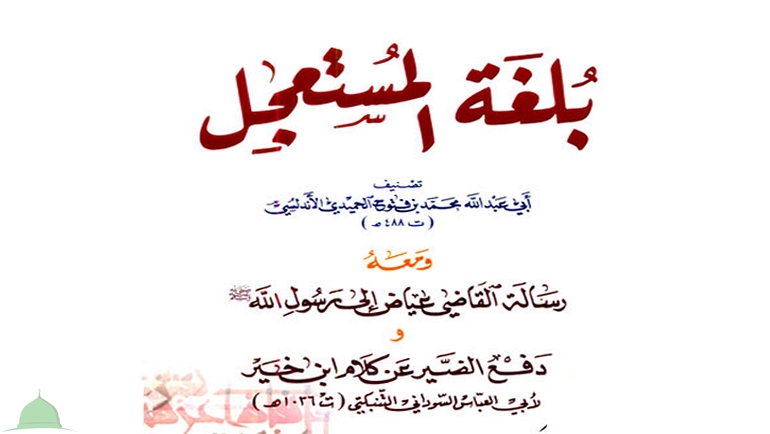شكل المجال الفقهي بعدا محوريا في مجال التداول، باعتبار أن السلطة العلمية كانت عنصرا أساسيا داخل السلطة السياسية، ما جعل «مؤسسة الفقيه» تصير عاملا في تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي والمعرفي والأخلاقي...، لأن الفقهاء في هذه الحقبة خاصة، كانوا المرجع أو الخلفية الإيديولوجية للمنظومة السياسية. وقد لاحظنا أن سقوط السلطة السياسة يستتبع تغير المنظومة المعرفية، والاختيارات المرجعية في «الهوية» أو«الثوابت»، وهو ما يؤكد قضية «التعالق» بين مجال الدين ومجال السياسية الذي يحكم تصور القادة السياسيين. وهذا ليس أمرا بدعا في استناد الأمر التدبيري إلى مرجعية الحكم الشرعي، أو الاجتهاد الفقهي، إذ الأصل -في مجالنا الإسلامي- أن يحصل التطابق بين السلوك والخلق، والسياسة والدين، والفعل والقيمة، وإنما الإشكال يبرز من خلال العمل على تصيير الدين جزءا من التدبير السياسي، أو أن يستولي التسييس على التخليق. وقد تبين سالفا أن كل منظومة معرفية إلا وضاقت بالأخرى، بل تم إخراج كل طرف للآخر من مجال الدين، وذلك من خلال أسباب فروعية ليست بالقوة التي يلزمها «الحكم بالتكفير». فاستمر الأمر على ذلك إلى أن برز عنصر آخر متمثلا في «التصوف»، لتصبح عناصر التأثير ثلاثية، السلطة السياسية /السلطة العلمية/ التصوف، كما عرف العنصران الأخيران أيضا اختلافا ظاهرا، غير أن هذا الاختلاف ليس بنيويا داخل هذين المجالين، وإنما أدت إليه عوامل خارجية، «فالفقه والتصوف عنصران أساسيان في تكييف المجتمع المغربي وتسييره» [1]. على أساس أن نظر الصوفي قائم على تحرير «قضية الباطن»، في حين أن الفقيه يرمي إلى مجال الحدود والأحكام، وهما أمران صنوان لتحقيق منطق السَّواء. ولأمر تحصيل هذه الأحكام الأخلاقية، والمعاني الروحية السامية، كان لابد من إرجاع الدلالة إلى أصلها، وتجاوز منطق التجزيء الذي عمل على إحداثه مدلول «الاصطلاح»، ليس من خلال إعمال الفكر أو النظر المجرد، وإنما عن طريق التجربة الحية، والممارسة العملية. على أن اسم الفقه في العصر الأول كان يطلق «على علم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة حقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب»، ليصير دالا على معرفة الفروع الغريبة في الفتاوى، واستكثار الكلام فيها، وحفظ المقالات المتعلقة بها [2]. وهو ما جعل حجة الإسلام يثير قضية «الإحياء»، لإعادة صياغة العلم الشرعي وفق منطق الظاهر والباطن، بالاعتناء بالأصول الروحية، والقواعد الأخلاقية، باعتبارها المُوجِّه للتصرفات البرانية، ولأجل الخروج عن هذه المراسم، كان لابد من مقاربة عملية، تصبو إلى تشييد الذات (الإنسان) من الداخل وليس العكس، وذلك عن طريق التحقق بالأخلاق، وملابسة الذوق للوجدان، والوقوف على بساط الفقر والاحتياج، بــتفريغ المحل من الأوهام والتمثلات. وهو الأمر الذي جعل رجالات من العلم الكسبي يسلكون الطريق الصوفي، لاستكمال التفقـه في أحكام «الفقــه الباطن»، ك: ابن حرزهم، وابن النحوي، والهسكوري، وأبي الوكيل... وغيرهم، باعتبار أن الأوصاف الجوانية هي أصل الأفعال البرانية، لذا أثر عن عدة شخصيات من رجالات العلم أخذهم الطريق الصوفي عن رجالات التصوف، كما هو حال أبي مدين مع أبي يعزى [3].
فعندما صار «فقه مالك» مطية لنيل المناصب العليا والإثراء السريع، انبرى رجال التصوف وفق هذا السياق إلى إقرار علوم التصوف ممثلا في «رعاية المحاسبي»، وذلك أن المصامدة لما أخذوا الفقه عن الصوفي عبد العزيز التونسي، عادوا إلى بلادهم فسادوا في أقوامهم بما تعلموه من الفقه، وصاروا قضاة وشهودا وخطباء وغير ذلك من المراتب، حينما كان شيخهم المذكور في سياحته إلى أقصى أرض المغرب، وجد تلامذته قد نالوا الخطط والمراتب بما تعلموه، فقطع تدريس الفقه وأمر بالنظر إلى كتاب الرعاية ونحوها من كتب التصوف، إلى أن عثر على بعض تلامذته وقد وقعوا من جهل الفقه في الربا، فقال: سبحان الله كرهت تدريس الفقه خوفا من أن تنال به الدنيا، فضيعتم معرفة الحلال والحرام، فعاد إلى تدريس الفقه[4]. وهو ما يؤكــد أن معظم صوفية المغرب امتازوا بكونهم كانوا من أهل العلم بأصول الدين وفروعه [5]. لذلك لم يكن الصدام بينهم وبين فقهاء عصرهم بالحدة التي في المشرق، على أن الخلاف الحاصل بين الفقهاء ورجال التصوف قد يكون جزء منه متعلقا بالجانب المعرفي، من منطلق التنازع حول تفسير السلوك الصوفي من الناحية العلمية، على اعتبار أن النشاط الصوفي ينحو إلى استخدام «طاقة التأويل» الذي يبرع فيه. إلا أن مجال الفرق بين الفريقين، لا يكمن فقط في وجود الدليل وعدمه، وإنما في العمق النفسي للناظر في الأدلة، فالبعد الروحي للصوفي هو الذي يعطي للكلمة مدلولها المناسب، والشحنة الروحية، أو القوة الروحية التي يضفيها رجال التصوف هي التي تشكل الفارق بين الطرفين، فالمشكل إذن يكمن في كيفية فهم الدليل ومدى تذوقه [6] كما أن سياق القرن السادس الهجري، والصراع حول السلطة أدى إلى هذه المواجهة، بالنظر إلى كون الفقهاء كانوا جزءا من النظام السياسي. وإذا نحن طرحنا مسألة السياق، وجدنا أن «علم التصوف وعلم الفقه» يصيران إلى التكامل أقوى مما يصيران إلى التقاطع، باعتبار أن الشريعة جاءت لإصلاح الظاهر والباطن، فإن عددا من مشايخ التصوف دخلوا إلى الطريق الصوفي ك فقهاء مريدين، كما أن من رجال التصوف من كان يرسل مريديه إلى الفقهاء بقصد تلقي الفتاوى عنهم.
إن عددا كبيرا من رجال التصوف كان لهم حظ وافر من العلوم، خصوصا منها المتعلقة بالفروع الفقهية، فلا غرابة أن نجد أغلب تراجم المستفاد جمعوا بين التصوف والفقه، واشتغلوا بمختلف العلوم، وتبحروا في بعضها بصفة خاصة، بل أغلبهم كانوا شيوخا فقهاء، وأساتذة كما ينعتهم التميمي، اشتغلوا بتدريس الفقه وتعليم القرآن...بما يمكن القول: إن التصوف قد أصبح إلى جانب الفقه (وليس على حسابه) من أهم دعائم بنية المجتمع المغربي الفكرية [7]. فقد تميزت حركة أبي يعزى بخصوص علاقتها بالفقهاء... فقد ربط بينهما ميثاق من الاحترام المتبادل، فأبو يعزى كان يعظم الفقهاء كثيرا، منهم حرز الأوربي، وأبو الربيع عثمان السلالجي، وكان الفقهاء يبادلون الرجل التوقير [8].كما أن أبا مدين كان مرجعا في الاستفتاء فيما يخص علوم الشريعة والحقيقة، كان مالكيا ترد عليه الفتاوى في مذهب مالك، لم يتجرأ بالرغم من الرقائق والحقائق التي هام بها أن يتحلل من مذهبه، وقد يكون اعتصامه بالمذهب المالكي السبب الرئيس الذي من أجله دعته السلطات إلى مراكش قصد معاينته، وكان الوقت قد اتسم يومئذ بالإنكار على التمذهب الفقهي، وخفي فيه صوت المالكية [9] وكان أبو عبد الله أمغار يحفظ المدونة ، وعنايته بالمدونة لم تزده إلا توطيدا في العلاقة بينه وبين السلطة المرابطية، التي جعلت من المذهب المالكي ركيزة سامية في ميدان التعليم والتوعية الدينية [10]، وأبو محمد الهسكوري كان من حفاظ مذهب مالك، ويقال إنه درس الفقه على عبد العزيز التونسي بأغمات [11]، وأبو الوكيل ابن تيكرت كان من العلماء العارفين بمذهب مالك [12]، كل هذه المرويات تدل على أن قضية معاداة الصوفية للفقهاء، أو للعلماء على اختلاف مجالاتهم، هي من المسائل غير الدقيقة، فليس الصوفية ممن حاولوا إقامة علمهم من أجل محاربة الفقهاء [13]، وإنما أقاموا علمهم من أجل إتمام «علم الفقه»، إذ لا سلوك في طريق القوم -على ما عبر عنه رجال التصوف- إلا بتلازم الباطن والظاهر، أو بتطابق الحكمة والحكم.
الهـــــوامــــــــــــش
[1] علال الفاسي: التصوف الإسلامي في المغرب، (ص 95).
[2] الغزالي: إحياء علوم الدين، (1/49).
[3] التليدي: المطرب بمشاهير أولياء المغرب، (ص 20). فعلى الرغم من كون أبي يعزى أميا، إلا أنه كان له الحظ الأعظم في طريق القوم، واللافت أن أبا مدين لم يتخل عن العلم الكسبي، على الرغم من أمية الشيخ، بما يعطي الدلالة على أن التصوف لا يناقض العلم، وإنما على العكس يربي العلم.
[4] التادلي: التشوف، (ص 93).
[5] الغرميني: الصوفي والآخر، (ص 94).
[6]المرجع نفسه، (ص 96).
[7]المستفاد (الدراسة)، (ص 201-202-203).
[8] الغرميني: المدارس الصوفية، (ص 290). أنس الفقير وعز الحقير، (ص 60). كان أبو يعزى يقول عندما يرى الفقهاء: مرحبا بموالينا، مرحبا بمصابيح الدنيا. في إشارة إلى تعظيمهم وتوقيرهم.
[9] المقري: نفح الطيب، (7/137). الغرميني: المدارس الصوفية، (ص 290).
[10] الغرميني: المدارس الصوفية، (ص 276).
[11] التادلي: التشوف، (ص 152).
[12] المصدر نفسه، (ص 193).
[13] محمد جلال: دراسات في التصوف الإسلامي، (ص 16). عبد المجيد الصغير: خصوصية التجربة الصوفية، (ص 24-25).