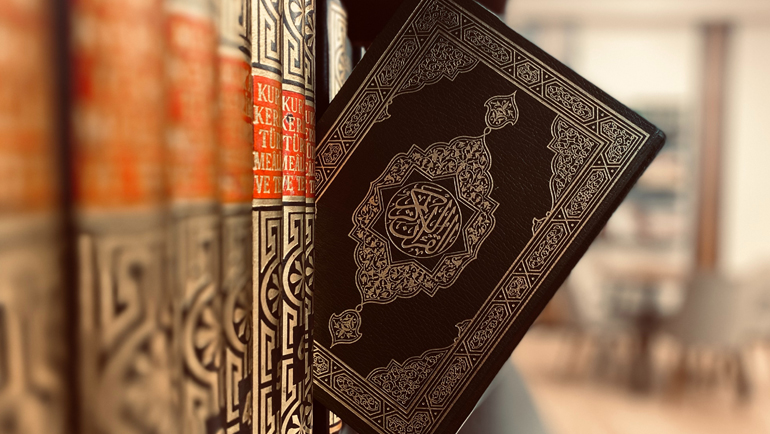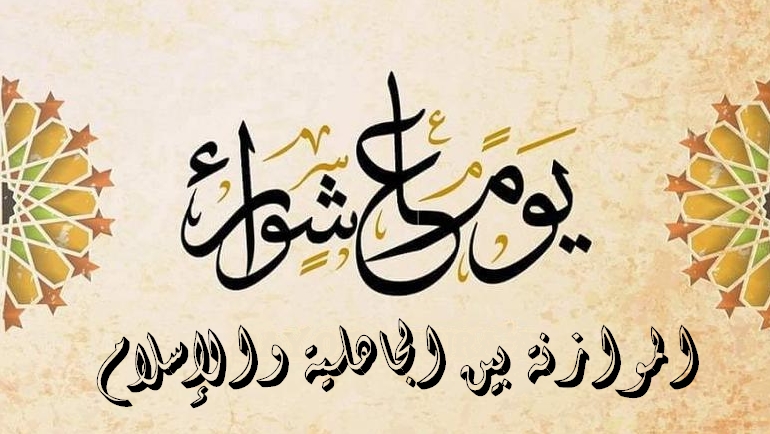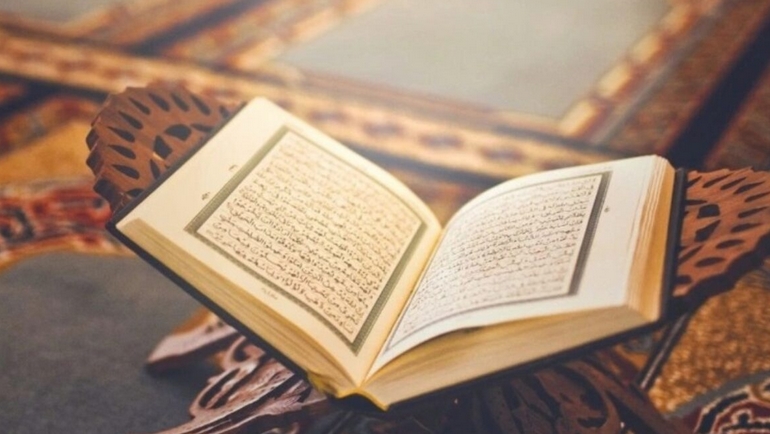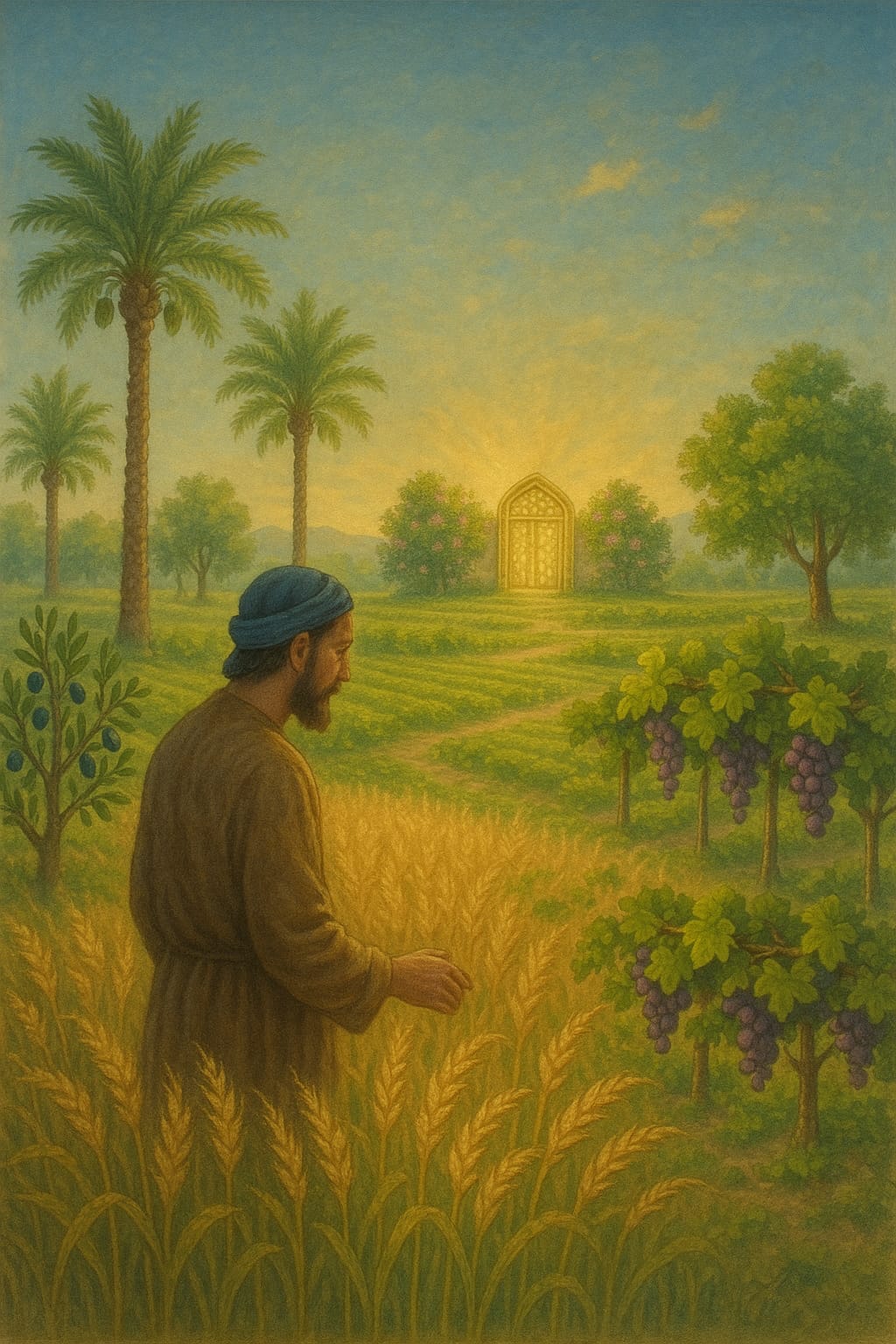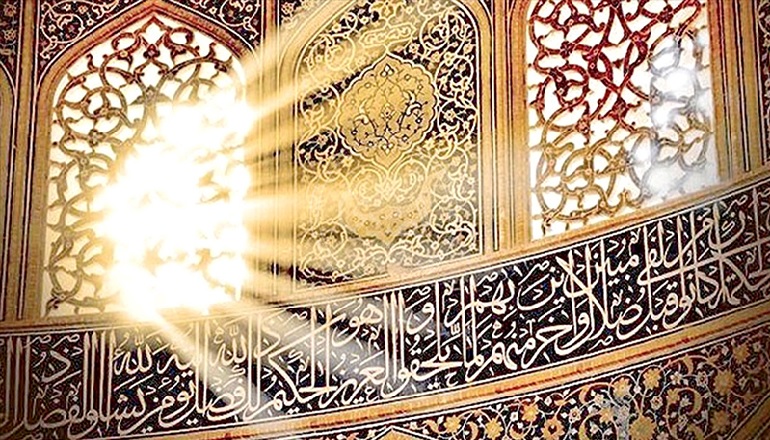ظاهرة التضاد في القرآن الكريم –دراسة إحصائية مع عرض آراء اللغويين ومواقف المفسرين –
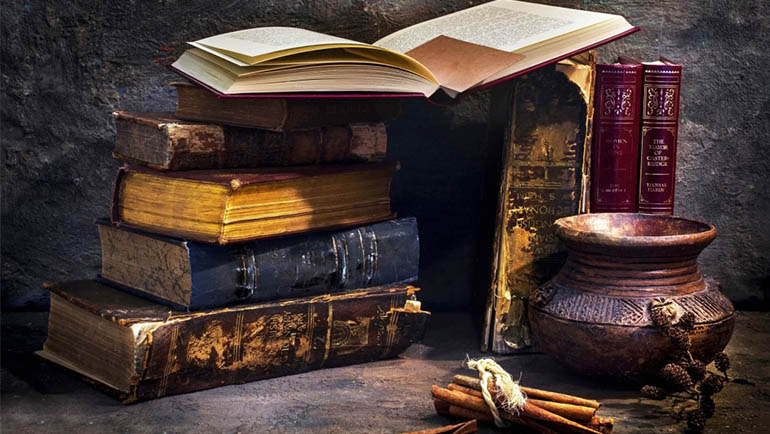
إن من المسائل اللغوية والقضايا المعجمية ظاهرة التضادِّ؛ وهو إطلاق اللفظ على معنيين متضادين، ومدلولين متناقضين، كإطلاق الجون على الأسود والأبيض، وإطلاق كلِّ من البيع والشراء على دفع الثمن، وعلى أخذ المُثْمَن، فكل منهما يطلق على الآخر، والتعزيز الذي يطلق على التكريم والتعظيم، وعلى اللوم والتعنيف، والقرء الذي يطلق على الطهر والحيض، والجلل الذي يطلق على الحقير والعظيم، وهلمّ جرا.
والتضادّ ظاهرة متفشية في كلام العرب، وألفت فيه كتب كثيرة، عنيت باستقراء الأضداد وجمعها، منها ما ألفه قطرب (ت:206هـ) والأصمعي (ت:215هـ)، وابن السكّيت (ت:244)، والسجستاني (ت:255هـ)، وأبو بكر بن الأنباريّ (ت:328هـ)، وأبو الطيب اللغوي (ت:351هـ)، والصغاني (ت:650هـ)، وكتبهم مطبوعة.
وأسباب التضادّ كثيرة منها:
- اتساع العرب في كلامهم، يقول أبو بكر الأنباري رحمه الله:«إذا وقع الحرفُ على معنيين متضادين فَالأصل لمعنى واحدٍ، ثمَّ تداخل الاثنان على جهة الاتساع، فمن الصريم يقال لليل صريم وللنهار صريم؛ لأن الليل يَنْصَرِمُ من النهار والنهارَ ينصرم من الليل، فأصل المعنيين من باب واحد وهو القَطْع، وكذلك الصارخُ: المُغِيث والصَّارِخُ المستغيث سمِّيا بذلك؛ لأنَّ المغيثَ يصرخ بالإغاثة والمستغيث يصرخُ بالاستغاثة فأصلهما من باب واحد»(الأضداد (ص:8).
- تداخل اللغات، ويقول أبو بكر الأنباري رحمه الله: «وقال آخرون: إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربيُّ أوقعَه عليهما بمساواة منه بينهما ولكن أحدَ المعنيين لحيٍّ من العرب، والمعنى الآخر لحيٍّ غيره ثم سَمِع بعضُهم لغة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء.
قالوا: فالجوْنُ الأبيض في لغة حيٍّ من العرب، والجوْن الأسود في لغة حي آخر، ثم أخذ أحدُ الفريقين من الآخر كما قالت قريش: حسِب يحسِب.
... قال الكسائي: أخذوا يَحْسِب بكسر السين في المستقبل عن قوم من العرب يقولون: حسَب يحسِب فكأنَّ حَسِب من لُغتهم في أنفسهم، ويَحْسِب لغة لغيرهم سَمِعوها منهم فتكلَّموا بها ولم يقَعْ أصل البناء على فعِل يَفْعِل».(ص:11).
* * *
وقد اختلف اللغويون في هذه الظاهرة اللغوية، وذهبوا في التضادّ طرائق قددا؛ فمنهم من أنكره، ومنهم من أثبته وهم الجمهور.
المذهب الأول: ذهب بعض اللغويين إلى جواز إيقاع اللفظ على معنيين متضادين، ومنهم:
- أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله (ت: 224هـ) صاحب «الغريب المصنف»، يقول عنه السيوطي رحمه الله:« وقال أبو عبيد في الغريب المصنف: باب الأضداد:سمعت أبا زيد سعيد بن أوس الأنصاري يقول: النَّاهِل في كلام العرب: العَطْشان والناهل: الذي قد شرِب حتى رَوي والسُّدْفة في لغة تميم: الظلمة والسُّدْفة في لغةِ قيس: الضوء...»[المزهر (1/306)].
- ابن قتيبة (ت:276هـ)، وعقد في «أدب الكاتب» بابا سماه (باب تسمية المتضادين باسم واحد)، وذكر فيه: الْجَوْن للأسْوَد والأبْيَض، والصريم للصبح والليل، والسدفة للظلمة والضوء، والجلل للكبير والصغير، والناهل للعطشان والريان، والصارخ للمغيث والمستغيث، والهاجد للمصلي بالليل، وللنائم([1]).
- المبرّد (ت:285هـ)، وذكر في كتابه: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» نماذج للكلمات المتضادّة، منها: الجلل، والجون، والمقوي للقوي والضعيف([2]).
- ابن دريد (ت:321هـ)، يقول في جمهرته: «وتظاهرَ القومُ، إِذا تعاونوا، وَقَالَ قوم من أهل اللُّغَة: تظاهرَ القومُ، إِذا تدابروا، فَكَأَنَّهُ من الأضداد» [الجمهرة (2/764)، «والوراء: الْخلف والوراء: القدام وَهُوَ من الأضداد» [1/236].
- أبو بكر بن الأنباريّ (ت:328)، وألف فيه كتابا نفيسا، قال في مقدمته: «هذا كتاب ذِكْر الحروف التي تُوقِعُها العربُ على المعاني المتضادّة، فيكونُ الحرفُ منها مؤدِّياً عن معنييْن مختلفيْن......»[ص:1].
- وأبو زيد القالي (ت:356هـ)، قال في أماليه:«الجَادي: السائل والمعطي وهو من الأضداد»[2/326]، وقال:«البَسْلُ: الحرام والبَسْل أيضا: الحلال وهذا الحرف من الأضداد»[2/279].
- وأبو إبراهيم إسحاق الفارابي (ت: 350هـ)، وذكر في كتابه: «ديوان الأدب»، جملة من الأضداد، قال: «والبثرُ: الكثيرُ، والبَثْرُ: القَليلُ، وهذا الحَرْفُ من الأَضْدادِ»[1/105]، «والتَّلْعَةُ: مَجْرى ماءٍ ارتفعَ من الأرضِ إلى بَطْنِ الوادي. وهي ما انْهَبَطَ من الأَرْضِ أَيضاً، وهي حَرْفٌ من الأَضداد »[1/141]، «والسُّدْفَةُ: الظُّلْمَةُ والضَّوءُ، وهو حرفٌ من الأَضْدادِ»، ومثله السَّدف[1/171]، «والنَّبَل: الكِبارُ، والنَّبَل: الصِّغارُ، وهذا الحَرْفُ من الأَضْداد»[1/229]، «. والنّاهِلُ: العَطْشانُ، وهو الرَّيّانُ أَيضاً وهذا الحَرْفُ من الأَضدادِ»[1/360].
- وابن فارس (ت:395هـ)، يقول في «الصاحبي»: « ومن سُنَن العرب فِي الأَسماء أن يسمّوا المتضادَّين باسم واحد. نحو: الجَوْن للأسود والجَوْن للأبيض. وأنكر ناس هَذَا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضدّه. وهذا لَيْسَ بشيء. وذلك أن الَّذِين رَوَوْا أن العرب تُسمي السيف مهنَّداً والفَرَسَ طِرْفاً هم الَّذِين رَوَوْا أن العرب تُسمِّي المتضادَّين باسم واحد. وَقَدْ جرَّدنا فِي هَذَا كتاباً ذكرنا فِيهِ مَا احتجوا به، وذكرنا ردَّ ذَلِكَ ونقصه، فلذلك لَمْ نكرره»[ص:60].
- والثعالبي (ت:429هـ)، وعقد في كتابه «فقه اللغة» فصلا أسماه: «الفصل السادس عشر: في تسمية المتضادين باسم واحد مِنْ غَيْرِ اسْتِقْصَاءٍ»، قال فيه:«الغَرِيمُ. المَوْلَى. الزَّوْجُ. البَيْعُ. الوَرَاءُ يَكُونُ مِن خَلْفُ وقُدَّامُ. الصَّرِيمُ اللَّيْلُ، وهو أيْضاً الصُّبْحُ؛ لأنَّ كلاّ مِنْهما يَنْصَرِمُ عَنْ صَاحِبِهِ. الجَلَلُ اليَسيرُ والجَلَل العَظِيمُ؛ لأنّ اليَسيرَ قدْ يكونُ عَظِيماً عِنْدَ مَا هوَ أيْسَرُ مِنْهُ، والعَظِيمُ قَدْ يكون صَغِيراً عِنْدَ ما هوَ أعظمُ منْهُ. الجَوْنُ الأسْوَدُ وهو أيْضاً الأبْيضُ. الخَشِيبُ مِنَ السّيوفِ الذِي لمْ يُصْقَلْ وهو أيْضاً الذِي أحْكِمَ عَملهُ وفُرِغَ مِنْ صَقْلهِ»[ص:215].
وفصلا آخر قال فيه: «الفصل الحادي والسبعون: في تسمية المتضادين باسم واحد»، هي من سنن العرب المشهورة كقولهم: الجَوْنُ: للأبيض والأسْوَد. والقُروء: للأطهار والحَيض. والصَّريم: للَّيل والصُّبح. والخَيلولة: للشَّكِّ واليَقين. قال أبو ذؤيب:
فَبَقيتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ ناصِبٍ=وَإِخالُ أنِّي لاحِقٌ مُسْتَتْبَع
أي وأتيَقَّن. والنّدُّ: المِثلُ والضِّدُّ. وفي القرآن: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً) على المعنيين. والزَّوج: الذَّكر والأنثى. والقانِعُ: السَّائل والذي لا يسأل. والنَّاهل: العَطْشان والرَّيان»[ص:263].
- وابن سيده (ت:458هـ)، وعقد في كتابه «المخصص» فصلا أورد فيه جملة من الألفاظ، مستندا إلى من سبقه من اللغويين غير غافل عن الرد على الذين ينفون الأضداد، وينكرون وقوع اللفظة لمعنيين متضادين.
المذهب الثاني: ذهب بعض اللغويين إلى إنكار ذلك، ومنهم النحوي اللغويّ أبو محمد عبد الله بن جعفر النحوي الفارسي المشهور بابن درستويه (ت:347هـ)، وألف في ذلك كتاباً، قال السيوطي: «قال ابن درستويه في شرح الفصيح: النَّوء: الارتفاع بمشقة وثِقَل ومنه قيل للكوكب قد ناءَ إذا طلع وزعم قومٌ من اللغويين أن النوء السقوط أيضا وأنه من الأضداد، وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد»، ثم قال: «فاستفدنا من هذا أن ابنَ درستويه ممن ذهبَ إلى إنكار الأضداد وأنَّ له في ذلك تأليفا([3])».
* * *
وقد احتوى القرآن الكريم على نصيب غير منقوصٍ من الأضداد، ووُضعت فيها كتب ودراسات وأبحاث، منها «ظاهرة التضاد في القرآن الكريم –دراسة إحصائية مع عرض آراء اللغويين ومواقف المفسرين -»، وهو كتاب ألفه الباحث السنغالي الشيخ أحمد امباكي بن الشيخ إبراهيم امباكي حفصة – حفظه الله ورعاه -، وأصله بحث تقدم به الباحث لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-جامعة محمد الخامس1989-1990م.
دوافع الدراسة والبحث:
ذكر الباحث في مقدمة كتابه دوافع الكتابة والتأليف، ونصه: «يشرفني أن أقدم للقراء الأعزاء هذه النسخة من كتاب "التضاد في القرآن الكريم"، وهو في الأصل بحث تمت تهيئته لنيل دبلوم الدراسات العليا (ماجستير في اللسانيات - تخصص علوم اللغة العربية أيام خضوعي للتكوين في جامعة محمد الخامس بالرباط.
ولما أجلت فيه النظر بعد أكثر من ثلاثين سنة، ألفيته أشبه شيء بمعجم مصغر للأضداد في القرآن الكريم، علما بأنه رغم تواضعه كعمل جامعي قام به أحد طلاب العلم في طور التكوين، فقد كان آنذاك فريدا من نوعه لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم. وقد عرض علي الأستاذ المشرف موضوعه بعد عثوره في كتابات بعض كبار اللغويين، ولعله الأستاذ تمام حسان على فقرة يلفت فيها النظر إلى هذه الظاهرة في القرآن الكريم وضرورة الاهتمام بها على نحو ما تعاملنا معه في هذا البحث، من إحصائها وذكر مواقف المفسرين وآراء اللغويين حولها وعقد مقارنة بينها واستخلاص النتائج.
ونظرا لوجازة الفترة الزمنية التي أنجز فيها والتي تحددها السنة الدراسية بكل ما تتضمنه من نشاطات علمية موازية، فقد حاولنا قدر الإمكان تضييق مجال البحث وحصره في كتب معينة من التفاسير مع مراعاة اختلاف اتجاهات مؤلفيهم المذهبية ومناهجهم الفكرية من معتزلين وبلاغيين وغيرهم ممن يعتمدون منهج التفسير بالمأثور إلى جانب النزعة التي تعتني أكثر باستخراج أحكام ودراستها. كما اخترنا من كتب اللغة تلك التي أولت أهمية خاصة لهذه الظاهرة.
ومن ثم فلا ندعي الإحاطة بالموضوع ولا الإلمام به، وإنما حاولنا تقديم نماذج مستخرجة من مراجع متعدّدة ومختلفة حتى نعطي فكرة عن تناول كل اتجاه لهذا الموضوع([4])».
منهج الكتاب:
هذا الكتاب «دراسة موازنة بين مواقف اللغويين والمفسرين من بعض الألفاظ والصيغ والتراكيب والتعابير العربية المندرجة في التضاد»، وجمع الشيخ المؤلف بين دفتيه جملة من الأضداد الواردة في القرآن الكريم، مرتبة حسب الحروف الهجائية، معتمدا على ما ألف في الموضوع قديما وحديثا، وعلى أقوال بعض المفسرين الذي آثر حصْر دراسته على تفاسيرهم وكتبهم.
وقد نص على منهجه في مقدمة الكتاب بقوله([5]): «وسنتبع في استخراج تلك الألفاظ وفي سرد آرائهم المختلفة حولها الخطوات التالية:
- الاقتصار فقط على إحصاء واستخراج الألفاظ التي أفردها اللغويون بشرح خاص، واستشهدوا على ضديتها بآيات قرآنية صريحة دون التي ذكروها في اللائحة ولم يردفوها بنصوص قرآنية.
- تخصيص الجزء الأول من شرح كل لفظ بآراء اللغويين ومواقفهم التي حددوها في كتبهم قبل إيراد تأويلات المفسرين وشروحهم الخاصة بالآيات التي استُعمل فيها اللفظ المذكور.
- الاكتفاء بآراء بعض الأسماء اللامعين من اللغويين الذين خصصوا للموضوع كتبا ومؤلفات دون غيرهم من الذين اكتفوا فقط بإدراج بعض الألفاظ منها في مصنفاتهم.
والمعتمد على كتبهم هم: ابن السكيت، وأبو حاتم السجستاني والأصمعي، والصغاني، والأنباريّ.
- الاعتماد على نماذج محددة من كتب المفسرين الذين تمكنا من الاطلاع على أعمالهم، وهم: ابن كثير، والبيضاوي، والزمخشري، والطبري، والفراء، والقرطبي([6])».
محتوى الكتاب ومضمونه:
استخرج المؤلف من القرآن الكريم ثمانية وثمانين لفظا، مرتبة حسب الحروف الهجائية (أب، ت،ث....)، منها (القرء-عسعس-قسط-القانع-اللحن-....) ومنهجه أن يعرض اللفظ، ثم يردفه بذكر آراء اللغويين، مثال ذلك:
- لفظ: (أسر)
يقول: «ونعثر على هذا اللفظ في مؤلفات أغلب اللغويين الذين اهتموا بالأضداد وبالتضادّ؛ فالأنباريّ يقول عنه: "وأسررت من الأضداد، يكون أسررت بمعنى كتمت وهو الغالب على الحرف، ويكون بمعنى أظهرت؛ قال الله عز وجل: (وأسروا النجوى الذين ظلموا) [الأنبياء: 3]، يعني (أسروا) هاهنا كتموا. وقال تبارك وتعالى في غير هذا الموضع: (وأسروا الندامة لما رأوا العذاب) [يونس: 54 وسبأ: 33] ، فقال الفراء والمفسرون: معناه كتم الرؤساء الندامة من السفلة الذين أضلوهم.
وقال أبو عبيدة وقطرب: معناه: وأظهروا الندامة عند معاينة العذاب، واحتجا بقول الفرزدق:
وَلَمَّا رَأَى الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَهُ =أَسَرَّ الحَرُورِيُّ الَّذِي كَانَ أَضمَرَا
معناه: أظهر الحروري".
وكذا ذكر الأصمعي وابن السكيت والسجستاني، وقد استشهد الكل منهم بقوله تعالى: (وأسروا الندامة) وأعطوا اللفظ معنى "أظهر ".
إلا أن اغلب المفسرين - كما أشار الأنباري إلى ذلك - يفسرون (أسر) بـ (كتم) ، لكن مع تذييل كلامهم بالإشارة إلى أن البعض يعتبره بمعنى (أظهر)؛ وعلى سبيل المثال فالزمخشري يشرح الآية قائلا: "فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخاً ولا ما يفعله الجازع، سوى إسرار الندم والحسرة في القلوب..... وقيل: أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم. وقيل: أسروها أخلصوها، إما لأن إخفاءها إخلاصها، وإما من قولهم: سرُّ الشيء خالصُه. وفيه تهكم بهم وبأخطائهم وقت إخلاص الندامة. وقيل: أسروا الندامة؛ أظهروها، من قولهم: أسر الشيء وأشره إذا أظهره. وليس هناك تجلد".
ويعقب البيضاوي على الآية قائلا: "لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل: (أَسَرُّوا الندامة أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصها، أو لأنه يُقال سر الشيء لخالصته من حيث إنها تُخفى ويُضنّ بها. وقيل أظهروها من قولهم: أسر الشيء وأشره إذا أظهره "
والقرطبي يقول: أي أخفوها، يعني رؤساءهم، أي: أخفوا ندامتهم عن أتباعهم... وقيل: (أسروا) أظهروا ، والكلمة من الأضداد. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم، لأن الندامة لا يمكن إظهارها. قال كثير:
فَأَسْرَرْتُ النَّدَامَةَ يَوْمَ نَادَى =بِسَرْدِ جِمَالِ غَاضِرَةِ الْمُنَادِي([7])».
- لفظ: (عاصم)
يقول: «وقد أدرجه الأنباري في قائمة الأضداد وذكر أن "العاصم من الأضداد يقال: الله عاصم لمن أطاعه، ويقال رجل عاصم، أي معصوم، إذا فهم المعنى؛ قال الله عز وجل: (لا) عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) [هود: 43]، فمعناه لا معصوم اليوم من أمر الله إلا المرحوم، ويجوز أن يكون (عاصم) بمعنى (فاعل) وتكون (من) في موضع نصب أو رفع على الاستثناء المنقطع ".
والملاحظ عند المفسرين هو ميلهم إلى التأكيد على صحة كلا النوعين من التأويل على أنه بمعنى (فاعل) أو بمعنى (مفعول)؛ ونلمس ذلك في موقف ابن كثير حين عقب على الآية قائلا: "أي: ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله، وقيل: إن عاصما بمعنى معصوم ، كما يقال: (طاعم وكاس) ، بمعنى مطعوم ومكسوّ".
وأما البيضاوي فيعلق عليها بقوله: "إلا الراحم وهو الله تعالى أو إلا مكان من رحمهم الله وهم المؤمنون .... وقيل: لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة، كقوله: في عيشة راضية)، وقيل: الاستثناء منقطع أي لكن مَن رحمه الله يعصمه "
وبالنسبة للطبري فيورد ما يلي: .... ولكن لو جعلت (العاصم) في تأويل (معصوم)، كأنك قلت: (لا) معصوم اليوم من أمر الله)، لجاز رفع (من). ولا ينكر أن يخرج (المفعول) على (فاعل)، ألا ترى قوله : (من ماء دافق) [الطارق 6]، معناه -والله أعلم-: مدفوق. وقوله : (في عيشة راضية)، معناها مرضية، قال الشاعر:
دَعِ الْمكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا= وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي
ومعناه: المكسُوّ"، "تستدل على ذلك أنك تقول: رضيتُ هذه المعيشة، ولا تقول: رضيتْ، ودُفق الماء، ولا تقول: دَفق، وتقول: كُسي العريان، ولا تقول: كسا "([8])».
- لفظ: (المسجور)
يقول: «وهي من ألفاظ القرآن التي ورد ذكرها في كتب كثير من اللغويين وأقروا على ضديتها، واستشهدوا على ذلك بآيات قرآنية، وهذا ما نلاحظه في كلام الأنباري حين قال: "يُقال: المسجور للمملوء، والمسجور للفارغ، قال الله عزّ وجل: (والبحر المسجور) [الطور: 5] ، يريد المملوء. وقال النمر بن تولب يذكر وعلا:
إِذَا شَاءَ طَالَعَ مَسْجُورَةً=تَرَى حَوْلَهَا النَّبْعَ وَالسَّاسَمَا
أراد: طالع عينا مملوءة... وقال ابن السكيت : قال أبو عمرو : يقال: قد سجر الماء الفرات والنهر والغدير والمصنعة، إذا ملأها ... وقال الله عز وجل: (وإذا البحار سجرت) [التكوير: 6] ، فمعناه أفضى بعضها إلى بعض، فصارت بحرًا واحدًا. وقال ابن السكيت: يجوز أن يكون المعنى فُرِّغت، أي فرغ بعضها في بعض".
وفي أضداد الأصمعي قوله: "المسجور: المملوء، والمسجور: الفارغ، قال تعالى: (وإذا البحار سُجّرت)، أي: فرّغ بعضها في بعض".
وأما أبو حاتم فيعلق على الكلمة بالعبارات التالية: "قالوا: المسجور: المملوء، وإذا البحار سجّرت) ، وقال بعضهم: المسجور: الفارغ، بلغني ذلك ولا أدري ما الصواب، ولا أقول في (البحر المسجور) شيئا، ولا (وإذا البحار سجرت)، لأنه قرآن فأنا أثق به.
ونجد في أضداد ابن السكيت تقريبا نفس تلك العبارات التي استشهد بها الأنباري على موقف هذا اللغوي. في حين اكتفى الصغاني بالقول: "المسجور: المملوء والفارغ؛ (سجّرت): البحار ملئت وفرغت ".
وأما المفسرون ففي تفسيرهم للآية يعتمدون على الدلالتين كلتيهما، ويؤكدون في أغلب الأحيان على احتمال اللفظ للمعنيين معا، ولذلك يقول الزمخشري: "والبحر المسجور): المملوء، وقيل: الموقد، من قوله تعالى: (وإذا البحار سُجّرَت) . " وسُجّرت: "قرئ بالتخفيف والتشديد من سجر التنور: إذا ملأه بالحطب، أي: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا. وقيل ملئت نيرانا تضطرم لتعذيب أهل النار. وعن الحسن يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة".
وفي هذا الصدد أورد البيضاوي الشرح التالي: "(والبحر المسجور) أي المملوء، وهو المحيط، أو الموقد من قوله: (وإذا البحار سُجرت) أي: أحميت أو ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدًا، من سجر التنّور إذا ملأه بالحطب ليحميه .
في حين يخصه القرطبي بهذا التأويل: "(والبحر المسجور)، قال مجاهد الموقد، وقال قتادة المملوء... وقال ابن عباس: المسجور: الذي ذهب ماؤه".
وابن كثير هو الآخر يفسر الآية بقوله: "واختلف في معنى قوله: (المسجور)، فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: (وإذا البحار سجرت) أي: أضرمت فتصير نارا تتأجج، محيطة بأهل الموقف. وعن سعيد بن جبير : يعني المرسل. وقال قتادة: (المسجور): المملوء، واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. وقيل: المراد به الفارغ".
وأما الفراء فيؤوّل الآية على النحو التالي: "كان علي بن أبي طالب رحمه الله يقول: مسجور بالنار، والمسجور في كلام العرب المملوء ". والأولى عند الطبري هو أن معناه: المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض"([9])».
ولم يقتصر الباحث على المفردات المتضادة، بل ذكر أيضا بعضا من الصيغ الصرفية والتراكيب النحوية التي يوردها كتب الأضداد، ومنها صيغة (فعيل)، كسميع وأليم، وصيغة (مفتعل) كمختال.، ومنها نحو قوله تعالى: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) [الأنفال: 33]، يقول الباحث -نقلا عن الأنباري- إن قوله تعالى: «يفسر تفسيرين متضادين أحدهما: وما كان الله معذبهم وأولادهم يستغفرون؛ أي قد وقع له في علمه جل وعزّ أنه يكون لهم ذرية تعبده وتستغفر لهم، فلم يكن ليوقع بهم عذابا يجتث أصلهم. والتفسير الآخر: وما كان الله معذبهم لو كانوا يستغفرون؛ فأما إذا كانوا لا يستغفرون فإنهم مستحقون لضروب العذاب التي لا يقع معها البوار والاصطلام، ... والله أعلم بحقيقة ذلك كله وأحكم([10])».
ومنها قوله: (ثم صُبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم) [الدخان 45 - 46])، يقول الباحث:«ومن التعابير التي ينبغي الوقوف عندها تلك التي ذكرها الأنباري ووصفها بأنها تشبه الأضداد، وهي غالبا ما تحتاج إلى تأويل بلاغي أو تداولي لفهم المعنى المراد وإن كان الأنباري لم يصرّح بهذا، واكتفى بالقول: "ومما يشبه الأضداد أيضا قولهم للعاقل يا عاقل، وللجاهل إذا استهزءوا به يا عاقل، يريدون يا عاقل عند نفسك. قال عز وجل: (ثم صُبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم) [الدخان 45 - 46] ، معناه: عند نفسك؛ فأما عندنا فلست عزيزا ولا كريما، وكذلك قوله عز وجل فيما حكاه عن مخاطبة قوم شعيب شعيبا بقولهم: (إنك لأنت الحليم الرشيد) [هود: 87]، أرادوا أنت الحليم الرشيد عند نفسك، قال الشاعر:
فَقُلْتُ لِسَيِّدِنَا يَا حَلِيـ=ـمُ إِنَّكَ لَمْ تَأْسُ أَسْوا رَفِيقَا
أراد يا حليم عند نفسك، فإنما عندي فأنت سفيه"([11])».
خلاصة البحث([12]):
ذكر الشيخ الباحث في خاتمة كتابه ما نصه: «يتضح مما سبق أن الألفاظ الواردة في القرآن والحاملة لهذه الظاهرة، شغلت بال كثير من اللغويين والمفسرين على حد السواء.
وإذا حاولنا أن نعقد مقارنة بين مواقف الدارسين، فإن أهم ما يميز أعمال اللغويين هو وجود تفاوت في كمية وحجم الألفاظ المودعة لكتبهم والتي تختلف باختلاف المؤلفين؛ فمن بينهم على سبيل المثال من يورد أقل مما أورده الآخر، كما أننا كثيرا ما نعثر عند لغوي معين على نفس الألفاظ التي ضمنها لغوي آخر لمؤلفاته الخاصة بهذا المجال. وأحيانا يورد هذا المؤلف شرحه الخاص بهذا اللفظ، وتارة يعقّب عليه بشرح لغوي آخر يصرح باسمه ويورد نفس النصوص التي أوردها هذا الأخير. ومنهم أيضا من يقتصر فقط على التعرض للشرح الذي خصه به باحث لغوي سبقه إلى ذلك.
ومما يلفت النظر في معاملة اللغويين مع ظاهرة التضاد بصفة عامة، هو وجود بعض ألفاظ لم يقع الإجماع على حملها على ظاهرة التضاد؛ إذ نلاحظ أن البعض يذهب إلى حد نقض كل الحجج والبراهين التي اعتمدها البعض الآخر في إثبات ضدية ألفاظ معينة، كما فعل الأنباري مثلا مع ألفاظ كثيرة من بينها (هجا).
كما أن هناك بعض الألفاظ قد يقبل بعض اللغويين، أمثال الأنباري، فكرة دلالتها على الشيء ونقيضه، لكن مع إقامة شروط لا بد أن تتوفر فيها وإلا رفضوها، وقد سبق أن لا حظنا كيف أن الأنباري يلح على ضرورة تقدم جحد على (رجاء) مثلا، وغيرها كثير.
كما أن مما ينتج عن ذلك الخلاف بينهم حول ضدية بعض الألفاظ، تلك المواقف الضبابية التي يتبناها البعض حين يورد لفظا ويعقب عليه بعبارات مثل (والله أعلم)، أو لا أعرف، كما مر بنا في كثير من المواد التي تناولها أبو حاتم السجستاني.
وبالنسبة للمفسرين فلا يمكن القول باتفاقهم على تخصيص شروح موحدة لكل هذه الألفاظ، وإنما نلاحظ أحيانا اختلاف وجهات نظر بينهم بشأن دلالات بعض الكلمات واتحادها أحيانا أخرى حول بعضها الآخر، كما لا تخلو مواقفهم من التعارض والتناقض في بعض الحالات.
ونلاحظ أيضا في تناولهم لهذه الألفاظ أن منهم من يصرح بضدية اللفظ، ومنهم كذلك من لا يصرح بها لكن يتناوله بكيفية توحي باعتراف الشارح بكون اللفظ يحمل هذه السمة، كما أن منهم من لا يصرح بضدية اللفظ ولا بعدم ضديته، لكن يلجأ في تفسير الكلمة إلى اعتماد وسائل مختلفة علها تمكنه من فهم المقصود منها دون أخذ مفهوم التضاد بعين الاعتبار، فمن بين تلك الوسائل نخص بالذكر:
1- مبدأ التفاؤل الذي يؤكد أن المعنى الأصلي للفظ ما يتحول إلى دلالة أخرى مخالفة ومعارضة، وذلك تفاؤلا بهذه الأخيرة للحصول على معنى مماثل لها، وقد سلكوا في ذلك مسلك اللغويين.
2- ومنها أيضا: إبقاء الكلمة على معناها الشائع مع استدلال ببعض عناصر أخرى سياقية كانت أو خارج اللغوية) على أن المراد هو كذا وليس العكس، وأوضح مثال لذلك شرح بعض المفسرين لقوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر)، وكذلك قوله: (والأرض بعد ذلك دحاها)، وقوله: (يا أيها الساحر)، وكذلك الآية (ذق إنك أنت العزيز الكريم)، وأمثالها عديدة، هذا دون الإغفال عن اعتمادهم أحيانا على المكون البلاغي في شرح بعض الألفاظ، وقد استخدموا هذه الوسيلة في تناول قوله تعالى: (لا عاصم اليوم....)، وكذلك قوله : (إنك لأنت الحليم الرشيد)، إلى غير ذلك. كما استعانوا بالنظريات والقواعد النحوية في تأويل كثير من ألفاظ قرآنية، وبرز ذلك بوضوح على سبيل المثال في معالجة بعضهم لقوله تعالى: (لقد تقطع بينكم).
إلا أن ما ينبغي التنبيه عليه هو أنه وإن كان المفسرون يخالفون اللغويين في شرح وتفسير بعض الألفاظ، فإنهم غالبا ما يستشهدون بأقوال اللغويين ويستندون إلى كثير من آرائهم في تأويل القسم الأكبر من الآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ.
وبصفة عامة يمكن القول بأن التضاد في القرآن ينقسم باعتبار مواقف الدارسين إلى الأنواع التالية:
1- أنواع وقع الاتفاق على ضديتها من قبل جميع الدارسين القائلين بتحقيق هذه الظاهرة في اللغة.
2- أنواع تخالفت الآراء حولها بين منكر ومقر.
3- أنواع أخرى بين مواقف مؤيدة وأخرى ضبابية.
كما أننا إذا حاولنا من جهة أخرى تتبع تجليات التضاد في الأسلوب القرآني نخرج بالملاحظة الآتية:
1- إن هناك ألفاظا تحمل سمة التضاد مطلقا وبصرف النظر عن محيطها، وكمثال على ذلك تذكر كلمة (القرء) الواردة في الآية الكريمة وأمثالها كثيرة، غير أنها في أغلب الحالات خاصة بأسماء وبقسم نادر من الأفعال.
2- إن هناك ألفاظا أخرى تتغير دلالتها تبعا للمورفيمات التي تتساوق معها، كما هو الشأن في كثير من الأفعال الأضداد، وفي غالبية الحروف مثل (إن ومن)، وبعض الأسماء؛ ك (إذ ، وعاصم)، وصيغة (مفتعل المعتلة العين وغيرها من الصيغ التي تحل محل الصيغ الأخرى وتدل على معناها وذلك طبعا خاضع لورود اللفظ في سياق معين.
3- وبخصوص طبيعة الألفاظ التي تتحقق فيها هذه الظاهرة، فقد لا حظنا من خلال القائمة الخاصة بهذه الألفاظ أنها تشتمل الكلام بأقسامه الثلاثة: من فعله واسمه وحرفه.
الهوامش:
[1]() أدب الكاتب (ص:177)
[2]() ما اتفق لفظه واختلف معناه (ص:48)
[3]() المزهر (1/311)
[4]() منهاج البلغاء (ص:268)
[5]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:14)
[6]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:14)
[7]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:24)
[8]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:101)
[9]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:153)
[10]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:175)
[11]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:176)
[12]() ظاهرة التضاد في القرآن الكريم (ص:179)