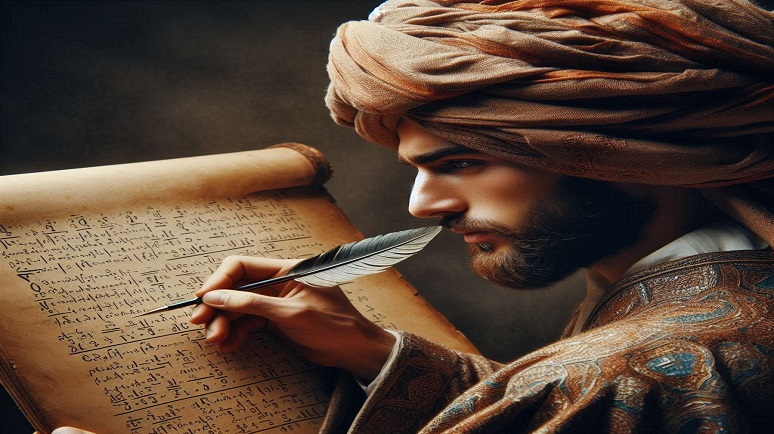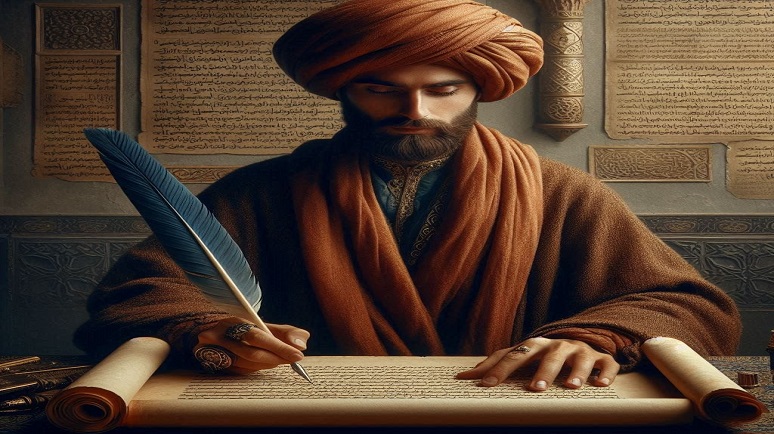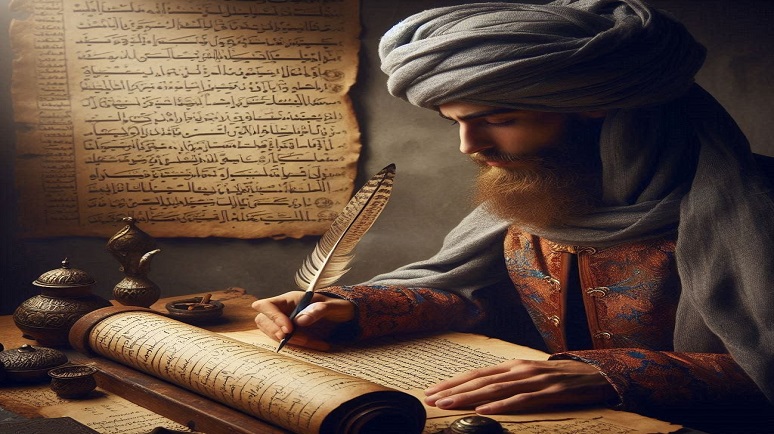تقرير عن محاضرة الأستاذ الحسن طالبي: “ملامح من التراث الفلكي المغربي”

تقرير عن محاضرة الأستاذ الحسن طالبي المعنونة
"بـ"ملامح من التراث الفلكي المغربي
عبد العزيز النقر
مركز ابن البنا المراكشي
نظم مركز ابن البنا المراكشي -بتاريخ 17 فبراير 2025- محاضرة علمية بعنوان: "ملامح من التراث الفلكي المغربي". وقد تفضل بإلقائها الأستاذ د. الحسن طالبي (عضو في المشروع الإسلامي لرصد الأهلة وعضو مكتب الاتحاد الفلكي الدولي للتوعية الفلكية). قام الأستاذ د. جمال بامي (رئيس مركز ابن البنا المراكشي) بتسيير المحاضرة، حيث أشار في تقديمه إلى بعض الأهداف التي يسعى مركز ابن البنا المراكشي إلى تحقيقها من خلال سلسلة المحاضرات التي ينظمها، من أهمها تعريف العموم بمبحث تاريخ العلوم وأهميته (وذلك من خلال تسجيل معظم هذه المحاضرات ونشرها على الأنتريت كي تصل إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين بتاريخ العلوم في الإسلام). كما تهدف مجمل الأنشطة العلمية -التي ينظمها المركز- إلى إبراز حلقة الوصل التي تجمع بين الأنشطة العلمية وتاريخها، ووصل كِلا هذين الجانبين بالبعد الثقافي الذي شكل، في نفس الوقت، أرضية استندت إليها ممارسة المعرفة العلمية داخل الحضارة الإسلامية، وجانبا تجلت فيه نتائج تلك الممارسة على المستوى العمراني بمعناه الأعم. وختم المُسَيّر تقديمه بالإشارة إلى الاهتمام الفريد الذي أولاه المغاربة لعلم الفلك.
أما بالنسبة للمحاضرة، فقد افتتحها الأستاذ الحسن طالبي بالإشارة إلى أن اختيار هذا العنوان (ملامح من التراث الفلكي المغربي) راجع بالأساس إلى أنه من الصعوبة بمكان على الباحث أن يحيط بمجمل هذا التراث الفلكي نظرا لغناه وتنوعه. من جهة أخرى، ارتأى أن يقسم المحاضرة إلى جزأين رئيسين: تناول في الجزء الأول منهما "الفلك في الثقافة الشعبية"، بينما خصص الجزء الثاني للحديث عن "الفلك في التخصص العلمي".
تحدث الأستاذ المحاضر في القسم الأول عن بعض مظاهر اهتمام المغاربة بعلم الفلك داخل الثقافة الشعبية، خصوصا في بعض المسائل المرتبطة بقياس الوقت ومعرفة فصول السنة. ومن بين هذه التجليات قدرة الإنسان المغربي "العامي" على تحديد بعض أوقات الصلاة في بعض المناطق النائية بناء على مواقع النجوم. كما يتجلى هذا الاهتمام أيضا في العديد من الأمثال المغربية (باللهجة الدارجة) التي يتناقلها المغاربة في بعض البوادي، خصوصا تلك الأمثال المرتبطة ببعض الأوقات الفلاحية المتصلة بالزراعة والحرث، إذ لا يخفى أن أمورا كهذه تحتاج في غالب الأحيان إلى معرفة "دقيقة" بأوقات محددة من السنة. قدم المحاضر أيضا أمثلة على كيفيات تحديد الوقت أو الأشهر من خلال بعض المعارف التقليدية، كما هو الحال مثلا في منطقة أرفود المغربية حيث يستطيع بعض الساكنة تحديد انتهاء شهر رمضان وبداية شهر شوال بناء على مراقبة مدى ارتفاع (الارتفاع أو الانخفاض) هلال آخر الشهر.
إضافة إلى مسألة تحديد الأوقات، أعطى الأستاذ طالبي أمثلة أخرى على إمكانية تحديد الاتجاهات بالاعتماد على بعض الوسائل والمعارف البسيطة، وغالبا ما يتم الاستناد في هذه العملية إلى موقع النجم القطبي. كما حرص المحاضر على تقديم بعض "التسميات" المغربية -الرائجة باللهجة الدارجة لدى بعض الناس في البوادي- لبعض الظواهر أو المسائل الفلكية. وقدم كذلك أمثلة على حضور علم الفلك في قصائد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الغناء المغربي.
أما فيما يخص القسم الثاني من المحاضرة، المخصص لـ"الفلك في الثقافة العلمية" أو "التخصص العلمي"، فقد قسمه الأستاذ المحاضر إلى خمسة محاور، هي على التوالي :
- العلماء: تحدث في هذا القسم عن حياة بعض علماء الفلك في الحضارة الإسلامية وأهم إسهاماتهم العلمية، من بينهم الشريف الإدريسي السبتي، أبو علي الحسن المراكشي، محي الدين المغربي، ابن البناء المراكشي، أبو زيد اللجائي، ومحمد بن سليمان الروداني ...
- التراث الفلكي المدون (المخطوط) أو المؤلفات الفلكية: أكد بخصوص هذه النقطة على أهمية المخطوطات الفلكية التي تزخر بها المكتبات والخزائن داخل المغرب وخارجه. ورغم أهمية الأعمال المنجزة بخصوص تحقيق جزء من هذا التراث الفلكي، إلا أن هذا المجال لا يزال يحتاج إلى تظافر جهود عديدة حتى يتنسى القيام بجرد وتحقيق ودراسة لهذا التراث المهم. وهذا الأمر سيؤدي، بكل تأكيد، إلى إمكانية تعريف الجيل الحالي (تلاميذ وباحثين) والأجيال اللاحقة بهذا التراث وبأهميته ومكانته داخل التاريخ العام للعلوم. وقف المحاضر في هذا المحور عند كتاب "جامع المبادئ والغايات في علم الميقات" -لمؤلفه الفلكي المغربي أبو علي المراكشي- نظرا لأهمية محتواه ولمكانة مؤلفه. كما أشار إلى عدة أعمال فلكية أخرى، من بينها: كتاب "المقنع في اختصار علم أبي مقرع" لمؤلفه المرغيتي السوسي، و"رسالة في الكرة" لعبد الرحمن العلج، و"رسالة إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل" و"إبداع اليواقيت على تحقيق المواقيت" لكاتبهما عبد السلام العلمي، و"منهاج الطالب لتعديل الكواكب" لابن البنا المراكشي ...
- الآلات الفلكية: خصص المحاضر هذا المحور الثالث لآلة الأسطرلاب باعتبارها أبرز آلة فلكية داخل الحضارة الإسلامية. وتحدث عن عدة أسطرلابات: كأسطرلاب الفلكي أبو جعفر أحمد بن حسين بن باسو (أو باصو أو باصه) المتوفى سنة 709هـ/1309م. هذا الأسطرلاب الذي اعتبره بعض الباحثين "من أبين أدق الأسطرلابات التي وصلتنا"، وتوجد منه نسخة في متحف بمدينة بولونيا بإيطاليا. تحدث أيضا عن الأسطرلاب الذي صنعه ابن مدينة آسفي المغربية الفلكي عبد الله بن ساسي (وهو معروض بمتحف أوكسفورد)، وأسطرلاب علي بن إبراهيم الحرار الذي عاش بمدينة تازة المغربية. إضافة إلى ذلك، فقد تحدث المحاضر، بشكل أكثر تفصيلا، عن أحد الأسطرلابات الفريدة من نوعها، وهو عبارة عن "أسطرلاب متحرك" (أي "أسطرلاب آلي") يعتمد على نظام هيدرولوكي (مائي) ...
- علم الفلك والمعمار: تطرق في هذا المحور إلى بعض "المعالم الفلكية الأثرية" الموجودة في مناطق مغربية مختلفة. كما أشار إلى بعض البنايات المخصصة لأغراض فلكية، كـ"برج المراقبة" الموجود على مقربة من مسجد القرويين بمدينة فاس. وقد تم إنشاؤه لأجل رصد السماء لأغراض دينية تتعلق بتحديد أوقات الصلاة والشهور، هذا بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"برج الكوكب" أو "برج الكواكب" الذي لا تزال شوهد منه حاضرة حتى يومنا هذا بمدينة فاس. أشار الأستاذ طالبي كذلك إلى ما يعرف بـ"غرفة المؤقت" أو "بيت المؤقت"، وهي عبارة عن حجرة تتواجد بجوار صوامع بعض المساجد الكبرى (المركزية) بالمغرب، وتكون مخصصة لأغراض فلكية بحيث يشتغل بها مؤقت مكلف بضبط أوقات الصلوات وتحديد بدايات الشهور من خلال مراقبة الهلال ...
- الساعات الشمسية: افتتح المحاضر الحديث عن هذه النقطة بالإشارة إلى الساعة الشمسية الموجودة على إحدى جدران مقر الرابطة المحمدية للعلماء الكائن بساحة الشهداء (باب العلو-الرباط). وأشار إلى أن الساعات الشمية -عموما- تنقسم إلى نوعين: ساعات عمودية تكون داخل "الصحن" بالمسجد، وميزة هذا النوع من الساعات أنها سهلة الاستعمال بحيث يستطيع عموم الناس تحديد الوقت من خلالها، وهناك ساعات أفقية تتواجد بأسطح المساجد، وتتميز بكونها أكثر دقة من الناحية العلمية، ولذلك فلا يتكلف بها إلا المؤقت. قدم الأستاذ طالبي مجموعة من الأمثلة على هذين النوعين، كالساعة الشمية -المشهورة- الموجودة بمسجد القرويين، أو الساعة الشمسية الموجودة بسطح المسجد الأعظم بمدينة مكناس المغربية. كما عرض كذلك مجموعة من الساعات الشمسية الأخرى المتواجدة بمدن ومناطق مغربية مختلفة.
ختم الأستاذ طالبي محاضرته بعرض فيديو يقدم برج المؤقت الموجود بمسجد القرويين بمدينة فاس، حيث يعرض محتوياته الداخلية ويشرح أهميته البالغة مع توضيح كيفية عمل المؤقت داخل وخارج هذه الحجرة المخصصة -حصرا- لكل ما يتصل بعلم الفلك وعلم الميقات.