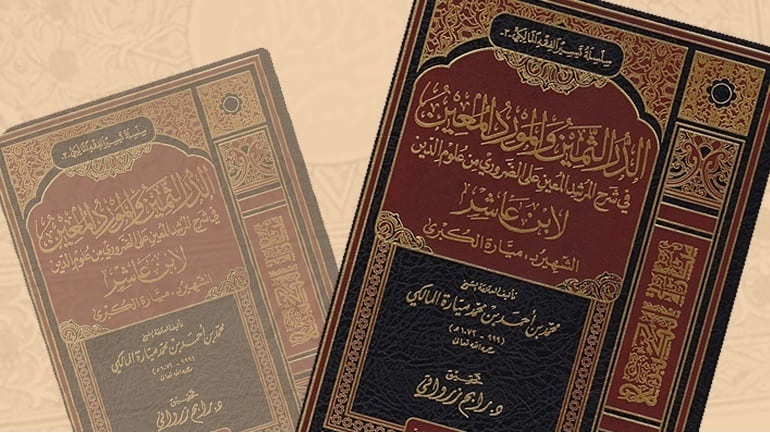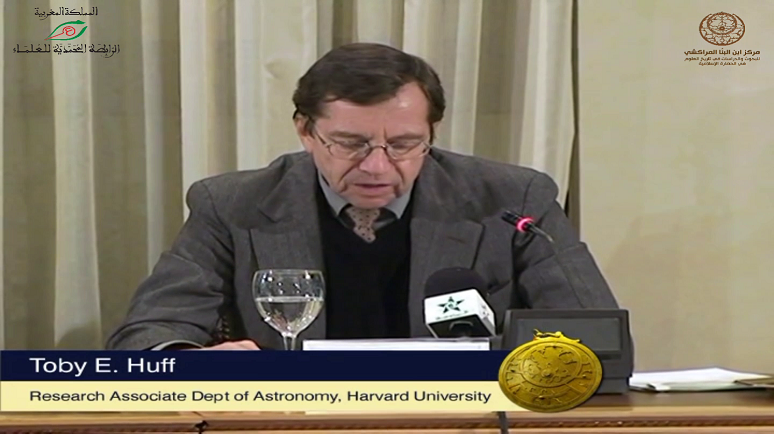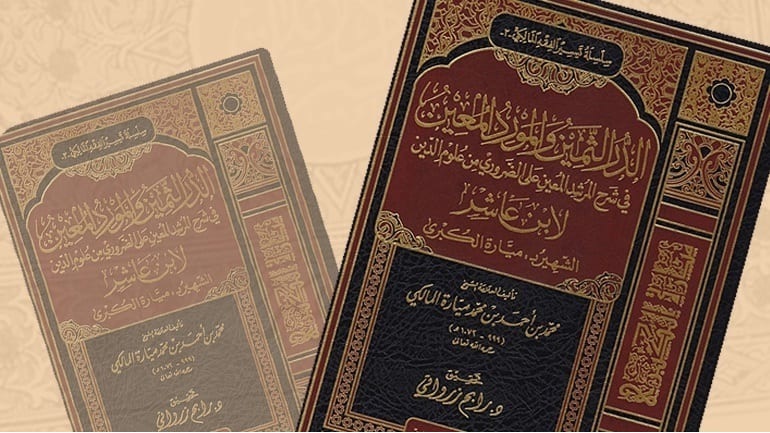تقريب نظم ابن عاشر شذرات من شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس على توحيد ابن عاشر(6)
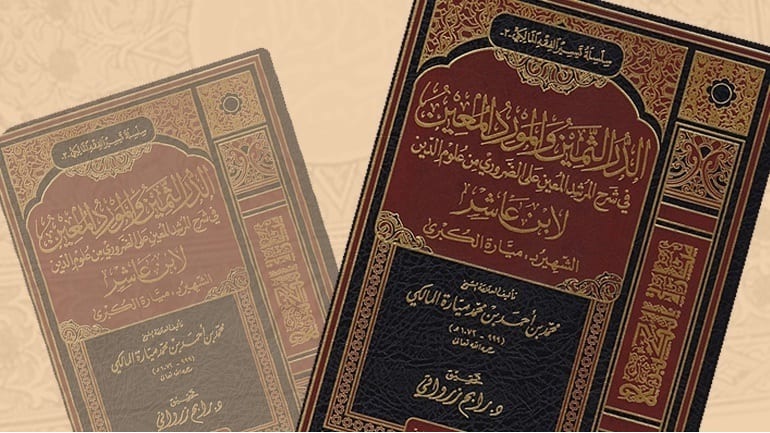
وقوله: "أن يعرف الله"؛ أي معرفة الله خبر المبتدأ، وهو قوله: "أول واجب"، والمعرفة؛ قال في شرح المقدمات: "المعرفة الحادثة من الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان"، ثم قال بعد كلام: "إلا أن الضرورة لم يُجْرِ الله تبارك وتعالى لها العادة، فتعين طلبها بالبرهان". انتهى. أي فتكون المعرفة المكلفُ بها هي الجزم المطابق عن دليل، ويتبين ذلك بتقسيمٍ ذكره في شرح الكبرى، وحاصله أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة؛ علم، واعتقاد، وظن، وشك ووهم؛ لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفيا إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أو لا، والأول إما أن يكون لسبب، وأعني به ضرورة أو برهانا أو لا، وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله، أو مرجوحا، أو مساويا، فأقسام الجزم اثنان، ويسمى الأول منهما علما ومعرفة ويقينا، ويسمى الثاني اعتقادا. وأقسام غير الجزم ثلاثة، ويسمى الأول منها ظنا، والثاني وهما، والثالث شكا. فإذا حصل الإيمان على أقسام غير الجزم الثلاثة فالإجماع على بطلانه، وإن حصل عن الأول من قِسْمَي الجزم وهو العلم فالإجماع على صحته. وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد فينقسم قسمين: الأول اعتقاد غير مطابق، ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين، والإجماع على كفر صاحبه، وأنه آثم غير معذور، ومخلد في النار اجتهد أو قلد، ولا يُعتد بخلاف من خالف ذلك من المبتدعة كالعنبري والجاحظ وهما معتزليان، ومذهبهما أن الكافر إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى صحة الكفر فهو معذور وغير آثم، وهو خلاف الإجماع، مع أنه لا يخلو أيضا عن تقصير في اجتهاده؛ لكثرة الأدلة على صحة الإسلام وجلالها، وقد وقع للبيضاوي قريب مما للعنبري والجاحظ.
القسم الثاني اعتقاد مطابق ويسمى الاعتقاد الصحيح، ويسمى صاحبه مقلدا، وفيه طرق وأقوال، وقد أشار ابن عرفة إلى ذلك، ونصه في شامله الذي حاذى به طوالع البيضاوي: "التقليد اعتقادٌ جازمٌ لقول غير معصوم، فيخرج اعتقاد قول الرسول والإجماع ومعرفةُ مدلول الشهادتين والمعاد والفتنة بدليل إجمالي معجوز عن تقريره وحَلِّ شُبَهِه، أو تفصيلي مقدور عليهما فيه. ففي إيمان ذي التقليد [فيهما] لا مع عصيانه أو معه، ثالثها: هو كفر؛ لنَقْلِ المُقْتَرَح مع عز الدين والآمدي، محتجين بأن أكثر من دخل الإسلام على عهده صلى الله عليه وسلم لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية، وحكم صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، ونقلِ الآمدي عن بعض المتكلمين وأبي هاشم مع مقتضى قول الفهري: اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين إنما هو في الأحكام الظاهرة، لا فيما ينجي من الخلود في النار. وقولِ الشامل: من مات بعد مضي ما يَسَعُ نظرَه، وتَرَكه اختيارا كافر، وإن مات قبل مضي ما يسع ذلك مع تركه النظر اختيارا فيما أدرك منه قولا القاضي: الأصح كفره، بعد قوله: يمكن أن لا يكفر. وفي وجوب المعرفة على الأعيان بالدليل الإجمالي، وعلى الكفاية بالتفصيلي، أو على الأعيان بالتفصيلي، نَقْلَا الإمام عن الآمدي وغيره قائلا: من كان اعتقاده دون دليل ولا شبهة فهو مؤمن [عاص] بترك النظر. الفهري: ولا نزاع بين المتكلمين في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي على الأعيان، وإنما هو كفاية. وظاهر قول ابن رشد في نوازله: إنما هو بالدليل التفصيلي مندوب إليه لا فرض كفاية". انتهى.
وقد اشتمل هذا الكلام على فوائد لا يستغني الطالب عنها، فلا بد من إيضاح مراده منها، فنقول: فقوله: جازم؛ تحرز به من الاعتقاد بمعنى الظن؛ فإنه قد يطلق عليه. وقوله: غير معصوم؛ خرج به اعتقاد قول الرسول والإجماع فيما لا تتوقف دلالة المعجزة عليه كالسمعيات وأحكام الحلال والحرام، وأما اعتقاد قول الرسول فيما تتوقف دلالة المعجزة عليه، كاعتقاد قوله أن الله موجود أو عالم أو قادر، وفي معناه اعتقاد قوله أنه رسول، فهو تقليد بلا شك، ويشمله الحد، ولا يخرج من قوله: معصوم؛ لأن الحيثية مراعاة في حدود الأمور التي تختلف بالاعتبار، فالخارج من الحد إنما هو اعتقاد قول المعصوم أنه معصوم، ومن اعتقد قوله في وجود الصانع مثلا فلم يعتقده من حيث أنه معصوم؛ إذ العصمة فرع دلالة المعجزة وما تتوقف عليه من معرفة وجوده تعالى ومعرفة صفاته التي لا تثبت دلالة المعجزة إلا بها. وقد أشار إلى هذا في شرح الوسطى، قاله سيدي أحمد المنجور في حواشيه على شرح الكبرى.