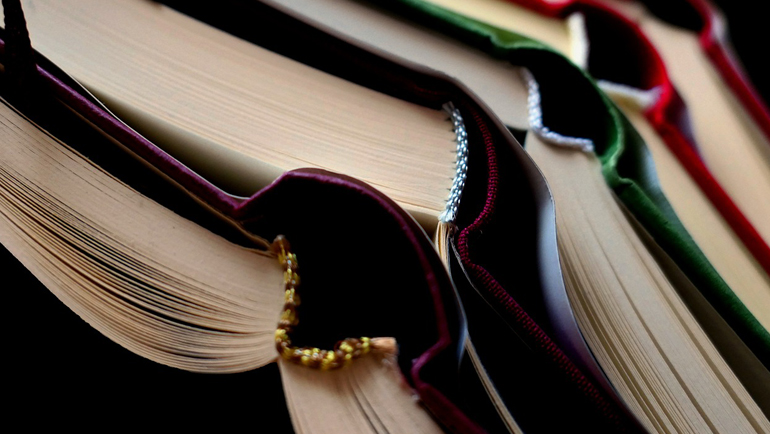بلاغة المشاكلة من خلال فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للإمام العلامة شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبيّ (ت:743هـ) – الحلقة التاسعة –
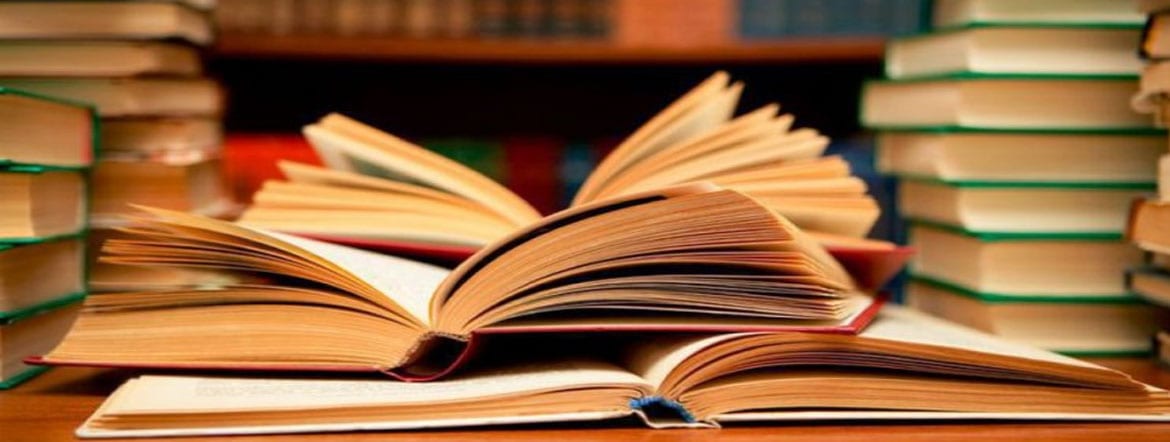
عُني الإمام الطيبي – رحمه الله تعالى – في فتوحه بتتبع النكت البلاغية المستكنة في كلام الله تعالى، واستقراء ما فيه من دقائق، وتتبع ما بين دفتيه من لطائف ورقائق، آخذا بإخذ العلامة اللغوي جار الله الزمخشري – رحمه الله تعالى – القائل: «ولله درّ أمر التنزيل وإحاطته بفنون البلاغة وشعبها، لا تكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه وأسدّ مدارجه» [2/382].
ومن الفنون البلاغية التي تعرض لها الإمامان «المشاكلة»، وهو فن بلاغي رفيع، وأسلوب في الكلام بديع.
تعريف المشاكلة:
المشاكلة في اللغة: الموافقة والمماثلة، وهي مصدر شاكَل، ويُقالُ: هَذَا أَمْرٌ لَا يُشاكِلُكَ، أَي لَا يُوافِقُكَ، كالتَّشَاكُلِ. والشَّكْلُ بالفتح الشِّبْه والمِثْل والجمع أَشكالٌ وشُكُول.[اللسان:شكل، التاج:شكل]
وفي الاصطلاح عرفه الطيبي – رحمه الله تعالى - في «فتوح الغيب (2/381)» بقوله: «المشاكلة وهي: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته»، وعرفه في «التبيان (ص:199)» بقوله: «والمُشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ مصاحبه لوقوعه معه، وهو إما حقيقي كقوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) [الشورى: 40]، وقوله تعالى: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ) [المائدة: 116]، وقول ابن كلثوم: [الوافر]
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا /// فنجهل فوق جهل الجاهلينا
...أو تقديري كقوله تعالى: (صبغةَ الله) جيء به وإن لم يصحبه لفظ الصبغ، ولكن سبب النزول دال عليه، وكذا قوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا) [البقرة: 26]، وقولك لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان، تريد رجلا يصطنع الكرام».
والمشاكلة إحدى المحسنات البديعية، وذكرها علماء الفن في مصنفاتهم، ومنهم: القزويني (ت:739هـ) في إيضاحه (ص:327)، وابن حجة الحموي (ت:837هـ) في خزانته (2/252)، وابن معصوم (ت:1119هـ) في أنواره (5/284)، وصفي الدين الحلي (ت:750) في شرح كافيته (ص:181)، وعبد الرحيم العباسي (ت:963هـ) في معاهده (2/252).
أما ابن أبي الإصبع العدواني (ت:654هـ) فسلك في تحريره (ص:393) مسلكا آخر، وكذلك ابن رشيق القيرواني (ت:463هـ) الذي أسماهُ بالمزاوجة، وقال: «ومن المزاوجة عندهم قول الله تعالى: (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)[النساء:142]، وقوله: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:94]، وقوله: (إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (*) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ...) [البقرة: 14- 15]، وكل هذه استعارات ومجاز؛ لأن المراد المجازاة فزاوج بين اللفظين»[1/331].
والمشاكلة أسلوب فاش في كلام العرب، وكثير في كلام الله تعالى، يقول الزجاج (ت:311هـ): « قوله عزَّ وجلَّ: (فَمن اعْتَدى عَليْكُمْ). أي من ظلم فقاتل فقد اعتدى، (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وسميَ الثاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتداء فسُمّيَ بِمِثل اسمه، لأن صورة الفعلين واحدة. وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية، والعرب تقُول: ظلمني فلان فظلمته أي جازيته بظلمه، وجهل عليَّ فجهلت عليه أي جازيته بجهله. قال الشاعر: [الوافر]
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا /// فنجهل فوق جهل الجاهلينا
أي فنكافئ على الجهل بأكثر من مقداره. وقال اللَّه عزَّ وجلَّ: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ)، وقال: (فَيسْخرون منهم سَخر اللَّهُ مِنْهُمْ). جعل اسم مجازاتهم مكراً كما مكروا، وجعل اسم مجازاتهم على سخريتهم سُخرياً، فكذلك: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ)»[معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 264-265)].
واختلف العلماء هل المشاكلة من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز، أو ليست حقيقة ولا مجازا؟ وقد لخص ذلك جلال الدين السيوطي (ت:911هـ) بقوله: «اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو: (ومكروا ومكر الله)(وجزاء سيئة سيئة مثلها) ذكر بعضهم أنه واسطة بين الحقيقة والمجاز، قال: لأنه لم يوضع لما استعمل فيه فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا كذا في شرح بديعية ابن جابر لرفيقه. قلت: والذي يظهر: أنها مجاز والعلاقة المصاحبة»، ونحوهُ في شرحه على «عقود الجمان»[الإتقان في علوم القرآن (3/141)، وشرح عقود الجمان (ص:254)].
أمثلة من أسلوب المشاكلة:
- قوله تعالى: (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) [البقرة:9]، قال الطيبي – رحمه الله تعالى -: «قوله: (وَمَا يَخْدَعُونَ إلاَّ أَنفُسَهُمْ)، ذكر لمشاكلته (يخادعون الله) المراد به الاستعارة كما سبق، أي: لما كان ذلك مبنياً على المفاعلة، جعل الذي من طرفٍ واحدٍ مثله، روماً للمشاكلة. قال الواحدي: فلما وقع الاتفاق على الألف في قوله (يُخَادِعُونَ اللَّهَ) أجرى الثاني على الأول، طلباً للتشاكل.
وقال المرزوقي في قول الطائي: [الكامل]
لا تسقني ماء الملام فإنني ... صبٌّ قد استعذبت ماء بكائي
لما قال في آخر البيت: ((ماء بكائي)) قال في الأول: ((ماء الملام)) فأقحم اللفظ على اللفظ إذ كان من سببه، كقوله تعالى: (وجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) [الشورى: 40] فالثانية جزاءٌ وليست بسيئةٍ، فجاء باللفظ على اللفظ إذ كان من سببه، فكذا ها هنا، لما كان خداع أنفسهم- أي: إيصال الضرر إليها- مسبباً عن تلك المخادعة المشبهة بمغافلة المخادعين ومصاحباً له، قيل: يخادعون، فجاء باللفظ على اللفظ»[2/167]
- قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا...)[البقرة:26]، فقوله: (لَا يَسْتَحْيِي) عند الزمخشريّ – رحمه الله تعالى - جار على سبيل التمثيل، « أي: لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيى أن يتمثل بها لحقارتها. ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة، فقالوا: أما يستحيى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال. وهو فنّ من كلامهم بديع، وطراز عجيب، منه قول أبي تمام:
مَنْ مُبْلِغٌ أَفْناءَ يَعْرُبَ كُلّها ... أَنِّى بَنَيْتُ الجَارَ قبْلَ المَنْزِلِ
وشهد رجل عند شريح. فقال: إنك لسبط الشهادة. فقال الرجل: إنها لم تجعد عنى. فقال: للَّه بلادك، وقبل شهادته. فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة المشاكلة. ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار. وسبوطة الشهادة لامتنع تجعيدها. وللَّه درّ أمر التنزيل وإحاطته بفنون البلاغة وشعبها، لا تكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه وأسدّ مدارجه».
يقول الإمام الطيبي –رحمه الله تعالى - : «اعلم أن ها هنا ألفاظاً يذكرها أرباب البديع، أحدها المقابلة: وهي الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما، وثانيها: المطابقة: وهي أن يجمع بين متضادين، وثالثها: المشاكلة وهي: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، والآية من قبيل النوع الأخير وإن سماه المصنف باسم النوع الأول، لكن المشاكلة على التقدير إذ لولا قولهم: أما يستحيي رب محمدٍ أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت على سبيل الإنكار لم يحسن قوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي) جواباً عنه، وبيت أبي تمام من المشاكلة التي لم ترد على السؤال والجواب وإن تأخر فيه المصاحب عن المصاحب، ومثله قوله:
لا تسقني ماء الملام فإنني ... صبٌّ قد استعذبت ماء بكائي
فإن المرزوقي عده من المشاكلة. وقول الشاهد: "إنها لم تُجعد عني" جواباً عن قول شريح: "إنك لسبط الشهادة" يحتمل أن يكون من المطابقة بالنظر إلى اللفظين؛ لأن السبط ضد الجعد، وأن يكون من المشاكلة، إذ لو قال شريحٌ: إنك لبديه الشهادة لم يحسن منه: لم تجعد عني. وموقع الاستشهاد هذا القسم، ولذلك قال: "لولا سبوطة الشهادة لامتنع تجعيدها»[2/380].
ثم قال: «وأما قوله: "فجاءت على سبيل المقابلة" فلم يرد منه المعنى المصطلح عليه بل ما يصح أن يقابل به الكلام؛ لأن قوله: "وإطباق الجواب على السؤال" عطفٌ تفسيريٌ عليه، والمصنف سلك في هذا المقام طريق التشابه في الكلام، فهو مفتقرٌ إلى تقادح الآراء واستنباط الأساليب حتى يصرح المحض» [2/381].
- قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ) [البقرة: 102]، قوله: فقوله(تتلو الشياطين) ذكر فيه الإمام الطيبي – رحمه الله تعالى – وجهين، وهو أن يكون «على سبيل المشاكلة التقديرية يشعر به قوله: "هو بين أيديهم يقرؤونه" كأنه قيل: تركوا قراءة كتاب الله، واشتغلوا بقراءة كتاب الشياطين، أو الاستعارة التهكمية؛ لأن التلاوة عرفاً خصت بقراءة القرآن»[3/22].
- قوله: (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) [البقرة: 138]، قال الزمخشري – رحمه الله تعالى -: « والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم، وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقاً، فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ)، وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا؛ أو يقول المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم، وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريقة المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان، تريد رجلاً يصطنع الكرام» [3/121]، قال الطيبي – رحمه الله تعالى -:« والمشاكلة واقعة بين فعل الغارس وقول القائل: اغرس، فإن المراد بقوله: "اغرس غرس الكريم" أي: أحسن إحسانه. فلولا فعل الغارس لم يحسن منه كما يغرس فلان، كما أن قوله: (صِبْغَةَ اللَّهِ) مشاكل لفعل النصارى وإن لم يوجد منهم قول»[3/121].
وفيه وجه آخر نبه إليه الطيبي – رحمه الله تعالى – بعدما أورد كلام القاضي وهو: «وقال القاضي: أي: صبغنا الله صبغته، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ، أو: هدانا هدايته وأرشدنا حجته، أو: طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره وسماه صبغة؛ لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب»، ثم قال الطيبي – رحمه الله تعالى -: «وقلت: فعلى هذا القول لا يكون مشاكلة، بل يكون استعارة مصرحة تحقيقية، والقرينة إضافتها إلى الله تعالى، والجامع على الأول- أي: على أن يراد بالصبغة: الحلية- التأثر والظهور على السيما، وعلى الوجوه الثلاثة الجامع الظهور والبيان، وهذا التأويل أظهر وأنسب من المشاكلة؛ لأن الكلام عام في اليهود والنصارى كما سبق تقديره، وتخصيصه بصبغ النصارى لا وجه له، ولأن قوله: (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) [البقرة: 93] عبارة عن حب عبادة غير الله. قال المصنف: "معناه: تداخلهم حبه والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب الصبغ"، فكذا ينبغي في عبادة الملك العلام».[3/123].
- قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) [البقرة: 193]، قال الزمخشري – رحمه الله تعالى : «(فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) فلا تعدوا على المنتهين؛ لأنّ مقاتلة المنتهين عدوان وظلم، فوضع قوله: (إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) موضع: على المنتهين؛ أو فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين؛ سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة»، قال الإمام الطيبي – رحمه الله تعالى -: «قوله: (أو: فلا تظلموا) معطوف على قوله: "لا تعدوا" فعلى هذا: (إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) قار في موضعه، لكن (فَلا عُدْوَانَ) وضع موضع "لا تقاتلوا، ولا تتعرضوا" على سبيل المشاكلة بحسب المعنى، ولهذا قال: "ولا تظلموا إلا الظالمين"، ومعنى الحصر على هذا: فإن انتهوا فلا تقاتلوهم، وقاتلوا غيرهم من المشركين الذين ليسوا بمنتهين، يعني: لابد لكم من المقاتلة مع مخالفيكم، فإذا انتهى هؤلاء من المخالفة فاتركوهم وقاتلوا غيرهم، فوضع "لا تظلموا" موضع لا تقاتلوا للمشاكلة. والفرق بين هذا الوجه الأول هو أن قوله: "فلا عدوان" على الأول: كناية عن قوله: "فلا تقاتلوهم" على سبيل المبالغة، وعلى الثاني لمجرد التحسين في الكلام، وأن النهي عن العدوان على المنتهين على الأول مقصود دون ما يعطيه اللفظ من معنى العدوان على الغير بالحصر؛ لأن الكناية لا توجب إثبات التصريح كما تقول: فلان طويل النجاد، فإنه لا يوجب إثبات نجاد وطوله، وعلى الثاني نهي المقاتلة عنهم وإثباتها للغير مقصودان». [3/265].
- قوله تعالى: (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) [آل عمران: 115]، قال الزمخشري: «لما جاء وصف اللَّه عز وعلا بالشكر في قوله: (وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) [التغابن: 17] في معنى توفيه الثواب ـ نفي عنه نقيض ذلك»، قال الطيبي: «يعني: لا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى الكفران؛ لأنه ليس لأحد عليه نعمة حتى يكفره، لكن لما وصف سبحانه وتعالى بالشكور في تلك الآية، والشكور: مجاز عن توفية الثواب، نفى عنه سبحانه وتعالى على سبيل المشاكلة الكفران الذي هو مجاز عن تنقيص الثواب» [4/225].
- قوله تعالى: (...... وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (*) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا...) [البقرة:106-107]، قال الإمام الطيبيّ – رحمه الله تعالى -: «وقلت: الحق أن يكون استحق مسنداً إلى الإثم، وأن يكون من باب المشاكلة والتضمين لقوله: "ومعناه: من الذين جُني عليهم"، والذي دعاه إلى هذا دعاه إلى هذا التأويل ابتناء قوله: (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) على قوله: (إِنَّا إِذاً لَمِنْ الآثِمِينَ)؛ لأن المعنى: إن كتمنا الحق كنا من الخائنين، ثم إن اطلع على أنهما قد خانا وجنيا على المشهود عليه واستحقا إثماً بذلك فآخران يقومان مقامهما بالشهادة، فكني عن قوله: "قد خانا وجنيا" بقوله: (اسْتَحَقَّا إِثْماً) ليُشاكل الكلام السابق وهو: (إِنَّا إِذاً لَمِنْ الآثِمِينَ)، يدل عليه قوله: "واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الآثمين"، ثم عبر عن المشهود عليهم بقوله: "استحق عليهم الإثم" ليشاكل ما عبر به عن الجاني، وهو (اسْتَحَقَّا إِثْماً)؛ لأن الجاني إذا كُني عنه بأنه استحق الإثم فالمناسب أن يثكنى عن المجني عليه بقوله: استحق الإثم عليه، فقول المصنف: "من الذي جنى عليهم" تخليص المعنى وزُبدته» [5/520].
- قوله تعالى: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) [المائدة: 116]، قال الزمخشري – رحمه الله تعالى-: «والمعنى: تعلم معلومى ولا أعلم معلومك، ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينه، » قال الطيبي – رحمه الله تعالى - في تفصيل كلامه: «قوله: (سلك بالكلام طريق المشاكلة)، يعني: لو لم تُقل: (مَا فِي نَفْسِي)، لم يجز أن يقال: (وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ)؛ لأنه لا يجوز أن يُطلق على الله ابتداء اسم النفس، قال الزجاج: النفس في كلامهم لمعنيين، أحدهما: قولهم: خرجت نفس فلان، وفي نفس فلان أني فعل كذا، وثانيهما: جملة الشيء وحقيقته، تقول: فلان قتل نفسه، أي: ذاته، وليس معناه أن القتل وقع ببعضه، فمعنى (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي) أي: ما أضمره ولا علم ما في حقيقتك وما عندك علمه، أي: تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم.
وقلت: ولابد من الإقرار بالمشاكلة؛ لأن "ما في النفس"- إن أريد المضمرات - فلا مطابقة من جانب الله، فيجب القول بالمشاكلة، وإن أريد ما في الحقيقة والذات فالمشاكلة من حيثالإدخال في الظرفية على أن لابد من القول به من جانب العبد؛ لأن المراد ما في الضمير؛ لقوله: (فِي نَفْسِي): في قلبي، الراغب: ويجوز أيضاً أن يكون القصد إلى نفي النفس عنه، فكأنه قال: تعلم ما في نفسي ولا نفس لك فأعلم ما فيها، كقول الشاعر:
لا ترى الضب بها ينجحر
أي: لا ضب ولا جُحر بها، فيكون من الضب الانجحار».[5/541]
قوله تعالى: (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:126]، قال الزمخشري –رحمه الله تعالى -: «سمي الفعل الأول باسم الثاني؛ للمزاوجة. والمعنى: إن صنع بكم صنيع سوء؛ من قتل أو نحوه، فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه»، ثم قال الطيبي – رحمه الله تعالى -: «قوله: (سُمي الفعل الأول)، أي: (فَعَاقِبُوا) باسم الثاني، وهو: (بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)، وهو من باب المشاكلة، سماه المزاوجة لغة، وإنما المزاوجة: بين معنيين في الشرط والجزاء، كقول الشاعر:
إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى ... أصاخ إلى الواشي فلج به الهجر» [9/227]
- قوله تعالى: (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (*) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (*) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) [الكهف: 29 - 31]، قال الزمخشري:« (وَساءَتْ) النار (مُرْتَفَقاً) متكا من المرفق، وهذا لمشاكلة قوله: (وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً)، وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء، إلا أن يكون من قوله:
إنيّ أرقت فبتّ اللّيل مرتفقًا ... كأنّ عينى فيها الصّاب مذبوح»
قال الإمام الطيبي –رحمه الله تعالى-:«أراد أن الآية الثالثة مقابلةٌ لهذه، وهي مفصلةٌ بذكر الارتفاق، فأوجب بموجب المشاكلة المجاوبة بين القرينتين وإن تأخر المتبوع عن التابع، ولولا المشاكلة كان إثبات (مُرْتَفَقاً) للكفار على سبيل التهكم كإثبات (يُغَاثُوا) لهم»[9/465]
- قوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[النور: 45]، في قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ)، قال الزمخشري: «فإن قلت: لم سمي الزحف على البطن مشياً؟ قلت: على سبيل الاستعارة، كما قالوا في الأمر المستمر: قد مشى هذا الأمر، ويقال: فلانٌ لا يتمشى له أمر. ونحوه استعارة الشفة مكان الجحفلة، والمشفر مكان الشفة، ونحو ذلك، أو على طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين»[11/121]
- قوله تعالى: (فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ)[الشعراء:45-46]، قال الزمخشري – رحمه الله تعالى -: «وإنما عبر عن الخرور بالإلقاء، لأنه ذكر مع الإلقاآت، فسلك به طريق المشاكلة. وفيه أيضا مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما رأوا، لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين، كأنهم أخذوا فطرحوا طرحا» [11/357].
- قوله تعالى: (قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) [النمل: 47]، يحتمل أن تكون الآية من باب الاستعارة، أو من باب المشاكلة يقول الإمام الطيبي – رحمه الله تعالى-: «استعير لقدر الله وقسمته لفظ الطائر، لأن السبب في تحصيل الخير والشر حقيقة هو قدر الله، وأن السانح والبارح- كما زعموا- إن دلا على حصولهما فهما أيضًا مسببان عن تقدير الله، فأطلقوا المسبب وهو الطائر على السبب، وهو قدر الله وقسمته، وقالوا: طائر الله لا طائرك، ويجوز أن يكون أسلوب الآية والاستشهاد من باب المشاكلة لا الاستعارة».[11/539]
- قوله تعالى: (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (*) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ) [السجدة: 19، 20])، فالمأوى هو المكان الذي يَقصدُه الرَّجلُ للسّكونِ والاستراحَة أو الالتجاء.فاستعماله في النّار من التَّهكُّم، قال الإمام الطيبي –رحمه الله تعالى-: «ويجوز أن يكون من باب المُشاكَلَةِ؛ لأنّه لما ذَكَر في أحد الفَصلَين (فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَى) ذَكَر في الآخَرِ (فَمَأوَاهُمُ النَّارُ)»[12/350].
- قوله تعالى: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) [سبأ: 13]، قال الزمخشري – رحمه الله تعالى -: «ومعناه: إنا سخرنا لكم الجنّ يعملون لكم ما شئتم، فاعملوا أنتم شكرا، على طريق المشاكلة»، وقال الطيبي – رحمه الله تعالى - موضحا:«يعني: كانَ أصلُ الكلام: اشكروا الله آلَ داود شكرًا، فأقيمَ مُقامَ ((اشكروا)): (اعْمَلُوا)؛ ليشاكل قوله: (يَعْمَلُونَ لَهُ)»[12/523].
- قوله تعالى: (وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ) [سبأ: 16، 17]، قال الزمخشري – رحمه الله تعالى-: «وتسمية البدل جنتين؛ لأجل المشاكلة، وفيه ضرب من التهكم»؛ لأن الجنة ما فيه أشجار مثمرة!
- قوله تعالى: (لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ) [غافر: 43]، قال الطيبي – رحمه الله تعالى -: « قوله: (سميت الاستجابة باسم الدعوة)، يعني: أنه من باب المشاكلة، وأصله: إن الذي تدعونني ليس له استجابة، أي: لا يجيب دعوتي، كما في قولك: كما تدين تدان، أي: كما تجازي تجازى، وأصله: كما تفعل تجازى، لكن قيل: كما تجازى؛ لوقوعه في صحبة "تجازى" الثاني.»[13/519]
- قوله تعالى: (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَاواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) [الجاثية:34] قال الطيبي – رحمه الله تعالى - : «يعني: أن الاشتغال باللذات والانهماك في الشهوات أذهلكم وألهتكم عن تذكر العاقبة، وسلط عليكم نسيانها، فيكون قوله: (إِنَّا نَسِينَاكُمْ) واردًا على المشاكلة، وإن تقدم على صاحبه، يعني: جازيناكم جزاء نسيانكم، والله أعلم»[14/262].
- قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح:10]، قال الزمخشري:«لما قال: (إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ) أكده تأكيدًا على طريقة التخييل، فقال: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)، يريد: أن يد رسول الله التي تعلو أيدي المبايعين: هي يد الله، والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام، وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله، من غير تفاوت بينهما، كقوله: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ) [النساء: 80]، والمراد: بيعة الرضوان»، وقال الإمام الطيبي: « لما روعيت المشاكلة بين قوله: (إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ) وبين قوله: (إنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ)، بني عليها قوله: (يَدُ اللَّهِ) على سبيل الاستعارة التخييلة، تتميمًا لمعنى المشاكلة، وهو كالترشيح للاستعارة، أي: إذا كان الله مبايعًا، ولا بد للمبايع - كما تعورف واشتهر - من الصفقة باليد، فتتخيل اليد لتأكيد معنى المشاكلة، وإلا فجل جنابه الأقدس عن الجارحة.
هذا هو المراد من قول صاحب "المفتاح": "وأما حسن الاستعارة التخييلية: فأن تكون تابعة للكناية، ثم إذا انضم إليها المشاكلة كانت أحسن وأحسن"»[14/282]