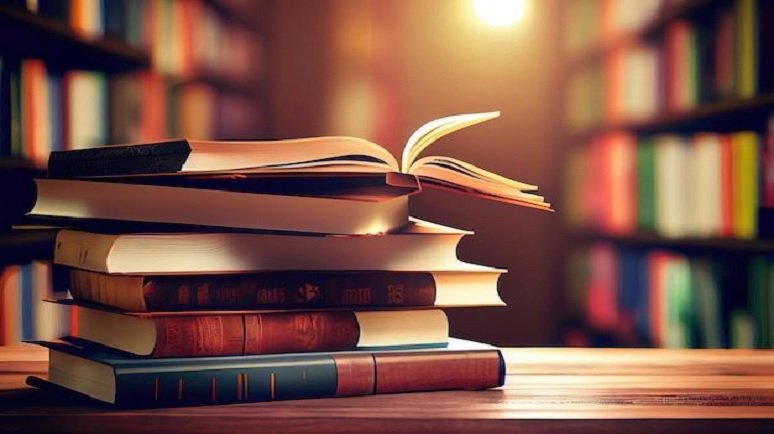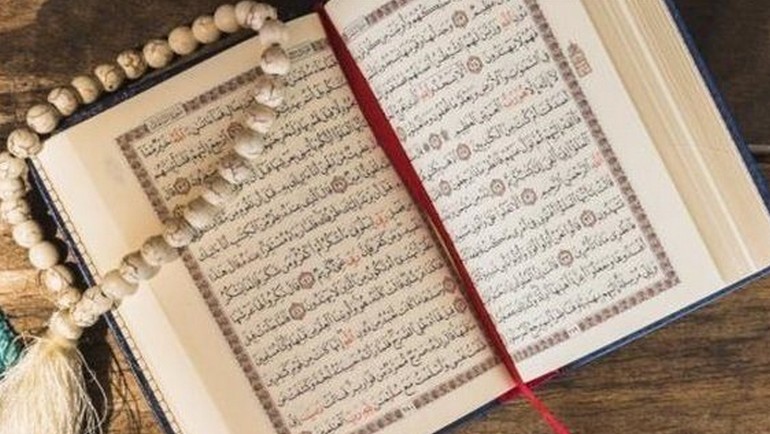يتميز العمل الصوفي بأبعاد روحية ومعان ذوقية، من خلال تفاعل العلم والتجربة، وتعالق الفكر والوجدان، أو العقل والقلب. فحقيقة التصوف تتحصل عن طريق الممارسة والتجربة عملا بالفرائض وزيادة في النوافل، ف«الأذواق التي يشير إليها القوم هي علوم لا تُنال إلا لمن كان خالي القلب من جميع العلائق والعوائق كلها»[1]، والمعاني الصوفية ليست من قبيل التعلم، كما هو شأن باقي المعارف الأخرى، وإنما هي مواهب وإشارات يتذوقها السالك أثناء تدرجه في مقامات القرب، تكون له استئناسا لمواصلة السير، ودعامة للمزيد من الاشتغال والتقرب، وذلك من أجل تحصيل سلامة قلبية، يكون باطن السالك إذّاك مُهيّئا لتلقي المعارف ربانية، تزيده اطمئنانا ورسوخا لما هو فيه، كما أنها تدفعه للمزيد من العمل والرقي في مدارج الكمالات الخلقية. فالعلوم والمعارف هي ثمرات التصفية والتطهير، «فإذا تطهرت الأسرار ملئت بالعلوم، والمعارف والأنوار، ولا يصح الانتقال إلى مقام حتى يحقق ما قبله، فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته، فلا ينتقل إلى عمل الطريقة حتى يحقق عمل الشريعة وترتاض جوارحه معها، بأن يحقق التوبة بشروطها، ويحقق التقوى بأركانها، ويحقق الاستقامة بأقسامها، وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، فإذا تزكى الظاهر وتنوّر بالشريعة انتقل من عمل الشريعة إلى عمل الطريقة الباطنة، وهي التصفية من أوصاف البشرية على ما يأتي. فإذا تطهر من أوصاف البشرية تحلى بأوصاف الروحانية، وهي الأدب مع الله في تجلياته التي هي مظاهره، فحينئذ ترتاح الجوارح من التعب وما بقي إلا حسن الأدب. قال بعض المحققين: «من بلغ حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن العمل، ومن بلغ إلى حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل بسوى الله، ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله»[2]. والمعاني الصوفية الحقة لا تحصل إلا بعد تخلية الباطن من السوى، وتحليته بفضائل الأخلاق وأنوار التجليات، حينها يكون السلوك الإنساني آمنا من الانحراف، وفاعلا في التأثير والتوجيه، فلا يصح الإنكار على أهل التصوف، بدعوى أن مستنبطاتهم هي من قبيل التخيل والبدع، لما في ذلك من أسباب الفصل والانقطاع بين العمل كوسيلة للتعمق في ثنايا الخطاب الشرعي، والنظر المسدد كآلية لإدراك مقاصد المشرع، والتجربة الحية كمنهج للتحقق بالكمالات الخلقية، بل إن مسلك المعرفة الصوفية، يعتبر من أدق الطرق التي يمكن أن يسلكها غيرهم، باعتبار أن مسلكهم قائم على العلم والعمل، والباطن والظاهر، والشريعة والحقيقة.
لذلك، يكون السلوك الصوفي ليس تحصيلا لتصور ذهني في مجال العقيدة، بقدر ما هو عبارة عن التحقق الوجداني بها، وهو الأمر الذي نجده متجليا من خلال مأثورات رجال التصوف، فالعقائد لها جانبان، موضوعي معروف، وذاتي عارف. فالصوفي عمل على تحويل هذا النسق العقدي من الثبات إلى الحركة، ومن التجريد إلى العيان، عن طريق إعادة صياغة التوحيد من منطلق التجارب الروحية، أي انطلاقا من مدرك القلب أو الروح[3]، على اعتبار أن مراتب الإدراك تختلف من مرتبة إلى أخرى، فما كان من مدارك الشهوات فمدركه النفس، وما كان من مدارك الأحكام الشرعية فمدركه العقل، وما كان من مدارك التجليات والواردات فمدركه الروح، وما كان من مدارك التحقيقات والتمكنات فمدركه السر، والمحل واحد[4]. «فإذا استثنينا رجال التصوف فليس من لم يغلب حديثه في العقل على حديثه في القلب، لكي ينتهي في آخر المطاف إلى تغييب معنى القلب، ويكاد هذا التغييب يبلغ حد النسيان الكلي عند جمهرة من المتفلسفة، منهم لشدة افتتانهم بالمنقول اليوناني، بل لضيق تصورهم لمضامين الفلسفة وآلياتها حتى توهموا أن الفلسفة لا تمارس إلا على طريقة واحدة، وهي طريقة الإغريق، أما الفقهاء والأصوليون والمتكلمون فإنهم إذا تعرضوا لمفهوم القلب عند تناولهم للعقل والمعقول والمعاني المعقولة في باب العلل والمقاصد، حصروا كلامهم من جهة أنه محل الاعتقاد والنية، ثم لم يلبثوا أن ينصرفوا عنه إلى كلام غيره...علما أن عدد الآيات التي ذكر فيها لفظ القلب مفردا ومثنى وجمعا تبلغ اثنين وعشرين ومائة آية، منها الآيات التي تربط القلب بالإدراك، إحداها الآية الكريمة ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا يفقهون بها﴾، ويبلغ العجب مداه حين نراهم يقيمون علم الشريعة تحت مسمى الفقه ولا يولون فيه لموضوع القلب أية عناية خاصة، مع أن لفظ الفقه في صيغة الفعل منسوب إلى القلب في سبع آيات، منها آية ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها﴾ وكذلك الآية ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾»[5].
وعلى الرغم من هذا الإيمان الوجداني المأثور عن رجال التصوف، إلا أن كمال الوصول عندهم يرتد إلى العجز والحيرة، على اعتبار أن كل ما يتسع به اللسان أو يشير إليه البيان من تعظيم أو تجريد أو تفريد فهو معلول، والحقيقة وراء ذلك، أي أن كل ذلك من أوصاف العبد وصفاته، وصفاته معلولة مثله، وحقيقة الحق هو وصفه له[6]. وعلى كون أن الصوفي العارف يستغرق في بحار التوحيد، والمشاهدة الإلهية، فإن أمر العقل ليس مغيبا على الإطلاق، بل إن من تدبر الكتابات الصوفية «يكشف على أنها لم تكن صنيعة الذوق الخالص، بل إن للعقل فيها نصيبا»[7]، وكأن الصوفي بعد ما تتحقق بأصل الاعتقاد في الوعي الروحي، فإنه يعمل على بلورته وفق أصول العقل النظري، كما هو الشأن في كتابات أبي حامد الغزالي والقشيري، بما يبطل معه أن التصوف رد فعل على التوحيد الكلامي الذي يقوم على التفريق بين الخالق والمخلوق، الله والعالم، القديم والحديث[8]، وإنما جاء رجال للارتقاء بهذه المعاني التوحيدية إلى مستوى الشعور القلبي، والانفعال الوجداني، علما بأن هذه الأصول النظرية إنما تمت صياغتها من أجل الدفاع عن المعتقد الديني، وليس من أجل الرسوخ المعرفي.
هـــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــــــش
[1] القاشاني: لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، (2/386).
[2] أحمد بن عجيبة: إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري، (ص: 31).
[3] حسن حنفي: من الفناء إلى البقاء، (2/489).
[4] ابن عجيبة: إيقاظ الهمم، (ص 25).
[5] طه عبد الرحمان: سؤال العمل، (ص 70).
[6] الكلاباذي: التعرف، (ص 135).
[7] بن الطيب: وحدة الوجود: (ص 56).
[8] حسن حنفي: من الفناء إلى البقاء، (2/505).