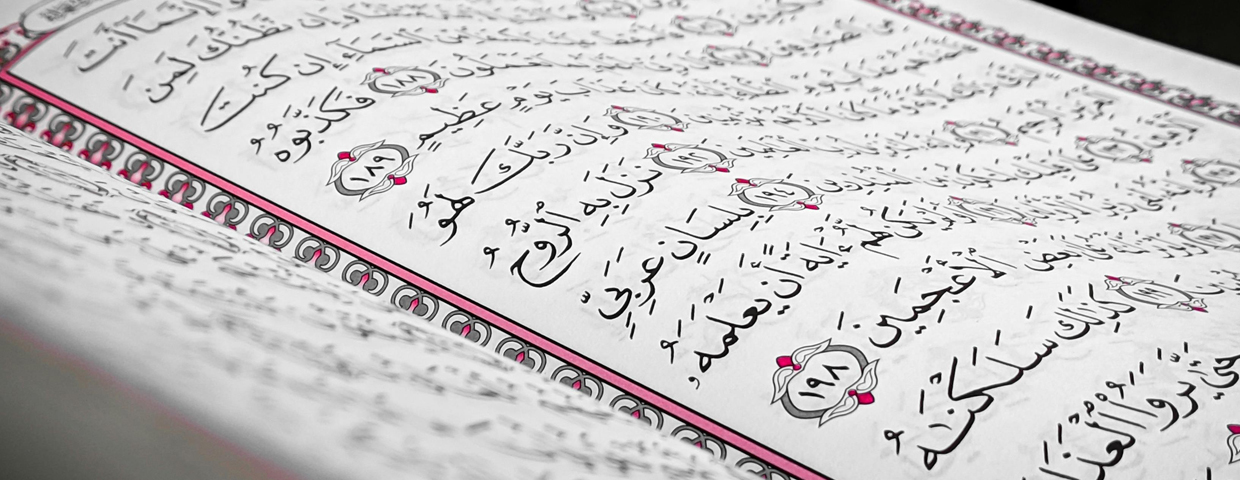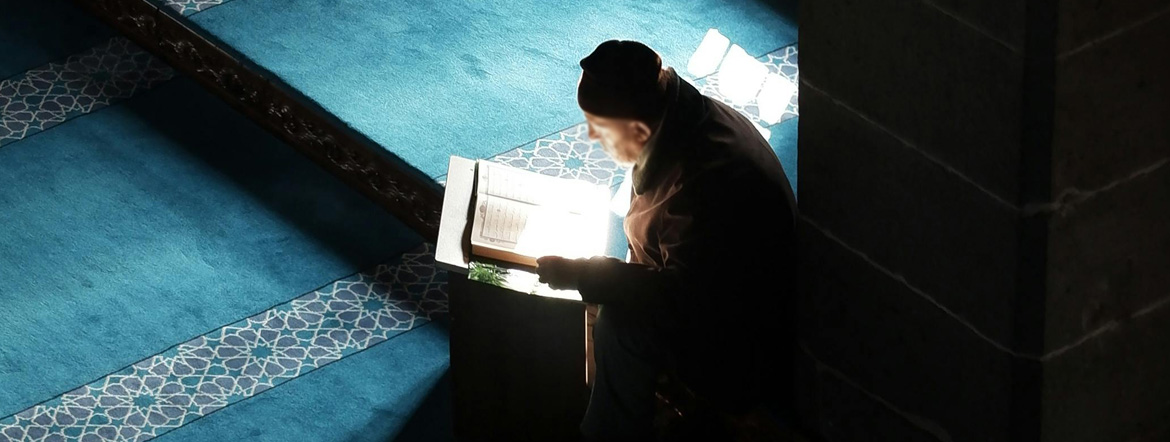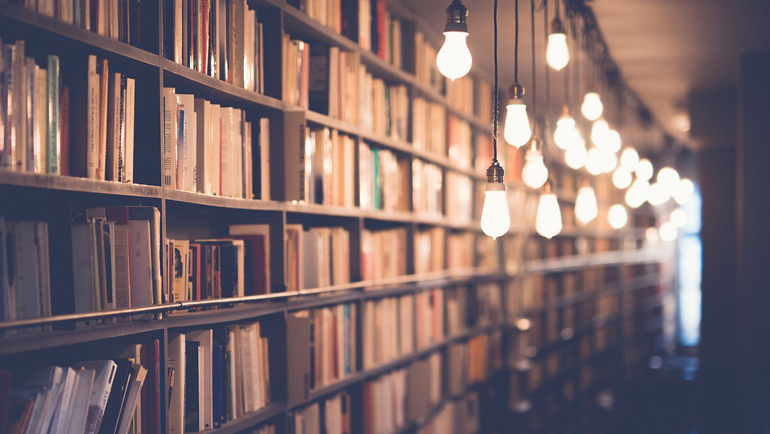
يندرج موضوع رؤية العالم فلسفيا في الإشكالية التأويلية المعاصرة التي برزت في نهاية القرن التاسع عاشر في سياق مشروع بناء "علوم الروح" أو "العلوم الإنسانية" في مقابل "علوم الطبيعة" أو "علوم التجربة"، وأخذت منعرجا هاما مع المدرسة الظاهراتية الهوسرلية بامتداداتها الثرية المتنوعة.
وقد تمحورت الإشكالية التأويلية للمعنى في ثنائية الذات والوجود، عبر مسلكين متمايزين: مسلك نقدي يتعلق بشروط تلقي النص وتفسيره، ومسلك أنطولوجي يتعلق بالعالم الذي يحيل إليه النص وينكشف من خلاله.
سنعالج في هذا البحث رؤية العالم في الفلسفات المعاصرة من خلال هذا التأرجح بين بعدي النص والوجود، من خلال محطات ثلاث تختصر حسب اعتقادنا الأطر النظرية الكبرى للمسالة التأويلية: التأويلية النقدية لدي وليام دلتاي، والتأويلية الأنطولوجية لدى غدامر (مع تمهيد يخص أستاذه هايدغر) والتأويلية الإنشائية لدى بول ريكور.
أولا: رؤية العالم في التأويلية النقدية: وليام دلتاي
اشتهر مفهوم "رؤية العالم" weltanschauung في الفلسفة الحديثة لدى الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني "وليام دلتاي" (ت1911م) رغم أن العبارة تعود في أصلها إلى: "إمانويل كانط" الذي استخدمها بمعنى حدس العالم عن طريق الحواس ,كما استخدمها "شلنغ" بمعنى الأثر اللاشعوري للتعقل.
ومن الجلي أن دلتاي هو الذي أخرج هذا المفهوم من دلالته الضيقة الأصلية المتعلقة بخارطة المعرفة، إلى دلالته الواسعة المتعلقة بالتجربة الحيوية والتصورات الكلية الجماعية التي تتوقف عليها مثل وقيم مؤسسة فاعلة ومؤثرة في النشاط الفردي والاجتماعي، مما يحمل بصمات الاتجاهات الرومانسية التي ينتمي إليها دلتاي.
ولابد من التنبيه أن مفهوم "رؤية العالم" يتحدد إجمالا وفق الإشكالية العامة في فلسفة دلتاي التي تتلخص في استكمال المشروع النقدي الكانطي بكتابة "نقد للعقل التاريخي" يشكل الإطار المنهجي لبناء علوم تأويلية للإنسان من حيث هي علوم للروح تتعلق بدلالات ورموز الحياة البشرية؛ أي بالطبيعة الإنسانية كما تتجلى في أشكال تاريخية معيشة من منظور كلي مقارن.
انطلق دلتاي من نقد ابستيمولوجي للنزعات الوضعية الطبيعية في طموحها لإخضاع الظواهر الإنسانية للمنطق التجريبي الاختباري. العلوم الإنسانية أو علوم الروح هي التي "يتحقق" من خلالها "بناء العالم التاريخي"، وتعني عبارة العالم التاريخي حسب اصطلاحات دلتاي "المجموع الذهني الذي يتوسع باطراد عبر تتابع أنماط من التحقق تستند لتجربة معيشة وتجربة معنى حيث تعضد المعرفة الموضوعية للعالم التاريخي وجودها([1])".
ثمة، إذن، علاقة عضوية بين البناء التصوري لعالم الروح ونمط معرفته التاريخية الموضوعية، أي بين التجربة الحية المعيشة ونمط فهمها والتعبير عنها. ومن هنا ليس الجانب الشعوري الذاتي عائقا أمام المعرفة الموضوعية بالظاهرة الإنسانية كما تقول الأطروحة الوضعية التجريبية، وإنما هو شرط هذه المعرفة التي تقف عند "الوحدات الحيوية المتفردة" التي هي تحديدات موضوعية للتجربة الروحية قابلة للدراسة والاستكناه([2]).
فلا سبيل للفصل بين مكونات الدائرة التأويلية التي يتشكل منها النسق الثلاثي: الحياة والتجربة الحيوية وعلوم الروح.
بذا يبرز مشروع دلتاي في طموحه لوضع مقاربة ابستيمولوجية للظواهر الإنسانية المعيشة عبر تحليلية تناسبها أطلق عليها مقولة "الفهم" understanding في مقابل "التفسير" explanationالذي يناسب العلوم التجريبية في وصفها للظواهر الطبيعية.
يوضح دلتاي مقولة الفهم بقوله أنه "المسار الذي من خلاله نعرف أمرا "داخليا" بالاتكاء على علامات تدرك من الخارج عن طريق حواسنا([3])".
في ما وراء هذا المستوى الأولي الأعم، يرجع دلتاي إلى تأويلية "شلرماخر" (ت 1834م) في توسيعه لمصطلح الفهم إلى ضبط الدلالة الأصلية للعمل المقروء في تميزه (التأويل في بعديه: النحوي grammatical والنفسيpsychological )([4]). وهكذا نمر من المستوى المعرفي الأولي أي الفهم بصفته تلقيا للمعطيات الحسية إلى المستوى النفسي، ثم بالمستوى التأويلي المتعلق بالأعمال المكتوبة بصفتها تجارب نفسية وحيوية([5]).
الفهم بهذا المعنى الموسع هو المنهج الأساسي للعلوم الإنسانية (أو علوم الروح أو العلوم الأخلاقية حسب عباراته).
فإذا كانت العلوم التجريبية تتوصل للقوانين الضابطة للظواهر من خلال ما يقبل القيس والضبط في التجارب الحية والقواعد الناظمة لها ,فان الطابع الموضوعي الكلي في المقاربة الفهمية للظواهر الأخلاقية يستند للمعيار التجريبي نفسه من خلال رصد ومقارنة تجارب الحياة النفسية([6]).
من الواضح هنا الإطار الابستيمولوجي لتأويلية دلتاي في سعيها للتأسيس المنهجي للعلوم الإنسانية في تميزها عن علوم الطبيعة موضوعا (الحياة الروحية في مقابل الظواهر الطبيعية) وطريقة (الفهم مقابل التفسير).
رؤى العالم بهذا المعنى هي مواقف حيوية وتصورات معبرة عن حالات نفسية متفردة ضمن المنظور الكلي للحياة، مميزا هنا بين ثلاث رؤى رئيسية للعالم: فلسفية وقانونية وفنية، تناسبها أطر تصورية هي النزعة الطبيعية (النظرة البيولوجية الغريزية للإنسان) والمثالية الذاتية (الإرادة الحرة للروح في استقلاليته عن الطبيعة) والمثالية الموضوعية (أي انسجام الفرد والعالم والانسجام الكلي للكائنات).
ويقدم دلتاي قراءة تاريخية لمسار تشكل وتطور رؤى العالم المتعلقة بالعصور الحديثة منذ لحظة النهضة والإصلاح الديني من خلال التحليل المزدوج للأعمال الفردية والسياقات الثقافية الكلية([7]).
ثانيا: رؤية العالم في تأويلية الوجود
مع أنه من غير الدقيق تصنيف أعمال دلتاي في المدرسة الظاهراتية Phenomenology، إلا أن قرابته الفكرية بهوسرل (ت 1938م) معروفة رغم الانتقادات التي وجهها الأخير لدلتاي في أعماله الأولى قبل أن يتبنى تصوراته النفسية للذات القصدية من حيث هي أنا روحي، أي كذات في علاقة معرفية وشعورية بالعالم([8]).
وقد شغل موضوع رؤية العالم التأويليات الوجودية التي برزت في سياق التصورات الظاهراتية، خصوصا لدى "كارل ياسبرز" (ت1969م) و"مارتن هايدغر" (ت1976م)، قبل أن تكتمل نظريا في أعمال فيلسوف التأويلية الأهم في العصر الراهن "هانس جورج غدامر" (ت2002م).
يتبنى "ياسبرز" تصورات دلتاي الابستيمولوجية في مقاربته النفسانية، مميزا بين منهج الفهم المتعلق بالعالم المعيش والحيوي (التمثل الحدسي والتفاعل بين البشر) ومسلك التفسير السببي الاستقرائي([9]).
يرتبط مفهوم رؤية العالم عند ياسبرز بهذا التصور لتأويلية التفاعل البشري، من منطلق أن رؤية العالم تعد أكثر من معرفة، "بل تتضمن أيضا المقولة التي ينظر إليها أحيانا بأنها مقابلة لها أي عبارة رؤية الحياة: الطريقة التي يقوِّم بها الفرد الأشياء، ما يهمه مطلقا وما لا يمنحه سوى قيمة نسبية، الطريقة التي يسلك وما ينتج عنها من فعل. رؤية العالم هي مبدأ هذا التقويم والممارسة السلوكية والعملية مصاغا بطريقة عامة([10])."
يخرج ياسبرز مفهوم رؤية العالم من التصورات الابستيمولوجية والنفسية ويرى أن الفلسفة هي وحدها التي يمكن أن تبلور رؤية متناسقة ومكتملة للعالم.
أما هايدغر في عمله الرئيسي الأول "الكينونة والزمان"، فإنه يتبنى بوضوح نقد أستاذه هوسرل لتأويلية دلتاي في نزعته النفسانية التي تفضي، حسب عبارته، إلى نمط من "فلسفة الحياة النسبية([11])".
بيد أن هايدغر في هذه المرحلة من فكره الفلسفي (نهاية العشرينيات) لا يبتعد عن التصور الحيوي لرؤية العالم كما قدمه دلتاي، باعتباره يعرف رؤية العالم بكونها صورة مقترنة باقتناع قوي حيث تلتقي أبعاد ثلاثة متعاضدة هي: التجربة المعيشة وصورة العالم والمثال آو النموذج الحي للعيش([12]).
بيد أن "هايدغر" سرعان ما رفض مفهوم رؤية العالم باعتباره تصورا موغلا في الذاتية يقوم على تصور تمثلي للعالم؛ فكل تصور للعالم يحوله إلى موضوع وكائن وينفي سمته الوجودية، في حين يقف هايدغر عند ظهور الدازين Dasein؛ (أي الوجود في العالم) بصفته ليس علاقة معرفية أو نظرية، بل تجربة أنطولوجية كثيفة.
رؤية العالم وفق هذا التصور هي حسب عبارة هايدغر "أخذ موقع في الكينونة ضمن العالم"، فلا يمكن القول إن للدازين رؤية للعالم، بل هو رؤية للعالم ([13]).
في المحاضرة الهامة التي ألقاها هايدغر في فرايبورخ سنة 1938 حول "عصر تصورات العالم"، يتحول مفهوم رؤية العالم إلى خاصية من خاصيات العصور الحديثة بصفتها قائمة على معيار "التمثل" representation؛ أي تأكيد مرجعية الإنسان وأولويته من خلال الرؤية التقنية للوجود بما تتأسس عليه من إرادة وتصرف وتخطيط.
في هذه المحاضرة تبرز بقوة أطروحة هايدغر حول التقنية بصفتها "جوهر الميتافيزيقا الحديثة([14])".
التقانة هي الرؤية الموضوعية للظاهرة سواء كانت طبيعية أو تاريخية تتعلق بالموجود المادي أو الروحي، بحيث تصبح المعرفة نشاطا بحثيا يختزل الوجود في المدى القابل للاستغلال والصياغة الموضوعية والتحقق الإجرائي.
في هذا التحول الذي يسم العصور الحديثة تتغير ماهية الإنسان الذي يصبح "ذاتا" بمعنى أنه يغدو "المركز المرجعي" للموجود الذي يستحضره بالتصور ويمتلكه بالتخطيط والتحكم.
بهذا المعنى لا يمكن القول إن البشرية انتقلت في العصور الحديثة من تصور للعالم (تصور العصور الوسطى) إلى تصور جديد مختلف في المرجعية والدلالة، لأن مفهوم تصور العالم لم ينشأ إلا في العصور الحديثة التي حولت معرفة العالم إلى مقاربة تصورية له.
بالنسبة للعصور الوسطى كان ينظر للموجود بأنه مخلوق، من إبداع علة أسمى، ومن ثم فإن كينونة الموجود تعني انتماؤه لدرجة ما من نظام الخلق وبالتالي الانسجام مع العلة المسببة. وبهذا المعنى لا يمكن للموجود المخلوق أن يكون موضوعا قائما بذاته في صلة تمثلية بالذات، كما أن التصور اليوناني للموجود لا يقبل المعنى التصوري باعتباره يعني ما ينفتح ويتفتق وينكشف للإنسان لا ما يتأمله الإنسان ويتمثله.
تعني مقولة التمثل الحديثة؛ استحضار الموجود بصفته موضوعا تمتلكه الذات وتتحكم فيه([15]). وهكذا يصبح العالم "مثالا متصورا" ويصبح مفتاح مسار العصور الحديثة هو "غزو العالم من حيث هو شكل متصور([16])".
ندرك من هذه التوطئة كيف ينتقل هايدغر من المفهوم النفسي الابستيمولوجي لرؤية العالم إلى المقاربة الأنطولوجية التي تنظر لتصور العالم بصفته ميزة العصور الحديثة في سياق الرؤية التقنية للوجود التي هي ميتافيزيقا الحقبة الراهنة.
يشترك "غدامر" مع أستاذه هايدغر في رفض المقاربة التأويلية الابستمولوجية لدى دلتاي معتبرا أنه يتسرع في استنتاج "اشتقاق موضوعية العلم من السلوك المعيش والبحث عن الصلاحية" validity([17])؛ بمعنى أن التأسيس الابستمولوجي لعلوم الروح من حيث هي ممارسة تأويلية للعالم المعيش الحي يظل هشا لتباين الطموح المنهجي وطبيعة تحديد المجال المدروس.
يعتبر غدامر أن هايدغر انتهى في تحليليته الظاهراتية للدازين إلى القطيعة مع مشروع بناء علوم الروح في نسختيه الدلتايية والهوسرلية بإعادة طرحه لسؤال الوجود، وهكذا يتحول مصطلح الفهم بالنسبة له من دلالته المنهجية بحيث يصبح "الخاصية الأنطولوجية الأصلية للوجود الإنساني ذاته([18])".
ينتج عن هذا التحول في المنحى التأويلي أفق جديد للفهم ناتج عن تأكيد علاقة انتماء المؤول لموضوع تأويله، مما يتبناه غدامر ويبني عليه نتائج جديدة في مقاربته للتأويلية التاريخية التي تنطلق من التقليد والأثر والسياق الناظم للممارسة التأويلية.
تحيل عملية الفهم من هذا المنظور المتأثر بها يدغر إلى البنية الأنطولوجية لنمط تشكل الوجود الإنساني في العالم وفي التاريخ. من هنا يعيد غدامر الاعتبار للتقليدtradition وللحكم المسبق prejudice بصفتهما يحددان رؤية العالم الموجهة والدافعة للعملية التأويلية.
يوضح غدامر هذا الرأي بقوله: "لا يمكن النظر للمشكل التأويلي في مقاييسه الحقيقية دون الاعتراف بأن كل فهم يصدر أساسا عن حكم مسبق([19])".
يصدق هذا الحكم على فكر الأنوار في نقديته الجذرية للتقليد والأحكام المسبقة لأنه يؤسس تقليدا قائما له مسبقاته الضمنية.
إن التصور السلبي للتقليد نشا، كما يرى غدامر، في فكر الأنوار الذي لم ير في الأحكام المسبقة سوى دلالة الجزم دون دليل والحكم دون تمحيص، في حين أنه فرضية خصبة قابلة لأنماط شتى من التوظيف ولا يمكن التخلص منها في أي نشاط معرفي وعلمي حتى ولو كان يفترض صرامة التأسيس كما هو شان العلوم التجريبية الحديثة.
يخلص غدامر من نقد العقلانية الأنوارية إلى أن الأحكام المسبقة ليست عوائق أمام المعرفة الموضوعية، بل هي شروط الفهم الضرورية.
ومن هنا إعادة الاعتبار للسلطة authorityوالتقلي، من منظور تاريخية الإنسان وعدم قدرته على الانفكاك من السياق الثقافي والمجتمعي، مما يؤدي به إلى الدفاع عن وجود "مسبقات شرعية".
يرفض غدامر القول بترادف السلطة والقهر والخضوع، ذلك أن الأساس العميق للسلطة هو "الاعتراف والمعرفة"؛ أي الإقرار أن الآخر "أعلى حكما وأبعد نظرا" من الرأي الذاتي الضيق، فالسلطة ليست موضوعا للإكراه بل تكتسب ضرورة وتقتضي الاعتراف والتقبل، مما يعني أنها تقوم على فعل عقلي حتى لو كان واعيا بحدوده ويحتاج إلى الاسترشاد بالآخر والاستناد إليه.
لا معنى، إذن، لربط السلطة بالخضوع، فهي مرتبطة مباشرة بالمعرفة وليس الإكراه. صحيح أن السلطة تتمتع بأهلية إصدار الأوامر الملزمة، ولكن ذلك محض نتيجة للتمتع بالسلطة وليس أساسها الذي يرجع للحرية والعقل([20]).
وكما يعيد غدامر الاعتبار لمفهوم السلطة، يقدم تصورا ايجابيا لمفهوم "التقليد"tradition الذي ينظر إليه منذ عهد الأنوار بأنه نقيض الحرية العقلانية أي العقل النقدي القائم على التحقق البرهاني.
يرفض غدامر المقابلة بين العقل والتقليد، مبينا أنه لا يخلو؛ أي تقليد، من حرية ومن وعي تاريخي، باعتبار أن تجذر أي تقليد لا يفسر بقدرته على الجمود والاستقرار وإنما بما يحققه من حاجيات موضوعية ومن إغراءات فعلية، التقليد هو في آن واحد حفظ ومحافظة من جهة، وتغير وتحول تاريخي من جهة أخرى.
تقتضي المحافظة استخدام الإرادة الحرة بقدر ما يقتضيه التجديد والإبداع؛ بحيث يمكن التساؤل حول شرعية الاعتراف "بحق التقليد في تأويلية علوم الروح".
تنطلق المقاربة التأويلية التاريخية التي بلورها غدامر، إذن، من تقويض وإلغاء "التقابل المجرد" بين التقليد والعلم التاريخي وبين التاريخ ومعرفة التاريخ، بحيث يبرز الاقتران العضوي بين فعل التقليد الذي حافظ على حيويته واستمراره والمبحث التاريخي الذي هو في بعض جوانبه عملية انتقال تقاليد أي تجارب تاريخية حية([21]).
يتضح من استعراض المقاربة التأويلية التاريخية لدى غدامر أن رؤية العالم تتم من خلال التقليد والسلطة، وإن كان غدامر نفسه يقول صراحة إن اللغة في أساسها العميق "رؤية للعالم" باعتبارها انفتاحا على الآخرين وعلى العالم.
فمجرد حضور العالم له "أساس لغوي"، ليس بمعنى أن العالم لا يكون عالما إلا من حيث يمارس التعبير باللغة، وإنما لكون اللغة لا وجود حقيقي لها إلا باعتبار أن العالم يحضر من خلالها.
يتم التركيز هنا على البعد التواصلي الحواري في اللغة بدلا من جانبها الألسني الداخل، من منظور تصوره لعملية الفهم كحدث لغوي([22]).
إلا أن تأويلية "غدامر" وإن بلورت مفهوما تفاعليا لرؤية العالم من خلال إبراز منزلة التقاليد والسياقات المعرفية التي لا يمكن الانفكاك معها حتى في العلوم التجريبية الطبيعية، إلا أنها ظلت تعاني من قصور نقدي عبر عنه "هابرماس" بخلوها من تصور واع لأوجه ومخاطر الاختلال التي تعترض الفعل التواصلي الذي صاغه وفق النموذج التوافقي الإجماعي دون اعتبار للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمارس تأثيرها الفاعل على التقاليد الثقافية والتاريخية، ومن هنا دعوة "هابرماس" لاستكمال المنهج النقدي بنظرية في النقد الإيديولوجي([23]).
ثالثا: رؤية العالم في التأويلية الإنشائية: بول ريكور
لئن كان ريكور يقر بوضوح بانتمائه للتقليد التأويلي في نسختيه الابستيمولوجية والأنطولوجية، إلا أنه ينطلق من رفض التمييز الذي قام عليه التقليد التأويلي كله؛ أي التمييز الذي أرساه دلتاي بين التفسير والفهم، معتبرا أنهما مستويان مترابطان لا غنى عنهما في العملية التأويلية.
فإذا كان دلتاي بالنسبة لريكور قد أسس التقليد التأويلي الحديث بنقل المسألة التأويلية من الإشكالية الفيلولوجية philologique (من الفيلولوجيا؛ أي فقه اللغة) والتفسيرية (بالمعنى الديني) إلى الإشكالية التاريخية النقدية في إطار استقصائه لشروط إمكانية "علوم الروح"، إلا أنه من خلال التأسيس الابستمولوجي لهذه العلوم من خلال ثنائية الفهم والتفسير قد مهد الأرضية للمقاربة الأنطولوجية باعتبار أن هذه الثنائية المنهجية تستند لتمييز وجودي أعمق بين الطبيعة والروح.
بيد أن هذا التمييز يفضي بالنسبة لريكور إلى إفقار وتضييق الإطار الابستمولوجي للمسلك التأويلي مما يعني الفشل في بناء علمي رصين للمعرفة المتعلقة بالإنسان أو بالروح.
ويرجع "ريكور" هذا الخلل الابستمولوجي إلى إهمال "دلتاي" للعلامات والرموز القابلة للمقاربة الموضوعية وفي مقدمتها العلامات اللغوية أي النص المقروء، والبنيات المؤسسية التي تترجم الحياة النفسية.
أما المقاربة الأنطولوجية لدى هايدغر فإنها تظل ناقصة لأنها تقف عند "الانتماء الأساسي" والانفتاح الأصلي دون الوصول إلى المسألة التأويلية ذاتها من حيث هي رهان لغوي وسياقات ثقافية وتاريخية عينية([24]).
وإذا كان غدامر يقف بالنسبة لريكور عند جوهر المسألة التأويلية في بعديها "المسافة السالبة" distance allienante؛ (أي المقاربة الموضوعية للظاهرة الإنسانية التي تفضي إلى اغتراب الإنسان الدارس واستلابه من حيث النظر لذاته كموضوع أو شيء) و"تجربة الانتماء" appartenance (انتماء الدارس للتقليد الذي يتأوله)، إلا أنه يرى أنه حصر المسألة التأويلية في السؤال الأصلي الذي يطرحه النص بالتركيز على سياقات التأويل الناظمة دون الانتباه إلى الأبعاد والآفاق التي يفتحها النص بعديا في مآلاته وأثاره الراهنة؛ أي الجانب الإنشائيpoetique والإبداعي في عملية القراءة([25]).
في مقابل هذه التأويليات التي ينعتها بالجزئية والناقصة، يرى ريكور أن العملية التأويلية لابد أن تجمع بين التأويليات التي تسلك الطريق التفسيري الحفري archeologique و"الاختزالي" reductice كما بلورتها "تأويليات الشك" المعاصرة (فرويد وونتشه وماركس) والتأويليات الغائية الممتلئة (هيغل وياسبرزونابر). فالتأويل هو من ناحية كشف للسياق في مسافته الفاصلة من أجل الوقوف عند الأفكار في تاريخيتها وآثارها، وهو من ناحية أخرى جواب على الأسئلة الجذرية التي تظل حية على تغير العصور والأزمان.
فلابد من ضبط العملية التأويلية في بعديها الانفصالي الناتج عن المسافات اللغوية والتاريخية والانتمائي الناتج عن انتماء الذات المؤولة للسؤال الذي يطرحه النص المؤول.
وهكذا يجمع ريكور بين "التأويلية الأنطولوجية" في نسختيها الهايدغرية والغدامرية في تركيزها على السياقات و"التأويلية التاريخية النقدية" التي برزت في الاتجاهات الأركيولوجية والتفكيكية ونقد الإيديولوجيا([26]).
في هذا السياق، يبين ريكور أن عملية فهم الذات لنفسها لا يمكن أن تتم ضمن عملية استبطانية شفافة ولا من خلال التقابل مع الموضوع المتمثل، كما لا يمكن تجاوزها في البعد الأنطولوجي على الطريقة الهايدغرية.
يوضح ريكور أن عملية فهم الذات لنفسها تتم عبر وسائط ثلاث هي:
أ. العلامات les signes التي تحيل إلى الطابع اللغوي الأصلي للتجربة الإنسانية.
ب. الرموزsymboles التي هي الأطر الناظمة لعملية التفكير في بعدها الجماعي وسياقاتها الثقافية المتنقلة، وإن كانت لا تحضر بكثافتها الدلالية القوية إلا عبر النص القابل لاستراتيجيات التأويل المتباينة والمتصادمة (صراع التأويلات).
ج. النصوص les textes التي من خلالها يخرج الخطاب من ضيق الحوار المباشر ويأخذ تميزه واستقلاليته الدلالية عن قصد المؤلف وعن السياق الأصلي لقراءته وتقبله وعن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحافة بإنتاجه([27]).
من هنا يخلص ريكور إلى أن عملية التأويل تقتضي دوما رؤية للعالم لا غنى عنها، سابقة على اللحظة المعرفية ومتلازمة، في المنشأ والنتيجة، مع بناء النص إنتاجا وقراءة.
فعندما يبدأ الإنسان يفكر يجد أنه يتأرجح بين عالم ممنوح قبليا مرتبط بأرضية الغير، وعالم من الرموز والمعايير هو الذي يشكل القاعدة التأويلية للعالم عندما نبدأ في ممارسة التفكير([28]).
النص لا يكتفي بتسجيل دلالة أصلية يبحث عنها في سياق سابق، وإنما يقترح أيضا عالما ممكنا، ويدشن أفقا جديدا من خلال التخيل والسرد والرواية؛ أي الفاعلية الإنشائية للعمل التأويلي.
ما تقدمه الحبكة السردية هو "تشكل عالم ممكن"؛ عالم النص ليس العالم الذي يصدر عنه النص، وإنما العالم الذي يفتتحه النص.
ومن هنا يعتبر ريكور أن القراءة هي في آن واحد "إيقاف" للفعل ودفع له، تتحدد على خط تفاعل العالم المتخيل للنص والعالم الفعلي للقارئ. القارئ يتماهي في توقعاته وانتظاراته مع النص المتخيل الذي يهاجر نحوه، لكنه من وجه آخر يثري رؤيته للعالم بقراءاته فيكون النص محطة في مساره العملي([29]).
نستنتج من هذه الملاحظات إن مقولة الفهم التي يستعيرها ريكور من دلتاي وغدامر تتغير دلالتها في اتجاهات جديدة، برفض الفصل بين التفسير المرتبط بالعلة والفهم المرتبط بالمعنى، وبالمرور من شيئية النص إلى عالم النص من حيث كونه يدشن إمكانات وجود وصيغ عيش متعددة.
كل نص يختزن عوالم ممكنة، وكل نص سردي يقدم رؤية للعالم لها آثار عملية في واقع المتلقي، وهكذا يتحدد مفهوم رؤية العالم لدى ريكور في الخيط الواصل بين المعنى والتطلع وبين النص والفعل والقراءة والأخلاق العملية.
الهوامش
[1]. W. Dilthey, l'edification du monde historique dans les sciences de l'esprit, Cerf 1988, p. 41.
[2]. Ibid, p. 86.
[3]. Dilthey, le monde de l'esprit, Tome:1, Aubier Montaigne 1947, p. 320.
[4]. راجع:
Schlelrmacher, Herméneutique EDLabor et Fides, 1987, p. 104-168.
راجع النص الذي كتب دلتاي حول حياة شلرماخر:
"the Schlelrmacher biography",In Dilthey: Selected writings CUP Archives, 1979, p. 35-77.
[5]. le monde de l'esprit, op. cit, p. 333.
[6]. Ibid, p. 335.
[7]. Dilthey, conception du monde et analyse de l'homme depuis la renaissance et la reforme, Cerf 1999.
The types of World-View and their development in the metaphysical systems, Dilthey, In Selected writings, P. 133-154.
[8]. Thomas J. Nenon: Husserl's Ideen Springer 2013, p. 128-129.
راجع:
la philosophie comme science rigoureuse, Husserl, PUF 1989, P. 63.
[9]. A.Kremer Marietti: Karl Jaspers: philosophie Harmattan 2002, p. 53-54.
[10] .philosophie: orientation dans le monde ,eclairement de l'existence metaphysique, K.Jaspers, Springer – Verlag, 1986 , p. 186.
[11]. Etre et temps Atlantica, M.Heidegger, 1985, p. 272.
[12]. les recherché philosophiques du jeune Heidegger Springer, P. Quesne, 2003, (p:76).
[13]. S. Jolivet, C. Romanto (edit): Heidegger en dialogue 1912-1930: rencontres, affinities et confrontations Vrin 2009.
[14]. Heidegger, l'époque des conceptions du monde" in Chemins qui ne menent nulle, part Gallimard, 1962, p. 100.
[15]. Ibid, p. 119.
[16]. Ibid, p. 123.
[17]. H. G. Gadamer, Verite et methode: les grandes lignes d'une hermeneutique philosophique, Seuil 1996, p. 274.
[18]. Ibid, p. 280.
[19]. Ibid, p. 291.
[20]. Ibid, p. 300-301.
[21]. Ibid, p. 302-306.
[22]. Gallimard, langage et verite Gadamer, 1995.
[23]. راجع حول حوار هابرماس وغدامر:
Alan How: The Habermas – Gadamer debate and the nature of the social Avebury, 1995.
[24]. حول قراءة ريكور لتأويلية دلتاي وهايدغر: راجع
Ricoeur, Du texte a l'action: essais d'herméneutique, 2 Seuil 1986 (pp:88-100).
[25]. حول قراءة ريكور التأويلية غدامر، راجع:
Ricoeur: Ecrits et conferences2: hermeneutique, Seuil 2010, p.134-145.
[26] .du temps a l'action, Ricoeur, p.362).
[27]. Ibid, p. 31-29.
راجع في الموضوع:
Dominico Jervolino: Paul Ricoeur: une hermeneutique de la condition humaine, Ellipses 2002, (pp:30-33).
[28] .Ricoeur, A l'ecole de la phenemenologie, Vrin 1986, (p:29).
[29]. Temps et recit Ricoeur, 3 Seuil 1985, p. 262.