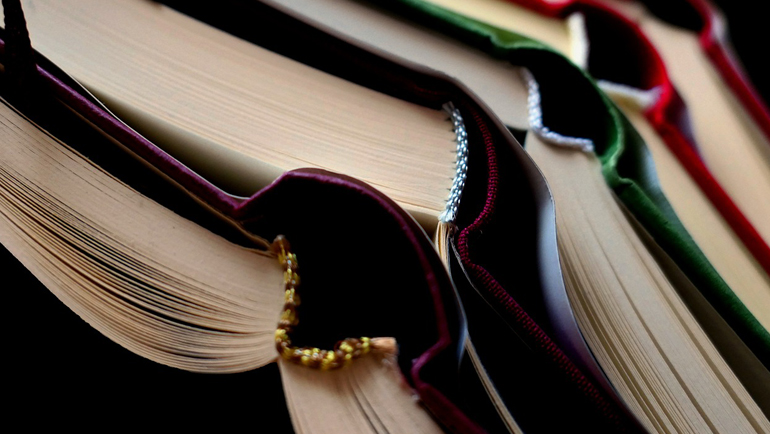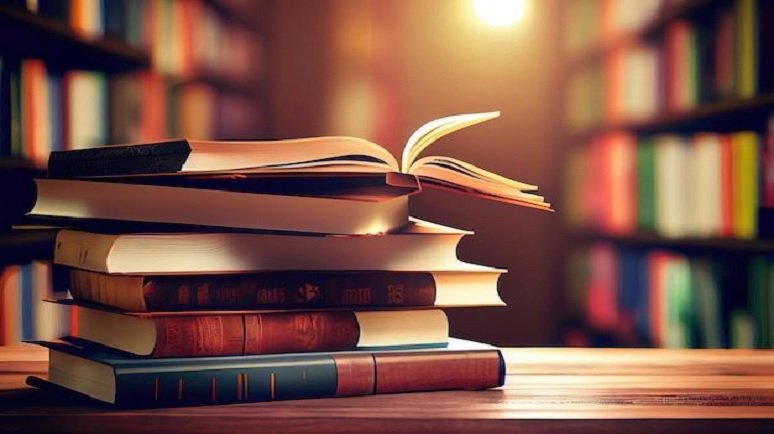يتحقق الاستنباط من خلال التعمق في النصوص الشرعية، والفهم الخاص للناظر فيها، حيث تختلف النظرات حسب اهتمام الناظر وفكره وتخصصه، فالأصولي يستنبط ما في النص من قواعد أصولية لغوية وشرعية، والفقيه يستخرج بواسطة تلك القواعد أحكاما شرعية من بواطن الدليل الجزئي.
ولا يشترط من أولئك المتأملين المستنبطين إلا صحة الاستنباط، وعدم خروجه عن واقع النص، واحتماله لذلك المعنى المستنبط، وإننا لنجد ذلك واضحا في قول الطاهر بن عاشور حيث قال: "معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة الشريعة ومقاصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد، تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها[1]"، ومن هنا كان لابد من توضيح ذلك، والإلمام بما يتعلق بالاستنباط وطرقه.
خاصة وأن الأمة اليوم بحاجة إلى الاستنباط، ولمن يقوم به حق القيام، لمعالجة ما يستجد من قضايا وما يحل بنا من وقائع ونوازل جريا على عادة علمائنا الكبار، فهو علم فريد وعميق؛ قلَّ من يدرك خفاياه، فكثير من الناس يخفى عليه ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام..
ومن خلال هذا العلم تنمو الملكة الفقهية، التي تؤهل صاحبها، بإذن الله تعالى، إلى الارتقاء في معالي الاجتهاد ودرجات الإدراك الحصيف.
وقد أحسن الشاطبي، رحمه الله، حيث قال: "إنَّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتَّصف بوصفين: أحدهما؛ فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني؛ التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها[2]".
وسأركز من خلال هذه الدراسة على المحاور التالية:
ـ الفرق بين الاستنباط والتفسير.
ـ طريق استنباط الأحكام من القواعد الأصولية.
ـ الاستنباط السديد.
ـ الاستنباط العليل.
جريا على عادة علمائنا في تحديد مدلولات المصطلحات، التي يودون استعمالها، سواء من حيث اللغة أو الاصطلاح قبل الشروع فيما سيقدمون عليه، نعرج على مفهوم الاستنباط.
الاستنباط؛ لغة واصطلاحا
أ. الاستنباط لغة
الاستنباط لغة هو الاستخراج، يقال: استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده، وكلمة "نبط" تدل على استخراج شيء، والاستخراج على وزن استفعال، وأصله من النبط، وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر[3]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: 82)؛ أي يستخرجونه.
وينبغي أن نشير هنا إلى أنه رغم تعدد التعاريف للاستنباط عند أهل اللغة، إلا أنها في مجملها، تدور حول معنى واحد، وهو الاستخراج كما رأينا.
ب. الاستنباط اصطلاحا
الاستنباط مفهوم من المفاهيم التي اهتم بها الأصوليون، وهو أحد العمليات العقلية التي يمارسها المجتهد خلال عمله في استخراج الحكم من النصوص الشرعية، فما هو إذن؟
للاستنباط عند أهل العلم تعريفات عديدة منها:
ـ تعريف ابن القيم حيث قال: "الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه[4]".
ـ كما عرفه الشوكاني بقوله: "الاستنباط هو استخراج الدليل عن المدلول، بالنظر فيما يفيده من العموم، أو الخصوص، أو الإطلاق، أو التقييد، أو الإجمال، أو التبيين في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون طريقا إلى استخراج الدليل منه[5]".
ـ أما الشريف الجرجاني فقد عرفه بأنه: "استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة[6]".
إن المتأمل في هذه التعريفات يتضح له بجلاء أن بعضها أعم من بعض، فالجرجاني، على سبيل المثال، نجده قصر الاستنباط على استخراج معنى النص؛ أما الشوكاني فقد وسع الدائرة شيئا ما، غير أنه حصر موضوعه في استخراج الأدلة؛ بينما نجد تعريف ابن القيم قد اتسم بمعنى أشمل خلافا للجرجاني والشوكاني، رحمهم الله جميعا، حيث لم يكن تعريفهما جامعا مانعا.
ومما نستفيده من هذه التعاريف أن الاستنباط مرحلة متأخرة في الترتيب على الفهم، قال ابن القيم: "ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم[7]".
وبناء على ما تقدم نستطيع أن نخلص إلى أن الاستنباط هو استخراج الأحكام الشرعية الخفية من مصادرها، ببذل الجهد ذهنيا، وذلك بواسطة القواعد الأصولية التي تساعد الفقيه على عملية تفسير النصوص الشرعية تفسيرا فقهيا[8].
أولا: الفرق بين الاستنباط والتفسير[9]
لا شك أن صلة الاستنباط بالتفسير صلة قوية، بل لا يمكن أن يستنبط من الآية إلا بعد فهم معناها والمراد منها، ومع ذلك، فلا يمكن القول بأنهما شيء واحد، بل كل منهما مصطلح يدل على ما لا يدل عليه الآخر، ويمكن بيان الفروق بينهما فيما يلي:
ـ التفسير معناه البيان والكشف، وأما الاستنباط فهو استخراج بعد خفاء..
ـ مرجع التفسير هو اللغة وكلام السلف، ومرجع الاستنباط هو التدبر والتأمل في الآيات، والتدبر يأتي بعد الفهم للآية، وقد يكون التدبر الذي نتج عنه الاستنباط من آية ظاهرة المعنى، لا تحتاج إلى تفسير، وقد يكون من آية ظهر معناها الصحيح، فيكون التدبر في هذه الحال بعد معرفة التفسير..
ـ التفسير مختص بمعرفة المعاني، والاستنباط مختص باستخراج ما وراء المعاني من الأحكام والفوائد الخفية..
ـ التفسير المصطلح عليه بين العلماء خاص بالقرآن الكريم، بينما الاستنباط لا يختص بذلك، بل هو عام في الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين، ولذلك كان الفقهاء يستنبطون من كلام أئمة المذاهب ما يدل على مذهبهم في المسألة..
ـ الاستنباط يحتاج إلى جهد وقوة ذهن، بخلاف التفسير الذي هو بيان المعنى..
ـ الاستنباط مستمر لا ينقطع، و أما تفسير الألفاظ فقد استقر و علم.؛ فقد يستطيع المفسر معرفة جميع ما تحتمله الآية من المعاني التفسيرية للفظ؛ ولا يمكن لأحد ادعاء معرفة جميع ما تحتمله الآية من الفوائد والأحكام.
ثانيا: طريق استنباط الأحكام من القواعد الأصولية
ليس المقصود من القواعد الأصولية معرفة الأحكام الشرعية الفرعية؛ إنما المقصود الرئيس منها هو كيفية استنباط هذه الأحكام من الأدلة؛ فلكي يستنبط الفقيه حكم الصلاة من قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (البقرة: 43) لابد من وسيلة تعينه على ذلك، وهذه الوسيلة هي القاعدة الأصولية التي تقول: "الأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة". ولاستنباط الحكم عن طريق هذه القاعدة نقول: إن قوله تعالى: "أقيموا" أمر، وهذا الأمر لم تصرفه قرينة عن الوجوب، فتكون الصلاة، إذن، واجبة.
وعليه، فالقواعد الأصولية للمجتهد ليست هي معرفة الأحكام الفقهية مباشرة، بل يأخذها المجتهد ليستعين بها على معرفة كيفية استنباط الأحكام واقتباسها من الأدلة[10].
فإذا وضعت هذه القواعد بيد المجتهد وتعلمها فستكون عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وإذا كان العلماء قد سبقوه في استنباط الأحكام من الأدلة، فسيكون لديه قدرة على الترجيح بين أقوالهم واختيار الراجح منها؛ ولذلك قال الرازي: "أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه[11]".
وباعتبار استنباط الحكم من القواعد الأصولية مباشرة أو بواسطة نجد لذلك طريقين:
1. طريق استنباط الأحكام من القواعد الأصولية المستقلة بذاتها
القاعدة الأصولية إذا كانت دليلاً مستقلاً بذاته، فإنه يستنبط منها الحكم مباشرة دون واسطة. ولتوضيح ذلك أورد أمثلة من هذه القواعد:
القاعدة الأولى؛ "الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين[12]".
هذه القاعدة مجمع عليها عند جميع الأصوليين[13]، والواجب الكفائي تكليف شرعي اجتماعي، الغاية منه جلب المصالح ودرء المفاسد، و الجماعة المسلمة مسؤولة عنه، فإذا قام به البعض سقطت المطالبة به عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع.
ومن هذه القاعدة يمكن أن تستنبط مجموعة من الأحكام بصورة مباشرة:
- وجوب إقامة صلاة الجماعة.
- وجوب غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم.
- وجوب إغاثة المستغيثين.
- وجوب تعلم كل العلوم التي يحتاجها المسلمون في حياتهم؛ من تفسير وفقه وحديث وطب وزراعة واقتصاد وهندسة، إلى غير ذلك من العلوم المفيدة.
القاعدة الثانية؛ "ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب[14]".
ومن الأحكام الشرعية التي يمكن أن تستنبط مباشرة من هذه القاعدة:
- أ. وجوب السعي إلى صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة لا تتم إلا بالسعي إليها.
- ب. وجوب السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج؛ لأن الحج لا يتم إلا بالسفر إلى مكة.
2. طريق استنباط الأحكام من القواعد الأصولية غير المستقلة بذاتها
القاعدة الأصولية غير المستقلة بذاتها لا يستنبط منها الحكم مباشرة، وإنما يتم لها ذلك بربطها بالدليل التفصيلي أو الجزئي، وهو الذي يتعلق بمسألة خاصة، وذلك بالإتيان بالدليل التفصيلي أولا، ثم القاعدة الأصولية ثانيا، للوصول إلى الحكم الشرعي العملي كنتيجة.
ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
المثال الأول: النهي عن قتل النفس إلا بالحق لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء: 33).
القاعدة الأصولية؛ "النهي يقتضي التحريم[15]".
وبناء عليه يحرم قتل النفس بغير حق، للنهي الوارد في قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس...". والنهي يدل على التحريم إذا أطلق، كما هو في القاعدة.
المثال الثاني: حرمة مطلق الدم، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (المائدة: 3).
وحرمته مقيدة بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (الأنعام: 145).
القاعدة الأصولية؛ "وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب[16]".
وبذلك لا يحرم من الدم إلا ما كان سائلاً عن مكانه الذي فيه، وأما غير السائل فإنه يحل تناوله، وذلك لأن كلمة الدم في الآية الثانية قيدت التحريم بالدم المسفوح دون سواه، والحكم في الآيتين واحد، وهو حرمة تناول الدم، والسبب الذي شرع الحكم من أجله كونه دما، فاتحدا في الحكم والسبب، فوجب حمل المطلق على المقيد.
المثال الثالث: إخبار النبي، صلى الله عليه وسلم، بأن الهرة ليست بنجس، بقوله: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات[17]".
القاعدة الأصولية؛ "النكرة في سياق النفي تفيد العموم[18]".
ونتيجة ذلك هو أن الهر ليس بنجس، سواء كان جسمه أو ما خرج منه؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بنجس" نكرة في سياق النفي، وهي من صيغ العموم، والأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص، ولا مخصص هنا.
المثال الرابع: مسألة الموالاة في الوضوء، ذكر القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه "المعونة" حكمها أولا، ثم استشهد على ذلك بالآية ثانيا، ثم أتي بالقاعدة الأصولية ثالثا، ليبين أن التفريق الكثير بين أعمال الوضوء غير جائز، ولابد من استئناف الوضوء من جديد، وفي هذا يقول: "وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه... لقوله عز وجل: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (المائدة: 6) والأمر المطلق على الفور[19]".
المثال الخامس: استنباط حكم عدم إخراج الزكاة في الغنم غير السائمة[20] مما ورد عن أنس، رضي الله عنه، أن أبا بكر، رضي الله عنه، كتب له كتابا لما وجهه إلى البحرين، ومما جاء في هذا الكتاب: "… وفي صدقَة الغنم، في سائمتها إذا كَانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ شاة[21]" عن طريق الاستعانة بما ذكره الأصوليون في القاعدة الأصولية التي تقول: "مفهوم الصفة حجة" فوصف الغنم بأنها سائمة، يفهم منه أن الغنم إذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة، وهكذا في بقية الأدلة.
هذه طريقة الفقهاء ومنهجهم الأمثل في استنباط الأحكام الشرعية واستخراج الفوائد من القواعد الأصولية لإبراز مراد الله ورسوله من كلامهما.
ثالثا: الاستنباط السديد
الاستنباط السديد هو الذي يقوم على الأصول والمقاصد الشرعية، فاعتماد الأصول الشرعية واللغوية في الاستنباط، وكذلك المقاصد الشرعية، يعد من الأهمية بمكان؛ فبها يسهل الفهم على الطالب، كما بها يتمكن من الاستنباط السديد والصحيح؛ فلا تزل قدمه في فهم الكتاب والسنة، ويتسنى له استخراج الفوائد والأحكام من النصوص الشرعية، كما بها تزداد ثقته، ويعلم أنه في ذلك على نهج السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية والاستنباط منها؛ إذ فهم سلف الأمة يعد ضابطا في فهم نصوص الكتاب والسنة، بل هذه أولى أصول الاستنباط، وهي السبيل الواقي من الانحراف في فهم نصوص الكتاب والسنة، فمن أهمل تلك القواعد ضل لا محالة، ولتفادي ذلك الإهمال، لابد من مراعاة الأمور الآتية:
1. الاستنباط القائم على القواعد الأصولية
إن الاستنباط الذي يبنى على القواعد الأصولية الشرعية ويقوم عليها، وكذا القواعد اللغوية، هو الغاية من علم أصول الفقه و قواعده، وإننا لنجد ذلك واضحا عند الطاهر بن عاشور، كما تقدم، حيث قال: "معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع، بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها[22]"، كما نجد ذلك جليا وواضحا أيضا عند الشيخ الخضري بك عندما قال: "من قواعد هذا العلم، أصول الفقه، ما يوصل إلى شكل الاستنباط من الكتاب والسنة[23]".
2. الأخذ بالمقاصد لاستنباط الأحكام
لما كان صحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعيشون وبينهم النبي، صلى الله عليه وسلم، حيا لم يكونوا بحاجة إلى قواعد لفهم النصوص واستنباط الأحكام، كما أنهم كانوا يعرفون اللغة العربية وبلاغتها، ويدركون المقصد من النص، ولكن بعد مرور الزمن واختلاط الأمم، أصبح الناس غرباء على لغتهم، يحتاجون لإدراك بلاغتها وشرح معانيها، هنا أصبحوا لا يدركون مقاصد الشارع التي تتحقق في العبودية الكاملة لتحقيق المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم في الدارين.
من هنا كان لابد من الأخذ بالمقاصد واستنباط الأحكام على ضوئها؛ لأن النصوص إنما كانت من أجلها، وحتى يكون تفسير النص صحيحا واستنباط الحكم سديدا، لابد من معرفة المصالح التي لأجلها ولغايتها نزلت، فإذا عرف ذلك فسر النص واستنبط الحكم على ضوئها، فمقاصد الشريعة أقوى دليل على فهم نصوص الشريعة، وتفسيرها، وتحديد مدلولات الألفاظ، ومعرفة معانيها لتعيين المعنى المقصود واستنباط الأحكام منها؛ لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها، وتختلف مدلولاتها، كما هو معروف في أسباب اختلاف الفقهاء، فتأتي المقاصد لتحديد المعنى المقصود للشارع الحكيم[24].
وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله: أن التوفيق بين الأخذ بظاهر النص والنظر إلى مدلولاته بحيث لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا العكس، حتى تكون الشريعة منتظمة لا تناقض فيها[25].
وهكذا فالميزان الذي يعمل على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية المتعددة المدلولات، هو ميزان مقاصد الشريعة التي من أجلها جاءت هذه النصوص، لتحقيق مصالح العباد في الدارين.
3. مراعاة المقاصد أثناء استنباط الأحكام من الأدلة المتعارضة
تعارض الأدلة فيما بينها إنما هو بحسب الظاهر، وليس تعارضا حقيقيا، فالشريعة لا تعارض فيها أبدا ولا تناقض[26]، والمجتهد يلجأ إلى الدليل عند إرادة الحكم، وإذا ما ظهر له دليل آخر يعارض الدليل الأول، كان لزاما عليه أن يعمل لأجل التوفيق بين الدليلين، أو يرجح أحدهما على الآخر.
وإن خير معين لهذا التوجه، هو العلم بمقاصد الشريعة، التي هي الحكم الفصل بين الدليلين، وهذا ما أكده العلماء، ومنهم الطاهر بن عاشور حيث قال: "لتكون أي مقاصد الشريعة نبراسا... ودربة... على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف[27]".
فالتعارض بين الأدلة غير وارد بشكله الحقيقي "فيستحيل، إذن، أن تتعارض الأدلة ويفهم المقصود منها؛ لأن التعارض يعني التناقض والتجهيل، وإبهام المقصود، وفوات شرط التكليف، وكل هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، ويستحيل على المشرع الحكيم عز وجل.
لكنه لا يستحيل بالنسبة لأنظار المجتهدين، فقد يبدو لبعضهم أن بعض الأدلة يعارض بعضا لقصور في فهم المجتهد وضعف في إدراكه، وعدم إحاطته بأدلة المسألة ووجوهها، فيكون التعارض ظاهريا لا حقيقيا[28]".
فلو أهملنا العمل بالمقاصد، فإننا سنقف حائرين أمام استنباط الأحكام في حال وجود دليلين يظهر لنا أنهما متعارضان، كما أن العلم بمقاصد الشريعة يفتح المجال للمجتهدين ليبينوا الأحكام في مسائل جديدة.
وهكذا، كلما دعت الحاجة المجتهد إلى بيان حكم الله في مسألة مستجدة عن طريق القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو غيرها، ينبغي أن يتحرى بكل دقة أهداف الشريعة[29].
رابعا: الاستنباط العليل
الخطأ في استنباط الأحكام يكون غالبا نتيجة ضعف في فهم المجتهد، وقصور إدراكه، وعدم إحاطته بأدلة المسألة ووجوهها، ولذلك نصح العلماء والأئمة وطلبوا بأن يكون المجتهد على علم ودراية بالاستنباط وما يتصل به، وذلك بمعرفة أسباب النزول وسبب ورود الحديث، وكذا العلم بالناسخ والمنسوخ وغيرها من الضوابط والقواعد العاصمة من الوقوع في الخطأ، فقد يقع الفقيه في الخطأ لسبب، بحيث لو أمعن النظر والبحث لما وقع فيه.
والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:
1. الاستنباط من الآية دون العلم بسبب نزولها
ذلك أن المجتهد قد يرجع في استنباط الحكم للنازلة المعروضة عليه إلى تفسير الآية من غير نظر في سبب نزولها، فيكون بذلك عرضة لأن يخطئ في استنباط الحكم. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 194) فقد حملها البعض على النهي عن المخاطرة بالنفس في القتال، وفسرها البعض بأنها النهي عن التخلي عن الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. وهو الصواب الذي يؤكده سبب نزول الآية.
فقد روى الليث بن سعد أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو حتى فرقه، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فأجابهم أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وشهدنا معه المشاهد، ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه، صلى الله عليه وسلم، ونصره حتى فشا الإسلام، وكثر أهله، وكنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 194)، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد[30].
2. الاستنباط من الحديث دون العلم بسبب وروده
كما أن الاستنباط من الآية دون العلم بسبب نزولها يوقع في الخطأ، ويزل الفقيه بسبب ذلك في فهم الآية، فكذلك يزل ويخطئ إذا رام الحديث يستنبط منه دون العلم بسبب وروده.
ومثال ذلك، حديث: "الميت يعذب ببكاء الحي عليه[31]"، فشرح هذا الحديث وتفسيره والبحث عن الحكم في معزل عن سبب وروده، يفضي بنا إلى القول بتعذيب الميت بسبب بكاء أهله عليه، وقد أنكرت عائشة، رضي الله عنها، ذلك، واحتجت بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: 166) ثم ساقت سبب ورود الحديث: وهو أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر على يهودية، يبكي عليها أهلها فقال: "إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها"، والمعنى أنها تعذب بسبب كفرها لا بسبب بكاء أهلها[32].
3. عدم العلم بالنص الناسخ
ذلك أن الفقيه قد يستنبط الحكم من نص منسوخ، ويغيب عنه النص الناسخ، فهذا لو علم بالناسخ، لرجع عن استنباطه الخاطئ للحكم، ولاتفق مع الذي استنبط الحكم من النص الناسخ ابتداء. والأمثلة على ذلك في السنة أكثر من أن تحصى.
خاتمة
مما تقدم يتبين، إذن، أن الاستنباط الفقهي يستلزم من الفقيه وطالب الاستنباط معرفة طريق الاستنباط وإدراك القواعد الأصولية والفقهية، وتحصيل كل ما يدخل في دلالة التقعيد، وذلك بأن يكون خبيرا بمناهج تركيب القاعدة وصياغتها وأساليبها، مدركا لحقيقة القاعدة وضوابطها وعناصر تكونها وطرق إيجادها، كما يتطلب منه أن يكون عالما بمقاصد الشريعة وأصولها، وكذلك بفقه الفروع والجزئيات، حاذقا بمنهج الاستنباط وطرق استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها حتى يكون استنباطه صحيحا.
الهوامش
[1]. محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ودار سحنون للنشر والتوزيع، ط 4، (1430ﻫ/2009م)، ص4.
[2]. أبو إسحاق ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ، بيروت: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ط3، (1417ﻫ/1997ﻡ) 4/105-106.
[3]. ينظر: محمد ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ط2، (1417ﻫ/1997ﻡ) مادة (نبط) 7/410 ومختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، دار إحياء الكتب العربية، ص275. وأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (ت 395ﻫ)، معجم مقاييس اللغة حققه: عبد السلام محمد هارون دار الفكر، (1399ﻫ/1979م)، ص972.
[4]. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق وتعليق عصام الدين الصبابطي، القاهرة: دار الحديث، (1427ﻫ/2006م)، 1/180.
[5]. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل، ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﺴﺎﻤﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺜﺭﻱ، الرياض: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ط1، (1421ﻫ/2000ﻡ)، ص342.
[6]. علي ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﺒﻴﺎﺭﻱ، بيروت: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ط1، (1413ﻫ/1992ﻡ)، ص22.
[7]. إعلام الموقعين، م، س، 1/180.
[8]. يراجع: محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، تقديم: فاروق حمادة، الجزائر العاصمة: دار الصفاء، وبيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع/لبنان، ط1، (1421ﻫ/2000م)، ص80.
[9]. ينظر: فهد بن مبارك الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن الكريم، ص58-60.
[10]. ينظر: الآمدي الإمام سيف الدين علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، (1401ﻫ/1981م)، ص6. وانظر: محمد الخضري بك، أصول الفقه، صيدا-بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ط1، (1423ﻫ/2003م)، ص7-97.
[11]. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ: ﻁـﻪ ﺠﺎﺒﺭ ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻨﻲ، بيروت: ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ط1، ( 1412ﻫ/1992ﻡ)، 2/499.
[12]. القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي (ت 422ﻫ)، المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط2، (1425ﻫ/2004م)، 1/197، وقد وردت هذه القاعدة بصيغة "فروض الكفايات"، 1/197.
[13]. محمد ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺩﺭ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، البحر المحيط، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺭ، القاهرة: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ، ط1، (1414ﻫ/1994ﻡ)، 1/322.
[14]. ينظر: أبو حامد ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل، وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، بيروت: مكتبة المثنى/لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي/لبنان، د. ت، 1/71-72 و محمد ﺃﻤﻴﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺎﺩﺸﺎﻩ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ، بيروت: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د. ت، 2/ 215.
[15]. المعونة، م، س، 1/52. و ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﻓﻲ، ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل، ﺤﻘﻘﻪ: ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺴﻌﺩ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ط1، (1393ﻫ/1973ﻡ)، ص68. ومحمد ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ﻭﻨﺯﻴﻪ ﺤﻤﺎﺩ، الرياض: ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، (1413ﻫ/1993ﻡ)، 3/83.
[16] . المعونة، م، س، 1/261 و340 و564. وﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ الجويني، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺤﻘﻘـﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﺏ، المنصورة: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ط1، (1412ﻫ/1992ﻡ)، 1/289.
[17]. رواه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم الحديث: 44، ص26 واللفظ له، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، رقم الحديث: 367، 1/136 وابن خزيمة، في جماع أبواب ذكر الماء، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة رقم الحديث: 104، 1/ 55. والحاكم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: 567، 1/ 213.
[18]. المعونة، م، س، 1/35. والرازي، المحصول، 2/ 343.
[19]. المعونة، م، س، 1/23.
[20]. وهي التي يعلفها صاحبها ولا ترعى في المرعى أكثر الحول، ينظر مختار الصحاح، ص452.
[21]. أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم الحديث: 1454.
[22]. الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، م، س، ص4.
[23]. محمد الخضري بك، أصول الفقه، م، س، ص15.
[24]. ينظر: عبد الكريم زيدان، أصول الفقه، ص378.
[25]. الموافقات، م، س، 2/396.
[26]. المصدر نفسه، 4/294.
[27]. مقاصد الشريعة الإسلامية، م، س، ص3. بتصرف يسير.
[28]. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، دار النشر: مؤسسة قرطبة، ط6، ص386.
[29]. ينظر: وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، دمشق: دار الفكر/سورية إعادة ط1، (1419ﻫ/1999م)، ص218.
[30]. الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي، مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/لبنان، 1/172.
[31]. أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن، أبواب الجنائز، باب ما روي أن الميت يعذب ببكاء الحي 2/112 ومسلم كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 3/41.
[32]. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم، 6/228.