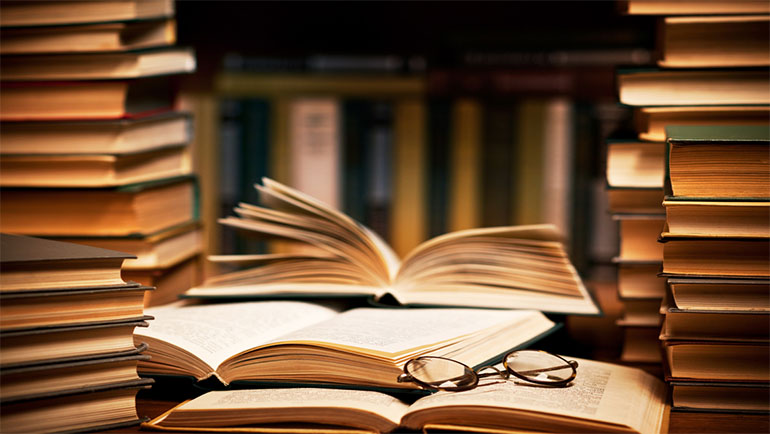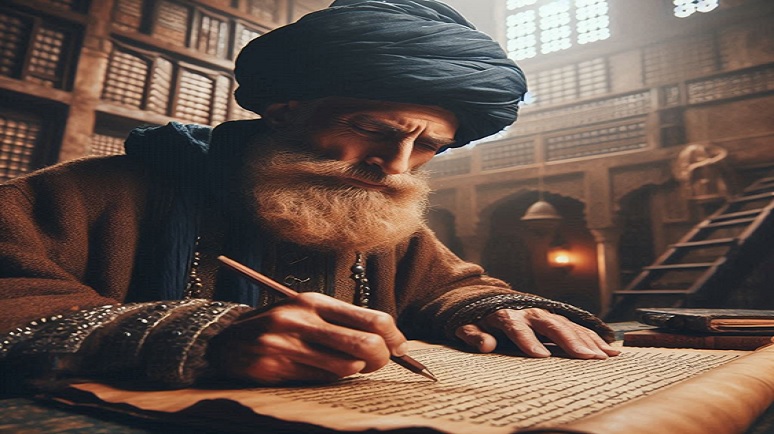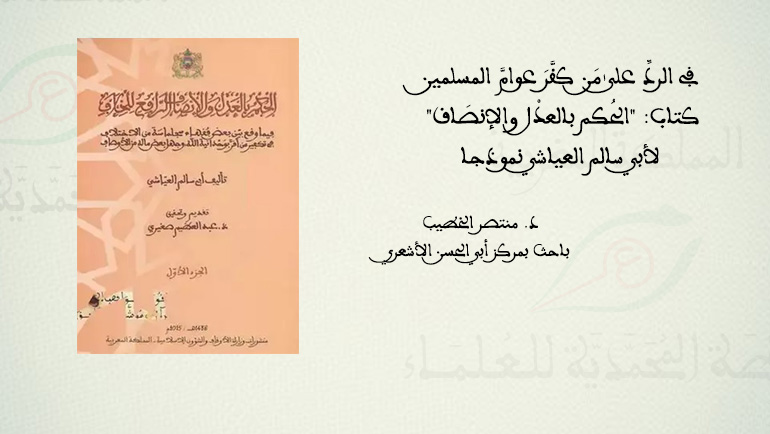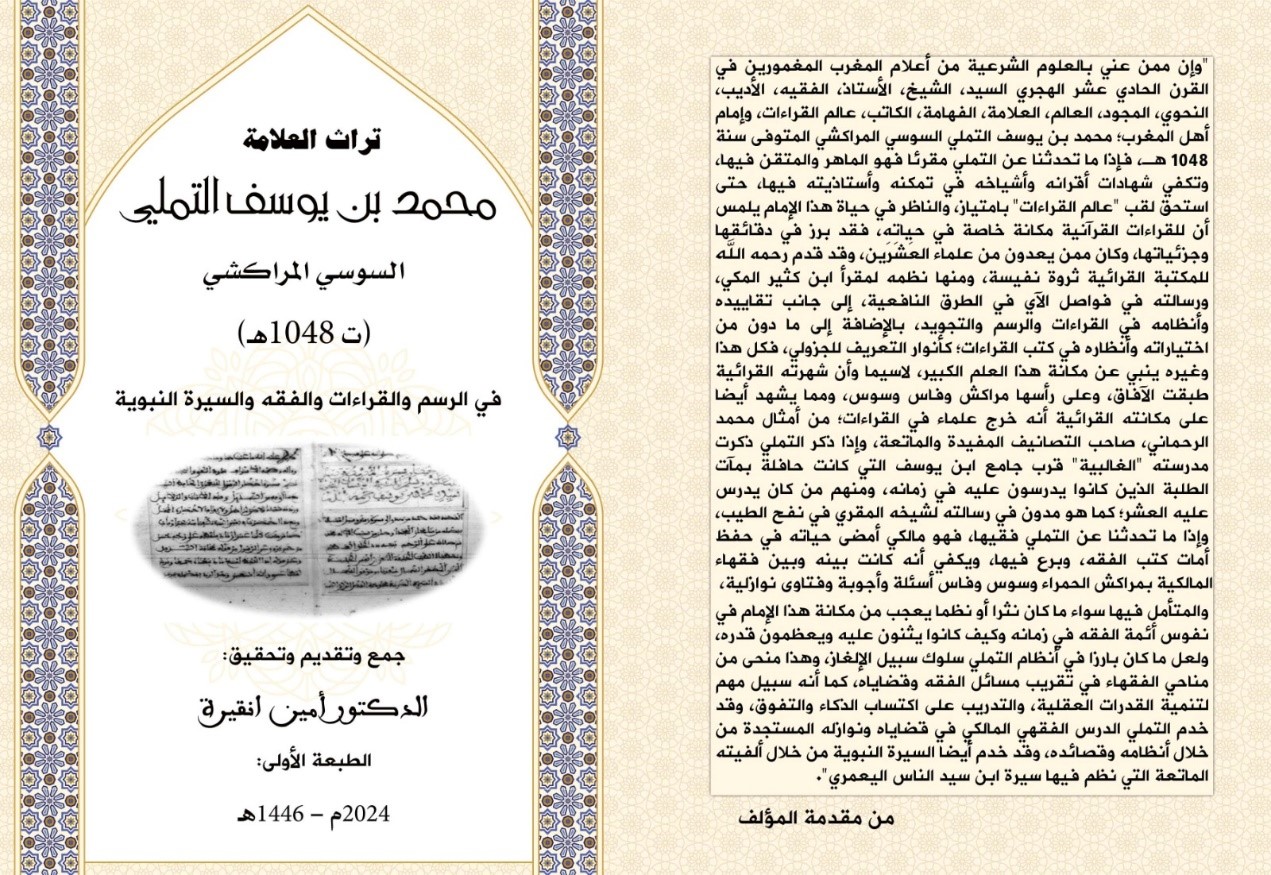لقد خلق الله، عز وجل، الناس متفاوتين في قدراتهم البدنية والفكرية حتى لا تكاد تجد شخصين يتوافقان تمام التوافق في تفكيرهما وقدراتهما على فهم الأمور، ولولا فضل الله الذي بعث رسله وأنزل كتبه لهداية الناس وتوحيد كلمتهم على الحق لتفرقت بهم السبل ولعمهم الضلال، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (النحل: 64). وقوله عز وجل: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِم﴾ (البقرة: 213).
وقد نهى الله عن الاختلاف في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (آل عمران: 105). ومع وجود كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، بيننا، فإن المسلمين قد اختلفوا في أمور كثيرة كما يشير إلى ذلك قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (هود: 118-119).
اختلف المسلمون منذ عهد الصحابة، رضوان الله عليهم، ولا زالوا يختلفون إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد شمل هذا الاختلاف جوانب عديدة من شؤونهم الدينية والدنيوية، فقد وقع الاختلاف بين الصحابة في بعض المسائل الفقهية، واتسع هذا الاختلاف منذ خلافة علي، رضي الله عنه، ليشمل المسائل السياسية والاعتقادية حيث ظهرت فرق كثيرة مثل الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كما اختلف الأئمة المجتهدون بعد ذلك في المذاهب الفقهية، حيث صار لكل إمام مذهبه الفقهي له أتباعه وأنصاره، وظهر اختلاف داخل المذهب الفقهي الواحد، ثم خلف هؤلاء وأولئك فوج من الفقهاء صار منتهى مبتغاهم الاطلاع على فقه إمام مذهبهم، وأقوال تلاميذ ذلك المذهب، فإذا استطاع بعضهم الترجيح بين تلك الأقوال أو التخريج عليها دل ذلك على علو منزلته الفقهية، وحظي ببالغ التقدير وكامل الاحترام من طرف الخاص والعام، وإن وقع اختلاف بين هؤلاء ظل محصورا في دائرة التقليد التي أحاطت بالعالم الإسلامي بعد ذهاب أئمة الفقه والاجتهاد.
من خلال هذه المقدمة تتضح أمامنا الخطة التي سنسير على نهجها في معالجة هذا الموضوع، وهو موضوع شائك، متشعب الجوانب بعيد الأعماق تقف محدودية قدرتنا دون الإحاطة به وسبر أغواره، فلم يبق أمامنا إلا أن نتوكل على عون الله وتوفيقه ونكتفي بلمس بعض جوانبه التي يعن لها أنها ذات فائدة. وهذا يقتضي منا أن نقسم الموضوع إلى ثلاثة مباحث وهي كما يلي:
المبحث الأول: نظرة عامة عن الاختلاف
المبحث الثاني: أسباب الاختلاف
المبحث الثالث: آداب الاختلاف
الخاتمة
المبحث الأول: نظرة عامة عن الاختلاف
نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: نتناول في أولهما؛ التعريف بالاختلاف، ونتعرض في ثانيهما؛ لأهم مراحل الاختلاف.
المطلب الأول: التعريف بالاختلاف
الاختلاف أو المخالفة أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو قوله، لذلك يمكن القول بأن الخلاف والاختلاف، يراد به مطلق المغايرة في القول، أو الرأي، أو الحالة، أو الهيئة، أو الموقف أما ما يعرف عند المختصين بـ"علم الخلاف" فهو علم يمكن من حفظ الأشياء التي استنبطها إمام من الأئمة وهدم ما خالفها دون الاستناد إلى دليل مخصوص، إذ لو استند إليه لأصبح مجتهدا أو أصوليا، والمفروض في "الخلافي" ألا يكون باحثا عن أحوال الفقه، بل حسبه أن يكون متمسكا بقول إمامه، لوجود مقتضيات الحكم، إجمالا، عند إمامه كما يظن هو، وهذا يكفي عنده لإثبات الحكم، كما يكون قول إمامه حجة لديه لنفي الحكم المخالف لما توصل إليه إمامه كذلك[1] وقد يتطور الخلاف فنكون حينئذ أمام ما يعرف بـ "الجدل".
الجدل أو علم الجدل
إذا اشتد اعتداد أحد المخالفين أو كليهما بما هو عليه من قول أو رأي أو موقف وحاول الدفاع عنه وإقناع الآخرين به أو حملهم عليه تسمى عندئذ تلك المحاولة بـ "الجدل"، فالجدل على هذا مرحلة أشد وأعنف من مجرد الخلاف. ويقوم علم الجدل على مقابلة الأدلة لإظهار أرجح الأقوال الفقهية. وقد عرفه بعض العلماء بأنه: علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد ولو كان حقا"[2] وقد ورد التنبيه على خطورة الجدل بغير حق في كثير من الآيات القرآنية نذكر منها قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ...﴾ (الحج: 3). وقوله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ (لقمان: 20).
وذهب كتاب الله إلى أبعد من هذا حيث جعل بعض الجدل من وحي الشيطان حين قال: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: 121). ونبه كتاب الله المؤمنين إلى أن يجادلوا غيرهم من أهل الكتاب بالتي هي أحسن، بمقتضى قوله عز وجل: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت: 46). وكما قد يتطور الخلاف فيتحول إلى جدل، يمكن أن يحتد الجدل فيصير شقاقا.
الشقاق
إذا اشتدت خصومة المتجادلين، وآثر كل منهما الغلبة بدل الحرص على ظهور الحق ووضوح الصواب، وتعذر أن يقوم بينهما تفاهم أو اتفاق، سميت تلك الحالة بـ"الشقاق" والشقاق أصله أن يكون كل واحد في شق من الأرض؛ أي نصف أو جانب منها، فكأن أرضا واحدة لا تتسع لهما[3] وقد وردت كلمة "شقاق" وفروعها في كثير من الآيات القرآنية، ومعظمها ورد في معرض ذم الكفار على موقفهم العدائي من دعوة الرسول الكريم، من ذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: 13). وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد: 32).
ونزل في حق اليهود بعد ما نقضوا العهد وحل بهم ما حل من الهزيمة والخسران: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر: 4). ومن ذلك أيضا قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: 115). وقوله عز من قائل: ﴿فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (البقرة: 137). وقوله: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص: 2). ونزل في محاولة الصلح بين الزوجين قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (النساء: 35).
يتضح مما سبق أن الاختلاف منه ما هو مقبول، ومنه ما هو مذموم، ذلك لأن الله تعالى خلق الناس متبايني العقول، وجعلهم مختلفين في أفكارهم وتصوراتهم، وألسنتهم وألوانهم، كما يشير إلى ذلك قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم: 22). وترتب على هذا الاختلاف أن اتجه كل واحد حسب قدراته وميوله إلى العمل الذي هو أهل له، وبذلك جعل الله الخلق خلائق، لإعمار الكون، وازدهار الوجود، ولو خلق الله الناس سواسية في كل شيء لما استقامت الحياة على هذه الأرض، ونتيجة لذلك نستطيع القول بأن الاختلاف الذي وقع في الماضي ولا يزال يقع بين المسلمين، يعتبر ظاهرة طبيعية، بل وصحية، في غالب الأحيان؛ إذ يدل على حيوية هذه الشريعة من خلال نصوصها، التي جاءت عامة ومجملة، وبفضل هذا الاختلاف في الفهم، نما الفقه الإسلامي وتكونت مذاهبه.
وحينما نتأكد من هذا يستحسن أن نقف عند أهم مراحل الاختلاف التي تشكل موضوع المطلب الآتي.
المطلب الثاني: أهم مراحل الاختلاف
غير خاف أنه لم يكن يتصور أن يقع اختلاف أو اتفاق بين فقهاء الصحابة في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع الذي لا ينطق عن الهوى، والمرجع الأعلى للمسلمين، يلجؤون إليه في كل صغيرة وكبيرة، فيجدون لديه الصدر الرحب، والحلول التشريعية لكل ما يحدث لهم من قضايا، سواء تعلقت بالعبادات أو بالمعاملات، وما إن التحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى حتى وجد الصحابة أنفسهم أمام مشاكل لم يسبق لها مثيل على عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بحكمها نص قطعي الدلالة والثبوت، فأخذوا يلتمسون لها الحلول الاجتهادية، وعندئذ نشأت المرحلة الأولى من الاختلاف، وحيث إنه من غير الممكن التعرض لجميع مراحل الاختلاف، فإننا سنقف عند مرحلتين فقط، لأنهما يشكلان الأساس لما بعدهما، وهما مرحلة الاختلاف على عهد الصحابة، ومرحلة الاختلاف بين أهل مدرسة الحديث وأهل مدرسة الرأي.
الاختلاف في عهد الصحابة
لم يعد الاجتهاد في عهد الصحابة محصورا في الحقوق الخاصة كما هو الحال في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، بل تناول الحقوق العامة، واتسع التشريع الاجتهادي في هذه الحقوق ليشمل الحقوق الأساسية، والإدارية، والحقوق الدولية، وتعرض لكل قضية لها مساس بحياة الدولة والمصلحة العامة، وقدم كثيرا من الأحكام والمبادئ الجديدة، التي كانت ضرورية لتأمين تلك الحياة وتلك المصلحة[4].
وكان الصحابة يتورعون عن الفتوى ويحيل بعضهم على بعض، خشية الخطأ والزلل، وكان الخليفة يستشير الصحابة ولا يستبد برأيه، لذلك كان اختلافهم قليلا.
ولعل أول مشكلة حدثت لهم بعد وفاة الرسول هي مشكلة خلافته، وهي تعد نتيجة لتلك الوفاة، فقد اختلفت وجهات النظر حول من يخلف الرسول وصار الصحابة ثلاث جماعات، فانحاز الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، ومعهم أسيد بن حضير في بني الأشهل[5].
وفي سقيفة بني ساعدة دارت مناقشة حادة بين المهاجرين والأنصار حول الخلافة انتهت بمبايعة أبي بكر الصديق، وكانت بيعة السقيفة بيعة خاصة، أما البيعة العامة فقد تمت في المسجد في اليوم الموالي، حيث جلس أبو بكر على المنبر، وبايعه الناس، وهكذا تمت بيعة أبي بكر بناء على رأي الأغلبية من المهاجرين والأنصار، وبقيت فئة معارضة، من بينهم سعد بن عبادة من الأنصار[6] وعلي بن أبي طالب ومن معه من بني هاشم... لاعتقادهم أنهم أولى بالخلافة من عامة قريش، وهكذا تمت مبايعة أبي بكر الصديق بالأغلبية أول الأمر، وصارت إجماعا بعد مبايعة علي بن أبي طالب ومن معه.
وبذلك حسم الخلاف في قضية الخلافة، لأن روح العقيدة كانت متمكنة من نفوس الصحابة، فكانوا، بفضل هذه الروح، يسارعون بالعودة إلى جادة الصواب أينما ظهر.
ومن أهم القضايا التي أثارت اختلافات كثيرة بين فقهاء الصحابة قضية الإرث، وإذا كانت طبيعة هذا البحث لا تسمح بتتبعها فإننا نكتفي منها بقضية نصيب الجد من الإرث.
من المعلوم أن ميراث الجدة بدوره لم يرد به نص خاص في سورة النساء، وبقي نصيبها مجهولا لدى جمهور الصحابة، إلى أن جاءت الجدة إلى أبي بكر تبغي نصيبها من الإرث، ولم يكن أبو بكر وقتها يعلم حكم هذه القضية في السنة، وبعد أن سأل الصحابة شهد المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة، بأنهما سمعا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس، فأنفذه لها أبو بكر، وانعقد الإجماع على ذلك، هذا وإذا كان حكم ميراث الجدة انتهى إلى الإجماع المستند إلى السنة، فإن نصيب الجد بقي مثار خلاف بين فقهاء الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الفقه.
ويظهر أن سبب الخلاف عدم وجود نص خاص في القرآن يذكر نصيب الجد بصورة صريحة ومحددة، كما هو الشأن في أصحاب الفروض المقدرة.
ونضيف أن لفظ الأب في اللغة كما يطلق على الأب المباشر حقيقة، يطلق على الأب غير المباشر مجازا، بخلاف لفظ الوالد، فإنه لا يطلق إلا على الأب المباشر، لذلك يصح أن نقول: أبونا آدم، ولا يصح أن نقول والدنا آدم.
وقد كثر الخلاف حول ميراث الجد إلى حد أن كره بعض الصحابة الحديث عنه، كما جاء في حديث سفيان الثوري عن عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي قال: كره عمر الكلام في الجد حتى صار جدا[7].
وإذا كنا لا نستحسن الاسترسال في أمر ميراث الجد فإنه لا مناص لنا من ذكر أهم ما استند إليه في هذا الموضوع، ليتبين لنا من خلال ذلك كيف كان الصحابة يفكرون ويجتهدون كلما وجدوا أنفسهم أمام ندرة النصوص أو غموضها.
وأول نص نورده حول هذه القضية، حديث عمران بن حصين الذي جاء فيه: أن رجلا أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدبر دعاه وقال: لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة[8].
وهذا الحديث على أهميته لم يكن كافيا لإزالة الخلاف، إذ هو يدل على أن الجد يستحق ما فرضه له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لكننا-كما يقول قتادة-لا ندري مع من ورثه، قال: وأقل ما يرثه الجد السدس، قيل: وصورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل، فللبنتين الثلثان، والباقي ثلث، دفع النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى الجد سدسا، بالفرض، لكونه جدا، ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب، لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى، أي ذهب، فدعاه وقال لك سدس آخر، ثم أخبره أن هذا السدس طعمة؛ أي زائد على السهم المفروض، وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض[9] .
وجاء في صحيح البخاري: "فقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير، الجد أب، وقال ابن عباس: "يا بني آدم" "واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب" ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني!
ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة[10].
وشبه علي الجد بالبحر والنهر الكبير، والأب بالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر، ألا ترى أنه إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر. وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها، والأب كغصن فيها، والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع، ولا يرجع إلى الساق[11].
ويتضح من المثالين اللذين ضربهما كل من علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أن الصحابة كانوا يلجؤون إلى القياس إذا لم تسعفهم النصوص، وتبعا لهذا القياس الذي كان الهدف منه إثبات قوة قرابة الأخ من أخيه على قرابته من جده، وبناء على هذا القياس لا يفضل الجد على الإخوة في الميراث. لذلك كان زيد بن ثابت يرى-كما يقول الشعبي-أن يجعل الجد أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان علي يجعله أخا بينه وبين ستة وهو سادسهم، ويعطيه السدس، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم[12] وكان مقتضى القياس الذي سلكه كل منهما أن يفضل الإخوة على الجد في الميراث ما داموا أقرب إلى بعضهم من جدهم.
ويظهر من هذه النازلة أن الاختلاف مشروع حتى لو تعلق بشؤون الأسرة والميراث، خصوصا عند غياب النصوص أو عدم كفايتها، أو عندما تكون هذه النصوص ظنية الدلالة، كما هو الشأن في هذه النازلة، وقد تشعب الخلاف حول نصيب الجد من الميراث، إلى درجة أن قال عمر عندما طعن: "إني لم أقض في الجد شيئا" وقال علي رضي الله عنه: "من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة"[13].
ونرى أنه ينبغي أن تحمل مثل هذه الأقوال على المبالغة في الحيطة عند إجراء عملية الاجتهاد، إذ أن الصحابة، رضوان الله عليهم، كانوا يتحلون بهذه الصفة تجاه الأحكام الاجتهادية، ليتركوا الباب مفتوحا للمزيد من البحث.
ومن القضايا الهامة التي اختلفت فيها وجهتا النظر بين عمر وأبي بكر، رضي الله عنهما، قضية قسمة المال العام بين السابقين الأولين والمتأخرين في الإسلام، وبين الأحرار والموالي، وبين الذكور والإناث، فكان أبو بكر، رضي الله عنه، يسوي في العطاء دون تفضيل بين السابقين واللاحقين، وقال حين طلب إليه التفصيل: "إنما أسلموا لله، وأجرهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، ومعنى هذا أنني لا أعطيهم على إسلامهم وفضائلهم التي يتقربون بها إلى الله شيئا من الدنيا، لأنهم فعلوها لله، وقد ضمن لهم أجرها في الآخرة، وإنما الدنيا بلاغ ودفع للحاجات، فأضع الدنيا حيث وضعها الله من دفع الحاجات وسد الخلات، والآخرة موضوعة للجزاء على الفضائل، فأضعها حيث وضعها الله، ولا أعطي أحدا على سعيها شيئا من متاع الدنيا[14].
ورأى عمر وجماعة من الصحابة أن يقدم أهل السبق في الإسلام على قدر منازلهم، وظل متمسكا برأيه أثناء خلافته وقال: "لا أجعل من قاتل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كمن قاتل معه"[15].
وإذا كان كل من أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، رأى المصلحة فيما ذهب إليه، فإننا نميل إلى رأي أبي بكر، الذي يفصل بصورة قاطعة بين العمل من أجل الدنيا ومتاعها، وبين العمل لرضى الله ونيل ثوابه يوم لقائه.
وبفضل اجتهادات كبار الصحابة الذين اطلعوا على السنة النبوية ووقفوا على أسباب النزول، وضعت الأسس المتينة للتشريع الإسلامي في مختلف المجالات، وخلفهم فوج من صغار الصحابة والتابعين حملوا العبء من بعدهم، وأضافوا لبنات أخرى لتلكم الأسس، ونشأ عن تفرق هؤلاء في مختلف الأمصار الإسلامية ظهور مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي، اللتين تشكلان المحطة الثانية في حديثنا عن مراحل الاختلاف.
2. ظهور مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي
في هذا الدور من أدوار التشريع الإسلامي، ترتب على انسياح العلماء من صغار الصحابة وكبار التابعين في الآفاق، وتفرقهم في الأمصار الإسلامية، وتشعب المسائل، أن بدأت بالظهور مدرستا الحديث والرأي، الأولى بالحجاز، والثانية بالعراق[16]. كان على رأس المدرسة الأولى، سعيد بن المسيب، ورأى هو وأصحابه أن أهل الحرمين الشريفين أثبت الناس في الحديث والفقه، وأعلمهم بفتاوى رسول الله، صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأوا في ذلك ما يغنيهم عن استعمال الرأي.
وكان على رأس المدرسة الثانية إبراهيم النخعي، وقد بنيت طريقتهم على أنهم كانوا يرون أحكام الشرع معقولة المعنى، مشتملة على مصالح راجعة إلى العباد، وأنها مبنية على أصول محكمة، وعلل ضابطة لتلك الأحكام، فكانوا يبحثون عن تلك العلل، ويتعرفون على الحكم التي شرعت الأحكام لأجلها، ويجعلون الحكم دائرا معها وجودا وعدما، ولذلك أكثروا من القياس، وربما ردوا بعض الأحاديث لمخالفتها لتلك الأصول، ولاسيما إذا وجدوا ما يعارضها[17].
يضاف إلى ذلك قلة انتشار الحديث في العراق أول الأمر، وتعقد الحياة المدنية فيه، وتشعب الأفكار، وازدحام الأعراف، وكثرة الحوادث التي لم يعرف فيها نص صريح، وكل ذلك يلجئ إلى استعمال الرأي[18].
أما الفريق الأول فكان بحثهم عن النصوص أكثر من بحثهم عن العلل، إلا فيما لم يجدوا فيه نصا،[19] بمعنى أنهم كانوا يعتمدون على الأثر أكثر من اعتمادهم على الرأي والقياس، وساعدهم على هذا النهج كثرة رواية الحديث في الحجاز، لأن المدينة دار الهجرة، ومأوى الصحابة، ومن انتقل إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر[20]، أضف إلى ذلك قلة حاجتهم لاستعمال الرأي، لندرة الحوادث المدنية المعقدة لديهم[21].
غير أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا أن أهل الحجاز اختصوا بالحديث، وأن أهل العراق اختصوا بالرأي، بصورة مطلقة، بل إن الرأي وجد بالعراق إلى جانب الحديث، وكان بالحجاز الحديث إلى جانب الرأي، غير أن الرأي عند أهل العراق كان أكثر منه عند أهل الحجاز، وكان بالمدينة رأي إلى جانب الحديث، إلا أن اعتماد أهل الحجاز على الحديث كان أظهر من اعتمادهم على الرأي. ومرد ذلك إلى أن حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بدأ وختم في الحجاز، والمستمعون لرسول الله كثيرون، ومن العسير الكذب في حادثة شاهدها الكثير، أو قول سمعه الجم الغفير، وليس الأمر كذلك في العراق، فبعده عن الحجاز يجعل اصطناع القول ممكنا، هذا إلى أن أخلاط المسلمين من الأمم المختلفة كانوا في العراق أكثر منهم في الحجاز، وفيهم من لم يصل الإيمان إلى أعماق قلبه[22].
وتبعا لكل ما سبق تغيرت نوعية الاجتهاد،إذ كان أهل العراق يعتمدون على القياس، في حين كان اعتماد الرأي عند أهل الحجاز على المصلحة، وتبع ذلك كثرة التعريفات الفقهية في العراق، والإفتاء فيما لم يرد من الوقائع لاختيار الأقيسة، وهذا ما سمي بالفقه الافتراضي أو التقديري، وبما أن اعتماد الرأي عند أهل الحجاز على المصلحة، فإن تقديرها لا يتحقق إلا فيما يقع من الحوادث، فلا يجيء فيها الافتراض والتقدير[23].
ويمكن تلخيص الاختلاف بين المدرستين في نقطتين أساسيتين:
- كان أهل مدرسة الرأي يكثرون من الفروع حتى الخيالي منها، وقد ألجأهم إلى ذلك كثرة ما يعرف لهم من الحوادث، لذلك انتقدهم بعض العلماء من هذه الناحية، حتى قال الأوزاعي إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط، وقال الشعبي: "والله لقد بغض إلي هؤلاء القوم المسجد، حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري، قلت من هم يا أبا عمر؟ قال: الأرأيتيون"[24].
- قلة روايتهم للحديث، واشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها إلا القليل، واكتفاؤهم بما وصل إليهم من الصحابة الذين وجدوا في العراق في ذلك العهد، وعددهم قليل[25] لذلك قال ابن خلدون: "وإنما قلل من قلل من الرواية لأجل المطاعن التي تعترضه فيها، والعلل التي تعرض في طريقها، سيما والجرح مقدم عند الأكثر...[26].
ومن جهة أخرى امتاز أصحاب مدرسة الحديث بميزتين أيضا:
- كراهيتهم الشديدة للسؤال عن الفروض، لأن المصدر عندهم وهو السنة محدود، أضف إلى ذلك عدم وجود حوادث طارئة جديدة لا نص فيها، وهم يكرهون الرأي.
- الاعتداد بالحديث حتى الضعيف منه، وتساهلهم في شروطه، وتقديمهم ذلك على الرأي[27] ويؤكد هذا ما قاله عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي[28].
وبهذا الاختلاف والتنوع قدمت كل المدرستين خدمة جلى للفقه الإسلامي، فالظروف التي نشأت فيها مدرسة الرأي جعلت أصحابها يكثرون من استعمال الرأي حين لا يوجد نص موثوق بصحته، وهم بذلك قدموا بآرائهم خدمات جليلة للفقه، وإليهم يعود الفضل في تنظيمه وجعله علما ذا قواعد وأصول، معلل الأحكام متين البنيان، واضطر أصحاب مدرسة الحديث بدورهم أمام اتساع الحضارة وكثرة الحوادث فيما بعد، إلى القول بالرأي في حدود ضيقة[29]. وقد كان وراء هذه الحركة الفقهية المباركة رواد قادوها من فقهاء التابعين، عبر ابن قيم الجوزية عن فضلهم، حيث قال: "كان أكابر التابعين يفتون في الدين، ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة حاضرون، يجوزون لهم ذلك"[30].
واعترافا بفضل هؤلاء الأعلام يستحسن أن نقتطف بعض الفقرات من كلام الإمام الدهلوي؛ إذ يقول: "صار لكل من علماء التابعين مذهب على حياله، فانتصب في كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة، وبعدهما الزهري والقاضي يحيى بن سعيد، وربيعة بن عبد الرحمان فيها، وعطاء بن أبي رباح بمكة، وإبراهيم النخعي والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، وطاوس بن كيسان باليمن، ومكحول بالشام، فأظمأ الله أكبادا إلى علومهم، فرغبوا فيها، وأخذوا عنهم الحديث وفتاوى الصحابة وأقاويلهم... وكان سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي وأمثالهما، جمعوا أبواب الفقه أجمعها، وكان لكل باب أصول تلقوها عن السلف، وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه، وأصل مذهبهم فتاوى عبد الله بن عمر، وعائشة، وابن عباس، وقضايا قضاة المدينة، فجمعوا من ذلك ما يسره الله، ثم نظروا فيها نظرة اعتبار تفتيش... وكان إبراهيم النخعي وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود، وقضايا علي، رضي الله عنه، وفتاواه، وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة، فجمع من ذلك ما يسره الله، ثم صنع في آثارهم كما صنع أهل المدينة في آثار أهل المدينة... فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما، وأخذوا عنهما، وعقلوه وخرجوا عليه[31].
وغير خاف أن هاتين المدرستين هما أصل المذاهب الفقهية التي تكونت فيما بعد، فمدرسة أهل الرأي هي أصل مذهب أبي حنيفة، ومدرسة أهل الحديث هي أصل مذهب الإمام مالك. وعلى الجملة فأصول المذاهب الفقهية كلها لا تخرج عن المبادئ التي أقامها الصحابة والتابعون، فكان حقا على من جاء بعدهم أن ينهجوا نهجهم، ويسلكوا طريقتهم، إنجازا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"[32].
وكان الإمام مالك، رضي الله عنه، أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأوثقهم إسنادا، وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة، وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى، فلما وسد الأمر إليه حدث وأفتى وأفاد وأجاد، وانطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة"[33].
وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم النخعي وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات مقبلا على الفروع أتم إقبال.
ونشأ الشافعي في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما، فنظر في صنيع الأوائل، فوجد فيه أمورا أكبحت عنانه عن الجريان في طريقهم، وقد ذكرها في أوائل كتاب الأم[34].
أما أحمد بن حنبل فقد قال عنه بعضهم بأنه: إمام السنة على الإطلاق، وأنه ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة[35].
إننا إذ نكتفي بهذا العرض الموجز عن مراحل الاختلاف نتساءل عن الأسباب الداعية إليه، والحديث عن هذه الأسباب هو الذي يشكل موضوع المبحث الآتي:
المبحث الثاني: أسباب الاختلاف
ليس في نيتنا أن نتتبع جميع أسباب الاختلاف، وحسبنا الإشارة إلى بعضها، وهكذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في أولهما أسباب اختلاف الصحابة، ونتناول في الثاني أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء.
المطلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع
من المعلوم أن الفقه لم يكن مدونا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن البحث عن الأحكام حينئذ مثل البحث عند الفقهاء فيما بعد، حيث أصبح هؤلاء يبينون الأركان والشروط والآداب... بل كانوا في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، يرونه يصلي ويصوم ويحج ويتوضأ... فيفعلون كما كان يفعل، ولا يبحثون عما وراء ذلك، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقع الاختلاف في بعض الفروع، وكان لهذا الاختلاف أسباب نورد بعضها في ما يلي منها:
- أن يسمع صحابي حكما في قضية أو فتوى ولا يسمعه الآخر، فيجتهد برأيه في القضية، وذلك على وجوه، أحدها، أن يقع اجتهاده موافقا للحديث، ومثاله ما رواه النسائي وغيره عن أبي مسعود، رضي الله عنه، سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا فقال: لم أسمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقضي في ذلك، فاختلفوا عليه شهرا، وألحوا، فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط،؛ (أي لا نقصان ولا زيادة) وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار، فشهد بأنه، صلى الله عليه وسلم، قضى بمثل ذلك في امرأة منهم، ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام[36].
- أن تقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث، بالوجه الذي يقع به غالب الظن، فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع، ومثاله ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة، رضي الله عنه، كان من مذهبه أن من أصبح جنبا فلا صوم له، حتى أخبرته بعض أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، بخلاف مذهبه فرجع[37].
- اختلاف الفتوى بسبب الاختلاف في فهم القرآن وذلك على وجوه:
أ. من ورود لفظ يحتمل معنيين، كاختلافهم في فهم القرء من قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ففهم عمر وابن مسعود أنه الحيضة، وفهم منه زيد بن ثابت أنه الطهر، ولكل منهما ما يؤيد فهمه. وكما في آية الإيلاء، فإن الله جعل للمولي أجلا يحق له أن يتربصه وهو أربعة أشهر، ثم عقب ذلك بقوله: "فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم"، فالنص يحتمل أن تكون المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب مضي الأجل المحدد، ويحتمل ألا يكون الفيء إلا في المدة المحددة، فإن انتهت فلا فيء والطلاق واقع بمضيها.
ب. من ورود حكمين مختلفين لموضوعين يظن أن أحدهما يشمل بعض ما يشمله الآخر، فيتعارضان في ذلك الجزء، ومثل ذلك آية معتدة الوفاة، فقد أوجبت الآية أن تتربص أربعة أشهر وعشرا، ويظن شمولها للحامل، وآية معتدة الطلاق جعلت عدة الحامل وضع الحمل، فمعتدة الوفاة الحامل مترددة بين أن تشملها الآية الأولى، فيجب عليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا وإن وضعت حملها قبل ذلك، وبين أن تكون عدتها وضع الحمل ولو لم تتربص تلك المدة، عملا بآية معتدة الطلاق. قال بكل من الرأيين بعض كبار الصحابة[38].
- أن يبلغ الصحابي الحديث، ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلا يترك اجتهاده، بل يطعن في الحديث، مثاله ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث، فلم يجعل لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نفقة ولا سكنى، فرد عمر شهادتها وقال: "لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، لها النفقة والسكنى".
- أن لا يصل إليه الحديث أصلا، ومثاله ما أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن، فسمعت عائشة، رضي الله عنها، بذلك فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا! يأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات[39].
- ومن أسباب الاختلاف، اختلافهم في علة الحكم، ومثاله القيام للجنازة، فقال قائل: لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر، وقال قائل: لهول الموت فيعمهما، وقال قائل: مر على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بجنازة يهودي فقام لها، كراهة أن تعلو فوق رأسه، فيخص الكافر.
- اختلاف الضبط، ومثال ما روى ابن عمر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقضت عائشة عليه بأنه وهم بأخذ الحديث على هذا. مر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها، فظن أن العذاب معلول للبكاء، وظن الحكم عاما على كل ميت[40].
هذه بعض أسباب اختلاف الصحابة في الفروع، أما أسباب اختلاف أئمة الفقه فنعرض لها بإيجاز في المطلب التالي:
المطلب الثاني: أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء
كانت دائرة الخلاف في عهد الصحابة ضيقة لا تتجاوز الفروع، لكن لما آلت السلطة التشريعية ابتداء من القرن الثاني الهجري إلى طبقة الأئمة المجتهدين اتسعت دائرة الخلاف بين رجال التشريع، ولم تقف أسباب اختلافهم عند الأسباب التي بني عليها الخلاف عند الصحابة، بل جاوزتها إلى أسباب تتصل بمصادر التشريع، وبالنزعة التشريعية، وبالمبادئ اللغوية التي تطبق في فهم النصوص، وعلى هذا لم يكن اختلافهم في الفتاوي والفروع فقط، بل كان اختلافهم أيضا في أسس التشريع وخططه، وصار لكل فريق منهم مذهب خاص يتكون من أحكام فرعية استنبطت بخطة تشريعية خاصة.
ويرجع اختلاف الخطة التشريعية للأئمة المجتهدين إلى اختلافهم في أمور ثلاثة: الأول في تقدير بعض المصادر التشريعية، والثاني: في النزعة التشريعية، والثالث: في بعض المبادئ اللغوية التي تطبق في فهم النصوص.
أ. فأما اختلافهم في تقدير بعض المصادر التشريعية فقد ظهر فيما يلي:
أولا: في طريق الوثوق بالسنة، والميزان الذي ترجح به رواية على رواية، لأن الوثوق بالسنة مبني على الوثوق برواتها وكيفية روايتها، فقد اختلف الأئمة في طريق هذا الوثوق فمجتهدو العراق، أبو حنيفة وأصحابه، يحتجون بالسنة المتواترة والمشهورة ويرجحون ما يرويه الثقات من الفقهاء، ومجتهدو المدينة، مالك وأصحابه، يرجحون ما عليه أهل المدينة بدون اختلاف، ويتركون ما خالفه من أخبار الآحاد، وباقي الأئمة يحتجون بما رواه العدول الثقات من الفقهاء وغير الفقهاء، وافق عمل أهل المدينة أو خالفه.
وترتب على هذا أن مجتهدي العراق جعلوا المشهور في حكم المتواتر، وخصصوا به العام في القرآن وقيدوا به المطلق فيه، وغيرهم لم يجعلوا له هذه القوة. وترتب أيضا أن الحديث المرسل -وهو الذي رواه الصحابي بقوله: أمر رسول الله بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، من غير أن يصرح بأنه سمع ذلك بنفسه- أو شاهده أو شافهه، يحتج به بعض رجال التشريع، ولا يحتج به بعضهم، فهذا الاختلاف في طريق الوثوق بالسنة أدى إلى أن بعضهم احتج بسنة لم يحتج بها الآخر. وبعضهم رجح بسنة هي مرجوحة عند الآخر، ونشأ عن هذا الاختلاف في الأحكام[41].
ثانيا: في فتاوى الصحابة وتقديرها
اختلف الأئمة في الفتاوى الاجتهادية التي صدرت عن أفراد الصحابة، فكان أبو حنيفة ومن تابعه بأخذ بأية فتوى منها ولا يتقيد بواحدة معينة ولا يخرج عنها جميعا. والشافعي ومن تابعه كان يعتبرها فتاوى اجتهادية فردية صادرة من غير معصومين، فله أن يأخذ بأية فتوى منها، وله أن يفتي بخلافها كلها.
ثالثا: في القياس
كان بعض المجتهدين من الشيعة وأصحاب الظاهر ينكرون القياس، ونفوا أن يكون القياس مصدرا للتشريع، ولهذا سموا نفاة القياس. بينما احتج جمهور الأئمة بالقياس، وعدوه المصدر التشريعي بعد القرآن والسنة والإجماع، ولكن مع اتفاقهم على أنه حجة اختلفوا فيما يصح أن يكون علة للحكم. ونشأ عن هذا الاختلاف في الأحكام[42].
ب. وأما اختلافهم في النزعة التشريعية، فقد ظهر في انقسامهم إلى فريق أهل الحديث، ومنهم أكثر مجتهدي الحجاز، وفريق أهل الرأي، ومنهم أكثر مجتهدي العراق، وعلى الجملة إن شئنا المقارنة بين الأئمة الأربعة من حيث استعمالهم للرأي وتمسكهم بالآثار ألفينا طرفين ووسطا، ويمثل الطرفين في جهة الرأي الحنفية، وفي جهة الآثار الحنابلة، وبين هؤلاء وأولئك المالكية والشافعية، غير أن المالكية أكثر من الشافعية استعمالا للرأي، لأنهم يعملون بالمصلحة المرسلة والاستحسان. وقد كان الإمام مالك فقيها كبيرا ومحدثا بارعا، في حين كان أبو حنيفة فقيها لا يلحق، كما جاء ذلك على لسان ابن خلدون، وقد شهد له بذلك أهل بلدته، وخصوصا مالكا والشافعي[43]. وكان الأئمة جميعا متفقين على أن الحديث حجة شرعية ملزمة، وأن الاجتهاد بالرأي، أي بالقياس حجة شرعية فيما لا نص فيه، وقد ترتب على هذا الانقسام أن فقهاء العراق أمعنوا النظر في مقاصد الشارع، واقتنعوا بأن الأحكام الشرعية معقولة المعنى، ولها مقاصد ترمي إلى تحقيق مصالح الناس، ولهذا لا بد أن تكون متسقة لا تعارض بين نصوصها وأحكامها، وعلى هذا الأساس يفهمون النصوص، ويرجحون نصا على نص، ويستنبطون فيما لا نص فيه، ولو أدى استنباطهم على هذا الأساس إلى صرف نص عن ظاهره، أو ترجيح نص على آخر أقوى منه رواية حسب الظاهر، وهم بذلك لا يتحرجون من التوسع في الاجتهاد بالرأي.
وأما فقهاء الحجاز فقد عنوا بحفظ الأحاديث وفتاوي الصحابة، واتجهوا في تشريعهم إلى فهم الآثار حسبما تدل عليه عباراتها، وتطبيقها على ما يحدث من الحوادث، غير باحثين عن علل الأحكام ومبادئها، وكانوا من أجل هذا يتحرجون من الاجتهاد بالرأي، ولا يلجؤون إليه إلا عند الضرورة القصوى[44].
فمثلا ورد في الحديث، أن في كل أربعين شاة شاة، وأن صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير، وأن من رد الشاة المصراة بعد احتلاب لبنها رد معها صاعا من تمر.
فهم فقهاء العراق هذه النصوص على ضوء معناها المعقول ومقصد الشارع من تشريعها، وهو أن المالك أربعين شاة يجب عليه أن ينفع الفقراء بواحدة أو ما يعادلها، وأن المتصدق بصدقة الفطر يجب عليه أن ينفعهم بصاع من تمر أو ما يعادله، واللبن المحتلب يضمن بمثله أو قيمته، وليس خصوص الشاة أو الصاع مقصودا للشارع، فمن زكى بقيمة الشاة، أو تصدق بقيمة الصاع، أو ضمن لبن المصراة بقيمته أجزأه، لأن المقصود نفع الفقراء وتعويض المال المتلف.
أما فقهاء الحجاز فيفهمون هذه النصوص حسبما تدل عليه عباراتها الظاهرة، ولا يتجهون إلى التأويل، بناء على مراعاة العلل المعقولة، وبناء على هذا يوجبون الشاة بخصوصها، والصاع بخصوصه، ولا يجزئ في مذهبهم القيمة.
ج. وأما اختلافهم في بعض المبادئ الأصولية واللغوية فقد نشأ من اختلاف وجهات النظر في استقراء الأساليب العربية، فمنهم من رأى النص حجة على ثبوت حكمه في منطوقه، وعلى ثبوت خلاف حكمه في مفهومه المخالف، ومنهم من لم ير ذلك، منهم من رأى أن العام الذي يخصص قطعي في تناول جميع أفراده، ومنهم من رأى أنه ظني، ومنهم من رأى المطلق يحمل على المقيد عند اتخاذ الحكم ولو اختلف السبب، ومنهم من رأى الأمر المطلق للإيجاب ولا يصرف عنه إلا لقرينة. ومنهم من رأى أنه لا يحمل عليه إلا عند اتحاد الحكم والسبب. ومنهم من رأى أنه لمجرد طلب الفعل، والقرينة هي التي تعين الإيجاب أو غيره... إلى غير ذلك من المبادئ الأصولية التي تفرع عليها اختلافهم في كثير من الأحكام[45]. ومن هذا القبيل اختلافهم فيما يراد باللفظ المشترك، لأنه موضوع لغة لأكثر من معنى، وليس في صيغته دلالة على معنى معين مما وضع له، فلا بد من قرينة خارجية تعينه، كلفظ القرء الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فإنه موضوع لغة للطهر والحيض، فأي المعنيين يراد به في الآية، وبناء على هذا الاختلاف في الفهم، هل تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيضات أم بثلاثة أطهار؟ ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور وجماعة... إلى أن المراد بالقرء في الآية هو الطهر، والقرينة تأنيث اسم العدد، لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر، وهو الأطهار، وذهبت الحنفية وفريق آخر من المجتهدين إلى أن المراد بالقرء في الآية هو الحيض، والقرينة هي:
أولا: حكمة تشريع العدة، فإن الحكمة في إيجابها على المطلقة تعرف براءة الرحم من الحمل، والذي يعرف هذا هو الحيض لا الطهر.
ثانيا: قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فإنه جعل مناط الاعتداد بالحيض.
ثالثا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان"، فالتصريح بأن عدة الأمة بالحيض بيان للمراد بالقرء في اعتداد الحرة، وأما تأنيث العدد، فلمراعاة تذكير لفظ المعدود وهو القرء[46].
ويدخل ضمن هذا اختلافهم في فهم المراد من الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فقد اتفقوا بالجملة على أن القبض شرط في الرهن بناء على هذه الآية، لكن اختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟ وفائدة الخلاف أن من قال: شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، ومن قال: شرط تمام قال: يلزم بالعقد، ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة، حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة، وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول: "فرهان مقبوضة".
وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك، فقد خرج من اللزوم، وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة، فمالك عمم الشرط على ظاهره، فألزم من قوله تعالى: "فرهان مقبوضة" وجود القبض واستدامته.
والشافعي قال: إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد، فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف، كالحال في البيع، وكان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترطه في الصحة أن لا يشترط الاستدامة[47]. هذه بعض أسباب الاختلاف ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر، وهي ترجع إلى اختلاف في الفهم وتبدو معقولة ومقبولة.
وما دام هناك اتفاق على مصادر التشريع الأساسية، فإن الاختلاف في الوصول إلى هذه المصادر والاختلاف في فهمها وتقعيد القواعد للوصول إليها يعد نعمة كبرى لا يقدرها إلا من رسخ علمه واتسع عقله لإدراك ضرورة وجود هذه المسالك للوصول إلى الكتاب والسنة، ومن هنا ندرك السر الذي دفع الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز للقول: "ما يسرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا"[48].
وإذا كان الاختلاف لا بد منه وله أسباب مشروعة فيجب أن تكون له آدابه التي سنتحدث عنها في المبحث التالي:
المبحث الثالث: آداب الاختلاف
إن الاختلاف بين أئمة الفقه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يعد ظاهرة صحية، ما دام الغرض هو الوصول إلى الصواب في معرفة الأحكام الشرعية من مصادرها الشرعية.
ويقتضي منا الحديث عن آداب الاختلاف أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في أولهما الحديث عن آداب الاختلاف عند أئمة الفقه، ونبحث في الثاني آداب الاختلاف عند الصحابة رضوان الله عليهم.
المطلب الأول: آداب الاختلاف عند أئمة الفقه
تجدر الإشارة إلى أنه لا يعتد بالاختلاف إلا إذا كان بين من هم أهل للفتوى، لذلك لما سئل محمد بن الحسن، متى يحل للرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان صوابه أكثر من خطئه[49].
وقال الشافعي فيما رواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجلا عارفا بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما يعرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مع هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإن لم يكن هكذا فليس له أن يفتي.
وقال صالح بن أحمد، قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وذكر الكلام المتقدم.
وقال علي بن شفيق: قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر، بصيرا بالرأي[50].
وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان اختلافهم في أولى الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءة، وعللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على الهدى. ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى أئمة المذاهب في هذه المواضع... فقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها، ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يرى في مس المرأة نقضا للوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل أو ما مسته النار مسا مباشرا، ومنهم من لا يرى في ذلك بأسا. ومع ذلك فقد كان بعضهم يصلي خلف بعض، مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه والشافعي وغيرهم، رضي الله عنهم، يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم، وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا، وصلى الرشيد إماما وقد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد، وكان أفتاه الإمام مالك بأنه لا وضوء عليه وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب... وصلى الإمام الشافعي رحمه الله قريبا من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدبا معه، وقال أيضا: ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق، وفي البزازية عن الإمام الثاني، وهو أبو يوسف، رحمه الله أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام، وصلى الناس وتفرقوا، ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام فقال: إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا[51].
وهذا ما دمنا بصدد الحديث عن آداب الاختلاف فإننا نظن انه من المفيد الإشارة إلى رسالة الليث إلى الإمام مالك، رضي الله عنه، فهذه الرسالة تعد بحق نموذجا للآداب الرفيعة التي يجب أن تسود بين العلماء، وإذا كان موضوع الرسالة لا يهمنا كثيرا في هذا المقام، فإننا نكتفي ببعض الفقرات منها حيث يقول الإمام الليث في ختام رسالته بعد الإجابة بأدب جم... "وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك، لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك، مع استئناسي بمكانك، وإن نأت الديار، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك، فاستيقنه، ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك، وحال ولدك وأهلك، وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل بك، فإني أسر بذلك، كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا وتمام ما أنعم به علينا، والسلام عليك ورحمة الله"[52].
نكتفي بهذه النبذة الموجزة عن آداب الاختلاف عند أئمة الفقه لننتقل إلى الحديث عن آداب الاختلاف عند الصحابة الذي يشكل موضوع المطلب الآتي:
المطلب الثاني: آداب الاختلاف عند الصحابة
لعل خير ما نختم به آداب الاختلاف هو ما يمكن استخلاصه من آداب الاختلاف التي كانت سائدة بين علماء الصحابة، وخصوصا في عهد الخلفاء الراشدين، إذ يمكن من تتبع قضايا اختلافهم أن الهوى لم يكن مطية أحد من الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، وأن الاختلافات التي تمخضت عنها تلكم الآداب لم يكن الدافع إليها غير تحري الحق والوصول إلى الصواب، ونذكر من هذه الآداب:
- أنهم كانوا يتحاشون الاختلاف حين يجدون عنه مندوحة، وكانوا يحرصون كل الحرص على عدمه.
- وحين يكون للخلاف أسباب تبرره، كأن تصل سنة إلى أحد في أمر ولم تصل إلى الآخر، أو حين يختلفون في فهم النص، أو في لفظه، كانوا يقفون عند الحدود، ويسارعون إلى الاستجابة للحق، والاعتراف بالخطأ دون أي شعور بالغضاضة، وكانوا شديدي الاحترام لأهل العلم والفضل والفقه منهم.
- كانت أخوة الدين بينهم أصلا من أصول الإسلام الهامة التي لا قيام لدولة الإسلام بدونها، وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل الاجتهادية.
- لم تكن المسائل الاعتقادية مما يجري فيه الخلاف، فالخلافات لم تكن تتجاوز مسائل الفروع.
- كان الصحابة، رضوان الله عليهم، قبل خلافة عثمان، رضي الله عنه، مقيمين في المدينة، وقليل منهم في مكة لا يغادرون إلا لجهاد أو تعليم أو ما شابه ذلك، ثم يعودون، فكان يسهل اجتماعهم، ويتحقق إجماعهم في كثير من الأمور.
- كان الفقهاء والقراء بارزين ظاهرين كالقيادات السياسية، ولكل مكانته المعروفة، لا ينازعه فيها منازع، كما كان لكل شهرته في الجانب الفقهي الذي يتقنه، مع وضوح طرائقهم ومناهجهم في الاستنباط، وعليها بينهم ما يشبه الاتفاق الضمني.
- كانت نظرتهم إلى استدراكات بعضهم على بعض أنها معونة يقدمها المستدرك لأخيه وليست عيبا أو نقدا[53].
- لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يجرؤون على إبداء الرأي إلا عند الضرورة، وكانوا لا يبحثون عن الحلول الاجتهادية لوقائع فرضية، لذلك كان فقههم فقها واقعيا.
- كانوا يكرهون التسرع في الفتوى ويحيل بعضهم على بعض، فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فما منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا[54] وقد صدرت عنهم أقوال تدل على هذا الاتجاه التحفظي فيما يخص إبداء الرأي، وكانوا يرون ما يبدو لهم من رأي منسوبا إليهم لا إلى الشريعة، فكان أبو بكر إذا اجتهد برأيه يقول: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله[55].
وحدث أن كتب كاتب لعمر: هذا ما رأى الله ورأى عمر، فقال له عمر: بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر[56].
وروي عن عمر أيضا أنه قال: السنة ما سنه الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة.
وفي هذا الاتجاه روي عن ابن عباس أنه قال: إن كل من أفتى في كل ما يسألونه عنه لمجنون[57].
الخاتمة
يستخلص من كل ما سبق أن الاختلاف أمر طبيعي فرض نفسه في مختلف الأحقاب، منه ما هو مذموم، ومنه ما هو مقبول ما دامت أسبابه ومبرراته قائمة، غير أنه يجب مراعاة آدابه كما رعاها السلف الصالح، فأضحى أتباعهم حقا على من جاء بعدهم، والاختلاف هو سبب ظهور مذاهب فقهية أغنت الفقه الإسلامي بنظريات فقهية وحقوقية في منتهى الأهمية، سواء تعلق الأمر بالعبادات أو بالمعاملات، وأكسبته مرونة كبيرة جعلته صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان، فما على علمائنا اليوم إلا أن يستفيدوا مما خلفه أئمة الفقه، ويضيفوا إلى ذلك حلولا اجتهادية لكل ما يطرأ من وقائع جديدة لم يسبق لها نظير، وعليهم عند الاختلاف أن يراعوا ما راعاه السلف الصالح من آداب، مع الاعتراف بالفضل لمن تفوق منهم، والتريث في الفتوى، كلما وجد أحدهم نفسه مرتابا في الحل المناسب، حتى يستعد لهذه الفتوى بما يتطلبه الأمر من جدية في البحث والتقصي والتشاور، فإذا استنفذ كل الوسائل ولم يطمئن إلى حل معين فعليه أن يتوقف عن الفتوى ويحيل الأمر إلى غيره.
ومن الأفضل في مثل هذه الحالة أن يلجأ إلى الاجتهاد الجماعي الذي بات ممكنا في بلادنا، بفضل وجود مجالس علمية في مختلف الجهات، تضم طائفة من علماء الشريعة يسهل جمعهم وأخذ آرائهم التي أجمعوا عليها كحجة شرعية اجتهادية.
ولا يخفى ما في هذا من إحياء سنة الاجتهاد والرجوع إلى الخطة التشريعية التي كانت سائدة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
(انظر العدد 3 من مجلة الإحياء)
الهوامش
- طه جابر فياض العلواني، كتاب الأمة، جمادى الأولى 1405هـ، ص23 و24.
- المرجع نفسه، ص25.
- المرجع نفسه.
- معروفي الدواليبي، المدخل إلى علم الأصول، ص67-68.
- سيرة ابن هشام، ج4، ص335-336. وعبقرية عمر لمحمود العقاد، ص149.
- حسن إبراهيم حسن، النظم الإسلامية، ص15، ومحمد حسنين هيكل، الصديق أبو بكر، ص70.
- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج1، ص212.
- رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، راجع نيل الأوطار، ج6، ص176.
- الإمام الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ج6، ص176.
- صحيح البخاري، ج8، ص188. ونيل الأوطار، ج6، ص176.
- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج1 ص212-213. ونيل الأوطار للإمام الشوكاني، ج6، ص177-178.
- نيل الأوطار، ج6، ص178. إعلام الموقعين، ج1، ص212.
- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج1، ص380.
- عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج1، ص60.
- سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ط5، دار إحياء الكتب العربية، ص203.
- مصطفى الزرقاء، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج1، ص178.
- الشيخ محمد السايس، نشأة الفقه الاجتهادي، ص55.
- مصطفى الزرقاء، م، س، ج1، ص189.
- الشيخ محمد السايس، نشأة الفقه الاجتهادي، ص55.
- مقدمة ابن خلدون، ص445.
- مصطفى الزرقاء، م، س، ج1، ص178.
- أحمد أمين، فجر الإسلام، ج2، ص152.
- أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ج2، ص33.
- الإمام الشاطبي، الموافقات، ج4، ص186.
- أحمد أمين، فجر الإسلام، ص242.
- مقدمة ابن خلدون، ص444.
- عبد الرحمان الصابوني، المدخل لدراسة الفقه، ص229.
- إعلام الموقعين، ج1، ص76.
- أحمد إبراهيم بك، أصول الفقه وتاريخ التشريع، ص30.
- إعلام الموقعين، ج1، ص25.
- حجة الله البالغة، ج1، ص143-144.
- الإنصاف في أسباب الاختلاف للإمام ولي الله الدهلوي، ص34.
- الإمام الدهلوي، حجة الله البالغة، ج1، ص145.
- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، م، س، ص41.
- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج1، ص28.
- الإمام الدهلوي، حجة الله البالغة، ج1، ص141.
- الإمام الدهلوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ص23-24.
- الشيخ محمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، ص124.
- الإمام الدهلوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ص25-.26 وحجة الله البالغة، ج1، ص142.
- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، م، س، ص27-28.
- عبد الوهاب خلاف، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، ص71-73.
- المرجع نفسه، ص74.
- المقدمة، ص447.
- خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، م، س، ص75-77.
- المرجع نفسه، ص77-80.
- بداية المجتهد، ج2، ص89. القواني الفقهية، ص173 عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص172.
- ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص274-275.
- منار الإسلام، عدد 4، السنة 18 أكتوبر 1992 مقال للأستاذ أحمد عز الدين يسر: "الحديثين المرسل وأثره في اختلاف الفقهاء"،ص18.
- الإمام الدهلوي، حجة الله البالغة، ج1، ص158.
- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج1، ص46-47.
- الإمام الدهلوي، حجة الله البالغة، ج1، ص158.
- تراجع هذه الرسالة بكاملها في إعلام الموقعين، ج3، ص83-88.
- طه جابر فياض العلواني، كتاب الأمة، أدب الاختلاف في الإسلام، جمادى الأولى، 1405هـ، ص72-73.
- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج1، ص34.
- الخضري تاريخ التشريع الإسلامي، ص116.
- إعلام الموقعين، ج1، ص54. وتاريخ التشريع الإسلامي للخضري، ص116.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج1، ص34.