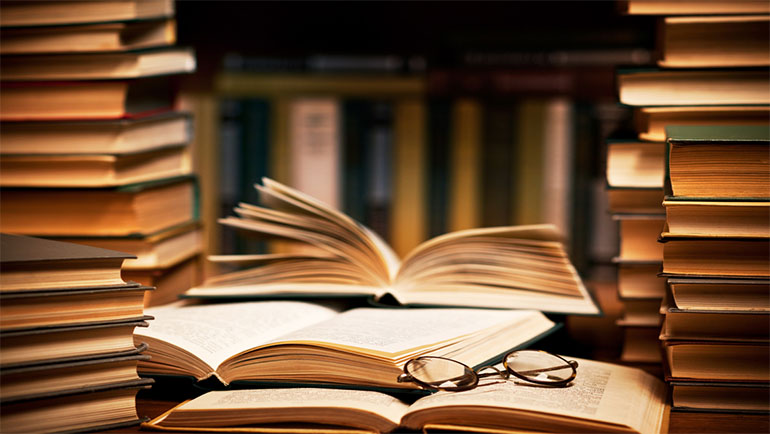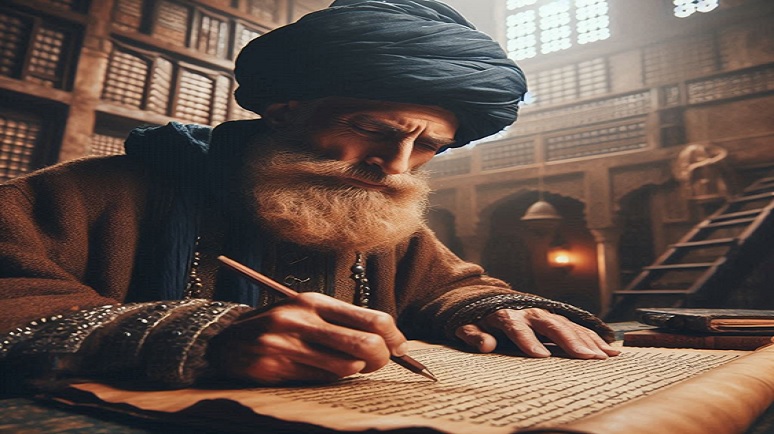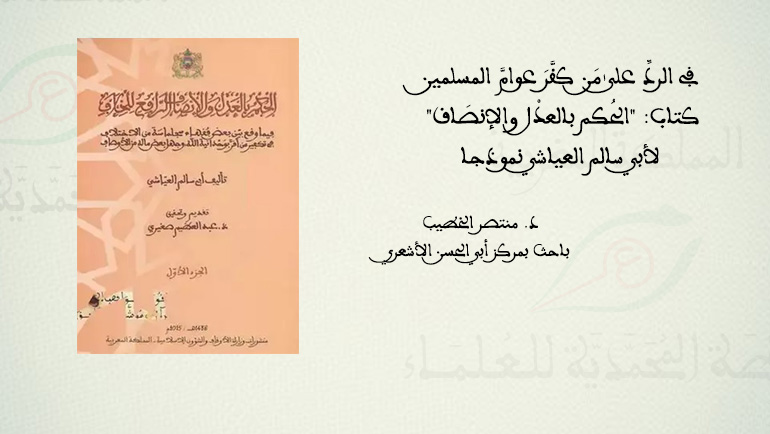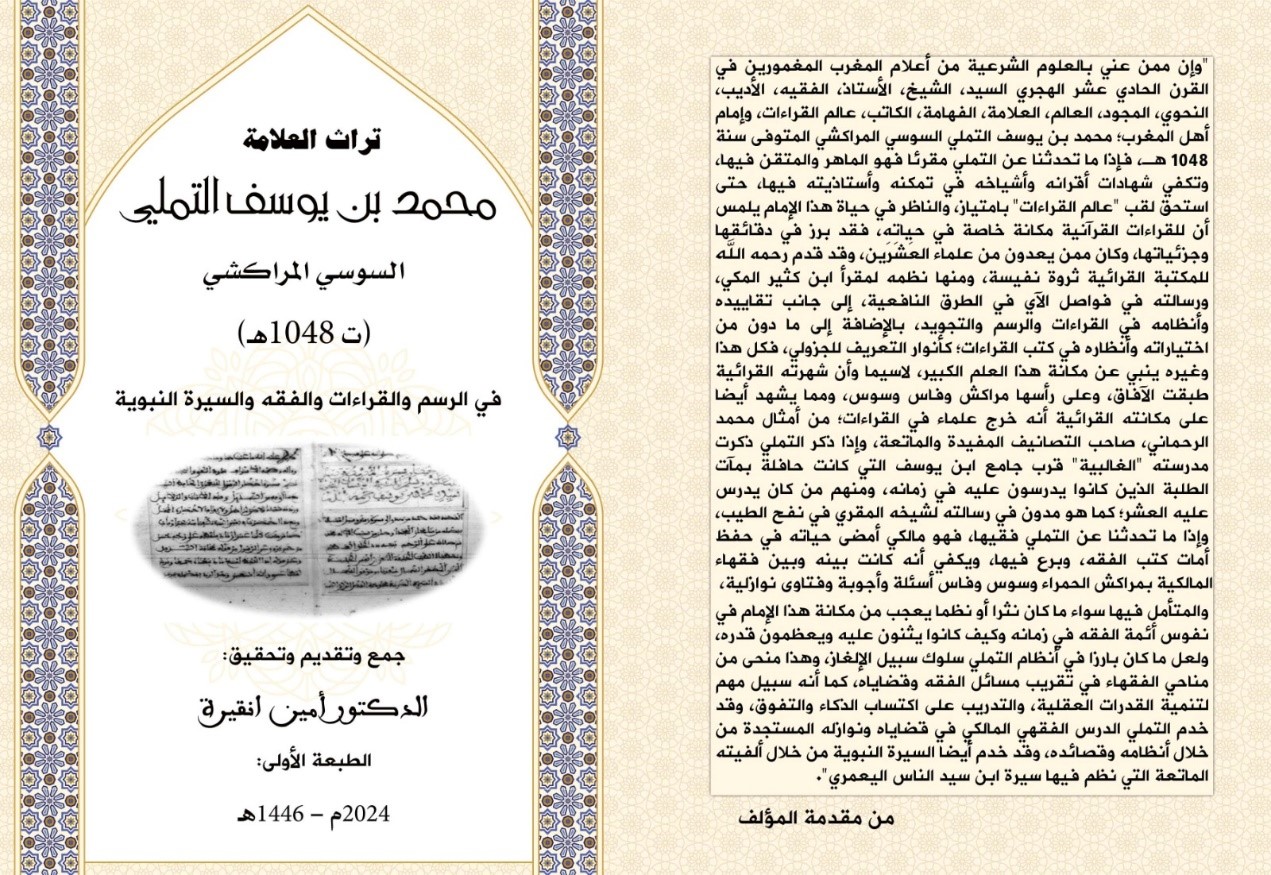تقوم التجربة الصوفية على رؤية خاصة للوجود، باعتباره تجليات للأسماء والصفات الإلهية، لذلك يحمل «العالم» في تصورهم دلالة رمزية، تشير إلى معاني روحية مقترنة بهذا الوجود الكثيف، فينشأ عن ذلك علاقة وجودية، ورابطة قيمية بين الظاهر والباطن، وهو ما يعبر عنه الصوفية بـ «رؤية الله في كل شيء». بحيث إن الرؤية الصوفية للوجود تحمل أبعاد تعبدية، ينتقل من خلالها المتقرب من العلم بالموجودات إلى العلم بموجِدها، ثم من العلم بالموجِد إلى العلم بالموجودات، فيصير نظره متراوحا بينهما، وهذا الوصل بين الظواهر والغيبيات ليس وصلا ذهنيا، كأن يربط المتقرب بين أمرين مستقلين فيما بينهما، ومصطنعا علاقات منطقية تشد أحدهما بالآخر، وإنما هذا الوصل هو علاقة وجدانية يرتبط الصوفي بفعل تحققه بوصف العبودية، بالتبعية الأصلية، التي تمده بوصف العينية[1]. وهذا التعالق بين الإنسان والوجود قائم على مبدإ «الكلمة الإلهية»، بحيث إنهما يشتركان في كونهما مظاهر للتجليات، ويتشاكلان بأنهما يحملان أوصافا ظاهرة وباطنة، فيجتمعان في الدلالة على المتعالي المطلق، بالإضافة إلى أن ربط الأسباب بالمسبِّب، والظواهر بالمُظهِر، تمنح مجالات إدراكية واسعة لا يقف عندها من اقتصر على الأسباب الظاهرة، واتخذ منهج الفصل بين الشيئية والغيبية. فاعتماد الوصل بين الظاهرة والقيمة عن طريق العقل المتصل بإمكان ذلك أن يحدث تعالقا بين الله والإنسان والوجود، على اعتبار أن التجربة الروحية تلبس الصوفي غطاء روحيا، وتقوي فيه الأبعاد الملكوتية، فلا يرى شيئا إلا ويشير لديه إلى معنى غيبيٍّ، أي علاقة وجودية بين الموجِد والموجَد، وهو الأمر الذي طبع الثقافة الإسلامية، بحيث نجد أثر هذه الرؤية من ناحية الاشتغال بالعلوم بصفة عامة. فقد غلب على علماء الإسلام إقامة هذا الربط بين المعرفة العلمية والمعرفة الغيبية، وهو ما فتح إمكانات واسعة كانت سببا في تطور العلوم وتوالدها، فانفجار هذه الدوائر العلمية في الثقافة الإسلامية كان مرتبطا بالممارسة التعبدية.
إن العمل الصوفي يعتبر الممارسة التعبدية من أقوى الوسائل في اكتساب المعرفة الإلهية، وهي من مرتكزات التجربة الروحية، والسلوك التربوي، وهو ما عرف عنهم «بالتقرب بالنوافل»، باعتبار أن هذا الأساس التعبدي يفتح للسالك من الأفضال الربانية، والتجليات الملكوتية، ما لم يمكن أن يخطر على من اكتفى بالنظر المجرد، أو عند من وقف عند حدود الفرائض فقط، بحيث إن الوصول إلى المعرفة الذوقية، والحصول على المحبة الإلهية إنما يتم على أساس الاستغراق في مسالك التعبد بالنوافل زيادة على الفرائض، إذ بفضل هذا الاستمرار تقوى رابطة العبد بربه، فيحظى عنده بمنصب «المحبوبية»، التي ينشأ عنها أن تتولى الإرادة الإلهية جميع أقواله وأفعاله وجميع حركاته وسكناته، فتخلع عليه أوصاف التأييد، فلا يرى العبد شيئا إلا ويرى الحق فيه، ولا يعرف شيئا إلا ويعرفه به، فتكون معرفة محفوظة من الاسترقاق، ومأمونة من التبعيات، لأنها قائمة على نسبة الأشياء إلى موجِدها، رابطة بين الفروع وأصولها. لذلك فإن من ثمرات هذا العمل التعبدي على الأفعال العقلية، والتصرفات السلوكية هو السداد والتأييد، من أن تنقلب على الإنسان –التصرفات والأفعال- بالضرر، وتعود عليه بالإفساد، لأنها مؤسسة على ضوابط أخلاقية، وعلى معاني روحية، بحيث إن الأفعال التي يكون شأنها هو هذا لا شك وأنها تكون أفعالا أخلاقية.
عند ما تتشكل الشخصية الإنسانية وفق قواعد التجربة الصوفية، فإن المقاربة المعهودة في «المعرفة» ينقلب حالها، فبعد ما صار المتقرب يتجه من الكون إلى المُكون، من أجل ترسيخ النسبة الوجودية للموجِد والخالق، يصير عند الدخول في هذه التجربة ينطلق من المُكون إلى الكون. وهذا التقسيم الذي تناقله رجال التصوف من سلفهم إلى خلفهم، ينطلق من مسلمة لديهم، وهي قائمة على اعتبار الناس عامة وخاصة، وهؤلاء الخاصة هم الذين خاضوا معاناة التجربة الصوفية، بما هي تخلية وتحلية، وذكر وفكر، ومجاهدة وممارسة، فعندهم أن الله تعالى أثبت «للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق، وأثبت للخاصة نفسه فأثبتوا به المخلوق. فشتان... بين من يستدل به على ظهور أثره، وبين من يستدل بظهور أثره على وجوده»[2]. فإن البادي من المكوَّنات معروف بنفسه لهجوم العقل عليه، والحق أعز أن تهجم العقول عليه، وأنه عرفنا نفسه أنه ربنا، فقال ﴿ألست بربكم ﴾، ولم يقل: من أنا، فتهجم العقول عليه حين بدا معرفا، فلذلك انفرد عن العقول الرمزية الصوفية عامل ، وتنزه عن التحصل غير الإثبات[3]، فقد أجمعوا على أن الدليل هو الله وحده، وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل، لأنه محدَث والمحدَث لا يدل إلا على محدث مثله[4]، فالنظر العقلي يقوم على الاستدلال، بينما العمل الصوفي يرمي إلى الذوق والعرفان.
-------------------------
- طه عبد الرحمان: العمل الديني وتجديد العقل، (ص 130).
- ابن عجيبة: إيقاظ الهمم، (ص 78).
- الكلابادي: التعرف لمذهب التصوف، (ص 65).
- المصدر نفسه، (ص 63).