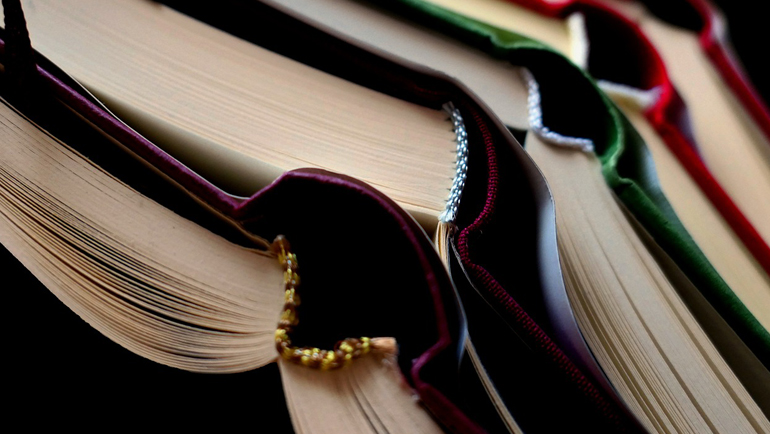إسهامُ نِسَاء طنجة في نهضة التّعليم بالمغرب 1930م – 1956م
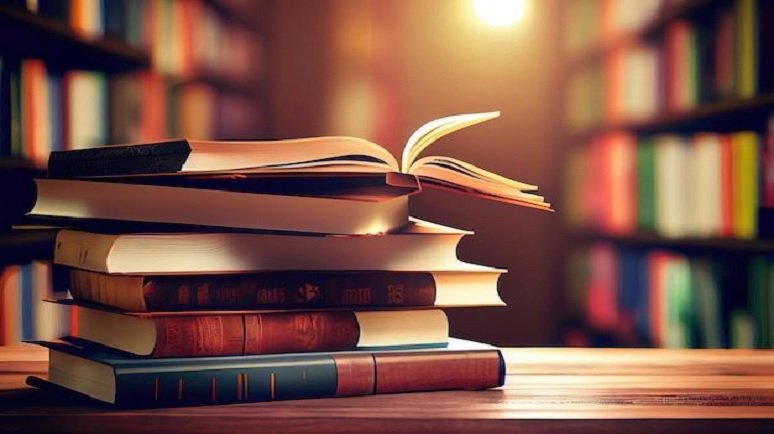
▪ بقلم : د. رشيد العفاقي
قد لا نُخطئ الحقيقة إذا قُلنا إنّ الحديث عن المرأة المغربية المتعلِّمَة، التعليمَ العصريّ، لا يكون مُتاحا للدّارس إلّا مع بداية القرن العشرين الميلادي، أي بعد ما صار للأوربيين بالمغرب مُستقرٌ ومُقامٌ. وكان هؤلاء قبل الحماية قد أنشؤوا - في إطار سياسة التّدَخُّل السِّلْمِيّ- العديد من المؤسّسات التعليمية لتربية وتثقيف أولادهم. وكان من تَبِعات هذا أنْ جلبوا إلى بلادنا مناهج جديدة في التعليم لم يكن للمغاربة بها عهد، وفضلا عن المدرسة تَعرّفنا بواسطتهم على وسائل جديدة لِبَثِّ الثقافة والمعلومة كالجريدة والمطبعة والمسرح.
وَ مَالَبِثَ المسلمون أن أدخلوا أولادهم المدارسَ الأجنبية، وبالتالي بدأ تكَوّن جيل جديد من طلبة العلم سيتخرّج حاملا ثقافة تختلف عن المعرفة التي كان يتلقّاها الطالب المغربي في المساجد أو المعاهد الدينية العتيقة. وكانت مدينة طنجة المُخْتبرَ الأوّل لهذه التجربة بالمغرب، فهي التي صيَّرها الأجانب «المدينة الأكثر أُورُبَاوِية بالمغرب»[1]، وذلك لأنّ جميع قنصليات وسفارات الدول الأوربية والأمريكية كانت مَقَرَّاتُها بطنجة، ثُمَّ إن الجالية الأوربية كانت قد استقرت بها منذ زمن بعيد.
وأوّل ما يُمكن تسجيله من رُدُود فعل المغاربة على هذه التّجربة الجديدة التي أتت محمولةً في حقائب الاستعمار قبل ترسّمه، وعلى مبادرة بعض المسلمين بالانفتاح على مدارس الأجانب والدّفع بأولادهم إلى «النّصَارى» ليُقْرِؤُوهُم، هو معارضة بعض الفقهاء لذلك، ويُمَثِّل هذا الاتجاه في طنجة الحاج محمد بن الصديق (ت.1354هـ) الذي قام بتحذير الناس من خطر الاستيلاب الفكري الذي بدأت بعض دوائر الاستعمار تمارسه على الأهالي من خلال مدارسها ومعاهدها، يقول وَلَدُهُ الحافظ أحمد بن الصديق في الكتاب الذي أفرده للتّعريف بوالده :
«إنّ الفرنسيين قبل احتلالهم المغرب كانوا أرسلوا بعض الشياطين من أذنابهم إلى طنجة، ففتحوا بِها مدرسة لتعليم الأولاد اللغة الفرنسية توصّلا بذلك إلى ما بعده. فسارع بعض المغرورين الراغبين في الدنيا إلى إدخال أولادهم فيها، فَلَمَّا عَلِمَ الشيخ بذلك خطب خطبة بليغة حَذَّرَ فيها المسلمين من إدخال أولادهم مدارس النصارى، وبَيَّنَ ضرر ذلك في الدِّين، وما يترتّب عليه من المفاسد في الاعتقاد والأخلاق ومصالح البلاد وبالغ في ذلك، وأطنب وأطال، فأثَّرت خُطبته في الناس. وسارع جُلّ من أدخل أولادهم المدرسة إلى إخراجهم منها، فاغتاظ لذلك سفير فرنسا واحتدّ غضبا، لأنّها أَوّل بُذرة بَذَرُوها في المغرب لِحَصْدِ الشَّرِّ والفساد منه، فأفسدها عليهم الشّيخ بِخُطْبَتِهِ»[2].
وعلى الرّغم من هذه الصَّيْحَة التي أطلقها فقيهٌ طنجيٌ مرموق، فإنّ مدارس الأجانب بطنجة ظلّت تستقبل مع بداية كُلّ سنة عناصر جديدة من أبناء المسلمين. لقد كانت موازين القوى في ذلك الوقت قد مالت لصالح الأجانب في غير ما مجال، من ذلك المجال الثقافي والتربوي، إذ بواسطة إمكانياتها المغرية، وجَدِيدِهَا الْمُبْهِر، استطاعت تلك المدارس أن تستقطب عددا كبيرا من أبناء الأهالي.
على أنّه إذا كان البعض قد اعتبر أنَّ إلحاق أولاد المسلمين بمدارس التعليم العصري بطنجة، الفرنسي والإسباني خاصّة، خارجاً عن جادة الصواب، فإنّ غيرهم - مِمّن نهلوا من معين مدارس البعثات الأجنبية- كان لهم رأي مغاير بحيث كانوا يرون لذلك التّوجّه بعض الإيجابيات، فهذا الأستاذ محمد أقلعي (1904م-1986م) أحد الذين درسوا وتعلّموا في المدرسة الفرنسية بطنجة يقول :
«بواسطة المدرسة الأجنبية انتبهنا إلى مَدَى تأخر بلادنا بالنِّسْبَة للعصر، وعن طريقها شعرنا بالخطر المحدق بنا والمُتمثل في الأطماع الاستعمارية، ومن جُملة خريجيها عدد من الأفراد ساهموا في العمل على حُرِّيَّةِ بلادنا»[3].
وبصرف النّظر عن هذا الرأي، الذي لم يكن لإيجابياته وُجُود إبّان ظهور مدارس الأجانب في بلادنا، فإن فكرة إنشاء مدارس أهلية بطنجة، يتولّى إدارتها مسلمون، ظلّت تجيش في نفوس عدد من الطنجيين، وكانت الدّعوة إليها من مطالب النُّخْبة الواعية من أبناء طنجة في ذلك الوقت لاسيما بعد أن طفت على السّطح مُعارضة بعض العلماء لمدارس الأجانب، وبَعْدَ أن غَزَتْ مَحلات اللَّهو ونوادي السَّمر العابث أحياء المدينة القديمة، فقد جاء التحذير من عواقب الارتِمَاء في أحضانها من على صفحات بعض الجرائد المحلية، وكان الذي يُحذِّر من ذلك يدعو في الآن نفسه إلى ضرورة إيجاد البديل النافع كالمدارس، كتب رئيس تحرير جريدة «الصباح» الصادرة بطنجة عام 1907م مقالا جاء فيه:
«تجدَّدت كثيرا القهاوي الأجنبية في المدينة على طراز أُرُوبّاوي جميل، فمتى نرى أبواب المدارس تُفتح للجُهّال لتعوِّض ما أفسدت القهاوي من الأخلاق»[4].
ولَمْ يَدُم انْتظار الناس طويلا حتى وجدوا أنفسهم يتوفّرون على مُنشأة تعليمية تُلقِّن أبناءهم العلم النافع وتُربِّيهم على الأخلاق الفاضلة، فتأسّست «مدرسة الترقي الإسلامية» بمبادرة من الجمعية الخيرية عام 1913م، وقامت بأداء الرسالة حتى منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين، ثُمّ ظهرت «المدرسة الإسلامية» بإشراف الشّيخ العلّامة عبد اللّه كنون عام 1936م، وبعد وقت قصير من هذا التاريخ تعزّز المشهد التعليمي بالمدينة بمؤسسة «المعهد الديني» عام 1943م.
على أنّ هذه المعاهد كانت، حتى حدود هذا التاريخ الأخير (1943م)، مقتصرة على الذُّكُور، ولم يكن يُسْمَح للفتاة بأن تُزاحم شقيقها الولد في مقاعد الدّرس، ولكن من المؤكّد أنه كانت لتلك النهضة التي عرفها التعليم الأهلي بطنجة، ما بين عامي 1913م - 1943م، تأثير إيجابي على تعليم المرأة بالمدينة، فما كاد العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي يبلغ آخره حتى بدأت المرأة الطنجاوية ترفع صوتها بين الرجال وتُنادي ببناء مدارس خاصة للبنات. وفي هذا الوقت كانت الدّعوة إلى السُّفُور على أشدّها في النوادي النِّسْوية بالمشرق، إلّا أنّ المرأة المغربية ظلّت بمنأى عن هذا «الوباء»، وسوف نراها تنتصر لِقِيَّمِهَا الدينية كما يتبيّن من قصيدة[5] لشاعرة لم تكشف عن اسمها، نشرتها جريدة «إظهار الحق» الصّادرة بمدينة طنجة يوم 14 يناير عام 1930م، تدعو فيها هذه الشاعرة إلى بناء المؤسّسات التعليمية للفتاة، وفي ذات الوقت كانت قصيدتها صَوْتًا مُعارضا للسُّفُور.
تَحْتَ عنوان : «ابْنُوا المدارس» نقرأ في الجريدة المذكورة قصيدة منسوبة «للسيدة الشاعرة صاحبة الإمضاء»[6]، وفيما يلي نصّها مع التّقديم الذي يسبقها :
«وبما أنّنا كتبنا في هذا الموضوع غير ما مَرّة، في موضوع تبرّج المرأة وسفورها، وكان [بدواع] هو بقاؤها بذلك الحجاب الرّهيب الذي أسبله عليها الشّرع الحكيم حتى لا تتلاعب بها يد الإباحية الممقوتة، أحببنا أن ننقل لقرائنا الكرام هذه الأبيات لِمَا فيها من الأدب والإنسانية والشعور الديني ولاسيما من امرأة هذا العصر الجديد، وإليكها :
| 1- قالوا التمدن بالسفور فقلت ما | ضرّ التمدن غادة بحجاب | |
| 2- إنّ الحجاب إذا تهذّب أمره | كان الكمال وزينة الآداب | |
| 3- يكسو الفتاة جلالة ومهابة | ويصونها من وصمة المرتاب | |
| 4- أترى يريد السفور ذوي الحِجَى | فليقتدوا بالعلم لا بالجلباب | |
| 5- ولا تسلكوا نهج السفور وأمسكوا | بالعلم فهو موفر الأسباب | |
| 6- ابنو المدارس علموا أبناءكم | طلب العُلى من شيبهم وشباب | |
| 7- ليس الطريق إلى العُلى بتهتك | لا تبلغ العليا بهتك حجاب | |
| 8- باب التفرنج أوصدوه فإنه | يجني على الجنسين غر عذاب»[7] |
إنّ ظهور أصوات نسوية على صفحات جرائد طنجة تنادي بضرورة تعليم الفتاة من غير أن تفرط في لباسها الشرعي يدل على أنّ المرأة بمدينة طنجة كانت تقوم بتحركات نشيطة في المجال التعليمي. فلا شكّ أنه بعد عام 1930م فَتَحَ بعض الأهالي أبواب بيوتهم لاستقبال فتيات المدينة الرّاغبات في التّعلّم، وإنْ كان الأمر قد ظلّ مرتبطا - في تلك المرحلة الأولية- بالتعليم في مستواه البسيط: أيْ تحفيظ سُوَر من القرآن، وتعليم الكتابة والقراءة، إلّا أنّ ذلك يظلّ علامة على أنّ التوعية وصلت إلى أذهان فتيات طنجة، وفي هذا الظرف ظهر بالمدينة عددٌ من الفقيهات حملن على عاتقهن مسؤولية تعليم المرأة، كل ذلك في بيوتهن وبدون مقابل مادي. وقد ألقينا السؤال على مَنْ هُم أكثر مِنَّا عِلْمًا في هذا المجال، فذكروا لنا عددا من أسماء النساء[8] كان لهنّ سهمٌ في نهضة تعليم الفتاة بمدينة طنجة.
وبقي أن نُشير في ختام هذا التقديم إلى أنّ القراءة في البيت بالنسبة للفتاة بطنجة كانت مرحلةً أوّلية، لأنّ الظروف لم تكن قد نضجت بعد لكي تُنْشَا للبنات مدارس خاصة بهن، ولكن الفتيات اللّواتي تَعَلَّمن في البيوت هُنَّ اللائي سيحملن مشعل تطوير العمل التعليمي للفتاة الطنجاوية والرُّقي به إلى المستوى العصري، ولعلّ أبرز الأسماء في هذه المرحلة الأولى هي الفقيهة خدوج الزّجْلي. وفي المرحلة الثانية برزت أسماء: الأستاذة ارْحِيمُو المدني، والأديبة شمس الضُّحَى بُوزِيد، والأستاذة فضيلة الزّجلي، والأستاذة عائشة كنون. وبما أنّ كُتب التراجم[9] الحديثة تخلو من تعريفٍ بِهِنّ، فقد رأيتُ من المُفيد أن أُتَرْجِم لهنّ في هذه الدِّرَاسَة.
1-● الفقيهة خدُّوج بِنْت عبد الوَاحِد الزَّجْلِيّ
الفقيهة السيدة خدُّوج بنت عبد الواحد الزّجْليّ، حرم قائد الطبجية إدريس الشاوي، المعروفة في أوساط النساء بـ(خدُّوج دْ القايد ادريس). هذه السيدة قد تكون هي أوّل امرأة فتحت بيتها في طنجة لتعليم فتيات المدينة الكتابةَ والقرآن الكريم، ويبدو أنها ظلّت تعمل وتُدَرِّس في البيت إلى بداية الأربعينيات من القرن العشرين قبل أن تُسْند إليها مُهِمّة التعليم بمدرسة القصبة للبنات[10].
2-● رْحِـيمُـو الْمَـدَنِـي
أوّل امـرأة مغربيـة تـكـتـبُ فـي الصُّحُـف
هي رحمة بنت العربي بن القايد ميمون المدني، مِنْ عائلة ريفية استوطنت مدينة سبتة في أواخر القرن 19م، عمل جَدُّهَا ميمون المدني في الجيش الإسباني، وحصل على الجنسية الإسبانية، وبعدما أحدث الإسبان طابور البوليس بطنجة فيما يلي عام 1912م، انتقل القايد ميمون بأولاده وأهله إلى طنجة واستوطنها في دار بحومة بني يدر، وفيها وُلِدت لابنه العربي بنت يوم 20 غشت 1921م، سمّاها: رحمة. وعلى عادة المغاربة في تصغير اسم البنت زمن الصِّبَا فقد كان يُنادى عليها باسم: ارحيمو، وهكذا كُتب اسمها في وثائقها الرسمية، واستمر الناس يدعونها بذلك الاسم إلى أن رحلت عن هذه الدنيا.
كان والدها العربي المدني موظفا بمصلحة البريد الإسباني بطنجة التي كان مقرها بالسوق الداخلي، أدخل ابنته ارحيمو مدارس الإسبان بمدينة طنجة، وإلى جانب الإسبانية تعلّمت العربية، وقد ذكرت لي الأديبة شمس الضحى - رحمة اللّه عليها- أنّ المُدَرِّسة ارحيمو المدني «قرأت كتاب اللّه العزيز على الفقيه محمد الخُمسي الطّنجي، ودَرَسَت النّحو على الفقيه سيدي اسْعيد العمراني». ولم أَعرف مِنْ أساتذتها غيرهما.
«وبتاريخ 25 نونبر 1935م عُيِّنتْ من لدن وزارة المعارف العمومية بالمنطقة الخليفية بتطوان مُدَرِّسَة للغة العربية بالمدرسة الإسلامية للبنات بمدينة شفشاون»[11].
وفي شفشاون يلتقي بها أمين الريحاني عندما زار منطقة شمال المغرب عام 1939م، بعد عودته من المهجر الأمريكي، ويُسَجِّل عنها شهادة - أدرجها في معرض كلامه على محاسن شفشاون-، قال فيها: «أمّا حسنة حسناتها، بعد النّظافة والأنوال ومعمل الزّرابي والمدارس المدنية والدينية، حسنة هذه الحسنات مَدرسة البنات، ومُديرتها السيدة رحمة المدني حرم عبد السلام الأندلسي. والسيدة رحمة الريفية المولد[12]، المُتَعَلِّمَة بطنجة، المُحْسِنَة اللغتين الإنكليزية والفرنسية هي أوّل امرأة تُعَلِّم وتكتب في هذه المنطقة من المغرب الأقصى. وقد تصير وَلِيّة - طال عمرها- فتُدفن إلى جنب مولى شفشاون علي بن راشد»[13].
وتاريخيا تأتي الأستاذة ارحيمو المدني في طليعة النساء اللواتي أُسندت إليهن مُهِمّة التدريس بالمدارس المغربية العصرية[14]. وهذا ما عَبَّر عنه أمين الرّيحاني بقوله: «أوّل مُعَلِّمَة وكاتبة في هذه المنطقة هي السيدة رحمة المدني»[15].
وبعد مُدّة قضتها ارحيمو المدني بشفشاون، رجعت إلى مسقط رأسها طنجة وبدأت تُقَدِّم دروسا في اللغة الإسبانية بمدرسة الزيتونة للبنات المسلمات، والتي كان مقرها بعقبة الوزانية من طنجة.
وقد احتفظت السيدة رحيمو المدني بمنصبها الإداري بمدرسة الزيتونة إلى 11 يوليوز 1558م، وبعد هذا التاريخ غادرت مدينة طنجة وانتقلت إلى تطوان لتتولّى هناك إدارة مدرسة. وأثناء ذلك انتسبت إلى جامعة غرناطة ونالت إجازة في الآداب عام 1964م، ثم عُيِّنت مديرة لمدرسة المصلى بتطوان وبقيت في هذا المنصب إلى أن أُحيلت على التقاعد عام 1981م[16]. ويذكر الأستاذ عبد الحق المريني أنّ رحيمو المدني كتبت عدة «مقالات تدور حول تحرير المرأة، .. وكانت حياتها حافلة بالنضال في مجالات التربية الوطنية. أسّست عِدّة جمعيات نسوية، اجتماعية ووطنية، في كل من تطوان وطنجة، .. وشاركت في انتخابات المجالس الجماعية لسنة 1976م»[17]. وكانت وفاة الأستاذة رحيمو المدني بمدينة تطوان يوم الأحد 6 يناير 1984م[18].
ونرجع الآن إلى الكلام على إسهامها في ميدان تعليم المرأة، فقد نادت الأستاذة رحيمو المدني بَاكِرًا عَبْرَ الصحافة إلى تعليم المرأة، وقد كان شائعا أنّ الأستاذة مالكة الفاسي هي أوّل امرأة مغربية تكتب في الصحف، إلّا أنّه بعد البحث والتنقيب ظهر أنّ ارحيمو المدني قد تكون تقدّمتها في ذلك، يقول زين العابدين الكتاني :
«فالذي يترجّح عندي، وكَمَا أكّد ذلك أيضا الشيخ التهامي الوزاني من تطوان، أنّ أوّل سَيِّدَة مغربية نشرت في صحيفة هي السيدة رحيمو المدني من تطوان، وكان ذلك بجريدة «الريف» التطوانية في أكتوبر 1936م/1355هـ. وكان ما نشرته نِدَاءٌ بعنوان: «فتاة مغربية تستنهض المغاربة»، والكاتبة تعتقد هذا الرأي وتُؤَكِّدُه في تقييدٍ لها»[19].
ومقال الأستاذة ارحيمو المدني المُشَار إليه في كلام الأستاذ زين العابدين الكتاني - رحمه اللّه- نشرته لها جريدة «الريف» في عددها 15 الصادر بمدينة تطوان عام 1355هـ/1936م، وقد قدّمت له المجلّة بما يلي:
«وصلتنا أخيرا كلمة لإحدى أوانس المغرب الناهضات، ألقتها بمناسبة حفل أقيم بمدينة شفشاون، وهي تنطوي على روح فياضة، وفكر ناضج، وحَضٍّ على المعرفة، ودفع بالأمة إلى الأمام والتقدم».
وكانت كلمة الأستاذة ارحيموا المدني تتمحور حول الدَّعوة إلى التعليم عامّة، وتعليم الفتاة بصفة خاصّة، هذا طرف مِنْ أوّل مقالتها:
«أيها السادة، أَمَا آن لمغربنا أن ينهض؟ أما كفانا هذا النوم العميق؟ أما علمتم أن الفُرَص تضيع؟ فها هي الطرق صالحة للعمل، وها هي تنادينا بِحَيَّ على النّجَاح. فَلِمَ لا نتكاثف ونتآزر على إحياء معالمنا، ونرفع رأسنا لتجديد مجدنا؟ وَا أسفاه على تَأَخُّرِنَا، بل وَا ويحاه على جمودنا.
مُواطنينا الأعزاء، إنّ للتقدم طرقا مشروعة لا يدرك من غيرها، وللحرية مقدمة واحدة لا تنال من سواها، ألا وهي العلم، فتعلموا ما ينفعكم وعلمونا، فإنكم إن تعلّمتم أرحتم حُكّامكم، وعرفتم كيف تنقادون وتقودون، بل إنْ تعلّمتم، أدركتم لذّة بلادكم إذ لا حياة إلّا بالعلم.
أيها السادة، علِّموا أولادكم فإنّ عهدة وطنكم على رقابكم مُلقاة. علموا أبناءكم كي يصبحوا سادة، قادة، ورجال المستقبل. عَلِّمُوا بناتكم ليصرن صالحات لتدبير منازلهن، عارفات بحقوق تربية النشء المقبل، مُلِمّات بمكارم الأخلاق، فيتسابقن إليها معرضات عن الخنا، ولا يحقّ لنا أن نستمر جامدين وجامدات، عاطلين وعاطلات»[20].
وقد تَقَدَّمَت السيدة ارحيمو المدني في هذا المسار الذي اختارته لنفسها، وهو التدريس، والكتابة في الصحف بِمَا يستنهض هِمّة الفتاة المغربية، وقد قطعت في ذلك شوطا بعيدا. وقفتُ لها في مجلّة «الأنيس» التطوانية على النِّداء الذي وجّهته للفتاة المغربية عام 1946م/1365هـ، وكانت وقتذاك مُدَرِّسَةً بمدرسة البنات بطنجة، قدّمت له المجلّة بما يلي :
«بكامل السرور والابتهاج ننشر هذه المقالة التي دبّجتها يراع إحدى فتياتنا المثقفات، وهي أوّل محاولة من نوعها تقوم بها فتاة مغربية على صفحات مجلّة ثقافية لم تنشأ إلا لخدمة العلم والثقافة والفنّ. وأملنا واسع في أن تكون هذه المقالة مثالا تحتذيه فتياتنا المثقفات فَيُبْرِزْن إلى الوجود أفكارهن وبحوثهن».
وقد وَرَدَ مقالها تحت عنوان: «نداء إلى الفتاة المغربية»، وفيما يَلِي نصّه :
«أُنَادِي - مُنَبِّهَةً- كُلّ فتاة مغربية ذات شعور حيّ وإيمان قوي أنْ تستفيق من سُباتها العميق وتنهض متجهة نحو الصراط المستقيم باحثة عن كل ما يُزيِّن أخلاقها وصفاتها، نابذة وراءها الأوهام والخرافات التي قعدت بالفتاة المغربية - طيلة حياتها- جامدة، وبحالة نفسها جاهلة.
أيتها الفتاة: أوصيك بالاجتهاد في تحصيل طلب العلم النافع والاغتراف من كوثره الفيّاض كي ترفعي شأن وطنك العزيز وتشاركي أختك الشرقية في نهضتها الثقافية، فقد سوّى الإسلام المرأة بالرجل في طلب العلم وأوجبه على كل مسلم ومسلمة، كما أوجب على أمهات المؤمنين أن يعلّمن الناس أبناءهم وبناتهم ذكورهم وإناثهم ﴿واذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّه وَالحِكْمَة﴾[21].
أيّتها الصديقات: إنّ الأمة تنتظر منكنّ خيرا كثيرا، فلا تخيبن انتظارها، وتأمل فيكن الوصول إلى غاية المرغوب، فَحَقِّقن آمالها، وعليكن بالإخلاص والعمل، والإقبال على الخير والبُعد عن الشر، ولا تحمن حول الشبهات، فمن حام حول الشبهات يوشك أن يقع فيها. واللّه ولي توفيقكن إلى خدمة دينكن ووطنكن وتهذيب نفوسكن والرفعة بها على الشائن من الأمور. واللّه مولاكن، هو نِعْمَ المولى ونِعْمَ النّصير، وكل رجائي في استجابة ندائي.
الخميس 25 ربيع الثاني 1365
ارحيمو المدنية : أستاذة بالمدرسة المغربية للبنات بطنجة» [22].
3-● شَـمْــسُ الــضُّـحَـى بُـــــوزِيــد ...
زِيـنَـةُ طَـنْـجَـة وبَـهْـجَـتُـهَـا
وُلدت الأديبة شمس الضُّحى بنت الأمين بُوزيد بمدينة طنجة عام 1920م[23]، ونشأت وترعرعت في أحضان عائلة كان لأفرادها اعتناء بالعلم، فوالدها هو الفقيه الأمين بوزيد «من بيت معروف بِالعِلْمِ والتقوى، وطيب العنصر وإسقاط الدّعوى» كما قال الفقيه محمد بن عبد الصمد كنون[24]. وقد حرص هذا الوالد على تثقيف أبنائه وتربيتهم تربية علمية متينة.
لم يكن في زمن طفولة الأستاذة شمس الضحى بوزيد مدارس للبنات، وجميع بنات جيلها المتعلمات تلقَّين العلم في البيت أو في مدارس الأجانب. وبما أنّ الدراسة في معاهد الأجانب كانت - في نظر الأُسَرِ المحافظة- تحوم حولها العديد من الشبهات، فقد اختارت لها العائلة أن تدرس بالبيت، واختار لها والدها مُدَرِّسِين تتوفّر فيهم الكفاية العلمية والنّـزاهة الأخلاقية. قرأت القرآن كتاب اللّه العزيز على بعض فقهاء طنجة، وقد شملت القراءة أيضا - في فترة متقدمة من الدِّراسة- بعض كتب التفسير، كتفسير ابن كثير، وتفسير البحر المحيط لابن حيّان، ثُمّ توجّهت إلى قراءة كتب الحديث، فقرأتْ: «صحيح البخاري»، و«صحيح مُسْلِم»، و«مُوَطّأ» الإمام مالك، ودرست العربية ونالت منها حَظًّا طَيِّبًا. وقد ذكرت لي الأديبة شمس الضحى أنّ الفضل في تعميق معرفتها بالعربية يرجع إلى زوجها العالم تقي الدين الهلالي، وقالت لي أيضا أنها ما قبلت الاقتران به إلا لتستفيد منه في العربية وفي غيرها من العلوم.
في مرحلة الشباب انتقلت شمس الضحى إلى تطوان لتجتاز اختبارا في اللغة العربية وآدابها بالمعهد الحر، أشرف على اختبارها بعض الأساتذة المرموقين من علماء تطوان كالفقيه والمؤرخ محمد داود، والعلامة سيدي التهامي الوزاني، وغيرهما. ومُنِحَت بعد نجاحها شهادة اعتراف وكفاءة من المعهد المذكور خَوَّلت لها تدريس اللُّغَة العربية.
وكان من نتائج مثابرتها على القراءة أن اكتسبت ثقافة عربية طَيِّبَة، ومضت في ذلك السبيل تُجَوِّدُ أدواتها المعرفية، حتى إذا أهلَّ عِقد الأربعينيات من القرن العشرين أَضْحَت شمس الضحى مُرَبِّيَة لامعة في بَلْدتها، وسَيِّدَة محترمة في مُجتمعها، تنشط في مجالس العِلم وتكتب في الصحف. صارت شغوفة بالعلم والتّعليم، فقرّرت أن تستنهض هِمَمَ المرأة الطنجاوية وذلك بأن تُنير أمامها السبيل لتخلع عنها رداء الجهل والتّخلف وتسير صَوْب المستقبل المشرق، وكانت شمس الضحى ترى أنّ خير وسيلة إلى ذلك هي أن تعمل على توصيل العِلم إلى الفتاة. وفي عام 1945م أنشأت مدرسة في منزل عائلتها بحي وادي أحرضان من طنجة القديمة، وشرعت في تعليم الفتيات، بمجهود فردي ومن غير مقابل مادي. يقول الأستاذ عبد الصمد العشاب عن هذه المدرسة:
«مؤسّسة شمس الضحى بُوزيد: هذه المؤسسة أنشأتها سيدة من فُضليات نساء طنجة، كانت على جانب من الوعي والثقافة العامّة، وأرادت أن تساهم في نشر الوعي بين بنات جنسها ومحاربة الأمية بينهن، فتطوّعت بفتح منزلها في المدينة القديمة لاستقبال النساء والفتيات، وكانت فصول الدراسة عندها لا تقتصر على تعليم القراءة والكتابة فقط بل وكذلك التوعية السياسية وخدمة مشاريع الحركة الوطنية، ومارست عملها هذا في مستهل خمسينيات القرن الماضي لكنها لم تستمر طويلا لظروف سياسية عاقتها دون مواصلة العمل الهادف الهادئ»[25].
وقد تَخرَّج على يد هذه السيدة الفاضلة جِيلٌ من المتعلمات، وَصَلَ عددهن في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي - بحسب ما ذكرته لي- إلى 191 فتاة، كانت الأستاذة شمس الضحى تَسِمُ كل فوج من المتخرجات بِاسْم مُعَيَّن، فمن ذلك: فوج «الْمُرشِدات» و«طلائع النجاح» و«طلائع الأميرة»، وكانت تُميِّز كلَّ فوج بلباس خاص في المناسبات الوطنية. ويبدو أنّ نواة الفوج الأخير من المُتَخَرِّجَات(طلائع الأميرة) كُنَّ من اللّواتي هَيَّأتهن الأستاذة شمس الضحى بوزيد لاستقبال الأميرة للّا عائشة لما حَلَّت بطنجة مع والدها السلطان محمد الخامس عام 1947م، إذْ كانت من أبرز سيدات المجتمع المدني الطنجي اللّواتي حَضَّرْن لهذه الزيارة ونَظَّمن للأميرة استقبالا حافلا بدار المخزن بالقصبة، كَمَا تُلِيَتْ في اجتماع نسائي طنجي مُوَازٍ لهذا الاستقبال الرّسمي ترحيبا بالأميرة بعضُ الكلمات[26]. وبعض تلك الأفواج استمرّ يعمل بعد الاستقلال تحت إشراف الأديبة شمس الضحى في جمعية الشُّروق. ومن المعروف أنّه كانت للأستاذة شمس الضحى بُوزيد علاقة طيبة بالأميرة فاطمة الزهراء بنت السلطان عبد العزيز، طالما استقبلها مع أفواج من تلميذاتها بقصرها بالجبل الكبير مِنْ طنجة.
وقد ذاع اسم هذه الْمُرَبِيَّة في طنجة، فصارت المُنشآت التعليمية الجديدة المُحْدَثة في ذلك الوقت تطلبها لتقديم دروس في العربية. وقد مارست شمس الضحى بوزيد التعليم بعدد من المدارس الخاصّة بطنجة، وفي سنة 1952م التحقت بمدرسة البنات العربية بالقصبة، وهي مؤسّسة رسمية، وعُيِّنت بها أستاذة للغة العربية.
وقد تخرّج على يد هذه الأستاذة الفاضلة عدد من نساء طنجة المتعلمات والمثقفات، لازلن يذكرن مُربيتهن بالخير، ويلهجن بالثناء عليها في كل مناسبة، وحديثهن عنها كله اعتراف بفضلها وإقرار بنباهتها ونُبوغها. وكانت بينها وبين الأستاذة آمنة اللُّوه التطوانية مُراسلات بشأن التربية وتعليم الفتاة المغربية، وقد تعارفا في أبريل من عام 1947م يوم زار السلطان محمد الخامس مدينة طنجة، واستمرّت علاقة الصداقة بينهما بعد ذلك لسنوات طِوال، كتبتْ الأستاذة آمنة اللُّوه في ذكرياتها عن تلك الرحلة الملكية:
«شخصيا، أَعْتَزُّ بأنّني كوّنت صداقات رائعة أثرتني وأسعدتني كثيرا وجعلتني أتخذ من زيارة محمد الخامس لطنجة، تاريخي الحميمي .. مِنْهُ أنطلق في كثير من أعمالي ... واليوم أتذكّر أولئك الأحباب وأشتاق بلوعة إليهم، وأَحِنُّ إلى زمن ما له من عودة أبدا..! وفي مُقدِّمة أولئك الأحباب السيدة الفاضلة شمس الضحى بوزيد .. زينة طنجة وبهجتها. لقد ربطت هذه الزيارة بيننا وكان نتاجها صداقة متينة استمرّت عن طريق المراسلة المتبادلة بيننا إلى أن انتقلتُ والأستاذ الإلغي إلى الرباط .. ثم لم أعد أعرف شيئا - مع الأسف الشديد- من أخبارها، وكم سأكون سعيدة لَوْ أنّ الأيام تجود عليّ بلقائها إحياءً لصداقة لم ينطفئ وهجها رغم تعاقب السنين»[27].
- المقالات الأدَبِـيّـة لـشَمس الضُّحَى بُـــوزِيــد :
خلّفت الأديبة شمس الضحى بوزيد عددا من المقالات الأدبية، لا نعرف منها الآن إلّا بعض ما كانت تنشره لها الجرائد والمجلات المغربية الوطنية في عهد «الحماية». ويُذْكَر أنها كانت من أُولى كاتبات جريدة «العَلَم» منذ ولادتها عام 1947م، فَلَمَّا تَقَرّر لدى إدارة هذه الجريدة أهمية تخصيص زاوية للمرأة، «عهدت هذه الزاوية في البداية للسيدة شمس الضحى البوزيدي التي كانت تُوَقِّعُ مقالاتها بـ«أم البنين» تيمّنا بأم البنين التي أسّست جامعة القرويين بفاس». وفي عدد 16 مارس 1947م نشرت «العَلَم» مقالا لشمس الضحى بوزيد «تنتقد فيه أعمال الدّجل والشّعوذة التي تتعرّض لها نساء فاس قصد ابتزاز أموالهن»[28].
وقد وقفتُ لها في العدد 177 من جريدة العلم عام 1947م على مقال في امتداح العقل والعِلم، هذه فقرة من أَوَّلِه:
«لقد أجمع البشر على أنّ العقل أفضل المواهب التي أنعم اللّه بها عليهم، فهو الفارق الأهم بينهم وبين بقية المخلوقات، جعله لهم نبراسا يهتدون به في معترك الحياة، ولجاما يكبحون به جموح الأهواء والشهوات، ودليلا يرشدهم إلى معرفة كنه الكائنات.
وهذا كتاب اللّه المُنَزّل على رسوله الأمين يحضنا على التأمل في ملكوت اللّه وما أودعه من روائع وعجائب نصّبها آيات بينات على وجوده وقدرته التي لا تغالَب، وسخّر لنا بعضها وجعل استفادتنا من البعض الآخر موقوفا على سعينا واجتهادنا بما يَسَّر لنا من أسباب العلم والعمل. وما نهض السّلف الصالح إلّا على أساس العلم وبسط ظِله وتعميم منافعه فنشروا ألوية الهناء وأقاموا قسطاس العدل وبثوا روح الفضيلة بين البشر وكانوا بالعلم خير أُمّة أخرجت للناس.
وهذه أُمَمُ الغرب دالت لها الدنيا، وسادت وسيطرت، وأتت بالعجب العجاب عن طريق العرفان. ولا تُقدّر قيمة الشعوب إلا بمقدار ما بلغت من رُقي وعظمة وازدهار بفضل اتساع رقعة الثقافة في بلادها وبفضل ما جنته من تحقيقات علمائها، وما هذه إلا حقائق مقررة مجمع عليها لا يكابر فيها عاقل ولا ينكرها ذو وعي سليم»[29].
ثم تطرّقت الأستاذة شمس الضحى بوزيد إلى دور المرأة المُتَعَلِّمَة في المجتمع، فقالت:
«المرأة رُكْن المجتمع العتيد، وكيف يضمن البقاء لبنيان مضعضع الأركان ؟
إِنّنا فتيات هذا الوطن المغربي الكريم - كَكُلِّ الفتيات المتطلعات إلى القيام بمهامهن السامية أحسن قيام- في حاجة إلى التهذيب المفيد الذي يُزَكِّي في النفس روح الفضيلة من حيث يجعلها تدرك بالاقتناع الفرق بين الصالح والطالح والخير والشر وأبواب السعادة الحقيقية ومظاهر الغرور الزائفة.
ونحن في حاجة إلى العلم الذي يؤهلنا لتربية الأبناء تربية صالحة تلقنهم الخلق الكريم وتجنبهم آفات الرذيلة.
ونحن في حاجة إلى العِلْم الذي يُمَكِّنُنَا من تدبير شؤون المنـزل بحذق و دراية وتيسير أسباب السعادة فيه»[30].
وذكرت الأستاذة شمس الضحى بوزيد أنّ الحركة التعليمية في زمنها كانت في سُمُوٍّ وارتقاء، وقالت :
«تزداد الحركة التعليمية كل يوم نُمُوًّا وازدهارا حتى تثمر بحول اللّه أطيب الثمار. ولقد طفقت الأمة تُلبي دعوة عاهلها المعظم عنوان فخرها ومحطّ آمالها، فأقبلت على حركة التعليم تُنشئ المدارس وتُؤسس المعاهد وتُجدد ما رث من دور العرفان، وأقبل الشباب على مناهل العلم وعيونه التي تنبجس في مختلف أنحاء الوطن»[31].
- أمّا المقال الثاني للأديبة شمس الضحى بوزيد فعنوانه: «الحذار من التقليد الأعمى!». نشرته مجلة «الأنوار» التطوانية، وهو مقال جدير بالاهتمام، وقد مرّ عليه الآن أزيد من 60 عاما إلّا أنّه لايزال محتفظا براهنيته، ويصلح لتنبيه الكثير من فتيات المغرب اليوم اللّواتي جرفتهن أوْدِية التّقليد إلى مهاوي غريبة، وفيما يلي نصّه :
- الحَـذَار مِنَ الـتّـقْـلِـيـد الأَعْـمَى !
« التّقليدُ سيفٌ ذو حدّين، ينفعُ، وكثيرا ما يَضُرُّ ولا ينفع. وللبَشَرِ مَيْلٌ واضح إلى المحاكاة والتشبّه، إمّا لمفاخرة أو غرور. وهم في ذلك متفاوتون بتفاوت عقولهم وأذواقهم، وحظهم من الاستقلال الفكري والرّوية والتبصر.
ولعلّ قائلا يقول: إنّ التقليد الضار هو الذي يشمل ما أجمع العقلاء على فساده كالإخلال بمكارم الأخلاق، والعبث بالمروءة، والإسفاف في الدين، وإذاية الناس، والانهماك في الرذائل، والاستهتار في اللّذَّات، والخروج عن حدود التقوى والاستقامة.
وأمّا النافع منه فما كان باتفاق العقلاء عائدا بطائلة على الفرد والجماعة كاقتباس علم، أو نقل فنّ، أو انتحال صناعة، أو أخذ مزية، أو اقتداء فضيلة.
على أن مثل هذا الحكم السطحي الذي يبدو بسيطا في حدِّ ذاته لا يمس جوهر الأمر الواقع ولا يتناول المشكل إلا من أطرافه وصورته النظرية، فإن الشيء الذي نراه أنا وأنتَ ضاراًّ قد يراه غيرنا مُفيدا، والعكس بالعكس. وسبحان من قسم العقول !
فَمَا الحِيلَة، ياترى، للتمييز بين ما ينبغي تقليده وما يجدر اجتنابه. هذا إلى أن الذكاء كثيرا ما يكون منقادا لأهواء النفس و﴿إنّ النفس لأمّارة بالسُّوء﴾.
قد يكون من صواب الرأي متى عميت على الإنسان الأمور، والْتَبَسَت عليه المسالك، وشكّ في سلامة ذوقه، أنِ يركن إلى نصيحة المُجَرَّبِين ممّن يوثق بخبرتهم ويُسَلَّم بحصافة فكرهم علّه يأمن بذلك آفة الوقوع فيما لا تُحمد عقباه أو يكون مظنّة للزّلل.
أجل ! ولكن بيت القصيد هو اليقين من أولئك المُحَنّكِين الذين نتخذهم قدوة ومثالا جادون غير هازلين مصيبون حقا غير مخطئين، ثم إن الاستبداد بالرأي قد يكون مزية أحيانا وقد يكون نقيصة أحيانا أخرى. والرأي عندي أن يوجد بين التحكم الذاتي الصرف والتقليد الأعمى المفرط مجال فسيح للتأمل والمقارنة واختيار الحَلّ الوسط وهو في جُلِّ الأحوال خير الحلول.
إِنّ النهضة النسائية المغربية تجتاز الآن طورا دقيقا يحتاج إلى كثير من الفطنة والتريث لأنّه الطوّر الفاصل بين الأمس الدابر والغد المشرق الزاهر، طور الخروج من ديجور الجهالة، والقعود إلى نور المعرفة والنهوض. والناس - ككل شيء في هذه الحياة الدنيا- يتكيفون في طور نشأتهم على شكل القوالب التي تُصاغ فيها نفوسهم وعقولهم. والمرأة المغربية مضطرة - بحكم الرغبة في الرقي المُطّرد- إلى اقتباس بعض المظاهر والمقومات من غيرها، لاسيما من الأوربيات.
وللأوربيات، بطبيعة الحال، فضائل تُذْكَر، وعيوب لا تُنْكَر، وأشياء تحسن فيها المحاكات، وأخرى ليس من ورائها طائل ولا جدوى، ولا ريب أنّ للطبيعة حُكمها في هذا الشأن. فقد شاءت حكمة اللّه أن تجعل للبشر آية في اختلاف ألوانهم وألسنتهم، وعبرة في تباين خصائصهم ومؤهلاتهم، وجعلت لكل قطر ميزات مخصوصة يتطور في دائرتها سكانه ويرتاحون إليها، وجعل كل قوم بما لديهم فرحين. أما إذا نقلت تلك الخصائص والميزات برمتها إلى بلد آخر دون اكتراث لفوارق البيئة والذهن والأخلاق، فلربما لا تجدي نفعا إن لم تجلب شرّ العواقب.
على ضوء هذه الاعتبارات يجب أن تفهم فتياتنا - أصلحهن اللّه- تقليد الأجنبيات، سواء فيما هو لازم كاللباس وتدبير شؤون المنزل أم فيما هو تافه كأسباب الزينة والتسليات وتنظيم الحفلات والولائم، مع أنّ هذه التوافه ضرورية بالنسبة إلى المرأة.
والحذار، الحذار من فتنة «المُوضَة» وتقلّبها المُطّرد، فلا يكاد يَمُرُّ يومٌ تظهر موضة جديدة لتسوية الشَّعَر أو ضَمِّه أو إرساله، ولا يكاد ينقضي أسبوع حتى تبدو بدعة جديدة في شكل فستان أو معطف أو حقيبة يد أو جوارب أو حذاء ربما تكون أقلّ جمالا وأضعف ذوقا مِمّا سبقها !
وما أغنانا – مثلا- عن خوض غمار هذا النزاع القائم في عالم الموضة الغربية اليوم بين الفستان الطويل وبين الفستان القصير. وفي كل ذلك ما فيه من تضييع الوقت وإصراف المال وهما آفتان لاتطيقهما إلّا صاحبات الثراء الواسع ولا تجلبان للجيوب الفقيرة إلا التضييق والضناء الذي يمكن الإستغناء عنه بسهولة.
وفتياتنا - والحَمْدُ لِلَّهِ- أُوتين من صواب الرّأي وتوقّد الذهن وسرعة الإدراك ما يضمن لهنّ سلامة الذّوق فيما ينتهجن من ابتكار أو تقليد. وإذا كان نصحهن لزاما علينا معشر المعلمات في ميدان التربية والتثقيف فليس إرشادهن أقل وجوبا في هذه الكماليات من زينة وتجمّل وتسلية، فإنها ولا غرو من أبرز ميزات الأنوثة الحقّة، وخليق بالفتاة أنْ تتجنّب كل تفريط أو إفراط، لأنّ التفريط في ذلك مدعاة للتخشن المذموم، والإفراط غرور مُخِل بفضيلة الاحتشام نهى عنه الكتاب والسُّنَّة. ومتى أردنا التقليد فليكن على هُدًى وبصيرة، واللّه نسأل أنْ يهدينا سواء السبيل»[32].
- وللأديبة شمس الضحى بوزيد مقالات غير مَا ذُكِر، ولَعَلَّ التقدم في البحث مستقبلا سيكشف لنا عن المزيد من تلك الدُّرَر التي كان يراعها يُدَبِّجُها قبل نحو 65 عاما. وأُشِير في ختام هذه الترجمة إلى أنّني كُنْتُ الْتَقيتُ[33] بالأديبة شمس الضُّحَى بُوزِيد، عام 2005م وكانت وقتذاك تبلغ من العُمر 85 عاما، وقد وجدتُها - حتى هذه السِّنّ المُتَقَدِّمَة- لاتزال مُتوقِّدة الذهن، لم يلحق ذاكرتها فتور ولا وَهَن، نسال اللّه - عزّ وجلّ- أن يُثيبها على أعمالها الخَيِّرَة وأن يُجزل أجرها في الآخرة.
- وفــاتـهـا
تُوفيت الأستاذة شمس الضحى بوزيد بمدينة طنجة يوم 11 رمضان 1429هـ/ موافق 12 شتنبر 2008م. رَحِمَهَا اللّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً.
4 - ● فَـضِـيلَـة بِـنْـت مُحَـمّـد الـزّجْـلِـيّ
فَـضِـيلَـة بِـنْـت مُحَـمّـد بْن عَـبْد الـوَاحِـد الـزّجْـلِـيّ. وُلِدت بمدينة طنجة عام 1925م، وواصلت مسيرة عمّتها خَدُّوج الزجلي المتقدِّمة الذِّكر بعد أن دَرَسَت بمدرسة السَّقَّايَة الجديدة وتعلّمت القراءة والكتابة وحفظت سُوَرًا من القرآن الكريم، كما دَرَسَت بمدرسة القصبة للبنات، وتلقّت دروسا متينة في اللغة الفرنسية، ولمّا ألمّت بهذه اللغة الأخيرة إلماما كبيرا انتقلت عام 1949م إلى التّدريس بمدرسة بِرْشِي (Collège Berchet) التابعة للبعثة الفرنسية بطنجة، وبقيت تعمل في هذه المؤسسة مُدَرِّسَة للفرنسية والعربية إلى سنة 1953م[34].
5 - ● عَــائِـشَـة بـنـت عَـبْدِ الصَّـمَـد كَــــنُّــون
عائشة بنت عبد الصمد كنون. سَيِّدَة تنتمي إلى عائلة طنجاوية مُتَدَيِّنَة، نشأت في وسط سِماته الصّوْن والعفاف. وهي شقيقة الشّيخ عبد اللّه كنون الحَسَنِيّ. تعتبر هذه السيدة من مُدّرسات طنجة في عَقديْ الأربيعنيات والخمسينيات، ولايزال بعض من قرأ عليها في تلك السنين بدارها بحومة جنان القبطان يتذكّرها، ويَذْكُرُهَا بالخير، ويُثني على نهجها في التعليم[35]. وقد وردت الإشارة إلى الأستاذة الأديبة عائشة كنون في شهادة لمُومن السميحي إذ تكلّم على دراسته الأولية، نقلها الكاتب الفرنسي دانييل روندو في كتاب «طنجة»[36] له، نأتي بها هنا بِنَصِّهَا الفرنسي :
Cette intéressante agitation ne m’a pas empeché d’aller à l’école. J’en ai meme fréquenté plusieurs, l’école traditionnelle coranique, et l’école moderne. Ma première institutrice fut ma tante. Elle donnait ses cours chez elle, dans sa maison. Nous étions une vingtaine d’écoliers. C’etait une très belle femme, une lettrée, qui s’appelait Aicha. Elle m’a enseigné l’alphabet et des bribes du Coran. A cette époque, son frère, Abdellah Guennoun, a ouvert à Tanger la première école libre marocaine arabe.
وقد تكلّمت الأستاذة زبيدة الورياغلي على الفقيهة عائشة كنون، فقالت: «برزت أسماء العديد من السيدات المتعلمات في الأربعينات وبعدها، مِمّن ينتمين إلى بيوتات عريقة وشريفة، قُمْن بتحويل بيوتهن إلى أقسام دراسية لتعليم الفتيات ومحو الأمية المتفشية آنذاك في المجتمع النسائي الطّنجي تطوّعا منهنّ واحتسابًا للّه. ولعلّ خير شاهد على ذلك ما قامت به الشريفة الفقيهة للّاعائشة عبد الصمد كنون من تخصيص بعض حُجَر بيتها الواقع بحي جنان قبطان لتعليم الفتيات القراءة والكتابة، وتحفيظهن القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وتدريسهن تاريخ المغرب، وقد أُطلق على هذه المدرسة اسم : الكُتّاب القرآني للبنات»[37].
●●●●
إلى هُنَا نكون قد ترجمنا لخمسة من النساء، كانت لهن الريادة في ميدان التعليم بمدينة طنجة، وقد ساهمن بقسط وافر في ترشيد فتيات طنجة إلى العلم والمعرفة. ومِمّا تجدر الإشارة إليه أنّ ازدياد عدد المدارس بطنجة تزامن مع ظهور الحركة الوطنية المغربية بداية من عام 1930م، ولاريب في أنّ هذه الحركة كانت قد أَوْلت شطرا من اهتماماتها إلى التعليم، وجعلت من تعليم المرأة أحد أهدافها، وقد تَنَمّى ذلك الاهتمام بعد زيارة السلطان محمد الخامس إلى طنجة عام 1947م، وظهور الأميرة للا عائشة كمُساندة لتعليم الفتاة بالمدارس العصرية. وهكذا وجدنا بعض المدارس التي تأسّست بطنجة في النصف الأوّل من القرن العشرين، والتي كانت خاصة بالذكور، تفتح أبواب حُجرات الدّرس بها أمام الفتاة الطنجية كما حصل في مدرسة الجامع الكبير والمدرسة الإسلامية، وفي مدارس جديدة ظهرت فيما بعد كمدرسة الفتح والمدرسة الشعبية الإسلامية.
ولا شكّ في أنّ هذه المدارس لم تُوجد إلا لتُحارب السياسة الاستعمارية في مجال التعليم، ومنافسة المدارس الأجنبية، ولذلك أدرجت ضمن مقرراتها الدراسية اللغة الفرنسية والإسبانية، فإذا وصلنا إلى مستهلّ عقد الخمسينيات من القرن الماضي نجد بعض مُتعلِّمات طنجة يتولّين تدريس الفرنسية والإسبانية ويكتبن في الصُّحف بهاتين اللُّغَتين، مثال على ذلك: الأستاذة أمينة بنت الحاج عبد اللّه السوسي، المعروفة باسم آمنة الحاج ناصر، مُدرِّسة الفرنسية بمدرسة «الرياض» الكائنة بعقبة مرشان، والتي أُسندت إليها إدارة ثانوية ابن الخطيب (ثانوية زينب حاليا) في بداية عهد الاستقلال[38]. وفي نفس هذه الطبقة نجد السيدة فَامَة الحُمراني التي كانت تكتب بالفرنسية والعربية في جرائد طنجة في الخمسينيات، وهي زوجة الأستاذ محمد المهدي الزيدي رئيس تحرير جريدة «طنجة» التي ظهرت في شهر مارس من عام 1956م وخصّصت جانبا مُهِمّاً من صفحاتها للتعريف بالأنشطة التي تقوم بها المرأة الطنجاوية في عدد من المجالات، منها تعليم الفتاة والنهوض بها إلى مستويات عُلْيَا من الوَعْي والتّقدم، وللأستاذة فامة الحمراني قصص أدبية ومقالات حول تعليم الفتاة، منشورة في الجريدة المذكورة[39].
[1] Tanger et sa Zone, p.III
[2] التّصَوُّر والتّصديق، ص.31-32
[3] عبد الصمد العشاب، من أعلام طنجة في العلم والأدب والسياسة، ص.140
[4] جريدة الصباح ، ع.41 ، طنجة.1907م، ص.3
[5] أتقدّم بالشُّكْر إلى الأستاذة هُدَى المجّاطي التي لفتت انتباهي إلى هذه القصيدة.
[6] لم نتحقّق من هوية هذه الشاعرة إلّا أنّه بآخر القصيدة يظهر اسم «لبنى»، ولَعَلَّه اسمٌ مُستعار.
[7] جريدة إظهار الحق، عدد 132 ، طنجة يوم الثلاثاء 13 شعبان 1348هـ/موافق 14 يناير 1930م، ص.2 . ولا بُدّ أن أشير هُنَا إلى أني وجدتُ هذه الأبيات منشورة بعنوان: «السفور والحجاب»، في عدد من مجلّة «وحي الشباب» الصادرة في المَوْصِل (العراق) عام 1357هـ/1938م، منسوبة لجرجيس فتح اللّه. لكن الملاحظ أنّ تاريخها مُتَأَخِّر عن الجريدة الطنجية.
[8] استقيتُ تعريفاتهن من حوار لي مع الأديبة شمس الضحى بوزيد - رحمة اللّه عليها-، ثم عثرتُ على معلومات مُكَمِّلَة لها في مقال الأستاذة أُمّ هشام (جريدة طنجة، العدد 3561 - السبت 5 دجنبر 2009م، ص.4)، إضافة إلى المقالات المُفيدة للدكتورة زبيدة الورياغلي المنشورة في «جريدة طنجة».
[9] عدا مقالات الأستاذة زبيدة الورياغلي المنشورة في (جريدة طنجة)، ومقال للسيدة أم هشام في نفس الجريدة، لا نعثر على كتابات حول المرأة الطنجاوية.
[10] ذكرت الأستاذة زبيدة الورياغلي أنّ الفقيهة خدوج الزّجلي هي أوّل مُدرِّسَة للقرآن بمدرسة القصبة للبنات. (جريدة طنجة، العدد 3574 – 06/03/2010م، ص.7).
[11] جريدة طنجة، ع.3601 . (11/09/2010م)، ص.9
[12] الصحيح أنّها وُلِدَت بمدينة طنجة في التاريخ المذكور أعلاه .
[13] الريحاني، المغرب الأقصى، ص.311
[14] Fernando Valderrama Martinez, Historia de Accion Cultural de España en Marruecos, p.652
[15] أمين الريحاني، المغرب الأقصى، ص.238
[16] انظر ترجمة ارحيمو المدني بقلم الأستاذة زبيدة الورياغلي في: «جريدة طنجة»، ع.3601 - يوم السبت 11/09/2010م- ص.9
[17] عبد الحق المريني، دليل المرأة المغربية، ص.123-124
[18] جريدة طنجة ، ع.3601 ، ص.9
[19] زين العابدين الكتاني، المرأة المغربية الحديثة في ميدان الإعلام والكلمة، مجلة «الفنون» ، س.2 العدد 9 – 10 (خاص بالمرأة المغربية)، رجب - شعبان 1395هـ/ يوليوز - غشت 1975م، ص.176
[20] رحيمو المدني، فتاة مغربية تستنهض المغاربة، جريدة الريف (تطوان)، عدد 15 ، الخميس 29 رجب 1355هـ/15 أكتوبر 1936م، ص.1 ، 4 .
[21] سورة الأحزاب، الآية 34
[22] مجلّة الأنيس، العدد الثاني، السّنة الأولى، تطوان ، جمادى الأولى 1365هـ / أبريل 1946م، ص.9
[23] كانت دار أسرتها بمدينة طنجة، وقد ذكرت - رحمها اللّه- لي أنها قضت فترة من طفولتها بتطوان في بيت الأمير عبد المالك الجزائري. والأمير المذكور لَعِبَ أدوارا سياسية في شمال المغرب خلال الربع الأوّل من القرن العشرين (انظر: معلمة المغرب، ج.9 ، ص.2985-2987). وعائلة بوزيد تَمُتُّ إلى آل الجزائري بالقرابة من جِهَة الأم، فوالدة الأديبة شمس الضحى بوزيد هي السيدة خِيرَة بنت الفقيه محمد بوطالب، وعَمّةُ والدتها وسَمِيَّتُها خِيرَة (وأهل الجزائر عندهم وَلَع بهذا الإسم) كانت زوجة للأمير عبد القادر الجزائري، هذا فضلا عن أنّ آل بوطالب هم بنو عُمومة آل الجزائري الذين منهم الأمير والمُجَاهِد المذكور.
[24] مواكب النصر وكواكب العصر، ص.115-117
[25] العشّاب، من أعلام طنجة، ص.434-435
[26] إحدى هذه الكلمات كانت للأستاذة شمس الضحى بوزيد. (هذه رواية عن بنت عمّتها السيدة فاطمة بوزيد رحمة اللّه عليها).
[27] الدكتورة آمنة اللُّوه، زيارة محمد الخامس التاريخية لطنجة – أبريل.1947م، «جريدة طنجة»، العدد 3529 ، السبت 29 ربيع الثاني 1430هـ/25 أبريل 2009م، ص.9
[28] كتاب «العَلَم» بمناسبة 50 عاما على صُدورها، عدد خاص رقم: 16938 ، الأربعاء 26 ربيع الثاني 1417هـ/ 11 شتنبر 1996م، ص.32
[29] جريدة «العلم»، العدد 177 ، الأحد 14 جمادى الأولى 1366هـ/ 6 أبريل 1947م، ص.2
[30] جريدة «العَلَم»، ع.177 ، ص.2
[31] نفسه (ع.177 ، ص.2)
[32] مجلة «الأنوار»، العدد.8 ، تطوان.1367هـ/1948م، ص.16-17
[33] أجريت اللِّقاء مع الأديبة شمس الضحى بوزيد، بحضور بنت عمّتها السيدة فاطمة بوزيد، رحمة اللّه عليهما، في بيتها بحي كاليفورنيا من طنجة يوم الثلاثاء 8 مارس 2005م. وفيما بعد انتبهتُ إلى أن هذا التاريخ يوافق ما يعرف في هذا الوقت عالميا بيوم عيد المرأة.
[34] حدّثتني عنها الأستاذة شمس الضحى بوزيد رحمها اللّه، ثم قرأتُ ترجمة جَيِّدة لها بقلم الأستاذة زبيدة الورياغلي في (جريدة طنجة، العدد 3606 - السبت 16 أكتوبر 2010م، ص.8). وقَبْلَ ثلاث أو أربع سنوات قرأتُ خبر نعيها في بعض صحف طنجة. والبقاء للّه وحده.
[35] جريدة الشّمال، العدد.234 ، 14 سبتمبر 2004م، ص.9
[36] Rondeau, Tanger, p.56
[37] جريدة طنجة، العدد.3574 ، 6 مارس 2001م، ص.7
[38] جريدة طنجة، ع.3574 ، 6 مارس 2010م، ص.7
[39] انظر : جريدة «طنجة»، سنة 1956م