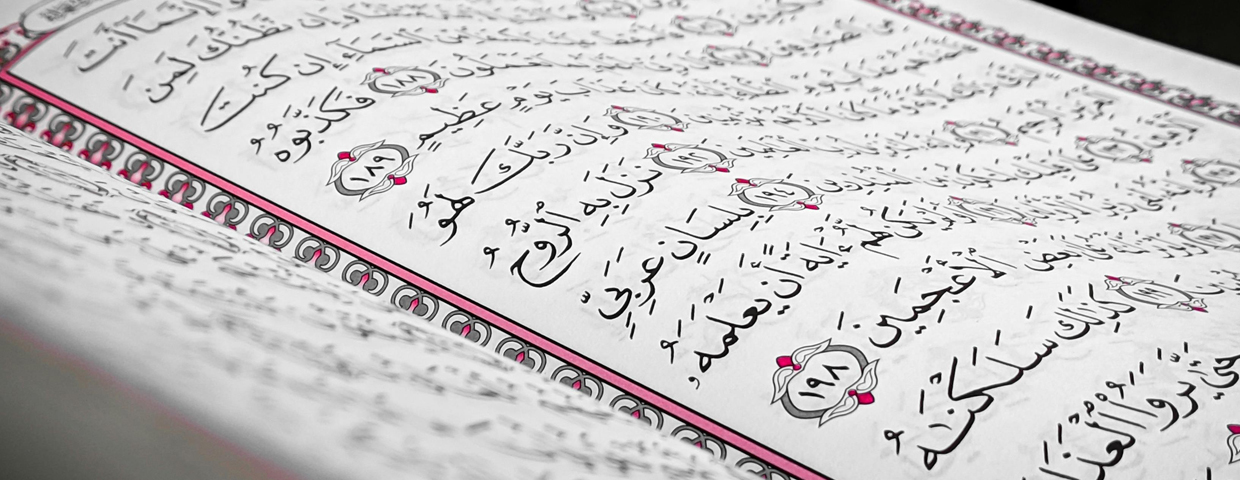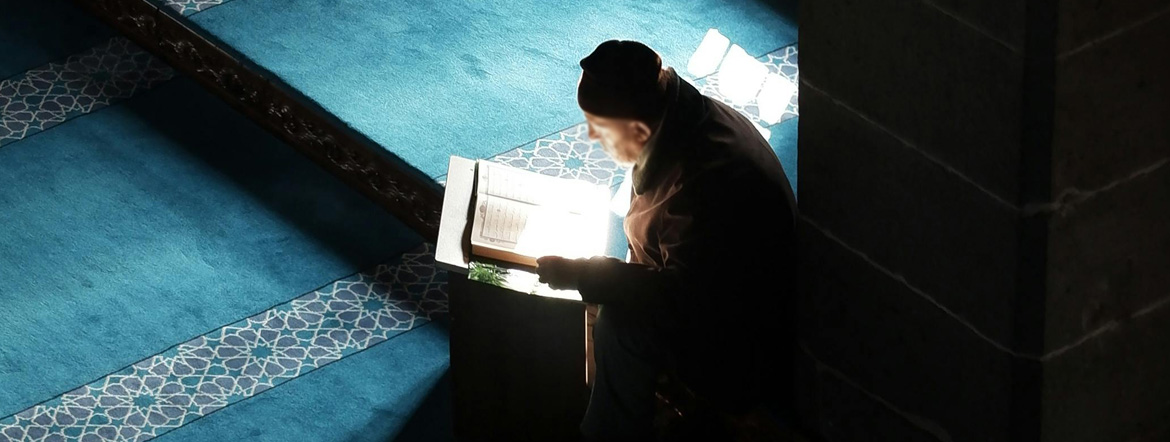أَسْرارُ البَيَان في القُرْآن(30) البَيَانُ في تَنْزِيهِ اللهِ تعَالَى عَن الشّرِّ، بِبِـنَاء الفِعْل للمَجْهُول في قَولهِ تعَالَى: ﴿وَإِنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ في الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً﴾
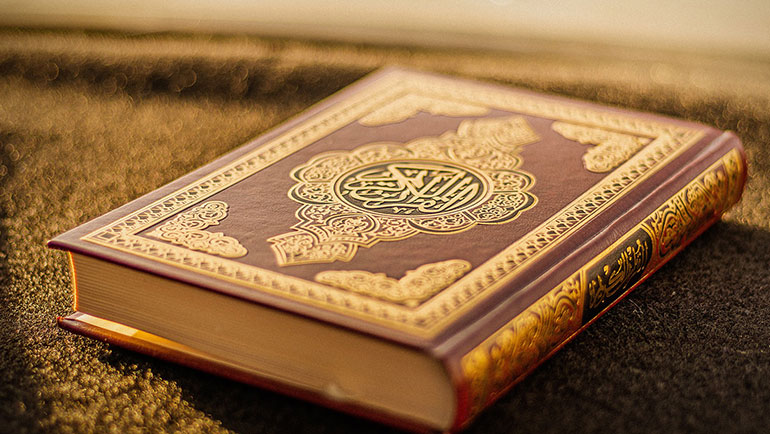
وَ ذَلكَ قَولهُ تعَالى، عَلى لسَانِ الجِنِّ في سُورَة (الْجِنّ): ﴿وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ في الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾.فَإنّهم اسْتعمَلوا فِعْل (الإرادَة) علَى وَجهَينِ، بصِيغَتينِ مُختلفَتينِ: صِيغَة المبْنيّ للمَجهُول(أَشَرٌّ أُرِيدَ)، وصِيغَة المبْنيّ للمَعْلُوم (أَرادَ بِهِمْ ربُّهُم رشَداً). ومنْ أوَّل نَظرٍ يَتـبيّنُ أنّ البنَاء للمعلُوم، بإظهَار الفَاعِل (رَبُّهُم)، جاءَ في سياقِ(الرَّشَد)، وأنّ البنَاء للمَجهُول بإخفَاءِ الفاعِل، جاءَ في سِيَاق (الشَّرّ). فخرجَ بذَلكَ الفعْلُ إلَى صِيغةٍ غَير صِيغَتهِ الأَصليَّة، فتَغيّـرَ بنَاءُ الجُملَة.
وهَذا التَّركيبُ يُحْذَفُ فِيهِ الفَاعِلُ ويَقُومُ الـمَفْعُولُ بِهِ مَقَامَهُ، ويَأخُذُ حركتهُ، فَيُعْربُ(نَائِبَ الفَاعِلِ). وهذهِ التَّـسميَةُ لمْ تَظهَر إلَّا معَ (ابنِ مالكٍ-تـــ:672هـ) في ألْفيَّتِهِ. وتَبعَهُ في ذلكَ (ابنُ هشامٍ) فقالَ في (الإعْرَاب عَنْ قَواعِدِ الإِعْرَاب): « وأنْ تَقُول في نحوِ(زَيْدٌ): نَائِب عنِ الفَاعِل. ولَا تَقُل: مَفعولٌ لِـمَا لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، لخَفَائهِ وطُولهِ». وَقَدْ كان يُسَمَّى قبلُ، عندَ الأوَائِل مِنَ النَّحْوِيِّينَ تَسمِيّاتٍ أُخَر ، منهَا: (الْـمَفعُول الّذي لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ)، و(الْـمَفعُول الّذي لا يُذكَر فاعِلهُ)، و(المفعُولُ بهِ في المعْنَى). وقالَ عنهُ (سِيــبَوَيْهِ في (الكتَاب) كَلاماً بَديعاً، جَمعَ فيهِ بَينهُ وبَينَ(الفَاعِل)، حيثُ قالَ: « هذَا بابُ الفَاعلِ الَّذي لَم يَتعدَّهُ فِعْلُه إلَى مَفعولٍ آخَر، والْـمَفعُول الَّذي لمْ يَتعَدَّ إلَيهِ فعلُ فَاعلٍ ولَمْ يتَعدَّه فعلُهُ إلى مَفعولٍ آخَر. والفَاعلُ والمفعُول في هَذا سَواءٌ، يَرتَفعُ المفعُولُ، كمَا يَرتفعُ الفاعِلُ، لأنّكَ لمْ تَشْغَل الفِعْلَ بغَيرهِ، وفَرَّغتَهُ لهُ، كمَا فعَلتَ ذلكَ بالفاعِل. فأمَّا الفاعِلُ الَّذي لا يَتعدَّاهُ فعلهُ، فقَولُك: ذَهَبَ زيدٌ، وجَلَسَ عَمْرٌو. والمفعُولُ الّذي لَمْ يَتعدَّهُ فعلُهُ، ولمْ يتَعَدَّ إليْهِ فعْلُ فاعِلٍ، فقَولُكَ: ضُرِبَ زَيدٌ، ويُضْرَبُ عَمْرٌو ».
فنائبُ الفاعِل يَجْري مَجْرى الفاعِل في أَحكامِهِ، منْ حيثُ الإسنادُ، والرتبةُ، والحَركةُ، والحَديثُ عنهُ. قالَ(ابنُ يَعيشٍ) في (شَرح المفصَّل): « اِعلَمْ أنّ المفعُول الَّذي لَمْ يُسمّ فاعلهُ يَجري مَجرى الفَاعلِ، في أنَّهُ بُنيَ على فِعْلٍ صِيغَ له علَى طَريقَةِ (فُعِلَ)، كمَا يُبْنَى الفاعِل علَى فعلٍ صِيغَ لهُ علَى طريقَةِ (فَعَلَ)، ويُجْعَل الفعلُ حَديثًا عنهُ كما كانَ حَديثًا عن الفاعِل، في أنّهُ يَصحُّ بهِ وبفعلهِ الفَائدَةُ. ويحسُنُ السُّكُوتُ علَيهِ، كمَا يَحسُن السّكوتُ علَى الفاعِل».
وقدْ حَدَّدُوا لِهَذَا الحَذْفِ أغراضاً هيَ أوثَقُ بعلُوم البَلاغَة منْـها بِعِلْمِ النَّحْو فَذَكَرُوا أَنَّ الفَاعِلَ يُحْذَفُ للخَوْفِ عَلَيْهِ، أَو الجَهْلِ بِهِ، أَوْ لعَظمَتِهِ أَوْ حقَارَتهِ، أو للرَّغبَة في الإيجَاز. وقد اعتَبَـر(ابنُ هشامٍ) ذلكَ تَطفُّلاً منَ النَّحويّينَ على صِناعَة البَيانِ، فقالَ في (الْـمُغني):«قَوْلهم يُحذَف الْفَاعِل لعَظمَته وحَقارَة الْـمَفْعُول، أَو بِالْعَكْسِ، أَو للْجَهْل بِهِ، أَو للْخَوْف عَلَيْهِ أَو مِنْهُ، وَنَحْو ذَلِك، فَإِنَّهُ تَطفُّلٌ مِنْهُم على صناعَة الْبَيَان».
لكنَّ فضْلَ نَظَر وبَصَر، يَكشفُ لكَ أنّ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِي القُرْآن الكريمِ، لَهَا وَجْهٌ يَنْفَردُ بِهِ التَّعْبِير الرَّبّانيّ. ذلكَ أنَّ تلكَ الأغرَاضَ جميعاً، إنَّما هيَ ألصَقُ بالمتَكلِّم الّذي يَتصرَّفُ في الكَلَام، فقدْ يَكُونُ عالماً بالفَاعِلِ، لكنَّهُ يُخْفِيهِ عنِ المتَلقّي، لغرَضٍ منْ تلكَ الأَغرَاض. ويبْقَى هذَا المتَلقّي للكَلَام في كُلِّ الأحوَالِ، جَاهلاً بالفَاعِلِ. فَقَدْ تَقُولُ مثلاً : ( فُتِحَ البَابُ)، وتَكونُ على عِلْمٍ بِمَنْ فَتَحَهُ، لكنَّكَ تُخْرِجُ الجملَةَ عَلَى هذهِ الصِّيغةِ، لغرَضٍ منْ تلكَ الأَغرَاضِ، لكنَّ المستَمعَ لنْ يَعرفَ أبَداً مَن فَتحَ البابَ، لأنَّ الفاعِلَ غيرُ مَذكورٍ، فقدْ أَخفاهُ المتَكَلِّمُ.
أمَّا اسْتعمَالُ هذَا البناءِ في القُرآنِ الكَريم، فيَتجاوزُ نطاقَ تلكَ الأغرَاضِ كلِّهَا؛ إذْ هَهُنا يَتساوَى في العِلْم بالفَاعِل، كُلٌّ منَ المتكَلِّم والمتَلقِّي. ولَا غَرْوَ، فكُلّ مُسلِمٍ صَحيحِ العَقيدَة، يعلَمُ يَقيناً أنَّ الّذي كَتبَ الصّيَام في قولهِ تعَالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، هُو اللهُ سُبحانَهُ وتعَالَى. رَغمَ أنَّكَ تَجدُ الفعلَ(كُتِبَ)في الآيَة قدْ أُخرِجَ علَى صيغَة المبْنيّ للْمَجهُول. لذَلك فبنَاءُ الفعْلِ للمَجْهُول فِي القُرْآنِ، لَهُ دَلالاتٌ فَريدةٌ تعْلُو بِهِ عَمَّا أَلفَهُ النَّاسُ، وَدَرَجُوا عَلَيْهِ في تَعابِيرهِم وتَآليفِهِم. ثمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لا يَغيبُ عنْ مُلكهِ ومَلكوتِهِ. وحُضُورُهُ فِيهِ دَائمٌ بِعِلمِهِ وحِفظِه، وإحاطتُهُ بِهِ إِحَاطَةٌ كُليّةٌ شَامِلَةٌ لا يَشِذُّ عنْـها شَيْءٌ. وهَذَا مِنَ الأمُور البَدَهِيَّةِ الَّتِي لا تَستَوجبُ شَيئاً منَ الاستِدْلالِ.
فإذَا اسْتجلَيْنا الأمْرَ بمَزيدِ تَدبُّر، تَكشَّفَتْ لنَا مَعانٍ، قدْ يكُونُ لهَا أوجُهٌ منَ الاسْترشَاد. فلعَلَّ مَناطَ ذلكَ أنْ يَكونَ أنَّ التّعبيرَ قدْ جاءَ في الفِعلِ الأوَّل مَبنيّاً للمَجهُول (أُرِيدَ)، لِـمَا في ذَلكَ منَ التَّرفُّعِ عنْ نِسْبَة (الشَّرّ) إلَى اللهِ تعَالَى، وهذَا منْ حُسْن الأدَب مَعَ اللهِ تعالى، وإفرَادِهِ بكَمَال التَّبْجِيل وجَليلِ التَّعْظِيم . فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ اخْتَلَفَ الفعلُ نَفسُه، فبُنِي للمَجْهُول أولاً ( أُريد)، وذلكَ لأنَّ الفعْلَ ارْتَبَطَتِ الإِرَادَةُ فِيهِ بالشَّرّ، وفي ذلكَ تَنْزِيهٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ شَرٌّ. وأمَّا الفعْلُ الثَّاني فَارْتَبَطَتْ فِيهِ الإِرَادَةُ بالخَيْر. فأَتَوْا بهِ مَبنيّاً للمَعلُوم، مَذكُوراً فَاعلُهُ، لِـمَا كانَ مِنْ نِسبَة (الرَّشَد)، وهُو خَيرٌ، إلى اللهِ تعَالى، مُصرِّحِينَ بهِ .
ولمْ يَفتْ هَذا المعنَى الدَّقيقُ (أبَا حيَّانٍ الأندَلسيّ)، فقالَ عنْ ذلكَ في (تَفسيرهِ) :« وَحِينَ ذَكَرُوا الشّرَّ لَم يُسنِدُوهُ إلَى الله تعَالَى، وحِينَ ذَكرُوا الرَّشَدَ أَسْنَدُوهُ إلَيْهِ تَعَالى». ولمْ يتطرَّق (الزَّمخشَريُّ) في (تَفسيرهِ) لهَذا المعْنَى، لكنْ جاءَ في الحَاشيَة الثالثَة منَ الصَّفحَة (225)، منَ الجُزء السّادِس، هذَا الكَلامُ، وهوَ منْ كتابِ (الانْتِصَاف منَ الكشَّاف) للإمَام(أَحْمَد بن الْـمُـنَـــيِّــــر): « وَلَقدْ أَحْسنُوا الأدَبَ في ذِكْر إرَادَة الشّرّ مَحذُوفَةَ الفَاعِل، والْـمُرادُ بالْـمُريدِ هُو اللهُ عزَّ وجَلّ، وإِبْرَازِهِمْ لِاسْمِهِ عندَ إرَادَة الخَيْر والرَّشَد. فجَمَعُوا بَينَ العَقيدَةِ الصَّحيحَة والآدَابِ الْـمَليحَةِ». وعَنْ هَذَا التَّأَدُّبِ السَّامِي مَعَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ (الألُوسيّ) في تَفسيرهِ (رُوح المعَانِي): «حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحُوا بِنِسْبَةِ الشَّرِّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الخَيْر. وإنْ كَانَ فَاعِلُ الكُلِّ هُوَ اللهُ تَعَالَى. ولَقَدْ جَمَعُوا بَيْنَ الأَدَبِ وَحُسْنِ الاعْتِقَادِ».
وقد وَرَدَ نَفْسُ الوَجْهِ التَّعْبِيريّ في التَّنزيهِ، في قِصَّةِ (مُوسَى)،عليه السلامُ، مَعَ العَبْدِ الصَّالِح في سُورَة (الكَهْفِ) حينَ فسَّرَ لَهُ أَفعَالَه الثَّلاثَةَ؛ فَنَسَبَ إِرَادَةَ خَرقِ السَّفينَة، وقَتْلِ الغُلامِ إلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَـهَا﴾، وقالَ ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبدلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ﴾ ، وَ لكنَّهُ أَسْنَدَ إِرَادَةَ الخَيْر في إِصْلاحِ الجِدَار لِحِفْظِ كَنْزِ اليَتِيمَيْنِ، إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرجَا كَنْزَهُمَا ﴾ . وَهَكذَا، فإنَّ نِسْبَةَ الخيْر إِلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، دُونَ الشَّرِّ، مِنَ الآدَاب القُرآنيَّة الشَّريفَة، وبَيانٌ بَديعٌ في الأسْلُوب القُرآنيّ، يَستَوقفُ النَّظَر، ويَستدْعي منَ القَارئِ، تَدَبُّراً وبَصراً. ومنْ ذلكَ ما جاءَ في قَول إبْرَاهيمَ (عَلَيْهِ السَّلام ): ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾،بَعْدَ أَنْ قَالَ ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾. فَأسْنَدَ الْـمَرَضَ لِنَفْسِهِ، ونَسَب الشِّفَاءَ والإطْعَامَ لِرَبِّهِ.
ومنْ أخفَى ما جاءَ علَى هذَا النَّحْو منَ الأسلُوب القُرآنيّ الفَريدِ، قولُهُ تعَالَى في سُورَة (الفَاتحَة): ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْـهِمْ غَيْـرِ الْـمَغْضُوبِ عَلَيْـهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. وخَفاؤُهُ منْ جهَةِ أنَّه جاءَ بِصِيغَة اسْمِ الْـمَفعُول، وذَلكَ في كَلمَة (الْـمَغضُوبِ عَلَيْـهِمْ). واسْمُ المفعُول كمَا هُو مَعلومٌ مُشتقٌّ اشْتِقاقاً فَرعيّاً، منَ الفعْلِ المبْنـيّ للمَجْهُول. فهُوَ مثلهُ ويَعملُ عَملَهُ. وفي هذَا السّياقِ، نَترُكُ (الإمامَ الزَّركشيّ)يَتحدَّثُ عنْ ذلكَ، فَكلامُهُ أَبلغُ وأوْفَى؛ قالَ في (البُرهَان في عُلُوم القُرآن): « وذَلكَ عَنْ طَريقِ التّأدُّب. وعلَى نَحو منْ ذَلكَ، جاءَ آخِرُ السُّورَة، فقَالَ: ﴿ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، مُصرِّحاً بِذِكْرِ الْـمُنْعِمِ وَإسْنَاد الإنْعَامِ إلَيْهِ لَفْظاً، ولَمْ يَقُلْ (صِرَاطَ الْـمُنْعِـمِ عَلَيْـهم). فلمَّا صارَ إلَى ذِكْرِ الغَضَب، زَوَى عَنهُ لَفْظَ الغَضَبِ، في النِّـسْبَةِ إليْهِ لَفْظاً، وجاءَ باللَّفْظِ مُنْحَرفاً عَنْ ذِكْر الغَاضِبِ، فَلَمْ يَقُلْ: (غَيْر الّذينَ غَضِبْتَ عَلَيْهِم)، تَفَادياً عنْ نِسْبَة الغَضَبِ في اللَّفْظِ، حالَ الْـمُواجَهَةِ». وكأنَّ (الزَّركَشيّ)، يَحذُو حَذْوَ (ضياءِ الدِّين بْنِ الأَثير)،من قبْلِهِ ،إذ كانَ قالَ في (المثَل السَّائِر): « وعَلَى نَحو منْ ذلكَ جاءَ آخِرُ السُّورَة، فقالَ: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، فَأَصْرَحَ الخِطابَ لَـمَّا ذَكَرَ النِّعْمَةَ، ثمَّ قالَ﴿غَيْـر الْـمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾عَطفاً علَى الأَوَّل؛ لأنَّ الأوّلَ مَوضعُ التّقرُّب منَ اللهِ بِذِكْرِ نِعَمِهِ، فلَمَّا صارَ إلى ذِكْر الغضَب جاءَ باللَّفظِ مُنحَرفاً عنْ ذِكْر الغَاضبِ، فأَسنَدَ النِّعْمَةَ إلَيْهِ لَفْظاً، وزَوى عَنهُ لَفْظَ الغَضَبِ تَحَنُّناً ولُطْفاً ».
وهكَذَا يَتبيّنُ لنَا أنّ استعمَالَ صِيغَة الفِعلِ المبْنيّ للمَجهُول في القُرآنِ، خاصَّةً معَ اللهِ تَعالى، يَنفردُ بمَعانٍ مَخصوصَةٍ، فلَا يَسري عَليهِ ما يَسْري علَى غَيرهِ منْ كَلامِ النَّاس. فذِكْرُ الفاعِل، وهُوَ اللهُ تعَالى في الجُملةِ، أَوْ حَذْفُهُ، سَواءٌ في إدْراكِ السَّامِعِ لهُ. فيَظلُّ مَعلُوماً مَعرُوفاً مَفْهُوماً منَ الكلَامِ، علَى قَدرِ السَّوَاءِ، ذُكِرَ أَمْ لَمْ يُذْكَر. بَيْدَ أنَّ في إِخْفَائهِ، وعَدَمِ ذِكْرِهِ، منَ الأَسرَار البَيانيَّةِ الجَليلَةِ الَّتي تَستَأثِرُ بالنّظَر ، وتَستَجلبُ الأَفئِدَةَ إلَى مَراتِعَ ذاتِ بَهْجَةٍ، منَ التَّدبُّر والتَّفَكُّر.