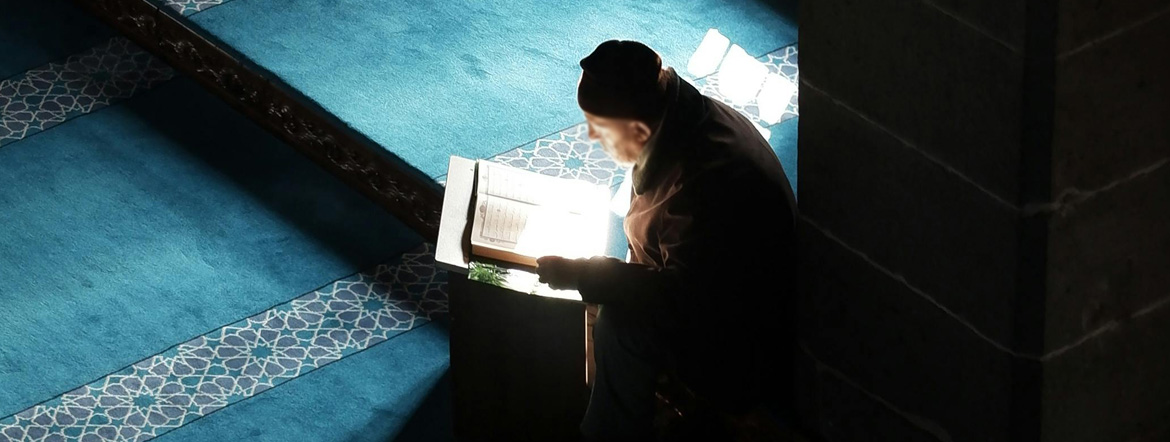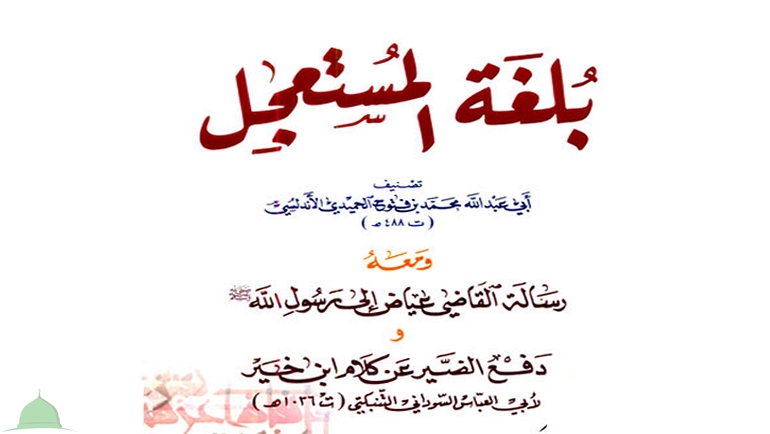أَسرارُ البَيان في القُرآن(36) البَيانُ في كَلمَة(الصّيَام) في قولهِ تعَالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا كُتِبَ عَليْكُمُ الصِّيَامُ كمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
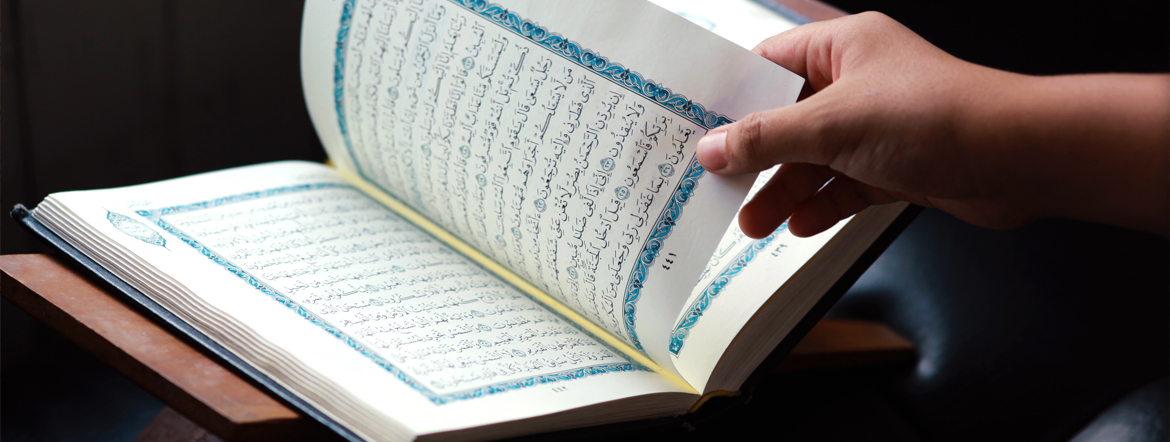
أمَّا عنِ اشْتقاقِها، فإنَّ كلمةَ(الصِّيَام)،من الجذر(ص-و-م)،ومنه الفعْلُ (صَامَ يَصُومُ)،والمصدَرُ: (صَوْمًا وصِيَامًا). ومعناهُ: الإمْساكُ والكَفُّ عنِ الشَّيْء. جاءَ في (مَقايِيس اللُّغَة)،(لابْنِ فَارسٍ)،عنِ الجِذْر (صوم)،قالَ :«الصّادُ والوَاوُ و الْـمِيمُ، أصلٌ يدلُّ علَى إمْسَاكٍ ورُكُودٍ». وجاءَ في تَفسير الإمامِ(الطَّبَريّ)،لآيَة الصّيَام، قولُهُ:« الصّيَامُ مَصدرٌ منْ قوْلِ القَائلِ: صُـمْتُ عَنْ كَذَا وَ كَذَا، يَعْني : كَفَفْتُ عَنهُ. ومنْ ذلكَ قِيلَ: صامَتِ الخَيْلُ ،إذَا كَفَّتْ عَن السَّيْر. ومنْهُ قَولُ (النَّابغَة الذُّبيَانيّ):
خَيْلٌ صِيَامٌ وخَيْلٌ غَيرُ صَائِمَةٍ ** تَحْتَ العَجَاج وأخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا »
ثمّ انتقَل هذا المعْنَى إلَى الاصْطِلاح الشَّرعيّ؛ فكانَ الصوْمُ هوَ الإِمْساكُ عن الأكلِ والشُّربِ والجِمَاع منْ طلُوع الفَجْر إلَى غُرُوب الشَّمْس. فصارَ لهُ مفهومٌ خاصٌّ انْفرَدَ في فِعْلهِ وفي زَمانهِ. ومنَ المعلُوم أنّ الكلمَاتِ في القُرآنِ الكَريمِ، تُستعْمَل علَى قَدرٍ منَ الدّقّةِ في المعنَى، والإصابَة في حَصْر الدّلاَلةِ، مَا يَكادُ يُستبعَدُ معهُ التّرَادُف. وقدْ وَردَتْ الكلمَةُ، بالمصدَر (صِيَام)، في القُرآنِ تسعَ مرّاتٍ. ثَلاثٌ منهَا في (آيَات الصِّيَام). في حينٍ لمْ تَرد الكَلمَة، بالمصدَر( صَوْم )، إلّا مَرّةً واحدَةً، في سُورَة ( مَرْيَم )، في قَولهِ تعالَى: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً﴾.
ويبدُو أنّ كَلمةَ (صَوْماً)، مَعناهَا هُنا مُختَلفٌ عنْ مَعنَى (الصِّيَام) الشَّرعيّ المعرُوف، بدَليلِ أنّها لمْ تكنْ مُمسكَةً عنِ الأَكلِ والشُّربِ، فقدْ سُبقَتِ الآياتُ بِذِكْر الرُّطَب والماءِ، فتَأكلُ منهُ وتَشربُ وتَقَرُّ عينُهَا، في قولهِ تعالَى: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً﴾. لذلكَ كانَ الصَّوْمُ هنَا، يُقصَد بهِ الإمسَاكُ عنِ الكَلَام. ويَتأكّدُ هذَا في قولهِ تعَالى:﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً﴾. وفي رَدّها علَى كلامِ قَومِهَا بالإشَارَة: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾. تَماماً كمَا صامَ النّبيّ(زَكَريّاء)،عليه السلامُ، ثَلاثةَ أيَّامٍ عنِ الكلامِ، ولمْ يُحدِّثْ قومَهُ إلَّا رمزاً بالإشَارَة. فهَذا نَبيٌّ وتِلكَ صِدّيقَة. ونحنُ لمْ نُؤمَرْ بالصَّوْم عَن الكَلامِ بإطلاقٍ. لكنْ أَليسَ في الأمْرِ سرٌّ خَفيّ، يَجمعُ الصّيَامَ عنِ المفطرَاتِ المادّيَّة، إلَى الصَّومِ عنِ الكلَامِ بخصوصٍ، في يَومِ صَومِ المؤمِنِ؟، ثُمّ أَفلا يَخلصُ بنَا ذَلكَ إلى أنْ نَزعُمَ، علَى اسْتِحياءِ، أنَّ مَعنَى (الصّيَام) يَختلفُ عنْ مَعنَى (الصَّوْم)؟. لِنكتَشفِ الأمْرَ بشَيءٍ منَ التَّدبُّر.
لقدِ اعتبَـر اللُّغويُّونَ كلمَةَ (يَوْم) منَ الْـمُشتَـرَك اللَّفظيّ؛ فقدْ تَعني مُجْمَلَ الزمَان الجامِع لِلَّيْل والنّهَار، أوْ كمَا قالُوا: مِنَ الطُّلُوع إلَى الطّــلُوعِ، أوْ منَ الغُرُوب إلَى الغُرُوب. وقدْ تَعْني نَهارَ النَّاس فَقَطْ، منْ طلُوعِ الفَجْر إلى غُرُوب الشَّمْس. قالَ(المرتَضَى الزَّبيديّ) في (تَاج العَرُوس):«مِقْدَارُهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، أوْ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، ذَكَرَهُ ابنُ هِشَامٍ فِي شَرْحِ الكَعْبِيَّةِ، والأخِيرُ: تَعْرِيفٌ شَرْعِيٌّ عِنْد الأكْثَرِ، وشَاعَ عِنْدَ المُنَجِّمِينَ أنَّ الــيَوْمَ مِنَ الطُّلُوعِ إِلَى الطُّلُوعِ، أوْ مِنَ الغُرُوبِ إِلَى الغُرُوب». والّذي يُوجِّهُ الدّلالَة في الكَلامِ، هوَ السّيَاق الْـمَقاليّ أوِ الْـمَقاميّ. فأنتَ إذَا قُلتَ مثلاً: (قَضى الفَلّاحُ يَومَهُ في الحَقْل)،فالمفهُومُ منْ هذَا الكَلامِ، هوَ أنَّهُ قَضى نَهارَهُ، فعَملُه لا يَمتَدُّ لَيْلاً. وهوَ ما يُفهَم منْ قولهِ تعالَى: ﴿سَخَّرهَا عَليهمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾. لكنَّكَ إذَا قلتَ مثَلاً: (قَضى التَّاجرُ في السفَرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)، فلَستَ تَقصِدُ أنهُ لمْ يكُنْ في السَّفَر إلّا وقتَ نَهارهِ. وإنمّا المفهُومُ منْ هذَا الكلامِ، أنّ اليَومَ يَجمَعُ النَّهارَ واللَّيلَ جَميعاً. تماماً كمَا تجدُ ذلكَ وَاضحاً مفهُوماً منْ قولهِ تعالَى: ﴿قالَ آيَتُكَ ألّا تُكَلّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إلّا رَمْزاً﴾. وذاكَ المعنَى الأوَّل هوَ الَّذي يُطابقُ التّعريفَ الشَّرعيّ للصِّيَام، كمَا حدَّدهُ الفُقهَاءُ: (مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ).
لكنْ يَنقدِحُ في الذِّهْن سُؤالٌ : فإذَا كانَ يومُ الصِّيَام هوَ النَّهَار، فأينَ اللَّيْلُ؟، أيْنَ التَّهجُّدُ والقيامُ ؟ ومَا حكْمُ أفْعالِ العِبَاد بالجَوَارحِ ليلاً؟. فهَلْ إباحَةُ الطّعَام ليلاً، تُبيحُ أعمَالاً أُخْرى، تَتحرَّرُ فيهَا الجَوارحُ منْ قُيُودهَا؟ فلْنَتأمّلْ قولَ (النّبيّ) صلّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم، في الحَديثِ القُدسيّ الذِي رَواهُ (البُخاريّ) و(مُسلِم) « إذَا كانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. فَإِنْ سَابَّه أَحَدٌ أوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ». وجاءَ الحَديثُ في روايَاتٍ أخرَى بِلَفظِ: «فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَجْهَلْ ». فهَلْ هذَا (الرَّفَثُ) الْـمَنهيُّ عنهُ، وقدْ قُرِنَ إلَى النَّهْـيِ عنِ الطَّعَام والشَّرابِ في يَوْم الصّائِم، يَبدَأُ ببِدَايَتهِ ويَنتَهي بانْتِـهَائهِ؟. قدْ يَبدُو في الظَّاهِر، اقْترانُـهُما وأثَرُ بَعضِهِما في بَعضٍ، منْ قولِ (النَّبيّ)،صلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ، في الحَديثِ المشهُور:« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بهِ، فَليسَ للهِ حاجَةٌ في أَنْ يَدعَ طعَامَهُ وشَرابَهُ ».
لكنَّ فضلَ تَدبُّرٍ في الأمْرِ يَكشفُ عنْ خَفيّةٍ بَديعَةٍ. ولعَلّ الأمرَ الجليَّ في هَذَا، هوَ أنَّ الإمْساكَ عنِ الطَّعَام والشَّرَاب، مَحدُودٌ زَمنهُ بنَهَار الصَّائِم، بينَ الطُّلُوع والغُرُوب. لكنَّ الرَّفَث وغيرَهُ من آفَاتِ اللِّسانِ، يَمتدُّ النَّهيُ عنهُ إلى مَا وَراءَ ذلكَ منَ الوقتِ؛ فهُوَ يَستَغرقُ نَهارَ الصَّائِم ولَيلهُ جَميعاً. و قدْ جاءَ في حديثٍ موقُوفٍ علَى (جَابِر بنِ عبدِ اللهِ)، قولُهُ « إذَا صُمتَ فلْيَصُمْ سَمعُكَ وبَصَرُكَ ولِسانُكَ عنِ الكَذِبِ والمحَارمِ ودَعْ أذَى الجَار، ولْيَكُنْ علَيكَ وقارٌ وسَكينةٌ، ولَا تَجعَلْ يومَ صَوْمكَ ويَومَ فِطركَ سَواءً». فصيامُ الجَوارحِ هوَ غيرُ صِيَام البَطنِ. لذلكَ فالصِّيَام في جَوهَرهِ، أوسَعُ ممَّا دَرجَ علَى تَصوُّرهِ كَثيرٌ من النّاس. ويَتجاوَزُ البَطنَ والفَرجَ إلى مَا هوَ أوْلَى بالكَفّ والإمْسَاك. وهيَ الجَوارحُ، وعلَى رَأسِهَا اللِّسَان فهيَ تابعَةٌ لهُ .
ولعلَّ مَا يشهدُ لذلكَ أنَّ الأَحاديثَ والآثارَ الوَاردَةَ في هذَا الجانبِ، لا تُـفَصّلُ القولَ إلّا فيمَا يتعلَّقُ باللِّسانِ منْ أفعَالٍ ؛ فالرَّفثُ والفُسوقُ والجَهْلُ والسِّبَابُ والكَذبُ وقَولُ الزُّور، كُلُّها أفعالٌ تَصدُرُ عنِ اللِّسَان. وصدقَ (رَسولُ اللهِ) صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ قالَ: « وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ في النَّارِ إلّا حَصَائدُ ألْسِنَتِهِمْ» وقدْ وردَ حديثٌ يُشيرُ فيهِ (النّبيّ) صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ، إلَى أنَّ الجَوارحَ كلَّها تَجعلُ اللّسانَ رَأسَهَا وقَائدَهَا، يَستقِيمُ فَتَستقِيمُ، ويَعوَجُّ فَتعوَجُّ مَعهُ. قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ:« إذَا أَصْبَحَ ابنُ آدمَ، فإنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسانَ فَتقولُ : اتَّقِ اللهَ فِينَا فإنَّمَا نَحنُ بِكَ ، إذَا اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإذَا اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا». بلْ إنَّ أثَرَ اللّسانِ يَمتدُّ إلَى القَلبِ الذي هُو مَناطُ الإيمَانِ، فيَعرضُ لهُ منْ فِعلِهِ مَا يَنالُ منِ اسْتِقَامَتهِ. فقدْ قالَ (النّبيّ) صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ذَلكَ: « لا يَسْتَقيمُ إيمَانُ عَبدٍ حتَّى يَستَقيمَ قَلبُهُ، وَلا يَستَقيمُ قَلبُهُ حَتّى يَستَقيمَ لِسَانُهُ». وبالتَّحليلِ المنطقِيّ البَسيطِ، يَتحصّلُ لنَا منْ هذهِ العِبارةِ الجَامعَةِ، نتيجَةٌ جَليلةٌ مبهرةٌ، تكونُ هيَ :(لا يَستَقيمُ الإيمَانُ حَتّى يَستقيمَ اللِّسَانُ). فيَصيرُ اللّسان بذَلكَ قُطبَ الأَمْرِ كُلِّهِ. وهذهِ المحَصّلةُ لا تَبعُدُ عمَّا قرَّرهُ (النّبيّ) صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ في حَديثه (لمعَاذِ بنِ جَبَل) حينَ قالَ لهُ: «رَأسُ الأمْرِ الإسْلامُ، وعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وذرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ». ثمَّ قال لهُ مُرْدِفاً « أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلكَ كُلِّهِ ...فَأخَذَ بلسَانهِ، وقالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا».
وهَكذَا نَخلصُ ممَّا سبَقَ، إلَى أمْرٍ ذي أهَمّيّة؛ وهوَ أنَّ الصِّيَامَ في عمقِهِ إنَّما يَسعى إلى حِفْظِ اللِّسَان؛ إذْ مِنهُ قِوَامُ الجَوارحِ والقَلبِ والإيمَان. فهوَ العِمادُ، وعليهِ الاعْتِمادُ. وهذَا ما تُعبّر عنهُ كَلمةُ (مَـلاك ) في الحديثِ السَّابقِ، فقدْ جاءَ في (تَاج العَرُوس)،عنِ الجِذْر (ملك)، قولُهُ « مَلاكُ الأَمْرِ بالفتْحِ ويُـكْسَر ، قِوامُهُ الّذي يُمْلكُ بهِ، وصَلاحُهُ». وفي (التّهذِيب)،(لِلأزْهَريّ)، قاَل: «الَّذِي يُعتَمَدُ عَليهِ». فإذَا ذهَبْتَ في التَّدبُّر شَوطاً أَبعدَ، وَ وَارَبْتَ علَى اسْتِحياءٍ باباً للنَّظَر، قلتَ: إنَّ هذَا هُوَ الصّوْمُ، أوسَعُ وأشَقُّ وأوفَى منَ الصِّيامِ. إذِ الإمْساكُ عنْ شَهوَتي البَطنِ والفَرج، مَحدُودٌ بالزَّمَن النّهاريّ، منَ الفَجرِ إلَى الغُرُوب، فهوَ صِيَامٌ. وهوَ أَهونُ وأيْسَرُ. وقدْ أُثِر عنْ (مَيمُون بنِ مَهرَان) أنهُ قالَ : «أَهْوَنُ الصِّيَام، الصِّيامُ عَنِ الطَّعامِ». وأمَّا إمْساكُ اللِّسانِ الّذي هوَ قوَامُ الإيمَان وعَـمَدُه، فَلا يَـحدُّهُ زَمنٌ، بلْ يَستغْرِقُ حَياةَ الصَّائِم كُلِّهَا، ويَملأُ عَليهِ نَـهارَهُ ولَيلَهُ. فيَقتَربُ منْ صومِ الصِّديقةِ (مَريَم) و النَّبيّ (زَكريّاء)، إلَّا أنّـهُمَا صامَا عَن الكلَامِ كُلّه، والمسْلمُ إنَّما يَصومُ لسَانُهُ عنْ مَحارمِ اللهِ، عَن الخَنَا وهُجرِ الكَلام وفُحشهِ، والرّفث والفُسُوق والكذِبِ وقولِ الزُّور، وعنِ الغِيبَة والنّمِيمَة، وكلّ ما يَنطلقُ بهِ اللّسانُ منَ الأذَى والآثامِ. وهذَا الصَّومُ هوَ الَّذي يَرفعُ قدرَ الصَّائِم ويَسمُو بهِ عن خَلْقهِ الطِّينيّ التُّرابيّ الّذي يَهوي بهِ مُسْفلاً، ليَرفعَهُ إلى جَوهَرهِ الرُّوحيّ منْ نَفخَةِ رُوحِ اللهِ ، الَّذي يرقَى بهِ مُصْعِداً إلَى الْـمَلَأ الأعْلَى. وهذَا هوَ المكسَبُ الغَالي الّذي يَكسبهُ الصّائمُ، وهوَ الصَّالحُ البَاقي، بعدَ أنْ يَعودَ بَعدَ رَمضانَ ،إلى طعامِهِ وشرَابهِ، ومَا أحلَّ اللهُ لهُ منَ الطّيّبَات. فإذَا لسانهُ مَحفوظٌ كمَا أمرَ ربُّهُ اسْتقامَةً ووَرَعاً. وإذَا الجَوارحُ تَستَقيمُ باسْتقامَتهِ، بلْ يَستَقيمُ القَلبُ ويَستَقيمُ الإيمَانُ، كمَا أخبرَ الرَّسولُ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ، في الحَديثِ الّذي سبقَ ذكرُهُ.
وهَكذَا نَخلصُ إلَى أنْ نقولَ: إنّ الصيَامَ أخَصُّ منَ الصّوْمِ؛ فكلُّ صَوْمٍ صِيَامٌ، وليسَ كلُّ صِيامٍ صَوْماً. والإنسَانُ يَصلُ بصِيامهِ نهَاراً في حِرمانِ بَدَنهِ ممَّا أحلَّ اللهُ لهُ، إلى الصَّومِ المتوَاصلِ في حِفْظِ لسانهِ عمّا حرمَ اللهُ، فيَستقيمُ قلبُهُ الدّهْرَ كلّهُ. فيكونُ الصِّيامُ بذلكَ مَسلكاً يَعبر منهُ الصّائمُ إلَى مقامٍ أعلَى، ويَرتَقى بهِ في مدَارج السّمُوّ الرّوحيّ، ليَصلَ إلَى الصّومِ الَّذي تَصفُو بهِ نفسُهُ، وتَتطهّرُ رُوحُه، ليُدركَ الهدفَ الأسمَى من كلِّ ذلكَ، فيكونَ منَ المتَّقينَ، ويُحققَ ذلكَ الرَّجاءَ المكنُونَ لهُ، في قولهِ تعالَى:﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.
ولعلَّ لتلكَ التَّقوى المتَمثّلةِ في حِفظِ اللّسانِ، أنْ تَتبدّى في أجلَى مَظاهِرِها، خُبْراً و خَبَراً، وعَيْناً وَ أثراً، في أَوّل شَعيرَة رَبّانيّة تَعقُبُ رَمضانَ، وهوَ الحَجّ. فمَا عوّدَ الصّائمُ عليهِ نفسَهُ صَبراً واحْتِساباً، طيلةَ شَهرٍ كاملٍ، يَلقاهُ أمامَهُ سَنداً وذُخراً ومَدداً. فيُؤدّي مَناسكهُ على الوَجهِ الّذي أَرادهُ لهُ ربُّهُ. فأنتَ إذَا تدبّرتَ آيةَ الحَجّ، والّتي تلتْ منْ قريبٍ آيَة الصّيامِ، سَبقتْ إلَى بَصركَ، وطرقَتْ سمعَكَ، كلمَاتٌ، فَأيقظتْ في ذِهنكَ مَعانيَ مَرّت بكَ في الصيَام. وذَلكَ أنّكَ تَقرَأُ قولهُ تعَالى:﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ﴾. فيَمضي بكَ الفكْرُ هَدياً حثِيثاً إلى قولهِ، صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم:« إذَا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ». وفي رِوايَةٍ « فَلا يَرفُثْ وَلا يَفْسُقْ». فَمنْ أينَ يَأتي الحَاُّج بهذهِ الاسْتِطاعَة في الاسْتِجابَة لهذَا الأَمرِ الإلَهيّ، فيَمْتَثلَ ويَمتَنعَ عمّا نهاهُ اللهُ عنْ فعلهِ في الحَجّ؟
إنَّهُ التّدْريبُ الرّبانيّ الرّمضانيّ الّذي يَخلقُ في الإنسَان هذهِ القُدرَة، ويَبعثُ في نَفسه تلكَ الاستِطاعَة، عنْ طريقِ التَّربيَة والتّأديبِ وكسرِ شَهوَات النَّفسِ، صِياماً وصَوماً. فمنْ لَمْ يُفلحْ في الاختبَار الرَّبانيّ الرَّمضانيّ، في الارتِقَاء منْ صيَامٍ إلى صَوْمٍ ، فاكتسبَ الدَّرجةَ العُليا في حفظِ اللّسانِ، أقدَمَ علَى الحجّ خَاويَ الوفاضِ، فَاترَ العَزيمَةِ، ضَعيفَ الهمّةِ، فانْفلتَ منهُ لسَانه، وأسرعَ بهِ، عَلى مَا دَأبَ عَليهِ، إلَى ما نَهاهُ اللهُ عنهُ منَ الرَّفثِ والفُسُوق والجِدالِ، فَفَسدَ حجُّهُ، وخابَ سَعيهُ.
إنَّ شَعائرَ اللهِ مَوصولٌ بَعضُها ببَعضٍ، في سِلسلَةٍ مُترابطَةِ الحَلقاتِ، مُحكمَة النَّظمِ، إذَا انحلَّتْ حلقَةٌ منهَا، انْفرَط العِقْدُ كلُّهُ. والحجُّ يَأتي بعدَ الصّيامِ مُباشرَةً. فقدِ اتفقَ المفسّرُون عَلى أنَّ (الأشهُرَ المعلُوماتِ) المذكورَة في آيَةِ الحجّ، هيَ (شَوّال) و(ذُو القِعدَة) و(ذُو الحِجّة)، أوِ العَشر الأوَائلُ منهُ فَقط. فتأمَّل كيفَ يُفضِي رَمضانُ بالصّائِم رَأساً إلى شَعيرَة الحجّ. إفْضاءَ التَّكامُل والتَّرابُط. ويَتكامَلُ الحَديثانِ عنِ (النّبيّ) صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ، تَكامُلاً عجيباً فقدْ قالَ عن الصَّومِ: «منْ صامَ رَمضَانَ إيماناً واحْتساباً، غُفرَ لهُ ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وقدْ رَأينَا سَابقاً عَلاقَةَ الإيمَانِ، بِحفظِ اللِّسَان. وقالَ عَن الحجّ :« مَنْ حجَّ للهِ فلَمْ يَرفُثْ ولَمْ يَفسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». فتكْتَملُ المغفِرَةُ بمَحوِ الذُّنُوب كلِّهَا، صَغائِرهَا وكَبَائرهَا. وهَكذَا يَقضِي المؤمنُ دَهرَهُ يتَقلَّبُ منْ تَطهيرٍ إلَى تَطهيرٍ، حتّى يلقَى اللهَ ومَا عليهِ خَطيئَةٌ. أَليسَ هذَا ما يَكشفهُ لنَا قولُ (النّبيّ) صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «الصّلَواتُ الخَمسُ، والجمُعَة إلى الجُمُعَة، ورَمضانُ إلَى رَمضانَ، مُكفِّراتٌ مَا بَينهُنّ إذَا اجْتُنبَتِ الكَبَائرُ» ثمَّ يكونُ الحجُّ، فيُكفِّرُ تلكَ الكبَائرَ. فيَعودُ المؤمنُ طاهراً نَقيّاً كمَا ولَدتهُ أمُّهُ.