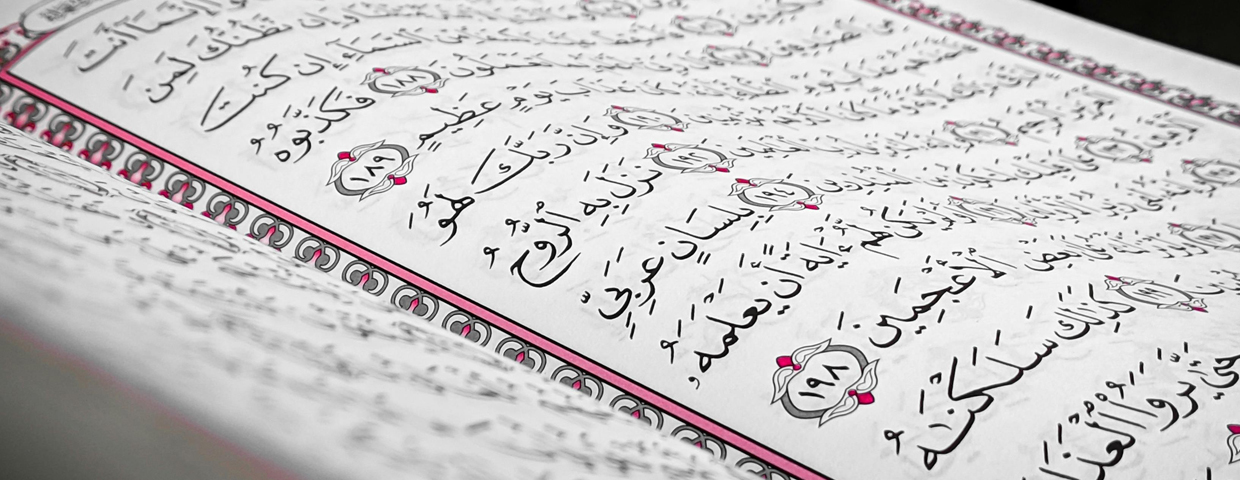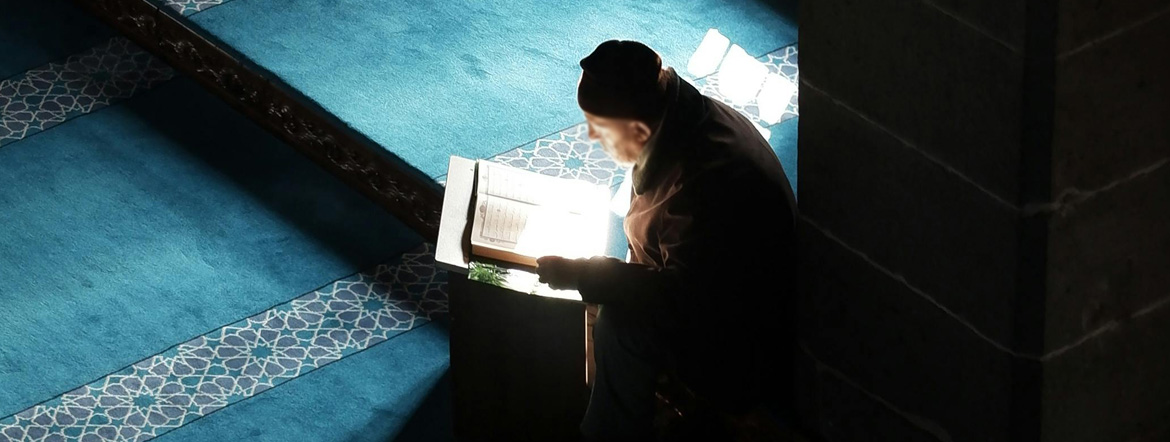أسْرارُ البَيَان في القُرآنِ(3) البَيَانُ في الجَمعِ بَينَ اسمِ الفَاعِل(شَاكِراً) وصيغَة المبَالغَةِ(كَفُوراً) في قَولهِ تعَالَى: ﴿إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وإِمَّا كَفُوراً﴾
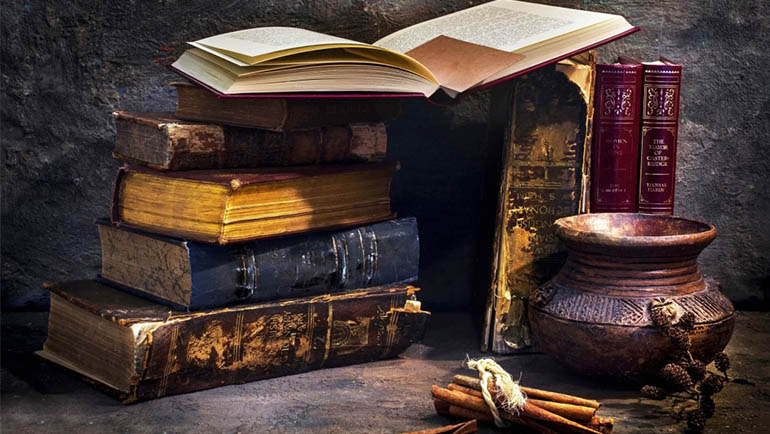
وذَلكَ قولهُ تعَالَى في سُورَة (الإنْسَان): ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إمَّا شَاكِراً وَإمَّا كَفُوراً﴾. فأنتَ تَرَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الإِنْسَانَ في الاسْتِجابِة لِهَدْيِ اللهِ صِنْفَيْن: صِنْفاً شاكِراً، وَصِنْفاً كَافِراً، إذِ الضَّميرُ في (هدَينَاهُ) يَعودُ علَى (الإنسَانِ) الَّذي سَبقَ ذكرُهُ في قولهِ تَعَالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ﴾.
لكنْ قبْلَ التَّفصيلِ في السِّرّ البَيانيّ في صِيغَة المبَالغَة، يَستَوقفُنَا الفِعْلُ (هَدَيْناهُ). فإنَّكَ تجدُ لهُ في الاسْتِعمالِ القُرآنيّ مَعنَيَينِ جَامعَينِ: أَحدهُما يَكونُ فيهِ الفعلُ (هَدَاهُ) بمَعنَى (عَرَّفَهُ، بَصَّرَهُ، بَيَّنَ لهُ...)، ومَا هُو مِثْلُه ممّا يَدلُّ علَى الإرْشادِ إلى المطلُوبِ، وثَانيهِمَا يَكونُ فيهِ الفعْلُ (هَدَاهُ) بمَعْنَى (وَفَّقَهُ، سَدَّدَهُ، أيَّدَهُ...)، ومَا أشبَهَ ذلكَ ممّا يَدلُّ علَى حُصُول المطلُوب. وقد وردَ هذَا في آياتٍ عَديدةٍ. و ممّا يَتبيَّنُ لكَ فِيهِ الفرقُ جَليّاً، قولهُ تعالَى: ﴿وَإنَّكَ لَتَـهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وقولُهُ عزَّ وجَلّ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. فَإثبَاتُ الهِدَايَة، ثمَّ نَفيُـها، ليسَ مُناقَضةً، وإنَّما هوَ منْ بَاب اختِلافِ المعنَى فيهمَا، عَلى الوَجهِ الذِي ذَكرناهُ. وفي ذَلكَ يقولُ (عُبيدُ اللهِ بنُ محمَّد بن بَطَّة العُكْبَريّ الحَنبليّ-ت 387 هـ)، في كِتابهِ (الإبَانةُ عنْ شَريعةِ الفِرْقَة النَّاجيَة): «فَبذَلكَ نَعلَمُ أَنّ الْهِدَايَة فِي الْقُرْآن لَهَا مَعْنيانِ: الْهِدَايَة بِمَعْنى الْإِرْشَاد وَالْبَيَان وَالدّلَالَة ،فَهَذِهِ لِلْقُرْآنِ وَالْـمُرْسَلِينَ، وَمَن يَقومُ مَقامَهمْ فِي الدَّعْوَة إِلَى الله. وَالثَّانِي الْهِدَايَة بِمَعْنى التَّوْفِيق ، فَهَذِهِ خَاصَّةٌ بِاللَّه تَعَالَى لَا يَقدرُ عَلَيْهَا أحدٌ إِلَّا الله تَعَالَى».
فالنّبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم، بَعثهُ اللهُ تعالَى هَادياً إلَى الصِّراط المستَقيمِ، أيْ دالّاً علَيهِ، مُبَصِّراً بهِ، وهوَ المعنَى المقصُودُ في الآيَة الأُولى، لكنَّهُ لا يَخلُقُ الهدايَةَ في النَّاسِ، وإنَّما ذَلكَ منْ أَمرِ اللهِ ومَشيئَتهِ، ومَا اسْتَأثَر بهِ في أَسرَار غَيبِهِ، وبَدائِعِ حِكمَتهِ. وقولُهُ تعَالى في الآيَة الّتي نحنُ بِصدَدِها: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيل﴾، يَكشفُ اللِّحَاقُ فيهَا بقولهِ:﴿إمَّا شَاكراً وإمَّا كَفُوراً﴾، أنَّ المقصُودَ هوَ المعنَى الأوّلُ: أيْ عَرَّفناهُ السَّبيلَ وبَصَّرناهُ بهِ. وهَذا مَا ذَهبَ إليهِ أهلُ التَّفسِير. قالَ(الشَّوْكانيّ) في (فَتح القَدِير): «أيْ: بَيَّنّا لهُ، وعَرّفنَاهُ طَريقَ الهُدَى والضَّلالِ، والخَيْـر والشَّرّ». وهوَ نَفسُ المعْنَى الَّذي يَردُ في قولهِ تعَالى في سورَة(فُصّلَت)عنْ(ثَمودَ):﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الْهُدَى﴾.
وتكُونُ هَذه التَّبْصرَة بالسَّبيل والهدَايَة إليهِ، ابْتلاءً منَ اللهِ لِهذا الإنْسانِ، ليَنظُرَ كيفَ تَكونُ اسْتِجابَتُه، وكيفَ يَعمَلونَ. جاءَ في (تَفسير الطَّبريّ): «قالَ: نَنظُر أيَّ شَيءٍ يَصنَعُ، وأيَّ الطَّريقَينِ يَسلُكُ، وأيَّ الأَمرَيْن يَأخُذُ، قالَ: وهذَا الاخْتِبَارُ». وإنّكَ لَتجدُ الإشَارةَ إلَى هذَا المعنَى بَيّنةً، فيمَا جاءَ علَى لسَانِ النّبيّ(سُلَيمان) علَيهِ السّلامُ، وقَدْ رَأى عَرشَ (بَلْقِيس) مُستَقرّاً بَينَ يَديهِ: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾.
أمَّا البَيانُ اللَّافتُ في الآيَة، والَّذي يَستَوقفُ القَارئَ، لِـمزِيدٍ منَ التَّدبُّر، فيَتَبَيَّنُ لَكَ في أَنَّ صِفَةَ الشُّكْر جَاءَتْ بصِيغَةِ اسْم الفَاعِل (شَاكراً)، بَيْنَمَا صَفَةُ الكُفْرِ أَتَتْ بصِيغَة الـمُبَالغَةِ (كَفُوراً). وَالـمُبَالَغَةُ، فِيهَا دَلالَةٌ عَلَى كَثرَةِ حُدُوثِ الفِعْل وتَعاظُم أَثَرهِ. فلَمْ يَتساوَيا في دَرجَةِ تَحقِيقِ المعْنَى، ولَو اسْتَوَت الصِّفَتَان لَكانَتَا علَى نَسَقٍ وَاحدٍ: ( شَكُوراً – كَفُوراً)، كمَا قالَ تعَالى عَن الإنسَانِ، وقدْ حَمَلَ الأَمَانةَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾.
وَفي ذَلكَ إِشَارَةٌ بَيَانِيَّةٌ مُبهرَةٌ إلَى حَقِيقَةِ أَنَّ شُكْرَ الإِنْسَانَ لِنِعَمِ اللَّهِ قَلِيلٌ، بَيْنَمَا كُفْرُهُ لَهَا كَثِيرٌ. وقدْ أَشارَ إلَى ذَلكَ كَثيرٌ من أَهْل التَّفسير؛ فَمنْ ذلكَ قوْلُ(الْـماوَرديّ) في(النُّكَت والعُيُون): «وجَمَعَ بَينَ (الشَّاكِرِ والكَفُور)، ولَمْ يَجمَعْ بَينَ (الشَّكُور والكَفُور)،معَ اجْتماعِهِمَا في مَعنَى الـمُبَالَغَةِ، نَفْياً لِلْمُبالَغَة في (الشُّكْر)، وإثْباتاً لَهَا في (الكُفْر)، لأَنّ شُكرَ اللهِ تَعالى لَا يُؤَدَّى. فانْتَفَتْ عَنهُ الـمبَالَغَة. ولَمْ تَنْتَفِ عَن الكُفرِ الـمبَالغَةُ. فَقَلَّ شُكرُهُ، لِكَثرَةِ النِّعَم عَليْهِ، وكَثُرَ كُفْرُه وإنْ قَلَّ، مَع الإحْسَانِ إليْهِ».
وفي القُرآن الكَريمِ آيَاتٌ عَدِيدَةٌ تَكَرَّرَتْ تُؤَكِّدُ هَذَا المَعْنَى، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ﴾ وقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾، وقولهُ تَعَالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾. ولذَلكَ تَقفُ علَى نُكتَةٍ بَيانيّةٍ لَطيفَةٍ، في قَولهِ تعَالَى في سُورَة (التَّغَابُن): ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾، حيثُ قدَّمَ (كَافِر) علَى(مُؤمِن). وقَدْ قالَ (الزَّمَخشريّ) في ذَلكَ: «وَقَدّمَ الكُفْرَ، لأنّهُ الأَغلَبُ عَلَيْـهِمْ وَالأَكثَرُ فيهِمْ». وإنَّكَ لَتقرَأُ قولَهُ تعَالَى في سُورَة (عَبَسَ): ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾،فَيَزدَادُ مَعنَى هذهِ الغَلبَة رُسُوخاً في نَفسِكَ، سواءٌ ذَهبتَ بالأُسلُوبِ: (مَا أَكْفَرَهُ)، مَذهَب التَّعجُّب، أيْ: (مَا أَشَدَّ كُفْرَهُ !) أَوْ ذَهبتَ بهِ مَذهَبَ الاسْتِفهَام، أيْ: ( مَا الَّذي حَمَلهُ عَلَى الكُفْر؟).
ثُمَّ أنْتَ إذْ تُنعِمُ المسْألَةَ فَضلَ تَدبُّرٍ، و بَسْطَ نَظَرٍ، تَخلُصُ إلَى أنَّ نِعَمَ اللهِ لا يحْصُرَها حَدٌّ، ولَا يُحصِيهَا عَدٌّ ، وَلا تُدْرَكُ مِنْهَا غَايَةٌ، ومِنْ ثَمَّ فَمَهْمَا أَجْهَد الإِنْسَانُ نَفْسَهُ، وَاسْتَجْمَعَ وُسْعَهُ، واسْتَفْرَغَ سَعْيَهُ وَوُكْدَهُ، فَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُوَفِّيَ مِنْ حَقِّ الشُّكْر إلَّا أقَلَّهُ، وَيَظَلُّ أَبَداً قَاصِراً عَنْ تَأْدِيَةِ مَا يَلْزَمُهُ تُجَاهَهَا من واجِبِ شُكْرها. وَعَلَى الضِّدِّ مِنْ ذَلِكَ، فَكُلُّ جُحُودٍ مِنَ الإِنْسَانِ وَكُفْرٍ لِنِعَمِ اللَّهِ، مَهْمَا قَلَّ، وَرَآهُ صَاحِبُهُ هَيِّناً، فَإِنَّهُ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ أَثَرهُ، بَالِغٌ خَطَرُهُ . فَعَظِيمُ الشُّكْرِ، قَلِيلٌ أَثَرُهُ لا يُوَفِّي حَقَّ النِّعَم، وهَيِّنُ الكُفْرِ، جَلِيلٌ خَطَرُهُ مُستَجلبٌ للنِّقَم.
لذَلكَ لَمْ يَأْتِ مَعْنَى الشُّكْر في القُرآنِ، صَادراً منَ الإِنْسَان عَلَى صِيغَةِ المُبَالِغَة (شَكُوراً)، إلّا مُرتَبطاً بالصَّبْرِ الشَّدِيدِ، وَكَأَنَّ هَذَا الْـمَقَامَ مِنَ الشُكْرِ، لا يَحْصُلُ إِلّا بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَبَذْلِ جُهْدٍ، يَسْتَلزمُ غَايَةَ الصَّبْر، عَبّر عنْـهَا بإخْراجِ صِفَةِ الصَّبرِ علَى صيغَةِ الْـمُبالَغَة الْـمُشدّدَة (صَبَّار). وذلكَ في عِبارَة تَكرَّرَت في أَربَع آيَاتٍ، وهيَ قوْلُهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾. فكَأنَّ الأَمرَ علَى أَنّهُ، لَا يَعْتَلي (الشُّكرُ) في العَبدِ، فَيَكونُ (شَكُوراً)، حَتّى يَغْتَليَ فيهِ (الصَّبْرُ) فيَكُونُ (صَبَّاراً). ومِمَّن اكْتَمَلَ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، اصْطِفاءً منَ اللهِ واجْتِباءً، ولأنَّ الصَّبرَ كانَ خُلُقاً خَلْقًا فيهِمْ، وجِبِلَّةً مَركُوزَةً في طِبَاعِهمْ، وعَنهُم قالَ عزَّ وجلّ لِنَبيّهِ: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرّسُلِ﴾. وَمِنْهُمْ (نُوح) عَلَيْهِ السَّلامُ، إِذْ قَالَ عَنْهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً﴾. وعَلى هذَا يُمكِنُ أنْ نَتلَمّسَ فَهماً، لقَوْل النّبيّ صلَى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «أَفَلا أَكونُ عَبداً شَكُوراً».
وَهَكَذَا جَاءَ الشُّكْرُ في الآيَةِ المذْكُورَة، بصيغَةِ اسمِ الفَاعِل (شَاكراً)، لِقِلَّتِهِ وقُصُورهِ. وجَاءَ الكُفْرُ بِصيغَةِ المبَالغَة (كَفُوراً)، لكَثرَتهِ وغَلبَتهِ وبَالِغ أثَرِهِ.