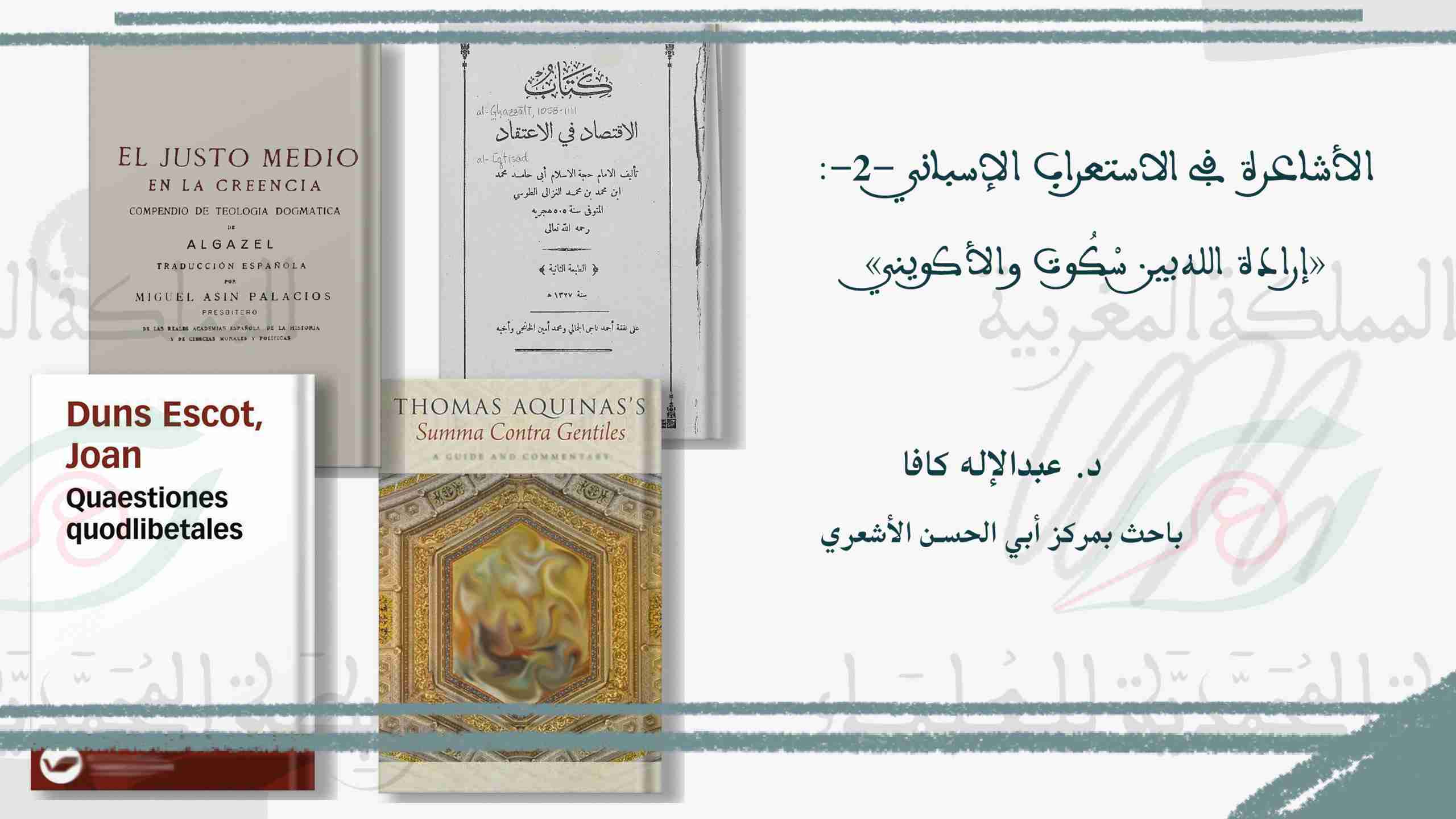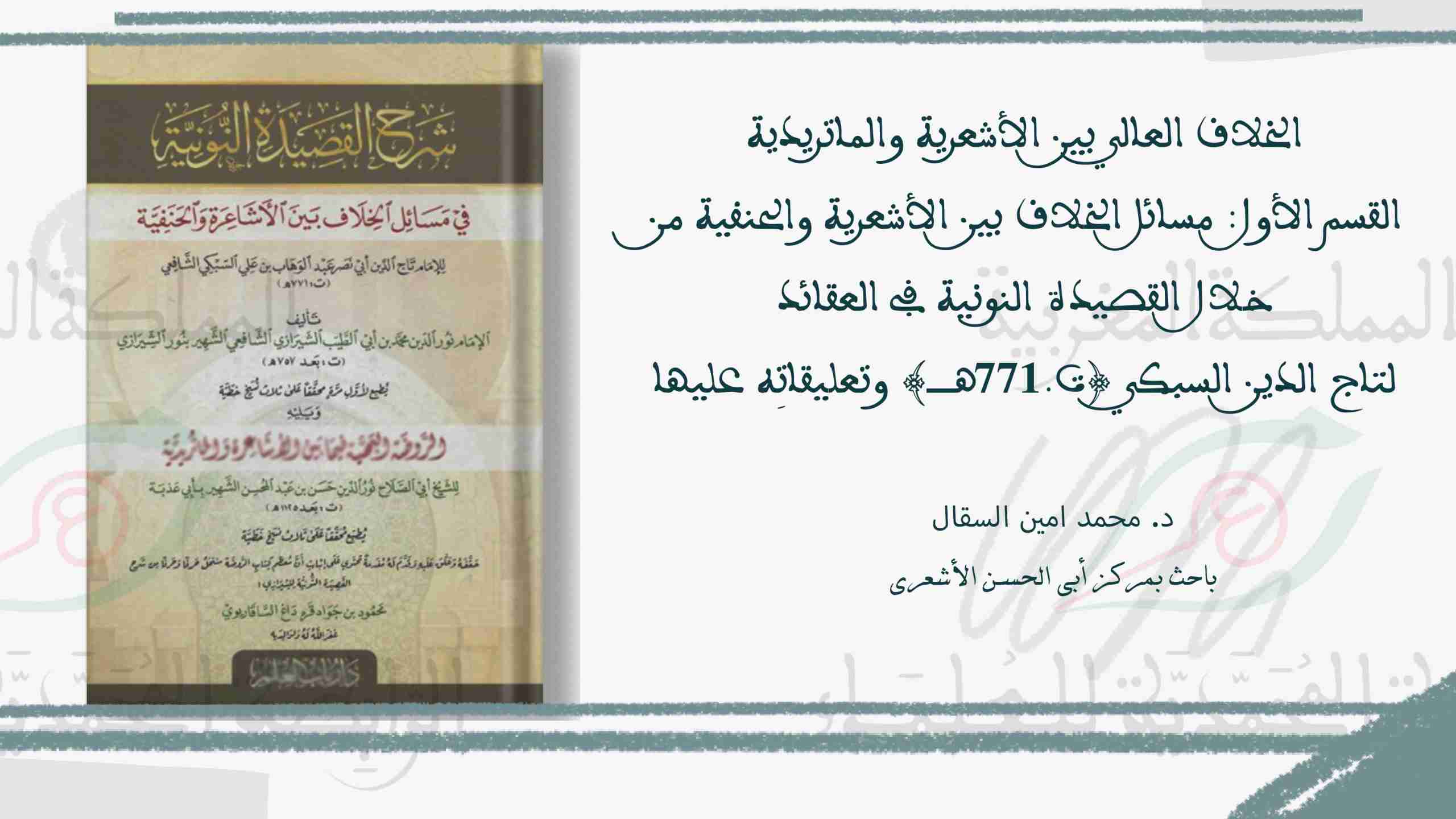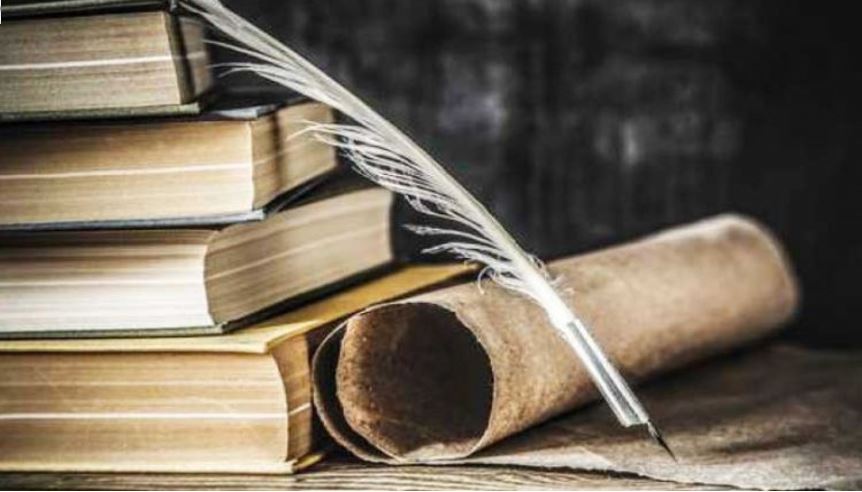شغلني التراث، قضية عامة عن التراث حقلاً أو حقولاً معرفية، ومن هذه الحقول "النحو" الذي كان محل اهتمامي حتى انتهيت من مرحلة الدراسة الجامعية الأولى، ثم خلصت له أو كدت في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) لا ينازعه على صعيد الدرس سوى قضايا التراث العامة التي تتصل بالتنظير له فهرسة وتحقيقًا ونشرًا، وباختصار "هَمًّا عامًّا" ثم بعد الدكتوراه أخذتني تلك القضايا أخذًا، لم تترك لغيرها إلا القليل مما تفرضه مناسبة علمية ما.
وهكذا وقع على النحو ظلم لا يشركني في وزره أحد، واقترنت عودتي إليه بإحساس بالذنب، أو بالأحرى بصحوة هذا الشعور، وهو شعور لم يكن يخفِّف من وطأته إلا شعور آخر بالسعادة، على أن إلحاح الأول وملازمته لم يتركا للثاني أن يصفو لي أبدًا.
لاشك أن المعرفة التراثية العربية الإسلامية جميعًا في أزمة، سواء كانت أزمة واقع أم أزمة تنـزيل، وليس من سبيل للحديث عن خروج من أزمة؛ معرفية كانت أو غير معرفية، إلا بالحديث عن "الأمة" والمنظومة الحضارية التي تسكنها. ولأن أزمة الأمة بدأت نذرها في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، فإن أزمة معرفتها تساوقت معها، فهي (أزمة المعرفة)؛ إذن ليست أزمة اليوم، بل هي أزمة عمرها قرون تقارب العشرة، ومن هنا كان السؤال: هل تحترق العلوم؟
لماذا النحو؟
وإنما اخترنا النحو ليكون نموذجًا في الإجابة على السؤال لأمرين:
أولهما: أن فيه المقولة الذائعة "نضج النحو العربي حتى احترق".
وثانيهما: أنه المعرفة القريبة من الباحث.
وعلى الرغم من ذيوع المقولة في النحو، فإن هذا العلم جزء من مقولة تصنيفية شملت ستة علوم، وكان النضج والاحتراق فيها مقترنين؛ مثبتين حينًا، ومنفيَّين حينًا ثانيًا، وموزَّعين بين الإثبات والنفي حينًا ثالثًا، فقد نقل الزركشي في قواعده عن بعض المشايخ أنه كان يقول:
"العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق (كذا) وهو النحو والأصول، وعلم نضج واحترق (كذا) وهو علم الفقه والحديث، وعلم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير."
إن ما جاء في نقل الزركشي، كما هو ظاهر، مخالف للمقولة الذائعة في النحو (نضج حتى احترق) فقد أثبت الزركشي له النضج، ونفى عنه الاحتراق!
ونحسب أن النقل قد وقع فيه وهم أو خطأ. وثَمَّة قرينة تتبدَّى للمتأمل، فقد سيق إثباتٌ ونفي أولاً، وإثباتان ثانيًا، ونفيان ثالثًا، كما رأيت، وفي ذلك اضطراب وتشويش، ولو أن السياق جاء هكذا: إثبات النضج والاحتراق معًا أولاً، ثم إثبات النضج ونفي الاحتراق ثانيًا، ثم نفي النضج والاحتراق معًا ثالثًا. لو أنه جاء بهذه الصورة لاستقام السياق شكلاً ومضمونًا، واتفق مع الصواب الذي نعرف من أن النحو هو الذي نضج حتى احترق، ومعه في ذلك "الأصول"، وإذا ما صوَّبنا الصنف الأول (النحو والأصول)، فلابد أن نصوِّب الصنف الثاني (الفقه والحديث) هذان العلمان نضجا، لكنهما لم يحترقا، ويبقى الصنف الثالث (البيان "علم البلاغة" والتفسير) فقد جاء على الصواب منفيًا نفيًا مركبًا بعد إثبات ونفي، الذي جاء بدوره بعد إثبات مركب.
على أن هذا الذي صوَّبنا هو من وجهة نظرنا، وإلاَّ فإن بعض المتأخرين تناقلوا نقل الزركشي، ولم يجدوا فيه شيئًا، بل إنهم فسروه، بل أيَّدوه، هذا ابن عابدين صاحب الحاشية الكبيرة على "الدر المختار" للحصكفي، في فقه السادة الحنفية، يقرر معلِّقًا على النقل أن النحو والأصول لم يحترقا، وأن الحديث والفقه احترقا!
مشروعية السؤال
وتبقى للسؤال الكبير (هل تحترق العلوم؟) مشروعيته، وللسؤال النموذج أو المثال: هل احترق النحو؟ مشروعيته، أيضًا، حتى إذا ما نأينا عن تاريخيته؛ إذ إنه لا يزال سؤالاً قائمًا، فنحن نعلم أن كثيرًا من طلبة الدراسات العليا في كليات الآداب واللغة العربية، يعزفون عن الالتحاق بالدراسة النحوية تحديدًا؛ لأن هذا العلم لم يبق فيه جديد، ماذا يمكن أن يفعل الدارس اليوم؟! قصارى ما يقوم به هو أن يحقق نصًّا قديمًا، يوثِّقه ويخرِّج نقوله، وينسبها إلى أصحابها، ويعلِّق بنقول من نصوص أخرى، ثم يقدِّم النصَّ، يعرِّف بمؤلفه وشيوخه وتلامذته، ويستخرج الآراء الجديدة (إن كانت موجودة)، وأخيرًا يذيِّله بإثبات (كشافات) مختلفة. وإذا ما نأى عن النصوص، ليس أمامه سوى أن يدرس شخصية نحوية، أو ظاهرة من ظواهر النحو، وفي الحالين ما عليه سوى أن يجمع الآراء ويحلِّلها ويناقشها في ضوء الآراء السابقة واللاحقة. والأمر كله دائر في الجمع والتصنيف وملاحظة الاختلافات والفروق، ولا شيء يذكر من بعد، فالنظرية النحوية مكتملة، والأسس مستقرة، والعلماء القدامى أحاطوا بالاحتمالات جميعًا، قد قتلوا "النحو" بحثًا: عَرَّفوا، وفرَّعوا، وحلَّلوا، واستشهدوا، وقرَّروا المطرد والمستقر، ورصدوا الشاذ والخارج، وتجاوزوا ذلك إلى ما يعده بعض الباحثين نوعًا من الترف العقلي الذي لا علاقة له باللغة وقواعدها وأنظمتها، وهو ما يمكن تسميته بـ"النحو الافتراضي".
ولأن الصورة كما رسمتُ فإن الباحثين اليوم منقسمون:
ـ فريق يرى الإبقاء على النحو (الذي نضج حتى احترق) والتمسك به، والوقوف عند حدوده، فهو كاف لا زيادة فيه لمستزيد، ولا خير في غيره.
ـ وفريق آخر يقطع بأنه نحو تجاوزه الزمن، وما عاد يصلح، لا في مناهجه، ولا في مادته، لمواكبة اللغة، ويرتِّب على هذا الحكم أن علينا أن ننأى عن هذا النحو في مناهج التعليم، ولا نتعب به عقول أبنائنا، وأن ننأى، أيضًا، عنه في الدرس اللغوي، فهو نحو ربما يكون قد قام بمهمة ما في الماضي، وليس فيه اليوم ما يمكِّنه من القيام بهذا الدور من جديد. وكأن هذا الفريق يقول إن النحو العربي (التقليدي) أصبح جزءًا من الماضي، والنظر فيه يكون (إذا ما صح) من باب التاريخ لا أكثر.
أزمة تعطيل.. وأزمة سجال
الفريقان متدابران، كلٌّ يسير في اتجاه مغاير، بل معاكس تمامًا لصاحبه. وهما معًا يوقعان النحو العربي في أزمتين: أزمة تعطيل، أو وقف اجتهاد، وأزمة سجال.
أزمة التعطيل قائمة من جهتين: جهة المؤيدين عن طريق التسليم للجهد التاريخي بالاكتمال والدوران في فلكه، وفقدان الحافز الذي يدع لبذل جهد جديد يعكس ثقة بالنفس دون أن يعدو على التراث أو ينتقص منه. وجهة المعارضين عن طريق الانصراف كليًّا عن تراث العلم!
وأزمة السجال تتماهى حينًا مع التاريخ، وتتميز منه حينًا آخر، وأقصد بالتماهي استدعاء قضايا النحو التاريخية: أبوابه وفصوله ومسائله وشواهده وخلافاته، وبالتميز الانصراف على مسائل حاضرة، تتصل بالمشكلات الحاضرة لـ"النحو" تعليمًا، وتجديدًا بتصنيف مسائله، والاجتهاد فيها، وربطها بالمسائل السنية أو التعليمية، وتذليل بعض قضاياه، ومحاولة التطوير عبر لغة جديدة وأمثلة عصرية.
وثَمَّة فريق ثالث كان متوازنًا، أعطى النحو القديم حقه، ووعى قيمته، وفي الوقت نفسه فقه أن اللغة ليست ساكنة، ومن ثم فإن النظر فيها لا ينبغي أن يسكن، وفقه أيضًا أن القطيعة مع النظر القديم أو إلغاءه لا يصح، بل إنه يناقض حراك اللغة وقواعدها؛ إذ ليس أقل من أن يكون للنظر الجديد ذاكرة يستند إليها، ويفيد منها، ويبني عليها، ولا يضير بعد ذلك أن يقع الباحث على ما يمكن إزاحته والاستغناء عنه، أو يدخله إلى دائرة الدرس التاريخي لا يجاوزها.
هذه النظرة المتوازنة تضع القضية في نصابها، وتستبطنها، وتتفهم أن الأمر أكبر من مجرد توجُّه فئة من الطلبة لدراسة اللغة ونحوها، وأعلى من السجال القائم بين فريقين، إذ إنه يتصل بالنظرة إلى التراث النحوي، وهو تراث ضخم، وما زال له حضوره القوي. وأبعد من ذلك أنه مرتبط عضويًّا بمستقبل الدرس النحوي العربي، وإن شئت قلت: بمستقبل العربية وحضورها بين اللغات اليوم. والأمر من بعد بحاجة إلى تفصيل.
ثنائية النضج والاحتراق
فَرَّق ابن عابدين بين النضج والاحتراق، قال: المراد بنضج العلم: تقرُّر قواعده، وتفريع فروعه، وتوضيح مسائله. والمراد باحتراقه: بلوغه النهاية في ذلك. يريد التقرُّر والتفريع والتوضيح، وبلوغ النهاية عنده كناية عن أنه لم يعد هناك جديد يضاف، وكأن الأقلام قد رفعت، والصحف قد جَفَّت.
إن هذا الفهم -لاشك- صوابٌ، لكن المشكلة ليست في مدلول كل من اللفظين، بل في أمر آخر، هو الذي سيتضح في السطور اللاحقة.
لقد بلغ النحو العربي نضجه في القرن الخامس الهجري، فصدق فيه صدر المقولة "نضج النحو" ولا أدل على نضجه من ذلك النتاج الرائع الذي تمثله مؤلفات سيبويه وابن السراج والفارسي وابن جني وغيرهم.
لكنه لم يحترق، فلا تصح فيه بقية المقولة "حتى احترق" إذا ما فهمنا الاحتراق على وجهه الظاهر، الذي جعل منه غاية النضج، أو بالأحرى نهايته، وكأنه تلك المرحلة التي تلي النضج، وتحيل الإفادة من "الطبخة".
إن العلم ينضج، لكنه -أبدًا- لا يحترق. ينضج؛ لأن النضج في تقديرنا مرتبط بمرحلة ما، ومع كل مرحلة جديدة تبدأ عملية إنضاج جديدة، قد تكون موادها من سابقتها، وهذه المرحلة مرتبطة بدورها بزمن، قد يطول، وقد يقصر، حتى يبلغ العلم فيها نضجه، لتبدأ بعد دورة إنضاج جديدة، وهكذا.
قد يصح أن نفهم الاحتراق على وجه آخر، وجه التوقف عند المرحلة السابقة، وعدم البدء في مرحلة جديدة، وهذا إنما يكون إذا لم يستأنف أصحاب هذا العلم النظر المبدع فيه، وانشغلوا باجترار أنظار سابقيهم، وترداد أقوالهم.
ويبدو أن المقولة (الصادقة الكاذبة) استبقت المرحلة الزمنية التالية، وقد تكون من أسبابها، فعندما استقر في الوعي الجمعي لأصحاب الدرس النحوي أنهم لن يأتوا بجديد، وأن أسلافهم ما تركوا لهم شيئًا، أدخلوا العلم في دوامة الاحتراق، وصاروا هم وقوده.
على أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على أن مرحلة الاحتراق أو الاجترار هذه لم تكن قصرًا على النحو وحده، بل كانت جزءًا من حالة عامة دخلت فيها العلوم العربية الإسلامية جميعًا، تدريجيًا، بنسب متفاوتة. وكان وراء ذلك أسباب عامة (خارجية) تشملها جميعًا، وأسباب خاصة (داخلية) ترتبط بطبيعة كل علم، ومشكلاته البنيوية، وظروفه. وقد كان لنا بحث خاص في هذا الباب يركز على أسباب انحسار العلم العربي تحديدًا، نعني العلوم الطبيعية Science.
الحد الزمني الفاصل
ليس بالإمكان وضع حد زمني فاصل، بين النضج والاحتراق، ذلك أن العمليتين متداخلتان، وعملية النضج لم تحدث مرة واحدة، كما أن عملية الاحتراق احتاجت إلى زمن حتى يصبح الاحتراق عملية ظاهرة لا تخطئها عين. وعلى الرغم من ذلك، فإن علامات النضج كانت ظاهرة في القرن الخامس، وإنذارات الاحتراق بدأت في القرن السادس. واستمر الاحتراق حتى نهاية القرن العاشر (السادس عشر الميلادي) بعد ذلك ما عاد هناك نضج ولا احتراق، ودخل النحو العربي في مرحلة عدمية.
والحديث عن الاحتراق، وعن تلك المرحلة الزمنية الطويلة (خمسة قرون أو تزيد) لا يعني أنه لم تكن هناك ظواهر فردية، أو طفرات علمية، هنا، وهناك، لكنها ظلت ظواهر أو طفرات، ولم تستطع أن تتحول إلى حالة علمية تحقق شيئًا ما للدرس النحوي، قد عرفنا أسماء كبيرة، مثل ابن هشام المصري (توفي 218ﻫ)، وابن مالك الأندلسي (توفي 672ﻫ)، وابن أبي الربيع السبتي (توفي 688ﻫ)، وغيرهم، على أننا نلاحظ أن ما أعطته هذه الأسماء الكبيرة ظل يدور في فلك العطاءات السالفة، فلا يخرج عنها، إلا في مسائل جزئية، أو اجتهادات فرعية، لا تمس جوهر النظرية النحوية وأسسها وقواعدها.
وهو ما عَبَّر عنه أحد الباحثين المحدثين مقررًا وواصفًا حالة الدرس اللغوي العربي عمومًا، ومنه الدرس النحوي (بعد القرن الخامس)، بأنه "كان إما في سبيل الشرح، وإما في سبيل التعليق، وإما في سبيل التحقيق والتصويب" (اللغة العربية: معناها ومبناها 11). وإذا كان الشرح والتعليق سبيلين لا يخفى فيهما الاعتماد أو الاتكاء على السابق، فإن التحقيق والتصويب اللذين قد يلتبس أمرهما على بعض الناس، لا يزيدان عليهما كثيرًا، وذلك لأن التحقيق والتصويب يدوران أيضًا في فلك المقولات القديمة، لا يخرجان عليها، ولا يؤسسان شيئًا جديدًا، ولا يبتدعان مقولات جديدة تحقق نقلات في مسيرة العلم، أو تدفعانه إلى مناطق معرفية جديدة لم يرتدها من قبل.
ما بعد القرن الخامس
إن الدرس النحوي العربي بعد القرن الخامس الهجري اتسم بأمرين:
أولهما: أنه تحوَّل إلى درس تعليمي (لا علمي) أو مدرسي (لا بحثي). ولهذا انتشرت الظاهرة المعروفة بالمختصرات والشروح والحواشي والتعليقات والطرد والتقييدات. وصرنا نجد الكتاب يشرح، ثم يختصر الشرح، ثم يشرح المختصر. وصرنا نجد الكتاب يشرح شرحًا صغيرًا ثم شرحًا متوسطًا، ثم يشرح شرحًا كبيرًا. وربما تمَّ ذلك في بعض الأحيان من مؤلف الكتاب الأصل نفسه! ولم نعد نرى كتابًا (إلا نادرًا) أصيلاً، عنوانه مبتدَع دالٌّ على أصالته، فالعناوين مقترنة أبدًا بـ"شرح" أو "حاشية" أو "مختصر" أو "تقييد" أو "تعليق"..الخ. وأكثر من ذلك أن بعض الكتب تحوَّلت إلى متون تشرح عشرات المرات، وصار من المألوف أن تجد أن الكتاب الفلاني للفارسي، أو للزجاج، أو غيرهما قد قارب عدد شروحه وما ألف عليه المائتين! ولاشك أن هذا الحراك له دلالاته، فأن تنشغل القاعدة العلمية بـ"كتاب" واحد أو مجموعة كتب، دون كبير تأمل، أنها انصرفت عن أن تقول شيئًا جديدًا، واستهلكت وقتها في بسط كلام سابق وتفسيره وتقريبه، وهذا عمل تعليمي لا علمي، فالعلم في جوهره تجاوز وإبداع.
وثانيهما: أنه اتجه نحو الجمع، سواء جمع الأشباه والنظائر من المسائل والقواعد النحوية وعنونتها وتصنيفها، أو جمع الخلافات النحوية ومحاولة الإحاطة بها واستقصائها وحشدها ضمن التبويب النحوي التقليدي، وهكذا رأينا مجموعة كبيرة من الكتب التي تحمل هذا الطابع، منها: "الأشباه والنظائر للسيوطي"، "وهمع الهوامع" له أيضًا، و"الدرر اللوامع" للشنقيطي، وغير ذلك.
ويقف وراء هذا الاحتراق، وهذه المرحلة، أسباب عديدة، فقد رأى بعض الباحثين في سيطرة الغريب (غير العربي) على الخلافة، وتحديدًا العنصر التركي، سببًا من أسباب القضاء على الإبداع، ووقف مسيرة العلم، حتى انتهى الأمر إلى إقفال باب الاجتهاد، ليس في علم النحو وحده، بل في العلم جميعًا.
وثَمَّة مقولات كثيرة تردَّدت في هذا السياق، منها الظروف التي دعت إلى نشأة الدرس النحوي خصوصًا والدرس اللغوي عمومًا، فالنحو، كما يقال، بدأ لعلاج ظاهرة اللحن بعد الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية، ودخول الشعوب والأمم الأخرى في الإسلام، وقد وجهت هذه البداية الدرس، وجعلته ينصرف انصرافًا إلى أمرين:
الأول: الاتجاه إلى المبنى، وعدم الالتفات إلى المعنى إلا تبعًا لذلك، وعلى استحياء؛ أي إلى النحو التعليمي؛ لا العلمي.
والثاني: الانشغال بفكرة التخطئة والتصويب، ليتحول الدرس من كونه درسًا، إلى كونه بحثًا عن معايير للحكم.
ومع تسليمنا بأن هذه البداية صحيحة، فلا يمكن أن تكون هي السبب؛ إذ إنها لو كانت كذلك لما تمكنت من فرض رؤيتها على مسيرة الحراك العلمي بعد ذلك. ربما كانت الشرارة التي انقدح بها زناد البحث. هذا صحيح، لكن هذه البداية ليست هي التي وجهت الدرس العربي الإسلامي في مجمله، فمن المعروف أن هذا الدرس بمختلف فروعه إنما قام من أجل القرآن الكريم والسنة النبوية، فهل نقول مثل ذلك على جميع هذه العلوم. ولو أن لها هذا التأثير الكبير لما رأينا كل تلك الجهود التي أثمرت حتى القرن الخامس الهجري دراسات علمية مجردة لا علاقة لها بالتصويب والتخطئة، بل فيها البحث عن أسرار اللغة وخصائصها وفلسفتها، واستكناه نظمها وجمالياتها.
إن النحو العربي، شأنه شأن غيره من العلوم العربية الإسلامية، نشأ لـ«فهم القرآن» وما اللحن إلا أول الطريق، وإذا ما وضعنا هذا في حسباننا أدركنا سر العطاء الكبير الذي أعطاه النحو العربي في القرون الأولى.
أطروحات التجديد
لم يستسلم النحو العربي للأزمة العامة؛ أزمة العلوم الإسلامية، ولا لأزمته الخاصة، فقد شهد خلال القرنين الخامس والسادس ثلاث أطروحات تجديدية، اختلفت في منطلقها وطبيعتها وغايتها، لكنها جميعًا هدفت إلى تجديد النظر في العلم "النحو" وإثارة الأسئلة، لكنها، جميعًا أيضًا، لم يكتب لها أن تستمر، ولا أن تحقق التراكم الذي يجعلها تمر بعملية إنضاج تجعل منها "نظرية" و"مدرسة" لها أتباع ومريدون، تزاحم النظرية السابقة (التقليدية). ولسنا في معرض البحث عن الأسباب فتلك قضية أخرى لا تتسع لها مساحة هذا البحث.
أطروحة عبد القاهر
كان من أولى أطروحات التجديد تاريخيًّا، وأهمها على صعيد البنية المعرفية للنحو العربي، هي أطروحة عبد القاهر الجرجاني (توفي 471ﻫ) والمعروفة بـ"نظرية النظم" وقد عرض لها على استحياء في "أسرار البلاغة" وعمَّقها تنظيرًا وتطبيقًا في "دلائل الإعجاز".
وعلى الرغم من أن الكتابين يصنفان على أنهما "أصلان جليلان في البلاغة" (محمود محمد شاكر: مقدمة تحقيق أسرار البلاغة 27) فإن عبد القاهر ربط ربطًا وثيقًا بين "الإعجاز" وهو قضية بلاغية أصلاً، و"معاني النحو" مما يعد لفتة عبقرية في العلاقة بين اللفظ أو المبنى الذي انصرف إليه النحويون انصرافًا بغرض الحفاظ على اللغة في ألفاظها وتراكيبها، والمعنى أو الدلالة الذي حظي بجلِّ اهتمام البلاغيين.
وكان عبد القاهر صريحًا في هذا الربط، فالبلاغة والإعجاز لا يتحققان إلا بـ"توخي معاني النحو" مازحًا، أو ربما موحِّدًا بين اللفظ أو المبنى والمعنى، فهما معًا اللغة في صحتها وبلاغتها.
على أن ما يلفت في هذه الأطروحة المهمة أنها لم تأت في سياق النقض للنظرية النحوية (التقليدية)، بل إنها لم تقاربها، ودليلنا على ذلك أن عبد القاهر شرح كتاب أبي علي الفارسي (أحد أعظم رجالات النظرية التقليدية) المعروف بـ"الإيضاح" ثلاثة شروح بمستويات ثلاثة، لم يصل إلينا منها سوى "المقتصد" وأعظمها أو أكبرها حجمًا "المغني" قيل إنه في عشرين مجلدًا، ولا يبدو علينا أن نابه لمن يجادل أو يرى أن هذه الشروح كانت في مرحلة مبكرة من حياة الشيخ، أو أنها كانت في مرحلة الطلب، والوفاء لابن أخت الفارسي أبي الحسين محمد بن عبد الوارث الذي تلمذ له عبد القاهر، وقرأ عليه "إيضاح" خاله، فالشروح ثلاثة، وأحدها كبير الحجم جدًا كما يشير اسمه، وتؤيد ذلك المصادر، وليس في "المقتصد" الذي نعرف، ولا في الأسرار والدلائل ما يشير ولو من بعيد إلى موقف رافض أو حتى معترض على الأسس النحوية التي عرفتها القرون السابقة.
وفي تفسير ذلك نحسب أننا أمام احتمالين:
1. احتمال أن عبد القاهر لم يكن يرى تعارضًا بين النظر النحوي في إطار النظرية السابقة، وبين النظر في ضوء نظريته في النظم، فهما مستويان للدرس اللغوي: مستوى يعنى بالمبنى في إطار القواعد والأصول التي رسخها النحويون، سواء على مستوى التبويب، أو على مستوى العوامل والعلل.. ومستوى يتجه إلى المعنى اتجاهًا ليدلَّ على مستوى آخر، في فقه البيان والفروق بين التراكيب اللغوية المختلفة.
2- واحتمال أن النظرية الجديدة (النظم) كانت في مرحلة التأسيس البنيوي الذاتي (الداخلي)، والنظرية لا يمكن أن تكتمل مرة واحدة، ثم إن هناك طورًا ثالثًا للنظرية يتمثل في ذلك الجدل الذي سيقع بينها وبين النظريات الأخرى، سواء في داخل العلم الذي تنتمي إليه، أو في داخل الحقل المعرفي الكلي الذي هو جزء منه، كما هو الحال في "النظم" فهي نظرية بلاغية أصلاً لها ارتباط بالحقل اللغوي الكلي الذي يجمعها والنحوَ، وما يترتب على ذلك من اتفاق وافتراق، أو ربما رفض.
ولعلنا أميل إلى هذا الاحتمال الأخير. وبالمناسبة فإن باحثة عراقية نظرت في القواعد النحوية في ضوء نظرية النظم من خلال أطروحتين جامعيتين: "نظام الجملة العربية" و"قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم". وعلى كُلٍّ فإن أطروحة عبد القاهر تظل في الاحتمالين أطروحة بنائية، بعكس الأطروحة التالية.
أطروحة ابن مضاء
تبدو أطروحة ابن مضاء القرطبي (توفي 592ﻫ) أكثر مباشرة في علاقتها بالنظرية النحوية، فهي نظرية رَدِّية (رافضة) أساسًا، وهذا ما يشي به عنوانها؛ عنوان الكتاب الذي تضمنها "الرد على النحاة" وإذا كانت أطروحة عبد القاهر أطروحة بناء - كما سلف - فإن أطروحة ابن مضاء هي أطروحة نقض، فهي في جوهرها ثورة على السابق، تسعى لإلغائه، وانفكاك منه، وقد رأى كثير من الباحثين (المحدثين) فيها وفي صاحبها تجديدًا أو اجتهادًا مطلقين، ونحن نعلم أن ابن مضاء نفسه قد سار على خطى ابن حزم (توفي 456ﻫ) الذي حذا بدوره حذو داود بن علي (توفي 270ﻫ) الظاهريين اللذين ثارا أيضًا على السابق، وإن كانت ثورتهما في حقل معرفي آخر، هو حقل الفقه، لكن المنهج الواحد، منهج الأخذ بالظاهر؛ ظاهر النص المقدس (القرآن والسنة) عندهما، وظاهر النص (اللغوي) عند ابن مضاء، بعيدًا عن القياس والتأويل والتعليل. على أن ابن حزم لم يقصر ظاهريته على الفقه، بل بَشَّر بها في النحو أيضًا، وإن لم ينظِّر لها، ويؤلف فيها، بل أطلق إشارات في كتبه، فقد رفض التعليل النحوي، ونعى على مَن يتعمقون في النحو، فينشغلون عما هو أوجب وأهم.
وجاء ابن مضاء الذي كان، أيضًا، فقيهًا وقاضيًا ليلتقط الخيط، وينقل فكرة "الظاهر" من العلوم الدينية (الفقه) إلى العلوم اللغوية (النحو)، ويؤسس لها تأسيسًا، لكن الصرح الضخم الذي بناه النحويون السابقون على مدة قرون كان صلبًا إلى حد أن الصيحة التي دوَّت في القرن السادس الهجري لم تكن لتترك أثرًا ذا بال، وعلى أية حال فنحن لسنا في صدد تقويم ما جاء به ابن مضاء، فما إلى ذلك مقصد هذا البحث.
أطروحة ابن رشد
ابن رشد عاصر ابن مضاء، كلاهما عاش في القرن السادس الهجري، وكلاهما عاش في الأندلس، في بلاط الموحدين، وكلاهما وصل إلى منصب القضاء، وكلاهما انشغل بقضية "النحو" لكن وجه الانشغال مختلف، وهذا ما أرجع إليه أحد الباحثين سكوت أحدهما عن الإشارة إلى الآخر أو كتابه، فأحدهما (ابن مضاء) يرتبط بظاهرية ابن حزم على مستوى العقيدة والشريعة، والآخر (ابن رشد) يرتبط بفكر أرسطو على مستوى المنطق والعلوم العقلية، ومن هنا جاء اختلاف الأطروحتين، فابن رشد فيلسوف، نعم هو -أيضًا- فقيه، لكن له مكانته في عالم الفلسفة، وما كان ابن مضاء إلا فقيهًا، أما الجرجاني فما كان إلا بلاغيًّا، دون أن ينفي ذلك أن لكل منهم نصيبًا قد يكون عظيمًا من العلوم الأخرى، لكن غلب عليه ذلك، أو برَّز فيه.
ثم إن الأطروحة الرشدية لا تسعى إلى الإلغاء والانفكاك من الأسس النحوية من عامل وعلة وتأويل، ولكنها تقوم على رؤية تنظيمية، غرضها إعادة ترتيب أبواب النحو العربي ومسائله على الطريقة الصناعية (المنطقية) التي فسرها ابن رشد بأنها الطريقة التي تشترك بها جميع الألسنة.
إن الطريقة التي صاغ بها النحويون أبواب العلم هي التي تحتاج إلى نظر جديد؛ لأنها جعلت تعلُّم هذا العلم وتعليمه صعبًا، ولذلك كان لا بد من أسس تنظيمية جديدة حتى تتحقق الفائدة، وتحصل الثمرة، ويسهل تعلُّم العلم وتعليمه.
وإذن، فإن الحراك داخل البنية التأسيسية والمعرفية للنحو العربي استمرت في القرنين الخامس والسادس، لكن النهر العظيم ظل يجري، وما شَكَّل ذلك الحراك سوى محطات صغيرة لن تستطع أن تحوّل المجرى، أو تستوقفه لتأخذ مكانها فيه، حتى جاء العصر الحديث، واكتشف الباحثون كتابي "الأسرار والدلائل" لعبد القاهر، ووقع شوقي ضيف على كتاب ابن مضاء، وظهر كتاب "الضروري في صناعة النحو" لابن رشد.
في العصر الحديث
التفت الباحثون العرب المسلمون في العصر الحديث إلى "النحو" مبكرًا، ولعل أول ما شغلهم فيه هو تجديده أو إحياؤه أو تيسيره، وقد استند التفات بعضهم إلى التراث كما فعل شوقي ضيف، وانطلق بعضهم من نظر خاص به، كما نرى عند إبراهيم مصطفى، ومحمد مهدي مخزومي وغيرهما، على أن هذه الجهود جميعًا لم نفد الإفادة اللازمة من النصوص التراثية التي أشرنا إليها، ولو أنها فعلت لتحقق خير كثير، ولوجد أثر ذلك واضحًا جليًّا على الدرس النحوي العربي بمستوياته المختلفة.
ولربما كان وراء هذا التقصير تأخر ظهور بعض هذه النصوص، فإذا كان كتاب "الرد على النحاة" قد نشر في أواخر النصف الأول من القرن العشرين (1947) فإن كتاب ابن رشد لم يعرف إلا قبل عقد من الزمان (سنة 2000) في طبعة متواضعة، صدرت في موريتانيا، تلتها طبعة أخرى في القاهرة (2002).
ولربما كان أيضًا وراء التقصير الانشغال بالنظريات اللغوية الغربية، ومناهج الدرس اللغوي العربي التي ظهرت مبكرًا مع مطلع القرن العشرين، وما حملته من إبهار غشى العيون، فقد انشغل كثيرون من الباحثين بالمنهج الوصفي، ثم بالمنهج التحويلي التوليدي، وكان من أبرز الأصوات وأكثرها أصالة وعمقًا صوت تمام حسان.
على أن جهود المحدثين في تجديد النحو ظلت في مجملها تتراوح بين اجترار القديم ومقولاته، وأسر الحديث واتجاهاته، ولا أدل على ذلك من أن الجهود المرتبطة بالتراث لم تستطع أن تحدث انعطافًا في مسيرة النحو العربي، أو تحقق نقلة جديدة، كما أن الجهود المتأثرة بالنظريات الحديثة لم تجاوز غالبًا الاستنساخ.
السؤال الغائب
انشغل الباحثون بأسئلة من نوع: هل النحو العربي وصفي - بنيوي، أم معياري تحويلي توليدي؟ هل هو مع دي سوسير، أم مع تشومسكي؟ لكن السؤال الجوهري الذي يقول: ما هي الطريقة التي تبنى بها اليوم نظرية نحوية ولغوية جديدة خاصة بلغتنا، تفيد من تراثنا، وما توصل إليه الدرس اللغوي الحديث في آن معًا؟ ظل سؤالاً شبه غائب. وحتى إذا ما أثير فإن الإجابة عليه لم تتحقق، وذلك يرجع في تقديرنا إلى المزاوجة بين:
1- الإيمان بالتراث والعودة إليه. وليس في ذلك مقارنة؛ إذ المراد ليس الاستحضار والاحتماء، وإنما الإفادة غير بعيد عن المفاتشة والمساءلة.
2- والانفتاح على الفكر اللغوي والنحوي الحديث ونظرياته واستيعابها وتمثلها، ولكن دون انبهار.
ثم يأتي تتويج ذلك باستذكار قول عبقري العربية ابن جني "النحو يصح فيه الاجتهاد، فهو علم متنوع من استقراء اللغة، ومن حق مَن يرى فيه رأيًّا صريحًا أن يقوله، فاللغة لا تغير، ولكن الذي يغير هو ما يستخلصه الباحث من اللغة" واستذكار قول الجاحظ: "ما على الناس شيء أضر من قولهم ما ترك الأول للآخر شيئًا".
إن لما يؤسف له أنه عندما كان النحو في الغرب وصفيًّا شُرِعت النبال والسهام على النحو العربي بأنه معياري، وكيلت له الاتهامات.
وعندما ظهرت التحويلية التوليدية استعاد بعضهم الثقة في النفس، ووجدوا القشة التي يتعلقون بها، وقالوا: انظروا: نحونا نحو تحويلي توليدي!
والحق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فالنحو العربي وصفي معياري في آن واحد، بغض النظر عن تفصيلات في هذه النظرية الغربية وتلك، لكن المشكلة في أن المصطلحات الحديثة التي صكَّها الغالب، بحسب تعبير ابن خلدون، أشد أسرًا وأكثر بريقًا، فالوصف أعلى من الملاحظة والاستقراء، والبنية السطحية والبنية العميقة فوق التقدير والحذف وما يرتبط بهذه المصطلحات من عامل وعلة وغيرهما.
إن النحو العربي الذي ورثناه جهد عظيم، لكنه ليس يظل جهدًا بشريًّا وتاريخيًّا، فليس قولاً فصلاً حتى بالنسبة إلى اللغة التراثية، ولنضرب، مثلاً، على قصور هذا الجهد بالكتاب العظيم الذي ألفه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة "دراسات لأسلوب القرآن الكريم" فقد جاء فيه كثير مما فات النحويين القدامى اعتمادًا على استقراء الأسلوب القرآني، ونحن نعلم كم عنى النحويون بالقرآن الكريم ّ ولنا أن نتخيل حجم العمل إذا ما قلنا إن المتن اللغوي العربي القديم من شعر ونثر لم يتم استقراؤه حتى اليوم استقراءً تامًّا. هذا على صعيد العمل التقعيدي، ويمكن أن نضيف إليه -أيضًا- الاهتمام بالكشف عن التراث الضائع أو المستور، من مثل كتاب "المشرق في النحو" لابن مضاء، الذي يعتقد بعض الباحثين أنه طبق فيه نظريته في النحو الظاهري التي فصلها في كتابه "الرد على النحاة".
خاتمة
وعودًا على بدء فإن أزمة النحو العربي في مجملها هي أزمة العلم العربي الإسلامي، وهذه أيضًا في مجملها هي أزمة "الأمة" وحضورها في العصر.
ومن مظاهر هذه الأزمة ذلك الهجوم (المجنون) على التراث جميعًا، ومنه النحو، فعندما يظهر أناس من أبناء العربية ليؤلفوا في جناية سيبويه على النحو العربي "الرفض التام لما في النحو من أوهام".
وجناية الشافعي "تخليص الأمة من فقه الأئمة" وجناية البخاري "إنقاذ الدين من إمام المحدِّثين" تدرك دون لأَيْ أن ثَمَّ خللاً عميقًا في البنية المعرفية لثقافة الأمة ومثقفيها.
والطريف أن مَن يكتب عن الجنايات لا يستطيع الخروج من أسر هذا التراث ولغته فيلجأ إلى التقليد التراثي بالموازنة بين جزئي العنوان وصياغته سجوعًا!
مثل هذا الفريق لا يكتفي بمهاجمة علم النحو، أو علم الحديث، أو علم الفقه، ولكنه -في علم النحو والعربية تحديدًا- يجعل القواعد شكلاً بلا مضمون، وتعلمها مضيعة للوقت وتشتيت للفكر، ويسمها بأنها معطيات متخبطة، خالية من الدلالة، مليئة بالوهم والحشو، ليخلص من بعد إلى أنه لا يمكن للأمة العربية أن تتطور وتعرف الدقة دون هدم هذه القواعد والتخلص منها.
المصادر والمراجع
ـ ابن جني، الخصائص.
ـ ابن رشد، الضروري في صناعة النحو، تحقيق ودراسة منصور علي عبد السميع، تقديم محمد إبراهيم عبادة، القاهرة: دار الفكر العربي، 2002.
ـ تمام حسان، اللغة العربية: معناها ومبناها.
ـ الحصكفي، حاشية ابن عابدين على الدر المختار.
ـ الزركشي، القواعد.
ـ سناء حميد البياتي، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم.
ـ شوقي ضيف، تجديد النحو، ط4. القاهرة: دار المعارف، 1995.
ـ عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة.
ـ عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز.
ـ عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج. بيروت: دار النهضة العربية، 1986.
ـ محمد عابد الجابري، التجديد في النحو بين ابن مضاء وابن رشد، (بحث في مجلة فكر ونقد، ع49، 50، يونيو 2002).
ـ محمد عيد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، القاهرة: عالم الكتب، 1973.
ـ فيصل الحفيان، مساءلات لزمن غروب العلم العربي، (بحث ضمن كتاب: التراث العلمي العربي.. أسئلة للمستقبل). القاهرة: مكتبة الإمام البخاري، 2010.