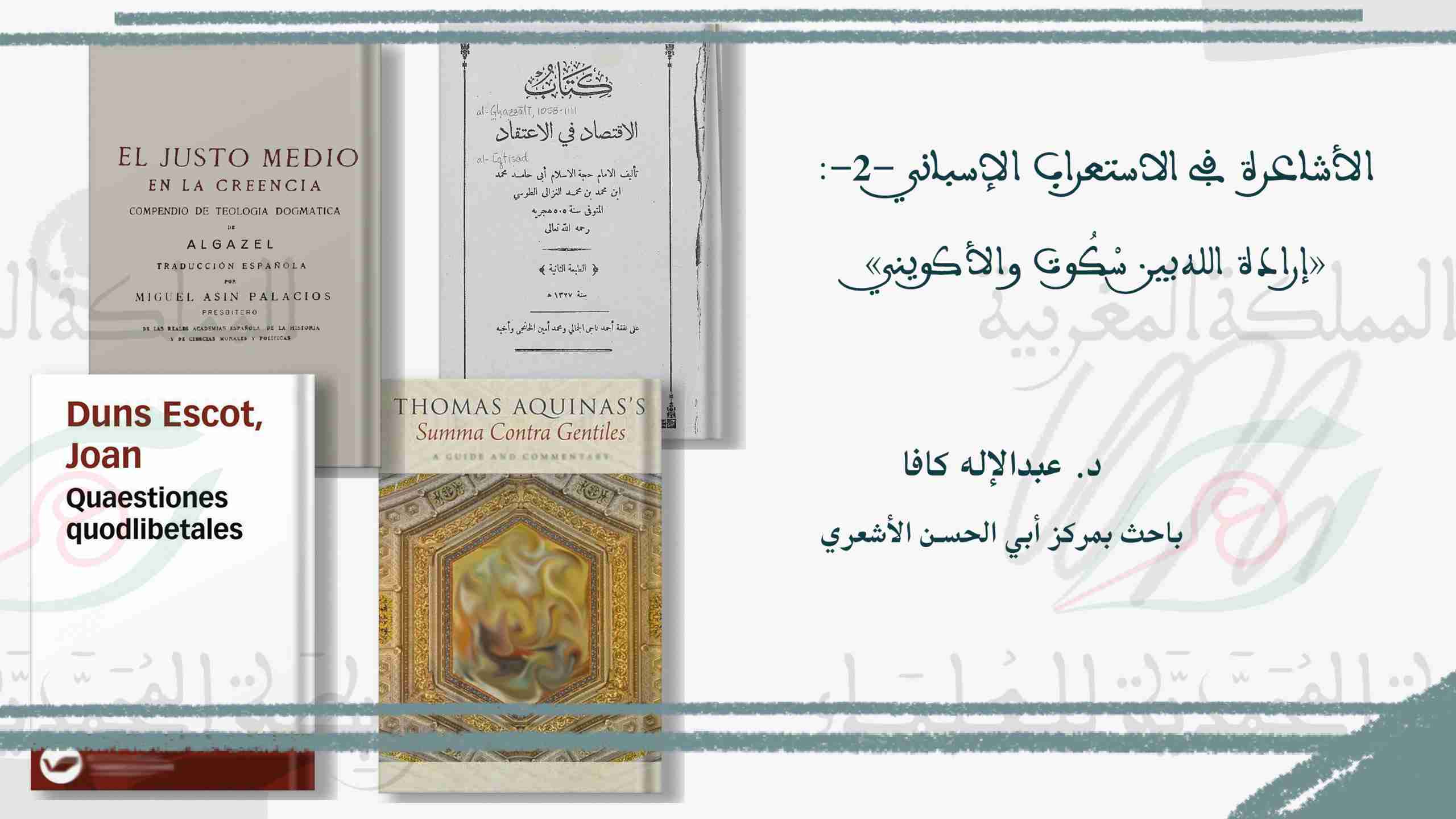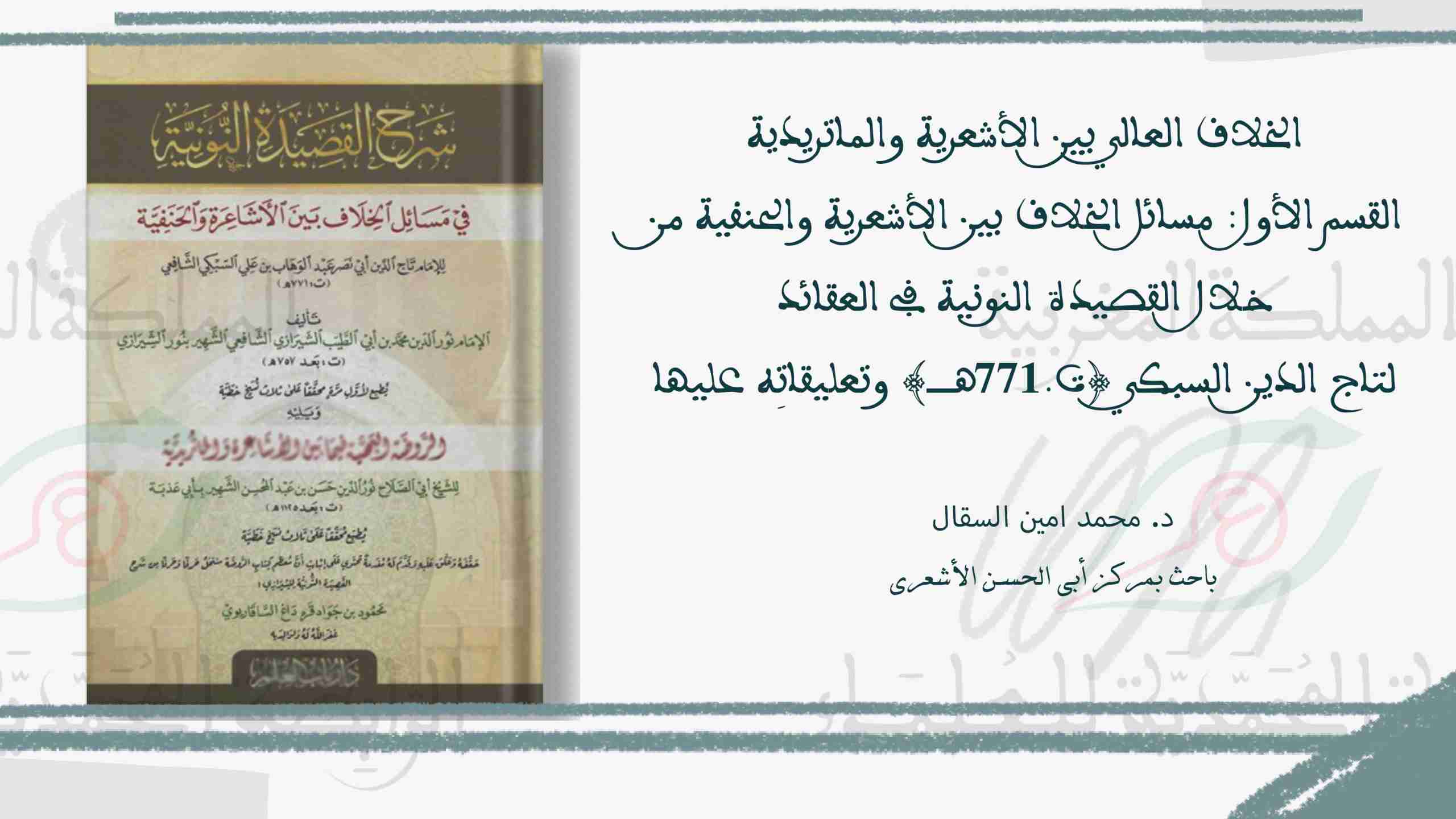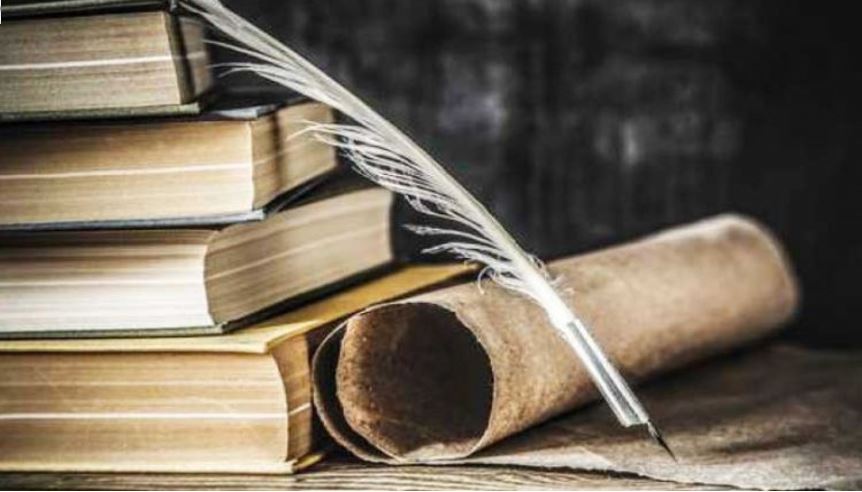من تجليات التداخل بين الأصول والتصوف عند الشاطبي .. نظرة في المقاصد الجمالية

لقد استطاع الإمام النظار أبو إسحاق الشاطبي أن يسبك من منظومة الأصول كليات اعتبرت عنده بمثابة قوانين؛ ليس كونها فقهية استنباطية بأولى من كونها أخلاقية جمالية، فكان كل أصل فقهي عنده إنما وضع، ومن مقاصده، لتوجيه الخلاف بين المجتهدين وحسم مادته وتوحيد قبلتهم في التقعيد للقواعد الأصولية المصبوغة بصبغة المقاصد التربوية الجمالية التي جعل منها المؤطر العام والكلي الحاكم على نظام المجتهد الوجداني وشعوره الإيماني، تخليةﹰ له من الأكدار والأغيار وتوحيدا للوجهة والمقصد وتجميعا للمفترق في الباطن وإقبالا بذل العبودية والانكسار على مقلب القلوب والأبصار.
فصار التداخل، بناء على ذلك، بين الأصول والتصوف عنده بنيويا داخليا؛ أي أن الضوابط الأخلاقية كامنة في بنية القواعد الأصولية تقعيدا وتوظيفا ملازمة لها غير خارجة عنها. ومن تم لم تقتصر نظرياته على خصوصية الفقه الصناعي في شقه الجوارحي، بل تجاوزته لتصير قادرة على احتواء المنظومة الشعورية والوجدانية لدى المكلف. ومن هنا جاء حديثه عن الجمال.
يقدم الباحث في هذه الدراسة إسهاما طيبا يسعى لاستجلاء بعض معالم نظرية الإمام الشاطبي القائمة على مبدأ التكامل المعرفي والتداخل المنهجي بين العلوم، ممثلةً في الأصول والتصوف؛ باعتبار أن الأول منهما خادم للثاني ووسيلة من أهم وسائله الموصلة إليه في الوجدان والضابطة لمقتضياته في السلوك؛ وفي هذا السياق يحاول جاهدا الإجابة على التساؤلات التالية: ما حقيقة هذا التداخل بين الفنين عند أبي إسحاق؟ وكيف تولدت عنه مقاصد الجمال؟ وما تجلياتها على المباحث الأصولية؟
أولا: في حقيقة التداخل العلمي بين العلمين
تتأسس أطروحة التداخل العلمي بين الأصول والتصوف على مسلمتين منهجيتين في منظومة النظر العلمي عند الشاطبي:
أولهما: مسلمة نقد الحشو المعرفي: قوامها أن "هذا العلم؛ (أي الأصول) لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله،وليس كذلك؛ فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له[1]." والنص نقد منهجي بالفعل، كما هو شأن العلوم الذي مثل بها، وبالقوة، كما هو شأن التصوف، للزوائد المعرفية التي أدخلت في العلم وهجرت إليه دون أداء وظيفتها المتناسقة المفضية إلى إنتاج فروع فقهية أو أخلاق جوارحية جمعا بين العلم والعمل ومراعاة لشعور المكلف وسلوكه.
المسلمة الثانية: هي امتداد للأولى، قال مشيرا إلى حقيقتها: "كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية[2]"؛ فالآداب الشرعية، المحتضنة للتصوف، تضاهي الفروع الفقهية في النسبة إلى الأصول، ومن محاله الأصلية التي تتنزل عليها حقائقه. وقد أشار إلى ذلك في موضع آخر إذ قال: "كل مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي؛ وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا[3]"؛ فعمل القلب، وهو محط نظر التصوف من المكلف، مطلوب في علم الأصول كعمل الجوارح، وهو محط نظر الفقه والفروع منه، فموضوعهما معا ومجالهما الرئيس فعل المكلف ظاهرا وباطنا، وهما فيه "شقيقان في الدلالة على أحكام الله[4]" كما قال الشيخ زروق. ومن هنا كان التسليم بصحة الأطروحة رهينا بمجموعة مبادئ يمكن تجميعها في قانونين هما:
1. درء التداخل الهامشي المفارق، الذي لا ينتج، أو المنتج لفرع فقهي وحيد تتوقف عليه صحته كشأن بعض قواعد اللغة والنحو والحساب والحديث...
2. اعتبار التداخل النسقي، الموجب للتسليم بمبدأ الكليات المحتضنة للعلوم الشرعية، والمنتجة لفروع فقهية متوالية مناط تعلقها الجوارح، أو آداب أخلاقية شعورية مناط تعلقها القلوب. ومن هنا كانت كل مسألة أصولية عند شيخ المقاصد جامعة بين دقة المورد العلمي ولطافة المذاق الصوفي. مما أضفى على المنظومة الأصولية مسحة من سراج الجمال التعبدي. فما حقيقة هذا الجمال إجمالا؟ وما هي معالمه عند أبي إسحاق؟
ثانيا: حقيقة الجمال في التصور الإسلامي عموما
الجمال في دلالته الأصلية الابتدائية: الحسن والبهاء والزينة، وإذا تعلق بالإنسان اشترط فيه التناسق والكمال في جميع الأحوال في صيغة كلية لا تقتصر على جزئي من جزئياتها. قال الراغب في نص ناظم: "الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين. والزينة بالقول المجمل ثلاث: زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة، وزينة خارجية كالمال والجاه. فقوله ﴿حبب إليكم الاِيمان وزينه في قلوبكم﴾ (الحجرات: 7) فهو من الزينة النفسية. وقوله ﴿من حرَّم زينة الله﴾ (الاَعراف: 30) فقد حمل على الزينة الخارجية؛ وذلك أنه قد روي أن قوما كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهوا عن ذلك بهذه الآية، وقال بعضهم: بل الزينة المذكورة في هذه الآية هي الكرم المذكور في قوله: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (الحجرات: 13)[5]"، وهو في التصور الإسلامي مقصد أصيل وظيفته خدمة كلي من الكليات المقاصدية الكبرى، كما سنرى بعضا من ذلك مع الشاطبي، وقد تعبر عنه اللغة التجريدية كما قد تعبر عنه اللغة التصويرية، وذلك غالب الشريعة[6] كما هو الحال بالنسبة لمجموع الصور الفنية اللغوية المنظومة في آي القرآن وجوامع كلم النبي، صلى الله عليه وسلم[7]، وكذا الصور التجسيمية إذا أمنت الوقوع في خرم أصول العقيدة وقواعد التوحيد. فتحريم الصور المنحوتة في قوانين التشريع الإسلامي إنما يرجع إلى بعده الوظيفي في المآل المشخص في قاعدته الجزئية "سد الذريعة"؛ لأن شيئا من الجمال فيها المحكوم بجلال الله تعالى المستأثر به قد تحدث محاكاته زيغا عقائديا شعوريا! فليس شيء من التحريم راجعا إلى ذات الشيء وماهيته، كما ادعى بعضهم، وإنما هو عارض عروض المآل لأصل الحال[8].
والجمال في التصور الإسلامي سواء تعلق بصورة الإنسان أم بفعله ونظامه النفسي أم بنعم الله الوجودية في الخارج، كل ذلك لا يخلو من تأطير نوعين من الإرادة مرتبطين بمشيئة الله في خلقه هما: إرادة التكوين إرادة التكليف. فما كان من الأولى فهو راجع إلى إرادته سبحانه الكونية القدرية المتعلقة بربوبيته وخلقه. وما كان من الثانية فهو راجع إلى إرادته الأمرية التشريعية المتعلقة بألوهيته وشرعه. فالإرادة القدرية الخلقية هي "المتعلقة بكل مراد؛ فما أراد الله كونه كان، وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه... والإرادة الأمرية هي المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه. ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه... وكذلك النهي يحب ترك المنهي عنه ويرضاه[9]، مما أعطى للحقيقة الجمالية بعدين تشكلا في شكل نوعين، هذه فذلكة بيانية لحقيقتهما نمهد بها للوصول إلى المقصود:
1. في الجمال التكويني (الابتلائي)
جمال التكوين هو أسباب الزينة التكوينية الابتلائية الموضوعة سببا للاستمتاع على الإطلاق، بناء على أن "الأسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد وامتحانا لهم، فإنها طريق إلى السعادة أو الشقاوة[10]"، فهو من المصالح المطلقة الراجعة إلى قصد الشارع الابتدائي قبل تصرف المكلف، قال الشاطبي: "فالرب تعالى قد تعرف إلى عبده بنعمه وامتن بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق[11]"، لكنه مسيج بغطاء مشيئة الله في خلقه بقصد ابتلائهم واختبارهم قضاء وقدرا. وعلى هذه النوع من الجمال وضعت أصول النعم في الكون ابتداء؛ قال تعالى: ﴿اِنا جعلنا ما على الاَرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا﴾ (الكهف: 7). وقال سبحانه: ﴿زيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة...﴾ (ءال عمران: 14). وقال جل وعلا: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ (الكهف: 45). وقال أيضا: ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين﴾ (الملك: 5). وقال أيضا: ﴿قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ (الاَعراف: 30)، إلى غير ذلك مما شاكلها... قال ابن القيم في تعليقه على الآيات "فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه للابتلاء[12]". وقال سيد قطب مقررا هذه الحقيقة: "ونظرة إلى السماء كافية لإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء الكون وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق، وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي وأن تصميمه قائم على جمال التكوين... فكل شيء فيه يؤدي وظيفة بدقة وهو في مجموعه جميل[13]". وقد أشار أستاذنا الأنصاري، رحمه الله، إلى هذه النكتة بإشارة لطيفة فقال: "فالزينة الكونية مبعث وجداني للتحلي بالزينة الإيمانية[14]". والكون هنا، كما ترى، ليس بمعناه الفيزيائي الضيق فقط ولكن بمعناه الابتلائي الرمزي الراجع إلى القضاء والقدر بدليل مقابله وهو "الزينة الإيمانية". ثم لأن الجمال التكويني لابد وأن تكون أشياؤه التي يزدان بها الناس، كما قال الشيخ ابن عاشور: "مغايرة لهم منفصلة عنهم ومثله قولنا: ازدان البحر بأضواء القمر[15]". قال الدكتور توحيد الزهيري في تعليقه على آية الزينة السالفة في سورة الكهف:"بنص هذه الآية نعلم أن الجمال الذي تبديه الأشياء هو حقيقة موضوعية توجد خارج النفس الإنسانية وتستند إلى عمل الهي هو "التزيين". والغاية منه هو الابتلاء[16]". والجمال التعبدي شرارة من باطن العبد متصلة به غير منفصلة كما سيأتي.
2. في الجمال التكليفي (التعبدي)
يعتبر جمال التكليف من لوازم عبادة المؤمن الاختيارية والخروج من عبودية الاضطرار، والتحلي بزينة أصل الإيمان حقيقته المجسدة له كما قال تعالى: ﴿ولكن الله حبب إليكم الاِيمان وزينه في قلوبكم﴾ (الحجرات: 7). والباعث على ذلك؛ الحمد والشكر على النعم الموضوعة في الكون أسبابا تكوينية لذلك. ومن هنا قالوا في تعريف الحمد، لمناسبته له، إنه: "الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم[17]"، بل الحمد هو مركز بؤرة هذا النوع من الجمال وقطب رحاه وإليه ترجع جميع تجلياته، فلا يزال العبد من خلاله يترقى "من معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومن هاهنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله[18]". والشكر أخوه[19] في هذا الميدان. قال ابن القيم: "فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده فإنه من الجمال الذي يحبه وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن[20]."
إن حقيقة الجمال التعبدي رهينة بوجود منازل الإسلام أو عزائم العلم، بتعبير الشاطبي، وهي مجموع المقامات والأحوال التي يتقلب فيها قلب السالك إلى الله فيرحل من منزلة إلى منزلة ويذوق من حلاوة مراقيها ويشرب من شريعتها الصافية كأسا لا يظمأ بعدها أبدا. وإنما خص الشكر والحمد ببيان الحقيقة الجمالية، وإن كان الجميع ينضوي تحت حقيقة "منازل الإيمان" أو "كليات عزائم العلم"؛ لأن لهما، دون الباقي، خصوصيةً جماليةً في نفس الخصوص تظهر في كونهما النافذة الأولى التي يطل منها العبد بقلبه على منظومة الجمال التكليفي التي يقع فيها الحراك الجمالي الخاص. ولهذا السر كان حدها عند العلماء قد روعي فيه التداخل الاصطلاحي والمفهومي مع الحقيقة الجمالية عموما كما يظهر من تعريف ابن القيم وغيره. وقد اتخذ أبو إسحاق من هذه المنازل مشيمة لتغذية شعور المجتهد السالك إلى الله، ومساطر لنحت منظومة المقاصد الجمالية وهو سر مشروعه الإصلاحي الأصولي ولب خصائصه الجوهرية.
ثالثا: في جمالية منازل الإيمان وتأصيل الأصول عند الشاطبي
تعتبر الكلية الحاكمة التي وجهت البحث في الأصول عند أبي إسحاق ومن أهم المعايير المنهجية والموضوعية التي خلخل بها موازين المنظومة الاجتهادية.
والأصل في هذه الجملة، عنده، قول الله تعالى: ﴿ولكن الله حبب إليكم الاِيمان وزينه في قلوبكم﴾ (الحجرات: 7)؛ فقد أخبر عن زينة أصل الإيمان في قلب عبده المؤمن فيشمل ذلك زينة منازله التي يتجلى فيها ويتقلب في مدارجها؛ إذ إن أصل الإيمان كلي قطعي من الكليات المنزلة بمكة، وأما تزيينه فمن المكملات التي جاء بها القرآن المدني ليكتمل نظام الإيمان في شعور المسلم ويتحقق في سلوكه إلى أقصاه كسائر جميع المكملات والمتممات. قال: ".. وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح، والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا في المدني، فالأصل وارد في المكي والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد، ويكون ما زاد على ذلك تكميلا[21]". والقناة الابتدائية الموصلة إليها في الوجدان عنده، كما سبق أن بينا في التصور الإسلامي عموما، هي الشكر أو الحمد، فهما الموزع لمعاني الجمال على باقي المنازل كالإخلاص والصدق والإيثار والمحبة... ومنهما تتناسل حقائق الجمال التي تثيرها حركة النعم الخارجية في وجدان المؤمن.
قال مشيرا إلى ذلك في نص مجمل: "هذه النعم هدايا من الله للعبد وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟! هذا غير لائق في محاسن العادات ولا في مجاري الشرع؛ بل قصد المهدي أن تقبل هديته. وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه، فليقبل ثم ليشكر له عليها[22]". فهذه النعم من جملة الزينة التكوينية الموضوعة كذلك في الكون للدلالة على المنعم؛ أي وضعت على نهج الشكر الذي يقود إليه، وقد بين ذلك في نص يفسر السابق فقال: "تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه إما في جهة تناوله واكتسابه وإما في جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. وفي ذلك قال تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ (الاَعراف: 30)[23]". فأنت ترى، إذا نظم النصان معا في سلك واحد، مناسبة الشكر، باعتباره القناة الأساسية في الوجدان للجمال التعبدي، للاستمتاع بالزينة الكونية الراجعة إلى الجمال الابتلائي القدري، حيث تشير الآية إليه، وخضوعهما في شعور العبد لنسق واحد. وإنما جعل هذا لخدمة ذاك وتخليصه من التبعات التي تعلق به في الدنيا والآخرة. قال في سياق المقابلة بين النوعين بعد سرده لآيات الزينة والجمال: "فامتن تعالى وعرف بنعم من جملتها الجمال والزينة وهو الذي ذم به الدنيا في قوله: ﴿اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة﴾ (الحديد: 19)... بل حين عرف بنعم الآخرة امتن بأمثاله في الدنيا... وهو كثير. فأنزل الأحكام وشرع الحلال والحرام تخليصا لهذه النعم التي خلقها لنا من شوائب الكدرات الدنيويات والأخرويات[24]"؛ فهذه النعم بدون خضوع لقوانين الامتثال التكليفي التعبدي تصير أشباحا بلا أرواح ورسوما بلا عنوان يترجم حقيقتها ووظيفتها ويضفي عليها جمالها ورونقها. أو بعبارة العلامة النورسي: "تنتكس منقلبة على عقبها من نفاسة الألماس الثمين إلى خساسة قطع الزجاج المنكسر![25]."
إن نظرية الجمال عند أبي إسحاق إذا ارتبطت بحقيقة الكليات الأصولية صار لها محطتين مركزيتين في ذوق الناظر:
أولها: صورة النعم الخارجية الماثلة في الكون وهي حقيقة الجمال التكويني الذي وضعه الله ابتلاء للعباد كما سبق، فلا يتعلق بها مدح أو ذم قبل التكليف بمقتضياتها الراجعة إلى قانون الانتساب الإيماني، قال: "... ولذلك ترى النعم المبثوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها، من حيث هي، مدح ولا ذم ولا أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات المكلفين فيها، وتصرفات المكلفين بالنسبة إليها سواء؛ فإذا عدت نعما ومصالح من حيث تصرفات المكلفين فهي معدودة فتنا ونقما بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضا[26]."
والثانية: حركة الانفعال الوجدانية الناتجة عن التأثر بالصورة، ومناطها الشكر الراجع إلى زينة أصل الإيمان وحسن تزيينه في باطن المجتهد الرباني، ومنه تتفرع منازله. وقد ألمح بلمحة إلى ذلك في سياق آخر فقال: "ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها؟... وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور، لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور حتى إنه وضع لأهل الامتثال الثائرين على المبايعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء حتى يكون سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبل تحمله إلا بالمشقة المنهي عنها. فإذا سقطت سقط النهي[27]". واعتبرت هذه المحطة عنده هي مظهر الجمال التعبدي وحقيقته لكن سيقت بمساطر علمية منضبطة هي مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه وكلياته الكبرى. وقد ترتب عليها مجموعة من المرتبات الاجتهادية كانت أبرزها تلك التي لاحت بحقيقة المجتهد المفتي السالك درب الرفق بالمكلفين في الفتوى،كما هو أصل الدين عموما، قال في الاعتصام: "فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه ولا يكون هذا مع شرعية المشقات. وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع، الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب، كان مكروها؛ لأنه على خلاف وضع الشريعة فلم ينبغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه[28]". فكان من تحققت فيه هذه السمة عند أبي إسحاق جديرا بأن يكون "منارا يهتدي به الناس[29]". بيد أن هذه المرتبة الرفيعة والمنزلة الحميدة الخاصة بالمفتي الرباني راجعة إلى الترقي في مقامات العبودية إلى أقصاها وأن تجلي الأحوال ليس كافيا لتحصيلها لصعوبة موردها؛ "لأن الأحوال من حيث هي أحوال لا تطلب بالقصد ولا تعد من المقامات ولا هي معدودة في النهايات ولا هي دليل على أن صاحبها بالغ مبلغ التربية والهداية والانتصاب للإفادة[30]"؛ فكان لابد من التقلب في جمالية تلك المقامات والترقي فيها؛ لأن ذلك أدعى لتحصيل الربانية في العلم، حيث انطباعها في النفس من غير مخالفة، آنئذ تسيل القلوب إلى المفتي، بما هو عبد لله، طلبا للاقتداء طوعا، فتبزغ جمالية حقيقة الانتصاب طبعا! لأن "التأسي بالأفعال بالنسبة إلى من يعظم في الناس سر مبثوث في طباع البشر لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال، لاسيما عند الاعتياد والتكرار وإذا صادف محبة وميلا إلى المتأسي به[31]". ولأن تلك الخصائص إذا صارت هي حاله صار" وعظه أبلغ وقوله أنفع وفتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك؛ لأنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه واستنارت كليته به وصار كلامه خارجا من صميم القلب والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب. ومن كان بهذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر: 28) بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه وإن كان عدلا وصادقا وفاضلا لا يبلغ كلامه من القلوب هذه المبالغ، حسبما حققته التجربة العادية "[32]."
إن تجلي تراتبية أسباب النظر الاجتهادي في علاقته بتلك المقامات والأحوال السنية المرضية عند أبي إسحاق؛ إنما هو رهين بتنوعها متلون بألوانها، آخذ من زينة كل منزلة بشبه ومن حلية كل مرتبة بقبس، بحسب درجة قوة النور الرباني المقذوف في كل واحدة منها الحاكم عليها في سلم الارتقاء الإيماني الموضوع سببا للوصول. فتراها تعرض للمجتهد الرباني تارة أحوالا يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار! وتارة تصير له مقاماتٍ تتصف بها نفسه وتنطبع في نظام وجدانه مرايا للنعم الوجودية التكوينية، فيتوسم بها ويتفرس ويقذف بقوانين الأحكام على وزان النفوس، ويداوي كل نفس بحسب ما يليق بها في مراتب الاعتناء التربوي والأخلاقي وبحسب ما يعرض لها من أدواء ووساوس. فلا يزال، لهذا الدافع، المجتهد في ترقٍّ دائم عبر مراتب الكمال؛ لأن "النفوس قد تستنقص الإقامة ببعض المراتب مع إمكان الرقي، وتتحسر إذا رأت شفوف ما فوقها عليها كما يتحسر أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا مراتب الكمال[33]". قال منوها بمن ذاق حلاوتها: "وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا الشدائد وحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم من إتلاف مهجهم إلى ما دون ذلك وطالت عليهم الآماد حرصا عليها واغتناما لها طمعا في رضا المحبوبين واعترفوا بأن تلك الشدائد والمشاق سهلة عليهم بل لذة لهم ونعيم وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم أليم[34]". وقال في سياق جدلي حول إثبات تفاوت هذه المراتب: "فإن قيل: هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال، وقد تقدم أن مراتب الكمال لا نقص فيها. فالجواب أنه ليس بإثبات نقص على الإطلاق، وإنما هو راجح وأرجح وهذا موجود. وقد ثبت أن الجنة مائة درجة، ولاشك في تفاوتها في الأكملية والأرجحية[35]."
وإذ قد ظهرت معالم نظرية الجمال التعبدي عند أبي إسحاق؛ فما هي بعض الأمثلة الإجرائية الموزعة لحقيقتها على مباحث العلم عنده؟
رابعا: نماذج تطبيقية لتنزيل النظرية (جمالية فاعلية القصد الشرعي اُنموذجا)
المقاصد جواهر الأحكام وأرواح الأعمال، والفعل إذا تجرد عن القصد الشرعي صار رسما بلا عنوان وشبحا بلا روح. وتلك قضية تجري على رسم البديهيات في أصول الفقه وكلياته، بيد أن المقصود هنا هو ذلك القدر الزائد على مجرد الامتثال للأحكام الحاملة لتلك الحكم والمقاصد؛ ومعناه الوقوف معها والاستجابة لها من حيث هي أسرار ربانية ومعاني إيمانية وعلامات تعريفية بالله تعرف به وتدعو إلى النهوض من أجله وشكره على آلائه ونعمه. فذلك نظر في حكمة الحكم مربوطة بالحاكم سبحانه لا بالحكم الحامل لها. وقد أشار العلامة ابن القيم، رحمه الله، بإشارة لطيفة تقرر هذا المعنى في سياق شرحه لكلام صاحب المنازل، فقال: "فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي للإيمان بها علما وعملا، فيقصد إجابة داعيها. ولكن مراده بداعي الحكم؛ الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال؛ فإنها تدعوا إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الامتثال وما تضمنه من الحكم، والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة[36]."
فمراعاة الغايات، باصطلاح ابن القيم، أعم من مراعاة علل الحكم، وإن كانت هذه جزءا من تلك؛ لأن العلة مرتبطة بالحكم عند الجلب أو الدفع في العملية القياسية، فذلك نظر فقهي محض مبني على صحة أو فساد القياس بمعناه المعياري الجزئي، كما هو متداول في الأدبيات الأصولية، بينما الغايات، وهي مقاصد الشريعة العامة، غير ذلك؛ إذ توقف العبد على الأسرار التعبدية والمعاني الأخلاقية الكلية المنتصبة مسباراتٍ تربوية لتشريح أفعال الإنسان القلبية زمن الدخول في المنظومة التكليفية من أجل الامتثال للحكم الخاص وحكمته الجزئية المتعلقة به وهي علته. فهي أعم وأهم. ومجالها مستقر الإيمان ومستودعه هناك يوجد " منادٍ ينادي للإيمان بها علما وعملا " كما قال، وعلى قدر إجابتها يكون ترقي المؤمن في مدارج السالكين، ومن هنا جماليتها.
وأما أبو إسحاق فقد أومأ إلى هذا المعنى الغريب في سياق حديثه عن تجاذب الفعل بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية، مما سنفصل القول فيه بعد، حيث قال: "فإذا وقع؛ (أي العمل) على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقا... وينبني عليه قواعد وفقه كثير:
من ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة[37]". فأنت ترى أن المقاصد الأصلية، وهي غايات الحكم المرادة من تشريعه، إذا صارت هي قبلة المكلف في عباداته ومعاملاته ترتب عليه إخلاصه لله ونفي الشركة عنه وهو فعل قلبي تعبدي ومنزلة إيمانية من منازل القلب في عروجه إلى الله. ومن ثم كانت قطعة من منظومة الجمال التعبدي في باطن الإنسان المؤمن ووجدانه. وصارت هي المعيار الأساسي لتصحيح الفعل الإنساني أو إبطاله؛ لأن حقيقتها مراعاة الدار الآخرة، وإن صحت في ميزان القوانين الفقهية المادية الدنيوية. قال وهو يحس بنوع من التفرد في التأصيل الفقهي: "حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع فإن ما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء، وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب... فكل ما خالف قصد الشارع فهو باطل بإطلاق لكن بالتفسير المتقدم والله أعلم[38]"؛ أي بالتفسير الذي يستحضر جانب الثواب وهو أثر أخروي. وهو شعور ينساب برفق من زينة أصل الإيمان وحسن تزيينه في باطن العبد المكلف.
تلك كانت حقيقة جمالية فاعلية القصد عند أبي إسحاق على الإجمال؛ إذ تصير المقاصد الإيمانية العامة والمعاني الكلية الربانية هي الموجهة للفعل البشري علما وعملا. مما يضفي على العمل التكليفي طابعه الرباني الإيماني، وتخرج بالفعل الإنساني من متابعة القوانين الدنيوية البحتة فقط إلى مراعاة مقامات الإيمان ومراقي الإحسان وتخليصه من شوائب الكدرات المهلكات إلى جمالية الحقائق المنجيات. هذا عموما وإليك التفصيل:
1. في فاعلية المقاصد الأصلية
وهي أصول المقاصد التي "لا حظ فيها للمكلف وهي الضرورات المعتبرة في كل ملة[39]"،وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وحفظها حاصل من جهة كونها عينية وكفائية؛ أي لخدمة مصالح الفرد والجماعة "حتى تحصل المصلحة للجميع[40]"، ومن هنا كانت مجردة عن الحظ أي لا منفعة مادية للمكلف فيها بالقصد الأصلي من حيث هي أصول تعبدية خالصة، وذلك ظاهر بالنسبة للفرد من مثل جميع "فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية: من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك[41]". وأما بالنسبة للجماعة، خدمة لمقاصد الواجب الكفائي، فمن جهة "أن القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك[42]" وذلك مثل سائر "الولايات العامة: من الخلافة والوزارة والنقابة والعرافة والقضاء وإمامة الصلوات والجهاد والتعليم وغير ذلك...[43]"، هكذا ظاهر الأمور إذا نظر العبد إلى الأمر والنهي ممتثلا لمقتضياتهما وقافا عند حدود قصد الشارع فيهما دون أدنى التفات إلى شهوة أو وطر! بيد أن رحمة الرحمن الرحيم اقتضت استجلاب حظ المكلف استتباعا؛ إذا سار على النهج السابق غير مبالٍ بغيره بناء على أن "ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني من الشارع[44]". وسواء علينا أتعلق الأمر بالحظوظ المادية النفعية أم بالحظوظ الإيمانية النابعة من معين الروح المتفجرة جداول رقراقة وأزهارا يانعة في باطن العبد الرباني مثل "ما جعل لهم من حب الله وحب أهل السماوات لهم ووضع القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم، وما يخصون به من انشراح الصدور وتنوير القلوب وإجابة الدعوات والإتحاف بأنواع الكرامات وأعظم من ذلك ما في الحديث مسندا إلى رب العزة " من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة[45]"[46]"، وذلك كله هبة من الله للعبد وهدية منه إليه كما يفيده قوله "من الشارع" في النص السابق قبل هذا.
هذا كله، كما ترى، ناتج عن جعل المقاصد الأصلية قبلة المكلف في سيره إلى الله، فتكون هي سفينة النجاة حينما تتكاثر النيات وتتشعب طرقا ملتوية في بحر الإرادات، حتى إذا ارتقى على متن صهواتها العبد الحائر في الفلك السائر؛كان قد حصل على أمانه، أولا، من اختطاف أمواج النزوات والرغبات المرعبة! ثم جال، ثانيا، بجوانحه المطمئنة في فضاء أسرارها، هنالك يصادف معارج الإيمان فيتنسم من صفو عليلها قطعا تنشل رئتيه من حريق التيه القاتم ! وقد جاء السياق ببعض أمثلتها من مثل:
أ. منزلة الإيثار؛ ومعناه "تقديم حظ الغير على حظ النفس وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل[47]"؛ وهو راجع في ماهيته إلى نوع المقاصد الكفائية التي يكون العبد فيها "وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر ولا يذخر لنفسه من ذلك شيئا... إما لعدم تذكره لنفسه لاطراح حظها حتى يصير عنده من قبيل ما ينسى، وإما قوة يقين بالله لأنه عالم به وبيده ملكوت السماوات والأرض وهو حسبه فلا يخيبه، أو عدم التفات إلى حظه يقينا بأن رزقه على الله. فهو الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه أو أنفة من الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى أو لغير ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال. وفي مثل هذا جاء: ﴿ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ (الحشر: 9)[48]". فهذا راجع إلى الوقوف على باب الخدمة، فلا يتجاوز صاحبه حدود الأوامر والنواهي ومقاصدها الشرعية الموضوعة علة شرعية أو غاية ربانية لها جلبا ودفعا. بغض النظر عن حظه؛ لأنه رخصة عنده ولا عبرة بها قبالة هذه العزائم العظيمة؛ لأنه "يرى تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه. فإذا دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها وهؤلاء هم أرباب الأحوال[49]."
ب. ومنها أيضا منزلة الإخلاص؛ لأن "المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبر في وجه محض العبودية[50]".
إن الإخلاص، بما هو مرتبة من المراتب العالية في الإسلام، لهو غاية العبد السالك إبان دخوله في الامتثال للأمر أو لعلته. فهاهنا عندنا أمران: علة الأمر التي تحتويها المقاصد الأصلية. ثم غايته الإيمانية التي قد يصادفها العبد تبعا؛ إذ "يتأتى تخليصه من الحظ[51]"، وقد تكون قبلته أصالة فلا يتحرك إلا من أجلها. فيكون عمله، بالإضافة إلى كونه موافقا فيه قصده قصد الشارع، مرادﹰا به التعبد المحض ليصير صحيحا في قوانين النظر الفقهي الصناعي؛ أي في الدنيا، وفي ميزان المطالب الأخروية. وهذه خاصيته المميزة له عن سير سائر العباد العادي. وقد نص أبو إسحاق على ذلك؛ إذ قال: "فإذا اكتسب الإنسان امتثالا للأمر أو اعتبارا بعلة الأمر، وهو القصد إلى إحياء النفوس على الجملة وإماطة الشرور عنها كان هو المقدم شرعا "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول[52]"، أو كان قيامه بما قام به قياما واجبا مثلا. ثم نظره في ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعض؛ كمن يقصد القيام بحياة نفسه من حيث هو مكلف أو بحياة من تحت نظره. وقد يتسع نظره فيكتسب ليحيي به من شاء الله. وهذا أعم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجر؛ لأن الأول قد يفوته فيه أمور كثيرة وتقع نفقته حيث لم يقصد ويقصد غير ما كسب، وإن كان لا يضره أنه لم يكل التدبير إلى ربه. وأما الثاني فقد جعل قصده وتصرفه في يد من هو على كل شيء قدير، وقصد أن ينتفع بيسيره عالم كبير لا يقدر على حصره. وهذا غاية في التحقق بإخلاص العبودية ولا يفوته من حظه شيء. بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه[53]."
فكلا النوعين من العباد انطلق في نوع عبادته مراعيا لعلة الأمر الراجعة إلى القصد الأصلي عموما، بيد أن نهاية السير لم تكن على وتيرة واحدة كما ترى في النص؛ لأن أحدهما قد جعل الغايات هي وجهة سيره، فتجشم مشقة حمل الأعباء و الآخر "ضعيف المنة عن حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في قطع مسافات النفس أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية أو راضي بالأوائل عن الغايات[54]"؛ لأن المراعي للمقاصد الأصلية قد أخذ مقتضى الأمر والنهي من تلك الجهة فوافق قصده قصد الشارع قطعا الذي هو "نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ[55]". فكان بهذا الاعتبار الآخذ في تحصيله عما قريب يقتطع له قبسا من ذلك النور "آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع، فهو حرٍ أن يترتب فيه الثواب للمكلف على تلك النسبة[56]". وهذا كله بخلاف القصد التبعي؛ لأن العامل فيه و إن صادف قصده قصد الشارع، حيث يظهر مع الأول على قدم واحدة، إلا أنه قاصر عن إدراك الغايات؛ إذ الطريق واحدة والنية فيها متشعبة الاتجاهات، وكيف لا؟! والأول قد وحد النية وجمع شتاتها وقافا بها عند حدود قصد التعبد، والآخر استولت عليه نيات الحظ فلا يدرك من مقاصد التعبد إلا ما صادفه تبعا في الطريق؟ فيكون عمله مشوبا مختلطا وليس خالصا مطلقا، فكيف يصل إلى الغايات؟! وكيف يترقى في الدرجات؟!
2. في توجيه المقاصد التبعية
المقاصد التبعية هي "التي روعي فيها حظ المكلف. فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات[57]"؛ أي أن حقيقتها راجعة إلى مراعاة قصد الحظ بالأصالة في مقابل قصد التعبد، حيث يتحقق ذلك في نيل منافع الإنسان في الدنيا و منافعه الروحية في الآخرة، وكلاهما داخل في مسمى الحظ. فخلق الله له بواعث لتحقيق ذلك كله من مثل "شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه. وكذلك خلق الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها... ثم خلق الجنة والنار وأرسل الرسل مبينة على أن الاستقرار ليس هاهنا وإنما هذه الدار مزرعة لدار أخرى وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حدَّه الشارع أو بالخروج عنه، فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض... فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله"[58]. بيد أن هذه الملذات والشهوات إنما وظيفتها خدمة المقاصد الأصلية فلذلك جعلت حقائق تبعية في مملكة الإسلام وجعلت الأخرى هي أصول الشريعة. وسير المكلف في عباداته ومعاملاته ومراتب جزائه بحسب قصده إليها على ما يقتضيه قانون الاختيار في التكليف بالمصالح الذي جاءت الشريعة لرسمه طريقا لها في الحكم ابتداء. قال: "فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها. ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة ﴿والله يعلم، وأنتم لا تعلمون﴾ (البقرة: 214) ولو شاء الله لمنعنا في الاكتساب الأخروي القصد إلى الحظوظ فإنه المالك وله الحجة البالغة ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا وعجل من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به. فبهذا اللحظ قيل إن هذه المقاصد توابع وإن تلك هي الأصول. فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية. والثاني: يقتضيه لطف المالك بالعبيد[59]."
لقد صارت المقاصد التبعية، بهذا اللحظ، ليست منافع شهوانية ولا تمتعات غرائزية فحسب؛ ولكن قنوات فطرية في الإنسان استقرت في سجيته لتكون كالدليل على معرفة الصانع والتعريف به سبحانه؛ لأن وجوه تلك التمتعات، كما قال: "هيئت للعباد أسبابا خلقا واختراعا فحصلت المنة بها من تلك الجهة[60]". فلا يجد المكلف بدا من الوقوف على باب الخدمة والخضوع المطلق لمالك التصرف المطلق؛ حيث يترقى بفعل جوارحه وتحويل طاقاته من محض قضاء الوطر الناتج عن "لطف المالك بالعبيد[61]" إلى صيرورته خادما طيّعا في يد مولاه يستنير في درب سيره بنور المقاصد الأصلية الراجعة إلى "محض العبودية[62]" و(إكسير) الإخلاص؛ وهو المحرك الأول لموازين الوجدان وأفعال القلوب كما تبين في غير ما سياق.
والنعم المباحة في الأصل هي خير ترجمة لهذا التوجيه؛ بتفعيل النية السليمة من الشوائب، بخلاف المباح العرضي الراجع إلى العفو ورفع الحرج وتلك حقيقته. قال في سياق بيان منازل الطاعات الناتجة عن تفعيل النوعين معًا، لكن مع اعتبار الفرق بينهما مفهوما ووظيفة: "الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب؛ وذلك أن ما كان خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه؛ فإن الأكل والشرب والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري، لا فرق في ذلك بين كون المتناول في الرتبة العليا من اللذة والطيب، وبين ما ليس كذلك؛ وليس بينهما تفاوت يعتد به إلا في أخذه من جهة الحظ، أو من جهة الخطاب الشرعي؛ فإذا أخذ من جهة الحظ؛ فهو المباح بعينه، وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي؛ فهو المطلوب بالكل؛ لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب، وطلبه بالقصد الأول، وهذا التقسيم قد مر بيانه في كتاب الأحكام.
فإذا ثبت هذا؛ صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة؛ إذ ليس بينهما إلا قصد الأخذ من جهة الحظ أو من جهة الإذن، وأما ما كان خادمًا لمطلوب الترك، فلما كان مطلوب الترك بالكل؛ لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب الفعل؛ لأنه إنما ينصرف إليه من جهة الإذن وقد فرض عدم الإذن فيه بالقصد الأول، وإذا أخذ من جهة الحظ؛ فليس بطاعة، فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة؛ فاللعب مثلًا ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها؛ فإن هذا داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما دار بها، بخلاف اللعب، فإنه داخل بالمعنى في جنس ما هو ضد لها، وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة، لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة، وقد مر بيان ذلك. وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح؛ فإن من الناس من يقول: إنه ينقلب بالقصد طاعة، وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق فيه إن شاء الله[63]."
إن توجيه المقاصد التبعية (أو قصد الحظ) لخدمة المقاصد الأصلية (أو قصد التعبد)؛ معناه ترقي المكلف عبر مراقي الإسلام ومدارج الإحسان المنبثقة من زينة أصل الإيمان في قلبه والدخول المباشر، عبر أفعال الجوارح، في قانون الامتثال الجالب لصفاء العمل من الأكدار المغبرة في وجه محض العبودية، تماما كما ترى في النص؛ إذ النوع الأول من المباح ارتقى إلى أن يصير منازل من الطاعات بحسب قوة النية الحاملة للمكلف على الانتقال، القادرة على تفعيل العمل وتسديده؛ مع اعتبار الخدمة للمقاصد الأصلية، فكان تعاطيه له، بذلك الاعتبار، لا يجوز الزهد فيه؛ لأنه خرم لميزان الأولويات في منازل التعبد. وأما الثاني؛ أي المباح العرضي، فإنما كان حريا بعدم المداومة عليه؛ لأنه بها أقرب إلى هدم مقصود الشارع، فكان تفعيل القصد فيه من جهة عدم الفعل وهو الأولى فيه؛ حيث يؤطر تحت منزلة الزهد والورع كسائر المتشابهات الموقعة في المحظور وهو قبس منها. قال يؤكد ما وصل إليه: "لذلك صار ما فيه حظ العبد محضا، من المأذون فيه، يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا، فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به. فإذا تلقى الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد، صار مجردا من الحظ. كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه تجرد عن الحظ. وإذا تجرد من الحظ ساوى ما لا عوض عليه شرعا من القسم الأول الذي لا حظ فيه للمكلف[64]."
فهذا كله إذا جعل للحظ معنى ماديا صرفا راجعا إلى ذات المكلف في دار التكليف، وأما بالمعنى الأخروي فلا يسمى، في حقيقة الأمر، حظا وإن احتواه اللفظ المشترك ظاهرا؛ لأنه "حظ أثبته الشرع حسبما تقدم. وإذا ثبت شرعا فطلبه من حيث أثبته صحيح؛ إذ لم يتعد ما حده الشارع، ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره ولا قصد مخالفته[65]". وإنما الحظ إذا أطلق في حقيقة التعبد فالمقصود به "التنعم في الآخرة بالنظر إلى محبوبه والتقرب منه والتلذذ بمناجاته، وذلك حظ عظيم، بل هو أعظم ما في الدارين، وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك فإن الله غني عن العالمين... والبراءة من الحظوظ صفة إلهية[66]".
فظهر هنا أن جوهره ضرب في عمق التعبد، ولا تخلو عبادة من العبادات ولا طاعة من الطاعات إلا وللحظ، بهذا المعنى، فيها نصيب، ومتعلقه إما الآخرة وقد مرَّ، وإما الدنيا ومآل الحال فيها راجع إلى الآخرة أيضا. ومن أمثلتهما "المواهب التي هي نتائج موهوبة من الله تعالى للعبد المطيع وحلىﹰ يحليه بها، وأول ذلك الثواب في الآخرة من الفوز بالجنة والدرجات العلا. ولما كان هذا المعنى، إذا قصد، باعثا على العمل الذي أصل القصد به الخضوع لله والتواضع لعظمته؛ كان التعبد لله من جهته صحيحا لا دخل فيه ولا شوب؛ لأن القصد الرجوع إلى من بيده ذلك والإخلاص له[67]."
لتنتهي القضية في فكر أبي إسحاق عند سبك قانون توجيهي ناظم لأطراف المسألة، قال فيه: "فالحاصل لمن اعتبر؛ أن ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة وغير قادح في الإخلاص فهو المقصود التبعي وما لا فلا[68]."
إن جمالية فاعلية القصد الشرعي عند الشاطبي رهينة بالتشوف إلى غايات الأعمال، بما هي مسالك معبدة إلى منازل القلب وأدلة عليها، إبان الدخول في قانون الامتثال وإخضاع الرقبة له، حيث تجعل تصرفات العبد، حركاته وسكناته، على محك ميزانها، فلا يزال العبد يتقلب في مدارجها ويتنسم شدى عندليبها المغرد بألحان الإيمان وجمال الإقبال على الرب لنيل مرضاته والفوز بجناته. وهذه هي خاصية قواعد المقاصد عند الشاطبي، وقد سرت في جميع المفاهيم الأصولية والقواعد الفقهية سريان الدم في العروق ! وهذا قبس منها اقتضته خصوصية المحل دون استيعاب. والله المستعان.
الهوامش
[1]. الإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: الشيخ عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، ط1، 2001م، 1/29.
[2]. المصدر نفسه، 1/29.
[3]. المصدر نفسه، 1/31.
[4]. قواعد التصوف. ت: عبد المجيد خيالي. دار الكتب العلمية. ط2، 2005 م، ص29.
[5]. الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، لبنان. ط3، 2008م. مادة (زين). ص219.
[6]. ذهب سيد قطب إلى أن "التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن". التصوير الفني في القرآن، مصر: دار الشروق، ط 17، 2004م، ص36.
[7]. مما طرقه غير واحد من علماء السلف والخلف قديما وحديثا من مثل عبد القاهر الجرجاني والزمخشري والطاهر ابن عاشور وسيد قطب وغيرهم كثير.
[8]. قال إتيان سوريو: "والحقيقة التي لابد من التنويه بها كذلك، هي أن الروحية الإسلامية تحترس على الأخص من مخاطر الفن التجسيمي وتجد لها ضمانات كبرى في الفن التجريدي. من هنا يجب تفسير الوضع الجمالي للفن الإسلامي من الناحية التجريدية". الجمالية عبر العصور. ترجمة الدكتور ميشال عاصي. منشورات عويدات بيروت باريس. 1982م، ص179. قلت: وهو حكم غير دقيق. ولأن النهي عارض للتجسيم وليس ذاتيا له. ولا ينبئك مثل خبير فسيد قطب ممن قتل ذلك خبرة، وتأمل كتابه الكبير "التصوير الفني في القرآن "يلح لك وجه الصواب في المسألة! وكذلك كتاب "الزخارف الإسلامية" للباحثة داليا أحمد فؤاد الشرقاوي. وقد أشار المفكر محمد عمارة إلى هذه الحقيقة في القرآن الكريم فقال:"... هكذا وعلى هذا النحو تتناثر في القرآن الكريم تلك الصور التي تجسد الأفكار وترسم المعقولات وتحول المعاني إلى لوحات فنية تقرأ باللسان وترى بالبصيرة وترسم بالمخيلة... وهكذا تتحالف هذه السبل من التعبير الجمالي والتربية الجمالية مع صريح موقف القرآن من التماثيل كنشاط جمالي على بيان الموقف الحقيقي للقرآن الكريم من فنون التشكيل الجمالي –نحتا ورسما وتصويرا. وهو الموقف الذي يرى فيه نعمة من نعم الله وآية من آياته إذا أمن الناس الشرك والتعظيم لغير الله". الإسلام والفنون الجميلة. دار الشروق، مصر. الطبعة الأولى: 1999م. ص117.
[9]. الموافقات في أصول الشريعة، م، س، 3/90-91.
[10]. المصدر نفسه، 1/148.
11. المصدر نفسه، 3/163.
[12]. المصدر نفسه، ص47.
[13]. سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق. ط1، 1972م، ج5/2984.
[14]. فريد الأنصاري. جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح، دار السلام. ط1، 2009م، ص43.
[15]. الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون للطباعة والنشر، د. ت، ج23/89.
[16]. توحيد الزهيري، نحو فلسفة إسلامية للجمال والفن، الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، ط1، 1998م. ص48.
[17]. محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار... تعليق محمد منير الدمشقي، نشر إدارة الطباعة المنيرية. د. ت، ج 1/01.
[18]. ابن القيم، الفوائد، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان. د. ت، ص182.
[19]. بغض النظر عن متعلقاتهما ومواردهما والخلاف فيهما، مادام مآل حقيقتهما الكلية واحدا.
[20]. الفوائد، م، س، 184.
[21]. الموافقات، م، س، 2/10-11.
[22]. المصدر نفسه، 1/89.
[23]. المصدر نفسه، 1/32.
[24]. المصدر نفسه، 4/226.
[25]. الشعاعات ضمن كليات رسائل النور. سعيد النورسي، طبع شركة سوزلر للنشر القاهرة. ط4، 2005م. ص11.
[26]. الموافقات، م، س، 3/165.
[27]. أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، تحقيق: أحمد عبد الشافي. دار الكتب العلمية. ط2، 2005م، 1/252-253.
[28]. المصدر نفسه، 1/232.
[29]. الموافقات، م، س، 4/236.
[30]. المصدر نفسه، 1/268.
[31]. المصدر نفسه، 4/181.
[32]. المصدر نفسه، 4/199.
[33]. المصدر نفسه، 3/184.
[34]. المصدر نفسه، 1235/.
[35]. المصدر نفسه، 3/183.
[36]. ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار، القاهرة. ط1، 2001م، ج 1/124.
[37]. الموافقات، م، س، 2/149.
[38]. المصدر نفسه، 2/173.
[39]. المصدر نفسه، 2/134.
[40]. المصدر نفسه، 2/138.
[41]. المصدر نفسه، 2/137.
[42]. المصدر نفسه، 2/135.
[43]. المصدر نفسه، 2/137-138.
[44]. المصدر نفسه، 2/140.
[45]. أخرجه البخاري في صحيحه ج5، ص،2385 حديث رقم: 6137. ينظر موسوعة التخريج أيضا:1/19236.
[46]. الموافقات، 2/140.
[47]. المصدر نفسه، 2/145.
[48]. المصدر نفسه، 4/147.
[49]. المصدر نفسه، 2/147.
[50]. المصدر نفسه، 2/149.
[51]. المصدر نفسه، 2/142.
[52]. رواه مسلم في الصحيح. رقم: 21312. البيهقي في سننه الكبرى ج 10، ص309 حديث رقم: 21327. النسائي في سننه الكبرى ج 3، ص193 حديث رقم: 5007. بألفاظ متقاربة.
[53]. الموافقات، م، س، 2/150.
[54]. المصدر نفسه، 4/210.
[55]. المصدر نفسه، 2/156.
[56]. المصدر نفسه، 2/156.
[57]. المصدر نفسه، 2/136.
[58]. المصدر نفسه، 2/136-137.
[59]. المصدر نفسه.
[60]. المصدر نفسه، 3/169.
[61]. المصدر نفسه، 2/137.
[62]. المصدر نفسه، 2/137.
[63]. المصدر نفسه، /3176-177.
[64]. المصدر نفسه، 2/142.
[65]. المصدر نفسه، 2/164.
[66]. المصدر نفسه، 2/164-165.
[67]. المصدر نفسه، 2/304.
[68]. المصدر نفسه، 2/309.