
يجدر التنبيه في البداية إلى أن تناولنا لإشكالية الإصلاح الديني سوف تكون على مستوى الثقافة الدينية السائدة. بمعنى آخر، سأحاول أن أتحدث لا عن المشكلات الجزئية اليومية العملية الميدانية، وإنما عن تلك التي توجهها كفكر وكثقافة. عن المرجعية التي شكلت وصاغت كثيرا من أشكال التدين وأنماط التفكير الديني الراهنة. إيمانا منا بأن عملية الإصلاح ما لم تشمل، بمنهج بحث علمي، الأسس الفكرية لمظاهر الانحراف أو الفساد أو الغلو والتشدد أو الانكماش والانغلاق.. أو الانحطاط بصفة عامة، لا يمكن أن تغير من واقع الحال شيئا؛ لأن هذا الواقع سيبقى يتغذى ويرتوي من نفس المعين ليعيد إنتاج نفس الظواهر والأنماط التي يشكو منها، وهذا سبب من أسباب الدورة التاريخية المفرغة التي تعاني منها الأمة طيلة عصور انحطاطها.
مسألة ثانية وهي ضرورة تحرير وعينا بمفهوم الإصلاح نفسه، فهو يمتد من إصلاح الفرد إلى إصلاح الأمة، على مستوى النظم التربوية والفكرية والحضارية وغيرها.. بل وعلى مستوى الملاءمة والمواءمة مع النظم والسنن الكونية والاجتماعية بحيث لا يشعر المسلم بالغربة في مجال استخلافه وتكليفه فيعجز عن البناء والعطاء والتفاعل والتعمير كما هو حال الأمة الآن. والله تعالى يقول: ﴿ولا تفسدوا في الاَرض بعد إصلاحها﴾، ومن إصلاحها تسويتها وتقديرها بضبط سننها ونواميسها وخيراتها.. والإفساد فيها مصادمة لذلك كله، تماما كما أن الإفساد فيها سعي بين الأحياء فيها بكل ما هو سيء وقبيح. والمعنيان يفيدان أن العمل والحركة فيها ينبغي أن يكونا وفق شرع وهدى ومنهاج مبثوث فيها أو منصوص يدل عليها. والقرآن الكريم ينسب الصلاح إلى الإنسان ﴿والله يعلم المصلح من المفسد﴾، وينسبه كذلك إلى الأعمال ﴿اِليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾. فاعتبار أن الإصلاح هو التزام الإنسان بشعائر دينه فقط، وأنه إذا استقام الناس في صلاتهم وصيامهم وأخلاقهم..
فهذا الإصلاح الديني المطلوب، يستصحب معه وعيا بمحدودية هذا المفهوم، هذا دون التقليل من أهمية وخطورة هذا المستوى لأنه الأصل والمبتدأ لمستويات إصلاحية أخرى ما تزال غائبة عن نظمنا الفكرية والتربوية، وهي التحقق بأحكام الاستخلاف والشهادة والخيرية والتعمير والعالمية.. وغيرها مما هو منوط كأحكام بالأمة، تماما كما أنيطت أحكام بالأفراد. وهذا سببه تضخم نوع من القراءة ولنقل الفقه للقرآن الكريم والسنة النبوية. الفقه النوازلي الأحكامي الفردي الذي غطى مساحات العلوم الشرعية كلها تقريبا، وهيمن بهيمنة الجمود والتقليد منذ القرن الرابع الهجري على كل أضرب الفقه الأخرى الممكنة من الوحي وخاصة تلك المتعلقة بالإنسان وعلومه وبالكون ومعارفه وبالخلق وآياته مما تكاد تخلو منه مكتباتنا ومعارفنا، وكأنه لا فقه في القرآن ومن القرآن إلا ما استقر تاريخيا، واحتل أو كاد بفعل التداول مكان القرآن نفسه. وهذا مصادم لمطلقية الرسالة واستيعابها للزمان والمكان وكونها معين لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ومصادم كذلك لحق الأجيال في كسبها التاريخي (تدينها) وفق ظروفها ونوازلها من خلال تجديد النظر دوما في ذلك المعين.
نحتاج، إذن، بين يدي الإصلاح إلى ضبط الرؤية الإصلاحية التي ينبغي أن تتحدد وفق محددات الشرع وخصائصه ووفق تحديات الواقع ومشكلاته، لا وفق رغبات معينة أو ميولات وطموحات. وحتى إذا توزعت مجالات الإصلاح على جهات مختلفة ومتنوعة فأدنى شروط نجاح هذا العمل الإصلاحي أن تتكامل هذه الجهود ولا تتقابل. وبدل الازدحام على بوابات بعينها هناك ثغور كثيرة لا تجد واقفا فيها أو عليها يسد ويلبي حاجات الأمة فيها. فكثير من علومنا ومعارفنا تشكو من مساحات تخلف واسعة تحتاج إلى استئناف البناء وردم الهوة بأضرب أخرى من النظر الاجتهادي التجديدي.
أود في مستهل هذه الكلمة أن أطرح كذلك بعض الأسئلة تعيننا كمداخل علمية على ضبط الرؤية والعمل الإصلاحي الذي نحن بصدده. مثلا هل يمكن لنظام فكري جامد ومتأخر عن زمانه أن ينتج خطابا إصلاحيا مواكبا؟ وهل الآليات "المناهج" المتاحة في هذا الفكر وبالطريقة المستعملة والمتوارثة تسمح بإنتاج خطاب ومعرفة تصحيحية إصلاحية، أم أنها لا تملك إلا إعادة إنتاج الظواهر الفكرية والثقافية نفسها ولربما بصورة أسوأ؟ فلو أردنا، ونحن دائما نريد، النهوض لما استطعنا لافتقادنا الرؤية والمنهاج في شموله وتكامله، وكثير من حركات الإصلاح والنهوض قديما وحديثا لم تستطع أن تغير التغيير المطلوب للسبب ذاته. كما أننا لو سلكنا سبل النهضة والتحديث على النموذج الغربي لما أمكننا أن ننتج، إن نحن نجحنا، إلا النموذج الحضاري الذي أنتجه بكل علله ومشكلاته الإنسانية والكونية لافتقاده لمرجع الترشيد والتسديد المطلق المتجاوز لنسبية وقصور الأداء البشري. وهل تحتاج البشرية الآن إلى دورة حضارية أخرى على النموذج الغربي وهي تتلمس سبل الخلاص في منقذ يخلصها من مآزقه؟ للأسف بدائلنا كنموذج حضاري كوني قابل للتحقق غير جاهزة بعد.. بل ولا نشتغل في هذا الاتجاه بالجدية العلمية والعملية المطلوبة، فجل أعمالنا محوطة بسياج حزبي أو حركي أو مذهبي طائفي مع انعدام النواظم والروابط التي تحقق التكامل في ظل التنوع والاختلاف. وبدل أن توضع لبنات الإصلاح في جدار الأمة فإنها توضع في جدار تساهم في عزل هذه الكيانات عن بعضها، فكيف بتوحدها لبناء هذا الجدار المطلوب، رمز الحضارة والعمران والثقافة والتدين.. وكل ما يميز هذه الأمة كذات عن غيرها من الذوات في ساحة التدافع أو التعارف الكوني. هذا يدفعنا إلى أن نطرح تساؤلا آخر، وهو: كيف نؤسس لنموذج إصلاحي بنائي للبدائل وفق الرؤية والمنهاج في ظل نظام العولمة وما تتيحه من تقريب ما كان غائبا عنا؛ أي الأفق الكوني الإنساني (وحدة المشكلات الكونية والبشرية)، أفق العالمية الذي هو أحد خصائص الرسالة نفسها؟
هذه الأسئلة وما في معناها، تدفعنا إلى الحديث عن ضرورة إصلاح الفكر السائد أولا وإعادة بناء المعارف والعلوم المغذية له. من زاوية الرؤية والفلسفة، ومن زاوية التكامل والتداخل، ومن زاوية الاستيعاب والشمول.. وهذا بدوره يطرح مشكل منهاج إعادة البناء، كيف يعاد البناء؟ هذا السؤال الكيفي هو سؤال منهجي، وكثير من حركات الإصلاح التاريخية تحدثت عن ضرورة العودة إلى الدين والالتزام بالدين.. لكن الكيفيات لم يكن فيها تفصيل تراكمي. كيف تكون هذه العودة؟ وفق أي مخطط؟ تحت أي سقف أو أفق؟ وفق أي رؤية ومنظور..؟ ففعلا هناك إشكال المنهاج، منهاج البناء الجديد بعبارة ابن نبي رحمه الله.
هذا في اعتقادي يقتضي أمورا ضرورية تحتاج إلى اجتهاد مستأنف لتحريرها وتخليصها وبعث الحياة والفاعلية فيها من جديد. أذكر منها أمرين اثنين لابد منهما:
الأول؛ الوعي والإلمام بمرحلة التأسيس الأولى، وحركة النص تجاه العقل وتجاه الواقع، والمعرفة والفقه اللذين سادا.. حيث كان الوحي ينزل وحيث كان يستوعب بفقه معين، ثم يتم تنزيله وفق فقه تنزيلي معين كذلك. وهذه خطوة منهجية ضرورية؛ لأنه لا يمكن أن يستأنف البناء من فراغ فلابد له من أصول ومستندات. ولسنا بحاجة إلى التذكير أنه ليس مرادا هاهنا استحضار الرسوم والأشكال والأنماط التاريخية القديمة بقدر ما هو مراد عندنا أن نستلهم الوعي والفقه والمنهاج والرؤية والتصور. وأعتقد أن المدرسة الإصلاحية الحديثة في المشرق والمغرب على حد سواء مع الأفغاني والطهطاوي ومحمد عبده ورشيد رضا ومع التونسي والكواكبي وابن باديس والإبراهيمي.. ومع محمد بن العربي العلوي والحجوي الفاسي وعلال الفاسي.. ومن إليهم، ممن كان لهم استلهام جيد للتراث الإصلاحي التأصيلي القديم ولأسئلة الظرف (الزمان والمكان) والتحديات الخارجية.. تشكل أرضية مهمة في طرح أسئلة الإصلاح الكبرى التي تم التعامل معها باختزال كبير، بل وتم التراجع عنها الآن لفائدة أسئلة واهتمامات جزئية.
الثاني؛ الوعي والإلمام بمرحلة الانحطاط أسبابا ومظاهر ونتائج. وخاصة التحولات الكبرى التي طرأت على مستوى بنية التعامل مع النص وعلاقته بالعقل "آلة الاجتهاد والتفكر"، ومع الواقع (مجال التنزيل والاستخلاف)، لإدراك مساحة الخلف والفراغ الواسعة في كثير من علومنا ومعارفنا التي توقفت ولم تستأنف حركة بنائها منذ قرون.
ومن غير خوض في التفاصيل والجزئيات أعرض بعض العناصر الأساسية لهذا المنهاج الذي لابد منه كمدخل علمي للاشتغال من جديد على بنية النص في علاقته بالإنسان المستخلف، وبالكون مجال الاستخلاف. (وقد سبق لي ذكرها بشيء من التفصيل في مناسبة أخرى).
ـ التحول إلى قراءة القرآن الكريم كشاهد لا كشواهد، فإذا تأملنا في العلوم التاريخية نجد أن القرآن تحول إلى شواهد، وأن البنية النسقية للقرآن الكريم تم تجزئتها، وأصبح كل مذهب وكل طائفة وفرقة تأخذ من القرآن بحسب حاجتها وما تريد هي لدعم وتعزيز بنائها الذي بني خارج النسق والرؤية القرآنية. والأصل في العلم، أي علم، أن ينبثق من القرآن رؤية وفلسفة، بما في ذلك العلوم الكونية والإنسانية وهي كلها شرعية بالمناسبة. وأحيانا منهاجا وآليات، كما في العلوم المسماة دينية أو شرعية. بعبارة وجيزة أن يكون القرآن شاهدا على العلوم والمعارف لا شواهد لها فحسب، فمن خصائصه أنه مطلق مستوعب ومهيمن ومصدق.. إنه كلام الخالق الذي خلق الأكوان والإنسان وأنزل القرآن، ومن ثم فالقراءة في كل هذه الواجهات "الآيات" ينبغي أن تكون باسم الله ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾، وليس من سبيل إليها إلا العلم والفقه فيها جميعا بما يتيحه كل عصر من معارف وبما يتوصل إليه الإنسان من خلال إبداعه واجتهاده الذي ينبغي ألا يتوقف.
ـ التمييز بين الأصول المؤسسة للمعرفة وتلك التي أسستها المعرفة. فهناك أصول أسست المعرفة، وهما الأصلان الأولان طبعا القرآن الكريم والسنة المبينة له. ولكن في التاريخ تأسست أصول أخرى، أسستها المعرفة والفكر الذي أنتج بعد ذلك. وهذا جهد مقدر لعلماء الأمة. لكن كثيرا من القيود والموانع والشروط التي وضعت وتقررت داخل المذاهب وعند الفرق، تحول دون استئناف الاجتهاد والتجديد فيها. إذ تحولت كثير من المقررات المذهبية والفرقية إلى أصول نائبة عن الأصول وحالة محلها. ومعروف أن كل ما أنجز تاريخيا فهو نسبي تبعا لنسبية وقصور الجهة المنتجة له، وليس الإطلاق ولا العصمة إلا للوحي الخالد، وتعميم المعرفة النسبية على كل الأجيال حرمان لها من حقها في أن تكسب من الوحي كذلك لزمانها ومكانها، من أن تجتهد لتحقق تدينها. ولهذا كانت ثقافتنا ولا تزال مرتهنة للتاريخ النسبي المتقلب ومستمدة منه وموجهة به أكثر من ارتهانها واستمدادها وتوجهها بالوحي. لهذا نفهم لماذا جاهد واجتهد علماء كبار في تاريخ الأمة قديما وحديثا للعودة إلى الأصول في ينابيعها قبل أن تشوبها الشوائب، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في حركته التأصيلية البنائية الكبرى، وكما فعل آخرون، إلى الحركة الإصلاحية الحديثة التي نوهنا بها حيث كان شعارها: الرد إلى الأصول قبل الخلاف. وليس هذا إنكارا لجهود العلماء في وضع الأصول والقواعد والضوابط.. لكنه دعوة إلى استئناف الجهد في البناء على تلك الأصول تفعيلا وتجديدا وتأصيلا بحسب ظروف الأمة والتحديات القائمة أمامها.
ـ تكامل مصادر المعرفة نصا وعقلا وواقعا، فلا يمكن للمعرفة أن تكون من النص وحده؛ إذ لا يبقى معنى للقرآن دون إنسان وواقع. ولا يمكن للعقل وحده أن يكون مستقلا بالمعرفة، وكل التجارب العقلية التي استقلت بالمعرفة تحولت إلى نزعات عقلية متحيزة إلى درجة تأليه العقل كما في التجربة الغربية. فالعقل عاجز عن معرفة الحقائق الكونية والإنسانية المنتمية إلى عالم الشهادة فكيف بالأسرار الخفية وعالم الغيب كله. ولا يمكن للواقع أن يستقل وحده كذلك بالمعرفة وإلا لتحول بدوره إلى نزعات واقعية كما في وضعية ووجودية ومادية فلسفات الغرب الحديث والمعاصر. فيبقى الوحي مرشدا ومسددا للعقل والواقع نحو الفعل والحركة والإبداع لا نحو الجمود والتقليد، بفتح الآفاق لا بغلقها، كما تشهد لذلك كل آيات الدعوة إلى التفكر والتدبر والتعقل والإبصار والاعتبار والنظر.. لكن للأسف التجربة التاريخية في عمومها لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المصادر في تكاملها، فأهمل الاجتهاد العقلي كما أهمل الواقع التنزيلي، وتضخمت بالمقابل نزعات نصية بدت وكأنها كل ما يمكن إنتاجه تفاعلا مع الوحي. ولم تسعف في ذلك جهود استدراكية تنبيهية قيمة نجدها في كتابات العز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم والشاطبي وابن رشد وابن خلدون وآخرون قليلون.
والمنهاج المحدد للرؤية والباني للمعرفة له من دون شك خصائص ومحددات يرتكز عليها، أعتقد أن أهمها أربعة أساسية هي:
1. التوحيد الذي يضفي الغائية والقصد على الفعل والتصور والوجود الإنساني بدل العدمية والعبثية التي تسود الكثير من الأنظمة الفكرية والمعرفية والفلسفية الآن.. 2. الوسطية التي تضفي الاعتدال وتؤسس حالة السواء في الفكر وفي السلوك، في الأفراد وفي الجماعات، بدل الغلو والتشدد والنزوع نحو الأطراف.. 3. العالمية التي تضفي طابع الشمول والاستيعاب وامتداد الأمة في علومها ومعارفها كامتداد رسالتها، بدل الفكر الطائفي والفرقي الذي لا ينتج إلا لنفسه وفي محيطه.. 4. الإنسانية التي تدفع في اتجاه التكافل والتعاون والتعارف والتدافع السلمي بدل الصراع والصدام لوحدة الأصل والمصالح وحتى الهموم والمشكلات البشرية..
قد يقال، هذه بعينها خصائص ومحددات الرسالة نفسها؟ أقول نعم، لأنه لا معنى لمنهاج ولا لفكر ولا لثقافة أو معرفة أو علوم ما لم تنعكس فيها وعليها خصائص ومقومات الرسالة، وإلا فكيف يثبت النسب (الإسلامي)؟ إلا أن يكون ذلك ادعاء لا حقيقة كما هو حالنا اليوم. فأين نحن من تلك المحددات ونحن نعيش تجليات كبرى للفكر الطائفي والقطري، وللغلو والتشدد، وللانغلاق والانكماش، وللصراع والاحتراب.. مرحلة صح أن يجتمع فيها القول وعكسه كما عبر البعض: أزمة فكر وفكر أزمة. بمعنى أننا أمام ضرورة البحث عن خصائص منهاجية من أجل قراءة أخرى لمعارفنا الدينية والدنيوية تأخذ بعين الاعتبار ما سبق التنويه عليه من مداخل نظن أنها علمية. مما نعتبره كذلك مداخل علمية مساعدة على إصلاح الفكر الديني والوعي به، ومساعدة على فهم واستيعاب ما تقدم معنا مجملا، الأمور التالية:
ـ فهم فكر الأزمة والانحطاط في سياقه التاريخي، لأننا نخطئ مرتين عندما نتعامل مع الظواهر بشكل بنيوي محض. فلا نحن نستطيع تفسيرها التفسير الصحيح ولا نحن نستطيع تغييرها التغيير السليم. فنقوم بترقيعات توهمنا أننا على خط التغيير الحقيقي والأمر ليس كذلك. فالفكر السائد الآن وإن كان متأثرا إلى حد كبير بتحديات العصر الراهنة، هو متأثر قبل ذلك بتحديات تاريخية أسست فيه قابلية التأثر ومقدمات الاستتباع والاستلاب للنماذج المغايرة ذات السطوة والغلبة. فكر تشكل في ظروف هيمن عليها منطق الجمود الفقهي، والفرقة المذهبية، والانحطاط الحضاري، والاستبداد السياسي.. وكل عنوان من هذه العناوين ورش ضخم لبحوث كثيرة، أنجز منها شئ قليل وتحتاج إلى استئناف وفق رؤية جديدة في البحث لإحداث التراكم المطلوب، لإحداث الوعي المطلوب، لإحداث التغيير والإصلاح المطلوب.
لقد اشتكى الإمام الغزالي منذ (ق5ﻫ) من شيء سماه (تبدل ألفاظ العلوم) في مقدمة (الإحياء)، وذكر منها خمسة ألفاظ كبرى في الثقافة الإسلامية هي: التوحيد والعلم والإيمان والتزكية والحكمة؛ إذ لم تعد لها في عصره، وهو قريب العهد من صدر الإسلام، نفس المعنى والدلالة التي كانت. ومعروف أننا من هذا القرن، وعند آخرين من الذي قبله وهو الأصح ما دام الغزالي نفسه يشكو من الموات فرام الإحياء، دخلنا الانحطاط على مستوى التدين الفكري ومن ثم الحضاري من أبوابه الواسعة. ولك أن تسأل عن تأثير العقيدة في أقوال وأفعال الإنسان الآن، إن تبقى هنالك أصلا تصور ارتباط بينهما. إنه ضرب من الإرجاء جديد ومثله تعطيل وجبر وتواكل.. لم تتخلص منها منظومة الفكر والاعتقاد بعد.
هذا الذي شكا منه الغزالي في المشرق شكا منه كذلك ابن حزم في الغرب الإسلامي وفي الفترة الزمنية نفسها تقريبا، حيث رام بناء ما يربو عن ثلاث وثمانين لفظا في كتابه (الإحكام)؛ لأنها لم تعد لها ذات الدلالة التي كانت لها. ولا يتعلق الأمر بعلم أصول الدين وحده، بل بالفقه والأصول والحديث.. كذلك، فالقضية واحدة على امتداد جغرافية الثقافة الإسلامية. فكثير من اصطلاحات العلوم صناعة تاريخية، بدل أن تساعد على نمو العلم وتطوره تحولت إلى قيود وحواجز أمامه، وأضحت غايات في ذاتها بدل أن تكون وسائل لغيرها. والعلوم نفسها انفرطت نواظمها المنهجية التي تربطها بأصل الانبثاق الأول وتوحدها عنده، فتحولت إلى كيانات مستقلة مادة ومنهجا واصطلاحات لا تكاد تلحظ تكاملها مع غيرها إلا نادرا. فإذا تعذر أن نحقق التكامل بين العلوم الإسلامية نفسها، فكيف بها مع العلوم الإنسانية، وكيف بهما معا مع العلوم الكونية؟ ولاحظنا أن هذه دوائر أصول لابد من تكاملها في إنتاج المعرفة وتحقيق التدين بمعناه الخاص والعام، فردا وأمة.
إن الأمر يحتاج إلى أن نعيد بناء الشبكة العلائقية بين هذه العلوم، ثم ربط هذه العلوم بأصلها الأول بحيث يهيمن عليها ويصدق. ينبغي أن نعمل في تراثنا بعد القرآن، ما عمله القرآن في التراث البشري الديني والفكري المعاصر للتنزيل أو السابق عليه من مراجعة وتصحيح.
ولست أقر هنا الرأي العدمي القائل بتجاوز التاريخ والتراث والماضي، علوما ومعارف ومذاهب.. باعتبار أن الاشتغال بذلك اشتغال بالتخلف وتكريس له، فهذه بالنسبة لي صورة عدمية وسفسطة نظرية لا تفضي إلا إلى تدويم حالة العجز والتبعية في الأمة، فمن لا هوية له ينتحل بالضرورة هوية غيره وبصورة شائهة؛ لأنه بكل بساطة لا يمكن أن يكون هو، ولا حتى أن يستنسخ تجربته في الإصلاح والنهضة. وكثير من أنصار هذه الأطروحة إنما عرفناهم من خلال اشتغالهم بالتراث، فعليه بنوا أمجادهم (مشاريعهم) ومنه يقتاتون، فأضعف البر به بصفته عائلا، الانخراط الإيجابي في قضاياه ونفي العلل والزوائد المضرة به. فكما نرفض تقديس التراث لأنه ليس وحيا، نرفض تدنيسه لأنه ذاكرة وماضي وتاريخ ونسب الأمة، شأنها شأن سائر الأمم المعتزة بتراثها وتاريخها المنخرطة في مراجعته وتصحيحه والاستفادة من كل إيجابي فيه لحاضرها ومستقبلها. وكما نعتبر الذي يرتحل إلى التراث فيقيم فيه مغتربا عن زمانه ومكانه، نعتبر كذلك الذي يرتحل إلى غيره فيقيم عنده، فهما يشتركان في الارتحال والإقامة والغربة عن الحاضر والمستقبل.
ـ التحرر من عوائق وموانع نفسية وفكرية، وأقصد الشحنة الصراعية الصدامية التقابلية بين الثنائيات التي تأسست في التاريخ وما تزال ممتدة إلى يومنا هذا. منطق الثنائيات الذي هيمن قديما بين (الرأي والأثر، والحكمة والشريعة، والعقل والنقل.. الخ). أو الصيغ الحديثة المتداولة الآن سواء في بعدها الفكري أو السياسي (أصالة معاصرة، تراث تجديد، قديم حديث، مدني ديني، إسلام غرب..الخ). يبدأ المشكل عندما تتوهم النخب المحتمية بهذا الطرف من الثنائية أو ذاك أنها تحميه وأنه يحميها، بل قد يتضخم هذا التوهم إلى حد الشعور بالملكية والحيازة إذ يتحول إلى حمى عليه حراس وجنود يدبون عنه ويحمونه، ولا فرق في هذا بين الحالة التاريخية القديمة والحالة الحديثة والمعاصرة إلا في بعض التسميات. فعندما يكون هناك دعاة للرأي وآخرون للأثر، ومثلهم للحكمة أو العقل وآخرون للشريعة أو النقل، فتقوم بينهم معارك تتحول إلى النصوص نفسها، ويصبح المدافع عن اختياره وتوجهه متوهما أنه مدافع عن النص فيشتد في الطلب والمغايرة، تتوقف حركة الفكر والمعرفة التي تحتاج في بنائها إلى تكامل واشتغال كل تلك المداخل بإدراك وتفعيل العلاقات الكامنة بينها. فلا أحد يمكنه احتكار النص والتحدث باسمه، ولا أحد يمكنه احتكار العقل والتحدث باسمه. فالنص رسالة للعالمين، والعقل نعمة الله إلى الناس أجمعين.
وقد نبه إلى هذا الدور التكاملي بين طرفي هذه الثنائيات ونفي أشكال التعارض بينها علماء متقدمون في الأمة ومتأخرون، كابن رشد في "فصل المقال.." وابن تيمية في "درء التعارض.." ومحمد عبده في معظم كتاباته وخصوصا رسالة "الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية" والحجوي الفاسي في (التعاضد المتين بين العلم والعقل والدين، وفي الفكر السامي..) وغيرهم، لكن لا حياة لمن تنادي.
شبيه بالصراع التاريخي القديم، الصراع الحديث والمعاصر بين طرفي الثنائيات المتداولة والمحتمين بها. فهناك أنصار للحداثة والتقدم والمعاصرة والمدنية.. الناطقون باسمها، وهناك آخرون ناطقون باسم الأصالة والتراث والقديم.. ولا أحد في الحقيقة مفوض للحديث باسم ما يزعم التحدث باسمه أو مالك وحائز له. وما لم تعد الصياغة وفق منهاج التكامل والتداخل بين العلوم والمعارف ووسائلها، فلن تكون هناك مقدرة على بناء ما، ولن نكون بحسب التصورين إلا نماذج تاريخية جامدة أو نسخ عن الغير شائهة، ولن يستطيع أي طرف التقدم لا في الزمان ولا في المكان إلا توهما. ليس معنى هذا تجاوز الثنائيات أصلا، فالله تعالى خلق من كل زوجين اثنين ونظام الثنائية في الكون سنة، لكن المعادلة الصعبة كامنة في إدراك التكامل بينها وتفعيله، والتحرر من آفة مصادرة حق الآخر بالتحيز للذات أو للغير.
ـ المعادلة الصعبة التي تجعل من الإنسان أصيلا معاصرا، قديما حديثا، تراثيا مجددا، مسلما عالميا، صاحب رأي وحكمة ونص وأثر.. إلى غير ذلك. ولا ندعو هنا إلى توفيقية أو تلفيقية على غرار ما درجت كثير من الأدبيات التي تضع رجلا هنا وأخرى هناك، أو تأخذ شيئا من هنا وشيئا من هناك في تركيب عجيب. بل نعتقد أن تمثلنا للرؤية القرآنية على مستوى نظمنا الفكرية والعلمية والسياسية والتربوية والحضارية عموما.. يفتح آفاق كونية من التعارف والتعاون والتدافع السلمي والتكافل الإنساني.. تتجاوز ما يطرحه أي فكر بشري نسبي. فلا خوف عندنا على الدين من العقل ولا من العلم، ولا خوف على العقل والعلم من الدين. وفرق بين تجربتنا وتجارب غيرنا ممن عرفوا صراعا داميا رهيبا بين العلم والعقل من جهة وبين الدين الموجه بالخرافة والمصالح من جهة أخرى.
فعلى العكس تماما، هذا الدين كلما تقدم العلم واجتهد العقل كلما نصعت وتكشفت حقائقه، وكلما بانت وتجلت معالمه. لكن للأسف لما وقع الإخلال بشرط النهوض العلمي والحضاري، وقبله بشرط الاجتهاد العقلي، وقع التراجع والانحطاط. فلا يمكن للحقائق الكونية في الخلق الموحد أن تتصادم إلا بتوهم من الإنسان ﴿لو كان فيهما ءالهة اِلا الله لفسدتا﴾. والتعرف على الحق في هذا الدين لا يكون إلا من خلال النظر في الآيات ﴿سنريهم ءاياتنا في الاَفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾، مع كل ما يمكن إنتاجه وتطويره من علوم مساعدة على الإبصار والرؤية في تلك الآفاق. ولو درج علماؤنا على الجمع بين القراءتين، قراءة الوحي وقراءة الكون، لاستمر البناء والعطاء ولقل الخلاف والنزاع لأن الاحتكام سيكون إلى الآيات الحسية والتجربة أو قل التنزيل، وليس إلى المقدمات والصياغات النظرية المجردة وحدها.
ـ تكاملية الإصلاح ومجالاته، فإصلاح الدين لا يمكن أن يكون بمعزل عن إصلاح الدنيا. ونحن عندما نتحدث عن الإصلاح الديني نقوم إما باستحضار التجربة الغربية القائمة على كون مؤسسة الدين منفصلة عن مؤسسة الدولة، ونشرع في إسقاط كل مواصفات الدين الكنسي بكل حمولته التاريخية الصراعية مع مؤسسات العلم والفكر والدولة. أو نستحضر قراءة تاريخية جزئية للدين لا ترى فيه إلا أحكاما جزئية فقهية كما أشرنا، مع إهمال كل أوجه القراءات الأخرى الممكنة باعتبار كل آيات الكتاب أحكام، وخصوصا منها أحكام الأمة وأحكام الإنسان وأحكام الكون والعمران. ولهذا لابد أن يتلازم إصلاح الوعي والفكر الديني بإصلاح مرافق الحياة ومؤسسات الدولة والمعاملات المختلفة. فتجديد التدين يكون بالاشتغال في حركة الواقع، ويكون بالإجابة عن تساؤلات وتحديات هذا الواقع، حتى إن بعض العلماء ربطوا بين نمو الفكر الديني وبين حركة ودينامية الواقع والعمران والحضارة. فليس الدين نظريات مجردة ولا علوم ومعارف صورية، ولا ينقص من قدره ومكانته أن ينزله الناس إلى واقعهم فعليهم نزل وإليهم وجه القول وحيثما توقف جهد الإنسان وطاقته في الطلب فذلك المطلوب منه شرعا، فـ ﴿لا يكلف الله نفسا اِلا وسعها﴾، وفي الحديث "ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم".
فالحركة الفقهية التي بدأت تنشط الآن تحركها تحديات في المعاملات المالية الجديدة وفي مشكلات الطب الجديدة وفي مشاكل أسرية جديدة وعلاقات دولية.. وغيرها، فرغم جمود هذه الآلية نجد هذه المشكلات تدفع في اتجاه تحريكها، وينبغي في حركتها أن تسترشد بالرؤية والمنهاج الكلي كي تكون اجتهاداتها مواكبة للتحديات ومستوعبة لها. ولهذا لا يمكن أن نفصل إصلاح الدين عن إصلاح الدنيا، بأن نجعل إصلاح الدين عالما خاصا، وإصلاح الدنيا عالما خاصا، فهما على كل حال متداخلان كما قلنا ومشمولان نصا وعقلا وواقعا.
ولعل المجال الأهم والأولى بالإصلاح هو مجال التربية والتكوين، مجال تخريج العلماء والباحثين والمفكرين.. والمسؤولين عن وفي مؤسسات الدولة. فأي نموذج نريد؟ وما السياسة التعليمية الممكنة من ذلك؟ من خلال ما ألمحنا إليه سابقا، نريد المجتهدين المجددين في مختلف التخصصات، الناهضين بالدين والدنيا معا. نريد فقهاء علماء ينتجون الفقه والعلم لزمانهم ومشكلاتهم وليس مجرد رواة يروون تاريخ المذاهب والفرق والمدارس أقوالها واجتهاداتها. وأيضا علماء ومفكرين ينتجون في العلوم الدقيقة وفي عالم الأفكار ولا يكتفون بمجرد نقلها واستعارتها من غيرهم. نريد تحريك العقل المسلم ليجتهد من داخل النسق الإسلامي، وليسهم في بناء المعمار الكوني من خلال نماذجه وبجهده مجددا لا مقلدا. وفي سوق (الإفلاس) الكوني وانسداد آفاق التواصل الإنساني الإنساني، بدل مظاهر الاستبداد والغلبة والتسليع والتنميط لكل شيء، يمكن لتلك النماذج أن تكون، وهي كذلك، قوارب نجاة لكثير من الشعوب وحلول لمشكلات عميقة لم تسعف الترقيعات في حلها.
إصلاح هذا المجال يتطلب إعادة نظر جذرية في مناهج وبرامج التكوين بما يتلاءم والحاجيات المطلوبة، ووضع البلد والأمة، بدأنا شيئا من هذا في المغرب لكن في تقديري مازال يعوزه الكثير رؤية ومنهاجا ومناهج وبرامج.. بل وأعتقد أن المغرب مؤهل أكثر من غيره لأن يقود حركة الإصلاح الديني بمعناه الواسع والشامل وأن يكون في ذلك كما كان منارة إشعاع وإبداع.



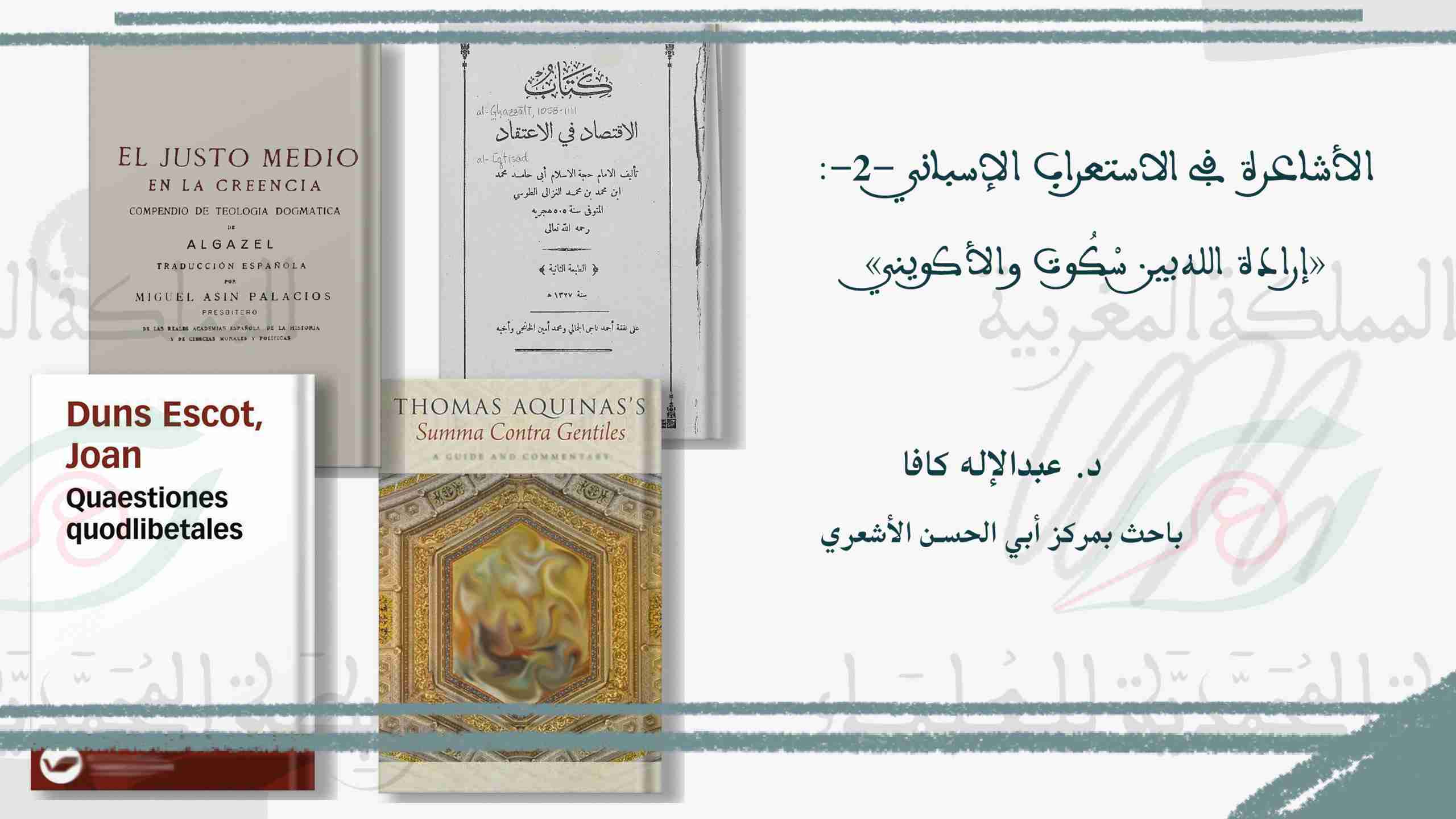

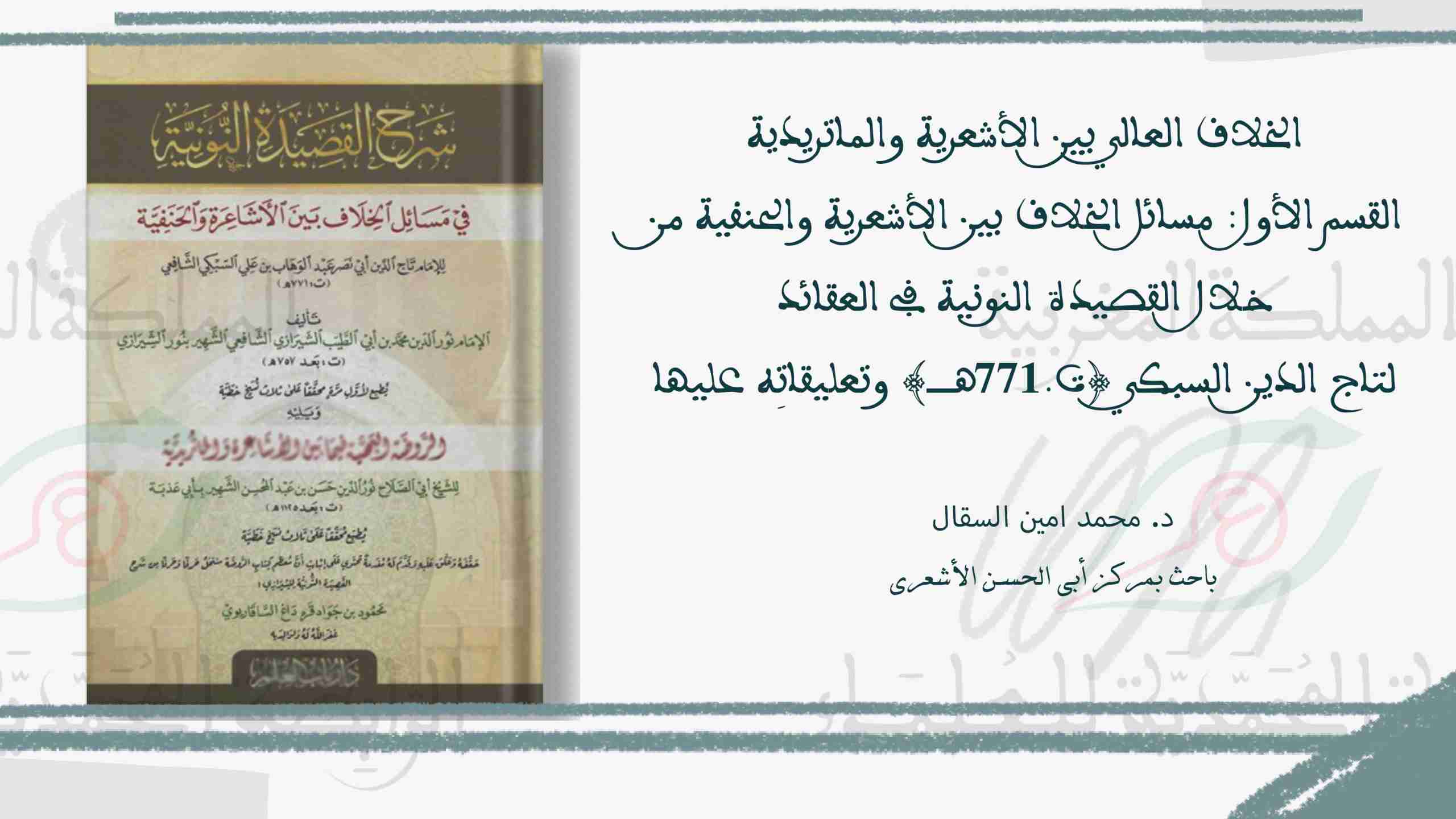


شكرا لك أستاذي على هذه الافادة