
الاجتهاد بمثابة روح الشريعة، ومنبع الحياة لفقهها، ومخزون الطاقة الأثرى لاستمرارها وتجددها، ولا يتصور أن تؤدي الشريعة وظيفتها، وأن يكون لها فقه حي مرن ينتظم مصالح الخلق على سبيل الدوام دون إعمال الاجتهاد وإحياء شروطه الثقافية والاجتماعية.
الخصيصة الثالثة: العموم أو الإحاطة؛ أي قدرة النظام الشرعي على استيعاب جميع صور الحوادث الواقعة أو المتوقعة، والاستجابة لمتطلبات كل عصر وقضاياه؛ ذلك أن الاجتهاد جزء من "النسق الأصولي الفقهي"، وهذا النسق بطبيعته "نسق مفتوح" له طابع استنباطي، والطابع الاستنباطي هو سمة معظم الأنساق القانونية الحديثة وهو الذي يلزم القاضي بالحكم في أي مسألة أو نازلة للفصل فيها، حتى ولو لم يكن هناك نص صريح يشملها؛ فالقاضي الذي يرفض أن يحكم متعللا بسكوت المشرع أو غموض النص القانوني أو عدمه يعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة. وكذلكم نسق الاجتهاد الشرعي، بقواعده ومداركه ووجوه النظر فيه، نسق مفتوح قادر على استيعاب القضايا المتجدّدة، والأوضاع الاستثنائية، وإيجاد الحلول المناسبة واقتراح الصيغ الملائمة لها، وهذا ما يشير إليه الشافعي، رحمه الله، بقوله: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها[5]."
الاجتهاد في اصطلاح بعض حذّاق الأصوليين المحدَثين هو: "استفراغ الوسع وبذل غاية الجهد إما في درك الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها[1]."
أريد في ضوء هذا التعريف أن أبرز شأن الاجتهاد في البناء التشريعي الإسلامي، ودوره ووظيفته في إنتاج الفقه، وحل المشكلات الناشئة عن تطور الحياة وتغيّر حركة المجتمع وأوضاعه وحاجاته ونظمه.
والحديث عن الاجتهاد ذو شجون؛ بدءًا من كونه أهمَّ وأدقَّ مباحث علم أصول الفقه، بل هو الغاية العالية والثمرة المرجوة من دراسته وتحصيله، ولذلكم قال الشوكاني: "فإن هذا العلم أساس فسطاط الاجتهاد[2]."
بيد أنه من المناسب اللائق بمقاصد هذا الملتقى وأولوياته أن أركز الحديث على التقريرات المنهجية العامة المهمة التي تسعف بتصور واضح عن أهمية هذا الركن في الشريعة، ودوره في تقرير أحكامها؛ هذه واحدة.
والثانية: أن أبين حاجة الأمة الضرورية إلى استعماله وتجديده، وإن كانت هذه الحاجة عند علمائنا مُسَلّمة بدَهية لا تفتقر إلى إثبات أو برهان، ولم تكن محل جدل عند الأقدمين حتى تحتمل الملاحاة والتأجيل لدى المعاصرين، ولاسيما بعد أن قامت في وجوههم تحديات رهيبة وتغيرات هائلة في شتى المجالات.
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن الاجتهاد هو بمثابة الروح للشريعة ومنبع الحياة لفقهها، ولا يتصور أن تؤدي الشريعة وظيفتها، وأن يكون لها فقه حيّ مَرِن مُتجدّد يستجيب لمتطلبات كل عصر ونوازله دون إعمال الاجتهاد.
والدليل على أن الاجتهاد روح الشريعة وسبيل مرونتها وجِدّتها، أنه لا ينفك أبدا عن مشروع الإسلام نفسِه ومهمتِه وخصائصِه. فالسؤال الذي يتداعى إلى الخاطر هنا: ما مقصود الشريعة من الخلق؟ وما الغاية من وضع الشريعة كلها؟ قال الأصوليون: "الشريعة جاءت لمصالح الخلق في عاجلهم وآجلهم"، وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقرأة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان[3]."
أما خصائص الإسلام المتفرعة عن وظيفته العليا ورسالته الكبرى فهي ثلاث:
ـ أولاها: خَصيصَةُ الختم؛ فالإسلام هو آخر الشرائع، ونبينا، صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الرسل، فالخاتمية أو ختم النبوة له معنى عميق وارتباط وثيق بمشروعية أصل الاجتهاد في الإسلام، وقد وقف عنده طويلا الأستاذ محمد إقبال في كتابه: "تجديد الفكر الديني[4]"؛ إذ جعل خصيصة ختم النبوة أو الخاتمية روح النظام الثقافي للإسلام، وجعل مبدأ "الاجتهاد" أساس الحركة لبناء مشروع الإسلام الاجتماعي العام.
ـ الخصيصة الثانية: الأبدية أو الخلود؛ أي أن رسالة الإسلام ليست موقوتة بزمن محدد، بل هي رسالة خالدة أبد الدهر، ولذلك استدل العلماء بحديث: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" على أنه لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، وأن الأمة لابد أن يوجد في علمائها قائم مجتهد كما قال الشنقيطي في مراقي السعود:
والأرض لا عن قائم مجتهد *** تخلو إلى تزلزل القواعد
وقال الجويني رحمه الله: "لست أحاذر إثبات حكم لم يدوّنه الفقهاء ولم يتعرّض له العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يُلفى مدونا في كتاب، ولا مضمّنا لباب... ولكني لا أبتدع ولا أخترع شيئا، بل ألاحظ وضع الشرع وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه، وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء معدّة، وأصحاب المصطفى، صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم، لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة، وأحكاما محصورة محدودة، ثم حكموا في كل واقعة عنّت، ولم يجاوزوا وضع الشرع ولا تعدّوا حدوده، فعلّمونا أن أحكام الله تعالى لا تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة."[6]
فإذا كانت الشريعة بمقاصدها وخصائصها كما وصفنا، فكيف يعقل أن تكون صالحة وخالدة وعامة، وأن يكون لكل حادث واقع أو متوقع حكم فيها دون إعمال آلية الاجتهاد ووظيفته الحيوية في التوسط بين خطاب التكليف والعقل، أو بين خطاب التكليف والمصلحة، أو بين الأوامر الشرعية والواقع الإنساني بأبعاده الزمانية والمكانية.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فكما قلت آنفا إن حاجة الأمة إلى الاجتهاد لم تكن محل جدل عند الأقدمين حتى تحتمل التردد أو التأجيل عند المعاصرين خصوصا بعد أن قامت في وجوههم اليوم تغيرات هائلة وتطورات مذهلة في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتداخلت العلاقات الدولية، وانتقصت أطراف الأرض، واشتد التمازج بين الثقافات والأقوام والأمم، وأضحت الأنظمة الدولية والمواثيق العالمية ونظم المبادلات والمعاملات جزءًا من القوانين الوطنية... في الوقت الذي تراجع فيه الاجتهاد وضاقت مساحة العلم الاستدلالي المستقل، وساد ضمور في الفهم ممّا أخل بالتوازن الاجتماعي، وانقسم الناس إلى فريقين أحدهما أيس من النظام الفقهي فأشاح بوجهه عنه وخطف بصره بالتنوير الغربي "التنوير الذي عرفه "كانت" بأنه تفكير بلا سقف لا يهديه كتاب ولا يرشده قسيس" والثاني لم يفهم من النصوص إلا بعض الظواهر يحاول أن يعيش في الماضي على حساب الحاضر والمستقبل، فقل علمه وكثر خَطَله.
وثمة فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بقوة منهجها وصواب نظرها حاولت أن تصوغ منهجا جامعا بين إرشاد الوحي وسداد العقل، مستوعبا أصول التعامل مع الكتاب والسنة في منطوقهما ومفهومهما، ونصوصهما ومقاصدهما.
إن هذا المنهج يوسّع دوائر الاجتهاد ليرشح الكلّيات ويبرزها ويرجّحها على النظر الجزئي الذي جعل الأمة تغرق في مناقشة الجزئيات والتفاصيل من غير بناء على أصول كلية، مما جعلها تعيش في خصومة مع التاريخ، واصطدام مع طبائع العمران وسننه. إنه منهج اجتهادي مركّب من ثلاثة أصول كلية: الشريعة نصوصا ومقاصد، ومصالح الناس أفرادا وجماعات، وموازين الزمان والمكان.
هذا المنهج التجديدي يشدد على ملاحظة الكُلّيات، ويعيد الاعتبار إليها عملا بمعنى قول الشاطبي رحمه الله: "إن اختلال الكلّي يؤدّي إلى انخرام نظام العالم"[7]. ونحن اليوم بأمس الحاجة لضبط الكليات وتوضيحها وتحريرها وردّ مختلف الجزئيات إليها، كما أننا بحاجة إلى التأصيل والتقعيد لمفاهيم كلية جديدة ينطلق منها النظر الاجتهادي في شتى المجالات.
ولعل حاجة الاجتهاد المعاصر إلى ضبط المفاهيم الكلّية التي تشكل "رؤية العالم" لدى كل أمة وفي كل مرحلة، وإحكام الربط بين الكليات والجزئيات التي تقذف بها حركة الحياة وتطور المجتمع، لا يقل أهمية وشأنا عن العلم بالأدلة الجزئية ومعرفة تفاصيل الحوادث المستجدّة؛ إذ إن إغفال القواعد أو المبادئ الكلية التي توجه السلوك الإنساني، وتنتظم مختلف قضايا الواقع وظواهره وجزئياته يؤدي إلى وضع الأحكام الشرعية في غير موضعها، كما أن الغفلة عن تقييدها بموازين الزمان والمكان قد يفوت المصالح المرجوة من ورائها، ولذلك قال أبو حامد الغزالي: "تحقيق المناط تسعة أعشار نظر الفقه"[8]؛ وتحقيق المناط هو معرفة حقيقة ما يُحكم عليه من فعل أو ذات أو علاقة أو نسبة ليكون المحكوم به مطابقا لتفاصيل الواقع ومنطبقا عليه، أو بعبارة أخرى: معرفة المناسبة أو العلاقة البينية بين الحكم والموضوع، ولم يشترط في معرفة الموضوع العلم باللغة العربية ولا بمقاصد الشريعة؛ لأنه اجتهاد في معرفة محل الحكم لا الحكم ذاته؛ قال الشاطبي رحمه الله: "قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية؛ لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قصدت المعرفة به، فلابد أن يكون المجتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيها ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى[9]."
وأتصور أن مسالك الاجتهاد والاستدلال اللغوية التي ترجع إلى مُفاد الألفاظ وعوارضها لا تقتضي منا بحثا جديدا، ولكن لنا في منهج تطبيق الأحكام، وتحقيق المناطات، والموازنة بين العلل، وتصفح المصالح مجالا واسعا وسبحا طويلا. وإن الاجتهاد في هذا المقام يقتضي تصفح قواعد الشرع، واستحضار القواعد الفقهية الكلية، وسبر المصالح وأنواعها ورتبها، والنظر في تعيين محل الأحكام بعد ثبوتها وتبيّنها، كما يستدعي الاستعانة بالمعارف والخبرات التي تدخل في تشكيل عناصر الحكم الاجتهادي لتحصيل معرفة دقيقة بالحوداث الجديدة على ماهي عليه، والتحقق من انطباق كليات الفقه عليها.
ولقد كان هذا الاجتهاد التحقيقي السر الأعظم في دوام الشريعة وعمومها وخلودها، وعصرنا هذا أحوج إلى هذا النوع من الاجتهاد نظرا للتّغير العميق الرهيب الذي اعترى حياتنا الخاصة والعامة، ولأن الأوضاع انقلبت انقلابا تاما بحيث أضحت المسائل المدوّنة في كتب الفقه قليلة النظائر في الحياة العملية المعاصرة، وذلك هو الذي جعل مشكلة الاجتهاد مُصوّرة في زماننا هذا بما لم تُتصَوّر به في القرون السابقة، ولا يمكن أن تتصَّور به! فنظام الحكم، والفكر السياسي والدستوري، والقواعد الأساسية للحكم الإسلامي، والعلاقات الدولية في السلم والحرب، والمعاهدات والمواثيق بين الدول، والمجالس النيابية، والفصل بين السلط، وأجهزة الإنعاش، وأطفال الأنابيب، وبنوك الحليب، وزرع الأعضاء، وقوانين التوريد والتصدير، وقوانين الملاحة البحرية والصيد، والشغل، والضرائب، والعقود الإلكترونية، والمؤسسات المالية العملاقة والشركات عابرة القارات، وعقود التأمين، والقوانين اللازم مراعاتها في المرافعات والدعاوى وفصل الخصومات، وتسجيل العقود، وتنفيذ الأحكام، ونظام التوكيل أو المحاماة... كل ذلك مما يتعيّن عرضه على النظر الاجتهادي قصد الكشف عن حكمه الشرعي.
وفي الختام
لا يمكن خروج الأمة من جحر الضب الذي دخلت فيه إلا بتجديد الاجتهاد، وذلك رهين بثلاثة أمور ضرورية مهمة:
أولها: توسيع دوائر الاجتهاد بأنواعه الثلاثة؛ (الاجتهاد البياني، والاجتهاد المصلحي، والاجتهاد بتحقيق المناط) بتوسيع إطاره النظري العام، وتجديد المفاهيم الكلية التي يصدر عنها في "رؤية العالم"، وضرورة مقاربة الظواهر والعلاقات والوقائع والأوضاع المنتمية إليه من خلالها وبمراعاتها، حتى ينضبط التعامل مع الجزئي سواء كان دليلا أم قاعدة أم قضية لهذا الإطار الكلي في مختلف مراحل النظر الاجتهادي ومراتبه، وحتى يُتفطن إلى أثر الزمان والخبرة الإنسانية وتغير الوسائل والأوضاع في تطور تلك المفاهيم الكلية وتحولها. إنها كليات، كما تقدم، ذات شُعب ثلاث: (الشريعة، والمصالح، وموازين الزمان والمكان). وإن اختلال أحد هذه العناصر في العملية الاجتهادية والتنسيق بينها يؤدّي إلى اضطرابها وانخرامها.
الثاني: تنظيم الاجتهاد؛ وذلك بتعيين مَحالّه وأهله، وتنقيح أحكامه، وتدوين مسائله، وترتيب خططه وهيآته وفق النظام المؤسساتي الحديث الذي يمنع انفراد الآحاد بالتشريع فيما يتصل بالمصالح العامة، ويلح على تقديم صيغة متكاملة لدور الاجتهاد في علاقته بباقي مؤسسات الدولة المنوط بها مهمة التشريع؛ بتحديد مهام المجتهدين وضبطها وترسيمها بما يضمن لأحكامهم قوة تشريعية معتبرة ولقراراتهم الملزمة نفاذا. ولن يتم تنظيم الاجتهاد إلا بشروط من أهمها أن ينظر العلماء إلى التراث الفقهي نظرة فاحصة قصد تنقيح الأحكام الاجتهادية المنتشرة في الكتب والدواوين، وجمعها في ديوان جامع بعد التنقيح والترتيب واختيار حسن التبويب، وحذف ما لا يحتاج إليه من الأقوال، والاقتصار على الراجح أو ما به العمل وفق آليات الاجتهاد الترجيحي، والتماس المخارج للحوادث الجديدة التي جاء بها الوقت مع مراعاة الأوضاع والعوائد التي لا تضاد قواعد الشرع.
ولا مناص للأمة من المبادرة إلى هذه الخطوة وتجاوز الجدل الذي أثير حولها، وذلك قصدَ ضبط الفقه الإسلامي وتقريبه وتيسيره، ليتبوأ مكانه الطبيعي في مؤسسات القضاء والتشريع.
الثالث: إقامة الشروط العمرانية والحضارية لعملية الاجتهاد؛ إذ الاجتهاد في حقيقته ووظيفته استثارة وبذل أقصى الطاقات الفكرية للإبداع، فيندر أن يستقيم أو يتأتى في بيئة تتسم بالفتور العلمي العام، وطغيان الاستبداد والجمود والأمية والتخلف والفقر حيث يقف الواقع السياسي أو المجتمعي عائقا في سبيل القوى الفكرية والمعنوية وانطلاقها وتألقها. وإذا نظرنا إلى تاريخ الأمة الإسلامية نلاحظ أن عصور الاجتهاد كانت هي عينها عصور الازدهار الحضاري، وما إن أخذ مسار الأمة ينحطُّ حتى أصيب الفكر بالجمود ونادى المنادي بإغلاق باب الاجتهاد. فالنشاط الفكري مظهر بارز من مظاهر تقدم الأمم، وهو لا ينفك عن أوضاعها السياسية والثقافية والاجتماعية؛ فالاجتهاد هو ركن العمران الركين الذي لا يمكن أن ترتقي أمة ولا ينتظم أمر حكومة مدنية بدونه، بل وجود السياسة الحق؛ والإمامة الحق، كما يقول محمد رشيد رضا، يتوقّف على هذا الاجتهاد. ومن هنا تتجلى ضرورة تحقيق شروطه الثقافية والاجتماعية بمعانقة الأمة لمشروعه، والإيمان بواجب الاجتهاد كما تؤمن بواجب الصلاة والزكاة، والذي يتمثل في ضرورة إيجاد المجتهدين، ووضع الأسس الصحيحة لإعدادهم وتكوينهم في مختلف المجالات، وتهيئة الظروف الملائمة لاضطلاعهم بمهامهم وإزاحة العوائق المادية والمعنوية التي تعترض سبيلهم. وقديما أصاب محمد الحجوي الثعالبي المحزّ حين قال: "ندرة المجتهدين أو عدمهم هو من الفتور الذي أصاب عموم الأمة في العلوم وغيرها، فإذا استيقظت من سباتها، وانجلى عنها كابوس الخمول، وتقدمت في مظاهر حياتها التي أجلُّها العلوم، وظهر فيها فطاحل علماء الدين مع علماء الدنيا، فيظهر المجتهدون[10]."
الهوامش
[1]. هكذا عرفه الشيخ عبد الله دراز في تحقيقه للموافقات، ج4، ص89. وانظر كذلك: محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت، ص306.
[2]. "إرشاد الفحول" الشرط الرابع، ج1، ص421.
[3]. محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ص63.
[4]. محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، ط3، 2006.
[5]. الإمام الشافعي، الرسالة، ص: 20.
[6] - غياث الأمم والتياث الظلم، لعبد الملك الجويني، أبو المعالي (478هـ) تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، و د. مصطفى حلمي، دار الدعوة 1979م، الاسكندرية، ص: 196-197.
[7] - انظر الموافقات، 2/16-17.
[8]. أبو حامد الغزالي، كتاب المنخول في علم الأصول.
[9]. الموافقات: 4/527.
[10]. الفكر السامي: 2/460.






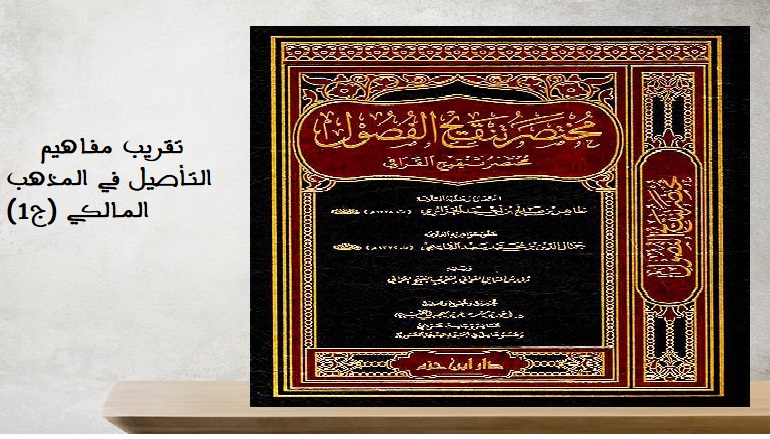
بسم الله الرحمن الرحيم
إن ضبط الاجتهاد من أوجب الواحبات في هذا الزمان حيث استطال عليه كثير من المتفيقهين وغير المتخصصين، لذلك كان عرض الأستاذ الدكتور عبد الحميد عشاق الذي أجاد فيه حيث بين خصائص هذه الشريعة السمحة والتي تتمثل في الربانية والعموم والإحاطة والأبدية والخلود ، ثم ضبط الاجتهاد وذلك بتوسيع دوائر الاجتهاد وتنظيمها كما أشار إلى مسألة مهمة وهي إقامة الشروط العمرانية والحضارية لإجاع الاجتهاد إلى مكانه الصحيح والدفع بهذه المة إلى استرجاع مجدها التليد والسلام.