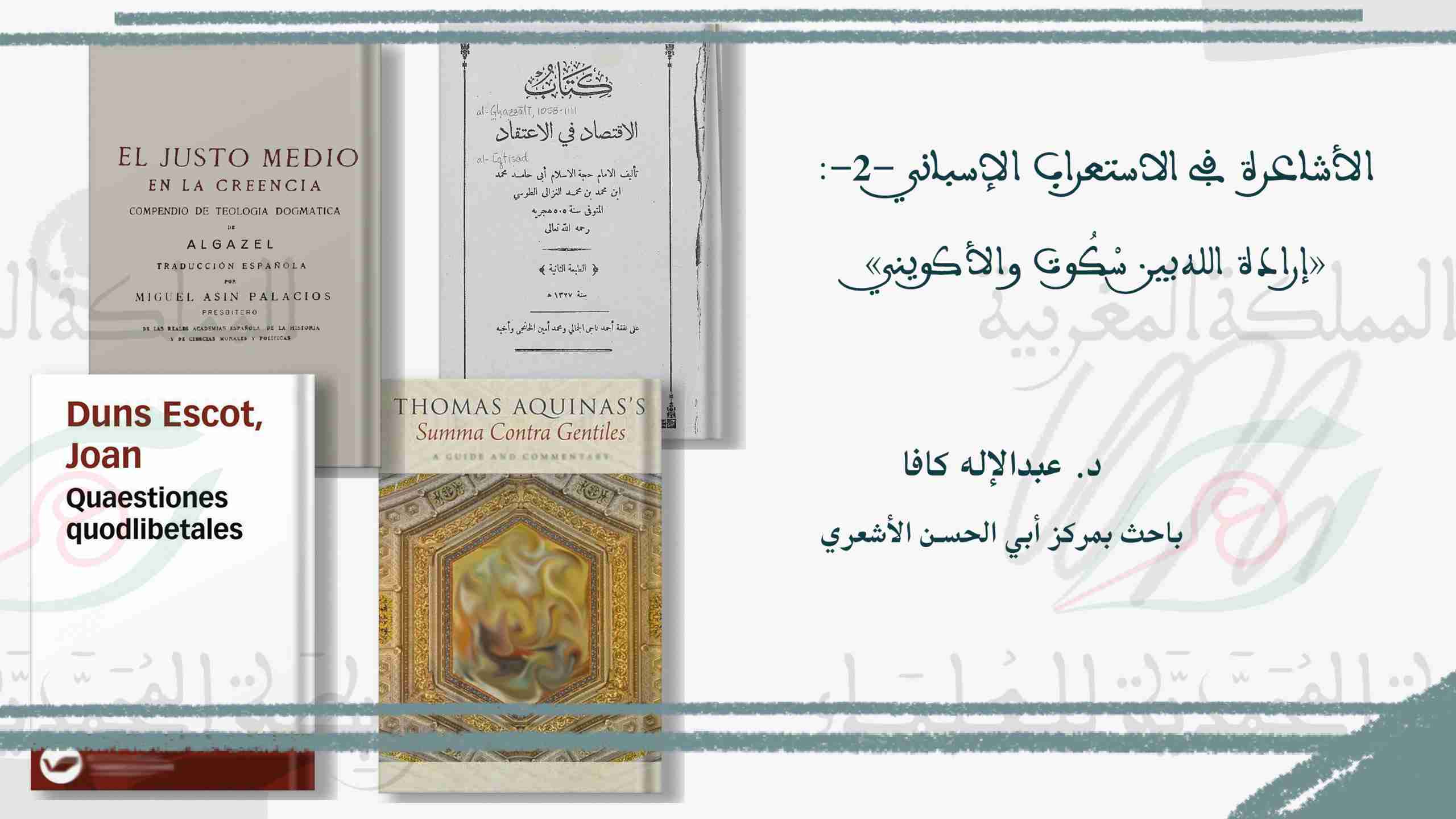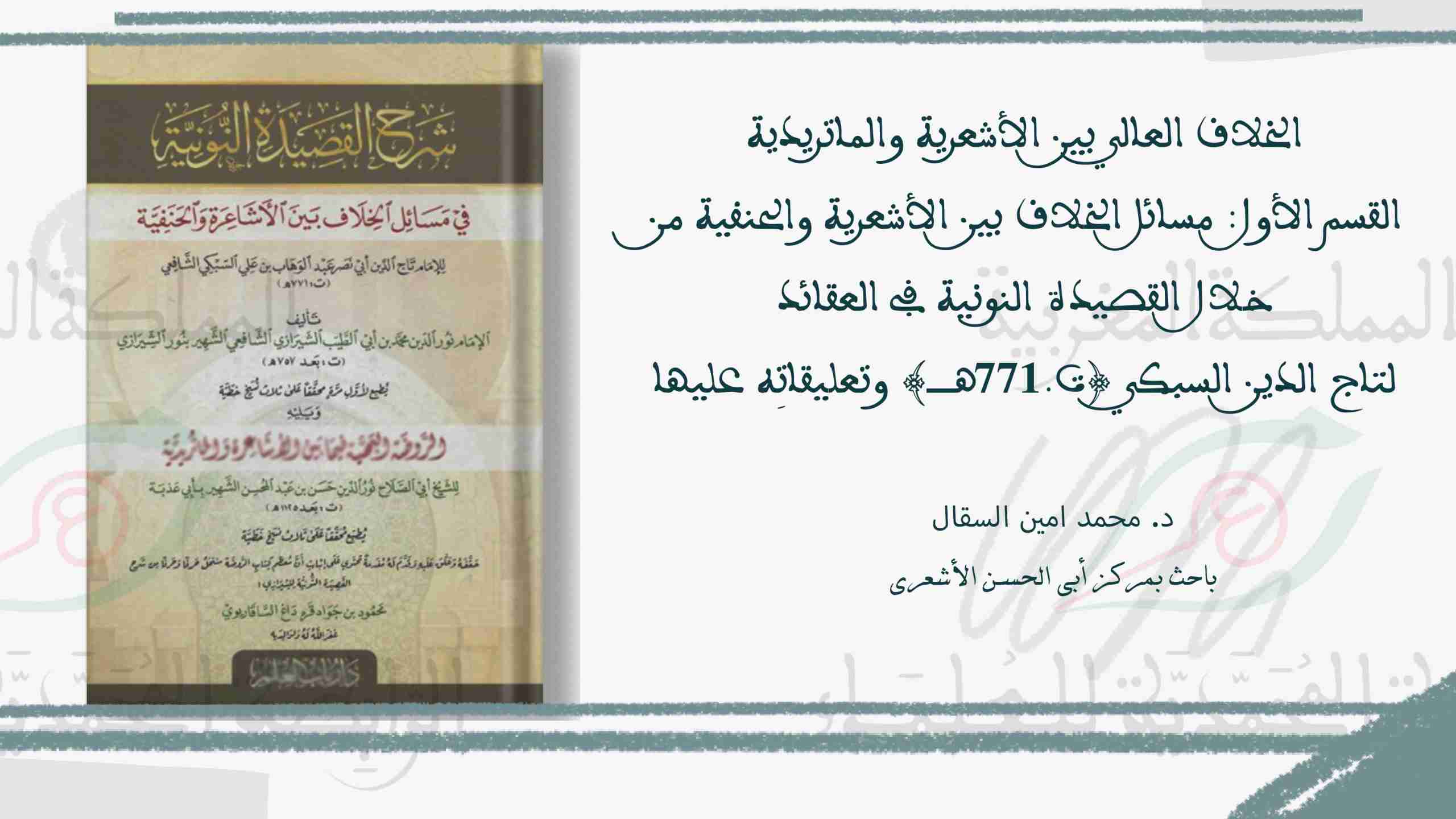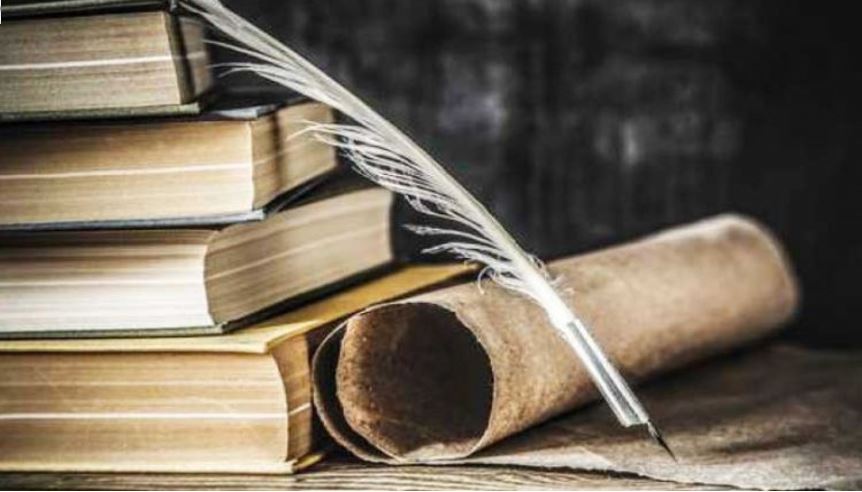دراسة في حقيقة الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم.. من الأصل اللغوي إلى التنوع الدلالي

تعد اللغة العربية من أهم اللغات الحية من حيث غناها وجماليتها، وكذا من حيث تعدد خصائصها وقدرتها التعبيرية عن المعاني المختلفة حقيقة ومجازا، بألفاظ متعددة ترتبط في ما بينها بعدة علاقات منها ما هو اشتقاقي، وما هو مفهومي ونحو ذلك من العلاقات المميزة لهذه اللغة المباركة.
قال سيبويه مقسما كلام العرب: "اعلم أنّ من كلامِهم اختلاف اللفظينِ لاختلاف المعنيينِ واختلافَ اللفظينِ، والمعنى واحدٌ واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين... فاختلافُ اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو جلسَ وذهبَ، واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ نحو ذهبَ وانطلقَ، واتفاق اللفظين والمعنى مختلِف قولك وجَدتُ عليه، من المَوْجِدة، ووجَدت إذا أردت وجدان الضّالَّة، وأشباه هذا كثيرٌ[1]."
كان هذا التقسيم مرجعا للغويين في اعتبار المشترك اللفظي قسما من أقسام دلالة الألفاظ عند العرب.
غير أن ظاهرة المشترك اللفظي عامة، والتضاد خاصة، كانت أيضا موضع خلاف بين اللغويين قديما وحديثا، حيث انقسموا بشأنها إلى منكر لوجودها في كلام العرب ومثبت، والمثبتون انقسموا إلى مكثر من شواهدها ومقل، كما انقسموا إلى القول بوجود هذه الظاهرة في القرآن الكريم، ونفي وجودها فيه، وتبعا لهذه الآراء كثر التصنيف في هذه الظاهرة قديما وحديثا، ولعل هذا التصنيف عموما كان بدافع الانتصار للقرآن الكريم واللغة التي بها نزل، وذلك عند الفريقين على السواء:
فالمثبتون لظاهرة المشترك اللفظي، ومنها الأضداد، كان دافعهم الأقوى في ذلك إثبات ثراء لغة القرآن وجماليتها، بينما رأى المنكرون أن هذه الظاهرة اللغوية تؤثر على دلالة ألفاظ القرآن الكريم، وتضفي على بعضها غموضا في الدلالة لا يتناسب مع البيان باعتباره خصيصة من خصائص الشريعة عامة والخطاب القرآني خاصة.
انطلاقا من هذه المعطيات سيحاول هذا البحث دراسة هذه الظاهرة عامة، ثم الوقوف عند بعض الألفاظ التي اعتبرت من المشترك اللفظي، أو من الألفاظ التي يراد بها المعنى وضده حسب القائلين بذلك، ورد هذه الألفاظ إلى أصولها اللغوية للتأكد من كونها وضعت في أصل اللغة لأكثر من معنى، أم أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى تنوع دلالتها بين معاني مختلفة أو متضادة، كما سيحاول هذا البحث، بمشيئة الله تعالى، الإجابة عن بعض الأسئلة المرتبطة بمدى صحة القول بوجود هذا النوع من الألفاظ في القرآن، وبعلاقتها، إن وجدت، بالبيان القرآني وكيفية فهمها في ضوئه.
وسأقسم الكلام في الموضوع إلى قسمين: فأتحدث في القسم الأول عن المشترك اللفظي، وفي القسم الثاني عن التضاد.
أولا: المشترك اللفظي
قال ابن فارس في فقه اللغة في باب الأسماء كيف تقع على المسميات: "يسمَّى الشيئان المختلفان بالاسمين المختَلِفين؛ وذلك أكثرُ الكلام؛ كرجلٍ وفرس، وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد؛ نحو عين الماء، وعين المال، وعين السحاب، ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة؛ نحو السيف والمُهند والحسام[2]."
قال السيوطي في المزهر، بعد أن أورد كلام ابن فارس: "والقسم الثاني مما ذكره هو المشتَرك الذي نحن فيه. وقد حدَّه أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة[3]."
من خلال التعريفين السابقين نفهم أن من شرط الحكم بالاشتراك أن يكون إطلاق اللفظ على معنيين أو معاني عند أهل لغة واحدة، وأن يكون هذا الإطلاق بالتساوي بين المعنيين أو المعاني دون أن يختص باللفظ معنى ويطلق على غيره مجازا.
كما يستفاد من تقسيمه دخول ما يعرف بالتضاد ضمن القسم الثالث: "وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد"؛ لأن الأشياء الكثيرة التي تسمى بالاسم الواحد هنا تنطبق على ما كان مختلفا وما كان متضادا معا.
كما يستفاد من كلام ابن فارس أن الاشتراك (والتضاد) من سنن العرب في الكلام؛ إذ يوحي تقسيمه بأنه يقرر أمرا معروفا حيث استعمل لفظ "يسمى" و"تسمى"...
غير أن هناك من اللغويين من أنكر وجود المشترك كما أنكر وجود التضاد من باب أولى، وعلى رأس هؤلاء المنكرين ابن درستويه (ت 347ﻫ) كما سيأتي قريبا في هذا البحث بمشيئة الله..
1. المشترك اللفظي والوجوه والنظائر
المشترك اللفظي لفظ عام يقصد به كل لفظ يحمل على معان متباينة، وقد تكون هذه المعاني مختلفة متقاربة المعنى، وقد تتباين معانيها حتى تصل إلى درجة التضاد، هذا التعريف هو بحسب معنى كلمة الاشتراك في أصل اللغة، غير أن المشترك في اصطلاح اللغويين يطلق ولا يراد به التضاد، فهم غالبا يطلقونه بالموازاة مع مصطلح الوجوه والنظائر عند المفسرين، قال ابن تيمية: "والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه، وبعض المتواطئة أيضا من المتشابه، ويسميها أهل التفسير: الوجوه والنظائر[4]."
وفي تعريف الوجوه والنظائر قال ابن الجوزي: "واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة، ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. فإذن النظائر: اسم للألفاظ، والوجوه: اسم للمعاني، فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر[5]."
وقال الزركشي في البرهان: "فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة والنظائر كالألفاظ المتواطئة وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني، وضُعّف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا آخر كالأمثال[6]."
يلاحظ أن صاحب البرهان نقل تضعيف ما قال به ابن الجوزي، وعرف النظائر بأنها غير الوجوه، بل قال إنها كالألفاظ المتواطئة، وإذا رجعنا إلى تعريف ابن الجوزي فهو يذكر هذا التعريف وكأنه يسميه بالوجوه والنظائر غير الحقيقية في مقابل الوجوه والنظائر الحقيقية السابقة في تعريفه حيث يقول: "وقد تجوز واضعوها فذكروا كلمة واحدة معناها في جميع المواضع واحد، كالبلد، والقرية، والمدينة، والرجل، والإنسان، ونحو ذلك. إلا أنه يراد بالبلد في هذه الآية غير البلد في الآية الأخرى وبهذه القرية غير القرية في الآية الأخرى. فحذوا بذلك حذو الوجوه والنظائر الحقيقية".
إذا تتبعنا صنيع معظم من ألف في الوجوه والنظائر، نجد أنه يتوافق مع تعريف ابن الجوزي، حيث يذكر هؤلاء في أبواب هذا الفن كلمات تأتي بلفظ واحد في القرآن، غير أن معانيها تختلف من استعمال لآخر حسب ما يفسرون به هذه الألفاظ من وجوه ومعاني، وابن الجوزي قال: "واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة، ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر" ثم قال: "فإذن النظائر: اسم للألفاظ، والوجوه: اسم للمعاني، فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر[7]."
غير أن كثيرا من التجاوز والتساهل صاحب معظم ما ذكره العلماء في باب الوجوه والنظائر؛ إذ إن القول بتعدد وجوه لفظ ما مما عدوه من هذا النوع، يرتفع بقليل تأمل، وقد نجد له مخرجا برده إلى أصله ومأخذه اللغوي اعتمادا على ما جاء في المعاجم اللغوية التي ترد الألفاظ إلى أصولها ككتاب المقاييس، وأمثل لذلك بلفظ الهدى:
جاء في الإتقان عن الوجوه: "وهذه عيون من أمثلة هذا النوع. ومن ذلك: الهدى، يأتي على سبعة عشر وجهاً. بمعنى الثبات: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾. والبيان: ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾. والدين: ﴿إن هدى الله هو الهدى﴾. والإيمان: ﴿ويزيد الله الذين اهتدوا هدى﴾. والدعاء: ﴿ولكل قوم هاد﴾ ﴿وجعلناهم أيِّمة يهدون بأمرنا﴾. وبمعنى الرسل والكتب: ﴿فإما ياتينكم مني هدى﴾. والمعرفة: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾. وبمعنى النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى﴾. وبمعنى القرآن: ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾، والتوراة: ﴿ولقد ءاتينا موسى الهدى﴾. والاسترجاع: ﴿وأولئك هم المهتدون﴾. والحجة: ﴿لا يهدي القوم الظالمين﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه﴾؛ أي لا يهديهم حجة. والتوحيد: ﴿إن نتبع الهدى معك﴾. والسنة: ﴿فبهداهم اقتده. وإنا على آثارهم مهتدون﴾. والإصلاح: ﴿إن الله لا يهدي كيد الخائنين﴾. والإلهام: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾؛ أي ألهم المعاش. والتوبة: ﴿إنا هدنا إليك﴾. والإرشاد: ﴿أن يهديني سواء السبيل﴾[8]."
وقال ابن فارس: "الهاء والدال والحرف المعتلّ: أصلانِ [أحدهما] التقدُّمُ للإرشاد، والآخر بَعثة لَطَفٍ.
فالأوَّل قولُهم: هدَيتُه الطَّريق هِدايةً؛ أي تقدّمتُه لأرشدَه. وكلُّ متقدِّمٍ لذلك هاد [..]ٍ وينشعب هذا فيقال: الهُدَى: خِلافُ الضَّلالة. تقول: هَدَيته هُدىً. ويقال أقبلَتْ هَوادِي الخيل؛ أي أعناقها، ويقال هاديها: أوّلُ رَعِيل منها؛ لأنّه المتقدِّم. والهادِيَةُ: العصا؛ لأنَّها تتقدَّم مُمسِكَها كأنَّها تُرشِده.
ومن الباب قولهم: نَظَر فلانٌ هَدْيَ أمرِهِ أي جِهتَه، وما أحسَنَ هِدْيَتَهُ؛ أي هَدْيَه. ويقولون: جاء فلان يُهادِي بين اثنَين، إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما. ورَمَيْتُ بسهمٍ ثمَّ رميتُ بآخَرَ هُدَيَّاه؛ أي قَصْدَه.
والباب في هذا القياس كلِّه واحد.
والأصل الآخر الهَدِيّة: ما أهدَيْتَ من لَطَف إلى ذي مَودَّة[9]."
إذا اعتمدنا الأصل الأول الذي هو التقدم للإرشاد، ومأخذ اللفظ من قولهم: "هدَيتُه الطَّريق هِدايةً؛ أي تقدّمتُه لأرشدَه" فإنه يصلح تفسيرا لكل ما ذكره السيوطي، فقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ مثلا يمكن أن يحمل على معنى الإرشاد إلى الطريق المستقيم، وقوله سبحانه: ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾، يحمل على أنهم متبعون للطريق الذي أرشدهم إليه ربهم بكتابه، وهكذا في باقي الوجوه التي ذكرها، فيكون الانطلاق من أصل الكلمة مع ربطها بسياق الآية ليتوصل إلى معنى اللفظ فيها، والله تعالى أعلم وأحكم.
وما قيل عن الهدى يمكن أن يقال عن كثير من الألفاظ التي ذكرت ضمن ما يحمل على وجوه مختلفة، والتي إذا تتبعناها نجد أن معظم تلك الوجوه إنما هي ما يحمل عليه اللفظ إما بالنظر إلى سياق الآية كما سبق و إما على وجه المجاز.
ومن أمثلة النوع الثاني ما قاله ابن الجوزي عن المطر، قال: "وذكر بعض المفسرين أن المطر في القرآن على وجهين: أحدهما؛ المطر المعروف. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: ﴿كان بكم أذى من مطر﴾ (الآية: 102). والثاني: الحجارة. ومنه قوله تعالى في قصة قوم لوط: ﴿وأمطرنا عليهم مطرا﴾ (الأعراف: 83)."
وقد يصح أن يقال إن اللفظ على وجوه مختلفة بالنظر إلى ما آل إليه معناه، بعد أن غلب بعض استعمالاته فأصبح يحمل عليه كما ما في مثال لفظ الذل الذي حمل على وجوه أيضا، قال ابن الجوزي: "الذل والخضوع يتقاربان.
قال الفراء: الذل والذلة بمعنى واحد".
ثم قال: "وذكر بعض المفسرين أن الذل في القرآن على ثلاثة أوجه:
ـ أحدها: القلة، ومنه قوله تعالى في آل عمران: ﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة﴾ (ءال عمران: 123).
ـ والثاني: التواضع، ومنه قوله تعالى في المائدة: ﴿فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المومنين﴾ (المائدة: 54)، وفي بني إسرائيل: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ (الإسراء: 24).
ـ والثالث: السهولة، ومنه قوله تعالى في هل أتى: ﴿وذّللت قطوفها تذليلا﴾ (الإنسان: 14).
وإذا رجعنا إلى أصل اللفظ، نجد أن الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي يمكن أن تحمل على المجاز؛ حيث قال ابن فارس: "الذال واللام في التضعيف والمطابقة أصلٌ واحد يدلُّ على الخُضوع، والاستكانة، واللِّين. فالذُّل: ضِدّ العِزّ. وهذه مقابلةٌ في التضادِّ صحيحة، تدلُّ على الحكمة التي خُصَّتْ بها العرب دون سائر الأمم؛ لأنّ العزّ من العَزَازِ، وهي الأرض الصُّلْبة الشديدة. والذِّلُّ خلاف الصُّعوبة."
فمعنى الذل في اللغة يتطابق مع استعماله القرآني، وإنما صرفه عنه الدارسون بعد أن اقترن بالمهانة في عرف اللغة بعد نزول القرآن، ولذلك راح اللغويون يبحثون عن مخارج للمسألة بعد إذ لم يستقم في تصورهم أن يصف الله المؤمنين بالذل الذي هو بمعنى المهانة مثلا، فقالوا إن المقصود بأذلة هنا القلة، والواقع أن أصل اللفظ الذي هو الليونة والخضوع والاستكانة ينطبق على المؤمنين قبل بدر وأثناء بدر؛ إذ إن قلة عددهم، وعدم تمرسهم بالقتال وانشغالهم بتلقي الوحي والخضوع له، وانصهارهم في حالهم الجديد الذي ملك عليهم حياتهم كلها وسخرها للآخرة والنظر إلى ما عند الله تعالى، جعل منهم فئة لينة الجانب متواضعة للحق، بعيدة عن الشدة والغلظة..
لكن الله تعالى أراد لهم حالين في آن واحد ولقنهم إياهما في بدر، وهو ما يظهر في الآية الثانية التي حمل فيها ابن الجوزي الذل على التواضع في قوله تعالى: ﴿أذلة على المؤمنين﴾ في مقابل قوله: ﴿أعزة على الكافرين﴾ وهذا المعنى يؤيده قوله سبحانه في سورة الفتح: ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾؛ فالشدة، هنا، بمعنى العزة في الآية قبلها، والرحمة، هنا، هي بمعنى الذل في الآية قبلها، والذل والرحمة يلتقيان معا في قوله سبحانه: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾، وقد سبق أن ابن الجوزي حمل الذل هنا على التواضع أيضا.
كما يؤيد هذا المعنى قول الطبري عند تفسيره لآية 54 من سورة المائدة: ثم نعتهم، فقال سبحانه: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى المومنين﴾ بالرحمة واللين، ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الكافرين﴾، يعنى عليهم بالغلظة والشدة، والله تعالى أعلم وأحكم.
لكن رغم ما سبق، فإن القرآن الكريم قد استعمل ألفاظا عدة استعمالات مختلفة متنوعة، وقد تتوزع السمات الدلالية لكل لفظ بين استعمالاته القرآنية، مما يعني أن الدارس لكي يُعرّف مفهوما قرآنيا ما، فإنه يتوجب عليه استخراج هذه السمات الدلالية من كل الاستعمالات للفظ المدروس، ثم جمعها للوصول إلى تعريف شامل لهذا اللفظ.
هذا من جهة المعنى العام للفظ في القرآن الكريم، أما لكي نفرق بين دلالات اللفظ الواحد بحسب استعمالاته، ونقترب من المقصود به في آية بعينها، فيجب الاستعانة بسياق الآية محل ورود اللفظ، وبمحددات أخرى كأسباب النزول وغيرها مما يعرف ضمن أدوات المفسر،أو أصول التفسير عامة.
2. الأضداد
كان هذا بعض ما يمكن قوله في مسألة تعدد معاني ألفاظ القرآن الكريم، أو المشترك اللفظي في القرآن، أما بالنسبة للأضداد فالأمر يختلف، ذلك أنه ينبغي النظر إليها من وجهين:
الأول؛ بالنظر إلى وجودها واقعا في اللغة، حيث إن دراسة وصفية بسيطة للمعاجم تؤكد وجود هذه الظاهرة وتحيل على عدد كبير من الألفاظ ذات المعاني المتضادة.
الثاني؛ بالنظر إلى أصل هذه الألفاظ في الاستعمال الأول في اللغة، وأصل وضعها عند أول استعمال لها، ومما يعين على معرفة هذا الأصل ما يسمى بمأخذ اللفظ أو أصله اللغوي عند العرب.
وبعد ذلك يمكن البحث عن حقيقة وجود هذه الألفاظ بالاستعمال وضده في القرآن الكريم؛ لأنه هو الذي يعنينا في هذه الدراسة.
تعريف الأضداد:
عرفها أبو الطيب اللغوي في كتابه: "الأضداد في كلام العرب" بقوله: "الأضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نافاه، نحو البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضدا له، ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان وليسا ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم، فالاختلاف أعم من التضاد؛ ،إذ كل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين[10]."
قال محمد نور الدين المنجد عن هذا التعريف بعد أن اختاره: "وبهذا التعريف أزال أبو الطيب الإبهام والاضطراب عن فكرة التضاد التي هي أخص من الاختلاف في معناها العام[11]."
وقد اختلف العلماء قديما وحديثا بخصوص وجود الأضداد في اللغة بين منكر ومثبت. كما كانت الأضداد أحد أهم أسباب الاختلاف بين المفسرين في تحديد معاني بعض الألفاظ التي قيل إنها من المشترك اللفظي.
غير أنه في البداية لابد من الإشارة إلى أن القائلين بالتضاد والقائلين بعدم وقوعه كلهم يتفق على أن بيان القرآن يقتضي عدم حمل اللفظ على المعنى وضده معا، يقولون ذلك في غير مناسبة الحديث عن التضاد، بل بمناسبة كلامهم عن معاني الألفاظ وطرق التفسير عامة، وإن احتفوا بالمشترك اللفظي وبحثوا عن شواهده في اللغة وفي القرآن معا، يقول السيوطي في الإتقان: "وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة. قلت: هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفاً، ولفظه: لا يفقه الرجل كل الفقه، وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعدد فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد".
غير أنهم سرعان ما يتجاوزون هذه القاعدة في معرض إثباتهم للتضاد في القرآن الكريم، فلا يجدون بأسا في تفسير بعض كلماته بالمعنى وضده، خضوعا منهم لهذه الظاهرة اللغوية، فالسيوطي نفسه، يعتبر المشترك من المجمل الذي يصحح وجوده في القرآن، ثم يمثل له بالتضاد الذي هو جزء من المشترك كما سبق، يقول: "المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافاً لداود الظاهري. وفي جواز بقائه مجملاً أقوال، أصحها: لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. وللإجمال أسباب: منها الاشتراك نحو والليل إذا عسعس فإنه موضوع لأقبل وأدبر، ثلاثة قروء فإن القرء موضوع للحيض والطهر[12]."
ويقول في موضع آخر مبينا أسباب الاختلاف في التفسير: "ومن التنازع الموجود منهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً لأمرين: إما لكونه مشتركاً في اللغة كلفظ القسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئاً في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين".
إذا رجعنا إلى وجود ظاهرة التضاد في واقع اللغة، ودرسناها دراسة وصفية، فلا يمكننا إنكارها، لكننا إذا استعنا بدراسة تاريخية تقوم على معرفة ظهور هذه الظاهرة، فإنه لا يسعنا إلا الاعتماد على المعاجم اللغوية التي تحدد أصل الألفاظ ومأخذها عند العرب، كما سبق أثناء الحديث عن المشترك اللفظي، ومن أبرز هذه المعاجم قديما كتاب المقاييس في اللغة لابن فارس، وحديثا كتاب "التحقيق في كلمات القرآن" للمصطفوي.
اعتمادنا على مثل هذه المعاجم يثبت أن الألفاظ في اللغة إنما وضعت لمعنى واحد، ولا يعقل أن يوضع اللفظ في أصل استعماله الأول للمعنى وضده لأن ذلك يناقض البيان، ويوقع في الإلباس الذي يتنافى مع الهدف من اللغة ومن وجودها، فهي "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" كما عرفها ابن جني (ت 392ﻫ)[13]"، ولا يعقل أن يعبر قوم عن أغراضهم بألفاظ وضعوها للمعنى وضده.
لكن تدخلت عدة عوامل عبر الأزمنة فأضافت لبعض الألفاظ معاني أخرى متباينة ومختلفة مع المعنى الأول، اختلاف تنوع في بعضها واختلاف تضاد في بعضها الآخر.
وهذه العوامل متعددة بحسب الدارسين لظاهرة التضاد، جمع منها محمد نور الدين المنجد اثني عشرة عاملا من كتب اللغويين القدامى والمحدثين على السواء، وقبل بها جميعا أسبابا لنشوء ظاهرة التضاد في اللغة، وهذه العوامل كما ذكرها هي:
ـ الوضع اللغوي الأول؛ أي أن التضاد من سنن العرب في الكلام، ﴿كما سبق نقله عن ابن فارس.
ـ تداخل اللهجات.
ـ الاقتراض من اللغات المجاورة.
ـ التطور اللغوي، الذي ينقسم إلى تطور صوتي وتطور دلالي.
ـ الأسباب البلاغية؛ كالحذف والاختصار، والاستعارة والمجاز.
ـ الأسباب الصرفية كأن تدل الصيغة الصرفية على الفاعل والمفعول معا مثلا.
ـ الأسباب الاجتماعية والنفسية؛ كالتفاؤل والتشاؤم الذي يؤدي إلى تسمية الشيء بضده مثلا، وكالسخرية وغيرهما، وهذا في ما يتعلق بالأسباب الاجتماعية، ومن الأسباب النفسية، مثلا، اجتماع المعاني المتضادة في النفس، واستحضار أحدها عند الحديث عن ضده.
ـ البدائية، أو ما سماه طفولة اللغة؛ بمعنى أن اللغة في بدايتها كانت قليلة الألفاظ مما دعا مع كثرة المعاني إلى استعمال لفظ واحد إزاء عدة معاني.
ـ قانون وحدة وصراع المتضادات؛ أي أن كل ضد سبب في اعتبار ضده ضدا، ولولا وجود أحدهما لما عرف الآخر، ومن هنا ارتباط الضدين ببعضهما البعض من جهة، وعمل كل منهما على نفي الآخر من جهة ثانية.
ـ علاقة الصوت بالمعنى.
ـ السبب والنتيجة؛ بمعنى أن اللفظ الواحد قد يدل على الفعل وعلى نتيجة هذا الفعل، فيطلق عليهما معا.
ـ غلبة التسمية بأحد الضدين، ويمثل لهذا العامل بلفظ المصعد الذي يعني الصعود لكنه أصبح يستعمل أيضا عند الحديث عن الهبوط، وبلفظ ميزان الحرارة الذي تقاس به أيضا درجة البرودة، ومثل لها عند القدماء بلفظ (تعال)، الذي يقصد به الدعوة إلى الاتجاه إلى مكان مرتفع، ثم أصبح يطلق على ضده أيضا[14].
هذا ما يتعلق بوجود الأضداد في اللغة العربية، ولكي نقف على حقيقة وجود التضاد في القرآن الكريم، فإنه يجدر بنا الرجوع إلى بعض الأمثلة التي أوردها الدارسون في هذا الباب، فمن أمثلة الألفاظ التي قيل بأنها تحمل على المعنى وضده، لفظ الصريم.
نلاحظ عند شرح هذا اللفظ أن ابن فارس يخضع لظاهرة التضاد ويفسر بها هذه اللفظة اتباعا لمن قال بالتضاد ممن سبقه من اللغويين والمفسرين، يقول: "فأمَّا الصَّريم فيقال إنّهُ اسمُ الصُّبْح واسم اللّيل. وكيف كان فهو من القياس؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَصْرِمُ صاحبَهُ ويَنصرِم عنه. قال الله تعالى: ﴿فأَصْبَحَتْ كالصَّرِيم﴾ (القلم: 20). يقول: احترقت فاسودت كاللَّيلِ. فهذا فيمن قاله إنَّه اللّيل[15]."
لكن عندما نرجع إلى أصل اللفظ عنده، فنجده يقول: "الصاد والراء والميم أصلٌ واحدٌ صحيحٌ مطَّرد، وهو القَطْع. من ذلك صُرْم الهِجران. والصَّريمة: العزيمة على الشيء، وهو قَطْعُ كلِّ عُلْقَةٍ دونَه[16]."
لكن عندما نرجع إلى الآية الكريمة التي ورد فيها لفظ الصريم، نجد تكلفا من المفسرين الذين حملوا الكلمة على التضاد، من ذلك ما قاله القرطبي: "فأصبحت كالصريم؛ أي كالليل. ويقال أيضا للنهار صريم. فإن كان أراد الليل فلاسوداد موضعها. وكأنهم وجدوا موضعها حمأة. وإن كان أراد بالصريم النهار فلذهاب الشجر والزرع ونقاء الأرض منه[17]."
بينما إذا حملنا الكلمة على أصلها اللغوي؛ بمعنى أن الجنة أصبحت كأن ثمارها قطعت واجتثت وسقطت عن أصولها، فإن هذا المعنى يكون أقرب إلى الأصل اللغوي دون أن يوقع في إشكال التضاد، وهذا التفسير قد أشار إليه أبو الطيب اللغوي نفسه بعد أن ذكر أن اللفظ من الأضداد حيث قال: "قالوا: وفي قول الله عز وجل: ﴿فأصبحت كالصريم﴾ يجوز أن يكون أراد المصروم[18]."
ويؤيد هذا المعنى ما قاله المصطفوي عند تحقيقه لأصل الصرم، قال: "والمراد من الصريم مطلق ما ينقطع ويتفرق عن الأصل، بحيث يكون ساقطا عن الحياة والنضرة والاستفادة منه[19]."
وكان قد قال قبل ذلك: "والتحقيق أن الأصل الواحد في المادة هو الفرق بالقطع، وليس بمطلق فرق ولا قطع، وهذا المعنى ينطبق على جميع موارد استعمالها[20]."
أما قول اللغويين إن الصريم يطلق على الليل والنهار معا، فذلك ينطبق على ما صاحبته قرينة تخصصه بأحد المعنيين، وإلا فإنه يطلق مقترنا بأحدهما، ويدل لذلك قول المصطفوي: "وليل صريم ونهار صريم أو منصرم: إذا انفصل وانقطع الاتصال بينهما[21]."
يتحصل من كل ما سبق أن مجمل آراء الدارسين لظاهرة التضاد تنقسم إلى الأقسام الموالية:
ـ قسم يرى أنها موجودة في كلام العرب، ومن ثم في القرآن الكريم، وأنها من سنن العرب في الخطاب وأنها من مظاهر جمالية اللغة واتساعها، وهذا القسم يدافع عن الظاهرة ويستشهد على وجودها في اللغة وفي القرآن معا، لكن هذا الفريق من الدارسين ينقسم بدوره إلى متوسع في ذكر شواهد هذه الظاهرة، فيذكر مئات من أمثلتها، وقسم آخر متحفظ في القول بوجود التضاد في القرآن الكريم خاصة، ولا يقول إلا بأمثلة محدودة منها.
ـ قسم يرى أنها وإن وجدت في اللغة، فوجودها ليس أصليا، بل هو حادث بسبب عوامل سبقت الإشارة إلى بعضها.
ـ قسم ينكر وجودها دفاعا عن العربية عامة وعن القرآن الكريم خاصة.
لكن بين القسم الثاني والثالث تقارب كبير بالنظر إلى أن المنكرين لوجود التضاد لا ينكرونه إلا من حيث أصل الوضع، وإلا فلا أحد يستطيع أن ينكر وجوده واقعا في كلام العرب ولا في كلام غيرهم؛ فالاختلاف بين الفريقين هو اختلاف غير حقيقي، لأنه ناتج عن اختلاف المقدمات الذي يفضي إلى اختلاف النتائج.
أما الفريق الأول، خاصة من قال بأن التضاد من سنن العرب في الخطاب، فهؤلاء أيضا لا يجزمون بأن العرب قد وضعوا اللفظ للمعنى وضده في وقت واحد؛ لأن أقصى ما يحتجون به هو روايته عن العرب دون تحديد زمن وضعه، فابن فارس الذي يحتج برأيه القائلون بالتضاد، وأنه من سنن العرب في الكلام، يقول: "وأنكر ناس هذا المذهب، وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده، وهذا ليس بشيء، وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي السيف مهندا، والفرس طِرْفا، هم الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحد[22]."
ومما يستغرب له في هذا المجال، أن ابن فارس الذي لم ينكر التضاد، يقول كلاما في نفس السياق يفهم منه إنكاره للترادف، مع أن أمر الترادف أخف في ما يتعلق بالبيان، وهو أدعى للقول بجمالية اللغة وسعتها، يقول قبل العبارة السابقة: "يُسمَّى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين، وذلك أكثر الكلام كرَجُل وفَرَس".
ونُسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، نحو: "عين الماء" و"عين المال" و"عين السحاب".
ويسمى الشيء الواحد بالأَسماء المختلفة. نحو: "السيف والمهنّد والحسام".
والذي نقوله فِي هَذَا: إن الاسم واحد وهو "السيف" وَمَا بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى.
وَقَدْ خالف فِي ذَلِكَ قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إِلَى معنى واحد، وذلك قولنا: "سيف وعضب وحُسام".
وقال آخرون: لَيْسَ منها اسم ولا صفة إِلاَّ ومعناه غيرُ معنى الآخر. قالوا: وكذلك الأفعال. نحو: مضى وذهب وانطلق. وقعد وجلس. ورقد ونام وهجع. قالوا: ففي "قعد" معنى لَيْسَ فِي "جلس" وكذلك القول فيما سواهُ.
وبهذا نقول، وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب[23]."
ثم يقول: "ونحن نقول: إِن فِي قعد معنىً ليس فِي جلس. ألا ترى أَنَّا نقول "قام ثُمَّ قعد" و"أخَذَهُ المقِيمُ والمقْعِدَ" و"قَعَدَتِ المرأة عن الحيض". ونقول لناس من الخوارج "قَعَدٌ" ثُمَّ نقول: "كَانَ مضطجعاً فجلس" فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن "الجَلْسَ: المرتفع" فالجلوس ارتفاع عما هو دونه. وَعَلَى هَذَا يجري الباب كلُّه"[24]."
إذا استثنينا من يقول إن التضاد من سنن العرب، وأنه يعود إلى الوضع الأول للغة، وحجتهم ضعيفة كما سبق بيانه، يتضح من خلال سبر أقوال القائلين بالتضاد والرافضين للقول به، أن الاختلاف بين الفريقين ليس اختلافا حقيقيا، ذلك أن القائلين بالتضاد أنفسهم يعللونه بأحد الأقوال السابقة التي ترجع التضاد إلى عوامل تاريخية ظهرت بعد وضع اللغة.
حيث نجد ابن الأنباري نفسه، الذي هو أشهر القائلين بالتضاد والمؤلفين فيه، يورد آراء تبين أن التضاد ليس أصلا في اللغة، بل هو ناشئ بسبب عوامل أخرى لا ينكر على القائلين بها، وهذا أحد الأقوال التي ذكرها ابن الأنباري في تفسير وجود التضاد، قال: "وقال آخرون: إذا وقع الحرف على معنيين متضادين؛ فالأصل لمعنى واحد، ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع[25]."
ثم ذكر عاملا آخر يتمثل في نقل بعض الأحياء لغة البعض الآخر باستعمال أدى إلى التضاد، قال: "وقال آخرون: إذا وقع الحرف على معنيين متضادين، فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما، ولكن أحد المعنيين لحي من العرب، والمعنى الآخر لحي غيره ثم سمع بعضهم لغة بعض، فأخذ هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء[26]."
فكأن الخلاف بين الفريقين غير ذي موضوع واحد، فالقائلون بالتضاد ينظرون إليه من حيث الواقع اللغوي، وما آلت إليه استعمالات الألفاظ؛ بمعنى أن دراستهم للظاهرة تعتمد الجانب الوصفي منها، بينما الرافضون يتحدثون عن رفض الظاهرة بالنظر إلى أصل وضع اللغة الأول؛ بمعنى أنه يستحيل في الذهن أن يوضع اللفظ لمعنى وضده في آن واحد، وفي لغة واحدة.
وجمعا بين الأقوال كلها نخلص إلى أن الأضداد موجودة في كلام العرب، ولكن لا يمكن تحديد زمن حدوثها في لغة العرب، خاصة إذا اعتمدنا رأي من قال إن سبب وجودها في اللغة يرجع إلى تداخل اللهجات أو التحريف الصوتي لبعض الكلمات كما سبق بيانه، ومن ثم نتساءل عن وجودها في القرآن الكريم، وأنا أفترض هنا أحد افتراضين:
الأول؛ أنها وجدت في اللغة العربية بعد نزول القرآن بسبب تداخل اللهجات الذي حدث بسبب دخول الناس في الإسلام، وأن ما يحمل من كلمات القرآن على التضاد إنما حدث في زمن متأخر عن نزوله بدليل أنها لم تُشكل على الصحابة في زمن النزول عند أول سماعها من الرسول، صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع معاني أخر، وكان يفترض عند سماعهم لكلمة تحمل معنيين عندهم أن يبادروا بطلب تحديد المعنى المراد في التنزيل.
الثاني؛ إنها إن وجدت في القرآن الكريم فوجودها قليل جدا عكس ما ادعاه المكثرون من جمع هذه الألفاظ، ويكون السبيل إلى معرفة ما يراد بها هو حملها على لغة قريش، كما أُمِر بذلك كتبة المصاحف[27]، كما أن الرجوع إلى سياق النص محل ورودها يعين في تحديد معناها؛ لأنه يبعد أن يكون المراد بها المعنى وضده معا؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإبهام الذي يتنزه عنه التنزيل، خاصة في قسم المحكم الذي منه آيات الأحكام، كما هو الشأن مع لفظ القرء مثلا، قال الزركشي في البرهان عن المشترك الذي يحتمل معنيين: "وادعاء أشعاره بالجميع بعيد[28]."
فيكون السبيل إلى معرفة حقيقة اللفظ اليوم، أو على الأصح ترجيح أحد المتضادين والقول به دون ضده، هو النقل عن الصحابة، فإن لم يوجد عنهم نقل فيرجع إلى سياق النص محل ورود اللفظ، وأقترح هنا أن تتولى جهة علمية ما حصر جميع الألفاظ التي قيل بتضادها ثم تحليلها، للقول بأحد المعنيين دون ضده.
الهوامش
[1]. سيبويه، الكتاب، باب اللفظ للمعاني، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الجيل، 1/24.
[2]. ابن فارس (توفي: 395ﻫ)، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق: أحمد صقر، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.
[3]. السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار الجيل ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1/369.
[4]. ابن تيمية، مجموع الفتاوي، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، ط3، (1426ﻫ/2005م)، ج13، ص276.
[5]. جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (توفى: 597ﻫ)، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، بيروت: مؤسسة الرسالة/لبنان، ط1، (1404ﻫ/1984م)،
[6]. بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، صيدا/بيروت: المكتبة العصرية، 1/102.
[7]. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، م، س.
[8]. جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، بيروت: دار الفكر، 1/143.
[9]. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (توفى: 395ﻫ)، مقاييس اللغة/هدي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الدار الإسلامية، (1410ﻫ/1990م).
[10]. أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي (توفي 351ﻫ)، كتاب الأضداد في كلام العرب، تحقيق: عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط2، 1996.
[11]. محمد نور الدين المنجد، التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، ط1، (1420ﻫ/1999م)، ص26.
[12]. النوع السادس والأربعون في مجمله ومبينه-الإتقان.
[13]. أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص- باب القول على اللغة وما هي، (نسخة إلكترونية).
[14]. انظر تفصيل هذه العوامل في كتاب: التضاد في القرآن الكريم، ص56-83.
[15]. مقاييس اللغة/صرم، م، س.
[16]. المصدر نفسه.
[17]. شمس الدين القرطبي (توفي: 671ﻫ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط2، (1384ﻫ/1964م)، 18/239.
[18]. ابن الأنباري، كتاب الأضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، صيدا-بيروت: المكتبة العصرية/لبنان، (1407ﻫ/1987م)، ص274.
[19]. الحسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن/صرم، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي (نسخة مصورة).
[20]. المصدر نفسه.
[21]. المصدر نفسه.
[22]. الصاحبي في فقه اللغة، باب الأسماء كَيْفَ تقع عَلَى المسميات.
[23]. المصدر نفسه.
[24]. المصدر نفسه.
[25]. كتاب الأضداد، م، س، ص8.
[26]. المرجع نفسه، ص11.
[27]. قال عثمان بن عفان، رضي الله عنه، لكتبة الوحي عند جمع القرآن في عهده: "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم" (الإتقان، م، س، 1/61).
[28]. البرهان، النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله، 2/208.