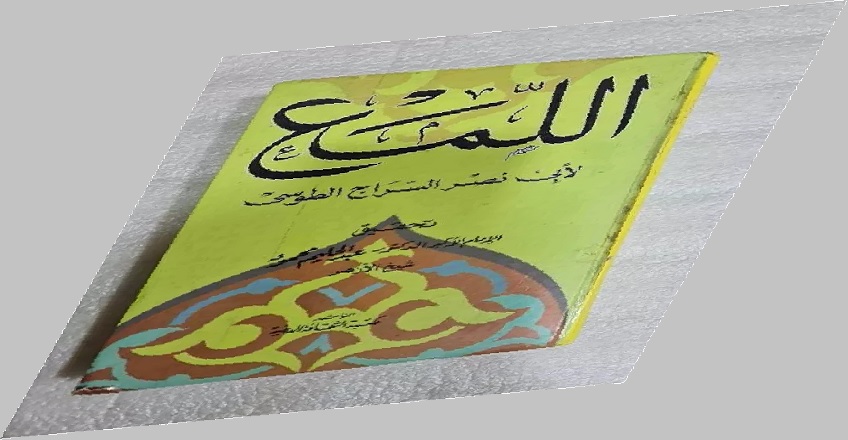قال العلامة: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، ت:1376هـ، في كتابه: (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي)، عند حديثه عن التقليد وأحكامه، تحت فصل: «هل يجوز الخروج عن المذاهب لضرورة أو مصلحة الأمة، وحال القضاء في هذه الأزمان وكيف ينبغي إصلاحه»، قال رحمه الله تعالى ما نصه:
(( ينبغي للأئمة أن يراعوا حالة الضرورات فيما تقضيه النظامات الوقتية، والأحوال العمومية لمُِجارات الأمم المتمدنة في مضمار الترقيات العصرية، وكثير من أحكام الشرعية لا سيما المعاملات والأحكام الدنيوية فيها مرونة مناسبة لحال التطور لإنبنائها على أعراف وعوائد تتغير بتغيرها، قال تعالى:(خذ العفو وامر بالعرف)[الأعراف:199، وقال عليه السلام: "كلي وولدك بالمعروف" 2 وكل حكم بني على عرف أو عادة فإنه يغير بتغيرها، وفي البخاري في كتاب البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة ... إلخ وساق أدلة على ذلك.
ثم إن الشريعة عامة صالحة لكل أمة، وكل زمان، فلا بد أن تتبع أحكامها الدنيوية الأزمان والأمم، لحفظ المصالح العامة، وحفظ البيضة، وارتقاء نظام المجتمع، وإن لم نعمل بهذا، جنينا على الشريعة جناية لا تغتفر، مثلا الرقيق كان تملكه مباحا لا واجبا في صدر الإسلام حيث كان الإسلام يعامل الأمم الأجنبية بمثل عملها، أما الآن فمنعه واجب لمصلحة عامة، ولا معنى لتعصب بعض العلماء في ذلك، فليس منعه خرقا لقاعدة من قواعد الإسلام الخمس، وأين هو الرقيق الذي يجادلون فيه هو كشيء محال، وكذا أخذ العين عن زكاة الماشية والحبوب جريا على مذهب أبي حنيفة والبخاري وبعض المالكية وأدلتهم من السنة ثابت لا يهدم أصلا من أصول الدين، وقتل المسلم بالكافر المعاهد جريا على مذهب أبي حنيفة، وله أدلة كتابا وسنة، وكفى قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 3 وقبول شهادة المعاهدين بعضهم على بعض جريا على قوله أيضا، وله دليله، بل قبول شهادة الكافر على المسلم، خليل: «وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين»، فأمثال هذه الأحكام هي جارية اليوم أحبَّ الفقهاء أم كرهوا، فلأن نجعل لها مخرجا وتجري على نظام، وباسم الشريعة خير من تعصب لا فائدة منه سوى العزلة، وسقوط هيبة الإسلام، ونبذ أحكامه كليا. فتأملوا رحمكم الله في أحوال وقتكم، وليس في إمكانكم إدارة الفلك حسب إرادتكم، ولا يجوز للعلماء أن يضيقوا على الأمة أو الدولة فيما لا مندوحة عنه وفيما به حياة الهيئة الاجتماعية "فإن خلاف علماء الأمة رحمة"، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه"، وإذا كان القاضي يحكم بالضعيف لدفع مفسدة، أو خوف فتنة، أو نوع من المصلحة، فالإمام أولى؛ لأن القاضي إنما هو نائبه، لكن لا ينبغي الترخيص في ذلك إلا عند التحقيق بمصلحة عامة لا خاصة، إبقاء لهيبة الشرع الأسمى، مثلا الحنفية لا يجوزون القياس في الحدود، وقد دعت ضرورة الوقت لسن زواجر من ضرب وحبس لمن فعل جرائم غير مذكورة في الكتاب والسنة كتأديب وال ارتشى، أو عامل، أو أمين اختلس مال الدولة، أو نحو هذا، فلا بأس بالحنفي أن يقلد مالكيا يرى أن الإمام يعزر لمعصية الله أو آدمي بأنواع التعازير، ثم تقدر تلك التعازير، وتبين بأنواعها، وتكون جارية على القوي والضعيف، لتنضبط الحقوق اقتداء بما فعل عمر من الزيادة في حد الخمر لما لم يبق كافيا بعدما استشار الصحابة، وتقدم ذلك صدر الكتاب، لكن هذا بعد تحقيق الضرورة ووقوعه من أهل الكفاءة والنزاهة والعلم والنظر، كما أن العقوبة بالمال قال بها عدد من الأئمة.
وكفى بما كتبه البرزلي فيها وإن أنكره منكرون، فله أدلته، فإن كان الجري على قوله يفيدنا مصلحة أو يدفع مضرة، فالحاجة في المذهب بمنزلة الضرورة، فلا مانع من التمسك بما تمسك به البرزلي ومن قبله، وإذا كانت التعازير تكون في الظهر، وبالسجن باجتهاد الحاكم، فالمال أهون، وفي المذهب المالكي من ذلك بعض فروع كأجرة العون تحمل على المال، ولا مانع على أن تقاس عليها صوائر الدعوى كلها إذا تبين لدد الخصم وتشغيبه، فكما أن صوائر هذه الدعاوى لم يكن في الصدر الأول وحدث، قبلتموه، وأكل منه القضاة وعدولهم، بل تمولوا، فلا مانع من حملها على الظالم، الذي هو أحق بالحمل، ولا موجب لحملها على المظلوم، فهو ضلال في الدين لم يكن في زمنه عليه السلام، ولا زمن الخلفاء ولا الصدر الأول تقيد مقال، ولا تقيد جواب، وإنما كان القضاء كما قال عليه السلام في الصحيح عن أم سلمة: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أبين بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها"، بعد ذلك حدث تقيد المقال والزيادة فيه، وحصره، وطلب بيانه وحصر الطلب، ورفع طلب البيان للمحكمين، فلا يصل المسكين طالب الحق للجواب حتى يصَيِّر شطر ما يطلب فضلا عن الحكم، فكما أحدثتم للحكم أجرة ثم أجرة أخرى لاستئنافه، وأجرة على الفتوى، وعلى الشهادات ونحو ذلك، وأحدثتم الصوائر، فالواجب أن تجعلوها من المبطل الذي تسبب فيها، ولا تضيعوا حق المظلوم، وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، لكني أظن أنه لو جعلت الصوائر على المبطل، لقلت الدعاوى، وكسد القضاة والمفتون، لذلك تركوا ذلك على الطالب، والله أعلم بالحقائق.
وهذا كله قد دعت الضرورة أو الحاجة إليه، وإلا فلا يجوز الإفتاء ولا القضاء إلا بالمشهور، أو الراجح إلا لضرورة كما سبق، نعم عند تحقق الضرورة أو المصلحة تعينت الفتوى بقول ولو ضعيفا، ولأجل الضرورة تذكر الأقوال الضعيفة في الكتب الستة الفقهية، بل قدمنا قبيل ترجمة التقليد أنه يتعين على الأمة الإسلامية تهيئة رجال مجتهدين، وإن ذلك متيسر ليكونوا عونا على تحسين القضاء والأحكام، وسن الضوابط والقوانين النافعة المطابقة للشريعة المطهرة، وروح العصر، وللمصالح العامة، مراعي فيها العدل، وإتقان النظم، ليجددوا للأئمة مجدها، ويسلكوا بها سبيل الرشاد، ويزيلوا عنها قيود الجمود المضر، ويعرفوا كيف يخلصونها من مستنقعات الأوهام، ومزال الأقدام، ويحفظوا بيضتها من الاصطدام، فإنه إن بقي قضاؤنا وأحكامنا على ما هي عليه من الفوضى من رقة الديانة، صار الناس إلى القوانين الوضعية، ونبذوا الشريعة ظهريا، وساء ظنهم فيها مع أنه لا ذنب على الشريعة التي فتحت باب الاجتهاد، وباب المصالح المرسلة ونحوها، وإنما الذنب على بعض من العلماء المقلدين الجامدين المتعصبين الذين جعلوا الدين أحبولة، ولا عيب على المتقدمين والسلف الصالح رضوان الله عنهم). انتهى منه بلفظه.
الفكر السامي: 2/717، طبعة: المكتبة العصرية، اعتناء: هيثم خليفة طعيمي، ط:1، سنة:1417هـ،2006م.