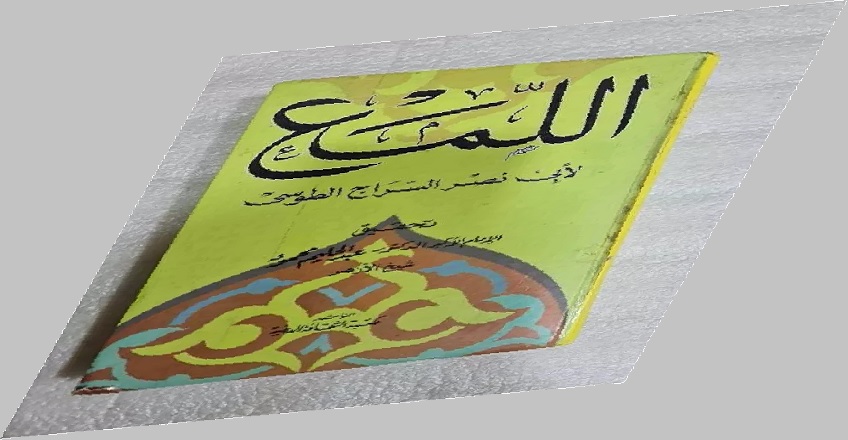"ما سماه الله سبحانه في كتابه: فقها، وحكمة، وعلما، وضياء، ونورا، وهداية، ورشدا، فقد أصبح بين الخلق مطويا، وصار نسيا منسيا..
ولما كان هذا ثلما في الدين مُلِمًّا، وخطبا مدلهمًّا، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما: إحياء لعلوم الدين، وكشفا عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإيضاحا لمباهي العلوم النافعة عند النبيئين والسلف الصالحين" [الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، 8/1].
ثمانية قرون ونيف مرت على هذا الكلام المبارك للإمام الغزالي، رحمه الله (ت 505ﻫ)، وقد قيل هذا الكلام نفسه، وأثيرت معانيه بصيغ متقاربة، قبل صاحب الإحياء وبعده، في اندراج تام ضمن قوله صلى الله عليه وسلم : "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" [أخرجه أبو داود في سننه، رقم 4291، والحاكم في المستدرك 568-567/4].
وهو كلام يمكن رصده في اللحظات التاريخية التي يكون فيها انفصال بين علوم الدين والنص المؤسس كتابا وسنة من جهة، وبينها وبين المجتمع من جهة ثانية، وهو ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله (ت 751ﻫ) في مدارج السالكين. حين قال: "سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي، واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زُبرا... درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم، فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم، فليسوا يرفعونها. وأفلَت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم، فلذلك لا يحبونها، وكُسفت شمسه عند اجتماع ظُلم آرائهم وعُقدها فليسوا يبصرونها.
خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنّوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين.." [مدارج السالكين 5/1]. وهو المعنى نفسه الذي نلمسه عند الإمام الشاطبي رحمه الله (ت 790ﻫ) في موافقاته حين يقول: "فإني شرعت في تأليف هذه المعاني، عازما على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني عليها عند القدماء... ليكون لك أيها الخِلّ الصّفي، والصديق الوفي، هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق، وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق، وليكون عمدتك في كل تحقُّق وتحقيق، ومرجعَك في جميع ما يعنّ لك من تصور وتصديق؛ إذ قد صار علما من جملة العلوم، ورسما كسائر الرسوم. وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم. لا جرم أنه قرَّب عليك المسير، وأعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير، ووقف بك من الطريق السابلة على الظهر، وخطب لك عرائس الحكمة ووهب لك المهر" [الموافقات 25-24/1].
لكن علامة المغرب الإمام الشاطبي رحمه الله، يستحضر كون دعوته التجديدية قد تكون مثار انتقاد وتشكيك، فيستبق بهدوء، وتمكن وإيجابية، ونسبية، وتواضع، الاعتراضات ويدحضها بجملة من التحريرات والتقريرات القبلية، بما يشبه المواكبة النفسية لخائض هذه اللجة؛ والتحصين بالحجة، من الشبهات مخمدا منها الضجة، وما أجمل تواضعه ونسبيته واحترازه، رحمه الله، حين يقول: "فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغرّ الظانَّ" أنه شيء ما سُمع بمثله، ولا أُلِّف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله، أو شكِّل بشكله، وحسبك من شرّ سماعه، ومن كل بدعٍ في الشريعة ابتداعه" فلا تلتفت إلى الأشكال دون اختبار، ولا ترم بمظنّه الفائدة على غير اعتبار، فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار.
وشدّ معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشدّ أركانه أنظار النظّار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول ما حواه، والاعتبار بصحة ما أبداه من الإقرار، حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل، ويطرق صحة أفكارهم من العلل، فالسعيد من عدت سقطاته، والعالم من قلت غلطاته.
وعند ذلك فحق على الناظر والمتأمل، إذا وجد فيه نقصا أن يُكمّل، وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام، واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام، حتى أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة دهره، فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوقه طوق الأمانة التي في يديه، وخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.." [الشاطبي 26-25/1].
التفطن نفسه نجد عنه تعبيرات مباشرة في كتابات بعض رواد العلماء المعاصرين.
فهذا علال الفاسي، رحمه الله (ت 1976م/1395ﻫ)، يقول في النقد الذاتي: "ولقد كان الإسلام رسالة تستمد قوتها من الوحي، وتستجيب في مطامحها لحاجة الفكر والروح، استجابتها لحاجة الجسم الإنساني في حدود الفطرة التي فطر عليها الإنسان، وإذا كان الوحي خاصا بصاحب الرسالة الأول؛ (أي من حيث الإيحاء وتقلبه)، فإن مهمة المواصلة لتحقيق الغاية التي بعث بها. وهي هداية الخلق إلى طريق السعادة في الدارين، لم تنته، ولن تنتهي أبدا، بل أصبحت ملقاة على عاتق من يشعرون بالمسؤولية، وينشدون الحرية من ذوي المعرفة والفكر من المسلمين، وأصبح تجديدها وتغيير أساليبها منوطين بكل رجال الإصلاح الذين يجب أن لا يخلو منهم جيل كي يصلحوا التحريف، ويحقوا الحق، ويزيلوا الزيغ، حتى يعود الفكر الإسلامي غضا طريا كما كان، وهل أدل على هذا من الحديث الشريف الذي يقول: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها". وإذا كان هذا الحديث خرج مخرج الوعد الإلهي، فإن له من سنن الدين وطبيعته ما يهيئ المسلمين لتحقيقه... على أن الذي يهمنا هو ما يشتمل عليه هذا الحديث من روح صريحة وضمنية تؤذن بأن الأمة الإسلامية تخضع للتطور كغيرها من الأمم الأخرى، وتنذر بأنه لا تمر مائة عام إلا وتكون في حاجة لبعث جديد ويقظة ثانية" [علال الفاسي، النقد الذاتي، ص127-126].
بيد أن بحاثة باكستان فضل الرحمن، رحمه الله (ت 1988م/1409ﻫ)، وهو يربط بمنهجية عالية الدقة، أزمة علوم الدين، بالانفصال عن النص المؤسس، يضيف عاملين آخرين هما: عدم تجريد الرؤية الكلية الناظمة الكامنة في الوحي، ليستهدى بهديها في سائر أعمال العلماء الاستنباطية، والثاني اختراق الفكر الهلينيستي للعلوم الإسلامية وفي ذلك يقول: "إن النقص وعدم الدقة في مناهج وأدوات العلوم الإسلامية، يرجع أساسا إلى غياب منهجية مناسبة لفهم القرآن نفسه، وقد بات ظاهرا وبينا وجود فشل في مجال استبانة معالم الرؤية الكلية الناظمة والتوحيدية الكامنة في القرآن، فشلٌ عززه الإصرار على التركيز على المقاربة التجزيئية الذرية لمفردات القرآن الكريم وآياته، بمنهج "التعضية"؛ (أي أخذا من قوله تعالي: "جعلوا القرءان عضين" [الحجر: 91]). وقد كانت نتائج هذه المقاربة الذرية للقرآن المجيد، أن الأحكام كانت في بعض الأحيان تؤخذ من آيات ليست أحكامية من حيث قصدها...
وفي غياب تجريد هذه الرؤية الكلية كانت الضريبة في مجال التشريع هي اختراق المناهج الدخلية لسد الفراغ الذي تركه غيابها مما كانت له آثار مدمرة في بعض الأحيان" [فضل الرحمن، الإسلام والحداثة ص2-3].
قبل الإمام الغزالي، رحمه الله، إذن، وبعده، كابد علماء كثر مسألة تجديد العلوم الإسلامية، فالإمام أبو حنيفة (ت 150ﻫ)، والإمام مالك (ت 179ﻫ). والإمام الشافعي (ت 204ﻫ). وكذا الإمام أحمد (ت 241ﻫ) واجهوا مشكلة المنهج في مجال التعامل مع النص والاستنباط منه، ولفيف المحدثين اجتهدوا في مضامير الرواية والدراية، ونخل الدخيل من الأصيل حتى صفّوا ووفّوا، رحمهم الله، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. والإمام الأشعري (ت 324ﻫ) رام جمع ورصد وتحليل وتأصيل مقالات الإسلاميين، كما حاول بناء إجماع إسلامي في مجال الاعتقاد، وبعده وارثه أبو بكر الباقلاني، رحمه الله (ت 403ﻫ)، والإمام الجويني (ت 478ﻫ) اشتغل بالتجديد في قضايا الإمامة والمجتمع والحكامة العملية في مجال التعامل مع النصوص الشرعية، والارتقاء بالعلوم الإسلامية إلى الوظيفية، والفقيه ابن رشد (ت 595ﻫ) اجتهد في تبيان ما بين الحكمة والشريعة من اتصال وتجاوز الثنائيات المستحكمة في علوم الدين وعقول المشتغلين بها، بين العقل والنقل، والإرادة والأسباب، كما تطلع إلى معالجة الفقه الخلافي والارتقاء به من ربقة النزاع والتأزيم، إلى آفاق الإيجابية والثراء، كما رأينا جهود مدرسة آل تيمية، وآل المقدسي، في كثير من القضايا المنهجية، ومحاولة العودة إلى الأصول ومنهج الصدر الأول، مع تميز ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت 728ﻫ) باجتهادات متعددة ونوعية في الفقه وأصوله، والتفسير، والمنطق، والسياسة الشرعية وغيرها.
كما أن عبد الرحمن بن خلدون (ت 803ﻫ) قاد حركة رائدة في مجال التأسيس للعلوم الاجتماعية، وإعادة تشكيل النسق الثقافي الإسلامي، في أفق إخراج عمران إسلامي قادر على استئناف نبضه وعطائه الحضاريين، دون نسيان ذكر رموز آخرين، من أمثال ابن حزم، والباجي، وابن عقيل، وملا صدرا، وشاه ولي الله الدهلوي، والنائيني، والشوكاني، والوزير الصنعاني، والآلوسي، والطباطبائي، وزروق، والأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي، والسنوسي، والمهدي، وابن باديس، ومحمد إقبال، وبديع الزمان سعيد النورسي، والمودودي، وأبو الحسن الندوي، ومالك بن نبي، وعبد القادر عودة، وإسماعيل راجي الفاروقي، ولويز لمياء الفاروقي، ومنى أبو الفضل، وغيرهم بفضل الله كثير ممن انتقلوا إلى رحمة الله، أو ممن لا يزالون أحياء بين ظهرانينا ولهم كسبهم البارز في هذه الحلبات المباركة.
ولئن كان ثمة من خلاصة، يمكن أن ينفصل بها المرء من مثل هذا الاستقراء الجزئي لمحاولات تجديد العلوم الإسلامية، فهي أن التجديد، ليكون ذا فاعلية ونفع اليوم، فلابد له من جملة شروط:
1. الاستيعابية: ونقصد بها الاستيعابية في مجال تمثل العلوم موضوع التجديد، من حيث المعرفة بها نشأة، ومضمونا، ومباحث، وسيرورة، ومقاصد، وثمرات ومشاكل، وبدون هذه الاستيعابية، فيعسُر تصوُّر تجديد مثمر..
2. التساؤلية: وهو شرط يُسلِمُ إليه سابقه، إذ لا يمكن دون استيعابية أن يفضى إلى مرحلة التساؤلية الفاحصة داخل هذه العلوم؛ والمؤدية إلى الوقوف على مدى انبنائها على النص المؤسس وانطلاقها منه وكذا الوقوف على مدى وظيفيتها، وواقعيتها، وعلى أنجع مناهج وأساليب التقويم والتجديد فيها.
3. المعرفية: ونقصد بها الغوص في بُنى هذه العلوم وأنساقها ومناهجها للتأكد من اندراجها في النسق المعرفي الذي جاء به الوحي.
4. الوظيفية: بحيث يتم الحرص على التأكد من مدى خدمة العلوم الإسلامية للإنسان فردا واجتماعا، وإعانته على تحصيل السعادتين في انضباط لضوابط التيسير ووضع الإصر والأغلال، وإحلال الطبيات، وتحريم الخبائث، التي بينها الوحي الخاتم (النص المؤسِّس).
5. الجماعية: ونقصد بها وجوب ارتكاز التجديد في مجال العلوم اليوم على العمل العلمي البحثي التجديدي الجماعي التكاملي وذلك لِتَفَرُّع الإشكالات ومجالات الإصلاح داخل هذه العلوم والمعارف، وهو شرط لن يكون تنزيله الاجتهادي ناجعا، إلا إذا توافرت الشروط الأربعة السالفة، مع إضافة أربعة شروط ضرورية أخرى وهي:
6. الانغمارية: ونقصد بها الانغمار الواعي والذكي، في هموم ومشاكل الإنسان محليا وكونيا لمعرفتها أولا، ثم الاجتهاد ثانيا لوجدان حلول وظيفية وعملية لها، انطلاقا من النسقين المعرفي والقيمي الإسلاميين، مما سوف يعطي للأداء الجماعي روحه ومقاصده ونفعيته.
7. الاستشرافية: بحيث لا يتم الاشتغال بالمهم وتأخير الأهم، وبالمفضول وإهمال الأفضل، كل ذلك في تحديد دقيق للأولويات وهندسة لها.
8. الحكامة والتدبير الجيدان: على المستويات الأكاديمي، والبشري، واللوجيستيكي، والزمني.. مما قد يجر إهماله إلى اضطراب في إنجاز شرط الجماعية. ولا شك أن من مقتضيات ذلك، الشرط الأخير، والذي هو:
9. التكوين الأساسي والمستمر: بحيث يتم بناء مناهج تكوين المكِونين والمكوَنين في ضوء الوعي بكل ما سلف، ليتم بعد ذلك، وتأسيسا عليه تنسيق جهود فرق البحث المنتقاة فكريا ونفسيا ووجدانيا واستراتيجيا ومواكبتها بالتكوين المستمر حتى يكون الأداء بحول الله مثمرا.
إن التجديد في علومنا الإسلامية كان وكما رأينا، دوما حاضرا وبطريقة عضوية عبر مسار أمتنا، تطلبا واجتهادا، كما أن هذا التجديد لاشك، أمر مصيري لها، وجوديا، فيما يستقبل من تاريخها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.