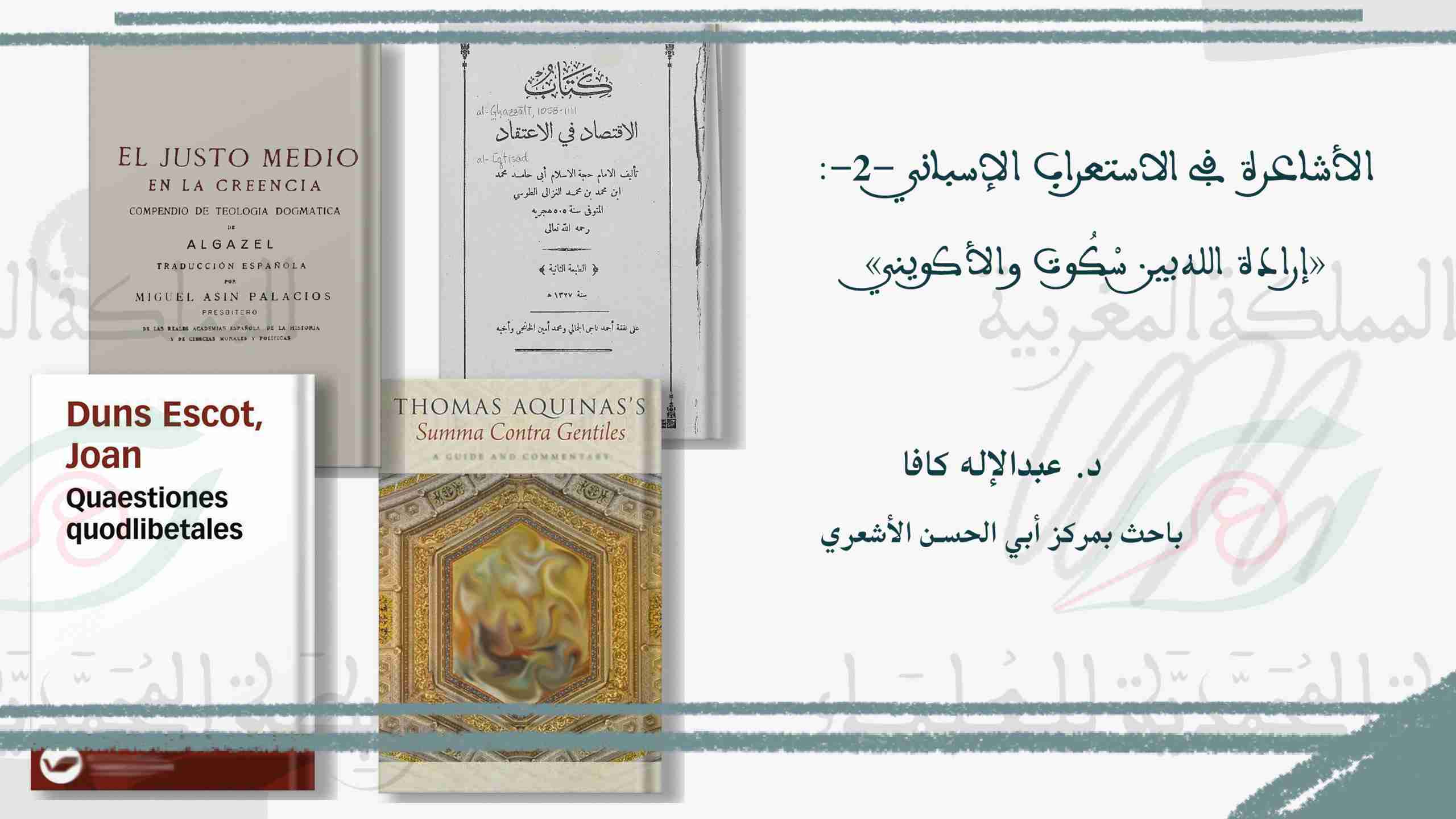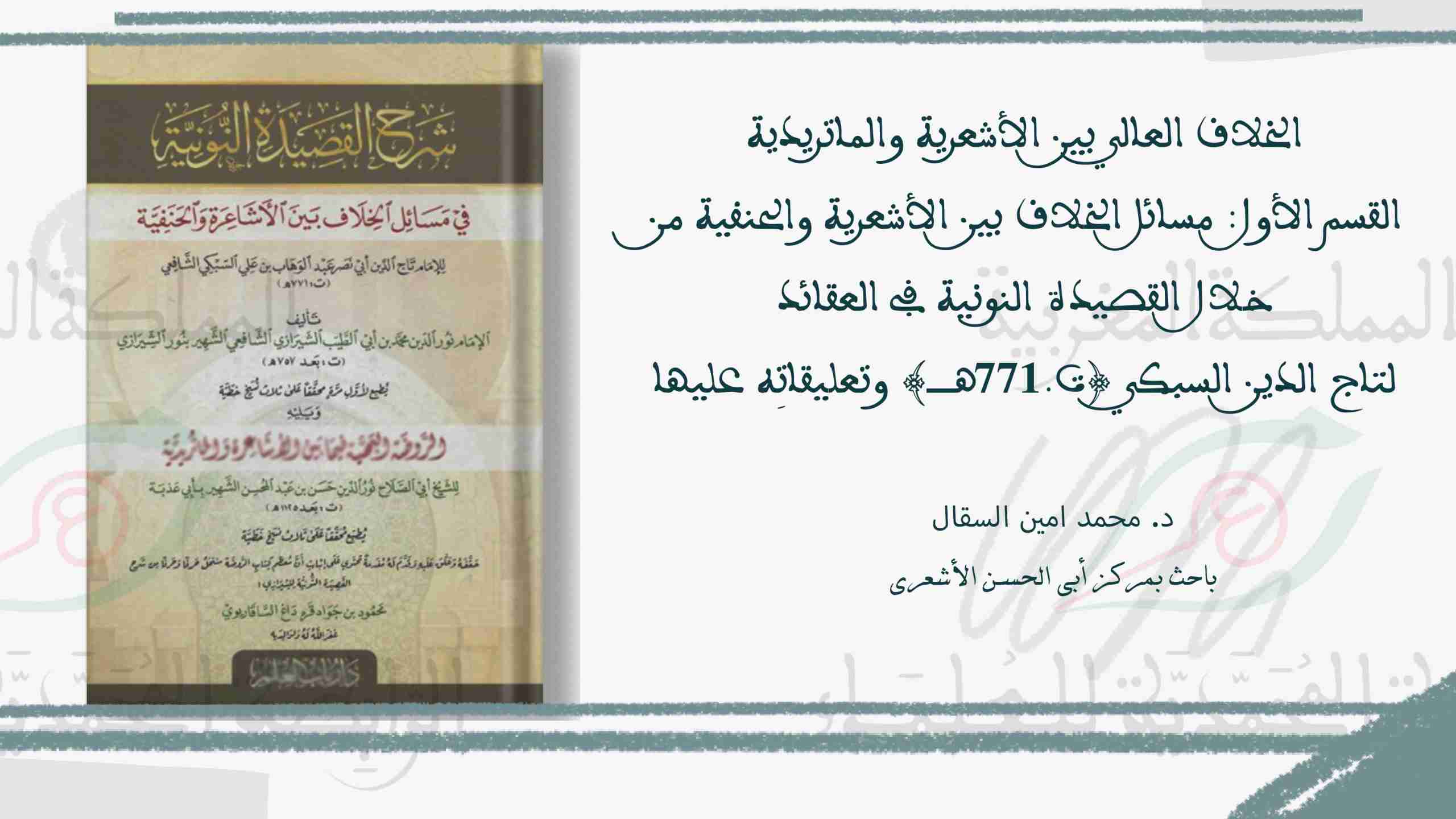لقد تشكل ونمى حول القرآن الكريم، ولا يزال، تراث معرفي بشري غزير؛ تراث تتجاذبه غايتان متضادتان: أولاهما؛ الكشف عن معاني القرآن الكريم والاستهداء بهديه، وثانيهما؛ الحيلولة دون هذا الوحي وصرفه عن الإعمال في مجال الإنسان. وما يؤسف له هو أن التراث الذي كانت غايته الوصول إلى القرآن صار، بعضه، حائلا دونه، عن غير قصد، وذلك بانتقال القدسية من النص المؤسِّس إلى النص المؤسَّس.
والمتتبع للإنتاج المعرفي البشري في جميع المجالات، يلاحظ أنه يبنى بعضه على بعض ويتجاوز بعضه البعض وأحيانا ينقض بعضه بعضا. فما ينتج في فترة من الفترات ويبدو أنه أقصى ما وصل وما يمكن أن يصل إليه الإنسان، يدور الزمان وتأتي فترة أخرى بإنتاج آخر يصبح السابق أمامه قزما أو عدما.
هذا بالفعل ما ينطبق على تراث الأمة الإسلامية، فبعض ما أنتج وأُسّس عن القرآن الكريم من مناهج وقواعد وأصول أسهمت في فترة من الفترات في ازدهار المعرفة والعلم وبلوغهما المدى، أصبح اليوم ينظر إليه، من طرف بعض الباحثين، بعدمية الجدوى وكأن النص لم يعد يستجيب له، أو بعبارة أخرى لن يستجيب له إلا بمقدار ما استجاب له من قبل والقرآن يعطيك بحسب الطلب. لهذا السبب تعلو أصوات خلال فترات متعاقبة من هنا وهناك تنادي بضرورة إعادة القراءة، وإعادة صياغة السؤال الموجه لنص الوحي وفق مناهج وقواعد جديدة منبثقة من داخل النص نفسه حتى تحول دون أن يدخل فيه ما هو خارج عنه.
فمن غير المعقول أن تبقى أجيال المسلمين أسيرة التراث الذي أنتجه أسلافها دون أن تسجل أيَّ إضافة إليه، وبين أيديها الكتاب الذي قال فيه عز وجل: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا) [الكهف: 104]، وقوله عز وجل: (ولو اَنما في الاَرض من شجرة اَقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم) [لقمان: 26]. وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يخلق عن كثرة الرد"، فهو الكتاب ذو العطاء المستمر والمتجدد باستمرار القراءة وتجددها.
في هذا الصدد، ظهر في السنوات الأخيرة منهج جديد في تفسير القرآن الكريم يعتمد على إلغاء الترادف في اللغة وما يتبعه من اعتباط، وينظر إلى القرآن على أنه نظام لغوي محكم مستقل بذاته لا يخضع لقواعد الاعتباط اللغوي. فهو رؤية جديدة لصاحبه عالم سبيط النيلي في فهم القرآن الكريم، وفي إنتاج المعرفة القرآنية قصد تحقيق الاستخلاف المنشود في الكون. فما هو هذا المنهج يا ترى وعلى ما يقوم وكيف يعمل؟
هذا المنهج هو كما سماه صاحبه: المنهج اللفظي، وهو منهج تحليلي لآيات القرآن الكريم يقوم على مبادئ ستة وقواعد ستة كذلك، وله اصطلاحاته الخاصة به.
أولا: اصطلاحات المنهج اللفظي
1. اللفظ؛ يقصد به في مرحلته الأولى اللفظ الواحد للمادة اللغوية فكل اشتقاق من مادة ما هو في المنهج اللفظي لفظ مستقل بحد ذاته. أما في مرحلته المتطورة فكل محلٍ إعرابي فهو لفظ مستقل (كفّار، أولئك، لولا، أمّاذا، الظالم، الظالمين....).
2. المركب؛ يقصد به اقتران لفظين أو أكثر سويا لتكوين عبارة أو مقطع قرآني معين، ولا يشترط في المركب أن يكون آية كاملة أو جملة تامة المعنى (مثال: ذلك الفوز العظيم، بئس القوم، فضل الله...).
3. التركيب؛ يقصد به الجملة التامة المعنى ولا يشترط أن يكون آية كاملة، بل قد يكون شطر آية أو آية وشطر أو آيتين.
4. الرباط؛ يقصد به اللفظ أو المركب الذي حافظ على صورته اشتقاقا وإعرابا ودخل في تركيبين منفصلين. ويتألف الرباط من أنطقة بعدد الألفاظ المشتركة.
مثال: قوله تعالى: (اِن جهنم كانت، مرصادا للطاغين مئابا) [النبإِ: 21-22]، وقوله عز وجل: (هذا وإن للطاغين لشر مئاب، جهنم يصلونها) [ص: 54-55]. فالرباط في الآيتين مؤلف من نطاقين هما: (جهنم) و(للطاغين). أما لفظ "مآب" فهو مركز أو نقطة شدّ هذه الأنطقة ويسميه المنهج بـ(المشدّ).
5. الاقتران؛ وهو مجيء ألفاظ بعينها في التراكيب المختلفة في مواضع متباينة أو مجيء مركبات في تراكيب كاقتران ذكر القلب مع الكفر والعقل مع الشرك، فهذا يسميه المنهج اقترانا لفظيا. ولا يشترط في الاقتران ثبات نفس التسلسل للمفردات ويفيد هذا الاقتران في الكشف عن حقائق جديدة في كل القرآن وإن اختلفت المستويات.
6. الشعاع؛ يشير إلى العلاقة بين لفظين اقترن كلا منهما مباشرة بلفظ أو مركب ولم يتصلا معا ببعضهما في كل القرآن في أي موضع مثل: (السماء ذات الحبك/السماء ذات الرجع/السماء ذات البروج) فالحبك والرجع والبروج هي ألفاظ مرتبطة بشعاع مع بعضها البعض. وتفيد معرفة الشعاع حاليا في تخمين وجود علاقات بين الآيات والسور والوقائع والمفاهيم.
7. المحور؛ هو اقتران لفظ أو مركب بعدد من التراكيب ثلاث مرات أو أكثر محافظا على وضعه الاشتقاقي والإعرابي معا (مثال: لفظ "رجال" في كل من (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) [النور: 36]، (من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) [الأحزاب: 23]، (وعلى الاَعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم) [الأعراف: 45]، (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) [التوبة: 109]، (ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهمُ أن تطئوهم) [الفتح: 25]). وتفيد معرفة المحاور في رصد العلاقات بين الآيات وتوسيع دائرة الاقتران ووضع التسلسل الزمني للحوادث إلى منافع أخرى كثيرة جدا.
8. الفارز؛ إذا تكرر استخدام مركب معين واقترن به في بعض المواضع مركب آخر سمي المركب الثاني بالفارز (مثال قوله عز وجل: (الذين ءامنوا وعملوا الصالحات) فمركب وعملوا الصالحات يسمى بالفارز). ويستفاد فيه في معرفة التفاصيل في مختلف العقائد والتكوينات والفئات من خلال تحديد المجموعات ويستعمله المنهج في إبطال دعاوى التناقض في القرآن والرد على الملاحدة وإظهار الإعجاز القرآني وكذلك إبطال أجوبة وردود العلماء المسلمين الخاطئة على تلك الدعاوى.
9. الترتيب؛ هو التسلسل الذي عليه الألفاظ في تركيب معين أو مركب ما والتسلسل في القرآن مقصودا ولا يؤدي المعنى التام سواه.
10. المعنى التام؛ وهو المعنى الكلي للجملة التامة التركيب، فهو معنى خاص بالجملة لا اللفظ. وهو لا يدرك ولكن تدرك أجزاؤه بحسب قوة الكشف للاقترانات المتصلة والمنفصلة.
11. المعنى الذهني؛ وهو المعنى المتبادر إلى الذهن عند استلام لفظ أو تركيب معين سماعا أو قراءة، وهو معنى نسبي متقلب في المكان والزمان والأشخاص.
12. المعنى الأصلي؛ وهو المعنى الذي لا يوصف إلا بجملة طويلة من المفردات لشرح مفردة ما بحيث يكون هذا الشرح جامع لكل الاستعمالات الصحيحة (نسبيا) ويصحح الاستعمالات المعجمية أيضا.
13. المعنى الحركي؛ وهو المعنى ما قبل الأصلي الذي يطابق حقيقة وجوهر المسمى في حركته الأولى في الوجود والذي يصف المسمى وصفا حقيقيا شاملا.
وما يمكن إدراكه من خلال المنهج اللفظي، هو المعنى الأصلي الذي يعطي ظلالا للمعنى الحركي، وهو كاف لمعرفة كثير من الحقائق وتصحيح الفكر الديني واللغة وقواعدها.
ثانيا: مبادئ المنهج
1. مبدأ عدم الاختلاف في القرآن؛ يقصد به خلو القرآن الكريم من أي اختلاف بصفة مطلقة وبالتالي خلوه من التناقض الذي يقول به المفسرون. وهذا مستمد من قوله عز وجل: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اِختلافا كثيرا) [النساء: 81].
2. مبدأ قصور المتلقي؛ يقصد به قصور المتلقي عن الإحاطة بكلام الخالق قصورا دائما، فلما كانت معرفة الله عز وجل لا نهائية فتبقى كذلك معرفة كلامه لا نهائية. (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا) [الكهف: 104].
3. مبدأ التغاير عن كلام المخلوقين؛ هذا مما لا مجال للتفصيل فيه فالفرق بين كلام الله وبين كلام المخلوق كالفرق تماما بين الخالق والمخلوق أو هو كالفرق بين "الإنسان وبين التماثيل الطينية".
4. مبدأ خضوع المتلقي للنظام القرآني؛ يؤمن المنهج اللفظي بأن على الباحث الخضوع للنظام القرآني إن أراد التوصّل إلى معارف القرآن. فالقرآن نظام محكم شديد الاتساق، وعلى الباحث السير على ذلك النظام والتحرك وفقه واكتشاف مسالكه وطرقه. هذا يعني أن على الباحث أن يكون تابعا للقرآن لا أن يكون هو قائدا له.
5. مبدأ التبيين الذاتي؛ يؤمن المنهج اللفظي بأن القرآن الكريم مبين لنفسه ومبين لكل شيء. بمعنى أنه يقول عن كل شيء، بما في ذلك ذاته، ولا يقول عنه شيء. (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) [النحل: 89].
6. مبدأ العلو والشمول والحاكمية والامتناع؛ يؤمن المنهج اللفظي بأن القرآن ممتنع عن قبول أي علم أو معرفة غير علمه هو، فهو متعال على كل علم آخر لأنه كلام الله (الذي أنزله بعلمه). فهو حاكم على كل علم غير محكوم بأي علم، أو كما جاء عند بعض الباحثين هو المهيمن على غيره المصدق لما عداه.
وهي مبادئ كما ترى لا يختلف فيها اثنان ولا ينكرها إلا جاهل بالقرآن الكريم، إن هذه المبادئ هي بعض الخصائص الثابتة للوحي بثبوته.
ثالثا: قواعد المنهج
القاعدة الأولى: في إبطال المترادفات
لا يجوز تفسير أو شرح مفردة أو لفظ بلفظ آخر بحجة التقارب بينهما في المعنى، ذلك لأن النظام القرآني يحتم أن يكون لكل لفظ دلالته المختلفة عن دلالة أي لفظ آخر. ولهذه القاعدة فروع:
الفرع الأول: قيد اللفظ أو المعنى، ومعناه أنه لا يمكن أن يؤدي المعنى المحدد المقصود إلا لفظا واحدا أو ترتيبا واحدا.
الفرع الثاني: قيود صيغ الحروف؛ يعني أن جميع الحروف هي ألفاظ تنطبق عليها جميع قواعد المنهج سواء كانت حروف جر أو ظرف أو نهي أو عطف وكل ما يمكن أن يوصف بأنه حرف زائد. فهي ألفاظ ذات دلالة ثابتة.
الفرع الثالث: قيود صيغ الأفعال؛ يعني يجب التقيد بصيغة اللفظ إذا كان من الأفعال، كالفعل الماضي للماضي، والحاضر للحاضر، ولا يجوز تقدير غيره، كما يجب التقيد بترابط الفعل وموضوعه. فالفعل يحمل زمانه في ذاته ولا يجوز لأحد تغيير هذا الزمان بحيث يقدر الماضي على أنه يفيد الحاضر أو العكس.
الفرع الرابع: في التقيّد بصيغ الأسماء والصفات؛ ويقصد به التقيد بصيغة الاسم أينما وردت في القرآن من التعريف بأنواعه والتنكير والجمع والإفراد والتثنية ويشمل ذلك أسماء الإشارة بلا فرق (ف"ذلك" ليست هي "هذا" وقس على ذلك).
الفرع الخامس: يجب التقيد بصيغة اللفظ إن لم يكن فعلا ولا اسما ولا حرفا مما اصطلح عليه النحويون (النعت والمفعول بأقسامه والفاعل) بنفس القيود. فيجب التقيد بهيئتها ولا يجوز تقدير غيرها أو فهمها بعكس ما تعنيه تلك الصيغة (مثال: لا يجوز تفسير لفظ "مستورا" بـ"ساتر").
القاعدة الثانية: في إبطال تعدد المعاني للفظ الواحد فلا يجوز تغيير معنى اللفظ عند تغير موقعه في التراكيب التي يرد فيها ذلك اللفظ.
القيود التي مرت سابقا تؤكد ضرورة التقيد بصيغة اللفظ، أما هذه القاعدة فهي تؤكد ضرورة التقيد بمعنى اللفظ مع ثبوت الصيغة.
القاعدة الثالثة: في إبطال التقديرات المتنوعة للمركبات والألفاظ في التراكيب فلا يجوز تقدير مركّب أو لفظ لا وجود له بحجة أنه محذوف جوازا كما لا يجوز حذف مركب أو لفظ بحجة أنه زائد أو مزيد أو مقحم، ويعد هذا العمل لتحصيل المعنى التام للتركيب باطلا في هذا المنهج.
نجد هذا معمولا به في كثير من التفاسير، وهذا مخالف للنظام القرآني وإقحام لما ليس فيه وتعطيل لما هو فيه.
القاعدة الرابعة: في إبطال التقديرات العشوائية للترتيب العام للجملة فلا يجوز تقدير ترتيب آخر للمركبات في التراكيب ولا للألفاظ فيهما بديلا عن الترتيب القرآني لتحصيل المعنى العام ويعد المعنى المتحصل من الترتيب المفترض باطلا وفق هذا المنهج.
محصل هذه القاعدة هو أن الترتيب القرآني هو جزء من النظام المحكم للقرآن، فلا يجوز تغييره بتقديم أو تأخير موضع مركّب أو مفردة في تركيب قرآني معين ولو تقديرا لتحصيل المعنى. فكل نظام يفرض نفسه، وعند تغييره فإن الحاصل لا علاقة له بذلك النظام، بل سيكون شيئا خارجا عنه.
القاعدة الخامسة: في إبطال المجازات فلا يجوز للباحث الاعتقاد بوجود مجاز في القرآن بكافة أقسامه ويعد شرح التراكيب بهذه الطريقة باطلا وله فروع (إبطال التشبيه الاستعاري، إبطال الكناية، إبطال الإيجاز والإطناب).
فالمنهج اللفظي يرفض الإقرار بوجود أي مجاز في القرآن من أي نوع كان، ويرى أن القرآن ليس فيه سوى الحقائق المجردة عن أي إبهام أو توهم. وبالمثال يتضح المقال، فمثلا في قوله عز وجل: (لو اَنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) [الحشر: 21]، فالآية تشتمل على فرض مفاده أن الجبل لو كان هو المتلقي للقرآن لخشع وتصدع من خشية الله، في حين نجد المفسرين حولوا هذا الفرض الحقيقي إلى مجرد مجاز وكأنهم استحالوا وقوع ذلك لأن الجبل في نظرهم لا يسمع ولا يعي فكيف به يتلقى القرآن فيخشع ويتصدع من خشية الله. وبقولهم هذا أغفلوا مجموعة من الآيات التي تخبرنا بأن جميع الكائنات سواء الحي منها أو الجامد تعي وتسمع ما يلقى إليها (اِنا عرضنا الاَمانة على السموات والاَرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الاِنسان إنه كان ظلوما جهولا) [الأحزاب: 72]، فهي هنا أكثر وعيا من الإنسان، (يسبح له السموات السبع والاَرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهمُ إنه كان حليما غفورا) [الإسراء: 44]، إلى غير ذلك من الآيات.
القاعدة السادسة: في إبطال تعدد القراءات فلا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بصحة جميع القراءات للفظ الواحد ويتوجب عليه الأخذ بالقراءة التي تطابق النظام القرآني ولو كانت شاذة وعند غياب القراءة المطابقة للنظام يجب التوقف والمرور من طريق آخر أو الترك.
دأب أغلب المفسرين على اعتماد القراءات الشاذة في تفاسيرهم، أي أنهم يستعينون بها في فهم بعض الآيات أو بعض الألفاظ القرآنية. لكن الغريب عند السيد عالم النيلي هو اعتماد القراءة الشاذة على أساس أنها هي القراءة الصحيحة والموافقة للنظام القرآني، وإبطال ما عداها من القراءات، ولسنا هنا أمام الدفاع عن تعدد القراءات ولا إبطال غيرها، ولكننا بصدد معرفة الأساس الذي اعتمده سيد عالم النيلي في دعواه هذه، لكن للأسف لم يقدم لنا سيد النيلي أي دليل على دعواه غير تخمينات فردية من خلال موقع واحد من القرآن الكريم.
هذه بشكل عام مبادئ وقواعد المنهج اللفظي كما سطرها صاحبها سيد عالم النيلي، وهو ما اشتمل عليه الباب الأول من الكتاب. أما الباب الثاني فخصصه لمناقشة قواعد النحويين ودحض أقوالهم وآرائهم في اتخاذهم آيات القرآن الكريم شواهد لآرائهم ومذاهبهم واعتبر ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يغفر أبدا في قوله: "إنَّ المنهجَ اللفظيَّ يكشفُ لكَ بجلاءٍ ومنطقٍ صارمٍ أنَّ الأمثلةَ القرآنيةَ التي تُكتَبُ كجُمَلٍ لشرحِ القواعدَ العربيةَ في المدارس والجامعاتِ، والشواهدَ القرآنيةَ المزبورة في كُتبِ النحو والبلاغةِ، هي جميعاً تأتي في عملٍ هو جزءٌ من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله أبداً"[1]. وفي بنائهم لقواعدهم النحوية من خارج القرآن الكريم باعتبار هذا الأخير بناء منظم واحد لا يقبل إلا أن تكون قواعده منبثقة من داخله.
أما الباب الثالث فخصصه لبيان موقع المنهج اللفظي بين باقي المناهج التفسيرية الأخرى، بحيث عرض لجميع المناهج، تقريبا، بالتفصيل وبيَّن مكامن القصور فيها، ولم يسلم من نقده حتى آخر ما ظهر في علوم التفسير وهو منهج التفسير الموضوعي حيث قال فيه: "نعم.. هناك منهجٌ ظهر أخيراً سُمِّيَ بالمنهج الموضوعي ووصفوه بأنَّه أفضل مقترحٍ تاريخيٍّ لتفسير القرآن الكريم وخلاصته أن يقوم مجموعةٌ من ذوي الاختصاصات المختلفة في فروع المعرفة ويبحثوا في الآيات التي تتحدّث عن موضوعهم الخاص. فأهل الفلك يدرسون آيات الفلك، وأهل الأحياء يدرسون آيات الكائنات من الأحياء .. وهكذا".
وعقّب على هذا بقوله: "إنَّ المنهج اللفظي يعتبر المنهج المذكور ليس إلاَّ واحداً من بقية المناهج، لا يختلف عنها بكونه مقترح تاريخي متميّز، بل بكونه أسوأ مقترحٍ تفتَّقت عنه أذهان الأمة منذ عصر نزول القرآن.
ذلك لأنَّ المنهج الواحد اللغوي أو الفقهي أو التاريخي الذي يدرس القرآن كلّه بمنهجيةٍ واحدةٍ يقع دوماً في تناقضاتٍ مع بقية المناهج ومع نفسه. وقد تأمل منه رغم ذلك أن يقع على النظام القرآني ولو مصادفةً لأنَّه بمنهجيةٍ محدّدةٍ وإن كانت خاطئةً.
أمَّا المنهج الموضوعي فإنَّه تجزئةٌ أكبرُ وأعظمُ للقرآن. ومن المتوقّع أن يُضاعِفَ عدد التناقضات في موضوعه وبقية الموضوعات، ولا يُحتمل منه الوقوع على النظام القرآني واكتشافه، بل لن يدخل هذا الباب حتى يلجَ الجملُ في سمّ الخياط. فهذا المنهج يستخدم جميع المناهج المعروفة بلا تحديدٍ بأيدٍ مختلفةٍ وعقولٍ مختلفةٍ لمواضيع مختلفةٍ، ويحاول في نفس الوقت الاقتراب من النصّ. فالنتيجة المتوقّعة هي في أنَّ عينيه سيصيبهما العمى، ويضلُّ تائهاً يدفعه كلّ نصٍّ إلى آخرٍ من غير أن يعلم من أين جاء وإلى أين يذهب"[2].
وقدّم سيد النيلي المنهج اللفظي بديلا عن مناهج التفسير باعتباره المنهج التوحيدي لها جميعا، حيث يقول: "إنَّ المنهج اللفظي يبطل هذه الاتجاهات جميعاً (أو يوحّدها جميعاً) باتّجاهٍ واحدٍ وهو الاتجاه القائل: إنَّ القرآن نظامٌ كليٌّ محكمٌ يكشف نفسَهُ بنفسِهِ، وهو غنيٌّ عن أيِّ علمٍ. وإذن يصحُّ أن يقال أنَّ على الجميع أن يمتنعوا عن القول فيه بآرائهم مهما أوتوا من معرفةٍ وعلمٍ. ويصحُّ أن يقال أنَّ على الجميع أن يتدبروا القرآن الكريم ويفسّروه ويفهموا مراميه خاضعين لهذا النظام طائعين له"[3].
ويضيف: "إنَّ المنهج اللفظي يحلُّ كبديلٍ محلَّ هذه المناهج، وهو بديلٌ سيحلُّ قسراً عليها. وهذه المناهج إن لم تحاول التمسّك به والانضواء تحت لوائه وتعديل طريقتها وفقه، فإنّها ستلغي نفسها بلا شك في ذلك، لأنَّ المنهج اللفظي لا يكشف عن النظام القرآني وحسب، بل هو منهجُ هذا النظام.. وهو نظامٌ كما تعلم (يعلو ولا يُعلى عليه ويُحطِّمُ ما تحته) وفق الوصف الذي وصفه به الجاحد فضلاً عن المؤمن"[4].
وحذر من إسقاط الآراء والأهواء على النص القرآني والوقوع في ظلمات بحر لجي يهوي بصاحبه إلى القاع، وذلك "أنَّ المرء إذا سمح لنفسه مرّةً أن يجعل القرآن تابعاً له، فإنَّه يدفعه إلى الضلال وإلى الهاوية. فالقرآنُ كائنٌ حيويٌّ يأبى أن يكون مأموماً ولا يرضى إلاَّ أن يكون إماماً"[5].
وفي هذا الباب ناقش سيد عالم النيلي المفسرين في مجموعة من القضايا من بينها:
ـ قضية الدفاع السلبي عن القرآن الكريم
يقول سيد النيلي في هذا الصدد: "لقد ابتليَ القرآنُ بأصدقاءَ من هذا النوع..! أصدقاءَ أرادوا أن يشهدوا له فشهدوا عليه، وأصدقاءَ أرادوا الدفاع عنه فأثبتوا التهمة ضدّه، وأصدقاء أرادوا أن يحاموا عنه فتوكّلوا عنه من غير أن يوكِّلهم، فنطقوا من غير أن يأمرهم.
ومع أنَّه (إمامٌ صامتٌ) لكن لسان حاله يقول: أيُّها الأصدقاء.. أنا الذي إن شئتم شهِدتُ لكم.. أنا الذي يجب أن تتحاكموا إليَّ.. أنا الذي تحتجّونَ بي وتخاصمون لا أن تحتجّوا ليَ أو تحاكموني، فمنكم من يتّهم، ومنكم من يدافع.. أنا خارجُ كلِّ اتِّهامٍ وفوقَ كلِّ دفاعٍ.. إن كنتم تعلمون!"[6].
ويندرج تحت هذه القضية مسألة التواتر باعتبارها الدليل على أن القرآن من عند الله، يقول سيد عالم النيلي: "لقد وضع العلماء القرآن في موقفٍ هو غير موقفه، وجعلوه في مكانةٍ هي غير مكانته. وكان ذلك ببدعة التواتر، لأنَّه إذا كان لا يثبت نفسه إلاَّ عن طريق (الرجال)، فهو إذن أعجز عن إثبات حقائق أخرى خارجة عنه. وإذن فالاختلاف فيه، والابتعاد عن روحه، هو أمرٌ محتومٌ يحتِّمه المنهج العقائدي والفكري المناقض أصلاً للقرآن، والذي اتَّخذه المسلمون سبيلاً للتعامل مع كتاب الله"[7].
ومعلوم أنَّ المعجزةَ لا تحتاج إلى دليلٍ لأنَّها هي الدليل على نفسها وعلى غيرها، وتأكيدا لهذا يقول سيد عالم سبيط النيلي: "إنَّ المنهج اللفظي يقلب الأمر رأساً على عقبٍ، لأنَّه يخبر المشكّك أنَّ الدليل أنَّه كلام الله ليس هو التواتر، بل الدليل على ذلك هو القرآن نفسه في نظامه الداخلي المحكم. فإعجازُهُ ليس كإعجاز عصا موسى عليه السلام، بل هو كلامٌ منظَّمٌ بصرامةٍ ودقّةٍ تفوقان ما في الكائنات. وهو حيويٌّ ومترابطٌ بمثلِ ما في الكائنات من نظامٍ وحيويةٍ. فإعجازُهُ في داخله وبرهانُهُ في ذاته. ولكن الإعجاز لا يمكن كشفه إلاَّ بشرطين: الأول: الخضوع لهذا النظام بكلِّ ما في هذه العبارة من معانٍ مرّت في هذه المقدِّمة، والشرط الثاني: التدبّر لمعرفة هذا النظام"[8].
ويضيف سيد النيلي: "إنَّ هذا المنهج إذ يكشف عن جزءٍ من طبيعة النظام القرآني، فإنَّه ينبّه إلى أنَّ الدفاع السلبي بمثل هذه الطرق كالتواتر وغيرها إنَّما هو في حقيقة الأمر هجومٌ على القرآن، وصدٌّ عنه، وتأكيدٌ على صحّة الشكوك، وموقفٌ هو الغاية من الضعف والهوان والتراجع"[9].
ويقول أيضا داحضا حجية التواتر: "فإنَّ التواتر يصحّ لإثبات قضيةٍ مضت منذ فترة من الزمان بحيث لا سبيل لإثباتها إلاَّ بهذا الطريق، ولا يصحّ لإثبات قضيةٍ لا زالت قائمةً وشاخصةً بيننا!
فإذا كان القرآن معجزةً وهو بين أيدينا الآن، فإنَّه يجب أن يثبت نفسه بنفسه باعتباره معجزةً. ولا يصحّ القول أنَّه كلام الله بدليل التواتر لأنَّ عبارة (كلام الله) هي تعبيرٌ آخر للمعجزة. وعليه فإنَّ التواتر كدليلٍ على الإعجاز يسوقه العلماء، هو نفسه دليلٌ مناقضٌ ومنافٍ للإعجاز وإن لم ينتبهوا لذلك"[10].
لكي ينتهي إلى نتيجة مفادها أن القرآن معجز بنفسه وليس عن طريق التواتر "وعليه فإنَّ كلام الله والذي هو بين أيدينا اليوم لا يصحّ إثبات إعجازه عن طريق التواتر، بل يجب البحث عن إعجازه الحقيقي على أساس كونه معجزاً بنفسه وغير محتاج إلى دليلٍ خارجي"[11].
ويعيب سيد النيلي على العلماء تعاملهم هذا مع القرآن، والموقف الذي وضعوه فيه قائلا: "لقد وضع العلماء القرآن في موقفٍ هو غير موقفه، وجعلوه في مكانةٍ هي غير مكانته. وكان ذلك ببدعة التواتر، لأنَّه إذا كان لا يثبت نفسه إلاَّ عن طريق (الرجال)، فهو إذن أعجز عن إثبات حقائق أخرى خارجة عنه. وإذن فالاختلاف فيه، والابتعاد عن روحه، هو أمرٌ محتومٌ يحتِّمه المنهج العقائدي والفكري المناقض أصلاً للقرآن، والذي اتَّخذه المسلمون سبيلاً للتعامل مع كتاب الله"[12].
وطرق سيد النيلي في هذه القضية؛ أي الدفاع السلبي عن القرآن، إلى مجموعة من المسائل كإثبات الإعجاز القرآني، ومخالفة القرآن لقواعد العرب، ومسألة التناقض والاختلاف في القرآن وغيرها. وأرجع كل هذه المسائل المثارة حول القرآن إلى سبب عدم إدراك النظام القرآني.
هكذا انتقد سيد النيلي التراث المنشأ حول القرآن ورجاله، بل بلغ به الأمر إلى حد اتهام هؤلاء الرجال؛ مفسرين، ونحويين، وبلاغيين، وكلاميين، وأصوليين وغيرهم بالتآمر والتحايل على القرآن الكريم وإخفاء الحقيقة.
يقول: "إنَّ هذا التراجع (لأهل القرآن) لم يكن وليدَ صدفةٍ ولا ذهولٍ عن (المنطق) من عقولٍ كانت تكتشف التناقض في قول الخصم بمثل لمح البصر. إنَّما كان وليدَ مؤامرةٍ واسعة الأطراف ومحكمةٍ إحكاماً شديداً اشترك فيها بعض رجال الصدر الأول من المسلمين.
فهؤلاء هم الذين أخّروا إخراج النصّ القرآني لفترة ربع قرنٍ إلى عهد عثمان، وهؤلاء هم الذين مهّدوا للاختلاف في ترتيبه وقراءته من خلال المجادلات التي افتعلوها ربع قرنٍ لحين الاستقرار على مصحفٍ مقبولٍ!
وهؤلاء هم الذين وضعوا (اللجان) المفتعلة لجمع قرآن مجموعٍ وموجودٍ أصلاً!
وهؤلاء هم الذين وضعوا المنادين في الطُرقات ليجلبوا لهم شهوداً يشهدوا للقرآن.
وجاءت من بعدهم (الرجال) تترى!
جاء النحويون والمفسِّرون.. وجاء البلاغيون من ثمَّ ليكملوا الشوط إلى آخره، وليؤسِّسوا عقائدَ كاملةً في الإعجاز والتفسير مرجعها كلّها إلى أمرٍ واحدٍ هو إفراغ القرآن من محتواه الإعجازي الحقيقي، وسلبه حجّيته بجعل الرجال حجّةً على القرآن.
فرجالٌ يجمعون القرآن، ورجالٌ يحرقون المصاحف، ورجالٌ يفسّرون، ورجالٌ يُعربون، ورجالٌ سبعةٌ أو أكثر يقرءون، ومدنٌ سبعةٌ تقرأ بقراءاتٍ مختلفةٍ، ورجالٌ لمعرفة الرجال!
كلّ أولئك وغيرهم (يحتاجهم) القرآن ليثبت أنَّه كلام الله!.. القرآن الذي احتاجه محمد، صلى الله عليه وسلم، ليثبت به أنَّه رسول الله!
ولم تكن حجّية القرآن لتنفع شيئاً حينما عادت إليه على أيدي الأصوليين في عصور تأسيس الفقه والأصول. فتلك الحجّية محكومةٌ بالرجال أيضاً. وهم كلُّ الجمع السابق، ومعهم رجال الأصول ورجال الكلام ورجال البلاغة الجدد! وهؤلاء يحتاجهم القرآن لإثبات حجِّيته عند أهل الأصول"[13].
ورغم كل هذه الانتقادات التي وجهها سيد عالم النيلي لـ"الرجال" حسب تعبيره، إلا أنه أنصف بعضهم واستشهد ببعض أقوالهم على صحة منهجه في ملاحق كتابه.
والجميل في طرح سيد عالم النيلي أنه لم يقتصر على الحديث عن النظام القرآني وإنما تعداه إلى النظام الطبيعي والنظام الاجتماعي وعلاقة هذه الأنظمة بعضها ببعض، وأن النظام الأحسن هو الذي يُستمدُّ من القرآن عبر اكتشاف نظامه الداخلي. وإن دل هذا على شيء إنما يدل على الوعي السديد لسيد النيلي بالوحدة العضوية أو البنائية أو التناغم والاتساق الموجود بين النظام القرآني والنظام الكوني والاجتماعي.
الهوامش
1. عالم سبيط النيلي، النظام القرآني/مقدمة في المنهج اللفظي، ص252-253.
2. المرجع نفسه، ص 226.
3. المرجع نفسه، ص 222.
4. المرجع نفسه، ص 223.
5. المرجع نفسه، ص 229.
6. المرجع نفسه، ص 238-239.
7. المرجع نفسه، ص 242.
8. المرجع نفسه، ص 243.
9. المرجع نفسه.
10. المرجع نفسه، ص 242.
11. المرجع نفسه.
12. المرجع نفسه، ص 242.
13. المرجع نفسه، ص 241-242.