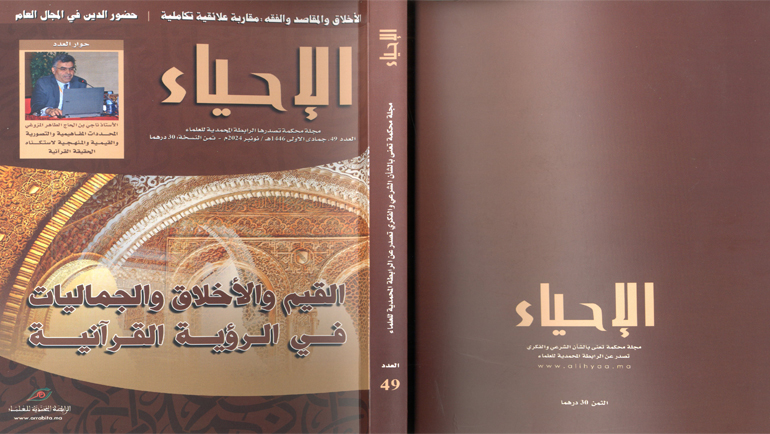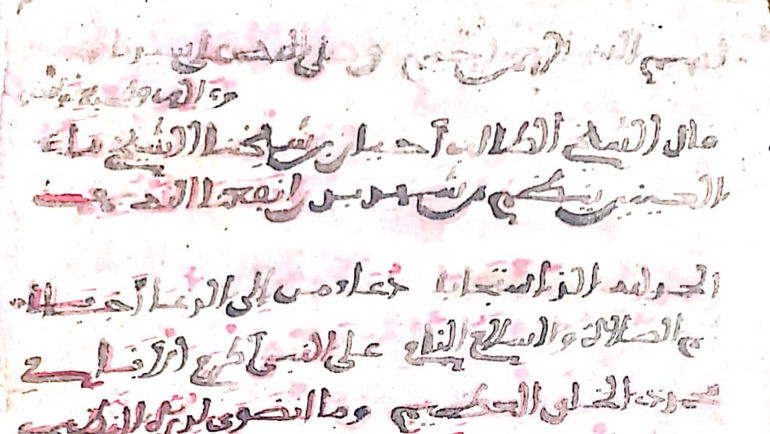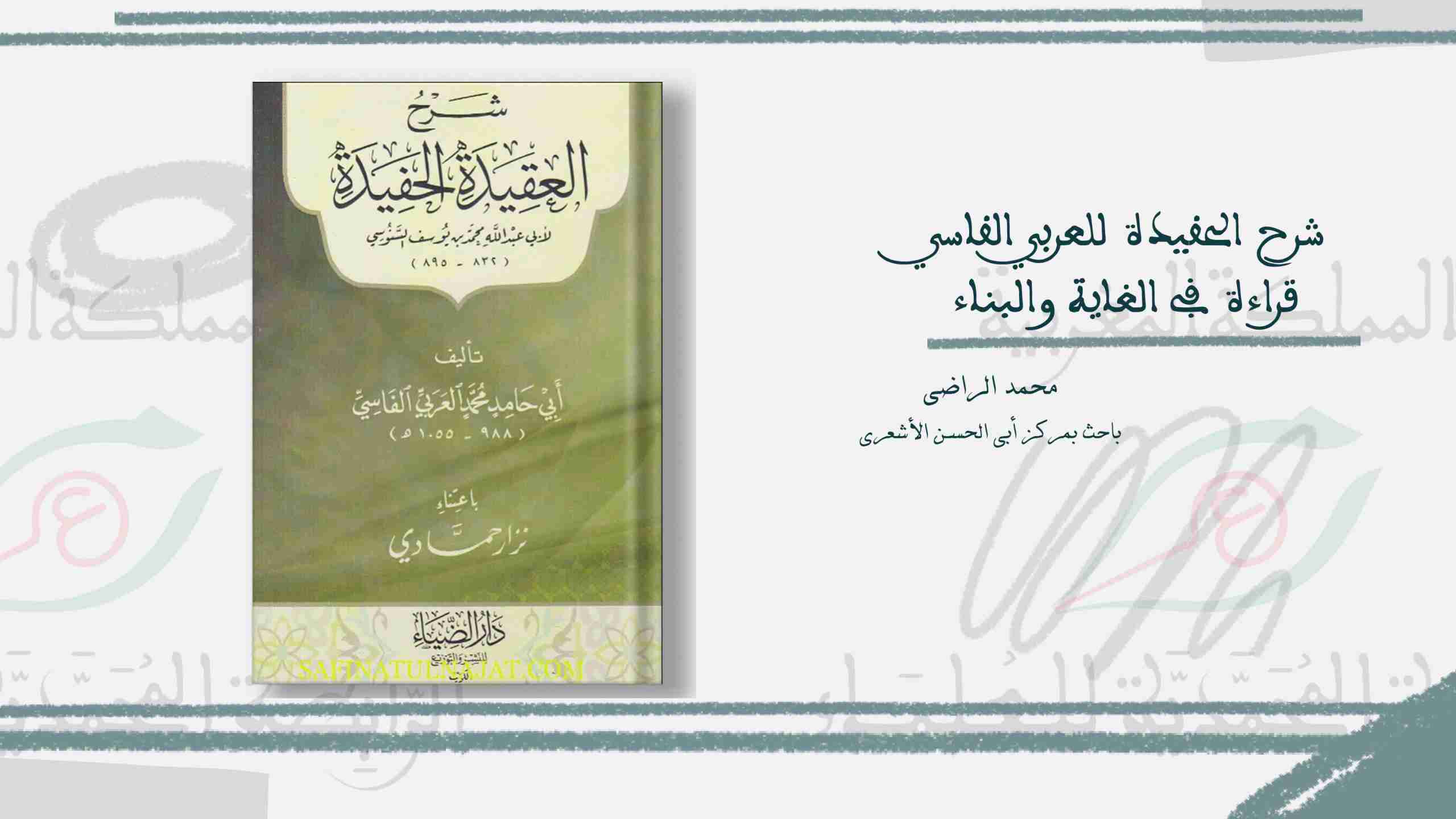الأخلاق و”الكاووس” أو إمبراطورية الذات قراءة في الفلسفة الأخلاقية عند بيير كاي

ينتمي هذا البحث إلى مجال النقد الفلسفي لتاريخ "الميثافيزيقا". وهو يعبر بمعنى من المعاني عن العودة الفلسفية المعاصرة للبحث في قضايا الميثافيزيقا والأسئلة الكونية الكبرى كسؤال الوجود، وسؤال القيم، وعلاقة الفلسفة بالدين، وجدلية الإنسان والطبيعة.. والجدير بالملاحظة أن الفكر الغربي اليوم، بعد مخاض عسير، يعيد اكتشاف الأبعاد الميثافيزيقية الثاوية في الإبداع الفلسفي الذي عرفته أوروبا خلال تاريخها الفكري الطويل..
ضمن هذا الإطار الفلسفي، وفي زمن المخاطر الشاملة وتزعزع الآمال المثالية والنقدية في خضم التاريخ، يقترح علينا بيير كاي، عبر كتابه "الأخلاق والفوضى[1]"، أخلاقية جديدة/قديمة لتجاوز تحديات عصرنا.. هو كتاب كثيف على المستويات؛ التأريخية، والفلسفية، والمعرفية، والمنهجية؛ ولذلك لا ندعي أننا سنلم بكل جوانبه، بل سنكتفي بطرق بعض الحقول المعرفية التي وردت فيه بشكل يفي بتحليل منظومته الرئيسة ومراميه الكبرى..
وصاحب الكتاب، باحث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس، وحقل اشتغاله الأساسي هو نظرية الزخرفة خلال عصر "الإنسيين" والعصر الكلاسيكي" كما يعتبر من أبرز المتخصصين فيDe Architectura de Vitruve؛ يتعلق الأمر بقياس أهمية علم الزخرفة، ليس فقط في تشكيل نظرية الفن من القرن الخامس عشر إلى بداية القرن التاسع عشر، بل وبشكل أعم، في تشكيل "باراديغم" paradigme تقني غير مسبوق، آخذا مسافة مع عالم الحرفيين والمهندسين على حد سواء...
إنه "باراديغم" يعلن عبر عديد الإشارات (ثقافة المشروع، استعمال الرياضيات) عن تقنية "المُحدثين"، لكنها تحافظ على علاقة مع الطبيعة، مختلفة بشكل جذري عن المقاربة اللاهوتية لخلق العالم démiurgique. إنه بحث يمكن، من خلال إعادة التفكير في "المسار التقني"، من مساءلة علائق الإنسان بالطبيعة والسلطة وبأفقه الميثافيزيقي بشكل مختلف. وبمعنى آخر، يريد كاي أن يقف موقفا "وسطا" بين التفسير اللاهوتي للطبيعة والوجود الإنساني، وبين التفسير "الحداثي" التقني المستلب بدوره للإنسان...
يقول بيير كاي في مقدمة كتابه: "الفوضى هي تعريف قرننا"، ولا ينم هذا القول عن أي حديث عن "نهاية العالم "، وإن نظرته "لفوضى" عالمنا لا تمت بصلة لنظرة الثيولوجيين أو "المأساويين".. لا يتعلق الأمر بالاعتقاد بأن العالم صار رمادا وحطاما كما يتصوره رجل الدين l’Ecclésiaste وفق رؤية طُهرانية، ولا هو تصور يرى الحياة كتاريخ بلا معنى، مليء (بالصداع) والرعب يرويه غبي، كما يظهر من خلال ماكبِث Macbeth شكسبير[2].
إن مصطلح "فوضى" يفهم اليوم كوصف للاّتوقعية imprévisibilité، والحيرة التي تميز مجتمعاتنا المعقدة واللاثابتة، والتي أضحى الإنسان أقل تحكما في تطورها ومساراتها، أو بمعنى آخر، أضحت علاقة الإنسان بـ"الغيب" مسألة أكثر إشكالية وتعقيدا، ذلك أن التجربة التاريخية الأوروبية مرت بمراحل طويلة من حيث تمثل الدين والكلام فيه، وتراوحت بين رفض وقبول وتحجيم وتقنين، وهو ما يمكن أن ندرج ضمنه معظم التنظيرات المتعلقة بالمسألة الميثافيزيقة ونظام القيم..
إن الفوضى والغبش والحيرة التي كانت تمثل في الماضي الشر المطلق صارت اليوم تمثل المظهر الجديد للخير، والتعبير التلقائي عن الحياة في كل تجلياتها، والوعد بحرية بلا حدود، والتمكن من قوة مشبعة بالطاقة، لكن في الحقيقة، تبدو "الفوضى" مستقلة عن الإنسان، ذلك أنها لا تتأطر ضمن معادلة الخير والشر، ولا تؤدي لا إلى تدمير العالم ولا إلى خلاصه.. إنها تمثل على الرغم من تعقد معطياتها "الدرجة صفر للواقع"، وهي تعتبر كاملة البراءة... وإن العيش بمحاذاة "الفوضى"، كما يعلَن في عالمنا المعاصر يترتب عنه أخذ هذه البراءة الأصلية بعين الاعتبار؛ لذلك فإن الأخلاقيات المعانقة "للايقين" و"غياب السيطرة" على العالم، يفترض فيها أولا التحرر من الأخطاء الثلاثة: خطأ "العناية" providence، وخطأ اللانظام anarchie، وخطأ التأقلم adaptabilité، وهي أخطاء تقوم بنشرها مختلف "نظريات الفوضى" الجاري بها العمل في عالم اليوم..[3].
إلى وقت قريب، كانت أخلاقياتنا تستند أساسا على التحكم maîtrise، لكننا اليوم مطالبون بتعلم طريقة في العيش مغايرة؛ أي على أساس "اللامتحكم فيه" l'immaîtrisable، بمعنى أنه ينبغي أن نقبل "الكاووس/الفوضى" كما لو كان قدرنا، لذلك يبعث من داخلنا قوة، لا تروم التحكم في العالم، بل فقط تمكن الإنسان من استبطان ومواجهة غربة "الكاووس" le chaos..
يسمي بير كاي هذه القوة "إمبراطورية الذات" Empire de soi، لكن هذا المفهوم يتميز عن مفهوم "التحكم في الذات" maîtrise de soi.. لا يتعلق الأمر هنا بالنسبة للإنسان بـ"تقوية الطاقات والدفعات التي تخترقه"، بل على العكس من ذلك، عليه أن يبدأ تجربة عجزه الأصلية في مواجهة "الكاووس" الذي يسود العالم، من أجل أن يكوِّن، انطلاقا من ضعفه وهشاشته الأصلية، قوته الخاصة به.. أي استيعاب الكاووس" واستبطانه من أجل صقل فلسفة أخلاقية تتعايش معه، ونلمح هنا تأثرا كبيرا لكاي بتكون الإمبراطورية الرومانية، وهو الدارس المتمرس لتطور عمرانها ومؤسساتها، التي يعتقد أنها انطلقت من ضعف بنيوي، لتبلور قوة تدريجية مكنتها من أن تكتسب مكانتها الكبيرة في العالم القديم.. لكن الجميل في منهج بيير كاي هو التوظيف لنظريات الفن، والفلسفات القديمة، والنظريات الطبيعية من أجل نحث "منظومة قيم" يرى أنها الأنسب لمواجهة "الكاووس" الذي يسود الكون.
إن كتاب "الأخلاق و"الكاووس" لصاحبه بيير كاي يصف لنا مراحل تشكل هذه القوة الخاصة التي تبنى انطلاقا من العجز الإنساني، وبدون أساس sans fondement، بل فقط بقدرتنا على الصبر على الزمن endurer le temps والحفاظ على النفس داخله من أجل المرور الجيد منه، ولجعله يمر عبر نفسه...
هل يمكن ترجمة "chaos" بالعشواء أو الشعواء؟ كما يمكن ترجمة كوسموس بالكون؟ وهل Cosmo chaos هو الكون العشوائي؟ يوجد الإنسان حسب جيل دولوز Gilles Deleuze وفليكس غاتاري Félix Guattari[4] أمام خطرين قصيين: خطر الانكفاء على الرأي الذي يريد الانفلات منه، وخطر ارتمائه في "الكاووس" العشوائي الذي عليه مواجهته؟ تعتبر نظرية "الكاووس" أو "الفوضى" أو"الشواش" Chaos théorie du من أحدث النظريات الرياضية الفيزيائية، وتترجم أحيانا بنظرية العماء، التي تتعامل مع موضوع الجمل المتحركة اللاخطية التي يتمخض عنها نوع من السلوك العشوائي يعرف بالشواش، وينتج هذا السلوك العشوائي إما عن طريق عدم القدرة على تحديد الشروط البدئية، أو عن طريق الطبيعة الفيزيائية الاحتمالية لميكانيكا الكم mécanique quantique. لكن وجبت الإشارة إلى أن "نظرية الكاووس" على الرغم من إيغالها في القدم، فإنها تطرح اليوم بلبوس علمي أكاديمي بعدما كان تناولها القديم يروم إبراز أبعادها الفلسفية والميثافيزيقية.. وإذا كان منطقيا ربط المسائل العلمية بالمقاصد الفلسفية والأخلاقية، فإن تناول "نظرية الكاووس" تناولا تاريخيا وإبستمولوجيا من شأنه إبراز التطور الفكري الذي حصل على مدى قرون، قطيعة وامتدادا، بين مدارس فلسفية متعددة بدأ بالفلسفة الإغريقية ووصولا إلى فلاسفة الأنوار والحداثة وما بعد الحداثة.. وإني أرى أن تناولا كهذا من شأنه أيضا، من زاوية منهجية، الكشف عن الكثافة المعرفية في الحقل الفلسفي خصوصا ما تعلق منه بنقد الميثافيزيقا، وتجلياته على مستوى تناول قضايا الذات والقيم والطبيعة والكينونة والزمن واللغة والمؤسسات والسياسة والحرية...
ومعلوم أن بوان كاريه Poincaré عالم الرياضيات الفرنسي كان قد توصل في بداية القرن العشرين لنتائج قلبت النظرة المقبولة عن الكون الحتمي الخالص الذي تقود إليه نظريات نيوتن الرياضية، وأستنتج بوان كاريه في بحوثه أن قوانين نيوتن لا تقدِّم أيَّ حلٍّ للتنبؤ بحركات الشمس والأرض والقمر، ووجد أن اختلافات طفيفة في حركة هذه الأجرام في مساراتها تُحدِثُ تباينات هائلة بالظواهر النهائية وتتحدى أي تنبؤات[5]..
وقد أبرز "جيمس غليك" في كتابه "نظرية الفوضى: علم اللامتوقع[6]" أن: أول من بحث في "الشواش"، من المعاصرين، كان عالم الأرصاد إدوارد لورينتز Edward Lorenz، وقد استفاد هذا الأخير من رياضيات "بوان كاريه" في تقديم نموذج رياضيّ مبسط لمنظومة الطقس، تمكن من خلاله الكشف عن نِسَب التغير في درجة الحرارة وسرعة الرياح؛ وقد أظهرت هذه النتائج سلوكًا معقدًا ناجمًا عن المعادلات البسيطة؛ وهو ما يشير إليه المضمون النهائي لنظرية "الكاووس"، وهو أن المقدمات البسيطة قد تقود إلى سلوك معقد... ويرى جيمس غليك أن هذه النظرية تبدأ من النظرية التي يتوقف عندها العلم التقليدي.. وأن المتحمسين لعلم الـ"كاووس" ذهبوا إلى أن القرن العشرين سيذكر بفضل ثلاثة أمور: نظرية النسبية، وفيزياء الكم physique quantique، ونظرية "الكاووس"، التي اعتبروها الثورة العلمية الثالثة في تاريخ علم الفيزياء، وتتميز بأنها تتناول العالم المباشر الذي نراه ونحسه، وتنظر إلى الأشياء على مقياس الإنسان، فيتأمل "الكاووس" في التجارب اليومية والعادية للبشر.. وهنا تكمن المفارقة الأولى؛ بحيث يتم الانطلاق من نظرية موغلة في "الغيبية" إلى عالم الحياة اليومية الحسية؛ وهو ما يمكن اعتباره، في نفس الآن، محاولة للخروج من التخبط الوجودي الذي يطبع العالم المعاصر، وذلك بإنزال "المتعالي" إلى الحياة "الدنيا" كمخرج فلسفي وواقعي في آن... ويبدو أن كل محاولات الإنسان في هذا الاتجاه كانت تطلب شيئا من "النظام" ليحمي نفسه من الكاووس، وهذا الأخير هو تشتت الوجود إلى ما لانهاية له بعد الانفجار العظيم أو هو هروب الأفكار من ذاتها وأفولها ولفها طي النسيان وعدم التحكم فيها. وتنعت هذه الأفكار بالمتغيرات اللانهائية، فهي سرعات تختلط مع ثبات العدم وصمته؛ لحظة لا يمكن أن نميز فيها بين طول أو قصر الزمان، فيها تندثر الأفكار وتنبعث في آن واحد. ولحماية نفسه من "الكاووس" يلجأ الإنسان إلى التشبث بالرأي، وإلى البحث عن تسلسل أفكاره وفق حد أدنى من القواعد ومن النظام؛ مانعا نزواته كالهذيان والحمق من سبر أغوار تلك اللحظة العشوائية[7].
بدوره يلخص "بيير كاي" "نظرية الكاووس" انطلاقا من دراسة معمقة لتاريخ تبلور المفهوم وتطوره بقوله: "انطلاقا من "فوضى" ولا استقرار محلي، يدعي "الكاووس" chaos إنتاج نظام تلقائي ومنظم ذاتيا على المستوى الكوني الشامل.. من الماجماmagma الاجتماعية، والعلبة السوداء للاقتصاد والمبادلات تنبعث هارمونيا جديدة...
إن نظريات الفوضى أو النظريات الهيولية تمكننا انطلاقا من "الغبش" flou واللايقين l’incertain واللامتوقع imprévisible وربما أيضا لاعقلانية الحياة اليومية، من الوصول إلى وضعية عامة من الاستقرار أعلى من الأنساق المنظمة والعقلانية؛ بفعل ذلك نمر بدون عناء من "درجة صفر" الكائن إلى كماله بواسطة مسلسل من الترتيب والتنظيم.. الفوضى تضمن في الآن نفسه التغيير والاستقرار، التغيير ضمن الاستقرار واستقرار التغير الدائم.. وحيث ما يوجد نسق ما شديد الصلابة بحيث يتكسر بفعل أدنى صدام، فإن "غبش" و"صدفوية" الفوضى تمكن من هضم وضبط الاضطرابات الأكثر عنفا.. إنها جواب الأنساق المعقد للأنتروبيا [8]entropie، والوجه الجديد لمكر التاريخ...
إن هذه القطائع والتقاطعات تمكن نسقا منهكا، على المستوى الكوني، من تجديد التزود، وذلك باستيعاب كل ما يحيط به، وما يعنفه، وما يهدده بالفناء، وفق تدرج التعقيد والاستيعاب... إن الفوضى هي بمثابة ديناميكية حلزونية hélicoïdale تقوم في الوقت نفسه، بتدمير تماثلات symétries وبناء أخرى على مستوى أكبر من التعقيد..[9] ألا يصدق هذا الكلام على ما دافع عنه Edgar Morin في كتابه "الفكر المركب[10]" باعتبار أن ما ينتظم المنظومة الكونية الشاملة هو علاقة جدلية بين الجزء والكل؛ بحيث يفترض أن يكون المنهج الباحث عن النسق الكوني يعتمد التبسيط من أجل الوصول إلى التعقيد، وينطلق من التعقيد من أجل الوصول إلى التبسيط في إطار دورة حلزونية تكون عدتها المعرفية والمنهجية معتمدة على رتق العلوم والمعطيات الكونية فيما بينها بعد فتق طالها على مدى قرون من تطور الفكر الغربي...
ألسنا هنا أيضا بصدد ما سبق أن نظر له المفكر الإسلامي أبو القاسم حاج حمد في كتابه "جدلية الغيب والإنسان والطبيعة[11]" في سعيه للبحث عن منهجية القرآن المعرفية، وهي المنهجية التي تنطلق من كون الغيب معادلا موضوعيا لحركة الكون وتطوره، بما يفضي لحركة جدلية بين "اللامرئي" ومعطيات الطبيعة الحسية دون الوقوع في استلاب مزدوج؛ استلاب لاهوتي واستلاب مادي... و"كاي" نفسه يحذرنا من الوقوع في مسارات لاهوتية مستلبة من شأنها إضعاف الفعل الإنساني. وقد سبقه إلى ذلك "جون ماري شيفر" في كتابه "نهاية الاستثناء الإنساني[12]" الذي رأى أن اعتبار الإنسان مستثنى من الطبيعة من شأنه إفقار الإبداع الإنساني وإخضاعه لاستلاب لاهوتي ميثافيزيقي.. خلاصة القول أن إعادة طرح السؤال الميثافيزيقي ضمن علاقة الإنسان بـ"الغيب" أضحى اليوم سؤالا معاصرا ذا طبيعة فلسفية معرفية ولم يعد سؤالا دينيا محضا بالمفهوم السطحي لكلمة دين، أي دين..
ويقترح علينا كلود آليغر Claude allègre في كتابه "هزيمة نيوتن[13]"؛ قراءة لتطور فلسفة العلم بشكل أفضى إلى تبني "الكاووس" كنظرية علمية لتفسير الكون وأنساقه المعقدة؛ يقول: "النظام، اللانظام، الكاووس، التوازن، خارج التوازن، اللاتوازن: مصطلحات استعملت منذ زمن بعيد من أجل وصف حالة نسق ما، سواء كان ماديا، حيا أو إنسانيا، ومنذ Lucrèce طرح السؤال حول العلاقات الموجودة بين هذه الحالات، وكان ذلك يحتم أن تحدد هذه المصطلحات بشكل دقيق.. مع تطور العلوم، وخصوصا ابتداء من القرن 18م انصب الاهتمام بالأساس على مفاهيم "التوازن"، و"النظام"، وكان التفكير وقتها أن هذه "الحالات المستقرة" لم تكن الأكثر انسجاما فحسب، بل أيضا "الحالات" التي يتجه كل نسق حي إلى بلوغها؛ وأصبحت مفاهيم "التوازن" والاستقرار مرتبطة بالنظام و"التماثل" و"الهندسية"، والهارمونيا، وليس هذا وحده استحقاق هذه الأنساق المتوازنة، بل إنها أيضا تدرس بشكل ناجع بمعادلات بسيطة..
إن هذا النوع من التفكير أتاح للفيزياء التقليدية تحقيق إنجازات كبيرة، بدءاً بالديناميكا الحرارية، والكريستالوغرافيا، وفيزياء الأجسام الصلبة، وفيزياء الجزيئات؛ لقد كنا أيضا على علم بأنه يوجد في الطبيعة أنساق غير منظمة، "خارج التوازن" ولا تبدو خاضعة لأي قانون؛ أي أنها جُوانيا خارج متناول العلم؛ ويرى Claude Allègre أن هذه الأسبقية للنظام والتوازن كان لها كبير أثر على نمط الفكر الغربي، "لكن خلال عشرين سنة فقط ستتبدل نظرتنا إلى العالم وتنقلب رأسا على عقب... كنا نعتقد أن تنظيم البلورات "المنظمة" يعد النموذج السائد في الطبيعة، فاكتشفنا أن "اللاتوازن" و"اللانظام" هما أصل انبثاق البنيات الجديدة، وكنا نعتقد أن القاعدة الحدسية التي تعتبر الأسبابُ بموجبها متناسبة مع المسبَّبات هي السائدة عموما في الكون، فاكتشفنا اليوم أن هذه الحالة تشكل استثناء؛ وكنا نعتقد أن "الهندسية" الكلاسيكية المعتمدة على الأشكال المستقيمة والزوايا، والمنحنيات المنسجمة تمكننا من وصف فعال لأشكال الأشياء في الطبيعة، فاكتشفنا أننا غير قادرين على "رسم" الطبيعة..."..
شيء آخر أكثر إثارة، هو أن الأنساق غير المنظمة، المعقدة، "خارج التوازن" يمكنها أن تدرس بطرق علمية فاعلة وصارمة، وهي خاضعة لقوانين، وتتبع "نظاما" ما؛ أي أن هناك نوع من النظام داخل "اللانظام" الظاهر... ويخلص Claude Allègre إلى أن "قاموسا جديدا مواكبا لتطور هذا الحقل العلمي قد تبلور وشاع من قبيل: التقاطعات bifurcations، وfractals، والجاذبات الأجنبية، و"الكاووس"؛ لقد طويت صفحة في مسار فهم الكون، وندخل اليوم إلى عصر اكتشاف "المركب".. ويرجع الفضل لرواد كيمياء "اللاتوازن" في تحقيق الاكتشافات الأولى لهذه الحقول العلمية المجهولة، بدأ من سنة 1960 بقيادة Ilya Prigogine من جامعة بروكسيل، وكان تخصص هذا الأخير وأصحابه هو الديناميكا الحرارية الكيميائية، مستعملين المفاهيم المكتشفة من طرف Carnot وClausius وJoule. لكن مع إدراك مدرسة بروكسيل لحدود هذه النظريات؛ ذلك أن مقاربات الديناميكا الحرارية التقليدية تندرج ضمن أنساق مغلقة ومتوازنة[14]؛ بيد أنه توجد في الطبيعة أنساق تتبادل المادة مع العالم الخارجي دون أن تكون متوازنة بالمفهوم الذي يعطيه علم الديناميكا الحرارية لهذا المصطلح، والمثال الأبرز على ذلك هو الكائنات الحية التي تنتظر الموت لكي تخضع لديناميكا التوازن الحراري! لكن يوجد في عالم الجماد أيضا أنساق خارج التوازن كالتي تستقبل الحرارة والمادة بشكل غير متجانس، أو كالتي تستجيب بسرعات مختلفة، والمثال الأبرز هو المعادلات الكيميائية التي تتشكل لتؤدي إلى انفجار.. وتبقى المسألة المفهومية الأبرز هي الانعتاق من قاعدة "التناسب"proportionnalité بين الأسباب والمسَبَّبات.. ويسمي Claude Allègre هذه الحرية الجديدة في التفكير "اللّاخطية" non-linéarité... ومع تبلور مفاهيم البيولوجيا الجزئية حاول Prigogine أن "ينمذج" modéliser كميّا مسلسل انقسام الحمض النووي ADN. ويفيدنا Allègre أن الطبقة الثانية من الأبحاث حول "ظواهر اللانظام" تنتمي إلى الفيزياء النظرية، ذلك أنه في سنوات السبعينيات حاول العالم الأمريكي Ken Wilson[15] فهم مجموعة ظواهر فيزيائية تسمى Transition de phases مثل تبدل الماء من حالة إلى حالة (بخار، سائل، جامد)، وخلص إلى أن انتظام المادة يخضع لتراتبية، بحيث أن كل ذرة لا ترتبط بعلاقة إلا مع الذرات المجاورة لها، وهكذا تتكون "مجالات" domaines تنسج علاقات مع "مجالات" أخرى. وتبعا لذلك، يمكن حساب سلوك النسق؛ وقد استعمل Wilson عند كل خطوة نتيجة المستوى السابق، وخلص إلى طرح السؤال التالي: ما هي المسافة التي عندها يؤثر سلوك ذرة ما على باقي الذرات؟ وإذا كان النسق شديد "الفوضى"، تكون هذه المسافة ضعيفة جدا، وكل ذرة تكون حرة أو تكاد.. ويفيدنا Allègre أن فيزياء الكم physique quantique لا تمكن من تفسير تعقد الظواهر الطبيعية؛ لأن الجزء لا يعبر بشكل كامل عن الكل، وأن معرفة الخصائص الكمية للذرات لا تمكننا من إدراك كامل لانتظام الكل، وهو الأمر الذي كان يعتقده رواد البيولوجيا الجزئية على رأسهم Jacques Monod في كتابهHasard et nécessité (منشورات le Seuil 1970)[16]، ويستدل Allègre بقولة معبرة لويلسون يقول فيها: "حتى لو عرفنا جيدا الخصائص الكمية لجزيئة الماء، لا يمكننا أن نستخلص من ذلك القوانين التي تتحكم في تكون الأمواج في البحار". ويستمرAllègre في إبراز الاكتشافات العلمية التي برهنت على وجود "اللانظام" في النسق الكوني مثل نظرية fractals مع Benoît Mandelbrot، وميكانيكا السوائل، والاكتشافات الحديثة في علم "الأرصاد الجوية" مع Lorenz، ونظرية الجاذبات الأجنبية مع David Ruelle...
وخلاصة القول أن حمى "الكاووس" قد انتشرت، وانبرى مجموعة من الباحثين إلى الجمع بين مختلف النظريات القائلة بسيادة "اللانظام"، من أمثال Yves Pomeau وPierre Bergé وMonique Dubois وShaw، وطفت على السطح من جديد أعمال الرائد Poincaré، وأضحى كثير من الفيزيائيين والكيميائيين والبيولوجيين يستعملون مفاهيم نظرية "الكاووس"..
جميل جدا الاقتباس الذي اقتبسه Allègre منPoincaré الذي صرح سنة 1920 بقوله: "بلا شك، إذا أضحت وسائل الاكتشاف لدينا أكثر عمقا واختراقا، سنكتشف البسيط تحت المركب، ثم المركب تحت البسيط، ومن جديد البسيط تحت المركب، وهكذا دواليك دون أن نستطيع الحسم فيما ستؤول إليه الأمور..".
ألا يحيلنا كلامPoincaré إلى كلام Edgar Morin في كتابه la pensée complexe، الذي يؤمن بانبثاق الكل عن الجزء وانبثاق الجزء عن الكل بشكل جدلي، وهو نفسه خطاب أبو القاسم حاج حمد حينما تحدث، في جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، عن العلاقة بين المتناهي في الصغر والمتناهي في الكبر بشكل جدلي، مستحضرا التمييز القرآني بين الخلق والتشيؤ؟ والخلق هنا يتسم بالتعقيد بشكل يجعل قوانين "التشيؤ" الطبيعية لا تعبر إلا على جزء بسيط من مفهوم الخلق، وهذا مسار مغر وشيق في البحث الفلسفي يعد بتطبيقات مفيدة على المستوى الفلسفي والمنهجي..
ضمن سياقات نظرية "الكاووس" المتعددة الأبعاد يحلق بنا "بيير كاي" في كتابه "الأخلاق والفوضى" ويطرح علينا تأملات فلسفية شاملة انطلاقا من السؤال الجوهري المتعلق بالفعل l’agir. لكن نظرية "الكاووس"، بمفهومها التاريخي، شكلت هاجسا لفلاسفة كثيرين قبل "بيير كاي". ولعل نيتشه وهايدغر من أبرز الفلاسفة الذين فكروا، بطريقة أو بأخرى، في "الكاووس" وتجلياته في حركة الفكر والوجود.. وقبل أن نتبع "بيير كاي" في سبره أغوار "الفوضى الكونية"، لنطالع بعض آراء نيتشه حول الكاووس الذي يعتبر بيير كاي قارئا نهما له، بل تبدو تأثيرات هذه القراءة بادية في "الأخلاق والفوضى" على الرغم من أن تناول نيتشه في كتاب بيير كاي لبس لبوسا نقديا..
يقول نيتشه في كتاب "هكذا تكلم زارادشت[17]": "هل سمعتم بذلك المخبول في ساحة السوق بفانوسه في واضحة النهار وهو يصيح "أبحث عن القيم" أبحث عن القيم"؛ وبما أن المتواجدين هناك لا يعيرون للقيم أي أهمية، صارت في الساحة جلبة ساخرة قائلة هل فقدناها؟ أين هي مختبئة؟ هل هاجرت؟ هل تاهت كطفل صغير؟ تفحصهم المخبول واحدا واحدا وصرخ في وجههم: لقد قتلناها لكن كيف تمكنا من ذلك؟ كيف استطعنا إفراغ البحار؟ وكيف مسحنا الأفق؟ وكيف أزلنا هذه الأرض عن الشمس والنور؟ وإلى أين نتجه الآن؟ ألسنا في هاوية ما بعدها هاوية؟ لم يعد هناك من فوق ولا تحت ولا جهات ولا اتجاه؟ ألا نتيه في عدم لا نهاية له، وفي فراغ لا مستقر له؟ ألا نشعر بالبرد القارص، والظلمة تلفنا من كل حدب وصوب؟ ألا ينبغي لنا أن نشعل شمعة بدل أن نلعن الظلام؟ ماتت القيم ونحن من ارتكب هذه الجريمة؛ أقدس ما كان في العالم فقد دماءه تحت حديد خناجرنا... بغتة توقف المخبول وتفحص وجوه المحيطين به، فوجدهم واجمين صامتين. ألقى بفانوسه أرضا وقال: "لقد جئت مبكرا؟ وزمني فيما يبدو لم يحن بعد." أو بعبارة أخرى "لست الفم الذي يلائم هذه الآذان."
واضح أن المخبول يجسد الحكيم الفيلسوف كما يجسده زارادشت، والفانوس يجسد نور الحقيقة، والجلبة عامة الناس أو القطيع الساخر من فقدان القيم لبريقها وقوتها، والجريمة هي المدخل الحقيقي للظلام والعدم والفراغ؛ أي العشوائية الكونية. لكن هل حان وقت تنظيم هذه العشوائية أو فهمها[18] يقول نيتشه: "لنصغ السمع إلى زارادشت ونتساءل معه: ما العشواء le chaotiqueأو ما هو "الشواش"؟ يعني العشوائي لديه ما هو "غير منظم"، وهو فراغ شاسع يشبه فراغ الصحراء؛ يتراءى هذا العالم لديه كوحش من القوى لا بداية له ولا نهاية، قوة قاسية لا تزيد ولا تنقص، يغلفها العدم ولا يرسم حدودها، يشبه لديه لعب القوى وتموجاتها، يمُّ يلفه الإعصار من كل جهة، مد، وجزر، ينتقل من المتعدد إلى الواحد، ومن الهادئ إلى المتوتر؛ لعب الأضداد والمتناقضات في حاجة إلى الانسجام[19]"، "هذا هو عالمي الديونيزوسي الذي يخلق نفسه ويحطمها أبديا..[20]."
إن عالم "فيما وراء الخير والشر" يسميه نيتشه "عالم إرادة القوة"؛ إرادة القوة من حيث هي تحكم وعزيمة، تحكم عشوائيتنا، وتدفعها إلى أن تأخذ شكلا وتغدو ضرورة في الشكل، وتصبح منطقا بسيطا، سلسا، رياضيا، وأن تكون قانونا، "هذا هو طموح الفنان[21]" باعتباره مقوما؛ أي خالقا للقيم ومبدعا لها[22]." ألسنا نلاحظ هنا التشابه الكبير بين "إرادة القوة" عند نيتشه في مواجهة "الكاووس"، وبين مفهوم "إمبراطورية الأنا" empire de soi الذي يدعو إليه بيير كاي كأخلاقية جديدة في مواجهة "الكاووس" الذي أضحى قدرنا؟ ثم أليس طموح الفنان الذي يدعو إليه نيتشه هو بمعنى من المعاني طموح "بيير كاي" نفسه العارف والمتمرس بتاريخ الفن العالمي؟ وليس غريبا أن يكون المنطلق الأساسي في كتابات بيير كاي هو "تاريخ الفن"، بل إنه يقترح علينا "أخلاقية" للتعامل مع "الكاووس" السائد في الكون عبر تحليله لتطور "التقنية" عبر تاريخ الفن وعلم الزخرفة... وهنا نلمس مرة أخرى تأثر بيير كاي بفلسفة نيتشه، وهذا يفصح عنه، وتأثر آخر بجيل دولوز وفيليكس غاتاري لم يعلن عنه، لكنه بدا لنا واضحا من خلال مقارنة النصوص والاشتراك في المقاصد... لكن الكاووس في العمق، حسب نيتشه، ينطلق من الذات، فهو سابق على كل تكون أو تصور، سابق على كل بناء ثقافي؛ منه يمكن الانطلاق لتأويل ملائم للوجود حسب بول ماتياس P. Mathias في مقدمة الطبعة الفرنسية لكتاب "هكذا تكلم زرادشت"؛ ورغم أن "الكاووس" يخبط خبط عشواء، فهو لا يخلو من قانون يشبهه نيتشه بقانون اللعب، ويربطه بالطفل والبراءة، ذلك أن الطفل براءة ونسيان، بداية جديدة، لعب عجلة تتحرك بذاتها أول حركة، أول تأكيد مقدس[23]. ثمة مسألة جديرة بالاعتبار، وهي الاستمرارية الفكرية التي تبدو لنا واضحة في أعمال هؤلاء الرواد الذين بحثوا في "تاريخ الميثافيزيقا"، بحيث نلاحظ كثافة معرفية بالغة الأهمية في نصوص نيتشه ودولوز وكاتاري وهايدجر تربط الماضي الفلسفي الغربي بحاضره بشكل منهجي كبير.. من ذلك مثلا أن نيتشه يعود إلى ما قبل السقراطيين، إلى هيراقليطس وإلى عبارته الكثيفة "hybris"؛ أي تجاوز الحد، كالكبرياء والعنف، ويستعيد نيتشه سؤال هيراقليطس: هل هذا العالم مليء بالأخطاء والجور والتناقضات؟ أجل يجيب هيراقليطس لكن فقط بالنسبة للإنسان محدود الأفق الذي يرى الأشياء منفصلة لا في كليتها؛ كل الأشياء متناغمة تناغما لا مرئيا، غيبيا، بالنسبة للإنسان العادي، معقولا بالنسبة لهراقليطس المتأمل؛ بمفردهما الفنان والطفل، يمكنهما في هذا العالم بناء وهدم الأشياء بكل براءة... نخلص إلى أن "الكاووس" كنظرة للكون، كان حاضرا بقوة في كل الفلسفات ما قبل السقراطية، صراحة أو بشكل ضمني؛ فهو مثلا "اللانهائي" عند أنكسيماند، وهو الصيرورة عند هيراقليطس وهو "الكاووس" عند أنكساغوراس[24].
كيف يرى كل من Deleuze وGuattari "الكاووس" وكيفية تمثله، وإمكانية تجاوزه؟ في الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يواجه "الكاووس" حسب دولوز وغاتاري[25] إلا بالفن أو العلم أو الفلسفة؛ فالدين يغطي "الكاووس" ويدثره[26] والرأي يغلفه ويطمسه، أما الفن والعلم والفلسفة فدعوتهم تميل إلى الارتماء في أحضان "الكاووس"؛ ومن هذا الانغماس يعود الفيلسوف بأفكار يعاد ترتيبها وفق المفهوم، ويعود العالِم بمتغيرات خاضعة للدوال (جمع دال) تنطلق من الاحتمالات المحلية إلى الكوسمولوجية الكلية، ويعود الفنان بتنوعات تبرز المحسوس وتمنحه لا نهائيته. كل محاولة من هذه المحاولات تواجه "الكاووس" بشكل من أشكال القفز والاختراق. الفنان يخترق "الكاووس" بالفاجعة أو الاحتضان فيترك أثر ذلك على الوجه، والعالٍم بالتكميمات المتغيرة العالقة في معادلاته، والفيلسوف يجمع العشوائية الشعواء بحب (فيليا) في المفهوم نبذا لكل كراهية أو عدوانية.
لكن هل يمكن رسم حدود الكاووس؟ يبدو أن "الكاووس" يتميز بالتقاطعات والافتراقات، كما يتميز بالتفردات والتوحدات، فليس من السهل تحديد ملامحه. فهو لا يأخذ شكلا شجريا بتفرعاته وتشعب أغصانه، إنه يأخذ، فيما يبدو، شكلا جذموريا لا يعرف صفات تحت/فوق ولا عمق/سطح.. أليست هذه هي العشوائية الكونية؟ تلك التي تجعل المجالات الثلاثة متباينة غير متداخلة، ذلك أن مجال المحايثة الفلسفية ليس هو مجال التركيب الفني ولا مجال الإحالة أو الترابط العلمي.. المجالات الثلاثة تتمايز في الدماغ وتتداخل في "الكاووس"، وتداخلها العشوائي جزء من نموها وتفاعلاتها؛ لا يمكن للفلسفة أن تنمو وتتفاعل إلا مع ضدها، مع ما ليست هو: الجزء الذي لا يفكر بعد فيما يفكر والجزء الذي لا يشعر بعد بما يحس والجزء الذي لا يعرف ما تمت معرفته[27].
وبناءً عليه فـ"الكاووس" ليس مفهوما ولا مقولة، بل إنه نقيض المفهوم، أو بكلّ بساطة لا مفهوم non-concept كما يرى بول كليPaul Klee[28]. والنقطة le point هي ما يرمز إلى الهاوية أو الفوضى أو الكاووس عنده، وهي نقطة بدون أبعاد؛ إنّ النقطة هي هذا الوجود المعدوم أو هذا العدم الموجود، هي هذا المفهوم الذي ليس بمفهوم إطلاقا والذي منه يصدر كلّ شيء أو لا يخرج أي شيء، ما يصير وما لا يصير، ما يوجد وما لا يوجد. النقطة حسب تعبير دولوز هي العلامة التشكيلية أو الدلالة التصويرية على الكاووس، وتكتسي لون الرماد الذي هو مزيج من الألوان جميعها، ويقع في موضع لا هو بالأعلى ولا بالأسفل، لا هو باللون الدافئ ولا باللون البارد.. إنها نقطة بلا أبعاد؛ لأنها أصل الأبعاد ويمثِّلها بول كلي Paul Klee بالمركز الأصلي للكون الذي تتحدَّد منه كلّ الأبعاد، إنها بدء العالم أو كما يمثلها بالبيضة، النقطة تلخِّص فكرته التشكيلية عن نشأة الكون؛ ما فعل الرسم حسب بول كلي سوى تحديد نقطة البدء في اللوحة ومن ثمّ جعلها، وهي النقطة الرمادية، المنبع الذي تخرج منه الأشياء بواسطة تمديدها وتوسيعها تمهيدا لجعلها تقفز على نفسها. فالنقطة الرمادية التي لا تقوى على تجاوز نفسها تسقط مجدَّدا في الفوضى أو في "الكاووس"، وبالتالي لا يخرج من صلبها شيء. أمّا الرسّام المبدع حقا هو من يجعل النقطة تتعدَّى نفسها، ويخرج بها من "الكاووس" إلى الكوسموس[29].
ألسنا هنا إزاء إعادة اعتبار لنظرة كوسمولوجية اعتُقد للحظة أن الفكر الغربي قد تجاوزها بعد أعمال كل من كانط وهيغل؟ ألم يخلص لوك فيري في كتابه حول فلسفة كانط[30] إلى أن هذا الأخير طوى بفلسفته الأخلاقية التصورات الكوسمولوجية والثيولوجية؟ ألم يذهب إلى أن مفهوم الحرية الإنسانية وبلورة أخلاق الغيرية بعيدا عن الوازع الديني هي من أهم خلاصات الفكر الكانطي؟ ألم يقل هابرماس أن فلسفة الحداثة هي فلسفة ما بعد هيغيلية؛ أي ما بعد ميثافيزيقية؟[31].
الحاصل، أن المخاض الفلسفي حول مفاهيم ذات علاقة بتفكير الإنسان في الكون بات اليوم معبرا عن الاختلاف والتنوع ونسبية المنطلقات الفلسفية، بحيث لا يمكن أن نتصور تاريخ الفكر الفلسفي كتاريخ خطي تطوري متسم بالحتمية التاريخية كما فعل أوجست كونت، وكما يحاول أن يقنعنا لوك فيري في دراسته لفلسفة كانط[32].
في إطار انخراطه في النقاش الدائر حول نظرية "الفوضى" ومآلاتها يرى "بيير كاي" أنه: لا يوجد هناك تبادل ولا اقتصاد بين ما يدمر وما يخلق.. إن نظرية المعادلة المعممة التي أبدعها لافوا زييهLavoisier "لا شيء يفقد، ولا شيء يخلق، الكل يتحول" لا مكان لها هنا.. بعض الأشياء تتلاشى دون أن نستطيع قياس تداعيات فقدانها، بينما تخلق أشياء أخرى دون أن يكون ضروريا احتمال الوجود القبلي للنّغفة [33]Chrysalide. وبين الفقد والخلق لا مكان لأي تحول بل الفوضى التي يفرزها "الخلل المظهري"dysmorphie بشكل جدلي؛ لأن الفوضى تفرز هذا "الخلل" كما تنتج عنه.. في هذه الظروف يبدو من المستحيل تقييم العلاقة بين النظام واللانظام، بين الربح والفقد، وتبعا لذلك يستحيل أن نقارن بين الأنتروبيا entropie ونقصانها..
إن الفوضى لا يمكن تعريفها بدقة، و"العناية" المرتبطة بها، إن وجدت، فهي ذات طابع غامض ومفاجئ وغير قابلة للاختراق، لكنها بضمان حرية متحررة من كل عوائق القانون والنظام والتراتبية، يمكن للفوضى أن تستغني عن العناية من أجل أن تبرر نفسها؛ لأن الحرية تنتصر لكل ما لا تستطيع "العناية" الحرص عليه.. إن الفوضى هي إضفاء صفة اللامُتناهي على "النسق" وحريته، وحيثما تسود "الفوضى" يكون كل شيء ممكنا بالنسبة للإنسان بما في ذلك المستحيل...
وبمعنى من المعاني، ليست الفوضى شيئا آخر سوى التعبير عن التحول من المتناهي إلى اللامتناهي بواسطة الحرية، بمعنى أنها تنتج مرة أخرى عن "خلل" في الشكل؛ لكن عندما تنتشر الحرية اللامتناهية للفوضى لا يعتبر وقتها ضروريا وضع حصيلة للربح والخسارة... الرصيد دائما إيجابي مثلما الشأن في رهان باسكال Pascal بين الخسائر المعلومة والمنتهية وربح الحرية اللانهائي.. الحرية تعوض "العناية " بشكل كبير دون المرور بالاقتصاد أو حساب "مبدأ أقل فعل[34]"...
"لماذا يوجد الفعل بدل العدم؟[35]" ناقدا للسؤال الميثافيزيقي، يطرح بيير كاي، في ظل الكاووس، السؤال المركزي في الأنثربولوجيا الفلسفية: كيف يستطيع الإنسان بلورة فعل حقيقي؛ بمعنى فعلٍ من إبداعه هو؟ وفق أي شروط يمكن للإنسان أن ينسب إليه القوة التي يدعي أنها ضمن أفعاله؟ والميثافيزيقا تقوم على مفاهيم رئيسة كالكون cosmos والمادة physis والغاية telos والكمال entelecheia... وقد قُوضَت هذه المفاهيم، حسب هابرماس، منذ ديكارت وليبنيتز وهيوم؛ أي منذ أن أصبحنا ملزمين بالتمييز بين المفاهيم الوصفية والمعيارية والتقويمية؛ فالمفاهيم الأساس التي تنهض عليها الميثافيزيقا لا تسمح بإقامة هذه الفروق التي نحن ملزمون بإقامتها اليوم. لا يمكننا أن نعيد استثمار صيغة ميثافيزيقية في التفسير تحيل على غائية موضوعية أو على شمولية أو على مطلق..[36]؛ كما أن هابرماس، من جانب آخر، لا يؤمن بالاستمراريات التي يقترحها هايدغر في دروسه عن التراث الميثافيزيقي، كما لو أن المرحلة الفاصلة بين أفلاطون ونيتشه لم تشهد إلا الطريقة التشييئية نفسها التي تضع الموجود محل الوجود[37].
نحن إزاء إعادة قراءة للتاريخ الميثافيزيقي بحثا عن فهم الإشكاليات الكبرى التي تؤرق العالم المعاصر مثل الحداثة ومفهوم العقل، والعلاقة بين اللغة والفكر، ومفهوم الزمن، وعلاقة عالم الشهود بعالم الغيب.. وإذا كان بيير كاي يبدو قارئا متعمقا في مسارات الفكر الميثافيزيقي الغربي، فإن فلاسفة آخرين مَهَّدوا الطريق لإعادة التناول المعرفي لهذا التراث بما يخدم تطور الفكر الفلسفي من منظور تاريخي...
نجد، مثلا، "ليو شتراوس" قد بحث في أفق إحياء لحظة الفكر الميثافيزيقي؛ والعمل الذي قدمه ليو شتروس لا يعبر، حسب هابرماس، إلا عن مهارة مؤول كبير ساهم، بكيفية غير حجاجية، في بعث نصوص قديمة لأرسطو وأفلاطون. و"أحسب أن المشاكل التي وضعها الأقدمون تعد بمعنى من المعاني مشاكل خالدة، غير أنه لا يبدو أنه بإمكاننا، بعد هيغل، التفكير استنادا إلى مسلمات أفلاطون أو أرسطو أو أتباعهما[38]."
من جهة أخرى، فإن إشكال الحرية، حسب "بيير كاي" يستدعي فحص التطور الميثافيزيقي للقوة.. ذلك أن أطروحة الكتاب الرئيسة هي أن الفعل الإنساني لا يمكنه أن يكون متحررا إلا إذا استند على قواه الخاصة بعيدا عن "السلطة الجوهرية للمبدأ" التي تم تصريفها بأشكال مختلفة على مدى التاريخ...
إن"الأخلاقية" تحيل على "الميثافيزيقا" ليس لكي تمنح هذه الأخيرةُ نماذجَ لتصريف قوة تأتي من أجل جعل الإنسان أمثل، بل على العكس من ذلك، لتحقق فرقا راديكاليا بين "قوة المبدأ" و"قوة الإنسان"، وهذا يستدعي اعتراف الإنسان بضعفه الخَلقي المتأصل وهو يستجمع ميكانيزمات تشكل قوته؛ أي بفتحه حوارا حول التقنية والفن والسياسة... هنا يعود بنا بيير كاي إلى اليومي، المحسوس، والمعيش متأثرا بتطبيقات "نظرية الفوضى" التي أنزلت التفكير الفلسفي من "أعلى" إلى "أسفل"؛ أي من التنظير إلى التعبير عن الأشياء البسيطة واليومية للإنسان.. ويرى بير كاي ضرورة التضامن بين حقول الميثافيزيقا والأخلاقية والتقنية والسياسة من أجل تركها تؤثر ضمن اختلافاتها البينية وليس عبر ديناميكية تفضي إلى انصهار بعضها في بعض، وهنا نستشف حضور التنظيرات الفلسفية حول "نظرية الفن" خصوصا مع نيتشه، وهايدغر ودولوز وغاتاري وكلي، مما يضفي على عمل pierre Caye عمقا وأصالة ضمن منطق استمراري.
إن القيمة المضافة الأساسية عند "بيير كاي" هو أنه يعيد قراءة التاريخ الميثافيزيقي الغربي باعتباره تاريخا تحولت فيه "فكرة المبدأ" إلى أداة استلاب واستسلام إرادي.. ذلك أن تاريخ الميثافيزيقا أضحى، تبعا لذلك، "مسلسلا" كبيرا بحث الإنسان بموجبه عن "سلطة عليا" يخضع لها، وناظرا لها كسلطة مكملة لنقص فيه.. وإن رعاية "المبدأ" تصبح في هذه الحالة ضمانا انطولوجيا؛ تبعا لذلك، فإن الإستراتيجية هنا تكمن في تحديد مصدر للقوة وبيان أنواع العلائق الجيدة من أجل أن تصب هذه القوة في الفعل الإنساني... وإن بنية العلاقة الميثافيزيقية هذه، هي البنية نفسها التي دافع عنها الفيلسوف اليوناني بارمينيدس Parménide القائل: من المناسب الانخراط في "الدائرة المستمرة" للكائن l’être؛ ذلك الكائن الذي يبدد الطاقة، والاستمرارية، والانسجام والاكتمال بتعاطيه للتقليد بواسطة التأمل.. إن "قوة المبدأ الأساس" الذي يفترض فيها أن تكون "القوة القصوى" بما لا يجعل أي شيء يعرقل مسيرها، تصبح مع أفلوطين Plotin، فيلسوف الأفلاطونية الجديدة، قوة لا نهائية عبر نظريته الشهيرة المسماة نظرية الفيض أو الصدور..
ويتكرر هذا الوعد الأنطولوجي عبر أنواع التناسخ avatarsالمتعددة في التاريخ الغربي سواء عبر الشكل الأنطولوجي الخالص "للمبدأ"، أو شكل "طبيعة الأحياء"، أو عبر "إله المؤمنين"، ذلك أنه في كل مرة يلتجأ الإنسان إلى عناية تشرعن وتقوي التجليات المختلفة لفعله، بذلك يتحول "الفعل الإنساني" إلى "فعل للمبدأ" عبر الإنسان..
إن تاريخ الفكر الغربي يصبح إذن، تاريخا للضبط الإشكالي "لما فوق القوة"superpuissance هذه بواسطة "الإنتاج البشري"، وإن هذه الصعوبات تغذي أيضا مشاريع التحرر من "الحداثة" كما تشهد بذلك العواصف السياسية التي شهدها القرن العشرون والتأثيرات الكارثية للتقنية المعولمة..
إن الجنيالوجيا النقدية لميثافيزيقا "القوة اللانهائية" بما فيها ممثليها المعاصرين، لا تهدف إلى تطليق "فكرة المبدأ"، ولا التدخل في متطلبات الحرية، بل على العكس من ذلك إعادة التفكير في "العلائق" ضمن تمفصلات جديدة بين النسق الميثافيزيقي الذي يربط بين "المبدأ" و"العالم" و"الإنسان"، وكأن "بيير كاي" يدعو في هذا الإطار إلى تناول جدلي لعلاقة "المبدأ" و"العالم" و"الإنسان. وأرى أنه يطرح بذلك موضوعا بعيد الغور متمثلا في طرح سؤال قديم/جديد يقع في قلب الرؤية الميثافيزيقية عبر سؤال الوجود.. في هذا الإطار، يدعم "بيير كاي" رأي هايدغر القائل بأن إنتاج التقنية مرتبط جُوّانيا بالميثافيزيقا، لكنه ينظر إلى العلاقة بينهما بشكل مختلف انطلاقا من تمييزه بين اتجاهين ميثافيزيقيين أساسيين.. ويذهب "بيير كاي" إلى حد اعتبار أن التأمل الهايديغري في الكائن يبقى لصيقا بفكرة "قوة المبدأ الخارقة".. وإن النقد الهايديغري "للوحدة المجمعة لكيفيات الاستثارة Gestell[39]"، أو ما يمكن ترجمته بالمصطلح الفرنسي arraisonnement، باعتبارها حارمة للإنسان من حريته دون أن تحرره من " القوة الخارقة" للسلطة الجوهرية pouvoir fondamental، يبدو هنا مركزا على مسألة الحرية كقضية وجودية في الفكر الفلسفي الغربي؛ وعلى الرغم من الانتماء الديني المعلن لعديد الفلاسفة ككانط وهيغل واسبينوزا وديكارت، فإن مسألة حرية الإنسان في مواجهة "القدرية الدينية" شكلت ولازالت تشكل أحد أهم إشكاليات الفكر الفلسفي المعاصر، وهي مسألة جديرة بالاهتمام...
من جهة أخرى، يرى كاي أن الخلاف الذي حافظ عليه هايدجر إزاء هيغل حول العلاقة بين المبدأ والزمن يبدو مسألة حاسمة من أجل فهم النسق، لكن هذه العلاقة لا تمكننا من التفكير في جوهر الزمن. والملاحظ أن هايدغر يبقى، أكثر من هيغل، مرتبطا بأرسطو وتصوره الفيزيائي للزمن. وإذا كان صحيحا أن هايدجر يعيد النظر في طريقة تصريف الزمن التي بسطها أرسطو في Physique IV، فإنه، مع ذلك، حافظ على شيء من تصور أرسطو الكوسمولوجي حول أصل الزمن وطريقة تصريفه.. بالنسبة لأرسطو الزمن ليس أولا، بل مرتبط بحركة الأشياء، وإذا حدث وكان العالم بلا حركة كامل السكون، فلن يكون هناك زمن.. ولأنه في الكوسموس الأرسطوطاليسي كل تتابع مرتبط بحركة السماء الأولى، وبالدوران النجمي للزودياك zodiaque، وتعاقب الليل والنهار[40]. وتجدر الإشارة إلى العمل الجيد الذي قام به Étienne Klein في كتابه le facteur temps ne sonne jamais deux fois[41] الذي أبرز فيه حضور فكرة الزمن في الفلسفة الغربية في بعديها القديم والحديث، متتبعا بالأساس تمثل النظريات الفيزيائية لمفهوم الزمن وتصور الإنسان له، وعيشه بداخله.. وقد أبرز كلاين الدور الذي لعبه كانط في إعادة طرح سؤال الزمن معيدا التفكير في المفهوم الأرسطي له، وانتهى كلاين إلى إبراز دور التقدم العلمي في مجال "التأريخ" Datation، مؤكدا على دور علم الديناميكا الحرارية و فيزياء الكم في تقديم صورة أوضح حول مفهوم الزمن.. ذلك أن الحركة الكونية هي التي تحدد في نهاية المطاف الزمن لكل الأشياء بشكل مماثل، ولا يصلح الزمن على الحقيقة إلا لقياس وترقيم حركة الأشياء في تتابعها؛ وإن جدلية الزمن والحركة تظل بلا تغيير، وهي تعتبر ضمن العناصر البنيوية الأساسية التي تخترق تاريخ الميثافيزيقا وتحدد جينيالوجيا النسق...
وضمن رؤية مفارقة لرأي هايدجر وكاي يقترح علينا هابرماس رؤية حول الميثافيزيقا تستحق التناول في إطار متابعة عمل بيير كاي التفكيكي لمعطيات التاريخ الميثافيزيقي الغربي، فهابرماس "لا يدعو البتة إلى تفكير أصلي، كما لا يدعو إلى استمرارية قسرية بين الفكر الميثافيزيقي الخالص والفكر الحديث. فهذا الأخير، بالنسبة إليه، يمكن أن يوصف بأنه نمط من فلسفة الذاتية؛ ولا يظن أن هناك ضرورة تدعونا إلى الالتفات إلى التاريخانية، فهو والفلاسفة الفرنسيون (باشلار أو باطاي أو فوكو أو ديريدا) أو أدورنو، يفكرون كلهم استنادا إلى مسلمات بعد هيغيلية؛ أي استنادا إلى مسلمات بعد ميثافيزيقية. بيد أن هذا لا يعني "أننا مسجونون، يقول هابرماس، في سياق تاريخي عارض أو طارئ أو محلي أو إقليمي؛ لماذا يجب أن نكون كذلك؟ لأنه لم يعد لدينا أي أساس ميثافيزيقي بعد أن تهاوت تلك المفاهيم الميثافيزيقية وانهارت. لم يعد لدينا أي منهج فلسفي مفضل، كما كان الحال عليه سابقا حين كان الجدل أو الحدس الفينومينولوجي منهجا متبعا، غير أننا اليوم محظوظون لامتلاكنا القدرة على الوقوف موقفا تبصريا إزاء كل أشكال الاستدلال الخطابي؛ فلا يمكننا باختصار أن نغض الطرف ونتخلى عن هذا الاستدلال الخطابي. ونحن، من حيث إننا فلاسفة، نعد كذلك أعضاء في المجموعة العلمية تماما كغيرنا من العلماء؛ ويتعين علينا أن نحافظ على وجودنا إزاء المباحث الأخرى حتى لا تبتلعنا، من دون أن يكون لدينا الحظ أو الحق في ادعاء أي امتياز في بلوغ الحقيقة وحدنا، بغض النظر عن الطريقة التي قد نفهم بها هذه الحقيقة؛ فالعلماء يحتاجون إلى نوع من الموضوعية، كما يحتاجون أيضا إلى نوع من تناسي المسلمات، وإلا فإنهم لن يحققوا أي تقدم يذكر؛ فلماذا لا يتعين علينا نحن الفلاسفة أن نواصل البحث الحديث في الصور والشروط الأكثر عمومية للكلام والفعل والتفكير؟ ألسنا من يملك ميزة الدفع بالتأمل أبعد مما يحتاجه العلماء عادة؟[42]
إن ما قام به هابرماس في كتابه "خطاب الحداثة الفلسفي" ينحصر في رواية قصة تشرح الموقف الذي وقفه الفلاسفة (الألمان منهم خاصة) منذ نهاية القرن 18 مما أدركوه هم أنفسهم بوصفه حداثة، فهذه الحركة انطلقت بكيفية من الكيفيات مع كانط، وغدت أمرا ملحا، بوجه خاص، مع هيغل والهيغليين الشباب، بمن فيهم ماركس. وجاء نيتشه لينخرط بدوره في أحداث هذه القصة عن طريق نقده الجذري للعقلانية،ثم تبلور، منذ نيتشه، اتجاهان نقديان في القرن 20: أحدهما: تمثل في نظرية السلطة، انتهت إلى فوكو عن طريق باطاي، والثاني: تمثل في نقد الميثافيزيقا، قاده كل من هايدغر وديريدا[43] لكن بيير كاي لا يدعو إلى قطيعة مطلقة مع "التفكير الميثافيزيقي"، ولا ينحو منحى هابرماس القائل "بالتفكير ما بعد الهيغيلي؛ أي ما بعد الميثافيزيقي"، بل يقترح علينا التمييز بين صنفين من الميثافيزيقا: ميثافيزيقا التحولّية بين الكائن l’être والواحد l’Un[44] وميثافيزيقا الانفصال بينهما.. فالكائن يحدد "قطب القوة" وتعدد أنواع التأثير، بينما يحدد "الواحد" قطب الانسجام والاستمرار والكلية؛ يتحدد دور الأول في بناء صورة المبدأ المسلح فوق العادة": إذا حل كل من "الكائن" و"الواحد" محل الآخر بشكل تلقائي، فإن القوة تكتسب بشكل طبيعي انسجامها ونظامها...
يبرز بيير كاي كيف أنه: "لا خيار أمام الفعل البشري إلا أن يخضع لهذا "التركيب" إذا أراد تجنب الشر و"الفوضى ". أما الخيار الثاني الذي يستنبطه بيير كاي من التقليد الميثافيزيقي نفسه، مشكلا هنا قطيعة مع فلاسفة الحداثة، وأساسا من الأفلاطونية الجديدة المتأخرة بزعامة Proclus وخصوصا Damascius، فيمكن من تصور مبدأ مبني حول "شطر" scission داخلي يأتي لقطع الدائرة الديناميكية للقوة، ذلك أن كون القوة لا تجد نظامها بشكل تلقائي، وكون فاعلية "الكائن" لا تصب مباشرة في انسجام "الواحد"، يفتح مجالا للفاعلية الطبيعية والأنثروبولوجية..
إن العالم، يضيف كاي، لم يعد تعبيرا مختزلا للقوة اللانهائية للمبدأ، بل مجموعة محاولات من أجل تجاوز انشطاره التكويني.. لم يعد المبدأ يحمل الإنسان بفعل ديناميكيته اللامحدودة؛ بل على الإنسان أن يجد بنفسه، الوسائل والممارسات التي تمكنه من أن يبقى داخل الكائن..على العكس من ذلك، يؤدي التمييز بين الخيارات الميثافيزيقية إلى الاعتراف بباراديغمات paradigmes تقنية مختلفة؛ وإن الإنتاجية المدمرة للتقنية المعاصرة لا تبدو تبعا لذلك كنتيجة ملازمة للعمل التقني، وذلك حسب زاوية المقاربة والباراديغمات المتبناة..
يستعمل بيير كاي ثقافته الواسعة بدءًا من vitruvianisme إلى عصر النهضة، ليفكر انطلاقا من الهندسة المعمارية، في نموذج تقني للتأسيس والتدعيم لا يروم تحويل الطبيعة، بل التموقع على سطحها وتهيئة موقع دائم قادر على جعل العالم زاهيا عبر ديكوره decorum؛ وإن تقنية اقتصاد الوسائل والتأثيرات هذه، تفضل الثابت على المتحول، والاستقرار على الحركية ولا تستسلم لدُوار "خلق العالم" démiurgie[45].
إن تجربة الفعل الإنساني هي في جوهرها تجربة زمنية، لكن لا يتعلق الأمر هنا بزمن طبيعي ينقل الإنسان إلى عمق خصائصه البيولوجية وانبثاقه الكوسمولوجي.. إن هذه التجربة الزمنية لا تكمن أيضا في تدفق الانزياحات النفسية dilatations psychiques في اتجاه الماضي أو المستقبل.. وبدل أن تؤطر هذه "النشوات النفسية الوقتية" الفعل، يقوم هو بتأطيرها... يتعلق الأمر بدل هذا التصور للزمن، حسب بيير كاي، بزمن اصطناعي، يتيح به الإنسان لنفسه الديمومة، ويزيح عنه، بذلك، القوة الاختزالية للزمن الطبيعي والزمن النفسي؛ بمعنى تكثيف قوى الإنسان ومقاومة "الرغبة الجامحة في التعبير عن النفس" بفعل التحولات الوقتية...
وبما أن الإنسان لا يستطيع الالتجاء لأي إطار أنطولوجي آخر: كخلود المبدأ و الأشكال العتيقة archétypales، فإن رهان الديمومة durée لا يمكن أن يتحقق إلا بسبق الزمن le temps، لكن لا يتعلق الأمر هنا لا باتباع الزمن ولا بالهروب منه، بل بإنجاز قفزة داخل الوقت أكثر سرعة من تدفق الوقت نفسه، وإن هذه القفزة تمكن من سبق التشتت وامتلاك ناصية الفضيلة، وفصل "الفعل" عن "الحدث"؛ ومن أجل الفوز بديمومة لا شيء يضمنها، لابد للإنسان أن يقاوم بصلابة "تحولات المظاهر الطبيعية"...
لقد شُتّت العالم بما فيه الكفاية، وأذيبت حقائقه في المجرى العفوي للأحداث، وليس مستبعدا أن تستمر "الفوضى" في الإعلان عن نفسها ميثافيزيقيا، ليس ضمن نظام الحقيقة، بل ضمن "نظام" الهيمنة.. نتعرف، إذن، على "الفوضى" كعودة إلى الميثافيزيقا وهي في سيرورة تطورها: عودة الميثافيزيقا داخل "الفوضى"، والتحالف بين هاتين "الحجتين الفرعيتين" instances يعرب عن نفسه على أعلى مستوى ضمن خيوط الزمن العولمي، الذي يعني هيمنة الشمولية الميثافيزيقية دون أن تنطوي هذه الشمولية على انسجام وعلى معنى ودون أن تكون غايتها الإنسان، إنها "الفوضى"...[46].
إن الأنساق الإنسانية المعقدة، الاجتماعية والتاريخية، تعاني في نهاية المطاف من "خلل " عضوي dysmorphie، ذلك أنه لاشيء يسمح بالتأكيد على أن لولبية تعقد الأنساق تبقى وسطية، وأن المرور الحلزوني إلى المستوى الموالي من التعقيد يكون متماثل الشكل isomorphe مع المستوى الذي قبله.. وباختصار، لا شيء يسمح بالتأكيد على أن المستوى السابق يحتفظ به، ضمن تحوليته، في المستوى الموالي كما تقرره الدياليكتيكية الهيجلية..[47].
إن التحولية "الفوضوية"، وتحت تأثير تعقيداتها وكثفاتها تغير وتمحو بشكل جذري ملامح تشكل نسق دائم الحركة.. إنها تحولية لا تعاني من أي فائض، ولأن النمو قد أزيح من المركز décentré فإنه ينتمي إلى التطور "الفوضوي" وليس النمو الخطي linéaire الملازم للأنساق المعقدة. بيد أن إزاحة النمو "الفوضوي" عن المركز يؤدي إلى عدم تأقلمه مع الإنسان.. إن العالم الذي صنعه الإنسان يفترق، بفعل مسلسل "إظهار ذاتي"auto-extériorisation ، عن الذي "خلقه" لكي يحقق استقلاليته ولكي يتبع المنطق الأوحد لنموه، ويعتمد على ديناميكيته الخاصة دون أن يحتفظ بأي أثر من "تكوينه" و"مبدعه" بشكل يجعل العالم المعقد غريبا عن الإنسان..
مزاحا عن المركز، لم يعد العالم المعقد قادرا على الاحتفاظ بماهيته الأصلية، وتكف لولبية نموه عن تشكيل مرآة ينعكس فيها عمل الإنسان الذي يستطيع بدوره التعرف فيها على نفسه كما تقرر ذلك دياليكتيكية هيغل.. هل نحن هنا إزاء تناقض في تصور بيير كاي للميثافيزيقا؟ فهو من جهة يستلهم آراء الأفلاطونية الجديدة، الغارقة في الميثافيزيقا، ومن جهة أخرى يكيل ضربة للجدلية الهيغيلية باعتبارها المظهر الأكثر "حداثة" للفلسفة الميثافيزيقية؟
إذا كان العالم غير موافق للإنسان، فهل يفترض في الإنسان التأقلم مع العالم كما يلح علينا معظم السياسيين؟ إن هذا يعني التسليم لخدعة ثالثة،هي خدعة تكيف الإنسان مع "الفوضى" بدعوى أن "الكاووس" يلفه الغموض وهو مدمِج ومحسّن optimisateur. يرى بيير كاي أن الإنسان في حقيقته غير قابل للتأقلم مع "الفوضى" ليس لأن البشر يتميزون بالصلابة والانزواء والخوف، لكن وببساطة لأنه لا توجد في جوهر "الفوضى" إمكانية للتأقلم... إن "العمَاء" يعيش من اللاتأقلم الذي يظهره في كل الأحوال والملابسات، وهو ما يغذّي ديناميكيته المبنية على لا توازن أبدي...
وبشكل أوضح، لا توجد طريقة أخرى تمكّن الإنسان من أن يكون في مستوى "الفوضى" وما تفرضه عليه سوى تبني عدم إمكان تأقلمه.. وحدها قدرته على تنمية لا "تأقلميته" تمكن الإنسان من العيش داخل "الفوضى" والاستمرار في البقاء بعدها.. إن الرابط بين الإنسان و"الفوضى" رهين بلا تأقلميتهم المتبادلة: "الفوضى" غير متكيفة مع الإنسان، والإنسان غير متكيف مع "الفوضى"..[48] إن الإنسان هنا مطالب بأن يصبح "فوق إنسان"، ليس سوبرمان الذي تبشر به الإيديولوجيات الليبرالية وتخيلات عصرنا eugénistes، لكن "فوق إنسان"؛ أي محافظا على حياته ضمن استحالة العيش الإنساني في مواجهة "الفوضى" بعد اكتسابه طريقة في العيش، بفضل شكل جديد من "فن العيش"، في تحد لاستحالة العيش..
ألسنا هنا إزاء تعبير ضمني عن مطلقية الإنسان في تعامله مع المنظومة الكونية التي يعبر عنها في هذا السياق بـ"الفوضى"؟ ثم ألا نلاحظ هنا نوعا من التردد في الحسم بين العجز الأصلي للإنسان و"قدرته الخارقة" في مواجهة "الفوضى"؟ إن بقاء هذه الأسئلة مفتوحة على كل احتمال يجسد بمعنى ما تعقد الظاهرة الإنسانية وجوديا وكونيا واستمرار السؤال الوجودي حيا على المستوى الفلسفي والمستوى التاريخي.. ويخلص كاي إلى أن هذه الوضعية أحدثت تغييرا عميقا في معنى السؤال الميثافيزيقي؛ إذ لم يعد الأمر متعلقا بالتساؤل عن أصل الكون إجابة عن سؤال: لماذا الوجود بدل العدم؟ بل أضحى التساؤل: لماذا وكيف تستطيع الأنساق الإيكولوجية والإنسانية أن تصمد وتستمر على الرغم من تعرضها لشتى الأزمات والتحديات؟
مسلما بعجزه إزاء الطبيعة، يقول كاي، يصل الإنسان اليوم إلى عتبة يعترف فيها بأنه لم يعد قادرا على التحكم في أفعاله الذاتية وكأن سعيه الطويل للتطويع والهيمنة كان دائما مصيره الفشل. غير أن معنى العجز الإنساني يتغير من وضعية إلى أخرى.. وإن القوة التي كانت في الأصل معينا للإنسان في تجاوز عجزه صارت اليوم داعمة لهذا العجز؛ و إذا لم تعد القوة علاجا للعجز فهذا يعني أن هذا الأخير يستعصي على كل علاج، إنه المعطى الخام الذي لا يمكن تجاوزه، والذي يعتبر منطلق تشكل أخلاق المفارقة التي تفرضها "الفوضى"، بل تصبح هذه الأخلاقية موضوع "الفوضى" الأول.
لقد أضحت الأخلاق اليوم متصلة بضعف الإنسان بدل قوته. لم يعد الأمر يتعلق، إذن، بتحقيق التحكم، بل بتدبير "العجز"... إن وظيفة الأخلاق هي أن تعلم الإنسان كيف يعيش عجزه، ويصوغ حياته وفْقَه دونما بديل relève، لذلك فإن الكلمة المفتاح لهذه الأخلاق هو "البقاء" la tenue. لقد أضحى مصيرنا هو التشبث بالعيش من أجل البقاء..[49]؛ هل نحن هنا بصدد إضعاف للإنسان أم تقويته؟ هل عجز الإنسان لصيق بقوة المبدأ أو "الواحد" بالمفهوم الميثافيزيقي للأفلاطونية الجديدة؟ ألا يوجد هناك تردد ما في نسبة القوة أو العجز لدى الإنسان؟ كيف يصبح الإنسان أكثر عجزا عن مواجهة "الكاووس " كلما نمت قوته وشعر بتزايد قدراته؟ أعتقد أن "بيير كاي" فتح هذا الباب على مصراعيه دون أن يحسم مادته، وهذا في نظري يشكل امتدادا "للأرضية الخلافية" التي يقف عليها الفكر الفلسفي المعاصر. وجدير بالاهتمام هذا الرتق المتزايد للإنسان مع أصله الكوني بعد فتق تم التفكير ضمنه بحثا عن "تحرير" الإنسان مما وراء الطبيعة دام لقرون عديدة، لكن شعلة التناول الكوني للوجود الإنساني ما انطفأت يوما، وهاهي تعود من جديد لتفرض نفسها في حقل التفكير الفلسفي وتفتح الآفاق لمستقبل جديد للإنسانية وفق جدلية الغيب والإنسان والطبيعة الكونية...
"الكاووس" والعولمة: الاقتصاد والأخلاق السياسية
يرى بير كاي أن أخلاقية بناء القوة لها امتداد في الفكر السياسي المتعلق بالمؤسسات... وحسب كاتب "الأخلاق والفوضى"، فإن مهمة السياسة ليست إعطاء الأولوية لمنح نماذج للمشاركة بالنسبة "للقوة الجماعية"، بل تشييد أشكال للسلطة تضمن "أوضاعا" لأعضاء الجماعة؛ إذ بواسطة "ثبات" l’inertie المؤسسة وليس بتحريك الثروات والشرف، تستطيع السلطة أن تبني "الزمن السياسي" الذي تحتاجه الجماعة من أجل استمرارها وسط زوابع الأحداث؛ بدون "عناية إلهية"، أو طبيعية، أو تاريخية تتجه السياسة إلى بلورة فكر قانوني قادر على "إنتاج الزمن" بفعل قوة المؤسسة... هنا نجد أنفسنا، مرة أخرى، مع "الثبات" المتبصر lucide للمؤسسة الذي يسبق اضطرابات "القوى الفوضوية" ويضمن نجاعة فعل إنساني دائم... من أجل ذلك يعيد بيير كاي قراءة Maurice Hauriou أحد أهم فقهاء القانون الدستوري خلال الجمهورية الفرنسية الثالثة، متوصلا إلى أن البناء التدريجي للدولة بدءًا بتدعيم القوانين هو الكفيل بمنح الاستقرار للجماعات البشرية، وذلك بتجنب "الجمود" التقليداني، وعشوائية اتخاذ القرارات، ومرافعات التغيير الساذجة..
إن الاستمرارية الإنسانية في الزمن وبناء القوة، لا تتخذ حسب بيير كاي شكلا عنيفا أو "غازيا"، بل تتمظهر على شكل "السفينة الرومانية" l’arche romaine؛ بمعنى التأسيس الخالص للقوى المحيَّدة neutralisées بما يتيح فتح عهد محمي يطلق الفعالية الإنسانية من عقالها، وإن الاختراعية التقنية لقرننا (القرن 20) لا تعوض التدمير المتزامن لآلاف الأنواع الطبيعية، كما أن عالم الاتصال والعولمة لن يعوض، أبدا، مئات اللغات واللهجات والثقافات التي تنطفئ جذوتها أمام أنظارنا...
أما بالنسبة للسؤال السياسي في بعده الميثافيزيقي، فيتعين على sôtéria الأفلاطونية العتيقة، حسب بيير كاي، أن تحفظ وتصون الكائن، لكن بشكل غير مسبوق؛ لأن الإنقاذ هنا والحفظ يتجليان في منع التحول من إبستيمولوجيا "الفوضى" إلى دمار العالم، وذلك بإحالة "العماء" إلى براءته الأصلية، بالمعنى الإتيمولوجي للكلمة الذي يعني in-nocere؛ أي غير المؤذي.. لكن يوجد مسلكان للإجابة على هذا السؤال؛ أي مسلكان لموازنة اضطرابات الأنساق المعقدة المهددة: مسلك السرعة، ومسلك "البقاء/المقاومة" la tenue، وذلك إما بتسريع المبادلات وتحرير التواصل (وهذا ما تطمح إليه العولمة)، أو بإعادة دمج السياسة بالأخلاق..
كلما زادت سرعة التواصل داخل نسق ما، كلما تراجعت اضطراباته واكتسب توازنه، ذلك أن سرعة التواصل تؤدي إلى تنويع وتكثيف العلائق داخل النسق وذلك بإحالة الاضطرابات إلى مستوياتها الدنيا، مما يسهل التنظيم الذاتي للنسق؛ وعليه "تصبح سرعة التواصل محددة للتعقيد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه نظامُ نسقِ ما دون أن يصبح كثير الاضطراب"[50]؛ السرعة تصقل النسق بجعله ممتدا، وهي تحول إلى "فائض" ما كان في البداية يرمز إلى "الصلابة"، أو إن شئت قلت الهشاشة البنيوية... تحت تأثير السرعة تتحول الأنساق إلى "ينبوع" للجوهر Immanence؛ وأكثر من هذا، فإن السرعة سباق ضد التفريغ الذاتي والاستلاب الذي تحدثه للإنسان: إنها تحاول أن تكون أكثر سرعة من مسلسلات إحلال الموضوعية، وبجعل النتائج غير المتوقعة للتعقيد complexité ظرفية قبل أن تصبح متحققة.
في إطار "الفوضى"، تبدو السرعة كشرط لإعادة استبطان الفعل الإنساني وإعادة نسبته إلى الذات عبر ديناميكية تغيير العلائق الاجتماعيةpraxis وتلك المرتبطة بالأشياء التي ينتجها...[51]. إن "الفوضى" أو"العَمَاء" هو مرحلة تحول النسق من مرحلة القوة اللانهائية لديناميكيته إلى "نهائية" وضعه الحالي، وهو نتيجة الاضطرابات التي تنتجها ديناميكية لا نهائية..
إذا كان المرور من المتناهي إلى اللامتناهي يدعو الإنسان إلى ميثافيزيقا المشاركة (مشاركة الإنسان في حركة العالم(، فإن المرور من اللانهائي إلى النهائي، والمرور من الكون اللانهائي إلى العالم المغلق clos الذي يقع في عمق السؤال البيئي، ويكتسب هو الآخر علاقة أخرى بالعالم تحت مظهر "الانسحاب"، وأخلاقية أخرى تحت مظهر" البقاء" tenue والانكماش retenue. ولكي يبقى "الكاووس" ضمن نسق معقد ما، داخل حدود معلومة لابد أن يفرض عليه شرط عام وبسيط[52]، بيد أنه، ولغياب بنية صامتة latente، وغياب "ثابت"، أو "تحديدية" مخبأة، فإن تحولية "الكاووس" ترتبط أساسا بالإنسان مادام هذا الأخير يحافظ على نفسه داخل النسق ويعطي الدليل على استمراره بداخله..
ألسنا هنا أمام جدلية "غيبية" بين المبدأ والإنسان والكون، مادام الإنسان، وهو هنا لابد أن يكون مطلقا كما يقول أبو القاسم حاج حمد في "جدلية الغيب والإنسان والطبيعة[53]" مرتبطا جدليا بتحولية "الكاووس" كتصور للكون، وهو مسئول حسب بيير كاي بحفاظه على نفسه بداخله.. وإذا لم يكن هناك من حل لجعل "العماء" يستقر غير الحل السياسي، فإن على "السياسي"أن يستبق présuppose الأخلاقية، وأن هذه الأخيرة تستدعي كفعل رجعي ميثافيزيقا، بيد أنه لا واحدة من الأخلاقيات الموجِّهة normatives التي نتوفر عليها اليوم تعتبر في مستوى هذه الرهانات؛ لابد من إعادة تأسيس للأخلاقية، وإن إعادة التأسيس هذه، تستدعي ميثافيزيقا جديدة[54] وإن كتاب "الأخلاق والفوضى" ينخرط في مشروع إعادة التأسيس هذا ويجيب على هذه الإشكالية بطريقته.. لا التسيير dirigisme الاشتراكي، ولا الليبرالية، لا النظام المخطط له taxis، لا الكوسموس (النظام العضوي والتلقائي)، ولاthésis (النظام الإيجابي بله حكم الرئيس الذي ينظم taxis) ولا النوموس nomos (القانون الشرعي بله العرفي الذي يحكم بموجبه القاضي/الحكم الذي يتابع ويرافق سير الكوسموس).. إذا أردنا أن نستعيد الثنائيات المتقابلة التي يقترحها علينا، لنفكر فيها، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد Friedrich Hayek[55] يمكنها أن تضاهي المجتمعات المعقدة و"الفوضى" التي تحكمها..[56].
إن العالم أشد تعقيدا، وأيضا أكثر "فوضوية" لكي يلعب بالنسبة إلينا دور البديهيات normes؛ لا يمكننا في مواجهة التعقيد، ادعاء بناء وتخطيط المجتمعات على طريقة المهندسين..في مواجهة "الكاووس" لم يعد الوعد الليبرالي "بالوفرة المثالية" optimum والتوازن ينطوي على أي معنى، على اعتبار أن يد السوق الخفية تفقد كل بعد مبشر بالرعاية providentielle. إن "العلبة السوداء" عمياء بشكل نهائي، وباختصار، فإن السياسة توجد في "لا مكان" نظري، على الرغم من وجود معظم الممارسات السياسية المعاصرة بهذا "اللامكان"؛ فبدل تثبيت "الكاووس" تزداد حدته بإضافة ما يسمى "الحَكامة" gouvernance. لا يتعلق الأمر بدمج هذين "النظريتين"، بل إبعادهما عن بعض؛ لأن كلا منهما تظل مرتبطة بالأرضية المجتمعية وباقتصاد المجتمع، ومرهونة داخل حقلها الجوهري، لذلك تساهم في "الفوضى" عوض ادعاء حمايتنا منها. من أجل تثبيت "الكاووس" يبدو ضروريا على السياسة أن تعيد تأسيس "الفارق" بين فعلها وبين الحقل الاقتصادي والاجتماعي الحاضن لتأثيرها. لا يمكن "لما بين الاثنين" أن يساهم في توازن المجتمعات المعقدة إلا إذا لعب دور "مكان الفارق"lieu de différence الذي ما فتأت الفلسفة تنادي به كمقصد أساسي لها، لكنها لا تستطيع اليوم مأسسته...
إن سلطة القوة، مهما كانت، تعبر عمّا يسميه تقليدنا السياسي المعاصر السيادة souveraineté.. بيد أن هذا المفهوم يبدو اليوم متجاوزا، فالعولمة والحكامة والبناء الأوروبي تشكك فيها حتى النخاع.. إن أنواع السيادة التاريخية القديمة التي بنت عليها الدول الكبرى سيادتها وثقافتها السياسية، تتلاشى اليوم دون أن تظهر في الأفق سيادة فوق-الدولة لتلعب دور البديل؛ والملاحظ أن الغياب الجذري للسيادة يساهم في تدعيم إحساسنا بالعجز إزاء مصيرنا.
في هذه الظروف، تبدو ثلاث مواقف ممكنة: موقف تفاعلي خالص، يدعو إلى العودة إلى أشكال السيادة الوطنية القديمة، وموقف إرادويvolontariste وإمبراطوري بالمفهوم التقليدي للكلمة، يدعو إلى تأسيس حكومة عالمية، وأخيرا موقف أكثر إبداعية، وأكثر واقعية وبراغماتية أيضا، مفاده التفكير في الظروف الخاصة بصناعة السلطة وممارستها داخل الأزمة الملازمة للسيادة.. إنها طريق ثالثة لابد أن تأخذها الطريقان الأولان بعين الاعتبار..
فبمعنى من المعاني، يؤدي غياب السيادة الوطنية إلى العودة إلى بعض المبادئ الرئيسة للسياسة التي عطلتها الأبعاد الميثافيزيقية والروحية؛ بالإمكان إعطاء تعريف للسياسة يمكن لدعاة السيادة، والفيدراليين، والبراغماتيين والمثاليين، وحاملي المبادئ ورجال المسئولية، والفلاسفة و الإداريين والساسة، أن يجدوا أنفسهم فيها... إن هذا التعريف هو "مادون السيادة"، وإذا كان هذا المفهوم السياسي قد ساهم تاريخيا في بناء السلطات الوطنية الكبرى التي فككت وركبت النسيج الأوروبي، فإنه ليس مرتبطا بها بالضرورة.. ذلك أن هذه السياسة تشكل نواة أي سلطة، سيادية كانت أم غير ذلك... إن هذه النواة هي المؤسسة أو بالتدقيق "المأسسة" institutionnalisation؛ بمعنى فن إنتاج السلطة عبر صناعة المؤسسات... وصناعة المؤسسات هنا ليس حبا فيها لذاتها، بل من أجل تحويل الثروات المادية والاقتصادية للبشر إلى تراث رمزي وقانوني... وهنا بالذات يتحدد عمل الاختلاف..[57] وحتى إذا ما تلاشت السيادة فإن الاختلاف يبقى، مما يتيح إمكانية ظهور نوع جديد من السيادة، بيد أنه، ولأول مرة في تاريخ العالم، يبدو المسلسل المؤسساتي الذي بموجبه تتطور وتستثمر أعمال الإنسان مهددا في وجوده؛ لأن أزمة السيادة الوطنية ترافقها أزمة مؤسسية، ومن أجل ذلك أيضا لازال البعض يشعر بالحنين إزاء البنيات السياسية العتيقة؛ وإذا كان صحيحا أن الأزمتين ارتبطتا تاريخيا، فإنهما ليستا كذلك على المستوى القانوني والنظري.. إذ لابد من كسب رهان إنجاح عمليات الفصل بين الأزمتين لدعم مسلسلات "المأسسة" institutionnalisation في عملية البناء السياسي لما بعد السيادة[58].
لقد نسبت سيادة التقنية والحركية الإنسانية التي أفرزتها، لوقت طويل، لانتشار العقلانية، والحساب والتدرجية كما تبرزها التايلورية taylorisme أو الفوردية fordismeلكن، على مدى أقل من قرن اخترقت الثقافات الجديدة للفوضى النسق الإنتاجي والتقني.. وتسلل الغبش واللايقين، ليس من أجل التخفيف من قبضتها، بل من أجل جعلها أكثر عمومية وأكثر مخاتلة، وذلك بتحريرها من كل القيود العقلانية...
لقد ترتب على هذا؛ أن التواصلية لم توضع من أجل التواصل بين بني البشر، بل في خدمة حركية شاملة للمجتمع هي مقصد النظام الإنتاجي ومنطقه الاستهلاكي.. يشهد على ذلك أيضا تطور النظرية الاقتصادية: من النظرية الكلاسيكية التي تعتبر الاقتصاد لصيقا بالعقلانية والحساب الدقيق المتعلق بالذمة المالية إلى نظرية التبادل المعمم catallactique التي تعتبر أن ليس هناك أي فعل عقلاني بالمفهوم الاقتصادي للكلمة، بحيث أن كل الأفعال المرتبطة بالذمة المالية أو غير ذلك لها نتائج و تأثيرات اقتصادية.. إننا هنا إزاء تعريف جديد للاقتصاد، تعريف مرن وانتشاري يتأقلم بامتياز مع "نظرية الفوضى" مع تبرير "التسليع" marchandisation الشامل للمجتمع..
كلما ازدادت درجة تعقيد نسق من الأنساق كلما تطور "فوضويا"، وكلما كانت تقلباته خطيرة، عندما نتجاوز بعض الحدود، يمكن لأي نسق أن ينزلق فجأة إلى اتجاه آخر، مثلما الشأن في تحولات "مرحلة المادة"، وذلك بأن ينهار بشكل كلي أو بتكوين أنواع أخرى من الأنساق تتميز بخصائص غير ملائمة تماما للإنسان.. ويستدل pierre Caye بالفيزيائي David Ruelle مكتشف "الجاذبات الغريبة" étrangers attracteurs الذي يلاحظ أنه "كما ينبئنا "العَمَاء" في مجال الفيزياء، فإنه في الاقتصاد يتعين على السياسات أن تواجه إمكانية أن تتحول القرارات المنتظر أن تحدث توازنا إلى إنتاج تقلبات عنيفة وغير منتظرة وذات نتائج وخيمة[59]."
إمبراطورية الذات" Empire du Soi أو الهينولوجيا بدل الأنطولوجيا
إن ما يبرز في نظر بيير كاي نوعا من "إمبراطورية الذات" Empire du Soi، وهو ما يعرفه الكاتب ليس كتسوية أو تدجين لقوة متوحشة وتلقائية؛ (لأنه لا يكفي الحد من القوة لتجاوز المفارقة)، بل كشجاعة وكرامة من يبقى مرفوع الرأس في غياب لأية قوة، في مواجهة "العماء"؛ وعليه، فإنه انطلاقا من هذه الشجاعة والكرامة، وبفعل عامل الزمن فإن شيئا ما يصبح ممكنا؟ يتعلق الأمر بقوة تنبثق من "لا قوة"، وتمتاز بكونها غير محتواة في النسق ولا في " القوة الخارقة" لمصيره الفوضوي... قوة هي بمعنى من المعاني "ضد أطروحة" antithèse العجز الذي تنتجه قوتنا؛ لأنه يتعلق،على العكس، بقوة منبعثة من عجزنا نفسه، مما يؤدي، عبر هذا المسار، إلى تجاوز مفارقة القوة. يحاول بيير كاي أن يبرهن في كتابه كيف يمكن بناء هذه القوة من داخل العجز، وكيف يتم تبنيها، ويسعى أيضا إلى إبراز كيف تنفلت هذه القوة من "مفارقة القوة" التي يفرضها "عماء" الوقت على الفعل الإنساني، وكيف أنها تساهم، تبعا لذلك، في استقرار "العماء"...
بدوره، ومن أجل أن يستوعب ويعاش، لابد لهذا المبدأ الأخلاقي أن يمتد إلى أفقه الميثافيزيقي: لم تعد الأنطولوجيا مقبولة؛ لأنها خاضعة بشدة "للكاووس"، بل المطلوب الهينولوجياl’hénologie؛ أي ميثافيزيقا الواحد l’Un[60] دون أن يستطيع بيير كاي التعبير بدقة عما يقصده بالواحد، لكن إعادة قراءته للأفلاطونية الجديدة، مع أفلوطين ونظريته حول الفيض أو الصدور، وخصوصا مع الأفلاطونيين الجدد المتأخرين Parménide وDamascius، تجعلنا نفهم أن "الواحد" حسب بيير كاي هو مفهوم كوني متعال مجرد، لكنه متفاعل جدليا مع الكينونة المادية ومع "النظام" الذي يسود الحركة الزمنية على الرغم من الحصيلة "الفوضوية" التي تعبر عبر تعقد النسق الكوني عن حركة الوجود...
يرى بيير كاي أن "الواحد" l’Un يثير أسئلة وإشكاليات مختلفة عن تلك التي يثيرها الكائن l’être. الكائن يحدد مفهوم الوجود ويتولد من سؤال: " لماذا يوجد الكائن l’étant بدل لاشيء"؟ بينما الواحدl’Un يحدد مفهوم الانسجام "cohérence " ويتولد من سؤال: "لماذا تقاوم أشياء العالم وتستمر؟" من هذا المنطلق تعتبر الهينولوجيا ميثافيزيقا عصرنا، وهي مطلوبة بشكل استعجالي بالنسبة "للكائن" في مواجهة "الكاووس"..
إن هذان السؤالان مختلفان بعمق على الرغم من أن معظم التقاليد الميثافيزيقية تتجه إلى الخلط بينهما، وذلك باعتبارها أن "الكائن" يقاوم ويبقى بفضل "انسجامه" الجبلِّي والتلقائي، وأيضا لأنه لا توجد وحدة أخرى غير وحدة الكائن تحت غطاء الوحدة الشمولية l’uni-totalité، وبصيغة أخرى ببسط "تحولية المتعالين" convertibilité des transcendants.. بيد أن طرح قضية قابلية الكائن أو "الواحد" للتحولية هي في نفس الوقت بمثابة غلق مبكر للسؤال الميثافيزيقي، سؤال الكائن وسؤال "الواحد" بواسطة تحليل دائري raisonnement circulaire: يوجد لأنه منسجم، وهو منسجم؛ لأنه موجود.. نلاحظ هنا رغبة ملحة عند بيير كاي لإنزال سؤال الوجود الإنساني من عليائه الميثافيزيقي إلى مستوياته "المنطقية" التي تفهم عبر ديناميكية الأنساق في الحركة الكونية.. فمن المبدأ الأول عند أفلوطين وفيض الموجودات عنه، و"دوار" خلق العالم بتعبير الكاتب نفسه، والصانع الأول عند أرسطو، وجدلية الغيب والإنسان والطبيعة عند أبو القاسم حاج حمد، والإنسان الذي خرج من رحم الطبيعة بالخلق عند بن عربي الحاتمي، نجد أنفسنا مع بيير كاي إزاء تحولية بين "الكائن"/الإنسان، و"الواحد"/المبدأ بما يفضي إلى الوجود ضمن الانسجام في سديم "الفوضى الكونية"... يقول بيير كاي: لا يعرف انفصال "الواحد" عن "الكائن" كسبب وأصل للعالم، بل كشرط لاستمراره عبر تجربة بقائنا notre tenue.. سيفقد "الواحد" لا محالة بعده الكوسمولوجي المتجلي في وحدته الشمولية uni-totalité، لكنه يكتسب بدل ذلك بعدا أخلاقيا يمكننا من تفهم "البقاء" و"الانسجام"..
إن "الكاووس" يفصل بالضرورة بين "الكائن" و"الواحد"، ذلك أنه في شكله "الفوضوي" يظهر "الكائن" ضمن تنوعه الخالص دون أن يطالب بمبادئ أخرى للوجود سوى ديناميكيته التي لا يلعب فيها مفهوم "الانسجام" إلا دورا ثانويا، لكن إذا ما تحرر الكائن من "الواحد" لابد من التفكير، من أجل الارتقاء إلى ما سماه Pierre Magnard "الانفصال[61] la disjonction"، في ضرورة استقلال "الواحد" بدوره عن "الكائن".
لقد قطعنا نصف الطريق، يقول كاي، لقد مررنا من l’Ontopraxie إلى فلسفة "نزع التسلح"، وانطلقنا من هذه الفلسفة إلى براغماتية قانونية، والآن علينا أن نغير الاتجاه إلى "الأقصى" بعودتنا إلى الميثافيزيقا، ضمن السباق الذي يدعونا نيتشه إلى الانخراط فيه، وهنا يغلق كاي نسق تفكيره بالعودة إلى نيتشه...[62].
إن العودة إلى الميثافيزيقا، حسب كاي، لا تعني استعادتها كما هي بل المضي قدما من أجل تجاوزها surmontement، لكن تجاوز الميثافيزيقا لا يمكن تحقيقه عبر البراغماتية؛ لأن المقاربة البراغماتية للفعل l’agir ليست إلا مرحلة انتقالية ضمن الأوديسا الميثافيزيقية، وهي بمثابة الحد الأقصى الذي نتحول في اتجاهه، والذي نتركه خلف ظهورنا من أجل الوصول إلى آخر السباق.. لا يمكن تصور براغماتية حقيقية؛ بمعنى المجاورة الجيدة للأشياء الأكثر قربا منا، إلا انطلاقا من "نزع سلاح" الميثافيزيقا والذي بدونه تنحو كل الأقوال والحركات، حتى المألوفة منها، إلى تسهيل عودة مظاهر الميثافيزيقا الأكثر قتامة والأكثر هيمنة، لكن بشكل "غير معلن"؛ ألسنا هنا إزاء هاجس الاستلاب، إزاء ارتياب المؤلف من "هيمنة" الغيب على الإنسان من أجل استلابه؟ وهو نفسه ما عبر عنه لوك فيري في كتابه حول الفلسفة الكانطية[63]، لكن يبدو أن منطلقات الكاتبين مختلفة، ذلك أن لوك فيري يستند إلى قراءته لفلسفة الأخلاق الكانطية ليقطع مع "الأخلاقية الكوسمولوجية" القديمة، ومع الأخلاقية الثيولوجية، بينما كاي، وعلى الرغم من إدراكه "خطورة" الميثافيزيقا، إلا أنه يقترح علينا ميثافيزيقا "إمبراطورية الذات" أو الهينولوجيا، ضمن سلطة الواحد مستعيدا التاريخ الميثافيزيقي خصوصا الأفلاطونية الجديدة بإعطائها نفسا جديدا..
لا يمكننا، يقول كاي، الخروج النهائي من الميثافيزيقا، وإن العلوم الإنسانية التي تَدَّعي إثبات فوات "زمن الميثافيزيقا" وظرفية الخطاب الميثافيزيقي، وتعمل جاهدة لتعويضها، لم تعمل في حقيقة الأمر إلا على حضورها بأشكالها الأكثر كثافة؛ يتعلق الأمر بالتفكير ليس في عودة الميثافيزيقا إلى الإنسان، بل في عودة الإنسان إلى الميثافيزيقا.. والمساران غير متماثلان: الطريق الأولى: "سيادة" règne، والثانية: "إمبراطورية" empire. من جهة نتحمل الأولى on la subit، والثانية نتبناها on l’assume. بيد أن الميثافيزيقا تهيمن علينا لسبب واحد هو أننا نحب سيادتها، لكن في ذاتها تعتبر الميثافيزيقا عميقة الحياد تجاه قوة خطابها، فهي لا تفضل "السيادة" على "الإمبراطورية"، يشهد على ذلك أن العلاقة التي تربطنا بها ذات اتجاهين... وإذا كان لزاما علينا "تبنيها" فذلك لأننا لا نستطيع تجاوزها ولا إعادتها recommencer؛ لأن إعادة بدئها ستفضي بنا لا محالة إلى إعادتها.. لكن يبدو بالنسبة إلينا ممكنا أن نفعل "بداخلها" عبر تغيير أمكنة ترساناتها و بجعل "شجرة نسبها" أكثر صفاء من أجل جعلها أقل تأثيرا وأكثر فاعلية...
لا يمكننا أن نتحرر من الميثافيزيقا إلا من داخلها؛ وإن الحرية إزاء الميثافيزيقا هي في عمقها حرية ميثافيزيقية، ولا يمكننا التحرر من هيمنة الميثافيزيقا إلا إذا مورست في أقرب ما يكون من قوتها... لذلك فإن السؤال الذي تتحدد عبره "إمبراطورية الذات": لماذا يوجد "الفعل" بدل "لاشيء"، يوجد هو أيضا في عمق الميثافيزيقا على الرغم من أنها تقودنا إلى طرق أخرى: طريق العودة والسلفية devancement.
إن الميثافيزيقا في نهاية المطاف، تضع "نظاما" بين الإنسان والعالم والمبدأ الذي يكون النواة الأصلية والبدائية لكل نسق... وعلى الحقيقة، فإن هذا "النظام" dispositif لم يكن حاضرا عند أرسطو، على الرغم من أن بعض شارحيه يعتقدون بإمكانية رصده في ثنايا كتابه[64]. لكن هذا "النظام" يتيح "التوسط" الضروري من أجل حل تناقضات apories نظرية" الحركة" الأرسطوطاليسية حول إعادة طرح سؤالها الأصلي عن جوهر القوة؛ مأخوذا هذا كله بعين الاعتبار، وعلى الرغم من أن النسق يظهر كميثافيزيقا ثانوية مكثف بناؤه فوق الأساس الأصلي لـStagirite[65] مستعملا أدوات بناء هذا الأخير، فإنه يستدل عليه أيضا بتجربة الفكر الأكثر بدائية والأكثر سذاجة: تجربة الإنسان، سواء أكانت طبيعة أو موضوعا أو وعيا، أو أيضا سواء كانت متحققة factuelle أو مبنية، مرهونة للعالم الخارجي أو مستقلة تجاهه..[66].
إن الميثافيزيقا تخلط بين بنية النسق ثلاثي الأبعاد (الإنسان والعالم والمبدأ) وطريقة اشتغاله، وتحيل العناصر الثلاثة إلى العلائق التي تربط فيما بينها... "النظام" يغلق مشكلا دائرة، ولهذه الأخيرة وضعا مميزا بالنسبة "للنظام"، ذلك أن دائرية النسق هي وضعية ما يتموضع على شكل "نظام"... وتظهر الدائرة بمثابة الشكل المتكامل "للنظام" الذي لا يقبل أي شكل آخر، وكتعبير عن اكتماله، بيد أن التموضع الدائري ليس ثابتا... الدائرة تدور معبرة عن "إعلان" الثلاثية عن جدليتها المنتجة للجهد والانكماش والتمدد والتركز و التقارب والتباعد، والذهاب والعودة، وكل من هذه العناصر التي تدور حولها الحركة تشكل قطبا، بذلك تنتج الدائرة حركة تحدد قوة النسق؛ بيد أن دائرية الحركة ليست بدون تأثير على جوهر القوة نفسه، وأن القوة الدائرية تظهر فاعليها بفعل تركزها الذاتي أكثر مما تفعله وتحركه. إن كل ما يتركز بمروره من درجة إلى أخرى، دون الكف عن الدوران حول نفسه، ينتج عنه حركة حلزونية، تركز حركية النسق دون إحداث أي انتقال. ألسنا هنا مرة أخرى، في قلب جدلية "الغيب والإنسان والطبيعة" التي حلل بعض أبعادها أبو القاسم حاج حمد؟
داخل الحركة الدائرية تتحول "الثلاثية" إلى "ثنائية"؛ لأن عناصرها تنتظم ضمن "لعبة موازنة" ممثلة في الانكماش والإبراز والتركز والتمدد والقوة والشكل.. إن الثنائية تصبح هنا جوهرا لتعبيرات قضية النسق وإدخال العبارات ضمن حركته، لكن هذه الثنائية لا تشكل نهاية المطاف، ذلك أنه مع تركز "القضية" procès تنمحي الفوارق بين وقتَيْ نبضه القوي والضعيف، وبين دفعات وثبات حركته، وبين قوته وشكله؛ والنتيجة هي توحد الحركة على شكل " فيض" أوحد بحيث يصير الكل في الوقت نفسه قوة وشكلا ضمن "لعبة" لا نهائية تفضي إلى بعث le procès؛ بذلك تتحول الثنائية إلى وحدة تتحد ضمنها القوة مع الشكل بحيث يبلغ "المسلسل" تركزه المطلق، وهو ما يسميه Proclus، لكي يحدد قوة "الواحد" l’apeirodunamon "المتناهي في القوة"…
والجدير بالملاحظة أنه في النقطة نفسها التي تغلق فيها الدائرة تكمن إمكانية فتحها.. بالواحد l’Un تبنى الدائرة وبالواحد تمحى.. "الواحد" هو المفهوم الأكثر غموضا في الميثافيزيقا، ذلك أنه يكمل تركيز قوته في الوقت نفسه الذي يدخلنا في قوة تعتمل ضمن "نظامه"؛ الميثافيزيقا "تتخلى عن سلاحها" وتنقلب داخل "الواحد"، إنه من مسئوليتنا العودة إلى هذا المشترك الحاسم داخل "الواحد"، داخل هذين" الإمكانيتين" من أجل فهم أفضل للنقطة التي تتخلى فيها الميثافيزيقا عن سلاحها وتنقلب...
إن "الواحد" متعالي transcendantal مثله مثل الكائن l’être.. لا يوجد أي شيء من "الروحية" أو "المتعال" ضمن المفهوم السكولانيscolastique للمتعال؛ إن المتعاليات مفاهيم بسيطة وكونية تنبثق من التكوين الجوهري للأشياء ومن الشروط المبدئية principielles لحضورها في العالم وتجاه البشر، إنها تنطبق على كل الأشياء، كيفما كان نوعها، بل ومتأقلمة مع نوع الشيء وفق مبدأ تماثل التناسب analogie de proportionnalité[67]، والحقيقة أن مفهومي "الكائن" و"الواحد" يبدوان لدى البعض في الغالب مجردين أو عفا عنهما الزمن. ويبدو أنهما ينتميان إلى "لعبة" للفكر خادعة ومنكفئة على نفسها وعلى تعريفاتها الدوغمائية[68] وهو ما يسمى بالمدرسية أو السكولانية [69]scolastique.
بيد أن تناول مفهومي الكائن و"الواحد" خارج استعمالهما السكولاني والدوغمائي، يعبر عن تجربة فكرية واضحة المعالم، بسيطة وبديهية تتجه الفلسفات المعاصرة إلى تغافلها.. إن سؤال الكائن يولد من اندهاشنا تجاه وجود الأشياء بينما يولد سؤال "الواحد" من اندهاشنا من انسجام الأشياء cohérence سواء أكان انسجاما داخليا للأشياء أو انسجاما فيما بينها... الوجود ينتمي إلى "براءة الكائن" والانسجام ينتمي إلى "إمبراطورية الذات".
لا تتأسس الميثافيزيقا عبر"الكائن"، بل بالضبط عبر العلاقات الغامضة التي ينسجها "الكائن" مع "الواحد". إن هذا الغموض معبر عنه على شكل "موضوع" بفرضيتين متناقضتين في Parménide أفلاطون: "الواحد هو.." (الفرضية الثانية)، أو على العكس "الواحد ليس..." (الفرضية الأولى)؛ تعني الفرضية الثانية أن الانسجام ينبع من الوجود، بينما تعتبر الفرضية الأولى أن مسلسل الوجود غير كاف لتفسير انسجامه..[70].
إن الوحدة-الشمولية تحد من أي تناقض بين وجود العالم وانسجامه؛ ما هو كائن يحيل على "الكل" الذي هو في الوقت نفسه "واحد"، وإن الوحدة، الشمولية هي، بطبيعة الحال، شرط لكل نسق بما يحقق إمكانية المرور من "الثلاثية" إلى "الثنائية"، ومن "الثنائية" إلى "الواحد"... إن هذا الشرخ داخل الشرخ الموجود بين "الكائن" و"الواحد"، وذلك الموجود بين الوجود والانسجام هو السر الغامض الذي يفجر اقتصاد سلطة الميثافيزيقا كما يشهد على ذلك تاريخ الأفلاطونية الجديدة néoplatonisme.
يرى كاي أنه الفضل يعود إلى تقليد الأفلاطونية الجديدة، من أفلوطين Plotin إلى Damascius في موضعة الفرضية الأولى في قلب Parménide أفلاطون وفي إضفاء المعنى على معادلة: "الواحد ليس..." التي بقيت aporétique عند أفلاطون.. ما اعتبر عند أفلاطون مجرد لعبة جدلية بسيطة أصبح عند الأفلاطونيين الجدد موقفا مؤسسا لكل مبدئية Principialité[71].
إن المبدئية تحدد جوهر المبدأ؛ أي ما يجعل المبدأ مبدءاً، ذلك أن جوهر المبدأ لا يحيل على "حالة" خارج المبدأ تفضي إلى ما "فوق-المبدأ" الذي يؤدي لا محالة إلى عملية إتلاف لا نهائية للمبدأ، إنها قوة النسق وطريقة اعتماله هي ما يعبر عن جوهر المبدأ.. إن فلسفة أفلوطين فلسفة سعيدة، يقول كاي، إنها تتحرك ضمن عالم من الاكتمال plénitude تدغدغها بالكاد أفكار من الفراغ والسكون والموت.. وإذا ما بدا أن تهديدا من هذا النوع ظهر في إحدى فترات فكرها، فإنها تستجيب بسرعة بواسطة الفرق بين "الكائن" و"الواحد"، ذلك الذي يوجد بين الوجود والقوة دون أن يعني ذلك أخذ المسافة أو ترك الكوسموس من طرف المبدأ، بل على العكس من ذلك يعد نفسه فيه بالعيش والخصوبة؛ إن المبدأ هنا قوة بل، أكثر من ذلك، مصدرا للقوة، قوة لا نهائية تتجاوز الوفرة وتفيض بتمريرها لفيضها إلى الكائنات عبر واسطة الذكاء.. "الواحد فيض، وغليان مادي substantielle ضمن الأزل الثابت لوحدته، وتبعا لذلك قوة كل شيء (...) إنه فوق-ممتلئ، وفائضه لا يمكنه إلا أن ينساب دون الخروج عن نفسه. فائضا من الوفرة، يتمدد دون أن ينقطع أو ينقسم؛ لأنه "الواحد"..[72]"؛ بهذا التواصل تصبح المادة عالما؛ أي لا كينونة الكائن le non-être être. إن الهينولوجيا l’hénologie الأفلوطينية هي ثيولوجيا للعطاء والنصر، الواحد-المبدأ (المبدأ الأول) هو سيد الكورال[73]chœur.
يتردد بيير كاي في نقد "طريقة اشتغال" بهذا الاكتمال النسقي خوفا من أن يخيب آمال وعد رائع بالسعادة على حد قوله[74] ويتقوى تردده حينما يبرز أن أفلوطين هو مؤسس الهينولوجيا l’Hénologie، وأب الاختلاف، وإليه يرجع الفضل في إعادة قراءة Parménide أفلاطون انطلاقا من الفرضية الأولى، وقد أثرت إعادة القراءة هذه بشكل حاسم في قدر الميثافيزيقا الغربية، بيد أن المبدئية pricipialité الأفلوطينية تتأسس على تمييز مفتعل بين "الكائن" و"الواحد".
ويؤكد بيير كاي أن استحالة الحسم في جعل "الكائن" كحصيلة "للواحد" هو ما يشكل الاقتراح الجوهري للميثافيزيقا الأفلوطينية[75]، لكن لا يوجد هناك دليل قاطع على أن أفلوطين تبنى بشكل نهائي هذه الاستحالة، أو تنبأ بما تعنيه واقعيا بالنسبة لاشتغال النسق. إن الفرق بين "الكائن" و"الواحد" يتأسس عند أفلوطين بشكل كبير على خطأ. يبدو هنا أن كاي يعيد قراءة أفلوطين بشكل نقدي، لكنه في اقتراحه لميثافيزيقا جديدة يشكل استمرارا للنقاش الفلسفي الذي تبلور في إطار الأفلاطونية الجديدة..
ما يضمن انسجام الكائن، حسب كاي، ليس شيئا آخر غير المبدأ الداخلي للحركة المولدة له. ومن جديد، نجد المسافة بين مبدأ الانسجام ومبدأ الوجود تتقلص لصالح هذا الأخير.. وعلى مستوى الأنطولوجيا المطلقة ينتمي "الواحد" دائما إلى "نظام" الكائن ويتحقق التحول فيما بينهما.. وقد اكتفى أفلوطين باستخلاص زوج "الفعل/القوة" من نظام الجواهر ordre des essences، وبإحالته إلى المطلق تحت شكل "الواحد"؛ الواحد ليس "لا كائنا"، وليس غيرا جذريا للكائن، لكنه فوق-كائن يرتقي بخصائص الكائن إلى درجة أقصى من السمو، بيد أن كونه فوق الكائن لا يجعله يخرج من دائرة هذا الأخير، مفكرا فيه من أجل الموجود، ذلك أن "الكائن" يتحرر من الجواهر من أجل إعادة تشكله ضمن قوته..
في نهاية المطاف فإن "الكائن" يمكن استخلاصه من المبدأ لكن بدرجة أكبر من "المادة"؛ لأن المبدأ يفيض عن كل مادة... لكن هذا الفيض يعلن بطبيعة الحال انتصار"الكائن" وسيادته son règne بدل انكماشه واندثاره... لا يمكن والحالة هذه، إلا أن نقول مع كاي، الذي يرسم لنا هنا صورة فنية، عن انبثاق الإنسان من "الكاووس" إلى "الكوسموس" عبر جدلية فلسفية كونية بين الطبيعة و"الغيب" والإنسان.. وهو إذ يتحدث عن سيادة الإنسان، وصناعة القوة من الضعف، وترتيب العلاقة الكونية مع المبدأ، إنما ينطلق من هاجس نلخصه بالخوف من الاستلاب بنوعيه: استلاب لاهوتي، واستلاب وضعي؛ وهذا عين ما فككه وركبه أبو القاسم حاج حمد في "جدلية الغيب والإنسان والطبيعة" لكن منطلقا من المنهج المعرفي القرآني باعتباره معادلا لحركة الكون وصيرورته..
إن عدم إمكانية التشارك imparticipabilité المطلقة التي تميز المبدأ/الواحد تؤدي إلى ضدية جذرية: كيف يمكننا تحصيل الانسجام مع الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع الواحد إذا كان هذا الأخير لا يمكن مشاركته والتواصل معه؟ كيف يمكننا فقط الإحساس بضرورة الانسجام ضمن "وجود" لا يتوفر على أي مبدأ جامع؟ كيف يمكن، في نهاية المطاف، تجربة قوة ليس في غياب المبدأ الجامع فحسب، ولكن ضمن إطار عجزه الجذري؟ كتبDamascius : "إذا كان الواحد لا يعطي شيئا للأشياء التي أنتجها، كيف استطاع إنتاجها دون أن تكون لها علاقة به، دون أن تتمتع بشيء من طبيعته؟ كيف يمكن أن يكون بطبيعته هو مسببها إذا لم يكن يمدها بشيء من طبيعته؟ كيف تكون الرجعى إليه وكيف ترغب فيه إذا لم تشترك معه في شيء، إذا كان غير قابل للتشارك بحال[76]."
إن إمبراطورية الذات تتكون مع امتحان العدمية à l’épreuve du nihilisme التي تنشل عن عدم إمكانية التشارك، ذلك أن العدمية ليست هبوطا أو أفولا انطلاقا من اكتمال أو إتقان، وهي لا تنطوي على أي حكم قيمي، بل تكتفي بالتعبير عن حالة ميثافيزيقية للنسق لابد من تبنيها: عدم القابلية التشاركية..
من أجل تجاوز العدمية، لا ينبغي جعل "الواحد" قابلا للتشارك والتواصل، ولا ينبغي تحويله إلى "كائن" بهدف إعادة تشكيل الوحدة-الشمولية. أو إن شئت قلت الحلول والاتحاد.. الميثافيزيقا تأتي إلى الإنسان، وليس هو من يذهب إليها.. وإن الميثافيزيقا تسود règne على حساب إرادتنا وحريتنا.. يتعين على العكس من ذلك لإقرار بعدم إمكانية تشاركية "الواحد"، ونزع القدرة المثلى للكائن و"كاووس" الوجود من أجل استعادة التجربة الميثافيزيقية لبراءة "الكائن" وانسجام "الواحد" دونما ادعاء ولا دوغمائية...[77].
إن هذا العمل "التنزيهي" الذي يقوم به بيير كاي إزاء "الواحد" يخفي رغبة ملحة عند الكاتب في التخلص مما علق بالفكر الفلسفي الغربي من تأثيرات ميثافيزيقية ذات طابع ديني مسيحي بالخصوص، خصوصا فيما يتعلق بعلاقة الإله/الابن المخلص بالإله/الأب المتعالي، وهو ما نلحظه في ثنايا الكتاب من قبيل رفض كاي لمقولات: إله المؤمنين، ودوار خلق العالم، والوحدة الشمولية بين "الكائن" و"الواحد".. وهذه مسألة فكرية جديرة بالاهتمام.
من جهة أخرى، يرى كاي أن الأفلاطونية الجديدة تميز بين فترتين في الهينولوجيا المرتبطة بها: مرحلة العرض التي فيها ينبثق المبدأ وينشر تأثيراته، ومرحلة العودة التي يرجع فيها الإنسان إلى المبدأ عبر تأثيرات العرض بشكل جدلي. في هذه النظرية، تعتبر المرحلتان شديدتا الارتباط، بفعل وجود علاقة وطيدة بين الظهور من "الواحد" والعودة إليه. ألم يقل الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي خرج الإنسان من رحم الطبيعة بالخلق، وسيعود إليها بالوعي، وهو النص الذي حلل أبعاده و تبناه أبو القاسم حاج حمد في جدلية الغيب والإنسان والطبيعة.. وبحمولة فكرية مستقاة من نظرية الفيض الأفلوطينية يقول بيير كاي أنه: "على حافة المادة وفي فيضها الأكثر ثقلا، وفي نقطة سكونها الأكثر كثافة، في الوقت الذي نحس فيه بالاختفاء والذوبان في قتامته الكثيفة تظهر فجأة قوة لا يمكن مقاومتها تشدنا وتحافظ على توازننا. إن بساطة الواحد توازن بساطة المادة.. وإن تجربة "الواحد" ليست شيئا آخر غير الإحساس بثقل يوازن الجاذبية التي تمارسها علينا المادة منزوعة "القوة المثلى" dépotentialisée بواسطة فيض سكونها. وإن فيض العالم يضمن في الجهة الأخرى للميزان، مبدأ انسجامه... من هذا التوازن يتحدد الانسجام الأقصى المتعلق بالفعل geste والعالم، وبفعل ثقله الموازن يتشكل اللامتحكم فيه "واحدا"...[78].
ومن أجل تجاوز اختبار "الواحد" لا ينبغي الانسلاخ عن العالم إلى درجة الوصول إلى فراغ كل واقع، و من أجل الوصول إلى "الواحد"، لا ينبغي أن يكون الإنسان مفرغا، بل صلبا بفعل الاحتكاك الدائم بالعالم بفعل الحرمان من "الواحد"؛ كلما كنا أكثر كثافة كلما كان الثقل الموازن أقوى.. عندما يبقى الإنسان بلا ثقل، لا شيء يمكن أن يحقق له التوازن، ولا أن يمنع عنه الغوص في كاووس "الكائن" le chaos de l’être. إذا كان "الواحد" ليس شيئا آخر غير الحالة التي نحس فيها بالثقل الموازن للامتحكم فيه كشرط لانسجامنا، فإنه يعبر في نهاية المطاف عن إمبراطورية ذاتنا.. وإن إمبراطورية الذات هي تجربة "الواحد" ضمن عدم قابليته للتشارك؛ "الواحد" يستند، إذن، إلى النقطة الصفر للتوازن بين الكتل، وهو في الوقت نفسه باعتباره مبدءا لانسجام النسق، وأيضا "صفر" على اعتبار أن هذا المبدأ لا يمثل شيئا ضمن نظام وجوده. لكن هذا "اللاشيء" كما يلاحظ كانط، ينبغي أن يفهم بمعنى آخر غير التناقض المنطقي؛ لأن هذا "اللاشيء" هو شيء ما[79]"؛ بمعنى النتاج الحقيقي لقوتين أو أكثر تتضاد فيما بينها محققة التوازن...
ومع مفاهيم "القوى السلبية" والتضاد الواقعي opposition réelle التي بلورها كانط، يتبين كما يوضح ذلك الفيلسوف الرياضي Gilles Châtelet أن"النقطة اللانهائية للعصر الكلاسيكي تترك مكانها للنقاط المحايدة التي تميز درجات التوازن، والتي تنبع منها التقاطبات polarités بشكل مستمر[80]." يعلق بيير كاي على هذا النص بقوله: "في جملة واحدة ذات كثافة قوية، استجمعت ثلاثة مفاهيم حاسمة: الحياد والتوازن والحركة، ذلك أنه بتضافر هذه المفاهيم الثلاثة يتحدد في نهاية المطاف تشكيل فعاليتنا efficience[81].
خلاصة القول، يؤكد بيير كاي، أن المصدر الرئيس لاستلاب الإنسان، خلال العصر الميثافيزيقي ليس خارجيا، بل يكمن إلى التجاء الإنسان إلى ما "فوق قوة" المبدأ.. داعيا إلى استدعاء أخلاقية للتحديد، تترك مسافة بينها وبين برامج فيض وتكثف الفعل؛ هذا يجعله يستعيد تلقائيا الأخلاقية الرواقية stoïcienne.
لكن هنا أيضا يميز بيير كاي بين ضربين من الرواقية: رواقية ضبط الأنا maîtrise du soi، ورواقية إمبراطورية الأنا، وإن إشكالية الضبط تعترض الإنسان القوي الذي يتعامل مع قوة طبيعية ذات طبيعة إلهية يفترض فيه احتضانها واحتواؤها.. في اتجاه آخر، تحيل "إمبراطورية الأنا" بشكل واضح للرواقية الرومانية الإمبراطورية، وتواجه مشكلا معاكسا وهو كيف نبني قوة شخصية انطلاقا من عجز جذري؛ ذلك أن الإمبراطورية تنطلق من العجز إلى القوة، وإن الاستمرار ككائن والإبقاء على ماهيته والحفاظ على " كفّتِه" بحيث لا تستطيع أي قوة "إلهية" أو طبيعية أن تنسب إليه، هنا تكمن الإشكالية الأخلاقية...
إن "إمبراطورية الأنا" ليست ممارسة واستثمارا منظما لقوة مستوحاة، بل تكوينا لقوة على قاعدة غياب الأسس fondements. وإن الشرط الميثافيزيقي "لإمبراطورية الذات" هي تحييد neutralisation "لقوة المبدأ"، بينما يكمن حل إشكالها في إرساء قواعد توصل إلى "تقنية" و"سياسة"، وهنا نسائل الكاتب حول "النموذج الروماني" ونقول: ألم تتزامن ممارسة القانون الروماني بحروب أهلية وبمشاريع غزو؟ ووفق أي شروط تستطيع المؤسسة تحويل العنف إلى قانون؟ وباعتبارها "أرستقراطية وديمقراطية" في الآن نفسه، فإن أطروحة "الأخلاق والفوضى" عند بيير كاي تشبه إلى حد ما "فلسفة القانون" عند هيغل، التي نجحت في ربط أبسط عنصر في المجتمع المدني "بسيادة الملك" عبر وساطة الدولة، يتعلق الأمر هنا بتشابه فقط؛ لأن الأرستقراطية والديمقراطية تأخذ في كتاب "الأخلاق والفوضى" لبيير كاي معنى آخر، أكثر تراجيدية مما عند هيغل، وتنسج فيما بينها، تبعا لذلك، جدلية مختلفة بين هذين القطبين المتناقضين للإحساس الأخلاقي والسياسي..
إن طرح "الأخلاق والفوضى" أرستقراطي بشكل راديكالي، وهو كذلك بشكل مؤكد بفعل الزهد والصبر داخل الزمن الذي يشترطه، وبحس التواصل الذي يغذيه، لكنه ليس أقل ديمقراطية، بل بروليتارية، بفعل تجربة "الفقر" و"الضعف" الذي يفرزه.. إنها، إذن، الأخلاقية غير"المعاصرة" التي يطالب بها عصرنا المتميز بإفقار الإنسان وابتعاده عن فكر المؤسسة..
وفي ختام قراءة هذا الكتاب الثري، يمكن أن نسائل الكاتب حول كيف يستطيع تجاوز العدمية Nihilisme ضمن سياق إضعاف المبدأ dépotentialisation du Principe، ونسائله أيضا حول قراءته لكل من نيتشه وهايدجر: بحيث كيف استطاع قراءة إشكالية تشكل القوة، التي هي أكثر تحررا من القوة الميثافيزيقية من تأملات الكائن" Méditation de l’Etre، عند منظر "إرادة القوة"؟ نسائله أيضا حول "الوضع "العاطفي" للأخلاقية التي يقترحها والتي يبدو أنها تتبلور دون تشكل نظري للعلاقة مع الآخر، وبدون إبراز حجم العلاقات "العاطفية" البشرية، وأسئلة أخرى تجعلنا ندرك ثراء هذا الحقل المعرفي، ومقاصده الأخلاقية والإنسانية ضمن إعادة طرح السؤال الميثافيزيقي كسؤال مركزي في تجربة الوجود...
الهوامش
1. Pierre Caye. Morale et Chaos. Principes d’Agir sans fondements, La nuit surveillée. Editions le Cerf, 2008, p. 338.
2. ماكبث، رواية شهيرة لشكسبير تدور أحداثها في اسكتلندا، كتبت سنة 1606، وطبعت لأول مرة على سنة 1623.
3. Morale et chaos, Principes d’agir sans fondements, La nuit surveillée, Les éditions du Cerf. Introduction, 2008.
4. Gilles Deleuze et Félix Guattari. Qu’est-ce que la Philosophie. Les éditions de Minuit. 1991.
5. Etienne Ghys, La théorie du Chaos, Institut de France, Académie des sciences. et Jérôme Buzzi, Chaos et stabilité, Le pommier 2005.
6. James Gleick, La Théorie du chaos, Champs Flammarion, Paris 2008.
7. إدريس كثير، العمى والعماء، العلم الثقافي، عدد 3 دجنبر 2010.
8. مصطلح أنتروبيا entropie مصطلح أساسي في الفيزياء ضمن التحريك الحراري في الغازات أو السوائل، وخاصة بالنسبة للقانون الثاني للديناميكا الحرارية، الذي يتعامل مع العمليات الفيزيائية لأنظمة التجمعات الكبيرة للجزيئات ويبحث في شروط مسيرها كعملية تلقائية أم لا.
9. Pierre Caye, Morale et chaos, Principes d’Agir sans fondement, Op. cit.
10. Edgar Morin, la pensée complexe.
11. محمد أبو القاسم حاج حمد، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة: العالمية الإسلامية الثانية. دار الهادي. 2004.
12. Jean-Marie Schaeffer, La fin de l’exception humaine. Gallimard 2007.
13. Claude Allègre, La défaite de Platon ou la science du XXème siècle. Fayard, 1995. p333-364.
14. Prigogine et I. Stengers, La nouvelle alliance, Paris. Gallimard, 1979.
15. Ken Wilson, Les phénomènes physiques et les échelles de longueur. In Le Chaos. Bibliothèque pour la science.
16. Jamal Bammi, Contribution à une renaturalisation de l’Homme. Rencontre internationale de Carthage. Beit Al Hikma. Tunis, 2010, P. 281-297.
17. فريدريك نيتشه. هكذا تكلم زرادشت. ترجمة فيليكس فارس. مطبعة جريدة البصير، الإسكندرية، 1938.
18. العمى والعماء، م، س.
19. المرجع نفسه.
20. نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، م، س، ص317.
21. المرجع نفسه، ص41.
22. المرجع نفسه، ص99.
23. Pierre Caye, Morale et chaos, Op. cit.
24. العمى والعماء، م، س.
25. Gilles Deleuze et Félix Guattari. Qu’est ce que la Philosophie. Editions de Minuit, 1991.
26. السؤال هنا عن أي دين يتحدث جيل دولوز وفليكس غاتاري؟ هل الدين بإطلاق؟ وهذه نقطة تحتاج إلى بحث مستقل حول علاقة الديانات بـ"الكاووس"..
27. العمى والعماء، م، س.
28. Henri Maldiney Regard, parole, espace. Editions de Minuit. 1973.
29. Ibid.
30. Luc Ferry. Kant, une lecture des trois critiques. Le collège de philosophie. Grasset. 2008.
31. يورغن هابرماس. حوار مع مجلة Autrement عدد 102. 1988.
32. مفيد جدا في هذا السياق مراجعة ما مكتبه René Guenon في كتابه:le règne de la quantité et les signes des temps خصوصا الفصل المعنون: l’intuitionnisme contemporain.
33. Chrysalide حشرة من الفراش، أي من حرشفيات الأجنحة، وهنا إشارة من الكاتب للمثال الشهير حول إمكانية إحداث الفراشة بحركة أجنحتها لإعصار في مكان بعيد...
34. Principe de moindre action.
35. Pierre Caye, Morale et Chaos, Op. cit, p.26.
36. يورغن هابرماس، م، س.
37. المرجع نفسه.
38. المرجع نفسه.
39. ترجمت "Gestell" " هنا بالوحدة المجمعة لكيفيات الاستثارة"، علما بأن الاستثارة قائمة هنا في كل الأفعال المشار إليها، فالإنسان يستثير الطبيعة لكي تتحول إلى طاقة يستثيرها عند الطلب والاستعمال، كما أنه هو ذاته خاضع للاستثارة عند التعامل مع الكائن بهذه الكيفية؛ لأنه لم يقم هو ذاته بتحديد هذا الأسلوب في إظهار الكائن، بل بالعكس وضع هو ذاته فيه…
40. Morale et chaos, Op. cit, p. 142-143.
41. Étienne Klein. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Champs sciences. Flammarion, 2007.
42. يورغن هابرماس، Autrement، م، س.
43. المرجع نفسه.
44. يبدو هنا الاقتباس واضحا من الأفلاطونية الجديدة وبالخصوص من نظرية الفيض أو الصدور الأفلوطينية.
45. من الاسم Démiurge الذي منحه أفلاطون للإله مهندس الكون، والتي تعنى في المجال الأدبي خالق أو منشِّط العالم...
46. يحسن هنا العودة إلى ما كتبه المفكر أبو يعرب المرزوقي حول هيغل وعلاقته الميثافيزيقية بالعولمة. في مقال: "العولمة والكونية"، مجلة التجديد، عدد4، 1998.
47. Morale et chaos, Op. cit, p. 15.
48. L’inadaptation du chaos à l’Homme contribue à sa dynamique, tandis que l’inadaptation de l’Homme au chaos marque l’impossibilité où l’Homme se trouve de participer à cette dynamique (Morale et chaos, p 16).
49. Morale et chaos, Op. cit, p. 16-17.
50. Ilya Prigogine et Isabelle Stengers. La Nouvelle alliance. P 244-245.
51. Pierre Caye. De l’univers infini au monde clos. Les enjeux philosophiques, politiques et juridiques de la question écologique. Cité dans morale et éthique…
52. Davide Ruelle. Hasard et chaos. p 157.
53. محمد أبو القاسم حاج حمد، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، العالمية الإسلامية الثانية. بغداد: دار الهادي، 2004.
54. Jean-Pierre DUPUY. Petite métaphysique des tsunamis. p 22.
55. Friedrich Hayek. Droit, législation et liberté, I, trad. R. Audouin. Paris, presses universitaires de France, 1983.
56. Morale et chaos, Op. cit, p. 21.
57. Ibid, p23.
58. الفصل السادس من كتاب Morale et Chaos.
59. David Ruelle, Hasard et Chaos, Paris, O. Jacob. 1991. p113.
60. الفصل السابع من كتاب Morale et Chaos.
61. Pierre Magnard. Le Dieu des philosophes. Paris. La Table ronde. 2ème édition, 2006. p 50-51.
62. Morale et chaos, Op. cit, p. 306-307.
63. Luc Ferry. Kant, une lecture des trois critiques. Le collège de philosophie. Grasset. 2008.
64. Rémi Brague. Aristote et le système du monde. Paris, presses universitaires de France, 1988, p.5-6.
65. Stagirite
66. Morale et chaos, Op. cit, p. 307-308.
67. L’être ou le bien de la chose a est à la chose a ce que l’être ou le bien de la chose b est à la chose b. il n’ ya pas d’être ou de bien en soi qui se prédique univoquement de toutes choses…
68. Morale et chaos, Op. cit, p.311-312.
69. المدرسية أو السكولائية (فلسفة المدرسة) (بالإنكليزية: Scholasticism، بالفرنسية: Scolastique) هي فلسفة يحاول أتباعها تقديم برهان نظري للنظرة العامة الدينية للعالم بالاعتماد على الأفكار الفلسفية لأرسطو وأفلاطون.
70. Morale et chaos, Op. cit, p.312-313.
71. Ibid, p314-315.
72. André de Muralt. Néoplatonisme et aristotélisme dans la métaphysique médiévale. Paris, J. Vrin. 1995. P 59. Et 63.
73. Plotin. Traité 9, Trad. P. Hadot. 8, 36-45.Paris, édit. Du Cerf. 1944. p 82.
74. Morale et chaos, Op. cit, p. 315.
75. Georges Leroux. «introduction» dans Plotin. Traité de la volonté de l’Un. (Ennéades, VI,8), note 73. Paris, J. Vrin, 1990. p. 99.
76. Damascius, Problèmes et solutions touchant les premiers principes, I, trad. A. E. Chaignet, E. Leroux, Paris, 1898, reprFsôt. Bruxelles, Culture et Civilisation, 1964, p 110-111. In Morale et chaos.
77. Morale et chaos, Op. cit, p. 320-321.
78. . Ibid, p 323.
79. Emmanuel Kant, «Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeurs négatives». trad. J. Ferrarri (œuvres philosophiques, I, éd. F. Alquié, Paris, Gallimard, 1980, p 266.
80. Gilles Châtelet, les enjeux du Mobile. Paris, éd. Du Seuil, 1993, p 115.
81. Morale et chaos, Op. cit, p. 331-332.