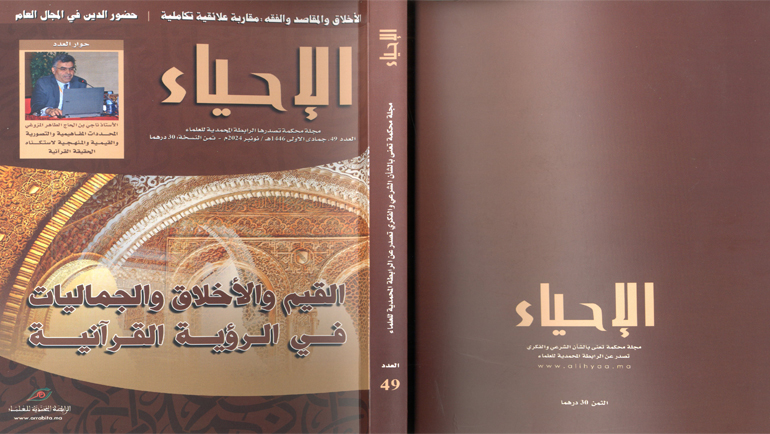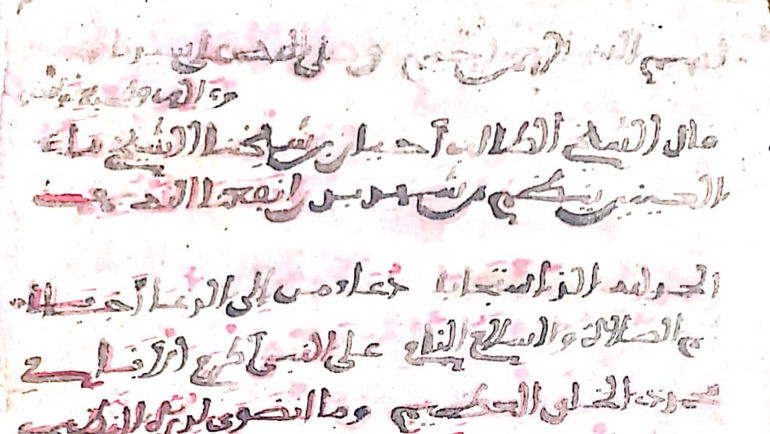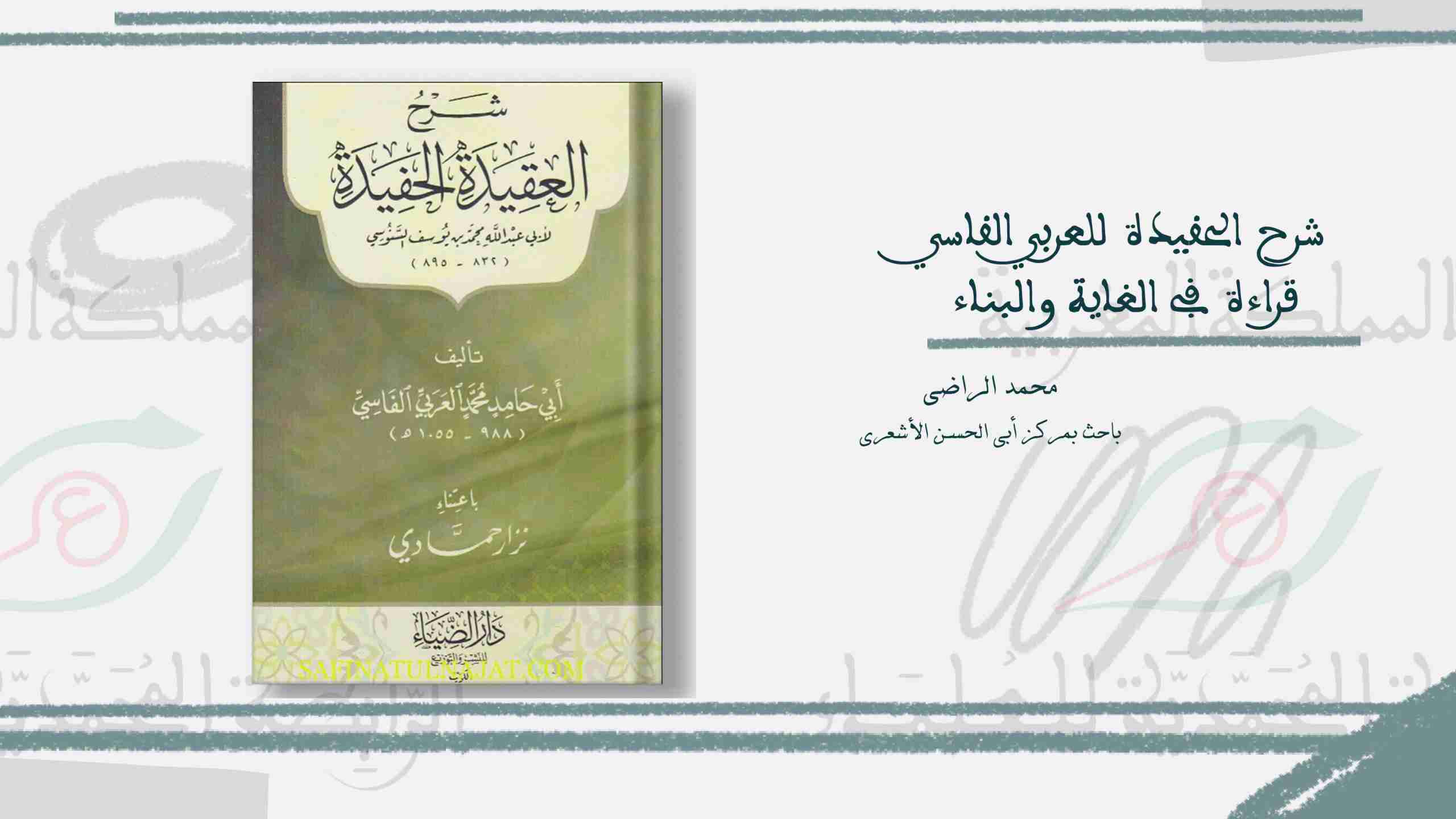أشجان الروح وترانيم الجمال: قراءة في كتاب “رجال ولا كأي رجال” للأنصاري رحمه الله

"ما لا يطاق في الحياة؛ ليس أن تكون، بل أن تكون أوجاعك... أن تعيش هو أن تحمل أناك المتألمة عبر العالم!*".
من كلام فرنسوا ريكار في رواية "الخلود" للعملاق التشيكي ميلان كونديرا...*
أن تقرأ للأنصاري معناه؛ أنك تضرب في عمق الغيب وتكتنه دفائن الروح؛ ثم لا تلبث حتى تجد نفسك خاضعة لقوى القرآن الخارقة؛ لأنها هي نفسها تنطلق من الغيب وتتصل بالروح عبر إكسير المعنى.
فلذلك أضحى هذا المعنى، أخي، موردا صعبا، لا يرسو على جودي بحره المواج إلا سفين من الإرادة صنع خصيصا لمخر عبابه!...
وقلب الأنصاري سفين ما كان لينتصب شراعه إلا لرياح الروح وأحزان الشجن، أيُّ وجدان يتحمل ذلك الكمد فلا تخرُّ ألواحه وتتكسر أضلاعه رهبا؟! فهل ترى تبقى له باقية؟!
اسمه فريد الأنصاري أو الأنصاري الفريد؛ من أي زاوية رمقت اسمه أو لقبه هجمت على فؤادك كل المعاني متدثرة بلباسين اثنين: النصرة والتفرد.
أما النصرة؛ فلدين الله في زمان ارتدت فيه كل الدعاوى إلى الوراء ورجعت القهقرى. وأما تفرده؛ ففي منهج تلك النصرة، بحيث انطبعت قواعد كل الفنون في سجيته وعجنت في طينته. بأي ريشة أيها السادة نرسم آثاره؟ أم بأي مجداف في يَمِّ علومه نجدف؟ كل الجداول تستقي من فيضه، وجميع الأعناق تشرئب إلى مقامه:
الزهد والورع، المقاصد والأصول، اللسان واللغة، التفسير والتأويل، الحكمة والفلسفة، الجمال والفن، الأدب والخيال، الخطابة والرواية، ثم الفقه في دين الله "ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين[1]."
يصفه أشياخه وقرناؤه وتلاميذه بأنه فريد، ويصفه تاريخ المغرب بأنه الحكمة، والحكمة سر النبوغ ﴿وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرة: 268).
عجبا عجبا؛ كيف رسم القدر اسما لرجل في الأزل؛ كانت حقيقة لقبه الفريد ثابتة في التاريخ قبل خلق الرجل وقبل خلق التاريخ! ويوم حان وقته؛ صارت روحه تتغنى بما لا يد له في صناعته، ولا قدرة لغيره على تعلمه بالنظر إلى قصر عمره.
سُكَّتْ نقوش خاتم الفهم القرآني الفطري على صفيح فؤاده؛ فأضحى يحمل من الأسرار ما لا قبل له به، ولا طاقة له على حمله، فلم يجد من ينفس عنه سوى من رزق من أسرار ذلك "المعنى" مثله تماما! أو من توسم فيه الأستاذية والمشيخة على ذلك المهيع، ولكن من هو؟ وما سبيل الوصول إليه؟
كولن والأنصاري: خلة وموافقات
لا عجب أن يغدو فتح الله هو قبلة الأنصاري، لأنه إمام شرب من جميع المشارب وارتوى من جميع الحياض، ثم انطلق في بطحاء السباق يَمْشُقُ ممتطيا صهواتِ الريح بلا تردد ولا تدعدع. وكم تمنى أن تخالط نبضاتُ قلبه نبضاتِ قلبه ولكن القدر كان هو السباق فاستأثر به، إذ ليس للإنسان ما تمنى!
ومن هنا كان بين الشيخ والأستاذ لوائح ولوامع من الموافقات، ألم يقل هو نفسه عن فتح الله:"فلعله فارس لم يشرق بعد زمانه، ولا حان وقته وإبانه، وأَيُّ بلاءٍ أشد على المرء من أن يعيش قبل أوانه؟ ويعاشر غير أهل زمانه؟[2]". أليس هذا كله لأنه ناصر لدين الله متفرد فوق قبة المعالي؟ ثم يستأنف "فتح الله سيرة بكاء، لقبه الأسري "كولن" ومعناه "الضحاك" باللسان التركي، وهذا من عجائب الأضداد، ومن غرائب الموافقات، أيضا، فهو بكاء الصالحين في هذا العصر، لكنه ما بكى إلا ليضحك الزمان الجديد (...)[3]". فهل رأيت كيف غدا الاسم صورة للمسمى؟ وهل الصورة إلا أيقون لنموذجها تحمل تجلياته ومعانيه، وقدر تتشخص في الوجود معالمه ومجاريه. وإنما القدر قدر الله والخلق خلق الله: ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ (لقمان: 10).
إن إلياذة هوميروس لم تكن لتشهد ذلك الإقبال الخارق من الإنسان الغربي خصوصا إلا لأجل أنها ضاربة في عمق الفلسفة والثقافة والدين في حضارته، فلا جرم كان الدين والأخلاق هناك في الغرب ينتعشان من غبار القصص والروايات وتمثلات التراجيديا والفانتازيا، بعيدا عن كل ثابت عقدي حاسم أو تصور سماوي يسيج الفطرة ويضبط الشهوة وينظم الأخلاق.
وهذه الثلاثية؛ أقصد الفطرة السليمة وتنظيم الهوى ومكارم الأخلاق، هي أثافي الوحي السماوي الذي انفتقت له مخيلات المسلمين وانتعشت به قلوبهم؛ فشكلوا به عمرانهم الاجتماعي وأساس بقائهم، وتغنوا به في آدابهم، ورسمته صحائف تاريخهم. هذا هو لب الفكرة الاجتماعية وليس النظرية فقط التي لطالما تغنى بها فتح الله كولن، وصارت خميرة في سريرته تنضج بها أرغفة الروح قبل توزيعها على المحرومين في زمن التيه!...
فمن خلالها كانت وشائج الروح موصولة الرحم مع كل عاشق، حتى بلغ شعاعها، المخترق لحدود الجغرافيا، قلب العندليب المهاجر. فصار يثغو بكلمات الوصال إلى أن رَنَّ جرس الاتصال... فكانت البداية!
في رمزية العنوان ومحتوى الكتاب
هل عرفت أن شخصية فتح الله تضم إلى ما سبق الجاذبية والكاريزما؟ هل عرفت أن هذه الشخصية إنما هي قطعة من البطولة والشهامة جادت بفارسها المشيئة التكوينية؟ فاعرف الآن أن هذه البطولة وتلك الجاذبية؛ هما حقيقة الرجولة ونخوة الإيمان عند الأنصاري، وهما الحداء الغنائي الذي انجدبت إليه روحه طواعية، وامتزجت به مادة فؤاده فصار يهتف "رجال ولا كأي رجال"!
فمنطوق العنوان يشير إلى احتفاء الأنصاري بانتصاره في ملحمته البطولية التي خاضها ضد الأوجاع الروحية والجسدية، إذ الرجال هنا ترميز إلى "عودة الفرسان القادمين من وراء الغيب[4]" بعدما سقط شراعهم زمن رحيل "آخر الفرسان[5]". فهما روايتان نعم؛ ولكنهما في ذات الوقت متتاليتان تراجيديتان وشوطان من الدراما قطعهما مسرح الأحداث المتشكلة من نزيف الروح ومواجع الجسد.
والذي يثير انتباهنا، هنا، في تركيبة مباحث الكتاب؛ هو حضور المشهدين معا وسيطرتهما على باقي المشاهد. إذ ما انفك الأنصاري يهرع إليهما لرسم لوحات فنية في تلك المباحث، بما هي أرض خصبة لاستنبات المواجع ثم في نفس الوقت مصحة روحية لتضميد الجراحات، ربما كانت عند غيره مطالب معرفية جامدة لا روح فيها ولا حياة، متجردة عن لطافة الذوق وعذوبة الفن وماء الجمال... ليس كما ينضح به قلبه هو فيترجمه قلمه.
وعلى كل حال فجملة الكتاب مجموعة من المقالات للأستاذ، سبق نشرها في منابر أخرى تفضل السادة الأتراك بنظمها في فصلين:
أما الفصل الأول فجاء بعنوان: البحث عن فرس اسطنبول؛ وضم مجموعة من المباحث كانت ديباجتَها تمهيدٌ هو شارة الكتاب وعَلَمُهُ الذي انتصب دالا على غرضه وبه سطر عنوانه "رجال ولا كأي رجال". ثم تلته مباحث هي أفنان منه وأغصان وبعضها ضم تحته مطالب وهي على التوالي:
رجل الأسرار، فتح اسطنبول، الفتح الأكبر وانكشاف السر المكنون، البحث عن فرس اسطنبول، بدا حاجب الأفق، ربي أنا، البحث عن صاحب العلامات، المجدد والإرث النبوي، جولة في عالم الأستاذ فتح الله كولن.
ثم جاء الفصل الثاني بعنوان: بين الجمالية والإنسان؛ وضم هو أيضا مباحث كان على رأسها مبحث؛ القرآن الكريم روح الكون ومعراج التعرف على الله، ثم تلاه: مفهوم الجمالية بين الفكر الإسلامي والفلسفة الغربية، فمفهوم الجمالية في الإسلام من الترتيل إلى التشكيل، والعقيدة الإسلامية بين جمال القرآن وتقسيمات علم الكلام، ثم جمالية التفكر الإيماني، فجمالية التعريف القرآني بالله، ثم تلاه روعة الانتساب التعبدي، فالقرآن العظيم وقضية الأمة، ومعراج الصلاة وإخراج الإنسان الكوني، وسر الدعاء وخفاء الأسماء، فكلمات الله في معركة السلام، ثم من أنت أيها الإنسان..؟ لتذيل جميعها بمبحث فلسفة العمر.
فهي مباحث متعددة الألوان الأدبية متنوعة المشارب العلمية، لكنها أثر من استشراف الروح ومواجعها وتكبد عناء السفر في سمائها وفضائها.
لقد كتب الناس عن لغز الروح عند أبي أيوب من شرق الأناضول إلى أدنى المغرب؛ فما وردوا حياضها ولا جابوا وديانها؛ لشساعة أبعادها وعمق غورها؛ وكيف لا؟! والقرآن مصدرها وموردها، والأنصاري فتًى قرآني لا يُبارى.
وأنا، هذا الكسير، وقد أفضت النوبة إلي من بعدهم؛ هل تظن أني سأسلك طريقا غير طريقهم، فأزعم في هذه العجالة أني سأبرز لك سر ما تغنى به فؤاده وعزفت على وتر أوجاعه روحُهُ؟ كلا، ولا الإحاطة بما كشفه الناس من لوعاته، ولا بما نحسه نحن المريدين من تلك اللوعات، وإنما نريد أن نصور لك بعض تلك الآهات التي تخالج الوجدان وتطل بأنوارها سافرة على الخاطر، كلما شبت نار الوجد واستعر لهيب الشوق، لعلك واجدٌ فيها ما يدلك على سائرها مما يعده عشاقه خصائصَ لتفكيره وفرائد، فلئن كشفوا لك من ذلك أنواعا؛ رجونا أن نزيدك نحن من النوع الواحد تجلياتٍ وأشواقا.
مركزية القرآن الكريم في التجديد والإصلاح عند الأنصاري
الفكر القرآني هو خاصية مذهب أبي أيوب الإصلاحي، فبه نطقت كتبه جميعا، وحوله دار قطب رحاها بناءً ونقدا، ومن أجله انطلقت كلماته رسائل تترادف إلى أبنائه العشاق مسهبة صافية، تقطر فيها نفسه كما ترسل السحابة قطراتٍ انعقدت ثم انحلت بماء منهمر! فعما قريب تتوضأ البلابل العطشى، وتروي نَهمتها، وتنطلق في سماء القرآن منتشية فرحا وتالية طربا!
والحقيقة أن القرآن الكريم صار إمدادا للفكر الأنصاري وغذاء لذيذا طيبا تقتات منه مخيلته على جميع الأصعدة. لقد كان أول ما استفز الأنصاري في محاولة اكتشاف سر الكتاب المكنون؛ هو حقيقته وماهيته على طريقة النظار في رصدهم موضوعات العلوم ومصطلحاتها الصناعية "ولنسأل الآن ما القرآن؟ ما هذا الكتاب الذي هز العالم كله، بل الكون كله؟[6]". لكنه ما انفك يلفي نفسه منقادا إلى الإبحار في عمق الروح؛ لأنها هي جوهر القرآن بعيدا عن أي محاولة لرصد الفصول والخواص المتعلقة بالحد كما في سائر الفنون. إذ ليس القرآن من طبيعتها؛ لأنه كلام الله الغيبي المعجز، ولا هي من سبيكته؛ لأنها صنع الناس وتفاعل أذهانهم، وهذا كاف في الفرق بينهما.
ولما كانت الروح ضاربة في مجاهيل الغيب، وحسب الناس التحويم على لوازمها فقط؛ كان القرآن أيضا من جنسها، بل صار قارئ القرآن ذاته وتاليه متصلا بأسرار الغيب "فليس عجبا أن يكون تالي القرآن متصلا ببحر الغيب، ومأجورا بميزان الغيب، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها (...) ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه من رفيع المنازل في الجنان العالية، وما أسبغ عليه من حلل الجمال[7]".
لا جرم أن هناك آصرة عميقة بين الأنصاري وحياته وفكره ومذهبه الإصلاحي، وبين مادة القرآن العظيم وأسراره وتجلياته. فالكينونة الأنصارية والحقائق القرآنية متساوقتان على أكثر من صعيد، كما هي عند النورسي شيخه الأول. بيد أن أهم الأصعدة التي ترجمت هذا التساوق؛ اختزلت عند الأنصاري في كليات المفاهيم الوجودية كما ضمها هذا الكتاب ونطقت بها أغلب كتبه، وهي: حقيقة الإنسان ووظيفته الوجودية، التعريف بالله الخالق وتوحيده، أسرار الكون، قضية الأمة.
أولا: حقيقة الإنسان ووظيفته الوجودية
يدبج الأنصاري أهم مبحث في هذا الكلي بسؤال استنكاري يرشق به سياج البديهة التي غلفت ذهن الإنسان وحبست قلبه عن أن يكون موصولا بالسماء، يحلق في الملكوت لإدراك سر وجوده أولا ثم سر تدفق الكائنات الخادمة له في الكون ثانيا، حتى يستشرف بعض تجليات الماوراء من خلال ذلك كله ثالثا:
"من أنت أيها الإنسان؟!
من أنت..؟! أنا وأنت...! ذلك هو السؤال الذي قلما ننتبه إليه.. والعادة أن الإنسان يحب أن يعرف كل شيء مما يدور حوله في هذه الحياة، فيسأل عن هذه وتلك إلا سؤالا واحدا لا يخطر بباله إلا نادرا هو "من أنا؟ (...) ولعل أهم الأسباب في إبعاد ذلك وإهماله؛ يرجع في الغالب إلى معطى وهمي، إذ نظن أننا نعرف أنفسنا فلا حاجة إلى السؤال، تغرنا إجابات الانتماء إلى الأنساب والألقاب، وتنحرف بنا عن طلب معرفة النفس الكامنة بين أضلعنا، التي هي حقيقة "من أنا؟" و"من أنت؟".. ويتم إجهاض السؤال في عالم الخواطر، وبذلك يبقى الإنسان أجهل الخلق بنفسه، فليس دون الأرواح إلا الأشباح"[8].
وحدهم أرباب الأحوال ينتقشون أسرار التكليف ويحومون حول حمى الروح، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه! ليس لأنهم يبدون ما الله مخفيه ﴿وَيَسْئلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي﴾ (الإسراء: 85)؛ ولكن لأن الله يلهمهم معرفة ما أخفاه ويسعفهم بالإلهام والفراسة الصادقة لتذوق أسرار كانت من قبل مسربلة بغطاء الخفاء والإبهام، تفضلا منه ورحمة وهدية منه ونعمة. "وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟! هذا غير لائق في محاسن العادات، ولا في مجاري الشرع[9]".
والأنصاري فحل من فحولهم لا يشق له غبار، تراه يرمي بروحه إلى عوالم مجهولة في الإنسان وعلى رأسها النفس البشرية، فيستنطق فيها ما هو إلفي تعودي عند غيره، ويكتَنِهُ، مستصحبا قوانين السير الحياتية كما رسمها القرآن، امتداداتها الإعجازية التي تصد دون معرفتها الشياطينُ. وصدق رسول الله "هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم؛ أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب![10]".
فلذلك تجده في كل وقت وحين يهرع إلى كلمات الأزل صاعدا إلى السماء يرتشف من معينها، ثم ينزل ليضمد بها جراحات أشباله، ويرش سنابل الريح الجافة بنسيم الفرقان العليل! أمله في ذلك أن يحيي نبضاتِ القلوب، وإعادة خَفْقِها بالقرآن، حتى يستأنف نبع الإنسانية تدفقه من جديد "فكيف تحل لغز الحياة والموت؟ وكيف تفسر طلسم الوجود الذي أنت جزء منه ولكنك تجهله؟! كيف وها قد ضاعت الكتب كلها ولم يبق بين يديك سوى هذا الكتاب؟!
فأين تجد الهداية، إذن، يا ابن آدم إن لم تجدها في القرآن؟ وأين تدرك السكينة إن لم تدركها في آياته المنصوبة، لكل نفس في نفسها، علامات ومبشرات في الطريق إلى الله؟"[11].
إن قدرة المخيلة على تمثل الأشياء المحيطة بنا تتحول بالظاهرة أو بالحدث كما يعيشه المسلمون في بيئاتهم وبلدانهم وبيوتهم... لينصب منه الأنصاري صورة كونية كلية تستجمع بعدي الزمان والمكان، وتجعل عين الخيال تتمثل الواقعة وكأنها تجري أمامها في شريط أو من على منصة، فإذا هي في النفس مشهد حياتي متحرك "فيا حسرة عليك أيها الإنسان، هذا عمرك الفاني يتناثر كل يوم، لحظة فلحظة، كأوراق الخريف المتهاوية على الثرى تترى! ارقب غروب الشمس كل يوم لتدرك كيف أن الأرض تجري بك بسرعة هائلة لتلقيك عن كاهلها بقوة عند محطتك الأخيرة، فإذا بك بعد حياة صاخبة؛ جزء حقير من ترابها وقمامتها، وتمضي الأرض في ركضها لا تبالي، تمضي جادة غير لاهية، كما أمرت، إلى موعدها الأخير[12]."
ومن منا لا يرى اضطرارا مشهد غروب الشمس كل يوم؟! ومن منا لا يرمق دوران الأرض في مجاري العادات كل لحظة؟! ثم من منا لا يبصر انفلات عمره إلى الزوال؟! وهكذا،...، ولكن لانغماس النفس في الشهوات جدار صلب يحجب يقظة الأرواح وتوقانها إلى المطلوب، إلا على أرباب البصائر الذين يقيسون أدنى حركة بسيطة في الكون بمقياس الروح؛ فإذا هي بلبل صداح يعزف سنفونيات كونية خارقة! وينتفض إذا انزعج بوارد أو بارقة!...
ثانيا: التعريف بالله الخالق وتوحيده
إذ من مقاصد القرآن العزيز بالاستقراء التام التعريف بجلال الربوبية وجمال العبودية، ومدار ذلك كله على نعمة الخلق. فخلق الله للإنسان وتكريمه بالإيجاد من بعد عدم؛ هو أول نور اختطفت إليه قلوب العباد وانفتقت له مشاعر التأله والعبودية. فالإنسان إنما عرف الله "أول ما عرفه (ربا)، فلما عرف منه تعالى ما عرف؛ ألهه قلبه فعبده[13]". إذ القلوب هنا مرايا تعكس جمال الخالق وجلاله بالعبودية من خلال صورتي التوحيد والإيمان المنطبعة في السجايا إذا صقلت بطواعية التكليف وحادي المحبة، "ومن هنا كانت البداية في قصة المحبة[14]."
فلا عجب، إذن، أن يكون الإيمان بهذا الاعتبار في نفسه جمالا وزينة، قال جل جلاله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: 7). ولا عجب أيضا في أن يكون جمال هذا الإيمان نابعا من مشكاة جمال الربوبية؛ لأن مادته صدًى من أصدائها وأثر من انعكاس تجليها، فـ"الله ربا؛ هو أول بدء تدفق الجمال على عقيدة الإسلام؛ إذ إن جمال الرب عز وجل يفيض من بهاء ذاته تعالى وصفاته (...) إنه النور الخارق الذي لا يطاق[15]."
إن انتساب العبد إلى الله معناه الخضوع بذل العبودية إلى عز الربوبية "ومن هنا كان وصف الإنسان بأنه عبد من أحب الأسماء والصفات الإيمانية إلى الله، ومن أحسنها في تسمية الإنسان، كما ورد في قول رسول الله "إن أحب أسمائكم عند الله: عبد الله، وعبد الرحمن" رواه مسلم. وذلك لأن هذين الاسمين فيهما نسبة العبد إلى اسم الجلالة (الله) وإلى أعظم صفة الله جل جلاله (الرحمن)[16]". لأن في التسمية نسبةً تشريفيةً وانتسابا تعبديا إلى الجناب الأعلى جل جلاله، على ما تقره قواعد النحو والبلاغة في حقيقة النسبة والإضافة بين المضاف والمضاف إليه.
والأنصاري ما فتئ يرجع إلى شيخه النورسي لاستمداد الطاقة العلمية والروحية في تحليل مثل هذه الرموز التي ينظر إليها المسلمون بمنظار العادة والتكرار. فلا جرم كان الكثير منهم ممن تحلى بهذين الاسمين المباركين؛ قد يرتكب من قبح الأفعال وفحش الأقوال ما يعود على أسرارهما بالنقض والإبطال؛ بسبب النظرة البديهية إليهما واختزال حقيقتهما في العَلَمِية والاسمية فقط. بيد أن المسألة على العكس تماما عند ذوي البصائر الذين يرون في الاسمين "لوحة وجدانية خالدة، كلما طالعت أنوارها تدفقت بالأسرار. ذلك أن المسلم لم يعد عندهم، باعتباره عبدا لله، مجرد اسم علم ينادى؛ أي (عبد الله) أو (عبد الرحمن)؛ وإنما هو صاحب وظيفة مستنبطة من التفكر الخفي، والتدبر الملي لطبيعة العلاقة بين المضاف والمضاف إليه (...) من حيث إنها تفيد اختصاص المضاف إليه بالمضاف، وتفرده به على سبيل (الامتلاك). وكذا اختصاص المضاف بالمضاف إليه، على سبيل (الاستناد) و(الانتماء)[17]."
فانظر بعد هذا أي بشاعة وإجرام يحملها المشرك في باطنه بإجهازه على نسمات الجمال في علاقته بذاته وبأخيه الإنسان، ثم في علاقته بسائر مخلوقات الله وخالقها الذي برأها ونَسَّمَها على فطرة التوحيد وجمال الإيمان. إذ الكل فاض جماله من جمال الربوبية، هذا الكون الخارق الممتد إلى غير نهاية المحمل بالأسرار الضاربة في عمق الغيب؛ أليس هو من عبيد الله ومصنوعاته؟ أليس جماله من جمال خالقه؟ فكيف لا تكون ذرة من الشرك كافية للقضاء على كل هذه الأسرار في قلب العبد والإجهاز على امتداد هذه العظمة وعلى سر ذلك الارتباط الجمالي العميق؟! لأنه مهما تعددت المخلوقات وتنوعت ماهيةً فهي لا تخرج وظيفةً عن قبلتها الواحدة المتحدة وهي العبودية الكونية لله. فهو عقدها الناظم لها الذي متى انحل خيطه اختل نظام الجمال فيها.
ومن هنا كانت "شهادة أن لا إله إلا الله توقيع عقد وإمضاء التزام، بضمان الهوى لله وحده[18]"؛ لأن تلك الشهادة شعور قلبي وجداني ومرآة تعكس كل جمال يَرِدُ على الأشياء في الكون، بل تعكس جمالَ وأنوارَ الأسماء الحسنى والصفات العلا. وبالجملة فقل: هي كل شيء، ومتى فقدها العبد فقد كل شيء، فكان منطقيا أن لا يستحق في الآخرة أيَّ شيء! وهذا سر خلود الكافر في النار.
ومن هنا كابد رسول الله وصارع من أجل إنقاذ البشرية التي كانت على شفا جرف هارٍ من العذاب الخالد والخسران الأبدي، "فلم يكن من منطق الأشياء أن تدور معركة، بل معارك مريرة، بين الرسول، صلى الله عليه وسلم، وبين العرب من أجل أحجار هي الأصنام، التي كانت تعبد من دون الله؛ بل إن حقيقة المعركة كانت حول ما ترمز إليه تلك الأحجار، من أهواء ساكنة في قلوب العباد (...).
ومن هنا حرص النبي، عليه الصلاة والسلام، على الإطاحة بأوثان الشعور، قبل الإطاحة بأوثان الصخور!. وقد ظل بمكة يعبد الله قبل الهجرة ويطوف بالبيت العتيق، وقد أحاطته الأصنام من كل الجهات، لأن عمله حينئذ كان هو إزالة أصولها القلبية وجذورها النفسية (...) ولذلك قلت: إن الشرك معنى قلبي وجداني، قبل أن يكون تصورا عقليا نظريا"[19].
فبان أن شهادة التوحيد هي أصل حياة الروح؛ لارتباطها العميق بشعور الإنسان وسيطرتها على بصيرته، ومن هنا ما كان للبصر سلطة على رؤية الأشياء على حقيقتها وعدم الخلط بين وظائفها الكونية الإلهية؛ دون نور البصيرة الوهاج. وتبقى شهادة التوحيد في البصيرة تمثل الإنارة الخلفية لمسرح الأحداث والوقائع التي تجري على شاشة الكون. فبدون إنارة تستمر الظلمة وتختلط الحركات وتضيع الفرجة الكونية والجمال الخِلقي.
إذا علم هذا؛ فإن أول ما طولب به الإنسان لنصب سلم الاتصال الدائم بخالقه هو مقابلة هذه النعم الجميلة بالثناء على خالقها الجميل، ولما كان الحمد في طبيعته جمالا؛ إذ هو "الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم[20]" كما قالوا؛ كان هو نفسه أنسب قناة لتحقيق التناظر الجمالي مع نعم الخالق الجميلة، إذ لما "توالت عليه بعد ذلك النعم تترى مما لا يحصى ثناء وشكرا، رزقا ورعاية وهداية... إلخ (...)؛ وجب أن يكون أول ما ينطق به الإنسان (أي إنسان) في حق ربه سبحانه هو الحمد والشكر أولا وقبل كل شيء (...) ولذلك فإن القرآن الكريم، وهو كتاب الله، افتتح بالحمد لله رب العالمين، وتمجيد أسمائه الحسنى[21]."
فكان تكليفه أن ينطق، لسانا ووجدانا، بشهادة التوحيد والإخلاص الجميلة نسفا لكل هوى يعارضها أو عقيدة تضاهيها. فلا غرابة أن يكون التوحيد بهذا الاعتبار صنو الحمد والشكر في الحقيقة الجمالية في الإسلام. ونقتطف لك قطعة من الإشراقات اللطيفة للأستاذ سعيد النورسي تزيدك بيانا لهذه الحقيقة وهذا التداخل؛ قال رحمه الله: "إن ثمرة واحدة وزهرة واحدة وضياء واحدا، كل منها يعكس كالمرآة الصغيرة رزقا بسيطا ونعمة جزئية وإحسانا بسيطا..
ولكن بسر التوحيد تتكاثف تلك المرايا الصغيرة مع مثيلاتها مباشرة ويتصل بعضها بالبعض الآخر، حتى يصبح ذلك النوع مرآة واسعة كبيرة جدا تعكس ضربا من جمال إلهي يتجلى تجليا خاصا بذلك النوع، فيظهر سر التوحيد جمالا سرمديا باقيا من خلال ذلك الجمال الفاني المؤقت... بينما إن لم ينظر إلى ذلك الجمال بنظر التوحيد؛ أي لولا سر التوحيد، لظلت تلك الثمرة الجزئية سائبة وحيدة فريدة معزولة عن مثيلاتها فلا يظهر ذلك الجمال المقدس ولا يبين ذلك الكمال الرفيع، بل تنكسف حتى تلك اللمعة الجزئية المتعلقة منها وتضيع وتنتكس منقلبة على عقبيها من نفاسة الألماس الثمين إلى خساسة قطع الزجاج المنكسر[22]."
فالتوحيد، بما هو كلي معنوي مستفاد من حقيقة النعم ووظيفتها وليس من هياكلها المادية، هو المقصود ابتداء من تلك النعم والآلاء المتجسدة في تلك الهياكل، فهو جمال تعبدي باطن وشكر وجداني قائم يترجم جمال تلك النعم الكونية في الوجود هنا ويضفي عليها سر الخلود الأبدي الموعود فيها هناك.
فإذا قدر للعبد أن يسير هذا المسار حيث يتعرف حق المعرفة على خالقه عز وجل المنعم عليه؛ دل ذلك على قوة المحبة بين جنبيه، لأن "المحبة ثمرة المعرفة[23]"؛ على حد تعبير أبي أيوب؛ إذ تحمله على بذل الجهد شوقا إلى المحبوب فلا يزال "يفني القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة، ويُعَمِّرُ الأنفاس ولا يرى أنه قضى نَهْمَتَهُ[24]". قال رحمه الله: "من هنا، إذن، كانت معرفة الربوبية مورثة لمحبة الله؛ أي لعبادته. ولذلك فقد وردت التوجيهات التربوية النبوية للأمة العابدة لربها تعبدا بجلال ربوبيته سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: "من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة" (رواه أبو داود)"[25].
فهذا أيضا السر في تعلق الأسماء والصفات الإلهية بأفعال المكلفين وأحوال المخلوقات وطبائع العمران؛ ومن ثم وجب على المسلم "تمثل مقتضيات أسماء الله الحسنى تمثل المحب المتعلق ببابه الكريم يرجو وصاله والنهل من أنواره، (مما) يفتح الطريق للعبد السائر إلى الله للحصول على الإذن المـُلكي العالي إكراما لمحبته والتعلق بأسمائه[26]."
لأن المحبة هي الدافع إلى ذلك كله، فلا جرم كان خلق الكون هو من ثمراتها عند نظار التربية الروحية وأصحاب عزائم الأحوال. قال ابن القيم: "إن العالم، العلوي والسفلي، إنما وجد بالمحبة ولأجلها وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك؛ إنما وجدت بسبب الحب[27]."
ثالثا: الكون وأسراره
هذا هو الركن الثالث المكون لأركان حاكمية القرآن الوجودية وأسرارها الحضارية. فالقرآن بالنسبة إلى الكون في منظور الأنصاري "فهرست الوجود والكشاف لكل موجود[28]."
الكون؛ هذا الفضاء الشاسع والواسع الممتد إلى ما لا يحده بصر الإنسان ولا عقله إذا ارتبط بوجدان الأنصاري وبأحاسيسه الزمردية المشتعلة؛ ازداد اتساعا واستحال مددا حراريا سرعان ما تشتعل به أشواقه ومواجيده، فيقذف بالكلمة منه ذات طبيعة شجية ووَهْجٍ حار تأسر القارئ وتشده.
"إن ما يبهر الإنسان من ذلك ويفيض مشاعره؛ أن القضية هي من العظمة والرهبة بحيث يستحيل على القلب البشري تحمل مواجيدها، بدءا بالتفكر في هذا الكون الشاسع الممتد من فضاءات لا يحدها بصر ولا تصور ولا خيال، وما يسبح فيه من نجوم وكواكب ومجرات وسدم غائرة بعيدة بملايين السنوات الضوئية، وما يحيطها من سماوات بعضها فوق بعض، وما يعمرها من خلائق نورانية مما لا يدرك له شكل ولا صورة، إلى ما بين هذا وذاك من طبقات الزمان المختلفة عدا وتقديرا، من الأيام والسنوات، قد يختزل اليوم الواحد منها (ألف سنة مما تعدون) إلى (خمسين ألف سنة).
ورب هذه العوالم جميعا الخالق لها والمحيط بأزمنتها وأمكنتها كلها، المدبر شؤون حياتها ومماتها وأرزاقها، بقيوميته الممتدة من الأزل إلى الأبد، المالك زمام أحوالها بأنوار أسمائه الحسنى وصفاته العلا سبحانه وتعالى، هذا الرب الرحمن الرحيم والملك العظيم المتنزه في مطلق علوه وسموه وجلال كبريائه؛ يقدر برحمانيته ورحمته أن يكرم الإنسان هذا المخلوق الضعيف القابع في الأرض، هذا الكوكب الضئيل السابح في بحر عظيم زاخر بأمواج السدم والمجرات، فيكون من أعظم مقامات هذا التكريم أن يخاطبه بهذا الكلام الإلهي العظيم (القرآن الكريم)[29]."
هل رأيت هذا الشريط الوجداني الصافي الذي يحكي قصة تكليف الإنسان، هذا المخلوق الكوني القابع في دركات الضآلة والصغر لولا تكريم القرآن الذي وهبه بعده الكوني ومسؤوليته العظمى؟ ما معنى الفن إن لم يكن هذه الأشواق الحَرَّى التي ينفذ من خلالها الإنسان إلى الماوراء ويذوق شَهْدَ الحقيقة المثالية من خلال محطات الملك والملكوت الحسية والروحية على السواء؟ أي شيطان لعين ذلك الذي اجتال عقول "يونان" وأرداهم ومن تلقف عنهم؛ حينما ألزموا الله علم الكليات ونزهوه، بزعمهم، عن متابعة الجزئيات لأنها لا تليق، في وساوسهم يزعمون، بكماله؟! أليس في هذا إزهاق لروح النعم الجزئية والآلاء الكونية في الآفاق وفي الأنفس الدالة على عظمة الخالق وتعلق أسمائه الحسنى وصفاته العلى بها؟! ما مقتضى هذه الأسماء والصفات إن لم يكن هو ارتباطها بأفعال العباد جليها وخفيها؟ وما متعلَّقُهَا إن عدمت الجزئيات المنتصبة علاماتٍ فطريةً للدلالة عليها. وماذا بقي من الاسم إذا فُرِّغَ من مسماه أو قل: من معناه الدال عليه؟! فلعمري إن لم يكن هذا شركا أو إلحادا فلا أقل من وسمه بفساد عقل أو برودة عناد!
إن من تجليات حاكمية القرآن على كل شيء؛ خضوع عناصر الكون لكشافه الوجودي والغيبي وتوجيهه الحُكمي والحِكمي لأشيائه ومخلوقاته عبر نفاذ عز الربوبية في تلك العناصر "امتلاكا وقهرا، كما أن الكائنات من خلاله تدور جميعها حول هذا المعنى، سالكة إلى الله خالقها، منجذبة إلى نوره تعالى[30]". مما "يلفت الإنسان إلى مظاهر الكون وحقائقه ليتفكر في خلق السماوات والأرض، كل على حسب طاقته وسعة إدراكه. فيكون القرآن بكونيته هذه خطابا لجميع الناس بجميع مستوياتهم الثقافية واختلافاتهم اللغوية والعرقية[31]". وهذا هو معنى كونه "روح الكون ومعراج التعرف على الله[32]."
إن هذا النظر الاستيعابي الشامل لحقائق القرآن ليوسع من أفق قراءة الإنسان للعلاقات بينه وبين المخلوقات الكونية من جهة، حيث يغدو إنسانا كونيا بامتياز لا يسكن الأرض إلا بقدر ما يحقق أخوة كونية مع مخلوقاتها. ومن جهة أخرى؛ تحقيق الألفة والتواصل العمراني مع أخيه الإنسان بشتى مذاهبه وعقائده وأفكاره، "ليس فقط لأنه لا يمكن أن يعيش بصورة انفرادية اعتزاليه، فهذا أمر بديهي؛ ولكن ليكون ذلك مقدمة لإنتاج حوار في المجال الروحي، والتداول المعرفي بحقيقة المعرفة بالله في طريق السير إلى الله[33]."
ذلك لأن القرآن بمعجزته الخارقة "المطلقة عن الزمان والمكان يحقق أخوة إنسانية كبرى، لا يمكن أن تتحقق على هذا الوزان بسواه؛ لأنه شبكة اتصال وجودية ذات أنسجة أفقية وعمودية، فيها مداخل لا حصر لها للإمكانات البشرية. ولذلك فهو يتيح لكل إنسان مهما كانت ميوله وإمكاناته الطبيعية والفطرية والاجتماعية والثقافية أن يتصل بحقائق الوجود الحق[34]."
والأنصاري يسمي العلاقات الإنسانية المبنية على التعارف الابتدائي بالعلاقات الأفقية، فإذا ترقت إلى تعارف قرآني وزرعت في القلوب حبات الإيمان البلورية؛ صارت علاقات عمودية[35]. وهذا هو السر في تقديم الأولى على الثانية في مقاصد القرآن التواصلية في بعدها الكوني والإنساني الشامل، من باب تقديم مقصد الوسيلة على مقصد الغاية كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13). تماما كما رسمها الأنصاري؛ لأنه عقل لم يرض بغير القرآن فضاءً للتحليق والجولان.
رابعا: قضايا الأمة
يعلم القرآن الناس أن الأمة كما الفرد، إذا انخرطت في سلك إرشاداته وتوجيهاته صارت بمثابة قدر الله وكلمته في خلقه، بل صارت رمزيا تمثل عصا موسى تجاه سحرة فرعون الساهرين على تخريب الإنسان والعمران وإفساد نسمات الإيمان والفطرة في القلوب؛ ذلك أن "من تخلق بهذا القرآن وتحقق في نفسه ووجدانه، صار جزءا حقيقيا من حركة القرآن في الفعل الوجودي[36]"، "واقرأ قصة موسى مع سحرة فرعون؛ فإن فيها دلالة رمزية عظيمة على ما نحن فيه في خصوص زماننا هذا! ذلك أن كلمة الباطل كانت تمثلها آنئذ زمزمات السحرة، فتجردوا لحرب كلمة الحق التي جاء بها موسى، وخاضوا المعركة على المنهج نفسه الذي يستعمله الباطل اليوم، إنه منهج التكتلات والأحلاف، تماما كما تراه اليوم في التكتلات الدولية التي تقودها دول الاستكبار العالمي ضد المسلمين في كل مكان[37]."
إن واقع المسلمين اليوم في مقاربات الأنصاري هي كمشهدين متتاليين دراميين على مسرح الوجود، يبدأ الأول بقصة الشر التي تغزو الناس والكائنات والحياة، ويتلوه المشهد الثاني الذي يأتي على غراره مباشرة قصد الإنقاذ وإعادة اللون الأخضر إلى الحياة، عبر شلالات الكلمات الأزلية الصافية التي تعمل على إزالة الأنجاس والأدناس مما يبثه سَدَنَةُ فرعون من شياطين الجنة والناس! لكن خاتمة الفيلم تراجيدية مع الأسف، حيث تقف القصة عند المشهد الأول وتصير اللقطات تدور على مقطع واحد بداية ونهاية. "إن المشكلة أن الآخرين، فعلا، يلقون ما بأيمانهم، فقد ألقوا اليوم (عولمتهم) لكننا نحن الذين لا نلقي ما في أيماننا، ويقف المشهد، مع الأسف، عند قوله تعالى: ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (طه: 65–66)، ثم لا يكتمل السياق، وتلك مصيبتنا في هذا العصر[38]."
ومن هنا كانت كلمات القرآن هي، وحدها، "عندما تؤخذ بحقها تصنع رجالا لا كأي رجال، فإنها تصنع رجالا ليسوا من طينة هذه الأرض؛ ذلك أنها تصنع الوجدان الفردي والجماعي والسلطاني للإنسان، على عين الله ووحيه، فيتخرج من ذلك كله قوم جديرون بأن يسموا بـ(أهل الله وخاصته). وبهذا يتحولون إلى قدر الله الذي لا يرده شيء في السماء ولا في الأرض، فيجري الله جل جلاله بهم أمره الكوني في التاريخ[39]."
فكم لأمة القرآن من عُدَّةٍ وعتادٍ وكنوزٍ في هذا الكتاب، إنه منجم ما فتئ الأنصاري كلما خط خطوطا ينبه إلى معادنه النفيسة التي تصنع الأسلحة الفتاكة بكل شيطان مارد من مردة "هذا العصر، إنها (كلماته) تتحدى اليوم، بما تزخر به من قوة غيبية، العالم كله، فهل من مستجيب؟ أو هل من مبارز؟! (...) إنها كلمات تصنع كل ما يدور بخيالك من أسباب القوة والمنعة (...) وبرهانا يدمغ باطل هذا الوابل الإعلامي الذي يهطل بالمصطلحات المغرضة، والمفاهيم المخربة للمخزون الوجداني والثقافي للأمة، بما يبني من الوجدان الفردي للإنسان ما لا طاقة لوسائل التدمير المادية والمعنوية معا، مهما أوتيت من قوة، على تغييره أو تفتيته. ثم هو يبني النسيج الاجتماعي للأمة ويقويه بما لا يدع فرصة لأي خطاب إعلامي مضاد ينال منه، ولو جاء بِشَرِّ الخطاب وأَشَدِّ الخراب كلمة وصورة وحركة[40]."
إنها النفس التواقة إلى الانبعاث الحضاري، مشرفة من عَلُ على أزمات الأمة وانتكاساتها، فهي تخطط لمنهج استئنافي تحكمه هندسة حضارية ما كان للأنصاري أن يوفق في رسمها لولا تحليقه عاليا في السماء حيث توجد كلمات القرآن.
لقد اتخذ القرآن ذكره في الأرض وروحه في السماء. فلا تزال كلماته من فيض الاستبصار برسالاته حمما بركانية تنساب في غياهب شعور المريد فتستحيل برودة الضمير فيه إلى نار من جنون لا يخبو لهيبها! بهذا إذن تتكون رمزية أبطال "رجال ولا كأي رجال"، ويصيرون كيانا واحدا متماسكا يصعب اختراقه، إلى أن تتفجر فيهم "الفطرية[41]" جداول من أنوار السلام والأمان! أجل؛ ويتحول المشهد من تذمرِ التدافعات البشرية الغثائية حيث يوجد ﴿شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ (الزمر: 28) إلى جمالية "الصالونات القرآنية[42]" حيث تجد ﴿رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ (الزمر: 28). فكيف لا تهفو إليه القلوب؟! وكيف لا تفزع إليه الأرواح؟! خاصة في زمان حاله كما ترى!
الأنصاري معزف مكسور
يتخذ الأنصاري من الطبيعة وعناصر الكون مصحة روحية واسعة لتضميد الجراحات وإعادة تركيب خابيته المشقوقة! فما دام الكون معادلا موضوعيا للكتاب المكنون، ولما كان هذا في وجدانه قواعدَ وفهرسة للموجودات؛ صار الآخر هو مائدة شهية وفضاءً "بانورامي" كاملا مادته تلك الموجودات.
والأنصاري يستغل الفرصة من خلال هذا التناغم بين الكتابين المنظور والمسطور لاكتشاف الروح الكلية للأشياء، بما فيها روحه هو، وفك شفرات طلاسمها التي باتت بالنسبة إليه شبحا في ظلام دامس لا يدري حقيقته وسره:
هل غادر الغدير نبض صخره؟!
أم هل جفاه غاضبا سناء برقه؟!
فأينها تلك التي كانت هنا؟
ما بين مائه وعطره؟
تشرب من أشعة الندى...!
وتلثم الثمر...!
رحيل فارس الأناضول النورسي بالنسبة إلى الأنصاري؛ هو انتكاس لروح الأمة ينعكس شعاعه على روح الأنصاري، فتغدو مناخا كئيبا يخيم بسواده على النفس المشرئبة إلى الانعتاق التواقة إلى الانبعاث "(...) بدل أن أكون أنا أدرس رسائل النور، صارت رسائل النور هي تدرسني... فقد شعرت بعد ذلك مباشرة أن بديع الزمان صار يسكنني![43]."
وذات غفوة تبددت أطيافها خلف الربى
كأنما امتطت شعاع الشمس ثم غربت
فأصبحت أفئدة الشجر فارغة!
وأرسل الغدير بينها أغرودة الحزن!
تلاحظون كيف تجثم سفينة الكون على ضفاف الروح! فيقتبس منها الفنان صورا رمزية ليست تتعدى حقيقة روحه هو (أطياف، شعاع، الشمس، الشجر، الغدير...) وهكذا في سائر القصيدة التي تحكمها تيمةُ الخلة مع الأشياء المنضوية تحت لواء الحزن المتفجر، كبركان متدفق، على الكلمات؛ لينسج منها الأنصاري لوحة فنية تتداخل فيها جميع الشعاعات ومزخرفة بكل ألوان الطيف.
إذا كان البطل الملحمي هو الذي يسحقه قدره في معركة مع قوات الطبيعة، فإن بطلنا هنا يزداد شموخا وعلوا حينما يوظف نفس هذه الطبيعة وأسرارها وعناصرها لصالحه، ويرى فيها قيما عزائية بديلة يصمد بها إلى حاكمية القضاء والقدر حيث تنتهي هناك أسرارها، فهو لا يثور ضد الأقدار ولا يرفضها كما في الحدث الدرامي.
ويحي، أنا المعذب المجنون!
(...)
"ولي كبد مقروحة من يبيعني
بها كبدا ليست بذات قروح؟
أباها علي الناس لا يشترونها
ومن يشتري ذا علة بصحيح"؟!
يا سيدي البوسفور
تلك الرياح مزقتني بين شاطئيك موجة!
أو حيرة من رجفة الخريف...!
فأخبرني عن سفينة
قد قيل: مرت هنا تحمل غابة صنوبرية!
فلم تزل تمخر حزن البحر!
حتى رست على مساء "التلة العليا"
ثم ارتقت معراج ريح عابر...!
واندثرت!
البوح والأنين يترجمان الصراع الدرامي مع النفس ويحيلان رمزيا إلى المعاناة والأسى الذي تتخبط في الروح جراء ما يحدث لواقع الأمة وما حدث بالفعل لتاريخها (أندلس الأشجان، أزمة الموريسكيين، والملحمة الفلسطينية...) كما أفصح عنها في روايته "عودة الفرسان"...
والأنصاري حينما يوظف التناص (أبيات ابن الدمينة)؛ يوغل في الرمزية ذات البعد التراجيدي بقصد توسيع أفق القراءة لدى المتلقي ووضعه في المشهد والاستحواذ على أحاسيسه من كل جانب...
إن التراجيديا فعل إنساني مأساوي ينتهي عادة إلى الموت أو قهر البطل بسبب متواليات اليأس المحبط، بيد أن المؤمن بالله المسلم وجهه إليه؛ لا تنتهي معاناته إلى هذه النتيجة؛ لأنها كفر في قواعد الدين. بل يجد في المعاناة فرصة لرسم لوحات الجمال، إذ "الفنان الأصيل يتميز بالقدرة على تحويل الجراحات التي ينزف بها قلبه إلى لوحات تتداوى ببلسمها الروح[44]". وهذا فارق ما بين الأمرين في الإسلام وغيره.
يا سيدي البوسفور...!
ها غيمك الجليل يزدهي بدره الجميل
فاقرأ سلام البرق للشطآن في مدائن الأحزان،
وقل لهم: سنلتقي بموعد الأذان
إذا تحرك الحجيج في مسيرة النخيل
يكبر الإمام أولا
……….
ويشرع الصهيل!
تلك كانت خاتمة الحكاية، وهي في نفس الوقت إعلان عن وقوف قاطرة السفر الطويل المؤذنة بالانتصار والوصول إلى البغية، والعثور على علامات الحق الكامل بعد بحث مضنٍ وشاق. فكأن سوق مبحث "البحث عن صاحب العلامات" رديفا لأشواق وتأوهات شعرية وأهازيج وتطلعات روحية (البحث عن فرس اسطنبول، بدا حاجب الأفق، ربي أنا)؛ إنما كان تتويجا لمسار الرحلة وإعلانا عن توقفها: "(...) هذه الرسالة كنت أبحث عنها منذ ما يقرب من عشرين سنة في بلدي... هذه الظلمات التي تعم العالم الإسلامي اليوم؛ لابد وأن يكون هناك نور يخرقها ويجليها ويبينها، لابد، هكذا تقول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.. لكن الحيرة التي كانت تنتابني هي أنه كلما عثرت على بصيص نور في المغرب أو في بلاد عربية أخرى من البلاد التي كنت أزورها (...) كلما وجدت بصيص نور وتتبعته لا تمضي مدة قليلة حتى ينطفئ هذا النور وتصبح مشكلة، وتعود الأمور إلى ظلماتها كما كانت من قبل.. فأتعجب أين هو النور الذي وعد الله جل وعلا، ووعد به الرسول، عليه الصلاة والسلام، الذي أخذ بيد الإنسان في آخر الزمان؛ نجا من فتن آخر الزمان..
كل مرة حينما أصل إلى نتيجة فاشلة أرجع إلى دراسة تلك العلامات التي هي في ذلك النور، فأكتشف أن ذلك النور ليس بنور حقيقي وإنما هو يشبه النور؛ أي منعكس عن النور الحق الذي أبحث عنه ولكن ليس هو إياه[45]."
إن دلالة النور في النص تعكس حقيقة الرسائل القرآنية والكلمات النبوية باعتبارهما وحيا، وطبيعة الوحي أنه نور وبرهان وشعاعات بلورية تخرق ظلمات الشرك والوثنية والأخلاق الفاسدة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (النساء: 173)، والنور والبرهان لا يحتاجان إلى دليل، ولا إلى ترتيب قواعد نظرية واستدلالات فلسفية ومنطقية لإثباتهما، ولا إلى تتبع دفائن المعاملات الإنسانية والطبائع العمرانية لاكتشافهما، بل وضوحهما متدفق كتدفق النهار: وهل يحتاج النهار إلى دليل؟!
إذن، لابد أن يكون صاحب العلامات من طبيعة ذلك النور ووُرَّاثِه، نوره يسعى بين يديه وبيمينه، لأنه قبس من مشكاة الوحي لا تخبو شعلته ولا تنطفئ جذوته؛ "كلماته تتنزل على الأرض مثل الغيث، مثل المطر، فتنبت الأشجار، والخضرة والأزهار... الكلمات الحقة؛ إذا تليت بحق تنبت العمران، تنبت الإنسان...[46]."
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الاستعمال المكثف الموزع للفظة "نور" ومشتقاتها يبقى دالا على فوران روح الأستاذ بأسرار القرآن، وتفطر قلبه بفجر اليقين، والتهاب وجدانه بأفكار التوحيد وأسرار العقيدة؛ إذ كان يروم إيقاظ هوامد الأفكار وبعث الحياة في موات النفوس الذي كانت تجسده الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والثقافية السائدة في مناحي البلاد. فالنور يدل بدلالته الرمزية المعاكسة على وجود الظلمة المفهومة من نظم الكلام وتراص الجمل ومن الصورة الخارجية للعصر المعاش آنئذ.
فكان هذا التوظيف للمادة المتدافع في النص يشي، ولابد، بقصة الانعتاق التي كانت تستولي على مخيال ووجدان شيخنا، بسبب رحيل ربيع الأخلاق وزينة أفعال المكلفين واسترسال ذلك الظلام المركب ظلام الغربة بسبب مشكلة الأخلاق وانحطاط التدين/ظلام الغربة بسبب اضطراب النفس اللاهثة وراء أطياف الحق الغائب لإصلاح الوقت وواجباته.
وبالنسبة لوضعي الروحي والنفسي، يسترسل الأنصاري: "أحسست تماما كما يحس ذلك الذي كان يبحث عن والده من بعد ما فقده... حوالي عشرين سنة (...) وذكرت كم هي النعمة عظيمة من الله، جل وعلا، على هذا الشعب التركي الذي سخر الله له والدا روحيا فعلا يخرجه من الظلمات إلى النور[47]."
ترى: هل كانت حقا اضطرابات الهوية عند المسلمين المشتعلة في باطنه؛ هي التي جعلته على صلة أشد ما تكون استفزازا مع المحيط والمسلمات والأصحاب فاختار الرحيل إلى وارث السر؟ أم أن البواعث كانت باطنية والأعراض الخارجية إنما كانت صدىً ينبئ عما في كيانه من استعدادات للموهبة، صارت تنتظر أجلها لتشخصها الإرادة القدرية في الخارج، فتكون إيذانا بتجديد الدين وعودة الصالحين؟!
التصوير الفني عند الأنصاري
1. التخييل الحسي
هو التعبير بالصورة المُحَسَّة المتخيلة عن المعنى الذهني المجرد. فالأنصاري ما فتئ يستجمع قواه الذهنية في مخيلته مستغلا كنز الموهبة الذوقية فيه والإبداعية ثم يقذف بالفكرة مسددة، عبر قنوات إحساسية تنساب بلطف وقبول إلى قرار المتلقي، فتأخذ منزلتها في فؤاده. يقول في فرسان الأناضول: "لولا أني رأيتهم لقلت إنه مجرد وهم أو هراء أو خيال (...) من بلاد الأناضول تشرق شمسهم، ثم تتدفق أشعتها نحو كل العالم خيوطا بلورية وهاجة، تصل الأرحام القديمة وتذكي الحنين الجريح... مهاجرون؛ تركوا خلفهم كل شيء وانطلقوا كالخيول العارية، يفتحون الأبواب والنوافذ للمحاصرين في كل بقاع الأرض، ويعلمونهم كيف يستنشقون من جديد هواء الفضاء الفسيح، بعدما فقدوا إحساسهم بالحياة منذ قرون[48]."
هناك لقطات حية ومشاهد متناسقة تحسها النفس وتتصورها حركة دائبة في الواقع. فالأنصاري يزرع من روحه وتأوهاته وخواطره وخلجاته في قوالب الألفاظ ما إذا شُخِّصَ؛ لصار مقاطعَ وصورا وأشرطة حية واقعية. وهو لا يعبر إلا عن شيء حي أو ذات حية، كأنما ألفاظه في النظم مغامرات بطولية لكنها مستوحاة من القصة الواقعية وليست من الأسطورة أو الخرافة...
إن تقنية الفرشاة المستعملة تتحرك في تساوق مستمر مع أنين الروح، فهي لا ترسم ألوانا مجردة ولا خطوطا جامدة فارغة؛ بل مشاهدَ مقياسُ أبعادها المشاعرُ والإحساسات الإنسانية التي يراد لها التفاعل مع الموقف، ليس كما عند الشكلانيين والإحساسيين الذين يعتبرون الفن والتصوير قوالب لنقل الإحساس بالأشياء كما تدرك فقط وليس كما تعرف![49]. وإنما الأمر هنا غير ذلك؛ إذ لواقع الذات وحركية الحدث سلطتهما في قولبة الألفاظ ونسجها على منوال ما تزخر به الروح من إعجاب وتفاعل "مجانين..! يعشقون الخدمة اغترابا (...) يبتسمون للسع الآلام، ويسعدون بعبور حقول الشوك الجارح فتسيل الدماء من أقدامهم، وتسيل الدموع من عيونهم والقلب مسرور بالله.
رجال لو تحدث عنهم كتاب قديم لقلنا؛ إنها مبالغة من مبالغات كتب القصص والطبقات والمناقب... لكنهم يعيشون الآن (...) جمعوا أخلاق الخير والفضيلة كلها، نظرة واحدة فيهم تغنيك عن قراءة كتب الفلسفة والأخلاق وخيالات المدينة الفاضلة[50]."
نصوصه تشف عن صور ومشاهد، وألفاظه تلوينات بلاغية تصور معانيها وتجعلها أقرب إلى خيال المتلقي، بمثابة مسلاط عاكس للصور على الشاشة. ومن هنا كان حقا التصوير الفني خاصية القرآن[51]، وللأنصاري أسلوبه القرآني المتميز الذي لا يجارى. يقول في مستشفى "سماء": "بل إنني رأيت، وأنا أحد نزلائه لفترات عديدة، النور يفيض بقوة من شرفاته ونوافذه، فيمتد كغدران الكوثر ليروي الأحياء المجاورة له، بل ليروي مدينة اسطنبول بأكملها ولم لا بلاد الأناضول جميعا. والسر في ذلك أن الحب الذي تتدفق جداوله من قلوب طاقمه الإداري والطبي والتمريضي لا يقف عند حدود بناية المستشفى، ومن ذا قدير على جعل السدود للحب والجمال إذا تدفقت أنهارهما (...)!
إنها لغة الإخلاص، هذه اللغة التي لا يتقنها إلا من تعلم بمدراس الروح، وأدلج بناشئة الليل الساجي، ورتل بوجدانه الجريح أحزان المستضعفين ترتيلا!"[52]. وهل من مريض يسمع هذا الكلام فلا تعتنقه نشوة وحشية للتحليق إلى هؤلاء؟!
إن الأمر لا يقف عند حد التشبيه والاستعارة والمجاز وغيرها من أساليب البيان، بل يتجاوزها لتتخذ عند الأنصاري قوانين ووسائل لرسم الصور والمشاهد... وكم شهد البيان من جمال وإبداع عند عبد القاهر الجرجاني وسيد قطب لتحويمهما على هذه الخاصية بالذات؛ خاصية التصوير في النظم.
وتمضي الحكاية عن هؤلاء الفرسان مستوعبة كل ما تزخر به ذهنية السارد من فنون وعلوم... ومن أشياء أخرى أهمها ما يلي:
2. الحيز والحركة والمساحة
كلما تلفظ الأنصاري واسترسل في الخطاب إلا وتجد في نظم كلامه حركة واستغلال للفضاء والحيز الذي كأنما يتحرك فيه هو لا ألفاظه، وينظر إلى الأمكنة والمقامات فيوسع من مساحتها بحسب كل لقطة من لقطات الشريط الذي يرتبه في ذهنه ومخيلته مثل ترتيب "المونتاج" للفيلم قبل القذف به إلى الخارج، مما يجعل القارئ تحت أسر الخطاب؛ تروعه مقاطع الشريط كلما استرسل في تتبعها؛
يقول: "فأن يترك الفتى حياة الراحة والدعة وبريق المدينة الجذاب، ثم يضرب في الأرض ليغوص في غربة بعيدة، يحمل في يده قنديلا من نور بحثا عن المستضعفين في بقاع الأرض، من أجل إطعامهم جرعة من رحيق الحياة؛ (...)[53]."
ثم يسترسل "من بلاد الأناضول تشرق شمسهم، ثم تتدفق أشعتها نحو كل العالم (...) كانت جحافلهم تتفرق في الصحارى والجبال والأدغال والمحيطات... وقد تكبو فرس هنا أو هناك، ولكن الطليعة أبدا تصل إلى غايتها، وترفع راية النور فوق أعلي القمم الشامخة، فيشمخ الدين بهم ويعتز[54]". "مجانين.. يعشقون الخدمة اغترابا من قرِّ سيبريا إلى حر جنوب إفريقيا، ولا تركوا جزيرة أو مغارة أو سهلا أو جبلا من كل قارات العالم إلا دخلوه ووزعوا فيه شعاعات الصبح القريب[55]."
فبأقل الألفاظ والدوال يشكل الفنان مساحة واسعة لعقد تواصل كافٍ مع المتلقي، وربط روحه إلى روحه، شأن عالمنا، لأن كلامه، قلبي "والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب[56]" على حد تعبير شيخه الشاطبي[57]. والأنصاري مريد بار بشيخه في كل شيء... كما ترى.
"معلمون انتشروا في كل مكان يعلمون أطفال العالم منطق الطير وتراتيل العصافير (...) فلطالما حملت بأجنحتها طلائعهم وهي تضرب في الأرض نحو غابات أستراليا أو صحارى آسيا أو أدغال إفريقيا أو نحو ضباب الغرب البعيد... ليطلقوا شعاع النور من فوق ناطحات السحاب![58]."
أرأيت كيف يرتب مقاطع الكلام ترتيب الشريط السينمائي فتأتي اللقطة في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب من خلال المشهد المناسب لتوصيل المطلوب وتحقيق البغية، فضلا عن استغلال الحيز المناسب للتسديد الهادف.
ما ترك مكانا معهودا على البسيطة إلا وأسنده إلى الفعل التنويري لدى هؤلاء، وأفرغ الإسناد في هيكل لفظي ودوال هي نسخة نورانية من ذلك الفعل تضرب في عمق الجاذبية في ذوق الناظر. (بلاد الأناضول، بقاع الأرض، الانتشار في كل مكان، غابات أستراليا، صحاري آسيا، أدغال إفريقيا، ضباب الغرب البعيد، قرّ سيبريا، حرّ جنوب إفريقيا، جزيرة، مغارة، سهل، جبل، قارات العالم، الصحارى والجبال والأدغال والمحيطات، أعالي القمم الشامخة، كل العالم..).
لتنتهي الحكاية عند وصول الجحافل إلى مكانهم الموعود المقصود من المغامرة، إنه مكان توزيع النور من فوق، المخترق ظلمات تلك المناكب "(...) ليطلقوا شعاع النور من فوق ناطحات السحاب"! ولما كانت طبيعة هذا النور أنه آتٍ من السماء؛ لم يصلح له سوى أعلى قمة سماوية مشرفة على جميع تلك الأماكن والبقاع "من فوق ناطحات السحاب"!.. هكذا. إنها رمز لحاكمية الوحي؛ حاكمية لا ترضى بغير العلو العالي والشرف السامي مكانا تنظر منه وتوزع شعاعاتها الوهاجة...
3. الضوء واللمعان
بمجرد مسٍّ عابر لكلمته وما أن يلمس المتصفح زهرة من رياض بيانه المتضوع؛ حتى تهزه صعقات كهربائية وتبرق في خياله موجات ضوئية تسري في كل ذاته سريان الدم في العروق، ليس لقوة جاذبية الأسلوب في توظيف العبارة أو الكلمة في النسق؛ ولكن علاوة على ذلك لمادتهما النورانية المشحونة بخزان من الوقود الضوئي القابل للاشتعال عند كل جس نبضٍ أو محاولةٍ لقدح الزناد...
بهذا تقر أدبية الأنصاري الشعرية وتعترف مشاعره الوجدانية وروحه المنزعجة الباحثة عن قنديل أينما حلت وارتحلت يقشع سحب الظلمات المتراكمة من جميع النواحي دخانا عارما يغطي السماء ويعم الأرض... "عندما حل عصر الظلمات؛ كانت اسطنبول في حاجة إلى شهقة من نور (...) هناك على شاطئ البوسفور (...) قذف فتح الله شهقة النور الأولى في عصر الظلمات الأخير؛ فإذا بالنوارس تتلقف وميضها لهبا يهيج أحزان التاريخ"[59] "(...) وارتدت الخفافيش إلى جحورها مذعورة من تدفق النور"[60].
فهذا النور الذي يشكل دائرة حراك الروح الأنصارية، كما أشير سابقا، هو الذي نفث أشعة الضوء واللمعان والجمال في الأشياء، فصارت مخيلة الأنصاري تتغزل بها ليس تغزلا أدبيا حسيا لفظيا فقط، ولكن حبا يخترق خواطر الشعور وحظيرة الوجدان وينعكس على الكلمات والرسائل فتزداد تألقا وتنمقا...
ومن هنا طفق فناننا يستقطب الموجودات وعناصر الكون التي يبدو ظاهرا عليها تجليات النور، لتركيب شِيَاتِهِ ورسم لوحاته رسما تتناغم فيه الأشياء مع وظائفها وتتواصل أشباحها مع أرواحها من غير تفكيك أو تغيير، كما في مخلوقات (الشمس، والمرجان، واللؤلؤ، والشعاع، والأقمار، والأنجم، والصباح، والأبصار، والثلوج..،) وغيرها مما يضيء بنفسه أو ينعكس عليه الضوء واللمعان من غيره. يقول في قصيدة "البحث عن فرس اسطنبول":
فأينها التي كانت هنا؟
(...)
كأنما امتطت شعاع الشمس ثم غربت!
(...)
يا سيدي البوسفور!
(...)
أقسمت أن تضمني إليك مرجانة من نور
أو صدفة تخرج من لؤلئها
(...)
أكلما التقطت من أخبارها خيط السنا؛
خطفه الظلام...؟!
(...)
وقيل لي: بل غادرت إلى غروب الدردنيل
حيث الشموس لا تنام أبدا...!
وإنني أذكر من غرامها حب الشعاع!
فلم تزل تقطف من سنائه ورد الصباح!
(...)
تشهد ذوب الشمس في بحيرة الأسرار!
على سنا الأقمار
(...)
يا سيدي الإمام دلني
فإنني أنا الحيران بين أنجم السفر...!
المخلوقات كائنات نورانية تلمع بالنور ولاسيما تلك التي برأها ربها في هيئته وطبعها بمادته ورسمها على شاكلته، فهي تضيء للأنصاري الطريق أو تساعده على اكتشاف ذاته بين دفائن الأسرار التي قد لفها الإبهام بجلبابه، وانسدل على مسرحها الستار فأظلمت ولم تنفرج...!
لكن لصبح الفرج ميعاد وميقات، ولفجر الحقيقة بعد انسدال الظلام إشراق، ولشمس النصر بعد الغروب إسفار... الإيمان ينفث في روع المؤمن؛ أن استرسال الظلام والسواد في مقابل نور الأمل وجمال الأنس بالله؛ إنما هو طيف عابر، هو في عقيدة المسلم؛ ما أشبهه بالزوال الذي ينصب في الحقول لإخافة الطيور!
رحم الله أبا أيوب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه بفضله ومنه وكرمه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الهوامش
* من كلام فرنسوا ريكار في رواية "الخلود" للعملاق التشيكي ميلان كونديرا...
[1] . أخرجه البخاري.
[2] . فريد الأنصاري، رجال ولا كأي رجال، دار النيل التركية، ط1، 2013م، ص32-33.
[3] . المرجع نفسه، ص33.
[4] . فريد الأنصاري، رواية: عودة الفرسان سيرة محمد فتح الله كولن رائد الفرسان القادمين من وراء الغيب، دار النيل، ط1، 2010م.
[5] . فريد الأنصاري، رواية: آخر الفرسان، دار النيل، ط2، 2010م.
[6] . فريد الأنصاري، رجال ولا كأي رجال، م، س، ص237.
[7] . الرجع نفسه، ص240.
[8] . المرجع نفسه، ص230.
[9] . أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: الشيخ عبد الله دراز، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2001، 1/89.
[10] . رواه أحمد.
[11] . المرجع نفسه، ص232.
[12] . المرجع نفسه، ص232.
[13] . المرجع نفسه، ص150.
[14] . المرجع نفسه، ص148.
[15] . المرجع نفسه.
[16] . المرجع نفسه، ص160.
[17] . المرجع نفسه، ص160-161.
[18] . المرجع نفسه، ص157.
[19] . المرجع نفسه، ص158.
[20]. محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث بمصر، ط1، (1413ﻫ/1993م)، 1/01.
[21] . المرجع نفسه، ص150.
[22] . سعيد النورسي، الشعاعات من "كليات رسائل النور"، طبع شركة سوزلر للنشر القاهرة، ط4، 2005م، ص11.
[23] . فريد الأنصاري، رجال ولا كأي رجال، م، س، ص151.
[24] . الموافقات، مصدر سابق، ص2/107.
[25] . رجال، م، س، ص151-152.
[26] . المرجع نفسه، ص153.
[27] .ابن القيم، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 1983م، ص55.
[28] . فريد الأنصاري، رجال ولا كأي رجال، م، س، ص101.
[29] . المرجع نفسه، ص102.
[30] . المرجع نفسه، ص103.
[31] . المرجع نفسه، ص104.
[32] . المرجع نفسه.
[33] . المرجع نفسه، ص111.
[34] . المرجع نفسه، ص110.
[35] . المرجع نفسه، ص112.
[36] . المرجع نفسه، ص178.
[37] . المرجع نفسه، ص180.
[38] . المرجع نفسه، ص183
[39] . المرجع نفسه.
[40] . المرجع نفسه، ص184.
[41]. فريد الأنصاري، الفطرية بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام، القاهرة: دار السلام، ط1، 2009م.
[42]. ضميمة اصطلاحية صناعية من وضعه يقصد بها كما قال:" فتح صالون البيت للأحباب والأصحاب من أجل الغاية نفسها، وهي تدارس القرآن الكريم، وتدبره، والإنصات إلى حقائقه وحِكَمِه وهذا أفضل ما يجتمع عليه الناس من الخير؛ لأن به تتكون الشخصية الإسلامية المتماسكة على المستويين: النفسي والاجتماعي، وبه يحصل "التعارف" بمعناه القرآني الذي يبني الثقة بين الناس؛ قصد التواصل العمراني، وربط العلاقات الاجتماعية، القائمة على التعاطف والتواد والتراحم، مما يعطي للحياة داخل المجتمع الإسلامي معنى جميلا" فريد الأنصاري، مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى من التلقي إلى البلاغ، دار السلام للطباعة والنشر و التوزيع، ط2، 2010م، ص53.
[43] . فريد الأنصاري، رجال ولا كأي رجال، م، س، ص52.
[44] . سليمان عشراتي، جمالية التشكيل الفني في رسائل النور، دار النيل، ط1، 2005م، ص60.
[45] . فريد الأنصاري، رجال ولا كأي رجال، م، س، ص51.
[46] . المرجع نفسه، ص59.
[47] . المرجع نفسه، ص64-65.
[48] . المرجع نفسه، ص22.
[49] . محمد مريني، سيميولوجية القراءة، مطبعة الجسور 40، وجدة المغرب، 2007م، ص36.
[50] . رجال، م، س، ص23.
[51] . سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق بمصر، ط.17، 2004م، ص36.
[52] . رجال، م، س، ص27.
[53] . المرجع نفسه، ص22.
[54] . المرجع نفسه، ص22-23.
[55] . المرجع نفسه، ص23.
[56] . الموافقات، م، س، 4/199.
[57] . المرجع نفسه، ص25.
[58] . المرجع نفسه.
[59] . المرجع نفسه، ص34-35
[60] . المرجع نفسه، ص37.