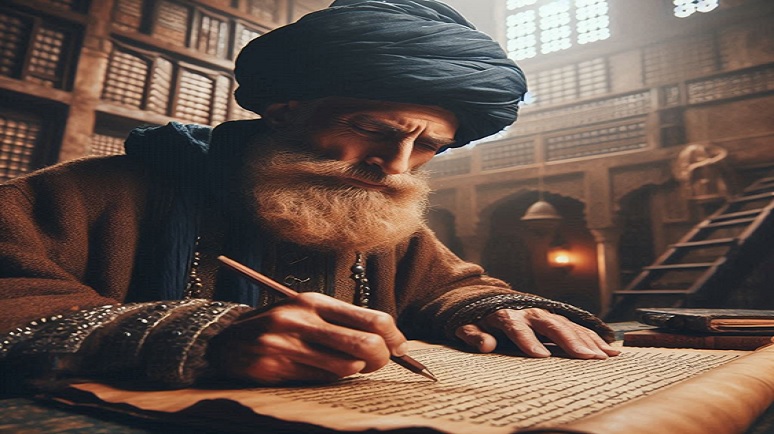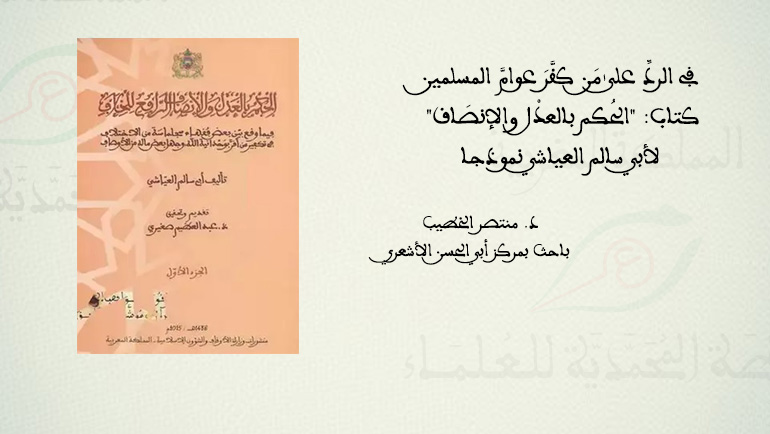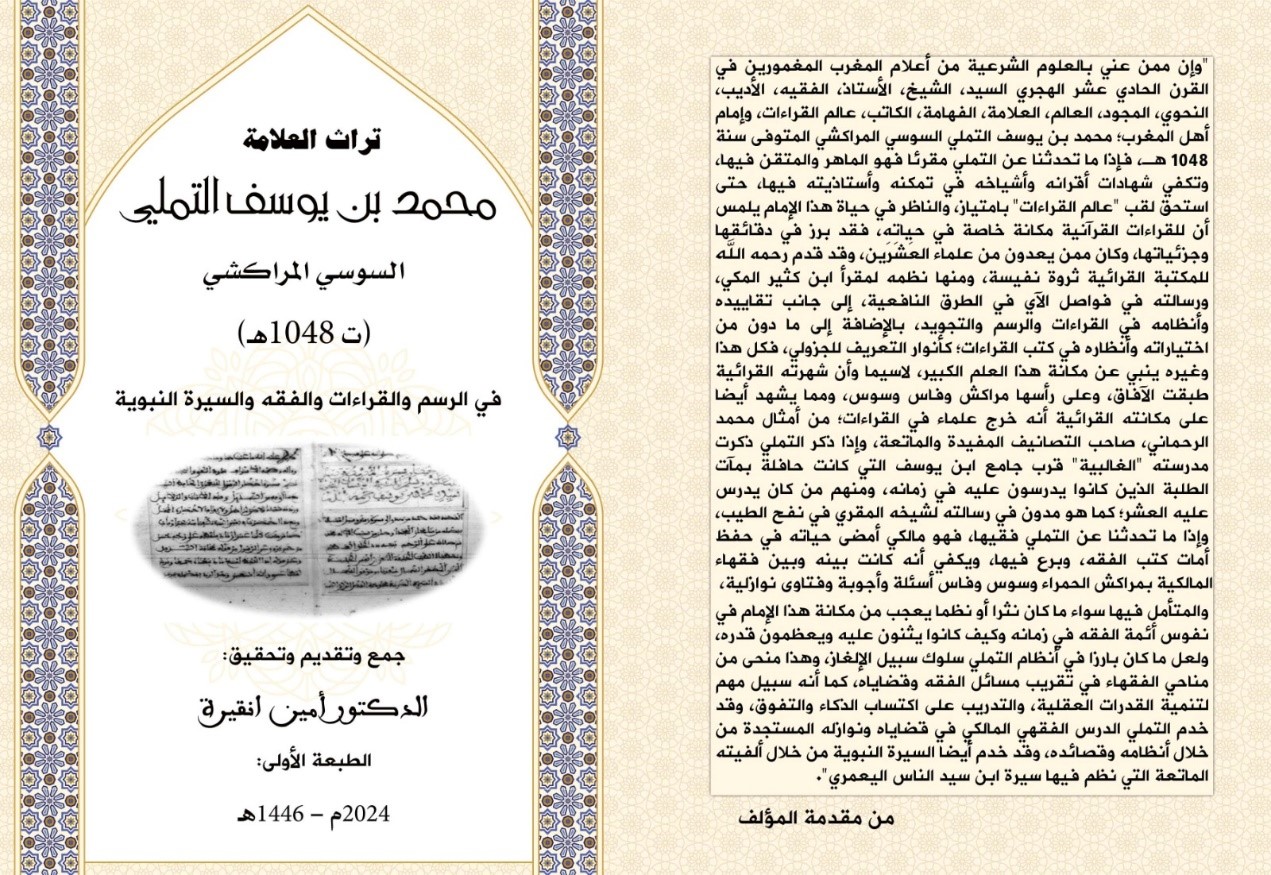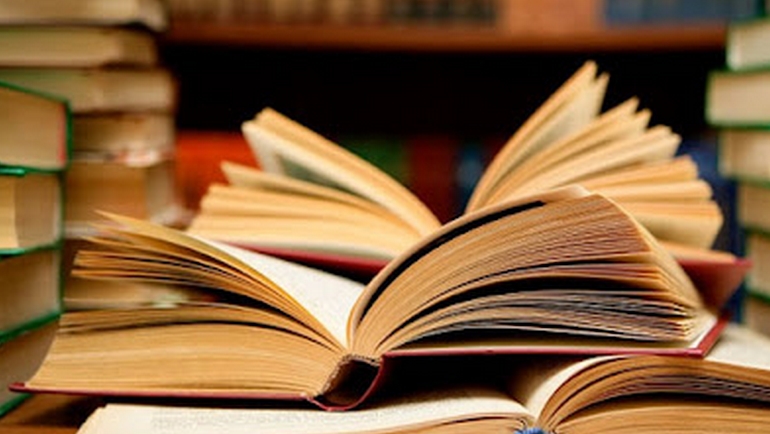أسْرارُ البَيَان في القُرآنِ(40) البَيانُ في صيغَةِ المبَالغةِ (كَفَّار) في قولهِ تعَالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾
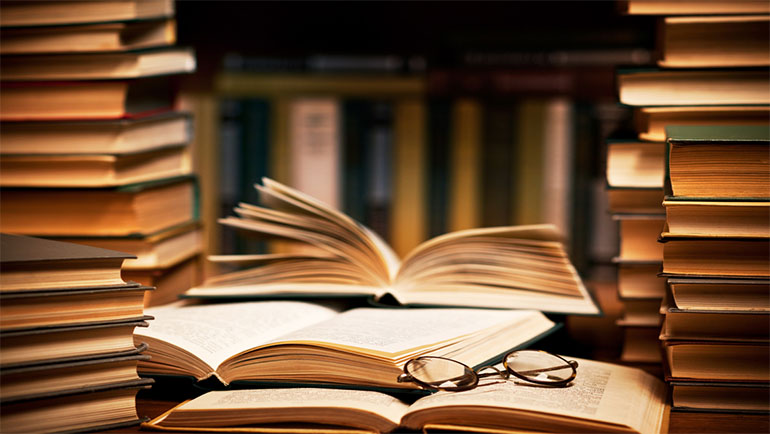
وذلكَ قولهُ تعالَى في سورَةِ (إبْراهِيم) ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار﴾؛ حيثُ جاءَ وصفُ الإنسَانِ بصفَتَي الظُّلْم والكُفْر، وأَخرَج الخطابُ الوَصفَيْن كِلَيْهما علَى صيغَة المبالغَة: (ظَلُوم = فَعُول) و(كَفَّار= فَعَّال). وقدْ وردَتِ الصِّيغةُ الأولَى (ظَلُوم) في القُرآن مرَّتيْن؛ في هَذه الآيَةِ، وفي سُورَة (الأَحْزاب)، في قَولهِ تعالَى عنِ الإنسَان وَقَدْ حَمَل الأمانَةَ: ﴿إِنَّهُ كاَنَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾. وأمّا الصِّيغةُ الثَّانيَة (كَفَّار)، فقدْ ورَدتْ في القُرآن خمْسَ مرّاتٍ، آخرُهَا في سُورَةِ (نُوح): ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً﴾.
ويَستلفِتُ انتبَاهَكَ قُوّةُ الخطابِ في عِبارَةٍ تَبدُو مُكَوّنةً منْ أربَع كلمَاتٍ: (إِنَّ الانسَانَ لَظلُومٌ كَفَّارٌ)؛ فَإضافةً إلَى أَثَر صِيغَتَــيِ المبَالغَة في تَقويَة المعْنَى، اجْتمعَ فيهَا تَوكيدَانِ: حرفُ التَّوكيدِ (إِنَّ) الّتي تَصدَّرَتْـها، ثمَّ تلكَ اللَّام المعرُوفةُ بِاسْمِ (اللّام الْـمُزَحْلَقَة)، وهيَ في أصْلِها (لامُ الابْتِداءِ)، وتُفيدُ التّوكيدَ، وتَأتي في صَدرِ الجُملَة. لكنْ معَ دُخول (إِنّ) الّتي تَصدَّرَتْ، نُقلَت (اللّام) إلَى الخَبَـر، وذلكَ كَراهَة أنْ يَجتَمعَ في ابْتِداءِ الجملَة تَوكيدَان. تَقُول مَثلاً: (لَلصِّدْقُ أَفْلَحُ لكَ)، فإذَا أَدخَلتَ (إنَّ)، نَقلتَ (اللّامَ) منَ المبتَدأ إلَى الخَبَر، فقلتَ: (إِنَّ الصِّدْقَ لَأَفْلَحُ لكَ). قالَ تعالَى: ﴿وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذينَ يَتَّقُونَ﴾. فَتصدّرَت (اللّام) الكَلَام : (وَلَلدّارُ الآخرَةُ). لكنْ في قولهِ عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، تَغيّرَت الرُّتَب، فَقدْ تَصدَّرَت (إِنَّ)، ونُقِلَت -أَو لِنَقُلْ زُحْلِقَت- (اللّام) إلَى الخَبَر: (لَهِــيَ الحَيوَانُ)، وكأنَّ الأصلَ كانَ قبلَ دُخُول (إنّ): (وَلَلدَّارُ الآخرَةُ هِــيَ الحَيوَانُ). فَتدبّرْ هذَا التَّكثيفَ التّوكيدِيّ الَّذي رَفعَ المعنَى إلَى غايَةٍ أَبعَدَ في التَّقويَةِ، وإصَابَة المعْنَى.
فإذا نحنُ أَوْلَيْنا صِيغتَي المبالَغةِ في الآيَة، فَضْلَ نَظرٍ وتَدبُّرٍ، بِناءً علَى مُقتَضَى أنَّ منْ أسْرارِ العَربيّة، اعْتِبار أنّ صيَغ المبالغَة علَى اخْتلافِها، تَتفاوَتُ في الدّلالَة علَى المبَالغَة، قُوَّةً وضُعفاً، شِدَّةً ولُطفاً، بحُكْم القَاعدَة المشْهُورَة: الزِّيَادَةُ في الْـمَبنَى تُؤَدّي إلَى زيَادةٍ في الْـمَعنَى؛ فأنتَ إذا وَازنتَ كلمةَ (ظَلُوم)، بكلمَة (كَفَّار)، منْ حيثُ بنَاؤُها الصَّرفيّ، وتَنسيقُها الصَّوتيّ، أدركتَ أنّ الصيغةَ الثّانيَة: (كَفَّار) بالتَّضعيفِ الذي فيهَا علَى(الفَاء) الْـمَفتوحَة، ثُمّ تلكَ الاسْتطالَة في فَتحَتِها بالأَلفِ الوَاسعَة الْـمُمتدّة، كلُّ ذلكَ يَزيدُ المعنَى قُوَّةً وشِدّةً، بخلافِ الصّيغَة الأولَى: (ظَلُوم)، والّتي تَجدُ الوَاوَ فيهَا معَ الضّمّةِ، في انْغلاقِها وانْسِدادِ الأفُق فيهَا، تَجعَل المعنَى فيهَا أَضعَفَ في المبالغَة وأقلَّ قوّةً. وقدْ أشارَ إلى ذلكَ (أبو هلالٍ العَسكريّ) في (الفُرُوق اللّغويّة) حيثُ قالَ عن اخْتلافِ صيَغ المبالَغةِ: «وَمَنْ لَا يَتَحَقَّقُ الْـمَعَانِي يَظُنّ أَنّ ذَلِكَ كُلَّه يُفِيدُ الْـمُبَالغَة فَقَطْ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كذَلكَ، بَلْ هِيَ مَعَ إِفَادَتهَا الْـمُبَالغَةَ، تُفِيدُ الْـمَعَانِي الَّتِي ذَكَرنَاهَا». ومنَ النَّحويّينَ الَّذينَ أَدرَكُوا هذَا الفرْقَ، وأَلـمَحُوا إلَيهِ (أبُو الْعِرفَان مُحَمّد الصَّبّان) في (حَاشيَتهِ علَى شَرحِ الأَشمُونيّ)، فقدْ قالَ: «وَقَدْ يُؤخَذُ منْ قَولِهِمْ: زِيَادَةُ البِنَاءِ تَدُلُّ علَى زِيادَة الْـمَعنَى، أَبْلَغِيَّةُ (فَعَّال) و(مِفْعَال) علَى (فَعُول) و(فَعِيل)، وَأَبْلَغِيَّةُ هَذَيْنِ عَلَى (فَعِل)، فَتَدَبّرْ». وقدْ فصَّلَ في تلكَ المعَاني (أبُو حيَّان الأندَلسيّ) في (ارْتشَاف الضَّرَب)، حيثُ قالَ: «هَذهِ الْـمُثُل تَتفَاوَتُ في المبالَغَة، فـــ(ضَرُوب) لمنْ كثُر منهُ الضّربُ، و (فَعَّال) لمنْ صارَ لهُ كالصِّنَاعَة، و(مِفْعَال) لمنْ صارَ لهُ كالآلَةِ، و(فَعِيل) لمنْ صارَ لهُ كالعَطيَّة والطَّبيعَة، و(فَعِل) لمنْ صارَ لهُ كالعَاهَةِ».
ومَا ذَهبُوا إليهِ، يَكادُ لا يُغفِلهُ النَّظَر، في مَبان أُخرَى كَالأفْعَال، تَماماً كمَا تجدُ ذلكَ جليّاً في الفَرقِ بينَ (حَرَقَ وحَرَّقَ) و(قَطَعَ وقَطَّعَ)، ففي قَولهِ تعالَى في سُورةِ (الأنْبِـيَاء): ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾، تكادُ تلكَ (الشَّدّةُ) علَى (الرَّاء)، تُفصِحُ عنِ الحَرقِ الشُّدَّاد، الّذي يَبلغُ الغايَةَ في الشِّدّة وَمَحْو الأَثَر. وتأمَّلْ قولهُ تعالَى في سُورَة (يُوسُف): ﴿قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾، كيفَ رفَعَ التَّضعيفُ قُوّةَ الفعْل (قَطَّعَ)، وكأنّهُ يتكَرَّر مُمتدّاً في اشْتدَادٍ. وانْظُرْ إلَى نَفسِ الفعلِ في قولهِ تعالَى في سُورَة (الحَشْر): ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا عَلَى أُصُولِهَا﴾. كيفَ يبدُو الفعْلُ علَى طبيعَةِ مَعناهُ الَّذي وُضعَ لَهُ.
كلُّ ذلكَ جعلَ هذهِ الآيَة علَى وجهٍ منَ التَّعبير بَديعٍ، يُخفِي لَطيفةً بَيانيّةً مُبهرَة. فالظُّلمُ في الغالِبِ الأعَمّ، يُوقعُهُ الإنسَانُ إمَّا بِنَفسهِ وإمَّا بِغيرهِ. لكنَّ الكُفرَ، في غَالبهِ الأعَمّ، هوَ منَ الإنسانِ نحوَ ربِّهِ، فهوَ مِنهُ كُفْرٌ بهِ، بآيَاتهِ ونعَمهِ. فإذَا أنتَ نظرتَ إلى الظُّلمِ منْ حيثُ علاقةُ الإنسَانِ بغَيرهِ، ونظرْتَ إلَى الكُفرِ من حيثُ علاقةُ الإنسَانِ بِربّهِ، يَتبيَّنُ لكَ، أنَّ ظُلمَ النّاسِ بَعضِهِمْ بعْضاً، ليسَ مُطلقاً، بلْ هوَ مَشرُوطٌ بالقُدرَةِ والقُوَّة، فالعَاجزُ الضّعيفُ لا يَظلمُ، ليسَ لعِفّتهِ، وإنَّما لِانْتفاءِ القُدرَة عنهُ، فهُوَ كمَا قالَ (الْـمُتَنبّي):
وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ
ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ
فالظّلمُ في النّاس مُقيّدٌ مَحصورٌ، لا يَمتَدُّ ولَا يَنطَلقُ إلّا إذَا تَهيّأت لهُ شُروط ذلكَ، منْ قُوّةٍ وقُدْرةٍ.
وأمّا كُفرُ الإنسانِ في عَلاقتهِ بربِّهِ، فهُوَ كُفرٌ مُطلَقٌ، غيرُ مَشروطٍ بالقُدرَةِ ولَا بالقُوّةِ؛ فَجُرأَةُ الإنسَانِ عَلى رَبّهِ، لحِلمِهِ عنهُ وإمْهَالهِ وإمْلائِه، أَكبرُ منْ جُرأتِهِ علَى النَّاسِ، لما يَخشَى من أَليمِ بأسِهِم ونَكالِ أَذيَّتهِم. قالَ تعَالى ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ﴾، وقالَ عنهُم: ﴿يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾. ويَتكرّرُ ذلكَ الكُفْر منَ الإنسانِ وَقتاً بَعدَ وقْتٍ، ويَتوَالَى حَالاً تِلوَ حالٍ، حَتّى يَصيرَ ذلكَ منهُ كالحِرْفَةِ والصَّنْعَةِ؛ لذَلكَ جاءَتِ الصِّفةُ (كَفَّار) علَى زِنَة الحِرْفَة: (نَجَّار وَلَبّان وبَنَّاء...). فلمّا كانَ الْـمُحتَرف لهذهِ الأعمَال يُزَاولُها ويُداومُ عَليْـها، صارَ هذَا الوَزنُ دَالًّا علَى ذلكَ.
فإذَا نُقلتْ هذهِ الدّلالةُ إلَى الصِّفَات قلتَ مَثلاً: (كَذَّاب)؛ فَكأنّمَا هوَ شَخصٌ حِرْفَتُهُ وصناعَتهُ الكَذِب. فكذَلكَ (كَفَّار)، لاشْتِغالهِ بالكُفْر وَعُكوفهِ عَليهِ، صارَ كَمَن اتَّخذَ ذلكَ حِرفةً لهُ، يعكُفُ علَيها ويُزاولُها. قالَ (فَاضِل السَّامرّائي) في (مَعاني الأبْنِيَة) عَن صِيغَة (فَعَّال): «وهذَا البناءُ يَقتَضي المزاوَلةَ والتّجديدَ، لأنّ صاحبَ الصّنعَة مُداومٌ علَى صَنعتهِ مُلازمٌ لهَا. فَعندَما تَقولُ: ( هُوَ كَذَّابٌ)، كانَ المعنَى كأنّمَا هوَ شَخصٌ حِرفتهُ الكذبُ، وهوَ مُداومٌ علَى هَذهِ الصّنعَة، كَثيرُ المعَاناةِ لهَا، مُستَمرٌّ علَى ذلكَ لَمْ ينقَطعْ».
وهَكذا فَالإنسانُ ظَلُومٌ لغَيرهِ، إذَا قَدَر. لكنَّهُ كَفَّارٌ مُبالغٌ في الكُفْر لِربِّهِ، سواءٌ أَعَجزَ أمْ قَدَر، أَكانَ ضَعيفاً أمْ قَويّاً، فهُوَ أَسرَعُ إلى الكُفْر منهُ إلى الظُّلمِ. إنّهُ (ظَلُومٌ) فَبالِغٌ ظُلْمُهُ، لكنَّهُ (كَفَّارٌ) فَهوَ أبْلغُ منهُ في كُفْرهِ. ولعلّكَ علَى هذَا يُمكنُ أنْ تَخلُص إلَى أنَّ الكُفرَ في الإنسَانِ أَظهَرُ فيهِ منَ الظّلمِ، لأنّهُ أَهوَنُ عَليهِ، لجُرأَتهِ علَى ربّهِ. فالكُفرُ بذَلكَ أعمُّ منَ الظُّلمِ؛ فكُلُّ كَافرٍ ظَالمٌ، وَليسَ كُلُّ ظَالمٍ كَافراً.
وإنّك، باسْتقرَاءٍ سَريعٍ، لَتجدُ أنّ الجذرَ (كفر)، ومَا اشتُقَّ منهُ في القُرآنِ، أكثَرُ وُرُوداً منَ الجذْرِ (ظلم) ومُشتَقّاتهِ. فعَسَى أنْ يَكونَ التَّعبيرُ عنِ (الكُفْر) بِصيغَةِ المبَالغةِ (فَعَّال = كَفَّار)، وعنِ (الظُّلمِ) بصِيغَة المبالغَة (فَعُول = ظَلُوم)، فيهِ دَلالةٌ علَى هذَا التَّفاوُت، فبعضُ الصِّيَغ في المبالغَةِ أشَدُّ منْ بَعضٍ. يَقولُ (أَبو الفَتح بنُ جِنِّـــي - تـــــ :392ه)، في(الخَصائِص): «وَذَلكَ أَنّكَ في المبالغَةِ لا بُدَّ أَنْ تَتْــرُكَ مَوضعاً إلَى مَوضِعٍ، إمّا لَفظاً إلى لَفظٍ، وإمّا جِنساً إلَى جِنسٍ، فاللَّفظُ كَقولكَ: (عُرَاض)، فَهذا قدْ تَركتَ فيهِ لَفظَ (عَرِيض). فَــــ(عُرَاض) إذَنْ أَبلَغُ منْ (عَرِيض). وكَذلكَ رَجُلٌ (حُسَّان) وَ(وُضَّاء)؛ فهُوَ أبْلغُ منْ قَولكَ: (حَسنٌ)، و(وَضِيءٌ)، و(كُرَّامٌ) أبْلغُ منْ (كَرِيم)». وقَبلهُ قالَ (أبُو عُبيدَةَ مَعمَرُ بنُ المثنَّـى-تـــ :209ه)، في (مَجَاز القُرآن)، عنْ قولهِ تَعالَى في سُورَة (نُوح): ﴿وَمَكرُوا مَكْراً كُبَّاراً﴾، قالَ: «مَجازُها: كَبيراً، والعَرَبُ قدْ تُحَوّلُ لَفظَ (كَبير) إلَى (فُعَال) مُخَفَّفَة، ويُثَقِّلُون ليَكونَ أشَدّ. فـــ(الكُبَّار) أَشدُّ منَ (الكُبَار) وكَذلكَ (جُمَّال جَمِيل)، لأنهُ أشدُّ مُبالغَةً».