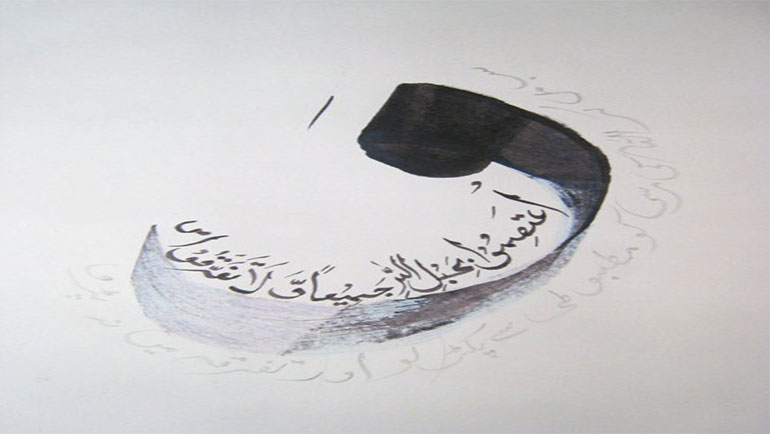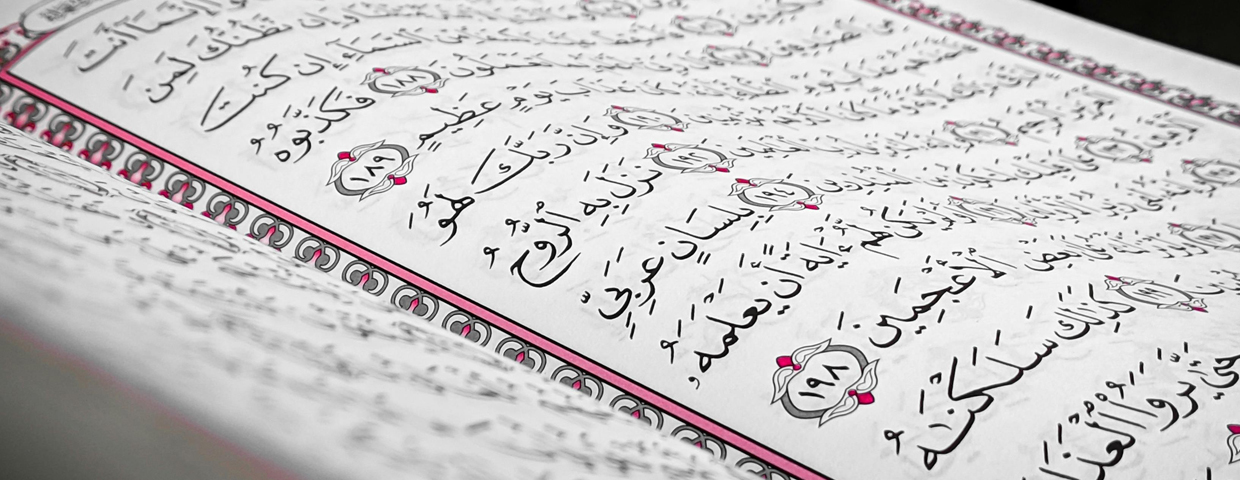أحوال المتذكر ومراتب المؤتسي المستفادة من قول الله تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) [سورة ق الآية 37 ]
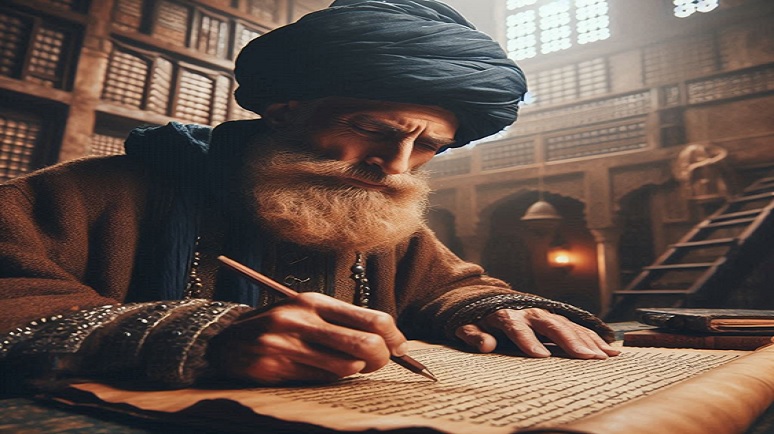
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلوات ربنا وسلامه على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين
أحوال المتذكر ومراتب المؤتسي المستفادة من
قول الله تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)
[سورة ق الآية 37 ]
وبعد؛ فمِنْ سابغ نعمة الله سبحانه وجزيل مواهبه على الخلق أنْ فَاوَت بين طبائع النَّاس في اقتناص حاجاتهم ومآربهم، ثم مَايَزَ بين فِكَرهم وهممم في إقامة معاشهم وصيانة متقلِّب أحوالهم، فأحوج بعضهم إلى بعض في درْك جُمْلةِ ذلك أو سَبَبِهِ، وحفَز دواعيَهم وقواهم للاِستدلال على معالم دينه واكتناه تَجَلِّيات صَنْعَته، ونُصْرة رُسُله المفسِّـرين فصول خطابه المعربين عن مكنون ودائع كتابه في سرعة خاطر وحضور جواب، فسماه الله سبحانه لذلك قرآنا وفرقانا وهدى ونورا، كما جعله عز وجل كتابا مبينا وصراطا مستقيما وذكرا حكيما، ثم أشاد سبحانه بمنزلة حملته من حفظته، ونوَّه بمرتبة وُعاته وسَدَنته، إذْ دعاهم للنظر في مبثوث لوامع عوالمه والتروّي في إثارة ميدان تأويله؛ تطلُّبا لفقاهة لطائف تصـرُّفاته، ثم التماساً لفرائد تركيبه وصَيْداً لغرائب نظْمه وروائق رصْفه وما يتبع ذلك، فألْقَوا – لأجل ذلك – أعناق العناية ومَدُّوا حَبْل الرعاية على ما يتصل بأوضاع ألفاظه ومتفيَّإِ ظلاله، ويَمتُّ نسبه بطرائق عرضه وأدائه (رواية ودراية)، فاستَوْلوْا من جُملته على الأمد الأبعد الأقصى، على تفاوت بينهم (سَبْقا وتوسطا وبسطاً)، فلأجل ذلك نزل القرآن وَفق معهود الناس في الكلام وأُلقي على النمط المألوف لديهم في القول والفهم والاستعمال حتى لا يكون بينهم وبينهم حاجز أو غطاء أو تباعد وما إليه، ولذلك تعلق نمط القراءة والأداء فيه - بأوجهه وعديد ألوانه - باللفظ (أصلا ووصفا)، ثم انبنى – في جوهره – على أوجه اللغة التي بها تنزَّل النص القرآني وأُوحي، فكان هذا التعدد في اللفظ والتنوع في التأدية والنطق إنما يستساغ فيستمرأ اعتبارا به مُلتحَداً نابضا بدواعي الإطاقة وتذييع موجبات اليسر والرحمة واتُّخذ موئل قوم أميين لم يكن لهم باستظهار الشرائع وترجيع تفصيلاتها سابقةُ أنس أو بادئةُ عناية أو ما أشبه، مكافئا لسائر الفروع اللسانية وشُعب النطق ومهيمنا على ما جرت به فطرة اللغة عند العرب من الأوضاع المتصلة بالنظم والتأليف (جرْسا ومعنى ...)، فبتلك الرعاية الربانية في الوحي والتنزُّل ... وباستصفاء ما ثبت صحيحا من بعض ألفاظ القرآن عن النبي الأرأف في قراءاته وأدائه وهو الأكفل الأقعد بوجوه لغة العرب وسَنَنها في التخاطب؛ ملَك كل عربي (شيخ فانٍ، عجوز كبيرة، غلام، جارية ...) أمر حاله في تنزيل أحرف القرآن وكلمه وَفْق لحنه الجبلّي وعلى نهج ما استُرضع من لبان قومه وعشيرته، تنزيلا يتخذ من الملاءمة بين جرْس الحرف وبين طبيعة المعنى والصوت الذي يتأدّى به؛ مطيّة نظمية بيانية تنهض على اعتلاء تصاريف الأبنية اللفظية واحتمال تقلبات الهيآت اللغوية الأفصحية، بالقدر الذي يشبع الحاجة الفطرية الأدائية فيستوي سِدادا أجْدى وأنفع لكل ثغر أو صقع ... ثم يلائم خصائصه الصوتية وموسيقاه اللغوية بالذي يُضـرَبُ مثلاً في لغة العرب ... ولأجل بيان جانب من ذلك نسوق أنموذجا طريفا يجلي لنا وجه الارتباط المتين بين تمام الاستجابة الحاصة لدى الكمَّل من الخلق بتحقق الوفاق التام بين صفاء الفطرة ونور الوحي واستجماع شرائط الانتفاع للنفحات النورانية الربانية، فتصير معاني القرآن كأنما نقشت على قلب الحيّ الواعي، فهو يقرؤها عن ظهر غيب بتفريغ سمعه وقلبه للسمع والتفكر والتعقل فيؤديه إلى رأي العين المسلم إلى مقام الإحسان ... قال الله تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) [سورة ق الآية 37]، وتقريبه أن لفظ الإشارة هنا (ذلك) إلى إهلاك القرون الأشد بطشا وعنادا وبعدا عن اتباع الحق والهدى .....، والذكرى أو التذكرة هي العقل ومحله القلب الذي به يكون الإدراك للحقائق وما هي عليه في الواقع وتدبر أحوال الإهلاك والتفكر في موجباته حتى يُعمل الفطن المتذكر قوته العقلية فيقيس عليها حاله فيعلم أن سيناله ما نال غيره أهل التفريط والعناد والغفلة ... فمن كان له قلب سليم متجرد؛ أفضى به عند التفكر إلى نتيجة التذكر والارتداع بمشاهدة آثار القوم المهلَكين والتنكب عن سبيلهم والتجانف عن سيرتهم وما أوجب عليهم العذاب والهلاك [إرشاد العقل السليم للعلامة أبي السعود (ت 982 ه)] ... فهذا قياس عقلي جلي يحصل للفطن اللبيب من ذات نفسه دون حاجة إلى منبِّه إذا استجمع شرائطه ... وأما وجه العبارة في قوله تعالى: (ألقى السمع) فلكونه استعير لشدة الإصغاء للقرآن العظيم ولمواعظ الرسول الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، فكأنَّ سمع المتلقي وأداة إصغائه قد طُرحتْ في سبيل ذلك وتحصيله فلا يشغلها شيء آخر تسمعه فلا تكون حاله كمن جاء لحاجة في نفسه يبغي قضاءها ثم يمزج ذلك بتعلق قلبه وفكره بغير ما جاء لأجله فأشبه الغائب ...، (وهو شهيد) جيء بصيغة المبالغة (فعيل) للدلالة بها على قوة المشاهدة لمبتغي التذكرة والعبرة وذلك يكون بتصويب العين وتحديقها إلى منبع الذكرى والعظة والحرص على فهم المراد من الخطاب أو مما يقارن الخطاب من إشارة أو ما يعرض للعين ... إذ إنَّ النظر وإعماله من معينات الفهم ومن موجبات إدراك وجه الحق وتحصيل أسباب اليقين، فهذه حالة المؤمن المتذكر وهو المنوَّه به في الآية ثم في الآية تعريض بأهل الغفلة والبعد عن الهدى والرشد من المشركين الذين منعتهم الحجب عن الانتفاع بالعبر والذكريات ورقي سلم النجاة واعتلاء نجوة الفلاح وما إليه.
وعليه؛ فإن في إلقاء السمع والتجرد للتنصت لمضمون خطاب الوحي قرآنا و سنَّة مع قوة المشاهدة والحضور إيقاظا لحبة القلب واستحثاثا سويدائه من غفلته ولهوه وبعثا له للذكرى والاتعاظ والاعتبار فيحصل منه الاستجابة الكفيلة بتحقيق الانتفاع والإذعان للحق ... وأداة (أو) في هذا المساق للتقسيم؛ لأنّ المتذكر إما أن يحصّل التذكر وينتفع بالآيات إما بأحد أمرين، أولهما: أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية من فهم أدلة القرآن ومن الاعتبار بأدلة الآثار على أصحابها كآثار الأمم المتهالكة قال تعالى: (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) [سورة النمل الآية 54]، فهذه حال من له قلب مكتمل غير محتاج في حصول الذكرى إلى دليل خارج عن ذاته، وهو قسم من له قلب (لمن كان له قلب)ّ، وأما الأمر الآخر المفضي للتذكر وحصوله؛ فيكون بإلقاء السمع (أو ألقى السمع) ويكون بتوجيه السمع لأخبار الأمم الخالية الملقاة عليه دون الاشتغال بغيرها، ففي الآية تعريض بحال المشركين وكونهم ممن ليس له قلب ذكي ولا ممن لا يلقي سمعه فيحصِّل البلاغ والانتفاع والذكرى، ولذلك فإن المتذكر بمصارع المهلَكين قد يكون حاضرا فيرى مصرعهم حال الإيقاع بهم أو يرى آثارهم بعد ذلك، وقد يُخبَرُ عن مصارعهم من غير رؤية ولا حضور، ولذلك قدَّم الله سبحانه في الآية الرائي على المخبَر فقال: (لمن كان له قلب) متجرد يرى به ويشهد ما يسلمه الفهم والتذكر، وهذا الرائي الناظر هو الأولى بالاعتبار والأجدر بالادِّكار ممن نُقلت إليه الأخبار أو دُعي إلى الاستماع بحضور ذهن وجمع خاطر، وهذه رتبة دون الأولى في الاعتبار، قال تعالى: (وهو شهيد) أ يحال كونه حاضرا بكليته حتى لا يغيب عنه شيء من جزئيات ما تلي عليه أو ألقي، وذلك خلاف من سمع فلم يُحضر ذهنه ولا استدعاه فيصير في حكم الغائب، قال العلامة البقاعي (ت 885ه) في نظم الدرر : (فالأول العالم بالقوة وهو المجبول على الاستعداد الكامل، فهو بحيث لا يحتاج إلى غير التدبر لما عنده من الكمال المهيّإ بفهم ما يذكّر به القرآن، والثاني القاصر بما عنده من كثافة الطبع، فهو بحيث يحتاج إلى التعليم فيتذكر بشرط أن يقبل بكليته ويزيل الموانع كلها؛ فلذلك حسن جدا موقع أَوْ المقسِّمة، وعلم منه عظيم شرف القرآن في أنه مبشر للكامل والناقص، ليس منه مانع غير الإعراض)، قال ابن القيم (ت 751 ه) رحمه الله في فوائده ص (3) : ( أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، فقوله: (إنَّ في ذلك لذكرى) أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر، وقوله: (لمن كان له قلب) فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا) أي حي القلب، وقوله: (أو ألقى السمع) أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام، وقوله: (وهو شهيد) أي شاهد القلب حاضر غير غائب)، فينبغي على المتذكر المؤتسي بالقرآن أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، قال الآجري (ت 360 ه): (أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه، ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها [سورة محمد الآية 25])...، ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الربّ عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم سلطانه وتفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب، فحذِر مما حذَّره مولاه الكريم ورغب فيما رغّبه فيه، ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال، وعزّ بلا عشيرة، وأنِس بما يستوحش منه غيره، وكان همّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها؛ متى أتّعظ بما أتلو ؟ ولم يكن مراده؛ متى أختم السورة ؟ وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب ؟ متى أزدجر ؟ متى أعتبر ؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق) [أخلاق أهل القرآن المقدمة ص 36]، ولقد تلطّف العلامة أبو القاهر الجرجاني (ت 471 ه) في إطلاق العقل ههنا على القلب فقال: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) أي لمن أعمل قلبه فيما خلق القلب له من التدبر والتفكر والنظر فيما ينبغي أن ينظر فيه، فهذا على أن يُجعل الذي لا يعي ولا يسمع ولا ينظر ولا يتفكر كأنه قد عدم القلب من حيث عدم الانتفاع به، وفاته الذي هو فائدة القلب والمطلوب منه كما يجعل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر فيما يؤديان إليه، ولا يحصل من رؤية ما يُرى وسماع ما يُسمع على فائدة، بمنزلة من لا سمع له ولا بصر، ...) [دلائل الإعجاز ص باب اللفظ والنظم ص 304].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع