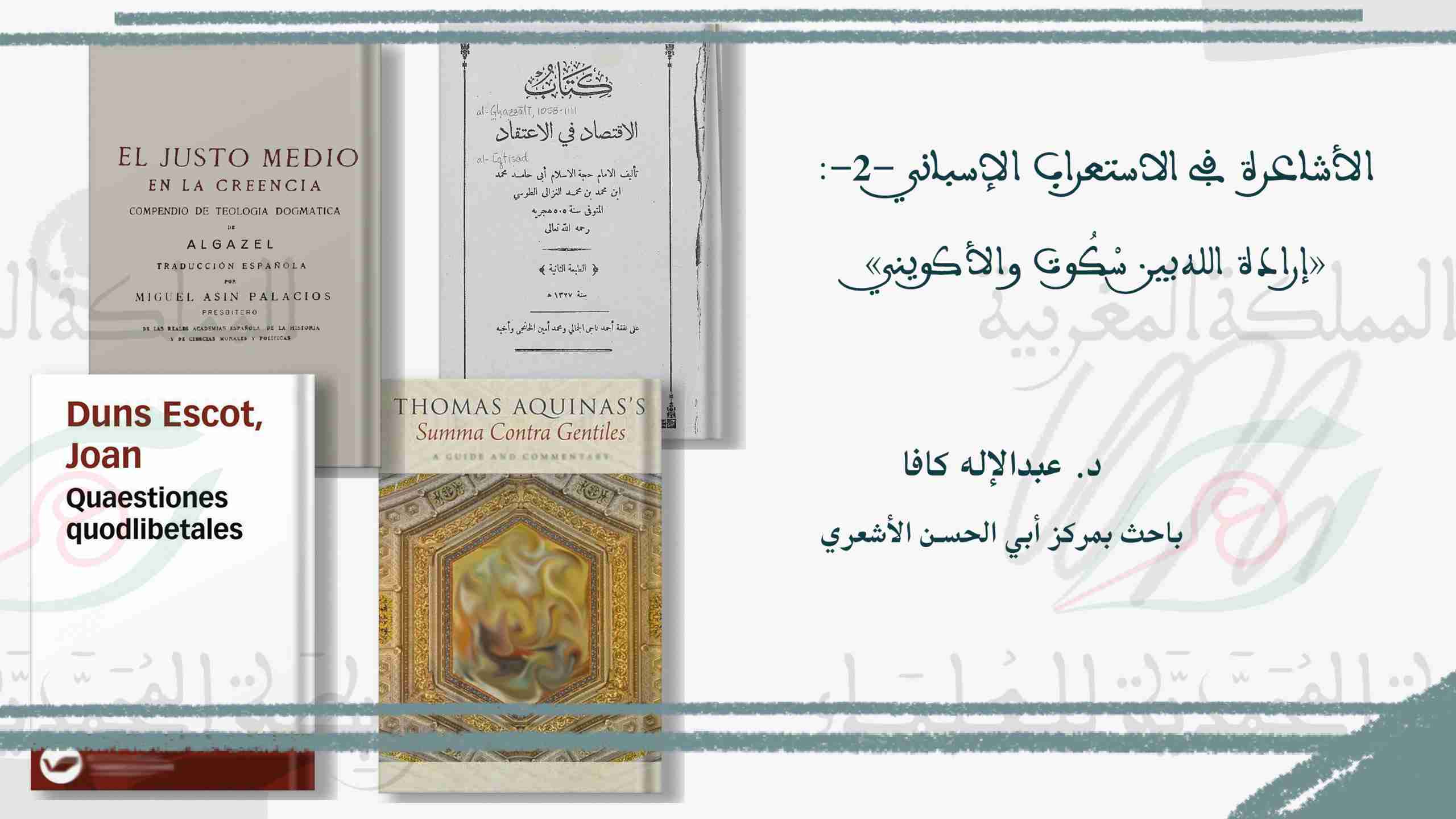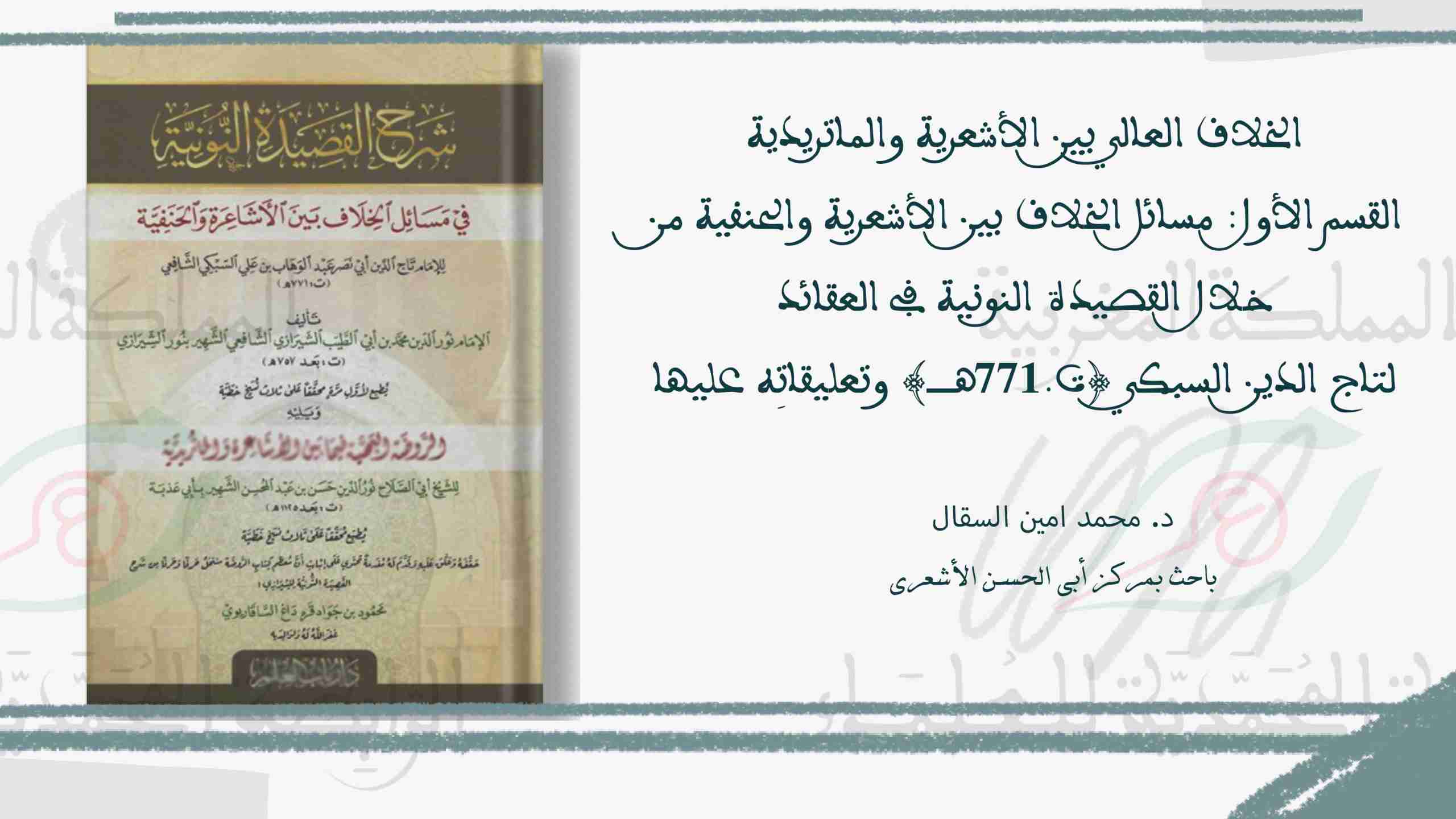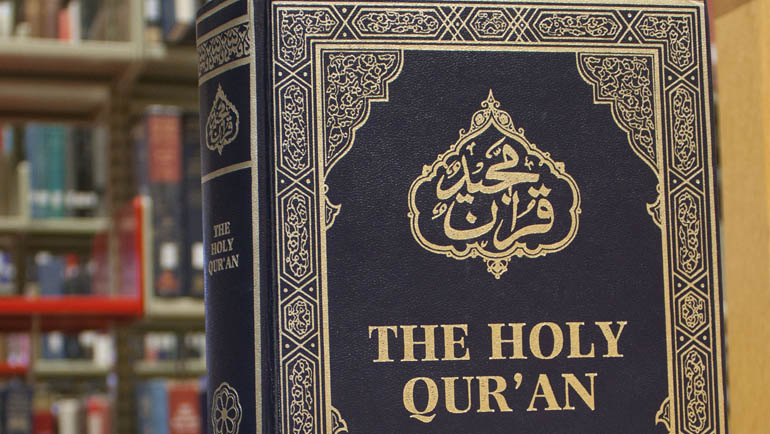
د. إبراهيم الوافي
 (العدد: 19)
(العدد: 19)
1. القرآن الكريم
إن تعريف القرآن الكريم المتفق عليه بين العلماء والأصوليين هو كونه "كلام الله المعجز"، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، بوساطة الأمين جبريل، عليه السلام، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبّد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس[1].
أما لفظه فمرادف لمعنى القراءة، قال تعالى: ﴿إن علينا جمعه وقرءانه. فإذا قرأناه فاتبع قرءانه﴾ [القيامة: 16- 17]؛ أي قراءته.
2. القرآن والعلوم
"وللقرآن وجه اجتماعي من حيث تأثيره في العقل الإنساني، وهو معجزة التاريخ العربي خاصة، ثم هو بآثاره النامية معجزة أصيلة في تاريخ العلم كله على بسيط هذه الأرض، من لدن ظهر الإسلام إلى ما شاء الله"[2].
لقد اهتم الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم بأصول الدين.
وتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص، والإضمار، والنص، والظاهر، والمجمل والمحكم، والمتشابه، والأمر، والنهي، والنسخ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن أصول الفقه.
وأحكمت طائفة النظر الصحيح، والفكر الصادق فيما فيه من الحلال والحرام، وسائر الأحكام فأسسوا أصوله وفروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالفقه أيضا.
وتلمحت طائفة إلى ما فيه من قصص القرآن السابقة والأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول النشأة وسموا ذلك بالتاريخ والقصص، كما استنبطوا منه علم المواعظ وعلم المواريث وتعبير الرؤيا، وعلم الفلك والتوقيت...ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ، وبديع النظم وحسن السياق والتلوين في الخطاب والتقطيع، فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع[3].
وهكذا فإن البحث في القرآن يمكن أن يتناول الناحية الفكرية فيدرس ما أثار القرآن من موضوعات ومسائل، وما بث من عقائد واختلط من خطط، ويمكن أن يجمع من ذلك ما تفرق في سورة في مختلف المناسبات والحوادث، وتصنف بحسب أنواعها وأصنافها، فيخرج الباحث من ذلك بفكرة عامة عن نظرة القرآن واتجاهه في كل ميدان من ميادين الحياة.
ويمكن أن ينظر إلى القرآن من ناحية فنه وطرائق تعبيره، فقد عرف القرآن بفن خاص انفرد به. ومع ذلك فالقرآن في واقعه التاريخي ليس بنظريات فيلسوف أو خيال شاعر، هذا عند أهله وأصحابه الذين نزل بينهم، وإنما هو كتاب حياة، فلا ينفصل فيه الفكر عن الفن ولا الفن عن الفكر؛ لقد فهمه العرب ودخل في وعيهم على أنه كل لا أجزاء[4].
3. أسلوب القرآن
لقد جاء القرآن بأسلوب متميز، لا هو بالنثر ولا يجري على طرائقه وأنواعه، ولا هو بالشعر ولا يركب أوزانه وخياله...
وإنما هو أثر من الآثار الإلهية، فهو مبني على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة، وجمله لها دلالتها الوضعية التركيبية التي يشاركها فيها الكلام العربي كله[5]. ويمكن للمتتبع لأسلوب القرآن أن يلحظ فيه ملحظين هما: التنويع اللفظي، والتنويع البياني[6].
أ. فأما التنويع اللفظي: فهو ما كان في الفواصل، وهي أواخر الآي، وقد يكون باتفاق السورة في كل الفواصل المقفاة كسورة القمر، وسورة الشمس، والأعلى، والقدر، والإخلاص، والناس، وقد يوجد في بعض الفواصل لزوم ما لا يلزم، وهو التزام أن يكون ما قبل القافية حرفا معينا وهو اتحاد ما قبل الحرف الذي تتواطأ عليه الفواصل نحو ﴿في سدر مخضود، وطلح منضود﴾، ونحو ﴿إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت﴾ ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق﴾.
ويكون التنويع باتفاق السورة في أكثر الفواصل كما في سورة الضحى، وبورود فواصلها على أنواعها من التقفية كما في سورة الشرح، والعاديات. ومن تنويع الأسلوب ختم السورة ذات الفواصل المقفاة بفاصلة على غير قافيتها كما في سورة الرحمن ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾، وفي سورة الضحى المتفقة في أكثر الفواصل: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾، وذلك لتنشيط السامع وإرهاف فكره.
ومن ذلك حفظ روي الفاصلة التي تبنى عليها السورة، وإن تخللتها فواصل مختلفة، وهي نوع غريب من التنسيق يحكيه الفن المسمى بالتوشيح ويوجد في سورة الرحمن وسورة (ص) [الرحمن: 15، وسورة ص: 54].
ب. التنويع البياني: وهو أن القرآن الكريم ينوع التعبير ويصوغ المعاني في قوالب مختلفة للإيذان بالتمكن في عقر البلاغة والجري على ما عرف عن العرب من تصريف المعنى الواحد على أساليب متعددة، وتقليبه على وجوه متنوعة من التعبير[7] من ذلك تنويعه التعبير عن سفينة نوح مرة بقوله: ﴿وحملناه على ذات ألواح ودسر﴾[8] في سورة القمر ـ ومرة في سورة الحاقة بقوله: ﴿إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية﴾، فقد نوع التعبير مراعاة للفواصل.
وفي حال الناس عند قيام الساعة ﴿وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد﴾ [الحج: 3]، ﴿ويكون الناس كالفراش المبثوث﴾ [القارعة: 4].
وفي حالهم عند البعث ﴿ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا﴾ [الكهف: 95] ﴿ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون﴾ [يس: 50]، ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون﴾ [المعارج: 43] ﴿يوم يدع الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع﴾ [القمر: 6- 7]، ﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون﴾ [الروم: 24]، ﴿ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة﴾ [النازعات: 13- 14]*، ﴿ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون﴾ [الزمر: 65]، ﴿يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير﴾ [ق: 44].
وقد وقع هذا التنويع في القسم تارة بعظيم مخلوقاته تعالى مثل النجوم ومواقعها ﴿والنجم...﴾ ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم﴾، أو بأماكن معينة ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾، أو بمشاهدة منتظرة كالقسم بيوم القيامة ﴿لا أقسم بيوم القيامة﴾.
كما وقع هذا التنويع في القرآن على أبلغ وجه وأكمله، بطريق الإطناب تارة، والإيجاز أخرى. ثم إنك "إذا أمعنت النظر وأنعمته في وصف يوم القيامة والجنة والنار، والاستدلال على المعاد الأخروي بآيات الله في الأنفس والآفاق المسوق في سورة التنزيل بالإسهاب تارة وبالإشارة والإيجاز أخرى لرأيت من أنواع التفنن في البلاغة وغرائبه ما يدهش ويخرس.
فاقرأ سور: المرسلات، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار، والمطففين، والانشقاق، والغاشية، والفجر، والبينة، والزلزلة، والقارعة، وغيرها يتحقق لك ذلك عن عيان"[9].
4. بلاغته وإعجازه بها
لقد كان القرآن المكي أول ما نزل من القرآن، وأن أول وحي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بغار حراء، وأن قريشا كانوا أول من خوطب بهذا القرآن المعجز، وهم ما هم عليه من صفاء القريحة، ونبل العقل وحصافة الرأي، والمنطق العذب، والقول الفصيح، والقرآن يسجل لهم الكثير من هذا مثل: ﴿وإن يقولوا تسمع لقولهم...﴾.
وكانت لهجتهم أرقى لهجات القبائل العربية بسبب ما تعرضت له من تهذيب وصقل في أسواقهم الأدبية التي كانوا يتصدرون فيها زعامة النقد الشعري، والكلمة الفاصلة، كما كانت مكة المكرمة محط رجال القوافل الضاربة في الأرض للاتجار.
ولما اجتمعت فيهم هذه الخصال خاطبهم القرآن في الغالب بأسلوب الإيجاز والإشارة والوحي، مراعاة لحق المقام، وأخذا بمقتضى الحال، وإنا لنرى ذلك جليا في السور المكية، كما نرى فيها تلميحات وإحالات على شؤون كانت معروفة لديهم، ذكروا بها وأعيدت على أذهانهم ليعترفوا بفضل الله عليهم فيها كما في سورة الفيل، وقريش.
وقد اتجهت معاني هذه السور المكية إلى تقرير أساس الدعوة وأصول الدين، وغرس مكارم الأخلاق في النفوس، كما اتجهت السور المدنية لتقرير الشرائع وبيان الحلال والحرام، وتفصيل أحكام المعاملة والحروب والمعاهدات، فكان الإطناب فيها هو مقتضى الحال ليتأتى تنفيذ خططها كما يجب.
أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "إنما نزل ما نزل منه سورة المفصل، فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تقربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنى أبدا، لقد أنزل على محمد، صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، "بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر"، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده"[10].
وذكر الجاحظ في كتاب الحيوان: "ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف وإذا خاطب بني إسرائيل وحكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام".
وعلق الرافعي بأن ذلك جار على منهاج الأدب العبري[11]، ورد عليه العلامة المغربي الضليع محمد بن عبد السلام السائح بأن هذا النوع من الخطاب لا يجري على الأدب العبري، وإنما الواقع فيه أنه لما كان وجدانهم لا ينفعل إلا لخطاب متكرر المعنى والألفاظ، روعي في خطابهم هذه النفسية وهذا الوجدان...فإن البلاغة هي أن يبلغ المتكلم ما يريد من نفس السامع، فهذا الأسلوب من أسرار اللسان العربي أيضا لا أنه جري على أسرار اللسان العبراني، والقرآن نزل بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم[12].
وإذا كان القرآن الكريم، قد سجل تفردا خاصا ومتميزا على مستويات عدة بوجه عام، وعلى مستوى البيان بوجه خاص، مما لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة به في هذه العجالة.فما أثره في مجال البلاغة؟
العرب والبلاغة
البلاغة على وزن فعالة مصدر من بلغ بالضم (بلاغة) فهو (بليغ) إذا كان فصيحا طلق اللسان[13]. وقال في لسان العرب: ورجل بليغ: حسن الكلام، فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه.
وفي البيان والتبيين: "سئل العتابي، ما البلاغة؟ فقال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ... فقيل له: قد عرفنا الإعادة والحبسة، فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث، قال عند مقاطع كلامه: يا هناه، ويا هيه، واسمع مني، واستمع إلي، وأفهم عني، أو لست تفهم، أو لست تعقل؟ فهذا كله وما أشبهه عي و فساد"[14].
ثم علق الجاحظ على جواب العتابي بكلام نفيس وطويل نقتبس منه ما يأتي:
"... فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثيرا من حاجاته، ونفهم بصغاء السنور كثيرا من إرادته، وكذلك الكلب، والحمار، والصبي الرضيع وإنما عني العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء...لأن تلك اللغة إنما انقادت واستوت واطردت وتكاملت بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة...ولفقد الخلطاء من جميع الأمم"[15].
فقوله: "ولفقد الخلطاء من جميع الأمم" يعني لما كانت اللغة تتشكل وتتأصل في الحضن العربي، وهو لا يناقض ما تقدم من هذه اللغة خصوصا اللهجة القرشية منها، قد استفادت تهذيبا وصقلا بسبب العلائق التي يقيمها العرب فيما بينهم كالمواسم والأسواق، وعقد المجالس الشعرية والنقدية، فهذا إغناء تهذيب وانتقاء، وليس سبيلا إلى الرطانة والعجمة التي تأتي من اختلاط التركيبة الاجتماعية بعناصر أجنبية عن اللسان العربي، والتي يحذر منها الجاحظ كما حذر منها غيره من كبار العلماء الذين تصدروا إلى ضبط علم البلاغة واستنباط أمثلته من فصيح كلام العرب ومن التفننات البيانية للقرآن الكريم، خصوصا بعد أن دخل الأعاجم في الإسلام.
لقد اعتنى العرب قبل الإسلام بلغتهم واحتفوا بها أيما احتفاء ورفعوا من قدر من ملك ناصيتها منهم، خصوصا وأنها وسيلة لرفع الشأن أو خفضه بالتفاخر والسجال، وحتى لما بدأ يغزوهم الاختلاط تحرزوا ببعث أولادهم إلى البادية...وكان الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب، ممن بعث إلى البادية لتصفوا لغته ويتقوى عوده...
وقد كانت حياة العرب قبل الإسلام ذات صلة وثيقة وخاصة باللغة والبلاغة والفصاحة، فحياتهم حياة أدبية، واللغة سلاح في أيدي القوم ولذلك كانوا يحملون أفانين القول إلى أسواقهم "فيحمل على السوق التهامي، والحجازي، والنجدي، والعراقي، واليمامي، واليمني، والعماني كل ألفاظ حيه، ولغة قطره، فما تزال عكاظ بهذه اللهجات نخلا واصطفاء حتى يبقى الأنسب الأرشق، ويصرح المجفو الثقيل..."[16].
ولذلك عد مؤرخو الأدب أو وحدة العرب اللغوية بدأت تتشكل بأكثر من قرن قبل الإسلام بسبب مؤتمرات عكاظ ومعارضة اللسانية، وفيه تهيأت لقريش تلك الزعامة والتحكم في اللغة والانتقاء فسلمت اللهجة القرشية من عيوب اللهجات[17]؛ كالكشكشة والكسكسة وغيرها.
وهذه الوحدة اللغوية هي التي نزل القرآن فرسخها وأرسى قواعدها، وذلك حين تنزلت آياته على ما عرف العرب، في نموذج اللغة الموحدة، من سنن القول وأساليب الخطاب.
ولو لم تكن لغة القرآن هي نفسها اللغة الموحدة التي تعارفوا عليها قبل نزوله لما واجههم حين أنكروا بالتحدي الصارخ الذي واجههم به، خاصة وأن هذا التحدي كان للقبيلة التي نزل بلسانها وهي قريش.
البلاغة في ظلال القرآن
سمع العرب آيات الكتاب المبين، فدهشوا بما عرفوا فيها من أساليب البلاغة، وحاروا في تعليل دهشتهم وإعجابهم وهم أهل اللغة وأرباب البلاغة، لقد سمعوا لغة من لغتهم وجملا من حروفهم، [18]ولكنهم لم يسمعوا قبلها مثيلا لا في نثر ناثر ولا في شعر شاعر، ولا في سجع كاهن.
ولذلك لما رشحوا كبيرهم للحكم على القرآن أدرك بلاغة القرآن وخضع وأذعن في أول الأمر، وقاموا يستفزونه بحمية الجاهلية، حتى قال لهم دعوني أفكر، فلما فكر وقدر قال: ﴿إن هذا إلا سحر يوثر﴾ [المدثر: 24]، ولذلك وصفه القرآن بقوله ﴿إنه كان ءلاياتنا عنيدا﴾ [المدثر: 16].
وعمر بن الخطاب أسلم بسماعه آيات من مطلع سورة طه وشكل سماع القرآن خطرا على مصالح المشركين لأنه بمجرد سماعه ترق له النفوس وتطمئن وتوقن بأنه من عند الله ولذلك ﴿قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ [فصلت: 25]، "وإذا كان في استطاعتهم أن يتواصوا بالبعد عنه، فإن في ذلك إقرارا منهم بسلطانه وروعة بيانه، ولكن كيف يظلون بعيدين عنه وعن الاستماع إليه وهو يناديهم متحديا أن يأتوا بمثله" ﴿أم يقولون تقوله، بل لا يومنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين﴾ [الطور: 32]، وإن عجزوا، وهم الفصحاء البلغاء، فلياتوا بعشر سور مثله ﴿أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾ [هود: 13] ثم يعجزون، ويلاحقهم صارخا في وجوههم متحديا ﴿أم يقولون افتراه، قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾ [يونس: 38].
حتى إذا انقطعوا عاد عليهم ملحا من جهة، وحاكما بعجزهم عن مجاراته في اللغة التي هي لديهم وسيلة كل فخر، ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين﴾ [البقرة: 23].
وعادوا إلى الصمت، فعاد صوته يعلن نتيجة التحدي: ﴿قل لئن اجتمعت الاِنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرءان لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾ [الإسراء: 88]. وهكذا لم تبق أمامهم وسيلة للصمم أو التصامم فإما الإيمان وإما الإنكار والعناد...
قال الجاحظ: "بعث الله محمدا، صلى الله عليه وسلم، أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيبا، وأحكم ما كانت لغة، وأشد ما كانت عدة، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته فدعاهم بالحجة، فلما قطع العذر وأزال الشبهة، وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة حملهم على حظهم بالسيف فنصب لهم الحرب ونصبوا له... فكلما ازداد تحديا لهم به وتقريعا لعجزهم عنها تكشف عن نقصهم ما كان مستورا، وظهر منه ما كان خفيا، فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف، فلذلك يمكنك ما لا يمكننا، قال: فهاتها مفتريات، فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر...[19].
وهكذا اتضح للعام والخاص، للمومن والجاحد، أن القرآن معجز ولم يجادل في ذلك أحد، ولم يكابر فيه مكابر، ولكن الاختلاف الذي بسببه تعددت المذاهب والآراء هو وجه الإعجاز وسره، لا الإعجاز في حد ذاته.
ومن أجل ذلك ظهرت كتب كثيرة، ومؤلفات جليلة تتناول موضوع الإعجاز، إلى جانب مؤلفات أخرى تتناول جوانب القرآن الأخرى بالبحث والدراسة، وساهم القرآن الكريم مساهمة فعالة في ازدهار اللغة العربية وقت نزوله، وحفاظا على بقائها وخلودها بعد ذلك عبر العصور والقرون، وسيظل الشأن على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
أطوار التأليف في علم البلاغة
ويذكر المؤرخون لعلم البلاغة أن أقدم كتاب اعتنى بتحديد معاني القرآن، وكان النواة الأولى للبحوث البلاغية كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 207ﮪ) تقريبا الذي حاول أن يدرس أسلوب القرآن ويقارنه بالأدب العربي شعره ونثره، ولا ننسى أن هذا العمل قد سبق إليه الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس والمتجلي في سؤالات نافع ابن الأزرق له[20].
ثم تعاقب التأليف في البلاغة مستمدا جذوره ومقوماته من القرآن الكريم، قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في "موجز البلاغة" متحدثا عن أوليات هذا العلم في الظهور وتدرج التأليف فيه: "كان هذا العلم منثورا في كتب التفسير عند بيان إعجازه وفي كتب شرح الشعر ونقده، ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة، فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى سنة 144 كتاب "مجاز القرآن" وألف الجاحظ عمرو بن بحر المتوفى سنة 244ﮪ كتبا كثيرة في الأدب.
وكان بعض من هذا العلم منثورا أيضا في كتب النحو مثل كتاب سيبويه ولم يخص بالتأليف إلا في أواخر القرن الثالث إذ ألف عبد الله بن معتز (ت قتيلا سنة 296ﮪ) كتاب البديع أودعه سبعة عشر نوعا وعد الاستعارة منها.
ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي (ت 471ﮪ) فألف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أولهما في علم المعاني والثاني في علم البيان، فكانا أول كتابين ميزا هذا العلم عن غيره ولكنهما كانا غير مخلصين ولا تامي الترتيب، فهما مثل در متناثر كنزه صاحبه لينظم منه عقدا عند تآخيه، فانبرى سراج الدين يوسف بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي المعتزلي (ت 626ﮪ) إلى نظم تلك الدرر فألف كتابه العجيب المسمى مفتاح العلوم في علوم العربية وأودع القسم الثالث منه، الذي هو المقصود من التأليف، مسائل البلاغة، دونها على طريقة علمية صالحة للتدريس والضبط، فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من كتابي الشيخ عبد القاهر ومن مسائل الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري فأصبح عمدة الطالبين لهذا العلم، وتتابع الأدباء بعده في التأليف في هذا العلم الجليل[21]. "على أنهم لم يزيدوا على الترتيب والتهذيب والتبويب"[22]. وفي مقدمتهم السكاكي نفسه.
ويظهر أن في كلام ابن عاشور إيجازا شديدا وقفزا واضحا على المعارك العلمية الساخنة التي دارت بشأن تعليل وجوه الإعجاز والمؤلفات الجمة فيه مثل ما كتب الجاحظ في كتابه المفقود "نظم القرآن" والرماني، والخطابي، والواسطي، والباقلاني، وهذا الرعيل كله كان قبل عبد القاهر الجرجاني المميز لعلم البلاغة، ولا ننسى كذل الجدال الذي دار حول قضية البلاغة بين اللفظ والمعنى، وما دار حولها في كتب النقد الأدبي التي كانت تستنير بالحس البلاغي في كل ما تأتي به.
وكان الذي حسم في هذا الأمر شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني الذي حاول أن يخرج بقضية الإعجاز من وضع خطير تردت فيه، حين أرجع سر الإعجاز إلى النظم، ولخص فكرته هذه في أن النظم ما هو إلا توفي معاني النحو، واستطاع أن يرسي دعائم علم المعاني في كتابه الدلائل.
كما أنه في أسرار البلاغة أوضح كثيرا من أسرار الجمال في الصورة الأدبية، وبين معالم التشبيه والاستعارة، وكان له فضل كبير في تحديد معالم الفن الذي عرف فيما بعد بعلم البيان.
وعبد القاهر يريد أن يصل إلى أن يجعل للذوق أساسا من العلم يرتكز عليه، فلا استحسان إلا بعلة، ولا استقباح إلا بعلة...وبذلك اتجه بالبلاغة نحو التقنين، وتحديد المعالم، فكانت له في الدلائل نظرة كاملة في المعاني، وكانت له في الأسرار نظرة كاملة تقريبا في علم البيان.
ويرى الدكتور شوقي الضيف أن عبد القاهر بحث فيما سبق إليه من فصول، لكنه وجدها غير محررة فحرر ودقق بحسه المرهف، وبصيرته النافذة. وتسلم الزمخشري إرث الجرجاني الضخم وما اشتمل عليه من آراء بلاغية شرح بها وجوه إعجاز القرآن، فانصرف إلى وضع تفسير للقرآن يكشف به عما في آيات الكتاب المعجز من أسرار البلاغة، ودقائق معنوية، وأتى في ذلك بما لم يسبق إليه.
كان الزمخشري يدرك أن تفسير القرآن أمر لا يدرك إلا عن طريق علمي المعاني والبيان، وهو نفس الرأي الذي أثبته عبد القاهر في دلائل الإعجاز، ولذلك سار على نهجه في التحليلات العقلية الذوقية، وأخذت البلاغة على يديهما بعدا تطبيقيا تجلى في النماذج البليغة والنصوص الرفيعة.
وقد تفرد الزمخشري بصنيعه العلمي في الكشاف، إذ لم يعلم الناس تفسيرا للقرآن مؤسسا على علمي المعاني والبيان سواه، ولم أر فيما أعلم من التفاسير تفسيرا سار على نهجه، في هذا الصدد واحتذى حذوه في صنيعه إلا تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الذي أخذ على نفسه أن يتتبع نظرات الزمخشري البلاغية وتطبيقاته الفنية ويدل على مواطن التوفيق فيها، وينبه على مواطن الضعف والهنات.
البلاغة بين الجمود والنهوض
جفت ساحة البلاغة بعد عطاء الجرجاني وتطبيقات الزمخشري في الكشاف، وأصيبت ميادينها بالمحل، وكثرت فيها الشروح والتلخيصات منذ أن لخص الفخر الرازي كتب الجرجاني ولخص القزويني القسم الثالث من كتاب المفتاح.
يقول ابن عاشور: "وفي ذلك، يقصد التلخيص للقزويني، ضاعت فلسفة التحارير، سعد الدين، والسيد الشريف، وعبد الحكيم، فمن جملة الأبحاث التي تفاتحك في درس المطول مسألة تعريف الجنس في الحمد لله، وهل حملها على الاستغراق يساوي حملها على الجنس ويتفاوت...".
ويكثرون من الشواهد الاصطناعية مثل قولهم: "زيد متطلق وعمرو، وخرجت فإذا زيد..." وساهم أدباء هذه العصور المتأخرة بما أمدوهم به من أدب هزيل وذوق سقيم.
كانت البلاغة فنا يدرك بالحس الجمالي، أو كانت جمالا يدرك بالذوق، فأصبحت على أيديهم أحكاما أو معارف صاغوها في حدود وتعريفات، وهذا أمر صاحب العلوم العربية في نشأتها، فقد بدأت بشكل عملي في كلام العرب، ثم لاحظها العلماء الحذقون والمتذوقون واستنتجوها من كلام أولئك ودللوا عليها ثم جاءت مرحلة الحدود والتعريفات، والتأثر بالمنطق والفلسفة، والابتعاد عن اللغة الحية والنصوص الأصلية..
وفي العصر الراهن أدرك علماء النهضة أهمية البلاغة ونجاعتها وأدركوا أنها ليست شيئا زائدا يمكن الاستغناء عنه، وإنما البلاغة أداة مساعدة لنا كفيلة بأن تعلمنا كيف نتكلم بلسان عربي مبين، وكيف ننشئ بأسلوب عربي صحيح، وكيف نفهم ما أنشئ في هذه اللغة من بليغ القول ورائع الكلام، إنها ترشدنا إلى الطريقة التي نوضح بها أغراضنا، ونبين بها عن المعاني الكامنة في نفوسنا.
ولذلك اتجهت الجهود إلى عملية البعث والإحياء، ومن جملة ما اتجهت إليه الهمم الاشتغال بتفسير القرآن الكريم وتقريبه من الناس وتقريب الناس منه باعتبار أنه كتاب هداية وإرشاد من جهة، والمنهل الوحيد الذي يمكن أن تنهل منه اللغة العربية في كل وقت وحين، لأنه أهم مقوماتها، ولا يمكن أن تستمد العربية إلا منه فهو المثل الأعلى الذي سار عليه كل المشتغلين في هذه اللغة على مر العصور من كتاب وأدباء وشعراء، وظل يشكل خميرة ملكاتهم اللغوية، ومن ثم يمكن اعتبار أن اللغة العربية مطروحة في القرآن الكريم ولا عكس...
يقول الرافعي: لقد كان لهذا النظم عينيه يقصد نظم القرآن هو الذي صفى طباع البلغاء بعد الإسلام، وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم، حتى كان لهم من محاسن التركيب في أساليبهم... ولو لا القرآن... لما بقيت اللغة نفسها.
لقد استقر في أذهان بعض الناس أن البلاغة أصبحت مادة (متحفية)، وأن دراستها اليوم والرجوع إليها لا يعني أكثر من جولة بين الآثار القديمة أو وقفة بين الأطلال.
وهذه الحقيقة استقرت في أذهان الكثيرين إن لم نقل إنها تكاد تمثل رأي جيل جديد في هذه المادة من علوم العربية.
ومن أسباب ذلك أننا نلقن لطلبتنا إبان دراستهم الثانوية صورة مشمئزة عن عيوب "أدب الانحطاط" وأكبر هذه العيوب ظاهرة تعلق أدبائه بالصنعة البديعية والبيانية وهل فهم المتلقون، فيما إذا كانوا قد فهموا شيئا من البلاغة، سوى أن البلاغة تشبيه أو استعارة وسجع وجناس وثورية وطباق ومقابلة؟
ما من شك أننا نفتح أعينهم على البلاغة يوم تحجرت ولم ندلهم عليها يوم كانت تمثل ذوب الذوق العربي الأصيل وثوب الجمال الفني الرائع البديع...ثم نأتي لنطالبهم في الدراسة الجامعية بالعناية بالبلاغة، وما هي في تصورهم إلا جثة محنطة، وهل عرف العربي البلاغة يوم عرفها حدودا وتعريفات؟
إنه عرفها يوم بدت جلية لناظريه، فجذبت سمعه وخلبت لبه وتمثلت أمامه مادة حية على لسان البلغاء من العرب قبل الإسلام، ثم عرفها ندية معجزة في الكتاب العربي المبين كما عرفها بعد ذلك رائعة في تراث الإعلام من خطبائه وكتابه وشعرائه حتى أواخر القرن الرابع الهجري.
إن البلاغة التي عرفها العربي بطبعه كما عرفها بعقله لن تصل إلينا على ما عرفها عليه... إنها وصلت إلينا بعد أن مرت عبر تاريخ طويل بعصور طبعتها بالكثير من سماتها، وشابتها بالكثير من آثارها وخصائصها، فإذا هي على ما نراها عليه اليوم من تأثر بالمنطق، وإيغال في الفلسفة، وبعد عن الطبع، واتسام بذوق عصور الدول المتتابعة، ونحن أنفسنا لم نصل إليها إلا بعد أن تأثرنا إلى حد بعيد بالأدب الغربي وفنون القول فيه، وتأثرنا بمذاهبه النقدية ونظرتها إلى الأمور البلاغية، وكانت لغتنا يوم اتصل الشرق العربي بالغرب، عاجزة على القيام بنفسها، وأحرى استيعاب ما جاءنا عنه، ولم يكن بد من تطوير اللغة وبدأ هذا التطوير فعلا، لكن غلب الانفتاح على التفتح، حسب قاموس محمد عزيز الحبابي، في كتابه من المنغلق إلى المنفتح.
إن طبيعة العقل العربي طبيعة وثابة، فالعربي حين ينطق بالكلمة فإن عقله يثب بين مفهومين لها بينهما بون بعيد... إنه يبدأ بالكلمة الدالة على الشيء المحسوس ثم لا يلبث حتى يقفز إلى مدلول معنوي آخر...إنه سرعان ما يترك المرحلة الابتدائية الأولى في التعبير، لينتقل على مرحلة فكرية راقية، فإذا قال "الحقد" لم يذكر معناه الحقيقي الذي هو انحباس المطر في السماء، ولكنه ذكر انحباس الغيظ في الصدر وإذا قال "المجد" لم يذكر امتلاء بطن الدابة بالعلف، وهو معنى المجد أصلا ولكنه ذكر امتلاء الإنسان بالصفات الكريمة، من خلال مراعاة هذه الخصائص في كلام العربي ينبغي أن ننظر إلى الألفاظ التي يستعملها، ومن خلالها ينبغي أن نقدر جمال صوره وما تقوم عليه من تشبيهات واستعارات، أما إذا كنا ننظر إلى البلاغة على أنها هي الإرث الذي وصل إلينا من عصور الانحطاط، ومن خلال قوالب وحدود منطقية وشروح واستطرادات فلسفية، ثم نوازن كل ذلك عند الغربيين من مذاهب النقد وفنون القول، فإن ذلك قتل لطبيعة البلاغة العربية وتزييف لحقيقتها، ثم هو قبل ذلك جهل بوظيفة البلاغة ومهمتها وصلتها باللغة التي هي بلاغتها.
ولعل هذا كاف لأن يفسر لنا ظاهرة العزوف عن البلاغة في الأدب والنقد الحديثين، كما يلاحظ قلة التأليف وانحساره في مجال البلاغة وعليه، فإذا أردنا للبلاغة ثوبا جديدا لابد لنا من فهم القديم واستعابه لكشف البلاغة في ثوبها القديم الذي لم يعد يعجب الكثير منا ولا يرضي أذواقهم، لأن التجديد نفسه ليدعو إلى معرفة القديم ليكون تجديدا صادقا أصيلا "وإنه لشتان ما بين تجديد مخلص، يعرف القديم ويعمل على تطويره، وتجديد يبدأ من جديد قاطعا كل صلة بالقديم وأصله".
وما أحوجنا إلى استثمار علوم البلاغة وتطوير الدرس البلاغي وجعله يستجيب لطموحات الباحثين في الدراسات النصية العربية، لأن هذا الدرس يرشد المتكلم والمنشئ إلى التأليف وفق الاستعمال العربي الرصين، وأقول هذا وأنا أعلم ما يجري في الساحة العلمية من دراسات وأبحاث في مجال الأسلوبية، وفي مجال الدرس اللساني أيضا، كل ذلك من أجل بعث دم جديد في أوصال الدراسات العربية بشكل عام، ولن يحصل شيء يذكر في ذلك إلا بإدخال الاستعمال القرآني في مجال الدراسات البلاغية.
وختاما فإن عملية رصد تأثير القرآن الكريم في الدراسات البلاغية عملية صعبة وشاقة، لا يمكن الإيفاء بها في مقال متواضع مثل هذا، لأن ذاك مجال فسيح لأبحاث أكاديمية ضافية وواسعة، وحسبي أنني ذكرت بعض الخطوط العريضة للقضية التي اخترتها في هذا البحث، ومن شأن ذلك أن يعطي تصورا تقريبيا لذلك التفاعل الهام الذي حصل بين المسلمين وكتاب الله تعالى الخالد، وهو الكتاب الحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطها والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها.
وإذا رمنا بعثا وإحياء للدرس البلاغي فلا مناص من وضع القرآن الكريم في مقدمة الأولويات، فمنه خرجت علوم البلاغة وإليه تعود.
الهوامش
1. بكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن، بيروت: دار الشروق، ط، (1399ﮪ/1975م)، ص 11.
2. الرافعي، إعجاز القرآن بيروت: دار الكتاب العربي، ط 9، (1393ﮪ/1973)، ص 114.
3. السيوطي، الإكليل دار الكتب العلمية، ط 2، 1405.
4. من منهل الأدب الخالد للأستاذ محمد المبارك (نسخة مصورة ليس فيها ذكر مكان وتاريخ الطبع).
5. ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر 1984، 1/110.
6. محمد السائح، إعجاز القرآن، دعوة الحق، ع، 7، أبريل 1959، ص 20.
7. المقال السابق ذكره بالهامش 7.
8. د سر: ما تشد به الألواح من مسامير وغيرها.
الساهرة، الأرض البيضاء.
9. محمد السائح، إعجاز القرآن، م، س، ص 22.
10. البخاري وفضائل القرآن، 6.
11. الرافعي، إعجاز القرآن، م، س، ص 257.
12. محمد السائح، إعجاز القرآن، م، س.
13. المصباح المنير للفيومي مادة (بلغ).
14. الجاحظ، البيان والتبيين، دار الكتب العلمية (د، ت) 1/113.
15. المصدر نفسه، 1/161-162.
16. سعيد الأفغاني، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، الأستاذ دمشق 973، ص 242.
17. المرجع نفسه.
18. مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر (د. ت) ص 34-35.
19. السيوطي، الإتقان، بيروت: دار الثقافة، 1973 (2/117-118).
20. المصدر نفسه، 1/120.
21. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، موجز البلاغة ط، 1، تونس، د. ت، ص 6.
22. للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، تونس 1967، ص 222.