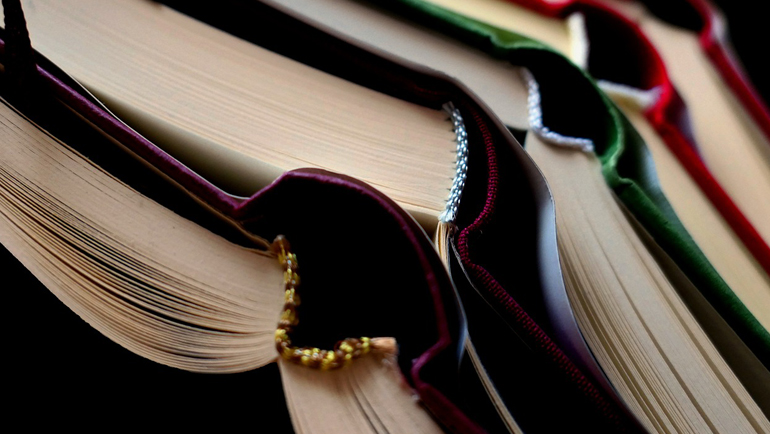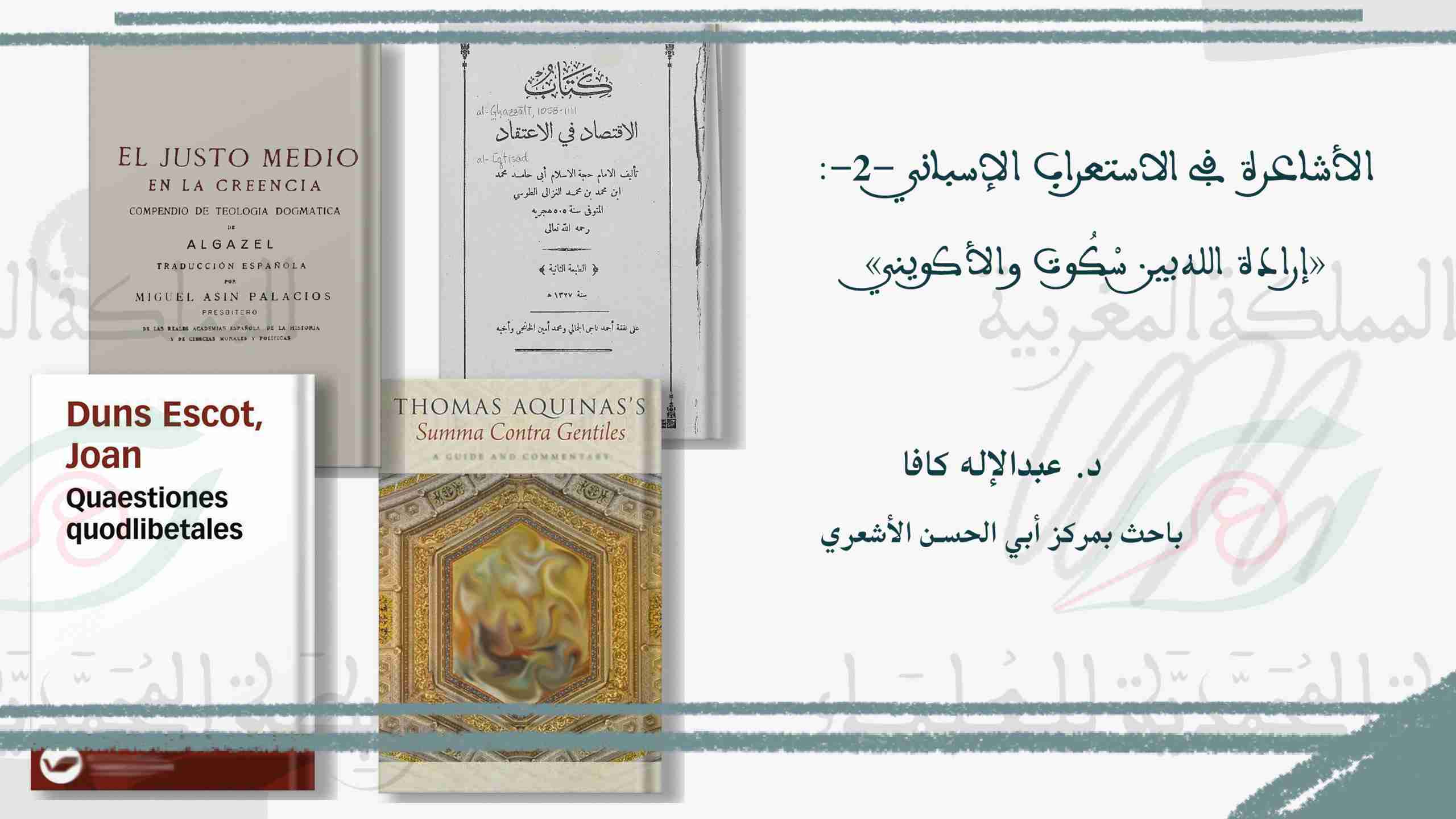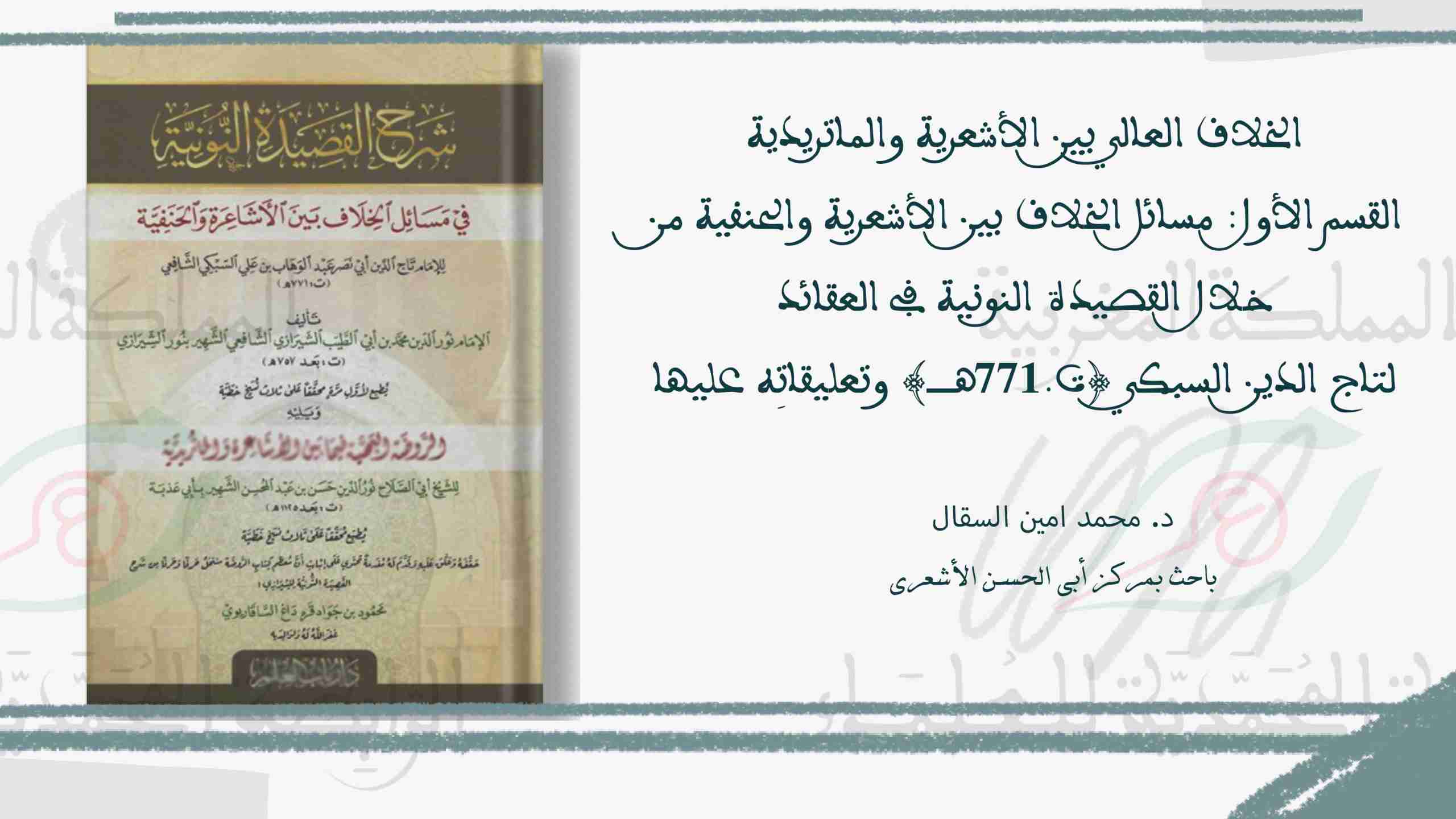المتن الصوفي وتعدد المشارب

تتسم التجربة الصوفية في حفرياتها الوجدانية بالتطابق بين العلم والعمل، وبين العقل والذوق، عبر صيرورة من التشكلات الوجدانية، والتحولات النفسية، التي بإمكانها إعادة صياغة المدارك الإنسانية والتصرفات السلوكية، وفق مكنونات الفطرة الروحية، ومنطلقات المعاني الأخلاقية. وذلك من خلال التجربة العملية الحية، التي من شأنها صناعة الأنموذج الإنساني، على هدي الشاهدية المثلى، ليس اقتصارا على مراسم الأخلاق البرانية، إنما –أيضا- على مبادئ القيم الجوانية، بحيث إن المعرفة الصوفية هي نتاج تفاعل بين الذات والنص، بين الظاهر والباطن، «فظاهر الأصول قول الشهادة، وباطنها تحقيق المعرفة، وظاهر الفروع القيام بالمعاملات، وباطنها تصحيح النية، ولا تقوم واحدة من هذه دون أخرى. فظاهر الحقيقة بلا باطن نفاق، وباطن الحقيقة بلا ظاهر زندقة، وظاهر الشريعة بلا باطن نقص، وباطنها بلا ظاهر هوس» [1]. وعلى أساس تكامل بنية العمل الصوفي، فإن المعرفة الصوفية مشدودة بين أساس الممارسة والنظر، متعالقة بين النص والمعنى، موصولة بين العقل والوجدان، يتمحض وجودها من خلال تعميل النصوص الأصلية وفق شرائط التجربة الحية. مما يبين أن المعرفة الوجدانية، والمعاني الذوقية، تُعتبر من سمات الممارسة الدينية الإسلامية، لما تنطوي عليه من روحيات متصلة بالأفق المطلق، فهي تحسن لمن تعمَّلها وفق آدابها وشروطها المرعية، بلطائف الحِكم، ودقائق المعاني، سماها بعضهم بـ «قوت القلوب» و«كشف المحجوب» و«عوارف المعارف» و«إيقاظ الهمم» و«الأنوار القدسية».. الخ.
ويبقى أن معاني التصوف تتلون على حسب شكل الإناء الذي تحل فيه، إما أخلاقيا أو تحقيقيا (الحقائق والشطحات)، فهي تقبل أن تتشكل وفق وجوه من المقاربات الخطابية، كما سار إلى ذلك أحدهم بكون «دقائق علم التصوف لو عُرِضَت معانيها على الفقهاء بالعبارة التي ألفوها في علومهم لاستحسنوها كل الاستحسان، وكانوا أول قائل بها، وإنما يُنَفِّرُهم منها إيرادها بعبارة مستغربة لم يألفوها، ولهذا قال بعضهم: الحقيقة أحسن ما يُعلم، وأقبح ما يُقال» [2]. لذلك فإن المتن الصوفي على الرغم من إشاريته في جوانب منه، فإن من الأخلاقيين من عمل على تقريب تلك المعاني الروحية بما يبرز دلالتها التربوية، ويمكن النظر في هذا السياق إلى تفسيرات الهجويري في كتابه «كشف المحجوب» الذي عمل على تبيان عبارات العارفين بما يُظهر عُمقها التربوي، فقد شرح كلام أبي يزيد البسطامي: «المعرفة أن نعرف أن حركات الخلق وسكناتهم بالله»؛ أن الإنسان لا يقدر على أداء أي عمل إلا إذا خَلَقَ فيه القدرة على العمل، ووضع إدارة العمل في قلبه، أن أعمال الإنسانية مجازية محضة، وأن الله هو الفاعل الحقيقي» [3] ، باعتبار أن الصوفي الشارح مُوجَّه بمقاصد التجربة الأخلاقية التي تعطي الأسبقية إلى المخاطَب المتلقي على حسب الذات العارفة.
مما يبين فاعلية التجربة الصوفية، أن نواتجها العرفانية بإمكانها أن تُصاغ بلسان مجالات علمية مختلفة، على اعتبار أن الروح الصوفية يمكن أن تُبَثَّ من خلال موضوعات علمية مختلفة، بما يبرز اللحمة الموصولة بين العلم والتصوف، أو بين العقل والذوق. «فللعامي تصوف حوته كتب المحاسبي، ومن نحا نحوه، وللفقيه تصوف رامه ابن الحاج في مدخله، وللمحدث تصوف حام حوله ابن العربي في سراجه، وللعابد تصوف دار عليه الغزالي في منهاجه، وللمتريض تصوف نبه عليه القشيري في رسالته، وللناسك تصوف حواه القوت والإحياء، وللحكيم تصوف أدخله الحاتمي في كتبه، وللمنطقي تصوف نحا إليه ابن سبعين في تآليفه، وللطبائعي تصوف جاء به البوني في أسراره. وللأصولي تصوف قام الشاذلي بتحقيقه، فليعتبر كل بأصله من محله» [4]. وعليه، فإن الصوفي يأخذ من ثقافة عصره، ويستعين بمعارف وقته، لصياغة المعاني الصوفية صياغة فكرية، وتشكيلها وفق مقاربة عقلية، قصد منحها مشروعية علمية، وتبقى روح الفكرة الصوفية بتجلياتها المعرفية لها خصوصية مميزة، ليست نتيجة نظر عقلي، ولا تأملات متخيلة، وإنما هي نواتج أذواق وأشواق، وتجارب وأعمال، ومقامات وأحوال، ومجاهدات ورياضات، وإن ساهمت القوة العقلية في منحها هذا الوجود والظهور، إلا أن لطائف المعاني الصوفية يستعصى عن إدراك مقاصدها، وتبين إشاراتها، واستجلاء عبارتها، بقوة الفكر والنظر المجرد، وذلك لتعذر مشاركة الصوفي مقتضى حاله، فمن لم يخرج إلى الاستغراق في العمل ويحصل التجربة، فلابد وأنه واجد الغموض في كل عبارة يلقيها إليه الصوفي، ولو أخرجها هذا له على وجوه متعددة، لأن الغموض ناتج عن تعذر المشاركة في التجربة الحية [5]. وعلى الرغم من أن المعرفة الصوفية موصولة بالعطاء الإلهي كشفا وإلقاء روحيا وإلهاما ربانيا، فإنها تبقى موصولة بالسياق الإنساني اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا، إسهاما منها في إعادة تقويم صيرورة الحياة الإنسانية وفق منطق القيم الأخلاقية، ورفع ما هو كائن إلى أفق ما ينبغي أن يكون.
الهوامش:
[1] الهجويري: كشف المحجوب، (ص 32-33). قال مالك بن أنس: «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، وتفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق». قواعد التصوف، أحمد زروق، (ص 25).
[2] عبد الله بن الصديق: الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام، (ص 62-63).
[3] الهجويري: كشف المحجوب، (ص 306).
[4] زروق: قواعد التصوف، (ص 108-109).
[5] طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل، (ص 165). محمد بن الطيب: أن النص الصوفي [يكون] قابلا للقراءة والتدبر والتأويل رغم صعوبته وخصوصيته. وحدة الوجود في التصوف الإسلامي، (ص 8).