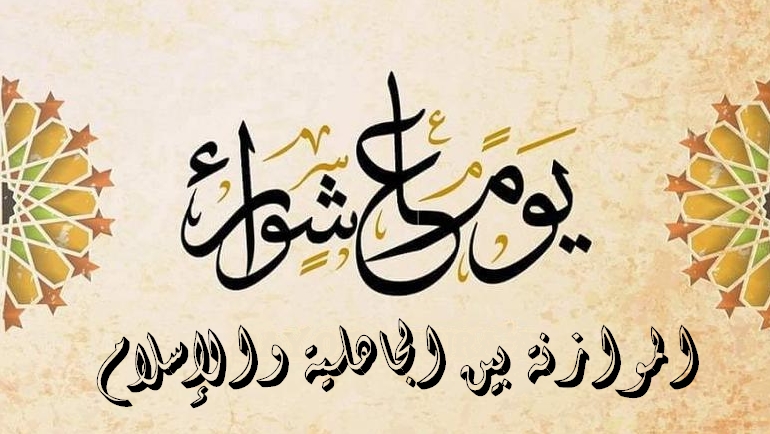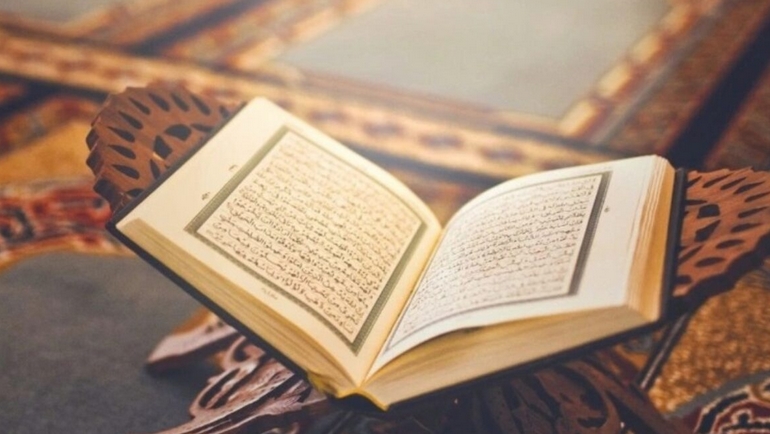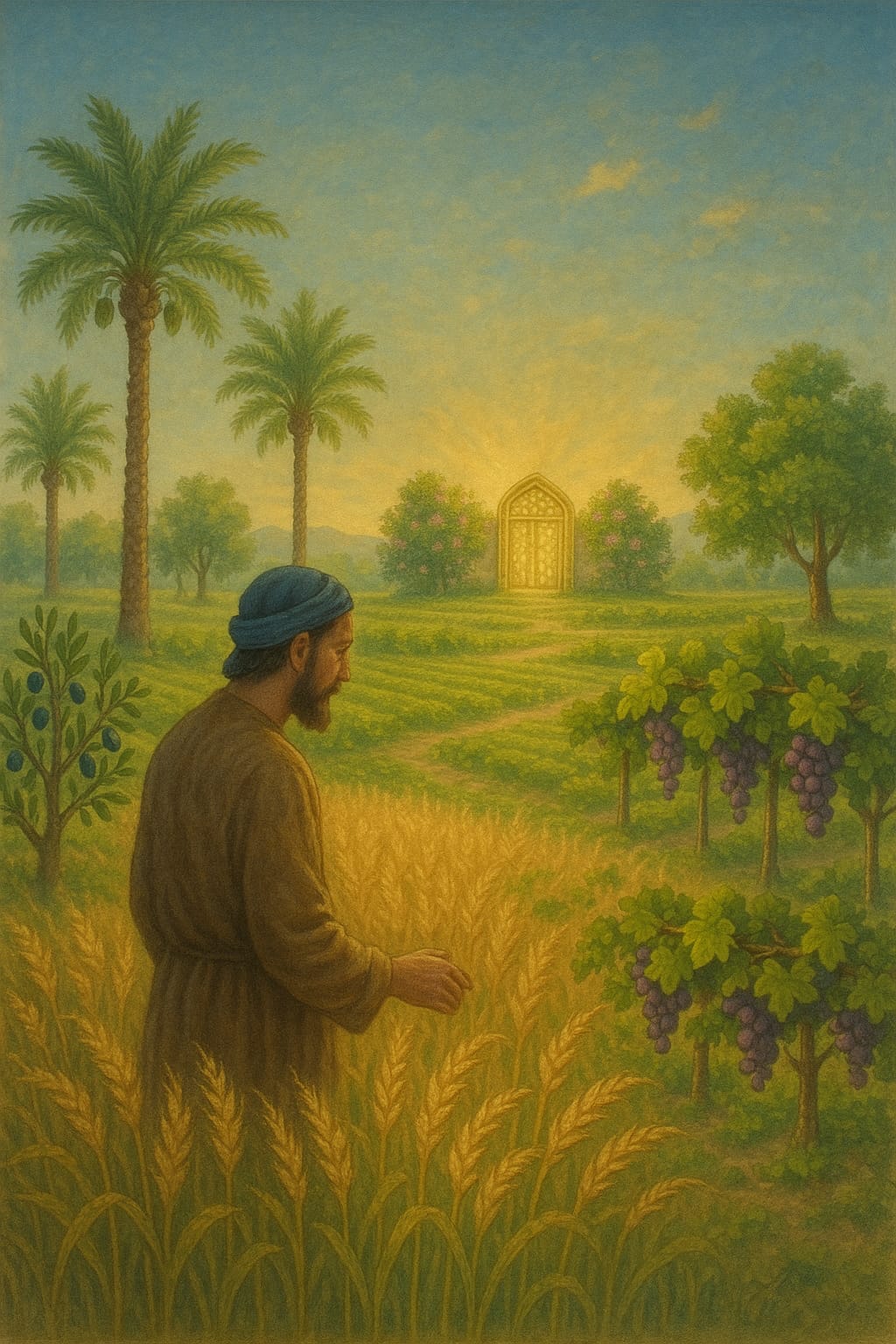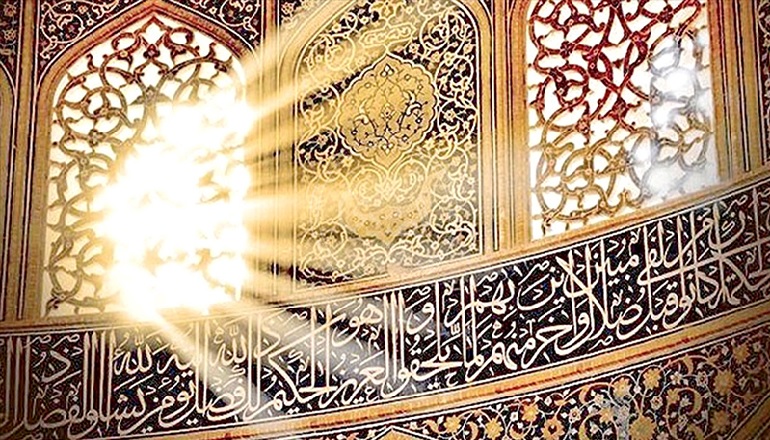الأشاعرة في الاستعراب الإسباني -2-: إرادة الله بين سْكُوت والأكويني
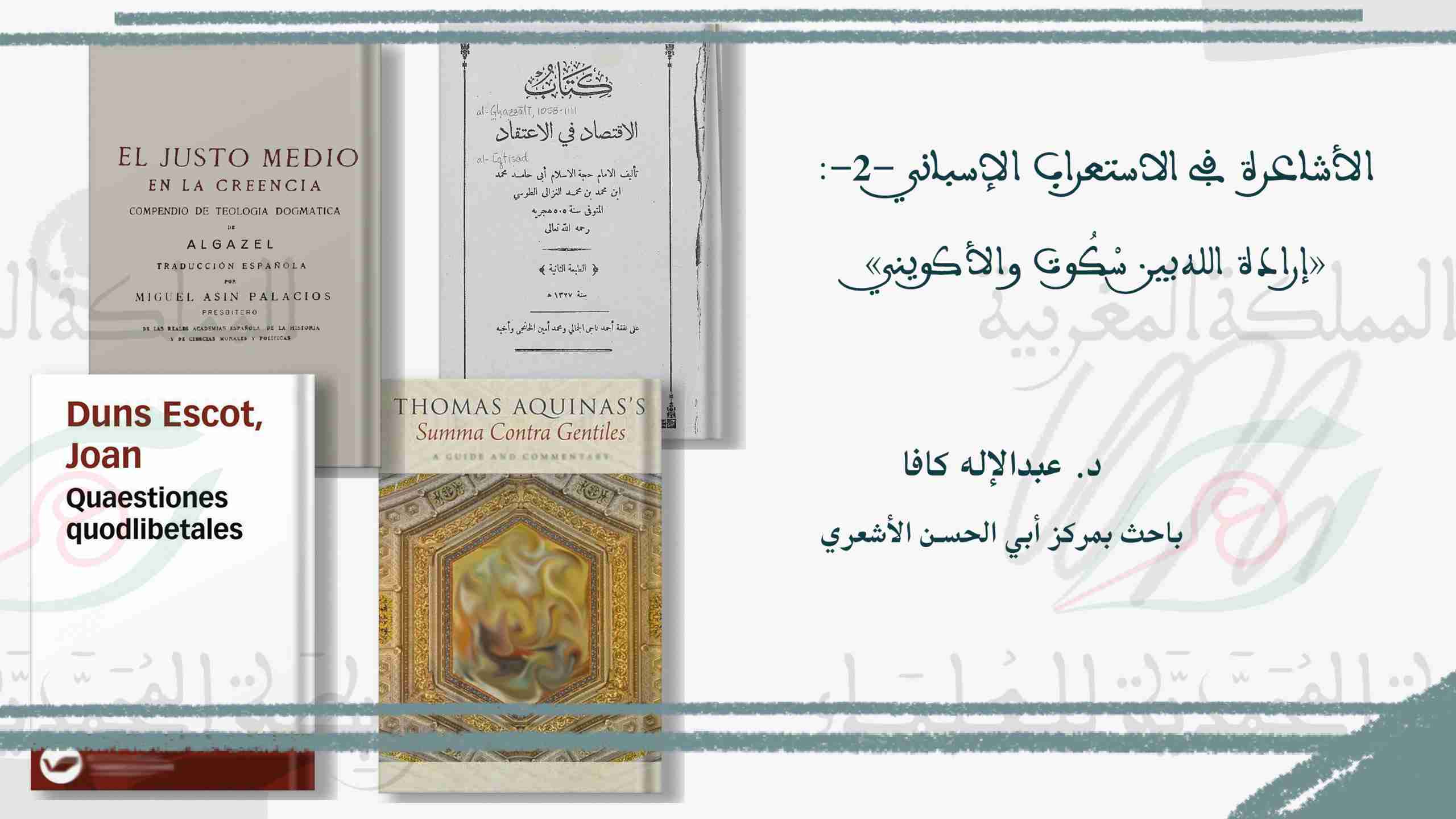
الأشاعرة في الاستعراب الإسباني -2-: إرادة الله بين سْكُوت والأكويني*
إعداد: د. عبدالإله كافا
باحث بمركز أبي الحسن الأشعري
***
في المقال السابق من هذه السلسة[1]، رصدنا حضور الغزالي –الذي لم يكن أندلسيا- عند بلاثيوس من خلال ترجمته لكتاب «الاقتصاد في الاعتقاد»، وتبينّا كيف أظهر ميغيل بلاثيوس في أعماله[2] عمقا فريدا في دراسة العقائد الإسلامية، حيث قارنها تحليليّا بنظيراتها المسيحية، كاشفا عن التأثيرات المتبادلة بينهما، وقد تميزت دراساته بمقدمات غنية بالمعلومات الدقيقة التي ربطت بين أفكار الأشاعرة والمعتزلة والمدارس المسيحية؛ مثل التوماوية والإسكوتية. وقد أعاد بلاثيوس قراءة النصوص الإسلامية بنظرة فاحصة، مبرزا أوجه التشابه والاختلاف في قضايا عقدية مثل العِلّية الإلهية والعدل، كما تضمنت أعماله إحالات موسعة إلى مصادر إسلامية ومسيحية، مقدماً كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي من حيث كونه مصدرا رئيسيا لفهم هذه التأثيرات.
بادئًا، ووفق بلاثيوس، تتجلَّى الأهمية التاريخية لكتاب «الاقتصاد» للغزاليal-iqtiṣād[3] بمجرد النظر الأولي إلى هيكل توزيع الموضوعات فيه؛ إذ يتطابق، وإلى حد كبير، مع منهجية الأطروحات الـمدرسية حول الإله الواحد Deo Uno. ويشتمل كتاب الاقتصاد على أربعة أقسام -أقطاب- رئيسية:
أولاً: في ذات الله؛ أي في وجوده، وأزليته، ولا مادّيته، وقيامه بذاته، وإمكانية معرفته، ورؤيته، ووحدانيته.
ثانياً: في صفات الله تعالى، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.
ثالثاً: في أفعال الله تعالى.
رابعاً: في النبوة ورسل الله.
إن التشابهات العامة التي يوحي بها هذا العرض الشامل مع أطروحات العقيدة المسيحية في العصور الوسطى تتبلور وتصبح أكثر وضوحا عند الخوض في كل موضوع على حدة، وهذا ما عرض له بلاثيوس في مواضع كثيرة بالإشارة إليها في الهامش بشيء من التفصيل؛ حيث يلفت فيها انتباه القارئ إلى نقاط التقاطع بين عقيدة الغزالي وعقيدة القديس توما الأكويني.
وبتتبع ما تمت الإشارة إليه في تلك الهوامش، يمكن إجمال الموضوعات التوماوية في كتاب «الاقتصاد» فيما يلي:
- مفهوم اللاهوت؛ 2. قيمة العقل الطبيعي في شرح أو إثبات إمكانية العقائد؛ 3. استخدام طريقة السلب[4] (via remotionis) في تكوين مفهوم الله؛ 4. إثبات وجود الله عبر فكرتي الإمكان والضرورة؛ 5. وحدانية الله المستندة إلى كماله المطلق؛ 6. مفهوم وإمكانية الرؤية[5] السعيدة (visio beatifica)؛ 7. القدرة الإلهية المطلقة في خلق الفعل الإنساني؛ 8. حياة الله كنتيجة لحكمته وقدرته؛ 9. علم الله الكلي؛ 10. أزلية وعلم الله السابق وإرادته الثابتة؛ 11. كلام الله المفهوم ككلمة عقلية (verbum mentis)، أي كلام الله النفسي؛ 12. العناية الإلهية وإدارة الله للكون؛ 13. عقيدة أسماء الله الحسنى؛ 14. مفهوم العدل فيما يتعلق بأفعال الله؛ 15. مفهوم المعجزة باعتبارها شهادة على صدق النبي وخروج عن النظام الطبيعي المألوف وتمييز المعجزة عن عجائب السحر؛ 16. إمكانية عقيدة بعث الموتى؛ 17. طبيعة فعل الإيمان وكيفية زيادته ونقصانه، وغير ذلك[6].
وعليه؛ أردت لهذا المقال أن يكون قراءة وتعليقا للمقدمة التي وضعها بلاثيوس في مطلع ترجمته لكتاب «الاقتصاد»، وبعض إحالاته على قضايا عقدية متعددة؛ حيث أتتبع المقارنات التي أجراها بين المدارس الكلامية الإسلامية (الأشاعرة، المعتزلة) وفلاسفة الإسلام، وتأثيرها على الفكر المسيحي المدرسي في العصور الوسطى، خاصة لدى كل من القديس توما الأكويني (ت.1274م) ودنس سكوت (ت.1308م)؛ حيث انعكست أفكار الأشاعرة (الإرادة الإلهية المطلقة) في المذهب الأسكوتي، بينما اقترب توما الأكويني من رؤية المعتزلة والفلاسفة (العقلانية الإلهية)[7]. كما يقصد المقال إظهار التشابه بين الجدل الإسلامي-المسيحي حول العِلّية والعدل الإلهي، كاشفا عن توظيف القديس توما الأكويني مصطلحات غامضة (مثل:[8]quorundam) للإشارة إلى خصومه من المتكلمين المسلمين دون تسميتهم.
يرى بلاثيوس أن القديس توما الأكويني، تجنب في أغلب الأحيان ذكر المدارس الفكرية -وحتى المفكرين أنفسهم- الذين يناقش آراءهم، إذ كان تركيزه منصبّا أساسا على الأفكار، غير آبه بالأشخاص، فهو ليس باحثا موسوعيا[9]، ولا مؤرخا يبحث عن أصول المنظومات الفكرية لتقييم المذاهب بناءً على انبثاقها من مبادئ محددة، فيصنفها على أنها أفلاطونية أو أرسطية أو رواقية أو أفلاطونية محدثة. بل هو مفكر موضوعي، إذا درس آراء الآخرين، فإنما يدرسها حصرا لاكتشاف الحقيقة فيها أو دحضها إذا رأى أنها خاطئة.
وهناك حالات كثيرة لهذا النفور من الاقتباس الاسمي، كان ينبغي لها أن تثير فضول الباحثين المدرسيين، ونقصد بذلك المقاطع المتكررة في كتاب «الخلاصة ضد الوثنيين» (Summa contra Gentiles)[10]؛ حيث يختتم القديس توما الأكويني الفصل من كتابه بالقول: إن الحجج المقدمة فيه تدحض -أو تستبعد أو تدمر أو تزيل- خطأ بعض الأفراد«quorundam» الذين لا يذكر أسماءهم ولا هوياتهم[11]. وفي أحيان أخرى، يستخدم نفس الأسلوب المتحفظ عند الاستشهاد بمدارس تدعم أخطاء معينة، مكتفياً بالقول ببساطة إن «هناك أفرادا معينين «quidam» يقولون أو يدّعون كذا وكذا[12]، أو يقدمون هذه الحجج أو تلك لدعم أطروحة معينة.[13]
وساق آسين أمثلة كثيرة، يبين فيها كيف أن القديس توما الأكويني أشار إلى فلاسفة الإسلام[14] عندما يرد على آراء المعتزلة؛ حيث كانت المذاهب الكلامية لهؤلاء تتشارك في العديد من النقاط مع آراء الفلاسفة المشائين، خاصة فيما يتعلق بموضوعي العدل الإلهي والقدرة المطلقة. ومن ذلك الفصول التي يرد فيها الأكويني على «خطأ بعض الذين يحاولون إثبات أن الله لا يستطيع أن يفعل... إلا ما يجب عليه فعله»
« error quorumdam probare nitentium quod Deus non potest facere... nisi quod debet ».[15]
فيعتبر أن كلا من المعتزلة والفلاسفة اتفقوا -على عكس الأشاعرة- في تصويرهم الإله موجودًا حكيمًا بالدرجة الأولى؛ أي أنه حكيم، عادل، وخيّر، تستند أفعاله تجاه مخلوقاته إلى المثال الأعلى للكمال والحكمة. أما الأشاعرة فكانوا على النقيض من ذلك، حيث تصوروا الإله فاعلاً مطلقًا بالدرجة الأولى، مطلق الإرادة وكلي القدرة، تنبثق أفعاله تجاه مخلوقاته حصـرا من إرادته المطلقة التي تعلو على أي قانون، غاية، أو عقلانية يمكن للعقل البشري أن يتصورها أو يحاول فرضها.[16]
كما يشير القديس توما إلى هاتين المدرستين المتناقضين؛ المعتزلة والأشاعرة، عندما يختتم الفصل التاسع والعشـرين من الكتاب الثاني من «الخلاصة ضد الوثنيين»[17] بهذه الكلمات: «وهكذا نستبعد من خلال ما سبق خطأ مزدوجاً: خطأ أولئك الذين يحدون القدرة الإلهية بقولهم إن الله لا يستطيع فعل إلا ما يفعله، لأنه يجب عليه فعله، وخطأ الذين يقولون إن كل شيء يتبع الإرادة المحضة دون أي غاية أو حكمة أخرى، سواء كانت مطلوبة في الأشياء أو معينة لها».
« Sic igitur per praedicta excluditur duplex error: eorum scilicet qui divinam potentiam limitantes dicebant Deum non posse facere nisi quae facit, quia sic facere debet, et eorum qui dicunt quod omnia sequuntur simplicem voluntatem absque aliqua alia ratione, vel quaerenda in rebus, vel assignanda » [18]
وفي مجموعة أخرى من الفصول التي يناقش فيها القديس توما مسألة حفظ الله للمخلوقات، والإشكالية المتعلقة بتداخل السببية والعلية الإلهية مع السببية والعلية الطبيعية، فإنه يشير مرارا إلى النظرية السببية الظرفية أو المناسبة[19] للأشاعرة La teoría ocasionalista de los Ashāʻirah[20]، لا سيما في الفصل التاسع والستين من الكتاب الثالث، المعنون: «بخصوص رأي أولئك الذين ينفون عن الكائنات الطبيعية أفعالها الخاصة».
« De opinione eorum qui rebus naturalibus proprias subtrahunt actiones » [21]
غير أن الإشارة هنا تكون أكثر وضوحاً؛ إذ يعود في متن الفصل إلى وصفهم بعبارة «بعض الـمُتَحدثين في شريعة المور»
« quidam loquentes in lege maurorum » [22]
وهي ترجمة شائعة للاسم الاصطلاحي «المتكلمون» [23]al-mutakallimūn الذي كان يُطلق أيضا على الأشاعرة[24].
وهذان الاتجاهان المتعارضان، المتكلمون الأشاعرة في مقابل المعتزلة والفلاسفة؛ يظهران تشابها كبيرا مع الاتجاهين اللذين ظهرا في المدرسية المسيحية خلال القرن الثالث عشر، واللذين يُطلِق عليهما المؤرخون اسميْ المذهب الإرادي (Voluntarismo) والمذهب العقلاني (intelectualismo)[25]. ولكي يتمكن الباحثون من دراسة الأصول التاريخية لهذين المذهبين الفكريين بدقة أكبر، فإن التعمق في أيديولوجية هاتين المدرستين الإسلاميتين -اللتين تقدمان نفسيهما للباحث في التاريخ على الأقل بمثابة أول من فتقَ النظريتين السابقتين- سيكون أمراً بالغ الأهمية.
يقع فكر القديس توما الأكويني في موقع وسطي بين هذين الاتجاهين، مساوياً في البعد عن التصور الأشعري والمعتزلي، وإن كان يميل قليلا نحو المدرسة الأخيرة (المعتزلة والفلاسفة). أما دنس سكوت (المتأثر بالأشاعرة)، فيبدو أكثر تعاطفاً مع الرؤية الأشعرية[26]؛ حيث إن النظام اللاهوتي لهذا الأخير يعكس بأكبر قدر من الأمانة -حسب بلاثيوس- تصور المدرسة الأشعرية لمفهوم «الإرادة الإلهية»، فبالنسبة لسكوت -كما هو الحال لدى الأشاعرة- يعتبر النظام الفيزيائي للكون، في ذاته، احتماليا بالكامل، يعتمد فقط على الإرادة الإلهية الحرة، التي يمكنها أن تريد كل الممكنات التي يتيحها علمها اللامتناهي، أي كل ما لا ينطوي على تناقض بالنسبة لعقل الله. ومن هنا؛ فإن القوانين الفيزيائية تفتقر في ذاتها إلى الانتظام الضـروري الذي يُفترض وجوده فيها، إذ كان بإمكان الله أن يخلق الكون منظما وفق نظام مختلف عن النظام الحالي، بل حتى داخل النظام الحالي نفسه، كما يمكنه أن يلغيَ أو يوقفَ أو يعدّل النظام الحالي للطبيعة بحرية، وإن كان في الواقع يحافظ عليه دون تغيير.[27]
يتّبع سكوت، والأشاعرة، المعيار الإرادي نفسه في مجال الأخلاق، حيث يجعل من الوحي الإلهي -باعتباره تعبيرًا عن الإرادة الحرة لله- الأساس النهائي لحسن الأفعال البشرية وقبحها. فالقانون الأخلاقي، مجردا عن كونه تعبيرا عن أحكام العقل الطبيعي فيما يتعلق بالعدل والظلم؛ يفتقر إلى الضـرورة والإلزام في ذاته، لأن العقل البشـري -مثل كل المخلوقات- احتمالي، وبالتالي فإن قراراته تخلو من أي صفة إيجابية ومحددة، ما لم يمنحها الله -بإرادته الحرة- الضـرورة التي تفتقر إليها بذاتها.
رغم أن ميتافيزيقا الاحتمالية، التي تميّز المذهب الإرادي عند دنس سكوت، من أكثر إبداعاته أصالة. إلا أنه لا بد من الاعتراف بأنها تعكس -بدرجة واعية أو غير واعية- الأطروحة الأساسية للأشاعرة، التي عبّروا عنها بالمصطلح العربي «التجويز» at-tajwīz[28]، والتي يمكن صياغتها بالقول: «كل شيء في الكون قد يحدث بشكل مغاير للمألوف، لأن كل شيء مرهون بالإرادة الحرة لله».[29]
ونختم باستعراض النتائج العامة للمقارنات التي أنجزها بلاثيوس بين التوماوية والإسكوتية من جهة وبين المدارس الكلامية (الأشاعرة، المعتزلة) والفلاسفة المسلمين من جهة أخرى:
- العقل والإرادة الإلهية بين الأكويني وسكوت.
| جون دنس سكوت (الإرادي) | توما الأكويني (العقلاني) | القضية |
| الإرادة أعلى من العقل ومستقلة عنه | العقل يوجه الإرادة (الإرادة العاقلة) | الإرادة في مقابل العقل |
| إرادة الله حرة وغير مشروطة بالعقل | الله يختار الخير وفق الحكمة لأنه عاقل وحكيم | إرادة الله |
| الخير والشر يُحددان بإرادة الله | الأخلاق مبنية على العقل الإلهي | الأخلاق |
| الإنسان حر تمامًا في اختياره | الحرية ضمن إطار العقل والناموس الطبيعي | الحرية البشرية |
- العقل والإرادة الإلهية بين الأشاعرة والمعتزلة وفلاسفة المسلمين.
| موقف فلاسفة المسلمين | موقف المعتزلة | موقف الأشاعرة | القضية |
| الله عاقل بالضرورة (حكيم لا يعبث) | الله يجب أن يفعل الصلاح (بحكم العقل) | الله يفعل ما يشاء (الإرادة مطلقة) | إرادة الله |
| العقل يدركها (انطلاقًا من نظام الكون) | العقل يحكم بها قبل الشرع | الشرع يُحددها (لا حكم للعقل فيه) | الحسن والقبح |
| محدودة (ضمن نظام العلة والمعلول) | حرية مطلقة (الإنسان خالق أفعاله) | "كسب" غير حر (الله خالق الأفعال) | حرية الإنسان |
بعد قراءة هذا من خلال كتاب الاقتصاد في الاعتقاد يتضح أن الفكر اللاهوتي لتوما الأكويني ضمَّ عناصر إسلامية، ليست فلسفية فحسب؛ بل ولاهوتية أيضا، وإن بدرجة محدودة، حسب التحفظات والتفاعلات المشار إليها سابقا. أما المذهب الإرادي عند دنس سكوت ومدرسته، فيظهر في الاقتصاد كصدى أمين لعقيدة الأشاعرة لاهوتيي أهل السنة في الإسلام.
***
* شكر وعرفان: أتوجه بالشكر الجزيل إلى زملائي الباحثين في مركز أبي الحسن الأشعري؛ الأستاذ منتصر الخطيب على تكرمه بالمراجعة والتدقيق، والأستاذ محمد الراضي على العناية والتجويد والإثراء. وأما ما قد يشوب هذا العمل من نقص أو خطأ، فالمسؤولية عنه تقع على عاتقي وحدي.
[1] منشور على موقع مركز أبي الحسن الأشعري، ضمن سلسلة « الأشاعرة في الاستعراب الإسباني -1- [الغزالي عند بلاثيوس من خلال كتاب: الاقتصاد في الاعتقاد]»؛
https://www.arrabita.ma/blog/حضور-العقيدة-الأشعرية-في-الاستعراب-ال/
[2] وقد سردت أبرزها في المقال السابق، في كل من مجالات التصوف؛ الفلسفة الإسلامية؛ اللاهوت والعقائد.
[3] يكتبها بلاثيوس Ictisad، والمثبت أعلاه هو الصواب بالنظر إلى قواعد النقل الصوتي للحروف العربية.
[4] انظر الهامش التالي.
[5] رؤية الله في الآخرة. نلاحظ أنَّ طريقة السلب تخص كل الفصول التي ضمنها الغزالي القطب الثاني من كتاب الاقتصاد، عدا الدعوى الأولى والثانية والثالثة، وهي، كما يرى القارئ، دعاوى في لا مادية الله.
[6] Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia, Madrid: Imprenta de Estanislao Maestre, 1929), 10, 11.
[7] ينظر الهامش [25].
[8] كلمة لاتينية تعني: بعضُهم أو بعض الأفراد.
[9] Erudito
[10] Tomás de Aquino. Suma contra los gentiles. Traducido por Miguel Oderberg. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2014.
ترجم إلى العربية في مجلد واحد، بعنوان: مجموعة الردود على الخوارج (فلاسفة المسلمين)، توما الأكويني (ت.1274م)، ترجمة وتعليق: المطران نعمة الله أبي الكرم، دار ومكتبة بيبليون، جبيل-لبنان، سنة: 2008.
[11] Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia, 12.
[12] Ibíd.
[13] يمكن الاطلاع على نماذج من هذا النوع من الاقتباس من خلال:
Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, I. I, a. 23, 63, 66, 69, 79, 87; I. II, c. 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 38; I. III, c. 65, 69, 71, 129. (citado en Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia, Madrid: Imprenta de Estanislao Maestre, 1929), 12.
[14] للإشارة فإن بلاثيوس يستخدم لفظ Falasifa del Islam ، عوض Los filósofos musulmanes، وهذا أمر ملحوظ في جل أعماله، حيث يستخدم transliteración؛ أي نسخ كتابة اللغة العربية بحروف اللغة الإسبانية.
[15] Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, I. II, c. 28, 29 (citado en Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia), 12.
[16] Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia, 13.
[17] سبقت الإشارة إلى عنوان الكتاب في الترجمة العربية في الهامش رقم [9].
[18] Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, I. II, c. 28, 29 (citado en Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia), 14.
[19] يقصد بالنظرية السببية الظرفية/المناسبة كلا من مفهوم العادة ونظرية الكسب عند الأشاعرة؛ لكنهما لا يستويان تمامًا؛ حيث يشتركان في كونهما الإطار الفلسفي الذي يفسر العلاقة بين الله والعالم، ويعتبر الكسب التطبيقَ العملي لهذا الإطار فيما يتعلق بأفعال الإنسان. ينظر: أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة: باب الإرادة، 46-53. أبو بكر الباقلاني، التمهيد في الرد على الملحدة والمعتزلة والخوارج والرافضة، 120-130 و200-201. أبو المعالي الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، 79-106. انظر جميل صليبا، المعجم الفلسفيّ، ج. 2: 32-33.
[20] يكتبها بلاثيوس: Los axaries
[21] Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, I. II, c. 28, 29 (citado en Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia), 14.
[22] Ibíd.
[23] يكتبها بلاثيوس: motacálimes
[24] في غير ما موضع؛ يرادف بلاثيوس بين الأشاعرة والمتكلمين، بل إنه يخرج المعتزلة من طائفة المتكلمين، باعتبارها فرقة عقلانية بين المتكلمين والفلاسفة.
[25] هكذا عند بلاثيوس intelectualismo، وعليه يكون الصواب هو المذهب الفكري، مع العلم أن المذهب العقلي (Racionalismo) والمذهب الفكري (intelectualismo) ليسا نفس الشيء، لكن يبدو أنه يقصد المذهب الفكري اللاهوتي للقديس توما الأكويني، المتمثل في موقفه من العلاقة بين العقل والإرادة، سواء في الإنسان أو في الله، وهو الموقف المتوسط بين العقلانية الصارمة والإرادية المطلقة.
[26] Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia, 15.
[27] Ibíd. 15 16.
[28] عند بلاثيوس tachuiz.
[29] Miguel Asín Palacios, El Justo Medio En La Creencia, 16.