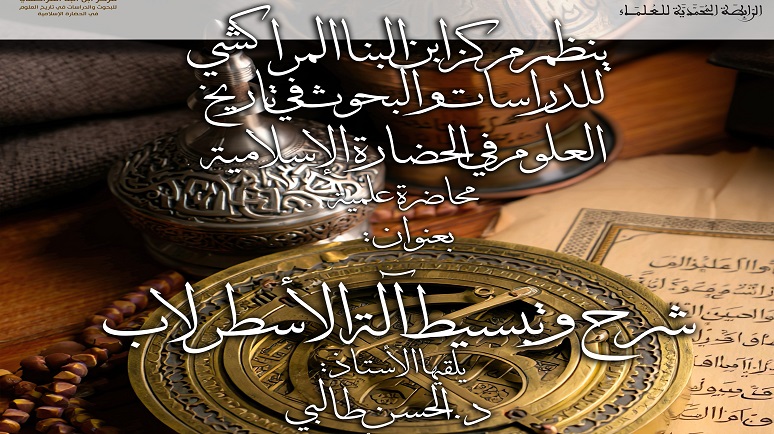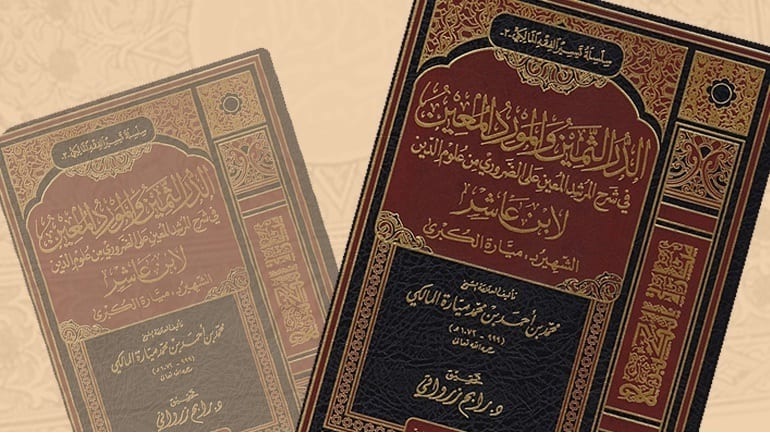تقريب نظم ابن عاشر شذرات من شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس على توحيد ابن عاشر(13)
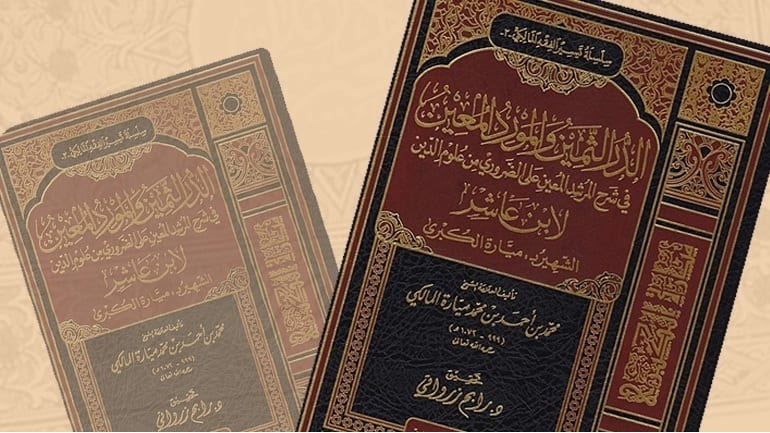
فأما العقل فقال الشارح: "قال بعضهم: وقد اختلف الناس في العقل من جهات شتى هل له حقيقة تدرك أم لا، وعلى أن له حقيقة تدرك هل هو جوهر أو عرض، وهل محله الرأس أو القلب، وهل العقول متفاوتة أو متساوية، وهل هو اسم جنس أو جنس أو نوع، فهذه أحد عشر قولا. ثم القائلون بالجوهرية والعرضية اختلفوا في رسمه على أقوال شتى أعدلها قولان، قال أصحاب العرض: هو ملكة في النفس بها يستعد للعلوم والادراكات، وقال أصحاب الجوهر: هو جوهر لطيف تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدات، خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلب". انتهـى. وعلى هذين القولين اقتصر سعد الدين في شرح النسفية.
القاموس: "الحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية، وابتداء وجوده عند اجتنان الولد، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ". انتهـى.
قال في التنوير: والعقل أفضل ما من الله به على عباده، فإنه سبحانه لما شرك جميع الموجودات في نعمتي الإيجاد والإمداد كما قد يفهم من قوله: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾[1]، وأراد أن يميز بعضها عن بعض ليٌظهر سعة تعلقات إرادته واتساع مشيئته، فميز بعض الموجودات بالنمو كالنبات وسائر الحيوانات، فظهرت القدرة فيه ظهورا أجلى من ظهورها فيما لا ينمو من الكائنات، ولما اشترك النبات في النمو مع سائر الحيوانات أفرد الحيوانات بوجود الحياة، فظهرت القدرة فيها ظهورا أجلى من ظهورها في الناميات، فأراد أن يميز الآدمي عن سائر الحيوانات، فأعطاه العقل، ففضَّله بذلك على الحيوان، وكمل به نعمته على الإنسان، وبالعقل ووفوره وإشراقه ونوره تتم مصالح الدنيا والآخرة. انتهـى ببعض اختصار.
وقال بعضهم: والعقل على [ثلاث] مراتب: عقل تمييز، وعقل تكليف، وعقل تشريف.
فعقل التمييز يشترك فيه الحيوان الناطق [89] وغيره، بل غير الناطق يخرج به من بطن أمه كالسخلة[2]، أو من البيض كفرخ الدجاجة فيميز بين ما يضره وما ينفعه، والآدمي ليس له بعد خروجه من البطن إلا قدر ما يلتقم به الثدي، ثم يتدرج إلى أن يصير إلى مقام السبر وغيره من الحيوان لا يزيد على ذلك، وإن زاد فيسير.
وعقل التكليف ولا يحصل غالبا إلا عند سن البلوغ، وهو الذي يحصل به التفرقة بين الواجبات العقلية والشرعية والعادية، والمستحيلات والجائزات العقلية والشرعية والعادية.
وعقل التشريف وهو لمن عمل بما علم؛ (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)[3]، وقد قال تعالى:﴿[وعلمناه] من لدنا علما﴾[4]، فهو العلم الذي يختص به الأنبياء والأصفياء صلوات الله عليهم أجمعين.
وقال الشيخ زروق في شرح الحكم: "العقل على قسمين: غريزي وكسبي، فالغريزي هو القوة المستعدة لقبول العلم وإدراك الأشياء على ما هي عليه، ومن ذلك إدراك أن الباقي خير من الفاني وأن الدنيا زائلة فانية، وعلامة ذلك وجود النفرة عنها وعكسه، دليل العكس قال الله تعالى: ﴿فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم﴾[5]، وسمي العقل عقلا لأنه عقال للنفس عن الدناءات والخسائس، ومن ذلك الفرح بالفاني وإيثاره على الباقي، فوجب التبرم من ذلك والتنصل منه لما هو عليه من الخساسة والدناءة، كما قال بعضهم: تركت الدنيا لسرعة فنائها وكثرة عنائها وخسة شركائها". انتهـى باختصار. ولم يتعرض لبيان العقل الكسبي.
ولبعضهم في فضل العقل الكامل:
وأفضل قسم الله للمرء عقله وليس من الأشياء شيء يقاربه
إذا كمَّل الرحمن للمرء عقلَه فقد كمُلَت أخلاقه ومآربـــــــه
وقد أثنى الله تعالى على أهل العقول الكاملة، ووصفهم بأنهم الآخذون بأحسن الأمور عند استماعها، فقال:﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب﴾[6]، فالعاقل هو المتصفح للأمور بعقله، الآخذ منها بأوفره، ولا يرضى بالنقص والتقصير، فلا يرضى أن يشغل نفسه بقليل زائل ويسير حائل يصده التشاغل به والعمل له عن أمور الآخرة التي يدوم نعيمها ونفعها، ويتأبد سرورها ويتصل بقاؤها، فالزهد في الدنيا من قضايا العقل.
قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: للعقل ألف اسم، ولكل اسم منه ألف اسم، أوَّلُ كل اسم منه ترك الدنيا. وقال الحسن: كيف يسمى عاقلا وهو يمسي ويصبح في الدنيا ومباهاة أهلها في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، أولئك هم الخاسرون، وأولئك هم الغافلون، وأولئك هم الجاهلون. انتهى.
الهوامش:
[1]- سورة الأعراف، الآية: 156.
[2]ـ- السَّخْلَة: الذَّكْر والأنثى من ولدِ الضأن والمَعز ساعَة يولَدُ والجمع: سَخْل، وسِخال، وسُخْلانٌ..
[3]- أورده أبو نعيم في الحلية، أحمد بن أبي الحواري ومنهم الزاهد في السراري النابذ للجواري العابد في القفار والبراري، رقم: 14320، بلفظ: "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ صَالِحِ بْنِ هِلَالٍ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: "الْتَقَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ: يَا أَحْمَدُ، حَدِّثْنَا بِحِكَايَةٍ سَمِعْتَهَا مِنْ أُسْتَاذِكَ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ، قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ بِلَا عَجِبٍ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَطَوَّلَهَا بِلَا عَجَبٍ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: إِذَا اعْتَقَدَتِ النُّفُوسُ عَلَى تَرْكِ الْآثَامِ جَالَتْ فِي الْمَلَكُوتِ وَعَادَتْ إِلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ بِطَرَائِفِ الْحِكْمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يؤَدِّيَ إِلَيْهَا عَالِمٌ عِلْمًا قَالَ: فَقَامَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَلَاثًا وَجَلَسَ [ص:15] ثَلَاثًا وَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيَ الْإِسْلَامِ حِكَايَةً أَعْجَبَ مِنْ هَذِهِ إِلَيَّ". ثُمَّ ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ». ثُمَّ قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ: صَدَقْتَ يَا أَحْمَدُ، وَصَدَقَ شَيْخُكَ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نُعَيْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَوَهِمَ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ هَذَا الْإِسْنَادَ عَلَيْهِ لِسُهُولَتِهِ وَقُرْبِهِ، وَهَذَا الحَدِيثُ لَا يُحْتَمَلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ". وذكره الغزالي في الإحياء، قال العراقي: "وأورده صاحب القوت بلا سند إلا أنه قال: بما يعلم بدل بما علم. تخريج الأحياء 28/3.
[4] - سورة الكهف، الآية: 65.
[5] - سورة النجم، الآية: 29، وجزء من الآية: 30.
[6] - سورة الزمر، الآية: 18.