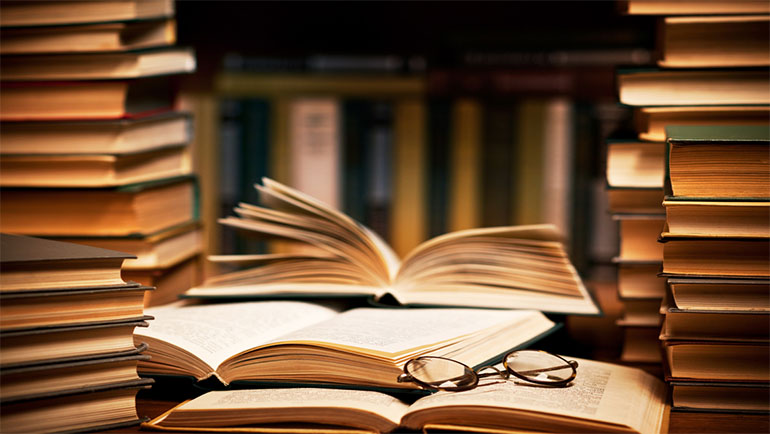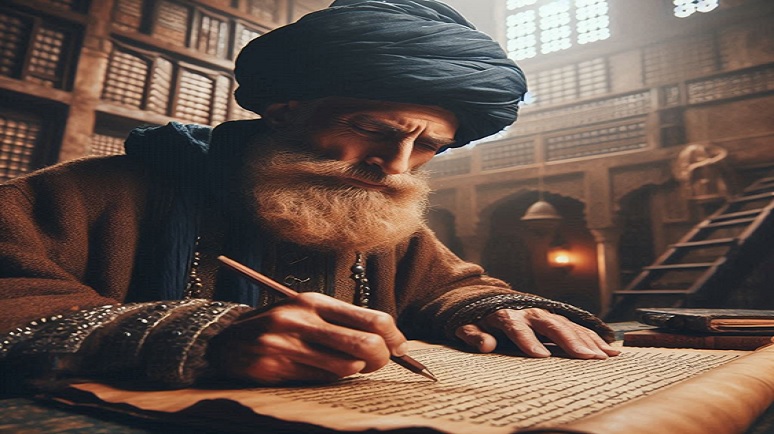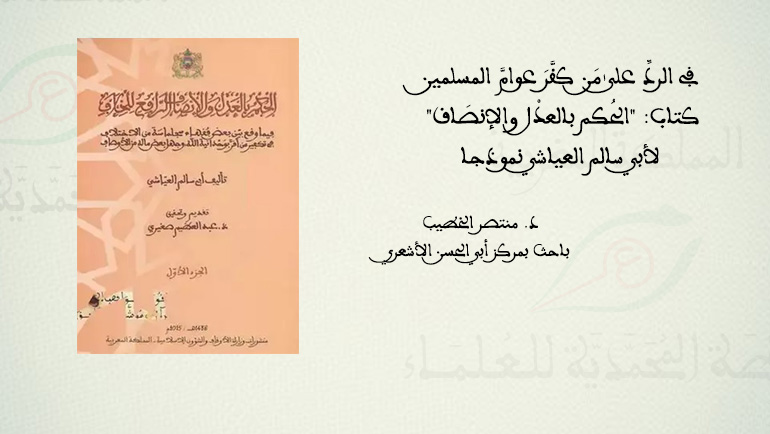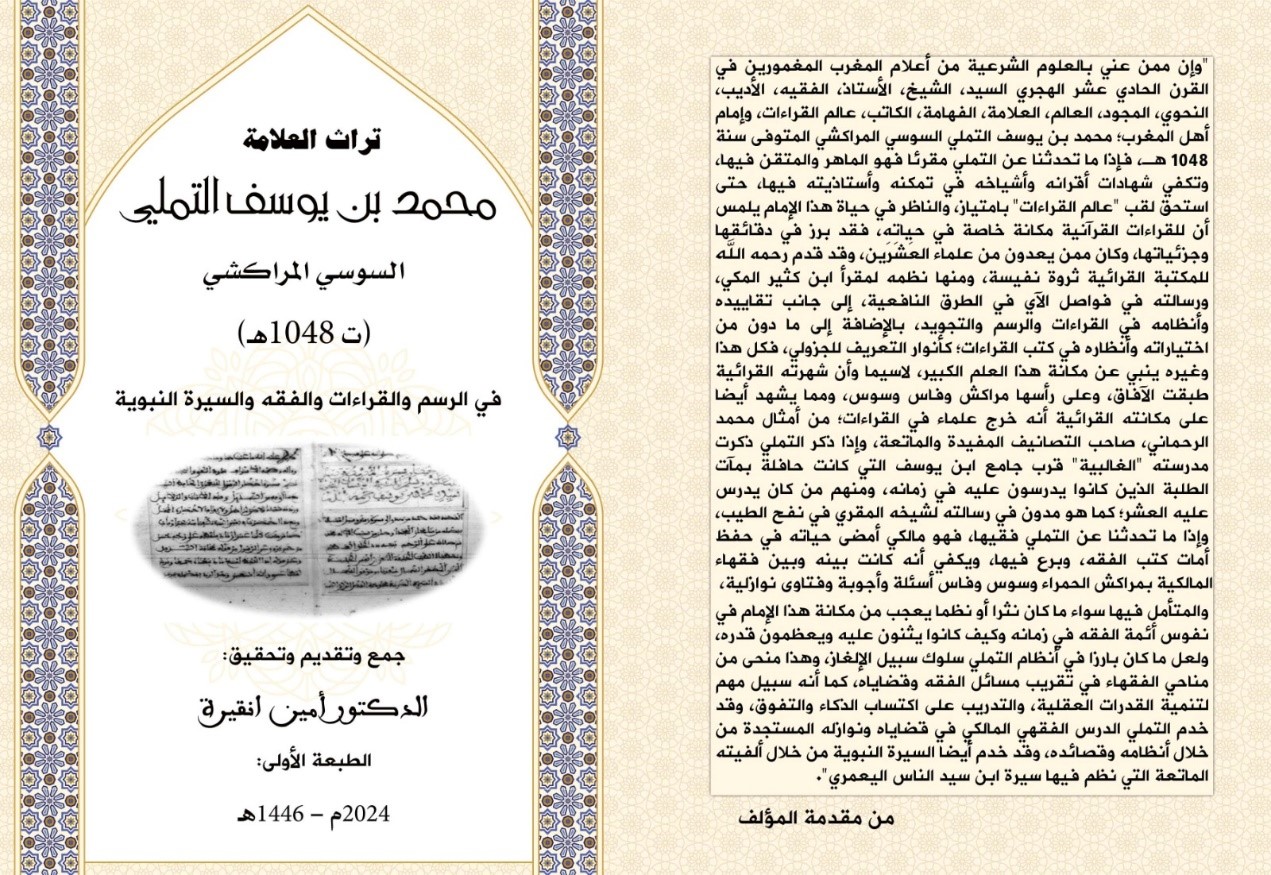أسْرارُ البَيانِ في القُرآنِ(41) البَيانُ في كَلمَةِ(الحَيَوَان) في قَولهِ تعَالَى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
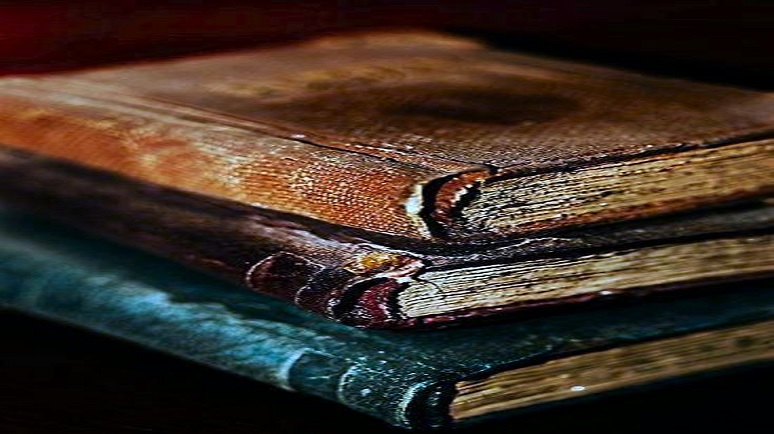
وذلكَ قولُه تعَالى في سُورَة (العَنْكَبُوت): ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾. فأنتَ تجدُ في الآيةِ هَذهِ المقابَلةَ البَليغَة بَينَ الدُّنيا والآخرَة، علَى نَظمٍ بَديعٍ، كَثيفِ الأَفَانين، منْ إِشارةٍ ونَفيٍ وحَصرٍ وتَوكيدٍ، لَطيفِ المعَاني، مُنفَسحِ الدّلالاتِ، تَستقْطِبُـها بُؤرةٌ جَامعةٌ لكلّ مَعاني التَّخليصِ والاصْطِفاءِ، إبرَازاً لأَفضَليّةِ الآخرَة وخَيْـــريّـــتِــها. تلكَ الخَيريّةُ الّتي عبَّـر عنهَا القُرآن الكريمُ في آياتٍ، منهَا قولهُ تعَالى علَى نَسقٍ قريبٍ منْ هذهِ، وذلكَ في سُورَة (الأنعَام): ﴿وَمَا الحَيَاةُ الدُّنيَا إلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِـمَنِ اتَّقَى﴾. وَآخرُها في سُورَة (الضُّحَى): ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾.
وكانَ ممّا زادَ من قُوّة البَيانِ لهَذهِ الخَيريَّة لِلآخرَة، تَعظيماً لشَأنهَا، مَا سبقَ منْ ضَمَائمَ نَظميّةٍ تَبعثُ في نَفسكَ إحْساساً بِتحقِير (الدُّنيا) واسْتصْغَار شَأنِها، وذَلك بأنْ ضُمَّ إليهَا اسمُ الإشَارَة (هَذِهِ): ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنيَا﴾، وهيَ هُنا إشارةُ امتِـهانٍ وازْدرَاءٍ، منْ عُلُوٍّ إلَى دُنُوٍّ. كالّذي تَجدهُ فيمَا حكَى القُرآنُ الكريمُ، ممّا تصوَّرهُ كفّار قُريشٍ من بَاطلِ سَفاهَتهِم، في كَلامِهم عنِ النَّبيّ، صلّى اللهُ عليهِ وسَلّم، بقَولهِ: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤاً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً﴾. أَوْ في قَول (إبْلِيس)، وقَدِ استَكبَر، عَن آدمَ عليهِ السّلام: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾.
ثمّ انظُر إلى ضَميمَة النَّفي (مَا) معَ أداةِ الحَصرِ (إلَّا)، وكيفَ أفادَت حَصرَ (الحَياة الدُّنيا) في (اللَّهْو واللَّعِب)، وكأنّها ليسَ فيهَا من شَيءٍ غير ذَلكَ، إمْعاناً في تَحقِيرها، ومُبالغةً في استِصغَارهَا. ثمَّ يتلُو كلَّ ذلكَ نَسَقٌ منَ التَّوكيدِ علَى رَتَلٍ فَريدٍ، تَصدَّرَهُ حرفُ التَّوكيدِ (إنَّ)، فغَلَبتْ علَى (اللّام) فَدفعَتها نَحوَ الخَبَر، أَوْ لِنَقُلْ زَحْلَقَتْهَا، فهيَ (اللّامُ الْـمُزَحْلَقَة). وذلكَ في قولهِ تعَالى: ﴿وَإنّ الدّارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾؛ إذِ (اللَّام) هيَ لامُ الابْتِدَاء، فلَها الصّدَارَة، وكأنَّ الكلامَ كانَ: (لَلدَّارُ الآخرَةُ هيَ الحَيوَانُ). فلمّا دَخلتْ (إِنَّ)،خَلَصَتْ لها الصَّدارَة، وثَقُل أنْ يَجتَمعَ في صَدرِ الكَلامِ تَوكيدَان، فاقْتسَمَتا الكَلامَ وأخَذَتَاه منْ طَرفَيْهِ، فكانَ أشَدَّ في التَّوكيدِ، وأَوغَل في المبالغَة.
ثمَّ هَذا القَصْرُ البَلاغِيّ الخَفيُّ الَّذِي أَفَادَهُ الضَّميرُ (هي)، والَّذِي يُسَمّيهِ البَصريُّونَ (ضَمير الفَصْلِ)، لأنّهُ يَأتي فَاصلاً بينَ (المبتدَأ) و(خَبَرهِ)، ويُسمّيهِ الكُوفيُّونَ (ضَمِيرَ العِمَادِ)،لأنّه يُعتمَدُ عليهِ في إدرَاكِ المعنَى المقصُودِ. قالَ (الرَّضيُّ الإسْترَابَاذيّ) في (شَرح الكافِيَة): «يُسمّى (فَصْلاً)، هذَا في اصطلاحِ البَصريّينَ، قالَ المتأخّرُون: إنّمَا سُمّيَ فصلاً، لأنّهُ فُصِلَ بهِ بينَ كونِ ما بَعدَهُ نَعتاً، وكونِهِ خَبَراً، لأنكَ إذَا قُلتَ: زَيدٌ القَائِمُ، جَاز أنْ يَتوهّمَ السَّامعُ كَونَ (القَائِم) صفَةً فيَنتَظرُ الخَبَــرَ، فَجئتَ بالفَصْل، ليَتعيَّنَ كَونُهُ خَبراً، لا صفَةً... والكُوفيّون يُسمُّونهُ عمَاداً، لكَونهِ حَافظاً لما بَعدهُ، حَتّى لا يَسقُط عنِ الخَبريَّةِ، كالعِمَاد للبَيْتِ، الحَافظِ للسَّقْف منَ السُّقُوطِ». وهوَ ضميرٌ لا مَحلّ لهُ منَ الإعرَابِ، وإنَّما يُؤتَى بهِ تَوكيداً وتَقويَةً للمَعنى، ودَلالةً على القَصْر؛ إذْ يَقوَى معهُ التّوكيدُ حتّى يَصلَ إلى الاخْتِصاصِ والتّفرُّد ونَفي المشارَكةِ في الصِّفَة. تَماماً كما تجدُه في الفَرق بينَ قولهِ تعالى في سُورَة (الجُمُعَة): ﴿وَاللهُ خَيْـرُ الرَّازقِينَ﴾، وقولهِ تعالَى في سُورة (الحَجّ)، بنَظمٍ أَقوى وتَوكيدٍ أنفَى لغَيرهِ: ﴿وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِينَ﴾. فأنتَ إذَا قُلتَ مَثلاً: (المتَنَبِّي هُوَ الشَّاعرُ) فقَدْ قَصَرْتَ هذه الصفةَ عليْهِ، وكَأَنَّكَ قُلتَ: (لا شَاعرَ إِلَّا الْـمُتنَبّــي). ولا تجدُ هذَا المعنَى إذا قلتَ: (الْـمُتَنَبِّــي شَاعرٌ)، فمَا زدتَ على أنْ جعلتَهُ شاعراً منَ الشُّعرَاء. وهكذَا فلَا حياةَ إلا الحيَاةُ الآخرَة.
كُلُّ ذَلكَ يجْعَلُ منَ الحيَاة الآخِرَة، هيَ الحياةَ الحَقِيقِيَّةَ، لأنّها هيَ المتَّصفَةُ بالكَمَال والخُلُودِ والدَّوَام. ومَا دُونَها لَيْسَ بحَياةٍ، فَما هوَ إلا لَهوٌ ولَعبٌ. وعلى ذلكَ، اختلف اللفظُ، فالدُّنْيا ( حَيَاةٌ) ، لكنَّ الآخِرَةَ (حَيَوَانٌ). وَتَسْتَوْقِفُك كَلِمَة (حَيَوَان) لِمَا يَسْبِقُ إلى فهمِكَ مِنْ مَعْنى هَذا الكَائِن المعْرُوف؛ ذِي الحِسّ والإدرَاك والحرَكَة والنُّمُوّ. لكنَّكَ إِذَا تَأمَّلتَ مَلِيّاً، تَبَيَّن لكَ أَنَّ الكَلمَتَين مَعاً: (الحَيَاة والحَيَوَان)، هُمَا مَصْدَرانِ لفعْلٍ واحِدٍ هُو (حَـيِــيَ يَحْيَـــى) بالفَكّ، عَلَى وَزْنِ (رَضِيَ يَرْضَى) أوْ (حَــيَّ يَحَــيُّ) بالإدْغام، مِثْلُ (مَلَّ يَمَلُّ). قالَ (المرتَضى الزَّبِيديّ) في (تَاج العرُوس): «حَيِــــيَ، كرَضِيَ، حَياةً، و لُغَةٌ أُخْرى: حَـــيَّ يَحَــــيُّ». وقدْ وردَتِ اللُّغتَان في قراءَاتٍ مُتواتِرةٍ، في قولهِ تعالَى في (الأنفَال): ﴿وَيَحْيَـى مَنْ حَيِـــــيَ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾، في روَايَة (وَرْشٍ عنْ نافعٍ)، وَ﴿وَيَحْيَـــى مَنْ حَــــيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾، في روايَةِ (حَفْصٍ عَنِ عَاصمٍ).
فَمَعْنى (الحَيَوان) في الآية هُوَ (الحَيَاة)، قالَ (أبُو عُبيدَةَ مَعمَر بنُ الْـمُثنَّى-تــــ:210هـ) في (مَجاز القُرآنِ): «وَمجازُ الحَيَوَانِ والحَيَاةِ وَاحِدٌ، ومنهُ قَوْلُهُم : نَــهْرُ الحَيَوَان، أَيْ نَهْرُ الحَيَاة» . وأصلهُ (حَيَيَان) بِيَاءَينِ، فَكرهُوا تَوالي مِثْلَيْن، واسْتثقَلُوهما، فقَلبُوا (الياءَ) الثّانيَة (وَاواً). معَ أنَّ (الوَاوَ) أَثقلُ منَ (الياءِ)، لكنَّ اخْتلافَ الحَرفَين جَعلَ اللَّفظَ أخَفّ. وفي ذلكَ يقولُ (أبُو الفَتحِ بنُ جِنّـي) في (الخَصَائص): «وَذلكَ نَحوُ (الحَيَوَان)، ألَا تَرى أنّهُ عندَ الجَماعَة، منْ مُضاعَف اليَاء، وأنَّ أَصلهُ (حَيَيَان)، فلمَّا ثَقُل عدَلُوا عنِ (اليَاء) إلى (الوَاو). وهذَا معَ إحَاطَة العِلْم بأنَّ (الوَاو) أَثْقَلُ منَ (اليَاء)، لكنَّهُ لَـمّا اختَلفَ الحَرفَانِ ساغَ ذلكَ».
وتكونُ صيغَتُهُ الصَّرْفِيَّة على وزْنِ (فَعَلَان). وهيَ صيغَةٌ دَالَّةٌ عَلى الحَركَة والاضْطرَاب، فبِــزيادَة مَبنــىً، فيهَا زيادَةُ مَعْنــىً. فالفَتحَة على حَرفهَا الثَّاني، ثمَّ الألفُ الزَّائدَة في آخرهَا، وهيَ فَتحةٌ طَويلةٌ، جعَلَ هذهِ الحَركةَ تَمتدُّ في إيقاعٍ صَوتيٍّ صاعِدٍ منْ أوّل الكلمَة إلى آخِرها، فأَكسَب ذلكَ المعنَى فَضلَ قُوّةٍ، وبَلاغَةَ قَصدٍ. وأَنتَ لَتُدْرِكُ ذَلكَ إِذَا مَثّلْتَ، فقلتَ: (فَاضَ النَّهرُ فَيْضاً)، فعبّرتَ عن امْتِلائهِ، وسَيْل الماءِ عَلى ضفّتَيْه. فإذا قُلتَ: (فَاضَ النَّـهرُ فَيَضَاناً)، فَقَدْ زِدْتَ المعنَى قُوّةً، في حَركةٍ واضْطرابٍ أشَدَّ ما يَكونُ الاضْطِرابُ. وكذلكَ هُو الأمرُ في قَولنَا: ( جَرْيٌ وجَرَيَان – طَوْفٌ وطَوَفَان – لَـمْعٌ ولَـمَعَان...) فكذلكَ المعنَى في الآيَة. فحياةُ الآخرَة بذَلكَ أَجَلُّ وأَسْمَى منْ هَذهِ الحَيَاةِ الدُّنيا، قالَ (الزَّمَخشريّ) في (الكَشّاف): «وفي بِنَاءِ (الحَيَوَان) زيَادَةُ مَعنىً، ليْسَ في بنَاءِ (الحَيَاةِ). وهيَ مَا في بِنَاء (فَعَلَان) منْ مَعنَى الحَركَة والاضْطراب، كالنَّــزَوَان والنَّغَصَان واللَّهَبَان ومَا أَشبَهَ ذلكَ. و(الحَياةُ): حَركةٌ، كمَا أنّ (الْـمَوت) سُكُون. فمَجِيئهُ علَى بِنَاءٍ دَالٍّ عَلَى الحَرَكَة، مُبَالَغَةٌ فِي مَعْنَى (الحَيَاة). ولذَلكَ اخْتِيرت علَى (الحَيَاة) في هَذا الْـمَوضِع الْـمُقتَضي للمُبالغَةِ».