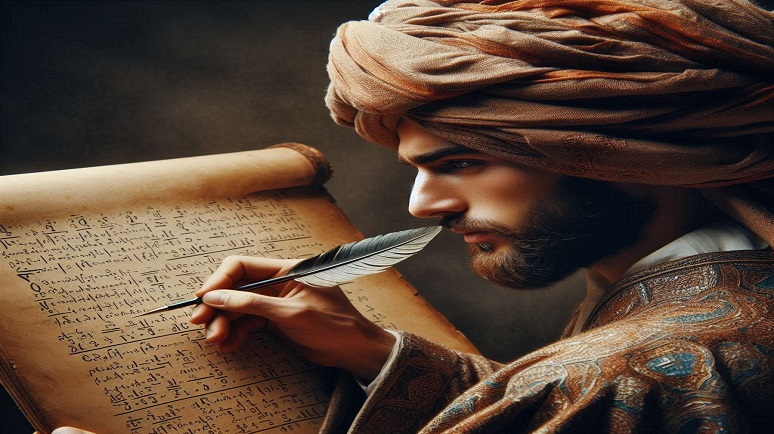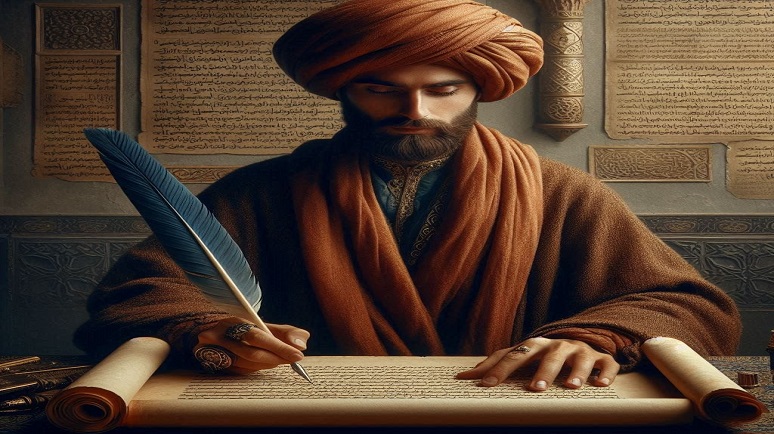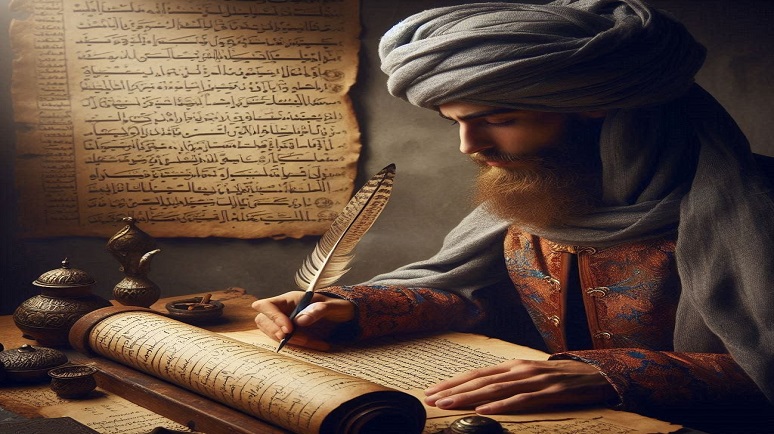الفلكي الأندلسي أبو القاسم أحمد بن الصفّار

الفلكي الأندلسي أبو القاسم
أحمد بن الصفّار (تـ. 426 هـ/1035م)
عبد العزيز النقر
مركز ابن البنا المراكشي
تقديم:
يُعتبر ابن الصفار من الأسماء العلمية المهمة التي عاشت ببلاد الأندلس. ومن الملاحظ أن اسمه يتردد كثيرا في العديد من الكتب -خصوصا الفهارس- المعاصرة التي تقدم جردا لعلماء الفلك وأعمالهم داخل الحضارة العربية الإسلامية. لكن، إزاء هذا "الصيت النسبي" الذي حظي به ابن الصفّار، سواء لدى بعض المؤرخين القدامى أو لدى المحدثين، فإن المرء ليستغرب من أننا لا نتوفر على معلومات وافية حول حياته الشخصية أو حول تكوينه ومساره العلميين. وعلى سبيل المثال، فإن أفضل ترجمة وصلتنا عنه لا تتعدى أسطرها أصابع اليد الواحدة. والمقصود بهذه الترجمة هي تلك التي كتبها عنه صاعد الأندلسي في مؤلفه الشهير طبقات الأمم. أما الترجمة التي يقدمها ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء فتكاد تكون نقلا "حرفيا" عما ورد لدى القاضي صاعد الأندلسي. وحتى إن اختلفت ترجمة ابن الصفار لدى آخرين، كما هو الحال لدى ابن بشكوال في كتابه المعنون بـ"الصلة في تاريخ علماء الأندلس"، فإن السمة المميزة لها هي كونها أكثر اقتضابا من سابقتها، إذ لا يتجاوز ابن بشكوال ذكر اسم المترجم له (ابن الصفار) ومجال اشتغاله، مع إشارة خاطفة لأحد تلاميذه وأحد شيوخه، ثم ذكر سنة وفاته.
أمام هذا النقص في المعطيات البيوغرافية المتعلقة بابن الصفار، فليس هناك بد من الاعتماد في تقديمه هنا على ما ورد لدى هؤلاء الثلاثة، أي صاعد الأندلسي وابن بشكوال وابن أبي أصيبعة. كما سنعتمد كذلك على بعض الأعمال المعاصرة التي عرّفت بابن الصفار أو درست بعض أعماله. رغم أن هذه الدراسات المعاصرة قد استندت، بشكل أساسي، إلى ما ورد لدى القاضي صاعد، إلا أنها تمتاز بكونها اعتمدت في دراسته على أمور أخرى، لعل أهمها هو ما يمكن تسميته بـ"التاريخ النصي" لبعض أعماله.
1 - اسمه وأصله:
اسمه الكامل هو أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر الغافقي، المعروف بـ"ابن الصفار". كان مهتما ومنشغلا بالعلوم العقلية، مع تركيز خاص على الرياضيات (علمي الهندسة والعدد) وعلم التنجيم. لم يشر صاعد الأندلسي بشكل مباشر إلى أن ابن الصفار كان مشتغلا بعلم الفلك، حيث يذكر العبارة التالية: "كان أيضا متحققا بعلم العدد والهندسة والنجوم". فهل المقصود هنا "علم أحكام النجوم" أم "علم الفلك"؟ على كل حال، ومهما كان مدلول العبارة، فإنها لا يمكن أن تنفي حقيقة أن ابن الصفار كان فلكيا جيدا، وذلك نظرا للاعتباريين التاليين على الأقل: أ- في حالة كان المقصود بالعبارة هو "علم أحكام النجوم"، فمن المعروف أن علم التنجيم كان في القديم متداخلا مع علم الفلك في عدة مناحي. لذلك، فمن المستبعد أن يكون العالم مهتما بعلم التنجيم دون إلمام جيد بأساسيات ومبادئ علم الفلك. ب- يذكر صاعد الأندلسي أنه ألف زيجا (جداول فلكية) "مختصرا على مذهب السند هند". ومن الطبيعي أن تأليف عمل دقيق كهذا يقتضي من صاحبه دراية واسعة وعميقة بميدان علم الفلك. ليس هذا فحسب، بل إن ابن الصفار ألف أيضا كتابا آخر ينتمي إلى ميدان علم الفلك التطبيقي، أي المجال الخاص باستخدام الأدوات الفلكية، عنوانه "في العمل بالأسطرلاب". فهل يعقل أن يؤلف صاحبنا هذين العملين الدقيقين دون أن يكون فلكيا جيدا؟
لا نعرف مكان ولادته، وما نعرفه عنه هو أنه عاش مدة من الزمن بمدينة قرطبة قبل أن يغادرها في اتجاه مدينة دانية (بالأندلس) حيث سيقضي ما بقي من عمره هناك إلى أن وافته المنية سنة 426 هـ/1035م. بناء على ما وصلنا من معلومات شحيحة، فإنه يصعب التقرير فيما إذا ما كان قرطبي المولد أم أنه أتاها (أقرطبة) بغرض التحصيل العلمي ليستقر فيها بعد ذلك كمدرس إلى حدود انتقاله منها. إن العبارة التي يذكرها القاضي صاعد ملغزة نوعا ما، حيث يقول: "وقعد بقرطبة لتعليم ذلك" (أي علم العدد والهندسة والنجوم). يمكن أن تُحمل هذه العبارة على معان مختلفة: فهل يقصد صاعد أن ابن الصفار ولد بقرطبة واختار البقاء فيها للتدريس دون غيرها من سائر المدن رغم وجود إمكانية ليصير مدرسا بمدن أخرى نظرا لمكانته وعلمه (يجب أن نستحضر في ذهننا أن شخصا مثله لم يكن ليعدم إمكانيات للتدريس بمدن أخرى، وهذا ما تؤكده واقعة كونه صار معلما بمدينة دانية بعد انتقالها إليها)؟ أم أن المقصود هو أنه جاءها للتحصيل العلمي ثم فضل بعد انتهائه من ذلك أن يمكث بها كمدرس؟ من جهة أخرى، يبدو أن ترجمة ابن بشكوال أيضا لا تسعفنا في الحصول على جواب مقنع، حيث إنه لا يزيد عن القول "من أهل قرطبة"، ومن الواضح أنها عبارة لا تقدم جوابا شافيا عن الأسئلة السالفة.
على تصاريف الأحوال، وعلى الرغم من أن الحسم في هذا الأمر يبقى متعذرا، إلا أنه من الثابت لدينا، بناء على شاهدة صاعد الأندلسي، أن صاحبنا ابن الصفار لم يترك هذه المدينة -التي كانت مركزا من أهم مراكز العلم في العالم الإسلامي- إلا مضطرا، وذلك بسبب الاضطرابات التي شهدتها المدينة في تلك الفترة بسبب "الحرب الأهلية". إذ يظهر أن ابن الصفار قد أدرك صعوبة الاستمرار في العيش بقرطبة بعد أن رأى بأم عينه ما آلت إليه الأوضاع بعد مرور مدة زمنية معينة على ظهور تلك الاضطرابات الداخلية، وهذا ما يمكن أن يستشف من كلام صاعد المقتضب، حيث يقول: "[...] وخرج (ابن الصفار) من قرطبة بعد مضي صدر من الفتة". لهذا، يبدو من الراجح جدا أن قراره بالانتقال كان ناجما عن وعيه بصعوبة الاستمرار في العيش -أو ممارسة مهنته- في ظل أوضاع تتسم بعدم الاستقرار.
2 - شيوخه وتكوينه العلمي:
أما بالنسبة لتكوينه العلمي، فنجد أن ابن بشكوال يشير إلى أحد شيوخه، وهو "القاضي ابن مفرج". يبدو أن المقصود هنا هو العالم والقاضي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الذي كان من علماء الحديث بالأندلس، كما كان له في علمي التفسير والفقه تصانيف. لا نعرف، في حقيقة الأمر، إذا ما كان ابن الصفار قد تتلمذ بشكل مباشر على ابن مفرج أم لا، وذلك نظرا لأن ابن بشوال يكتفي بالقول بأنه "كانت له (ابن الصفار) رواية عن القاضي ابن مفرج وغيره". رغم ذلك، فالمهم بالنسبة لنا هو أن هذه المعلومة تؤكد أن ابن الصفار قد تلقى، إضافة إلى تكوينه في العلوم العقلية (الرياضيات والفلك بشكل خاص)، تكوينا علميا في بعض العلوم الشرعية -كعلم الحديث- على يد علماء معروفين من طينة الشيخ ابن مفرج.
من المحتمل أن يكون للوسط العائلي الذي تربى فيه ابن الصفار تأثير في توجهه صوب علم الفلك والاهتمام بالأسطرلابات. لقد كان له أخ -اسمه محمد- اشتهر في الأندلس بإجادته لصناعة الأسطرلابات، حتى أن صاعدا الأندلسي يقول فيه: "وكان له أخ يسمى محمدا مشهورا بعمل الأسطرلابات، لم يكن بالأندلس قبله أجمل صنعا بها منه". إضافة إلى ذلك، كان أبوهما "صفارا"، أي يشتغل بصناعة النحاس.[1] ومن المعروف أن هذه المادة هي أحد المواد المهمة التي كانت تصنع منها عادةً الأسطرلابات. إذا أخذنا هذين المعطيين في الحسبان، أي براعة الأخ في صناعة الأسطرلابات ومهنة الوالد في مجال النحاس، فقد يبدو معقولا أن اهتمامات العائلة بهذا الجانب العملي كانت أحد الأسباب التي حدت بان الصفار للاتجاه صوب الاهتمام بعلم الفلك، خصوصا في شقه العملي.
كان ابن الصفار تلميذا للفلكي الأندلسي الشهير أبو مسلمة المجريطي الذي ستجمع بينهما فيما بعد أعمال فلكية مشتركة. إن تتلمذه علي يدي مسلمة ليس مجرد تخمين، بل إنه ثابت بشهادة صاعد الأندلسي الذي يقول في ترجمته لـ"إمام الرياضيين بالأندلس" (هكذا يلقب صاعدٌ مسلمةَ) ما يلي: "وقد أنجب [المجريطي] تلاميذ جلة، ولم ينجب عالم بالأندلس مثلهم، فمن أشهرهم ابن السمح وابن الصفار والزهراوي والكرماني وابن خلدون".[2] والجدير بالذكر هنا هو أن مبحثا الرياضيات وعلم الفلك قد شكلا محور اشتغال معظم هؤلاء التلاميذ.
3 - تلاميذه:
لئن عاكسنا الحظ في معرفة شيوخ ابن الصفار، فإن القاضي صاعد يسعفنا هذه المرة، بنوع من التفصيل، في معرفة بعض تلاميذه حيث خصص ترجمة لكل منهم على حدة. من الملاحظ أن "كل" هؤلاء التلاميذ كانوا "من أهل قرطبة"، ويظهر أن ذلك راجع إلى سبب بديهي هو أن ابن الصفار كان يدرس بهذه المدينة التي كانت تمثل مركزا علميا مهما داخل مجمل الحضارة العربية الإسلامية.
وهؤلاء التلاميذ هم: محمد بن عمر بن محمد المعروف بابن برغوث المتوفى سنة 444 هـ/1052م.[3] جمع بين مباحث مختلفة، كعلم النحو والفقه والوثائق والعلوم الرياضية مع "إيثار" لعلم الفلك وكل ما يرتبط به. منهم أيضا أبو الأصبع عيسى محمد بن أحمد الواسطي الذي كانت له دراية واسعة بعلم العدد والهندسة والفرائض، فضلا عن إلمام بعلم الهيئة. وكان هو أيضا مشتغلا -كأستاذه ابن الصفار- بالتدريس في مدينة قرطبة. وكان منهم كذلك أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن مختار بن شهر الرعيني ابن شهر المتوفى بمدينة قرطبة سنة 435 ه/1043م. حصّل، إضافة إلى معرفته بعلم الفلك، معرفة عميقة بعلم اللغة والنحو والحديث والفقه، ناهيك عن اطلاع مهم على "السّير والتواريخ". أما أصغر تلاميذ ابن الصفار، فكان هو محمد بن خيرة العطار (الملقب بابن العطار) الذي اشتغل بدوره بتدريس علم العدد والهندسة والفرائض بمدينة قرطبة، كما كان أيضا ذا "بصر بصناعة النجوم وعناية بعلم حركاتها".
إضافة إلى هؤلاء، يذكر صاعد تلميذين آخرين دون أن يترجم لهما، وهما: "الأفطس (أو الأخطش؟)[4] المرواني"، وآخر يسمى "القرشي". بخصوص هذا الأخير، فالأكيد عندنا أنه غير الرياضي أبو القاسم القرشي الذي درّس بمدينة بجاية (أصله من إشبيلية). نستند في تأكيدنا هذا إلى حقيقة أن الرياضي أبو القاسم توفي سنة 1184م بينما توفي ابن الصفار سنة 1035م، ومن غير المعقول أن تفصل بين الأستاذ وتلميذه مدة زمنية تصل إلى قرن ونصف (149 سنة بالضبط)!
في المقابل، من المحتمل أن يكون المقصود بكلام صاعد هو العالم الأندلسي عبد الرحمن بن مسلمة بن عبد الملك بن الوليد القرشي المالكي (الملقب بأبي مطرف) المتوفى سنة 446 ه/1054م. لقد دفعنا إلى هذا الاحتمال ثلاثة أسباب: 1- كان عبد الرحمن القرشي مشتغلا أيضا بعلم الحساب، وهو من المجالات التي درسها ابن الصفار بقرطبة. 2- ترد في ترجمة عبد الرحمن القرشي[5] هذا أنه "أخذ العلم بقرطبة عن شيوخ كثيرين". لهذا، يمكن أن يكون ابن الصفار أحد هؤلاء الشيوخ بحكم تدريسه بقرطبة قبل رحيله إلى دانية. 3- إن التقارب الزمني بين تاريخي وفاة كل من ابن الصفار وعبد الرحمن القرشي (مات الأول سنة 1035م بينما توفي الثاني سنة 1054م) يجعل من مسألة التلمذة أمرا معقولا، حيث إن الفارق بين سن "الأستاذ" وعمر "التلميذ" لا يتجاوز تسعة عشر سنة. رغم ذلك، يبقى هذا مجرد احتمال يحتاج تأكيدُه إلى أدلة أكثر إقناعا.
4 - مؤلفاته العلمية:
شكلت "علوم التعاليم" مدار اشتغال ابن الصفار تدريسا وتأليفا. ويُطلعنا صاعد الأندلسي على عنوانين اثنين من تأليف المترجَم له: أولهما هو "زيج مختصر على مذهب السند هند"، أنجزه ابن الصفار رفقة أستاذه مسلمة المجريطي. لا يكتسي هذا الزيج أهميته من الناحية العلمية فقط، بل إنه مهم كذلك من الناحية التاريخية. ترجع هذه الأهمية إلى أن "النسخة الأصلية" لزيج الخوارزمي (التي قام ابن الصفار بعمل مختصر لها) تُعتبر في عداد النصوص المفقودة. ورغم أن النسخة العربية لمختصر ابن الصفار هي أيضا مفقودة، إلا أن الباحثين يعرفون اليوم جل مضامين "الزيج المختصر" بناء على ترجماته اللاتينية الموجودة في بعض مكتبات العالم، كما توجد منه أيضا نسخة عربية مكتوبة بحروف عبرية.[6]
تُرجم هذا العمل إلى اللاتينية من طرف المترجم الشهير أديلار الباثي Adelard of Bath [7]. تُرجم النص أيضا إلى اللغة العبرية، وتمت هذه الترجمة فيما بين أواخر القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر (الميلاديين) على يدي مترجم يهودي اسمه "بيتروس ألفونسي" Petrus Alphonsi. لا نعرف تفاصيل عن تاريخ إنجاز هذه الترجمة، وإنما أشرنا إلى أنها تمت خلال هذه المدة الزمنية نظرا لأنها نفس الفترة التي عاش إبّانها هذا المترجم.
لا ينبغي أن يفهم من عبارة "مختصر" الواردة في عنوان الزيج أن دور ابن الصفار (وأستاذه مسلمة المجريطي) قد اقتصر على تلخيص لا يتجاوز المعطيات الأساسية الواردة في الزيج الأصلي للخوارزمي. فعلى العكس من ذلك، يتعدى الأمر، في هذه الحالة، المعنى التقليدي لكلمة "مختصر". ذلك أن بعض الباحثين (خوليو سامسو، خوان بيرنيت، ومونيكا ريوس) يؤكدون أن زيج ابن الصفار يتضمن معطيات ترجع إلى فلكيين أندلسيين، كما أنه يحتوي على مواد تعود إلى تقاليد فلكية مختلقة، من بينها التقليد الهندو-إيراني (الفارسي) والتقليد اليوناني العربي وأيضا التقليد الإسباني (الأندلسي). من جهة أخرى، يذهب مؤرخا العلوم خوليو سامسو وخوان بيرنيت إلى أنه يمكن، مبدأيا، أن نعتبر أن المواد الهندية-الإيرانية الموجودة في نص ابن الصفار تعود إلى الصيغة الأولية (الأصلية) لزيج الخوارزمي. رغم ذلك، فإنهما يستدركان بالقول إن هذا الحكم لا يمكن أن يكون دائما دقيقا وصائبا. ويوضحان ذلك من خلال مثال "حركة الكواكب المتوسطة"، إذ من الملاحظ أن الزيج المختصر لابن الصفار يتضمن، بخصوص هذه الحركة، وسائط حسابية ذات أصل هندي، لكن "الجداول الموجودة" به "تشكل تعديلا شكليا مهما يُنسب عادة إلى مسلمة".[8] بالتالي، يظل الفصل التام بين المعطيات الأصلية لزيج الخوازمي وما تمت إضافته من طرف مدرسة مسلمة المجريطي (ابن الصفار) أمرا متعذرا في ظل غياب الصيغة الأصلية لزيج الخوارزمي.
لقد صار من الثابت اليوم لدى الباحثين أن الزيج المختصر لابن الصفار يحتوي تعديلات مهمة أدخلت على نص الخوارزمي الأصلي. من المحتمل أن بعض الأسباب العملية -من بين أسباب أخرى طبعا- كانت وراء إدخال معطيات جديدة على هذا الزيج (الخوارزمي)، لعل أهمها الرغبة في تكييف هذا الزيج مع بلاد الأندلس أو بعض المدن المتواجدة بهذه الرقعة الجغرافية. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مختصر ابن الصفار لم يكن هو المختصر الوحيد الذي أنجز حول زيج الخوارزمي، فقد قام ابن السمح -هو أيضا من تلاميذ مسلمة المجريطي- بإنجاز صيغة أخرى مختصرة لهذا الزيج. لكن حظ هذه الصيغة كان أسوء من حظ صيغة ابن الصفار، حيث لم تصل إلينا صيغة ابن السمح العربية، ولا نعرف إن كانت قد ترجمت وضاعت أم أنها لم تترجم أصلا.
أما العمل الثاني الذي يشير إليه القاضي صاعد فيتعلق بمجال الأدوات الفلكية، وهو كتاب يحمل عنوان: "العمل بالأسطرلاب". نُشر هذا النص محققا من طرف المستعرب الإسباني خوسي ماريا مياس باييكروسا J. Millás Vallicrosa ضمن مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1955. أما العنوان الموجود على النص المنشور فهو: "كتاب العمل بالأسطرلاب وذكر آلاته وأجزائه لابن الصفار". أشار محقق النص، في الهامش رقم 1، إلى أننا لا نتوفر على نسخ أخرى لهذا المخطوط، مما يعني أنه اعتمد في تحقيقه على نسخة واحدة. من ناحية أخرى، يشير فؤاد سيزكين في كتابه تاريخ التراث العربي إلى أن هذا الكتاب وصل إلينا "بصيغ متباينة" مؤكدا أن "عدد الأبواب يترواح ما بين 25 و30 و42 و53 بابا".[9]
بناء على ما تقدم، فقد بدا لنا قول الأستاذ سيزكين مربكا نوعا ما: فهل كان يقصد نسخا أخرى من المخطوط العربي، أم أن تعليقه يرتبط بمجل الصيغ التي وصلتنا من الكتاب (العربية والترجمات اللاتينية والعبرية)؟ يشير سيزكين في عملية جَرْده لأماكن تواجد النسخ المخطوطة من الكتاب إلى مكتبات الإسكوريال والمكتبة البريطانية بلندن وإلى مكتبات القاهرة والرباط وتونس وبرلين. بالتالي، يظل من المحتمل أن يكون المقصود بكلامه وجود نسخ عربية أخرى غير تلك التي اعتمدها باييكروسا في التحقيق. على كل حال، قد يكون كلامنا هنا مجرد "حكم متسرع" لأننا نعتقد أن الأمر لا يزال في حاجة إلى مزيد من التدقيق والبحث قبل تأكيد أي شيء. لكن، إن صح هذا الأمر فعلا، فسيكون من المفيد جدا أن تتم إعادة تحقيق النص بناء على هذه النسخ الأخرى. وهذا لا ينفي البتة سبْق وأهمية عمل المستعرب الإسباني مياس باييكروسا الذي يعود إليه فضل نشر الكتاب محققا منذ سبعة عقود خلت (70 سنة بالضبط).
حظي هذا الكتاب بانتشار واسع، حيث ظل مستخدما في أوربا خلال القرن الخامس عشر الميلادي. يبدو أن هذا الانتشار الذي لقيه راجع إلى سببين على الأقل: طبيعة موضوعه العملي، إذ إنه يقدم معارف وطرائق تساعد المرء على فهم واستخدام هذه الآلة (الأسطرلاب) التي كانت تُعد من بين أهم الآلات المستخدمة في العصر الوسيط. ب- تميزَ هذا الكتاب، حسب شهادة صاعد الأندلسي نفسه، من حيث أسلوبه بأنه كتاب "موجز حسن العبارة قريب المأخذ". رغم أن هذه الشهادة تنطبق على الصيغة العربية ابتداء، إلا أننا نعتقد أنه يمكن تعميمها أيضا على الصيغ (الترجمات) اللاتينية والعبرية، إذ حتى لو أسقطنا من شهادة صاعد جملة "حسن العبارة" من حيث إنها قد تخص اللغة العربية التي كتب بها النص في الأصل، إلا أن باقي العبارات، أي "موجز" و"قريب المأخذ"، تكفي لتوضيح طبيعة هذا العمل الذي يظهر أن صاحبه كان يتوخى -في المقام الأول- أن تعم فائدة كتابه أكبر قدر ممكن من المتلقين.
وهكذا، إذا أخذنا في الحسبان طبيعة موضوع الكتاب (بُعده العملي) من جهة، وأسلوبه الذي يتميز بالإيجاز و"سهولة المأخذ" من جهة أخرى، فستتضح لنا بعض الأسباب الكامنة وراء وصول هذا العمل إلى البلدان الأوربية خلال العصر الوسيط. كما يكفي دلالة على أهميته وطبيعته "الإجرائية-العملية" أنه كان محط اهتمام من لدن فلكيي الملك ألفونسو العاشر (الملقب بالحكيم) الذين اعتمدوه في أعمالهم قصد الانتفاع بمادته العلمية وفائدته العملية.
أما عن كيفية وصول هذا العمل إلى أوربا، فيمكن القول إن فضل ذلك يعود إلى ترجماته اللاتينية والعبرية. بخصوص اللغة اللاتينية، فقد تُرجم هذا المصنف إليها مرتين. هناك ترجمة أنجزها أفلاطون التيفولي Platon de Tivoli الذي اعتبر في مقدمة ترجمته لهذا المصنف أنه أفضل كتاب عربي ألف بإطلاق (ولعله كان يقصد أفضل كتاب في مجال علم الفلك). أما الترجمة الأخرى، فقد تمت خلال القرن الثاني عشر الميلادي علي يدي يوحنا الإشبيلي Jean de Séville.
يذهب الباحثون إلى أن كتاب ابن الصفار نُسب خطأ، في ترجمة يوحنا الإشبيلي، إلى أستاذه مسلمة المجريطي. أما عن سبب هذا الخطأ، فهناك احتمالان: أ- تذهب المستعربة الإسبانية مونيكا ريويس Mònica Rius إلى احتمال أن يكون الباب الأخير من الكتاب عبارة عن جزء مقتطف (fragment) من زيج مسلمة، وهو ما أوقع العلماء اللاحقين في الخلط حيث نسبوا عمل ابن الصفار كله إلى المجريطي بينما يُحتمل أن يكون الجزء الأخير فقط هو الذي يرجع لمسلمة (أي مقتطف من أحد أعماله). ب- يذهب باحثون آخرون، كفؤاد سيزكين ومياس باييكروسا، إلى أن السبب الذي أوقع أولئك في الخطأ هو تشابه كنية كل من مسلمة وابن الصفار، حيث إن كنيتهما معا هي "أبو القاسم".
إضافة إلى هاتين الترجمتين اللاتينتين، هناك ترجمة عبرية قام بها شخص يُدعى Profeit Tibbon (Jacob ben Makhir) [10]. ليس هذا فحسب، بل هناك أيضا ثلاث ترجمات إسبانية موجودة لهذا المصنف: واحدة بلغة إسبانية قديمة، وأخرى بإسبانية مكتوبة بأحرف عبرية، بينما الثالثة حديثة نسبيا (سنة 1955)، وهي التي قام بها محقق النص العربي المستعرب الإسباني مياس باييكروسا.
خاتمة:
لقد حاولنا في ما تقدم من فقرات أن نقدم تعريفا بهذا الفلكي الذي لم ينحصر تأثيره فيمن درّسه من تلاميذ في مجال العلوم الدقيقة (الرياضيات والفلك) ببلاد الأندلس، بل إن تأثيره وصل إلى البلدان الأوربية من خلال ترجمة مصنفاته التي لم تكن لتنال ما نالته من حظوة لولا طابعها العلمي الدقيق من جهة، وفائدتها العملية من جهة أخرى. ولا غرو في أن هذا الطابع العملي الفريد الذي ميز مصنفات ابن الصفار يستند إلى دعائم متينة من التكوين المعرفي الواسع والدراية العلمية العميقة.
[1] - ليس صحيحا ما يرد عند بعض الكُتاب المعاصرين، كـ .Rosenfeld, B. A وEkmeleddin Ihsanoğlu، من أن اسمه أحمد بن عبد الله الصفار. وذلك نظرا لأن أباه هو من كان صفارا (مشتغلا بمهنة النحاس) وليس هو. (يُنظر بخصوص عنوان كتباهما لائحة المراجع أدناه).
[2] - ننبه إلى أن ابن خلدون المقصود هنا هو أبو مسلم عمرو بن أحمد بن خلدون الحضرمي المتوفى سنة 1057م، وليس عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة المتوفى سنة 808 ه/1406م.
[3] - يصحح محقق النص، الدكتور حسين مؤنس، هذا التاريخ حيث يذهب إلى أن الأصوب هو سنة 447 هـ/1056م.
[4] - نجد في نص طبقات الأمم المحقق من طرف الأب لويس شيخو كلمة "الامطش".
[5] - يُنظر بخصوص ترجمته: زهير حميدان، أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، ص. 273.
[6] - يشير مؤرخ علم الفلك الأستاذ خوليو سامسو إلى أن هذه الحالة (أي كتابة نص عربي بحروف عبرية) ليست حالة خاصة بهذا النص وحده، بل هناك نصوص فلكية أخرى وصلتنا على نفس الشاكلة.
[7] - تشير الباحثة الإسبانية مونيكا ريوس إلى أن مراجعة هذه الترجمة تُنسب إلى مترجم شهير آخر هو روبرت التّشستري (من تشاستر) Robert of Chester.
ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن معظم المعلومات الخاصة بأعمال ابن الصفار وترجماتها، إضافة إلى معلومات أخرى متفرقة ضمن عملنا هذا، مستقاة من النص المُركز والدقيق الذي كتبته هذه الباحثة الإسبانية عن ابن الصفار. هذا فضلا عن أننا استفدنا كثيرا من العناوين الموجودة ضمن لائحة مراجعها بحيث سهلت علينا تلك اللائحة البحث عن أهم الدراسات المنجزة حوله والاستفادة منها.
[8] - خوان فيرني وخوليو سامسو، تطورات العلم العربي في الأندلس، موسوعة تاريخ العلوم، ج1، ص. 367.
[9] - بخصوص أماكن تواجد مخطوطات هذا الكتاب، يُنظر: فؤاد سيزكين، تاريخ التراث العربي، ص. 334.
[10] - هكذا يرد لدى الباحثة مونيكا ريوس، أما في الترجمة العربية لكتاب فؤاد سيزكين، فيرد هكذا "يعقوب بن مَحِر".
المصادر والمراجع العربية والأجنبية:
- ابن الصفار، كتاب العمل بالأسطرلاب وذكر آلاته وأجزائه لابن الصفار، تحقيق مياس بياكروزا، ضمن: مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، العدد الثالث، المجلد الأول، 1955. (ص. 47-76).
- أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس، اعتنى به ووضع فهارسه الدكتور صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، الطبعة الأولى، 2003.
- خوان فيرني وخوليو سامسو، تطورات العلم العربي في الأندلس، ضمن: موسوعة تاريخ العلوم العربية، الجزء الأول، إشراف رشدي راشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 2005. (ص. 351-401).
- زهير حميدان، أعلام العلوم العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، الجزء الخامس، منشورات وزارة الثقافة، دمشق-سوريا، 1966.
- فؤاد سيزكين، تاريخ الأدب العربي، المجلد السادس (علم الفلك)، ترجمة د. عبد الله بن عبد الله حجازي، جامعة الملك سعود، الرياض، 2008.
- القاضي صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، تحقيق الدكتور حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة-مصر، د.ت.
- القاضي صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، تحقيق الأب لويس شيخو، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة-مصر، 2016.
- Castells, Margarita and Julio Samsó (1995). “Seven Chapters of Ibn al‐Ṣaffār's Lost Zīj.” in: Julio Samsó, Astronomy and Astrology in Al-Andalus and the Maghrib. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 229–262.
- Goldstein, Bernard R. (1971). “Ibn al‐Ṣaffār” In Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. Vol. 3, p. 924. Leiden: E. J. Brill.
- Mònica Rius (2007), Ibn al‐Ṣaffār: Abū al‐Qāsim Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUmar al‐Ghāfiqī ibn al‐Ṣaffār al‐Andalusī, in : Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers. New York: Springer, pp. 566-567.
- Rosenfeld, B. A. and Ekmeleddin Ihsanoğlu (2003). Mathematicians, Astronomers, and Other Scholars of Islamic Civilization and Their Works (7th 19th c.). Istanbul: Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), pp. 121–122.
- Suter, Heinrich (1900). “Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke.” Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, p. 86 num. 196.