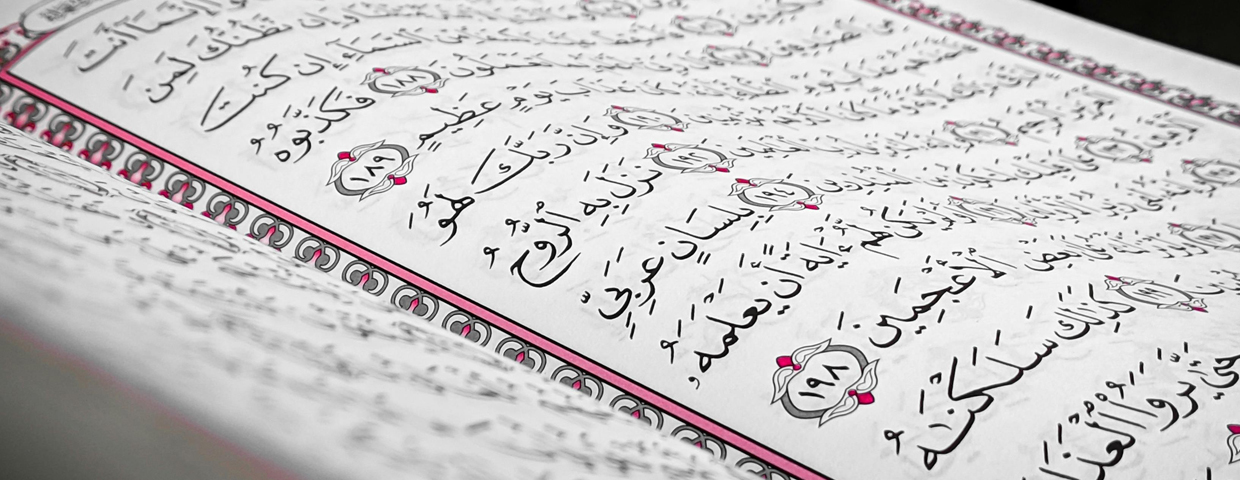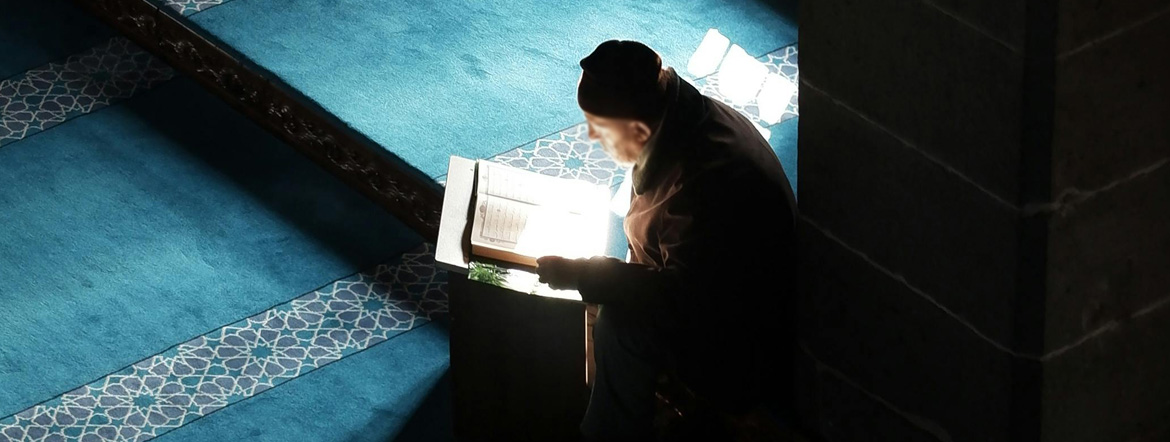تأخذ المفاهيم موقعها القوي في صناعة التاريخ، فهي تولد من رحم السياق التاريخي لتؤثر في إعادة تشكيله، ومن هذه المفاهيم مفهوم صدام الحضارات، الذي تحدث عنه برنارد لويس، و طوره صامويل هنتنجتون في كتابه الذي أصدره سنة 1996 بعنوان صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي، وقدم فيه نظرية للصراع الحضاري، مفادها أن الصراع لن يكون أيديولوجيا أو اقتصاديا، وإنما سيكون بين المجموعات الحضارية المعاصرة[1]، ولاسيما بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية تأثيرا وتأثرا، فجاء نظريته ردا على نظرية نهاية التاريخ والإنسان الأخير لفرنسيس فوكوياما[2]، ليثبت هنتنجتون أن الإنسان الأخير عند فوكوياما لم ينتصر مطلقا، مادامت هناك حضارات أخرى تنافس حضارته في مفهومها للدين والعقل والإنسان والثقافة والحضارة.
وقد كانت الآثار السلبية للنظريتين على المجهود الأممي للتقارب بين الشعوب والثقافات، سببا من أسباب ظهور مراجعات في التأصيل المعرفي والفلسفي لمفاهيم عدة منها مفهوم التسامح[3].. ووعيا من اليونسكو بخطورة نظرية صراع الحضارات ومآلاتها السيئة على الأمن العالمي، اعتمد مؤتمرها في دورته الثامنة والعشرين بباريس 16نوفمبر 1995، إعلان المبادئ بشأن التسامح، وتم تقرير هذا التاريخ يوما عالميا للاحتفال بالتسامح، الذي عنوا به "الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا"[4].
لكن المتفحص الناقد لهذا الاهتمام العالمي بالتسامح، يجده محكوما بمركزية العقل والأنسنة في النظر المعرفي للقيم، وبهذا صارت كل المفاهيم خاضعة للدهرانية[5]. مما يقتضي تفكيرا نقديا معرفيا، يرسم للتسامح مسالك أخرى تقوي المشترك الإنساني، وتحترم المختلف الحضاري، وتنزع التوظيف الإيديولوجي له لتحقيق مصالح ثقافة مهيمنة واحدة ووحيدة. وفي هذا المنحى النقدي المعرفي لإشكالية التسامح في الواقع المعاصر، يندرج تحليل موضوع، قصدية التسامح بين سياق الهوية وسياق الفعل الحضاري، بعيدا أولا، عن الاكتفاء بالتأصيل التراثي للتسامح، الذي يبقى في حدود إظهار معالم التسامح في الحضارة الإسلامية، وتجلياته التطبيقية في نماذج مضيئة من تاريخ المسلمين من بغداد إلى الأندلس. وبعيدا ثانيا، عن الانبهار بمنظومة التسامح في فكر الآخر، واعتبارها نهاية التاريخ في تأسيس النماذج المعرفية، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي جاءت في أدبيات نقد الحداثة وما بعدها (هابرماس وجورج لاتوش). فالنظر التسامحي من رؤية الحضارة الإسلامية، التي يعتبر النص القرآني الكريم أصلها الشرعي والمعرفي، ليس قياسا على الماضي ولا قياسا على الحاضر، بل فاعلية حضارية منضبطة بالفطرة، وقائمة على التعقل المقاصدي، والتفكر بآليات التعليل المصلحي، وقوانين العمران البشري. ولذا تعمل هذه المداخلة على تحليل أسئلة قصدية التسامح من خلال المحاور الثلاثة الآتية:
المحور الأول: مفهوم التسامح بين القصدية والتشكل التاريخي.
المحور الثاني: قصدية التسامح في سياق الهوية.
المحور الثالث: استراتيجيات التسامح في سياق الفعل الحضاري
المحور الأول: مفهوم التسامح بين القصدية والتشكل التاريخي
إن مفهوم قصدية التسامح، لا ينحصر فقط في الدلالة اللغوية للتسامح[6] في المعاجم اللغوية العربية، التي لا تخرج في مجملها عن معاني العفو والصفح والغفران والسهولة والسماحة والاعتدال والجود وعدم الإساءة والتزكية بالنفس إلى مراتب قيمية عالية في المعاملات الإنسانية،بل يتعداها إلى دلالات كلية يظهرها توسع مفهوم قصدية التسامح من جهتين:
الجهة الأولى: تأسيس قصدية التسامح ونظامها القيمي في الوحي القرآني على قاعدتين:
الأولى: الفطرة، من حيث إنها عبارة عن الهيئة الخلقية والروحية التي انطوت عليها نفس الإنسان، والتي توصله إلى معرفة عبوديته للخالق، قال تعالى ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: 30)، فالدين الحق مركوز في الهيئة الداخلية الأصلية التي خلق عليها الإنسان، وجوهرها هو الذي يحافظ على صدقية القيم الأخلاقية التجريبية في الواقع التاريخي للإنسان، وحينما تغيب هذه الهيئة، وتعتبر منهجا غير علمي، تغيب مجموعة من المعايير المرشدة للإنسان في فعل الخيرات وترك المنكرات، وفي جلب المنافع ودفع المفاسد، وفي جعل الحق مزهقا للباطل.
الثانية: المقاصد الشرعية الكلية، الموافقة لتلك الهيئة الداخلية الأصلية، من حيث تأصيلها في الإنسان الميزان الترجيحي بين المصالح الحقة والموهومة، ولذا كانت المقاصد الكلية الضرورية للعمران البشري، في كل زمان قيم فطرية عالمية، قال الآمدي "المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات، وهي أعلى مراتب المناسبات، والحصر في هذه الخمسة أنواع، إنما كان نظرا إلى الوقوع والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة"[7]، فهذه المقاصد قيم أخلاقية عالمية، ومشترك إنساني لا تستقيم الحياة إلا به بحيث إذا فقد لم تجر الحياة إلا على فساد وتهارج، فكل الملل والأديان والنظريات الفلسفية تعمل على المحافظة عليها، لكن التمايز في حفظها، إنما يحصل بالقوة الروحية الصادقة، والوسطية العلمية الفاعلة، والاستقامة المنهجية الواضحة في قواعدها العلمية والعملية، التي تكشفها المحددات المعرفية للوحي القرآني وعالميته[8]، ولذا كانت قيمه الحضارية والمعرفية، محققة للتي هي أقوم في صلاح الإنسان، وصلاح مجال استخلافه الأرضي، وصلاح العلاقة المعنوية بينهما المتجلية في إقامة العمران والفكر العمراني.
ويمكن أن نستخلص من القاعدتين أمرين:
الأول: أن قصدية التسامح هي المصالح الكلية المتحققة من فقه قيمة التسامح، في علاقة الإنسان بالإنسان فرديا ومجتمعيا، عالميا وكونيا. وفقه قيمة التسامح هو العلم بجماع القيم العملية الفطرية، والمكتسبة الضرورية، لاستقامة الحياة البشرية والتعارف فيها والتعايش. وقيم التسامح مدارها على اتخاذ مواقف الاحترام والتكريم والتقدير لحق الإنسان، في التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية، المستمدة من المقاصد الضرورية، التي تم تحديدها عند الأصوليين، بحسب الاستقراء والاصطلاح المعرفي في المقاصد الكلية الخمسة، وهذا ما يفيد إمكانية الاجتهاد في تحديد الاصطلاح المعرفي، وفي عدد الكليات إضافة أو نقصا.
فقد يمكن إضافة العدل والتكريم والاستخلاف والحقوق والائتمان، وقد تحصر مثلا في ثلاثة: التوحيد والتزكية والعمران، أو في التوحيد والحرية والصلاح، مع مراعاة أن الكليات الخمس موضوعة على العموم الذي يستوعب كل أنواع الحقوق المتعلقة بالإنسان في سياق الحفظ والتكريم، الذي يراعي المصالح المشتركة للشعوب والدول.
ومن المصالح المقصودة في جميع الملل والفلسفات العقلانية، تحقيق التعارف والتسامح الذي يعمل على تكثير المنافع للجميع، وتقليل المفاسد للجميع، فحفظ قصدية التسامح يرقى بالحضارات، ويدفعها نحو التعاضد والتشارك في الإصلاح والتنوير والتجديد.
الأمر الثاني: في ضوء تحديد أهمية الفطرة، واستقراء الكليات المقاصدية، تفهم في الوحي القرآني الكريم كليات تسامحية، متعلقة بحرية الاعتقاد، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 64)، وعدم الإكراه في الدين، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 256)، والاعتراف بالرسل، قال تعالى: ﴿قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: 136)، واحترام أمكنة العبادة، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: 251)، والبر بأهل الكتاب، قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8)، والحوار والجدل معهم، قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (العنكبوت: 46)، والأمن والسلم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنفال: 61)، الإنصاف والعدل، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (البقرة: 113).
فهذا بيان لجزء من المبادئ الكلية القرآنية، التي تبرز التسامح منظومة من القيم المتفاعلة، في فتح مسالك التعارف والتعاون، وسد ذرائع التنازع والطغيان، وفي ضوئها يمكن أن تفسر مفاهيم ذات علاقة بفقه التسامح نحو مفهوم أهل الذمة ومفهوم الجزية، ومفهوم الردة ودار الإسلام، ودار الكفر..
الجهة الثانية: التنزيل العملي والواقعي في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، المفصل لما تأصل في الوحي القرآني من كليات تسامحية سبق ذكرها، ومن تلك التفصيلات ما روي عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"[9].
وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو قائم على المنبر، يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين، أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا؟ قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، فقال: فهو فضلي أوتيه من أشاء"[10].
وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان، واليهود فسلم عليهم النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "من آذى ذميا مقرا بعهده فأنا خصمه"[11]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة"[12]. مما يكشف عن تأصيل التسامح مع أهل الكتاب وغيرهم، بتحمل المسلمين مسؤولية حمايتهم، والحفاظ على حقوقهم. ومثل هذه النماذج من جوامع القول النبوي في تفصيل قيم التسامح في الوحي القرآني، كثيرة لا تحصى، نجدها محققة لأصول التعارف البشري، والتعايش الاجتماعي في علاقة الإنسان بالإنسان والدول بالدول، نذكر منها[13]:
- نموذج قيم التسامح في الدعوة بمكة، وتأسيس الكليات القيمية، من خلال التعايش مع ريادة قريش العمرانية، لما كان لها من صدارة بين القبائل.
- نموذج التسامح في الاحتماء بغير المسلمين، الواضح في هجرة المسلمين للحبشة ودخولهم تحت حاكم نصراني، والوفاء في التعامل مع عهده.
- نموذج التسامح في صياغة وثيقة المدينة، وتثبيت الأمن الاجتماعي والتماسك الداخلي، وتأكيد المساواة بين أفراد المجتمع، وتنظيم العلاقات بين المسلمين أنفسهم، وبين غيرهم من اليهود والنصارى، وتأسيس الدولة الساهرة على حقوق رعيتها مهما تعددت أديانهم واختلفت أجناسهم، وهذا ما يؤسس لمفهوم المواطنة من المنظور الإسلامي.
- نموذج التسامح في قواعد التفاوض مع الآخر، وإدراك مآلاته القريبة والبعيدة، وإدراك مناطات الأحكام، بمراعاة فقه الأولويات الشرعية في ترتيب المصالح الشرعية كما وكيفا في صلح الحديبية وفتح مكة.
- نموذج التسامح في الحرب، بالوقوف عند المطلوب الشرعي، والتزام الأخلاق الإسلامية الرفيعة في التعامل مع الأعداء المحاربين، بعدم التخريب وقتل النساء والشيوخ والصبيان..
وقد صارت هذه الكليات أصلا متبعا، ومعاني واقعية في التجربة التاريخية للحضارة الإسلامية، بحيث نجد نماذج لا تحصى من تحقيق معنى التسامح، بكونه القبول بالاختلاف العقدي والفكري، والتعامل الحسن مع الآخرين في السلم والحرب. ويجد المتتبع لكتب الفقه فتاوى عديدة ونوازل حكيمة في تقرير قيم التعايش في التعامل بين المسلم والذمي[14].
وبتنزيل تلك الكليات تفوقت الحضارة الإسلامية وصارت نموذجا أعلى وأقوم في بيان معنى التسامح الديني والفكري والاجتماعي، حيث إن نموذج الأندلس يعكس، بكل موضوعية، واقعية التسامح الديني في ظل الحضارة الإسلامية، الذي لا يخطئه البحث التاريخي والوثائق التاريخية. مما جعل عددا من العلماء والمفكرين في العالم يكتشفون حضارة الإسلام، وما تميزت به من قيم التسامح والحب والعدل والمساواة بين أقوام وشعوب وعروق وقوميات وأجناس وثقافات مختلفة، ومنهم المؤرخ الشهير غوستاف لوبون في كتابه "تاريخ العرب"، ومنهم أرنولد توينبي في كتابه "الدعوة إلى الإسلام"[15]، ومنهم زيغريد هونكه في كتابها المترجم بعنوان "شمس العرب تسطع على الغرب".
ومن شأن إثبات التوسع المقصدي لدلالة التسامح، من حيث المحافظة عليه من جهة الوجود والعدم، أن يزيل شبهات ادعاء بعض الباحثين المعاصرين، أن مفهوم التسامح عند المسلمين لا ينطوي على دلالات مفهوم التسامح في الفكر الغربي[16]، التي يمكن تتبع نشوئها في القرن السادس عشر، وتحولها في القرون الموالية إلى دلالات متعلقة بإفادة التسامح الإقرار بمبادئ حرية الاختلاف الفكري، والتنوع الثقافي، والاعتراف بالآخر، فمما يذكره فولتير في رسالته عن التسامح، "أن العنف المسعور الذي يدفع إليه العقل اللاهوتي المغلق، والغلو في الدين المسيحي، قد تسبب في سفك الدماء، وفي إنزال الكوارث بألمانيا وانجلترا وهولندا، بقدر لا يقل عما حدث في فرنسا"[17]، وهذا فيه إشارة بليغة عن غياب التسامح أصلا، بين النحل المسيحية الأوروبية الكاثوليكية والبروتستانية، التي تصارعت حول مفاهيم إيمانية وتأويلات عقدية، فصار الاقتضاء الطبيعي لذلك الصراع، أن يفرض التفكير في إرساء مبادئ أخلاقية، تعمل على الخروج من مآسي التقاتل الديني، وتسمح بالاختلاف والتعدد. وفي حركية هذا التفكير ولد مفهوم التسامح في القرن السادس عشر، ثم نجح التأمل الفلسفي العقلاني الغربي، في ترسيخه بكونه ضرورة لتأسيس ثقافة الاعتراف بين القوى المجتمعية المسيحية التي كانت تتصارع[18]. فجاء تشكل مفهوم التسامح في أوروبا، حسب جون لوك، رد فعل "على الصراعات الدينية المتفجرة في أوروبا، ولم يكن من حل أمام مفكري الإصلاح الديني في هذه المرحلة التاريخية، إلا الدعوة والمناداة بالتسامح المتبادل والاعتراف بالحق في الاختلاف والاعتقاد[19]"، فاستقر أن التسامح اقتضاء طبيعي، دعت إليه الضرورة التاريخية، وأكثر من كونه فضيلة خلقية تدعو إليها التعاليم الدينية المسيحية، وإنما جاء نتيجة الصراع الاجتماعي الأوروبي، ونشوء التفكير العلمي المفارق للعقائد الكنسية، والمتجاوز لها في إقرار أهمية العلم التجريبي في الوصول إلى معرفة الظواهر الاجتماعية والكونية. وتطور مفهوم التسامح ليشمل في القرن الثامن عشر مجالات، تتعلق بحرية الفكر والمعتقد، ليصل إلى مدخلات حقوق الإنسان، في سياق ما سموه بفلسفة الأنوار والحداثة، والتي أبرزت مفاهيم جديدة حول الدين والعقل والحرية والمساواة والحقوق الطبيعية..
وما توصل إليه السياق الفكري الغربي من إثبات للتسامح الطبيعي وأبعاده الإنسانية والحضارية، متأصل كما تقدم لنا في قصدية التسامح، باعتبارها قضية فطرية ومبدئية يتوجب تنزيلها حسب مقتضيات التاريخ، وقد تنبه باحثون لإشكالية مفهوم التسامح في السياق الحضاري الإسلامي، وعلاقتها بإشكالية مفهوم التسامح في السياق الغربي، ونشير إلى تحليل كل من علي أومليل ومحمد عابد الجابري[20].
إن قصدية التسامح قيم عالية في تثبيت حرية الفكر، في المظنونات والمتشابهات، واحترام رأي المخالف والاعتراف به، والابتعاد عن الغلو والتحامل، ولذا إذا جمعت بين العلم المتين والعمل الصالح والتخطيط الرشيد والانفتاح الحكيم، فإنها تنقي أولا، من النفس نزوعها نحو الانحراف والكراهية والتعصب والتطرف، و مداخل الشر في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. و تراعي ثانيا، مبدأ وحدة أصل الإنسان، فتنمي فيه المحبة والتكريم، وبناء مجتمع التعاون والأخلاق الفاضلة، وتقوي ثالثا مركزية الحقوق الضرورية للعيش الإنساني الآمن والسلمي.
المحور الثاني: قصدية التسامح و سياق الهوية
إن قصدية التسامح باعتبارها حفظا للكليات المقاصدية، نظرية جامعة بين القيم والمصالح، تشكل إطارا مرجعيا للنظر في علاقة الهوية بالخصوصية والعالمية، وذلك على الرغم من أن مفهوم الهوية من المفاهيم المركبة التي تثير أسئلة عديدة في أبعادها التاريخية والحضارية، فإنه يمكن اعتبارها منظومة من العناصر المرجعية الروحية والمادية والذاتية والاجتماعية المصطفاة التي تسمح بتعريف خاص لشخص ما، فهي "تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفية، ولكن لا يمكن لمثل هذه المنظومة أن تكون في حيز الوجود، ما لم يكن هناك شيء ما يعطيها وحدتها ومعناها، ويتمثل في الروح الداخلية التي تنطوي على خاصة الإحساس بالهوية والشعور بها"[21].
وهذا التكامل بين مكونات عدة، يحقق الهوية الذاتية بوصفها وعيا للفرد أو الجماعة، بإمكانيات المشاركة، ومعرفة الانتماءات الثقافية والاجتماعية، التي تشكل الصور المختلفة للهوية، ولها آثار على حقيقة نموها ونضجها وتكاملها، إذ "أن تطور الكائن الفردي، وضرورات الاتصال، وحقائق الحياة الاجتماعية، وتاريخ تطور الجماعات والحضارات، كل ذلك يشير إلى وجود هوية مشتركة جمعية، "أنا مشترك"، سابق في الوجود للهوية الفردية، "أو الأنا الفردية""[22]. وهذا يظهر أن بنية الهوية عموما، تتشكل من مكونات البناء الحضاري والثقافي، في مجتمع من المجتمعات الإنسانية، حيث يتداخل مفعول النظام العقدي والفكري، والنظام السياسي والتدبيري، والنظام الاجتماعي والاقتصادي، والنظام التفاعلي، مع المحيط الجغرافي الجهوي والإقليمي والعالمي، ونتيجة مفعول تداخل هذه الأنظمة، تحدد معالم الخصوصية في الهوية، وآثار اللغة فيها، من حيث الفكر والقيم، والتثاقف مع الحضارات الأخرى تأثيرا وتأثرا.
وما تقدم من الإشارة إلى أهمية السبق للهوية الجمعية، لا يلغي الوظيفة الأساس لدور الفرد في تشكيل الهوية الجمعية، بناء على فاعلية الفرد ومسؤوليته التاريخية في ضرورة التغيير والتجديد، وهو مما يؤكد نماء الهوية الفردية أو الجماعية، في المتغيرات التاريخية، ويسهل تحليل عوامل أزمات الهوية، التي يمكن أن تصيب الشخصية الإنسانية، تحت تأثير عمليات عدة من الفعل الحضاري، تنال المكونات المعنوية والمادية، فمما يظهر علاقة أزمة الهوية بالتسامح، ما يفرضه اتساع الثقافة الغربية، وهيمنتها على الكرة الأرضية، وفرض قيم جديدة على الخصوصيات الحضارية للشعوب، فالتسامح الفاعل يرفض الإكراه والاستلاب عند وجود نموذجين ثقافيين متناقضين.
إن منهج التسامح، باعتباره مركبا من القيم الدينية والحضارية، وفاعلية الإرادة الحرة للإنسان، يجعل الهوية أمرا متحركا في مكوناتها المتغيرة، ويدفعها للاجتهاد في بناء تصور جديد للخصوصي والعالمي، ومدى تبادل التأثير والتأثر، مع إدراك كونية الخصوصية، حينما تتأكد فيها عالمية قيم الاعتراف بالآخر والتعايش والتعارف، ومع إدراك كونية العالمية، حينما تحترم القيم الحضارية للخصوصية، وبهذا يتم تحليل حدود الكوني والعالمي، في صياغة هوية حريصة على تقوية الخصوصي بالعالمي، وإغناء العالمي بالخصوصي.
وقبول الهوية، بناء على مبدأ التسامح بالتأثير والتأثر بين الخصوصي والعالمي، لا يعني غياب إرادة الاستقلال، والعمل على رفض التبعية، ومهاجمة قابلية الخضوع للغالب، المؤدي لقتل الهوية باسم التسامح والتطور والعصرنة، وإنما يؤكد أن الهوية مركب تاريخي وثقافي وحضاري متحرك يرفض الجمود والتقليد من جهة، ويثبت القيم الأصيلة المدافعة عن الوحدة الإنسانية وخيريتها واستيعابها لأجناس وثقافات متنوعة، فتسعى إلى الاعتراف بالآخر والسعي نحو التحاور معه، وهذه الحركية نجدها في نموذج الهوية الإسلامية وعلاقتها بضرورة الاجتهاد الحضاري الذي لا يمثل الاجتهاد عند علماء أصول الفقه إلا جزءًا منه.
وتتحدد الهوية الإسلامية بأصول حضارية، تتكون من الوحي ومقاصده الشرعية، واللغة العربية ونظامها البنائي، وتطور العلوم وآثارها في تشكيل العقل الإسلامي، والتاريخ الإسلامي وسننه الفاعلة. وبهذه الأصول ترسخ الهوية الثابت والكلي، وتنمي المتغير والفرعي، بالاجتهاد الشرعي في صيرورتها التاريخية، وتدفع منزلقات اندثار الخصوصية أو استبدالها بالهويات الفرعية، التي من شأنها إشاعة اضطراب الأمن الاجتماعي، ومظاهر الفوضى والتطرف في المجتمع، فالهوية الإسلامية متشربة للتسامح دون تمركز أو تحيز، وتفاعل مع التراث الإسلامي دون استلاب به، وفاعلية عقلية مقاصدية في تنزيل الشرع ومقاصده في الواقع التاريخي، يقول الطاهر بن عاشور:" يحق لنا أن نقول إن التسامح من خصائص دين الإسلام، وهو أشهر مميزاته، وأنه من النعم التي أنعم الله بها على أضداده وأعدائه، وأول حجة على رحمة الرسالة الإسلامية المقررة بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107)[23].
إن الوعي المعرفي بمسألة الهوية الإسلامية، يجعل التسامح مؤديا أغراضه الحضارية بكل علمية، ليسد الذرائع أمام كل المناهج، التي تعمل على تهديم منظومة القيم الإسلامية والوطنية، واستبدالها بأساطير وهمية مستمدة من التنظير لصدام الحضارات، وثقافة التطرف والانغلاق والإرهاب، فمقصدية التسامح تؤسس الوعي العلمي والعملي، لدفع استغلال ثقافة التسامح، بما من شأنه نخر القيم الإسلامية ومفاهيم المواطنة الحقة، فإخراج هذه المفاسد من تفعيل حفظ الهوية الإسلامية، يجعل التسامح حصنا معرفيا لبناء هوية قائمة على شروط الخصوصية وضوابط العالمية، وذلك بأن يكون محققا للحوار الداخلي، داخل أفراد المجتمع للتعاون على النهوض بالوطن في سلم التقدم والازدهار، وعاملا في الوقت ذاته على تمتين العلاقات الدولية وتبادل الاعتراف بالثقافات، وبانيا لجسور التواصل الحضاري والانفتاح العالمي.
وتشتغل مقصدية التسامح في سياق الهوية بمنطق المعادلة التفاعلية القيمية، التي لا تعني الاستلاب ولا التبعية، وإنما استلهام عقلاني وموضوعي يتطلبه منطق التاريخ، ومنطق المكونات البانية في الثقافة. فالاستلاب والتبعية والغزو الثقافي، ليست أمورا وهمية أو تخيلية تخترعها الثقافات الضعيفة والمغلوبة، وإنما هي حقيقة تاريخية، تكمن ورائها سنن اجتماعية وسياسية وعسكرية واقتصادية، تولد انتصار سمات الصراع والطغيان والغلبة، وتنشئ لدى الثقافة المغلوبة تساهلا في التعامل مع ثقافة الغالب، وولعا بالاتباع وإرادة البحث عن مسوغات الخضوع والهيمنة والاستلاب.
فالمقصود من تفاعلية التسامح في سياق الهوية، إيجاد بديل ثقافي أرقى، عن طريق استلهام ما هو مشترك وإنساني، متحقق فيه شرط عدم العودة على العناصر الثابتة المؤسسة للهوية بالإبطال، لكنه يؤدي إلى صالح الوحدة الإنسانية، في التقدم الحضاري وتثبيت ثقافة التفاعل التسامحي، التي تقوم على مرتكزات تشكل فيصلا بين التسامح واللاتسامح[24].
ويمكن تلخيص معالم ثقافة التفاعل التسامحي في المرتكزات الآتية:
المرتكز الأول: الوحدة الإنسانية والتساوي في الخلقة والتكوين
والمراد بهذا المرتكز أن الناس سواسية في علاقاتهم بالله تعالى، فهو سبحانه ليس إله ثقافة معينة، أو قومية معينة، لتكون سيدة والباقين مسودين، وإنما الناس عند الله تعالى كأسنان المشط، لا فضل لأحد على آخر، ولا كرامة خاصة لأحد إلا بالعمل الصالح، وفق صواب السير على منهج صراط مستقيم، لخدمة الناس بسعي اجتهادي لا يفتر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13)، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾(النساء: 1)، فالناس متساوون في الخلقة، وفي استثمار المسخرات، وفي معرفة أسماء الأشياء من أجل التزكية والتعارف والتكامل، قال تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (الإسراء: 20)، وبهذا لا توجد تفاوتات أو فواصل منيعة في الخلقة، فالبشر متشابهون في جوهرهم الإنساني وطبيعتهم الإنسانية، ومن ثم كان المشترك الثقافي الجامع بينهم متعدد السبل ومتنوع الإمكانات، لا يقف أمام تحقيقه إلا الخروج على المنهج الطبيعي الفطري العملي المنسجم مع كل الكون.
المرتكز الثاني: التعارف والتحاور
إن التعارف سبب وشرط لحصول التحاور، فلما كان الناس متساوون في ارتباطهم بالله تعالى، وفي الخلقة والتكوين والتكريم، وفي الانسجام مع الكون، كان التواصل والتعارف والتعايش نتيجة ضرورية لذلك، لا بد منها لتعمير الأرض، فالتساوي يدعو إلى التعارف، وهذا يدعو إلى التحاور، والأخير يدعو إلى التعايش، وهذا المنطق يتناسب مع منطق الدعوة إلى الله، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: 125).
ثلاث خطوات منهجية، تتضمن البرهان العقلي، و الميزان الأخلاقي، لترسيخ الاعتراف بالآخر، كان من المسلمين أو من غيرهم. فبخصوص غير المسلمين سواء من المشركين، أو من أهل الكتاب، أو من غيرهما، نجد تأكيد الدعوة على التواصل معهما، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: 6)، وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 64)، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون: 1-6)، فالتحاور، والكلمة السواء، والاعتراف بالآخر، منطلقات مبدئية للتحاور والتعايش وعدم الإكراه، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: 256)، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (يونس: 41).
المرتكز الثالث: التدافع وضوابط الاختلاف، فالتدافع يمنع الفساد والتعدي والظلم، وينمي الخير ويقوي الحق، ويكسر الباطل، ولهذا كانت أصول التدافع عدم التعدي وعدم الإفساد وعدم الظلم، وهذا ما يضمن تفاعلا ثقافيا، رغم الاختلاف الذي لأجله تم خلق البشر، مما يفيد التدافع داخل الوحدة الإنسانية، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (هود: 118-119)، فقد خلقوا لكي يختلفوا ويتعارفوا ويتحاوروا ويتعاونوا، ومن ثم إزالة الذرائع المؤدية إلى الاختلاف المذموم الذي هو منطق اللاتسامح، والعمل بضوابط الاختلاف المحمود في التدافع تعارفا وتحاورا بناء على التساوي في الخلقة، وهذا هو منطق التسامح.
وتؤكد هذه المرتكزات، أن التسامح التعارفي والحواري قيم سلوكية أصيلة، في مركب تكامل الهوية والثقافة والحضارة، قائمة على وجود رؤية معرفية للقيم الأخلاقية، لا تفصل القيم الدينية عن العقل و الأخلاق العقلية عن الدين، وتستطيع أن تجعل القيم الأخلاقية موضوع الحوار بين الحضارات والثقافات والهويات، من مدخل النقد لهامشية القيم الأخلاقية في الفكر الإنساني المعاصر، الذي يرتكز على وثوقية العقل الإنساني، وإنتاجها لمنطق يعمل على تغييب التسامح في العلاقات بين الشعوب والدول.
ومن هذا النقد تتولد ثقافة التسامح في سياق الهوية، فتعمل أولا على تحرير الإرادة الإنسانية من التطرف الديني والعقلي، ونبذ العنف والتعصب، واحتكار الحقيقة والصواب من لدن جهة واحدة غالبة، وتعمل ثانيا على مقاربة علمية لإشكالية تحاور القيم بدل صراعها، التي أرقت الإنسانية من حيث العلاقة بين الهويات والخصوصيات والكونيات وبين الأديان والثقافات والحضارات[25].
المحور الثالث: مقصدية التسامح وسياق الفعل الحضاري
يكشف الاقتران بين قصدية التسامح والحضارة، الارتباط القوي بين التزكية القيمية ومراعاة الكليات المصلحية، وبين الإبداع الحضاري والنمو الحضاري. فالحضارة ظاهرة إنسانية[26] غير منحصرة في الثقافة ولا في المدنية ولا في النمو الاقتصادي، وإنما هي منظومة متكاملة، منطلقة من التأطير الديني السليم إلى الإبداع العلمي الراقي، إلى الاجتماع البشري المتوازن، فتصير مظاهر واضحة في العلم الراشد والفكر الخلاق والاجتماع الآمن، ومن هذا المفهوم الشمولي للحضارة، يستمد أولا، الفعل الحضاري مقاييسه في الفقه الحضاري، بوصفه الفهم العميق للقيم الكبرى للحضارة، نحو العدل والأمن والحرية والتعاون [27]، ويتوضح ثانيا، سياق الفعل الحضاري، باعتباره سياقا قيميا، يتجاوز ضيق السياسة وخنق الاقتصاد إلى المبادئ الكونية الجامعة لجلب مصالح الإنسان.
فالحضارات تزدهر، من خلال بناء مؤسساتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفقا لرؤية أخلاقية متينة، وهذا التلازم بين الرقي الحضاري والقيم الأخلاقية الرفيعة، يبرز أزمة الأخلاقية المعاصرة في الشرق والغرب، ومدى قصورها في صياغة مسالك حقيقية لبناء تسامح حضاري حقيقي، منتج للحوار بين الحضارات، مجابه للهيمنة الثقافية والتنميط العالمي الذي نظرت له الحداثة، وتحققه العولمة.
ولكي نبرز أهمية قصدية التسامح في تجاوز مأزق الأخلاقية المعاصرة، نقدم نموذج هنتنجتون في التحليل الحضاري، الذي يستنتج منه أن الحضارات الكبرى في العالم لا توجد بينها قيم عالمية مشتركة، ولذا فالصراع حتمي بينها، لأنها قد بنيت على مجموعة معينة من القيم التي تكمن جذورها في الماضي التاريخي المعقد، والتي شكلت في نهاية المطاف مجموعة من القيم غير المتكافئة. وقد عمل هنتنجتون على كشف مفهوم الحضارة من خلال أربعة أمور[28]:
الأول: التفريق بين الحضارة بمعناها المفرد والحضارات بصيغة الجمع
الثاني: الحضارة كيان ثقافي، والثقافة هي الفكرة العامة في كل تعريف للحضارة، فالحضارة هي ثقافة على نطاق أوسع، وكلاهما يضم المعايير والقيم والمؤسسات، وطرائق التفكير التي علقت عليها أجيال متعاقبة أهمية أساسية في مجتمع ما، إذ كلاهما يشير إلى مجمل أسلوب الحياة لدى شعب ما.
الثالث: الحضارات شاملة، بمعنى أن أي جزء من مكوناتها لا يمكن فهمه تماما دون الرجوع إلى الحضارة التي تضمه، فالحضارة حسب توينبي تشمل ولا يشملها غيرها، وأن الحضارات كيانات ذات معنى وهدف، و الخطوط بينها نادرا ما تكون حادة إلا أنها حقيقية.
الرابع: الحضارات فانية، أو أنها ليست أبدية، إلا أنها أيضا تعيش طويلا، فهي تتطور وتتكيف، وهي أكثر الجماعات الإنسانية ثباتا وتحملا، وجوهرها الفريد والخاص، هو استمرارها التاريخي الطويل، فالحضارة هي أطول قصة في الواقع.
وفي منظور هذه الأمور، يقرر أن الحضارة لا تقوم ردا على تحديات، كما يذهب إلى ذلك توينبي، وإنما تتحرك عبر الامتزاج، والحمل، والتوسع، وعصر الصراع، والإمبراطورية الكونية، والتآكل والغزو. ليصل إلى تحديد الحضارات الرئيسية المعاصرة في: الحضارة البوذيّة الكونفشيوسيّة وتضمُّ الصّين، والحضارة اليابانية وتضم تقاليد اليابان الدينية، والحضارة الهندوسيّة وتضمُّ الهند وبعض الدّول القريبة منها، والحضارة الإسلاميّة وتضمُّ جميع البلاد التي يدين أفرادها بدين الإسلام، والحضارة الغربية الأوروبية والأمريكية الشمالية وأمريكا الجنوبية، وقد تشكَّلَت من امتداد المسيحيّة واعتمدَت على العلمانيّة بشكلٍ أساسيٍّ، والحضارة الأرثوذكسيّة وتضمُّ العالم الروسيّ وأوروبا الشرقيّة بسيطرة الكنيسة الأرثوذكسيّة.
والعلاقة بين هذه الحضارات حسب رأيه، انتقلت من المواجهة إلى صعود عالمية حضارة الغرب وغلبة تأثيرها على غيرها من الحضارات، ثم إلى نظام ذي تفاعلات متعددة الاتجاهات بين الحضارات، محددا سمات هذا التفاعل الحضاري في انتهاء التوسع لحضارة التغريب، وامتداد النظام العالمي إلى ما وراء الغرب[29]. لكنه يبرز أن مفهوم الحضارة العالمية إنتاج مميز للحضارة الغربية لا يجد سوى القليل من التأييد في الحضارات الأخرى، فما يراه الغرب عالميا أو كونيا، يراه غير الغربيين خصوصيا وغير كوني، وميزان الرفض يبدو لديه في ظاهرة عالمية هي العودة إلى الدين، باعتباره محركا للتقدم والتغيير الحضاري.
إن القراءة النقدية لهذا التحليل الحضاري تكشف أن حديثه عن المشترك الإنساني غائب، وإقراره أن الحضارات الأخرى غير معتبرة من الحضارة العالمية التي يحصرها في حضارة التغريب فقط، ويؤكد أن مواجهة حضارة الغرب آتية من دعوة غير ناضجة للعودة للأديان والثقافات والهويات، من لدن شعوب الحضارات الأخرى بحسب قوة كل حضارة على حدة.
ولتجاوز مأزق الصراع الحضاري وتغافل المشترك القيمي بين الحضارات، يصير العمل بمنطق التسامح وثقافته، من الضروريات التي لا تستقيم الحياة الإنسانية إلا بها، ومن هنا مشروعية قصدية التسامح في تأسيس الحضارة العالمية، من منطلق فكرة عالمية الإنسان. فقصدية التسامح ضرورة وجودية ومطلب إنساني، في جميع مجالات الفعل الحضاري الديني والفكري والسياسي، لتحقيق صلاح الإنسان والكون وتحقيق صلاح العمران البشري، في أفق ما يعرفه الواقع العالمي من الخصوصيات العرقية والدينية والفكرية والبيئية.
فالواقعية الحضارية تفرض التعارف في عالم تتدافع فيه نوازع الخير والشر، والحب والبغض، والتجانس والتنافر، والسلم والحرب، وفيه الأنا والآخر، فالاختلاف قانون كوني لا يثبت توازنه ويثمر ثمرة التعايش إلا بقصدية التسامح التي تقر بالاختلاف، وتقبل بالتنوع، وتعترف بالتغاير، وتحترم الخصوصيات الحضارية والثقافية. ولهذا كان التعصب والتشدد والانغلاق والاستبداد، أشد النكب التي تصيب التدين والتفكر والتعقل، فتعمل ضد قانون التوازن الكوني، ليس في العلوم الكونية فقط، وإنما في العلوم الإنسانية والاجتماعية أيضا.
إن قصدية التسامح بمرتكزاتها الفطرية والكليات المقاصدية والتجربة الحضارية، تعمل على تطوير التحليل المنهجي، لكون "الحضارات تجمعها علاقة تفاعلية، تقوم على التبادل والتكامل، وبهذا فإن الحوار بين الحضارات ليس ظاهرة جديدة، بل هو لازم للحضارة لا انفصامَ لها عنه، خاصة وأن الحضارة الواحدة تتنفس من فضاء الحضارات الأخرى"[30]، وينطبق هذا على الحضارة الإسلامية كما ينطبق على غيرها من الحضارات، وذلك أن منطق القصدية منطق تفاعلي وتحاوري وتحالفي وسلمي بين الحضارات، لا مناص منه في بناء حضارة برؤية للعالم أوسع أفقا وأنضج تحليلا لأزمات العالم وآثارها المدمرة للاجتماع الإنساني، وهذا هو التحدي العالمي، الذي يقتضي النظر الحكيم، في استكشاف الآليات المنهجية لعقلنة التفاعلية الحضارية، والرقي بها في عالم مفتوح، تحكمه مصالح السوق، التي جعلتها العولمة مدخلا أساسا في نقل ثقافة غالبة، والتمكين لهيمنتها، لا لقوة قيمها التسامحية، وإنما لفرط تعصبها واعتقادها أنها نهاية التاريخ.
وقد يكون من الآليات المنهجية لتحقيق التفاعل الحضاري، تقنين التعارف الحضاري القائم على التكافؤ والندية بين الحضارات، من منطلق التنوع الثقافي، الذي أصدرت بخصوصه منظمة اليونسكو سنة 2002 الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، وأبرزت فيه إثبات قيم متكافئة في جميع الحضارات العالمية، تمثل مشتركا إنسانيا حقيقة وليس وهما، والمقصود بالتكافؤ "أن تكون العلاقة التفاعلية بين الحضارات والثقافات قائمةً على مبدأ الندية، وهي حالة لا يتم معها الشعور باستعلاء طرفٍ حضاري على الآخر، أو بهيمنة حضارة على الحضارات الأخرى"[31].
كما أنه لا يقصد بالتكافؤ بين الأطراف الحضارية استواء جميع هذه الأطراف في الإنجاز، والحضور حجماً ومستوى، به وإنما يقصد به سيادة "الاعتقاد بأن كافة هذه الأطراف شريكة في الميراث الإنساني العام، وبوسعها أن تساهم بجدارة في صنع الحاضر والمستقبل، وأن يتمّ إدراك هذه الحقيقة والتعامل بمقتضاها دون إلغاء أو إقصاء أو تهميش"[32].
وقد يتسرب الشك إلى وظيفة قصدية التسامح من الرافضين لمفاهيم التكافؤ الحضاري وحوار الحضارات وحوار الأديان وحوار الثقافات[33]، من الباحثين في ميدان الفكر الحضاري الإسلامي والاجتهاد الحضاري، بناء على أنها مداخل منهجية لإقصاء الإسلام والتقليل من العناية به. لكن المتفحص لمفهوم قصدية التسامح، وكيفيات تحقيقها لمصالح الإسلام المستنبطة من نصوصه استدلالا واستنباطا، يستخلص أثرها الحضاري في إغناء الهوية والخصوصية والعالمية، وتمكينها من مقاييس التمييز بين المنفصل والمتصل بأصول الهوية الحضارية، فهي تراعي واقعية التنوع الثقافي والتعدد الثقافي، والتعامل معه بما تقتضيه القصدية الشرعية الأصلية والتبعية العامة والخاصة، في تكييف قيم التسامح المعاصرة ومتعلقاتها بحقوق الإنسان وتكريمه وصلاحه.
وبما أن قصدية التسامح منظومة قيمية وإنجاز عمراني، فإن لها في سياق الهوية والفعل الحضاري، استراتيجيات راشدة بوصفها بحثا علميا وتخطيطا مستقبليا، لحضارة عالمية، مؤسسة على فاعلية المشترك الإنساني، ومراعاة الخصوصيات الحضارية والمنهج التعارفي التعاوني في تحقيق مقاصد قصدية التسامح.
ويمكن صياغة هذه الاستراتيجيات، الناقلة لمجموع قيم التسامح من كونها قيما أخلاقية مبدئية واختيارية، إلى كونها قيما عملية يتعين إنفاذها بدخولها في حد الواجب والحق،في التصورات الآتية:
- استراتيجية النقد التفاعلي، الذي يقوم على مراعاة التمييز في الحضارات بين الوسائل والمقاصد وبين الضروري والحاجي والتحسيني وبين الخصوصي والعالمي.
- استراتيجية تفعيل المعرفة القيمية الروحية والأخلاقية والإنسانية، والاجتهاد في جعلها أصلا كليا في تدبير الاختلاف الإنساني والتنوع الثقافي.
- استراتيجية التربية والتعليم والتواصل، في تحقيق ثقافة التسامح ضمن حركية المجتمع.
- استراتيجية تنشئة ثقافة الحوار والاعتراف ونقلها من النظر إلى العمل.
- استراتيجية الهوية الناضجة المدركة لمقاصد التفكير العلمي والتجدد في الوحي القرآني واستمرار معانيه ولا نهائيتها في التاريخ؛ يقول تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (الكهف: 109). وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: 27).
- استراتيجية مقاصد عالمية الوحي و علاقتها باستيعاب الواقع الإنساني.
فنستخلص أن أثر قصدية التسامح في سياق الفعل الحضاري يكمن في أن:
- قيم التسامح من الكليات الضرورية لصلاح الحضارة.
- قيم التسامح بناء قيمي إنساني مشترك يقتضي جلب الحوار ودفع الصراع.
- قيم التسامح تنزيل عملي للعدل والمساواة والحقوق في بناء العمران الفكري والبشري.
- قيم التسامح بناء للحوار الداخلي والخارجي وتأسيس المجتمع التعاوني.
- قيم التسامح تحقيق لثقافة السلم والأمن في المجتمعات وفي العالم.
- مقيم التسامح تنشئة اجتماعية على مبادئ العفو والصفح والمغفرة والرحمة.
خاتمة
يبزغ التطور الحقيقي للبشرية، حين ترتقي الثقافة الإنسانية لتفعيل قصدية التسامح، التي من مقاصدها تحقيق التوازن العالمي، بفعل الارتكاز إلى أصل الوحدة الإنسانية، ثم تكييف الفطرة بنزعة الخير وإلهاميته، والتنشئة الهادفة لحضارة عالمية، تجد فيها الشعوب هويتها وآمالها وطموحها. فقصدية التسامح منظومة من القيم الشرعية الكلية والجزئية التي تمنع موت إنسانية الإنسان، وموت الأخلاق الدينية الفاضلة،وتقطع مع النموذج المعرفي القديم، الذي يقوم على أخلاقيات الاقتصاد المادي والفصل بين العلم والدين، لتؤسس نموذجا معرفيا جديدا،يفتح آفاق التكامل الحضاري، والتركيب بين المعرفة العلمية والحكمة، وبين العلم والدين، لممارسة الاقتصاد القيمي الجامع بين التربية الروحية والتربية العلمية، وذلك تحدي تفعيل قصدية التسامح في مستقبل الإنسانية.
الهوامش
[1]. سيأتي ذكرها لاحقا، وقد كان أصل كتابه صراع الحضارات مقالة نشرها سنة 1993، بالمجلة الأمريكية فورين آفيرز. Foreign affairs .
[2]. نهاية التاريخ والإنسان الأخير، أشرف على ترجمته مطاع صفدي، بيروت: مركز الإنماء العربي، 1993.
[3]. ومن هذا الدراسات دراسة لهابرماس: من التسامح الديني إلى الحقوق الثقافية، ودراسة بول ريكور، حوار الثقافات: تصادم الموروثات الثقافية، ودراسة جين هورش التسامح بين الحرية والحقيقة.
[4]. إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح الذي أعلنه ووقعه المؤتمر العام لليونيسكو في 16 نوفمبر 1995. رسالة اليونيسكو، آذار/مارس 1996، ص34.
[5]. من المصطلحات التي يعتمدها طه عبد الرحمان في نقده للحداثة الغربية بالمفرد والجمع في ارتكازها المطلق على العلمنة والأنسنة والعقلنة، انظر كتابه شرود ما بعد الدهرانية: النقد الائتماني للخروج من الأخلاق، بيروت: المؤسسة العربية، ط1، 2016.
[6]. انظر مادة سمح في: مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب، لابن منظور، تاج العروس، للزبيدي.
[7]. الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط2، (1406هـ/1986م)، 3/300.
[8]. تستكشف عالمية الوحي من غائية مقاصده وقيمه الكونية، فمقاصد الوحي طرائق منهجية لا تمثلات ذهنية، وهي منظومة عالمية قابلة للتطبيق في المجال الإنساني. ومن المحددات المعرفية القرآنية التصديق والهيمنة. انظر مدخل تأسيسي في الفكر المقاصدي، لعبد الرحمان العضراوي، مركز نماء، الطبعة الأولى، بيروت، 2015.
[9]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم الحديث 1496
[10]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة قبل الغروب، رقم الحديث 542.
[11]. أخرجه السخاوي في المقاصد، الحسنة كتاب الجهاد والإمارة والقضاء، رقم الحديث 44.
[12]. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا رقم الحديث 3052
[13]. انظر السيرة النبوية، لابن هشام، حققه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار الكتب العلمية، د.ت.
[14]. أفتى ابن رشد الجد بجواز التعامل بين المسلم والذمي، فقد أجاب في سؤال عن بيع أصول الكروم من النصارى، هل يجوز ذلك وهم يعصرون تمرها خمرا أملا؟ وكيف إن لم يجز ذلك ووقع البيع، هل يفسخ أولا؟ فأجاب رحمه الله: "ذلك مكروه ولا يبلغ به التحريم في فسخ". مسائل أبي الوليد ابن رشد 2/1144. وسئل القاضي أبو عبدالله بن الأزرق عن اليهود يصنعون رغائف في عيد لهم، يسمونه عيد الفطر، ويهدونها إلى بعض جيرانهم من المسلمين، فهل يجوز قبولها منهم وأكلها أولا؟ فأجاب: "قبول هدية الكافر منهي عنه على الإطلاق نهي كراهة". المعيار للونشريسي، قابله وصححه، عمر بن عباد، نشر وزارة الأوقاف المغرب، طبعة 1986، 11/111. ويستفاد من الجوابين جواز التعامل مع أهل الكتاب، لأن الكراهة المقصودة ليست كراهة تحريم، وإنما كراهة من أجل الاحتياط والحذر من الوقوع في موالاتهم، وسدا لذريعة الركون إليهم.
[15]. معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوروبية، لعبد الله علوان، بيروت، حلب: دار السلام، 1980، ص156.
[16]. التسامح بين شرق وغرب، دراسات في التعايش والقبول بالآخر، بيروت: دار الساقي، 1992.
انظر مقال سمير الخليل بعنوان التسامح في اللغة العربية، يقول: "فإن الواقع المدهش حقا هو أن التسامح الذي يعتبر سمة عامة في الفكر الغربي منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر وفكرة معاصرة في زمننا، هذا التسامح يبدو في المقام الأول غائبا عن اللغة العربية، وبالتالي غائبا غيابا طبيعيا عن أنماط التفكير كافة والتي تعمل عبر هذه اللغة". ص5.
[17]. رسالة التسامح، لقولتير، ترجمة هنري عبودي، دمشق: دار بترا للتوزيع والنشر، ط1، 2009. ص31.
[18]. انظر تاريخ التسامح في عصر الإصلاح، لجوزيف لوكلير، ترجمة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة.
[19]. انظر رسالة جون لوك حول التسامح، ترجمة منى أبو سنة، مراجعة مراد وهبة، ط1، المجلس الأعلى للثقافة بمصر، 1997.
[20]. فقد تساءل علي أومليل عن مفهوم التسامح هل هو محايد؟ وأوضح أنه وليد حروب القرن السادس عشر الدينية في أوروبا، أدى إلى التسليم بالحق في الاختلاف في الاعتقاد والرأي وإقرار حريتهما، ومع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى، فباسمه سعت القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر إلى تفكيك الدولة العثمانية وإلى أن تنتزع منها الحماية على الأقليات غير الإسلامية. وبهذا يرى أن مفاهيم عدة ومنها التسامح كانت إيجابية في موطنها الأصلي لكنها غير إيجابية في سياقات أخرى، الإصلاحية العربية ص109.
يحاول الجابري تأصيل مفهوم التسامح في التراث العربي الإسلامي من خلال مفهومي الاجتهاد والعدل والإيثار، ولاسيما الصورة التي يأخذها مفهوم العدل عند ابن رشد في قوله" من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه"، ويأخذها عند المعتزلة والفرق الكلامية العربية الإسلامية، التي كانت تركز على مفهومي التسامح من جهة، وحرية الإنسان من جهة أخرى، وفي ضوئها عمل على إعادة بناء مفهوم التسامح في التراث العربي الإسلامي بصورة يتوافق فيها مع المعنى الذي يوظف فيه داخل الفكر الأوروبي كمفهوم ليبرالي. انظر قضايا في الفكر العربي المعاصر، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997، ص29.
[21]. الهوية لأليكس ميكشيللي ، ترجمة: علي وطفة، ط1، 1993، ص99.
[22]. المرجع نفسه، ص129.
[23]. أصول النظام الاجتماعي، للطاهر ابن عاشور عمان: دار النفائس، ص229.
[24]. انظر قضايا في الفكر العربي المعاصر، م، س، ص32.
[25]. صراع القيم بين الإسلام والغرب لرضوان زيادة وكيفن جيه أوتول، طبعة 2010 ، دمشق: دار الفكر. يقول رضوان زيادة بخصوص صدام القيم والصراع على القيم الكونية" يختفي تحت الجدل الدائر حول مفهوم الكونية أو العالمية والخصوصية صراع خفي حول إسهام الحضارات الأخرى في بلورة هذه القيم الكونية، فالمؤمنون بالخصوصية يحاججون أن هذه القيم ليست كونية البتة، بل هي تنحدر بالأخص من حضارة الغرب المسيحي-اليهودي، وهم يجادلون بأن الإقرار بكونية هذه القيم يلغي خصوصية الثقافات الأخرى، لكن مع الإقرار في الوقت نفسه أن هناك حقائق أخلاقية أساسية معينة يشترك كل العالم في الإقرار بها، إذ لكل حضارة وثقافة مسار تشكلي خاص بها مرتبط بتطورها، واتساقا مع ذلك يفرز هذا المسار مفاهيمه التي تعبر عن رؤية للعالم خاصة به حسب تعبير اشبنجلر، ونظرة للآخر مشكلة وفق بناه، التي أفرزها التاريخ المجتمعي بكل مصائره واختلافاته وتحولاته" ص13.
[26]. الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، لحسين مؤنس، عالم المعرفة، العدد 1، السنة 1978، ص44.
[27]. أنظر فقه التحضر لعبد المجيد النجار، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1999، 1/112.
[28]. صراع الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، لصمويل هنتنجتون، ترجمة طلعت الشايب، ط2، 1999، ص69.
[29]. المرجع نفسه، ص88.
[30]. الوسطية والبعد الحضاري، لأحمد الراوي منشور بموقع: islam.gov.kw، ص8.
[31]. المرجع نفسه، ص8.
[32]. المرجع نفسه.
[33]. وقد نظمت عدد من المؤتمرات حول حوار الحضارات والأديان والثقافات، لكنها لا تناقش الجوهر في الفعل الحضاري ووضع الآليات للقطيعة المعرفية مع وسائل هيمنة الثقافة الوحيدة وتأويل الأمور الحضارية والدينية من منظورها للعقل والإنسان والدين، ونذكر من هذه المؤتمرات على سبيل التمثيل قراءة مشتركة للكتب المقدسة: القرآن والإنجيل والتوراة (2003)، تفاعل الأديان في ظل القيم الدينية الحضارية المشتركة (2004)، دور الأديان في بناء الإنسان (2006)، القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة (2007)، الدعوة للمصالحة بين الأديان (2008)، دور الأديان في التضامن الإنساني (2009)، التعاون بين الأديان لتحقيق السلام (2010).