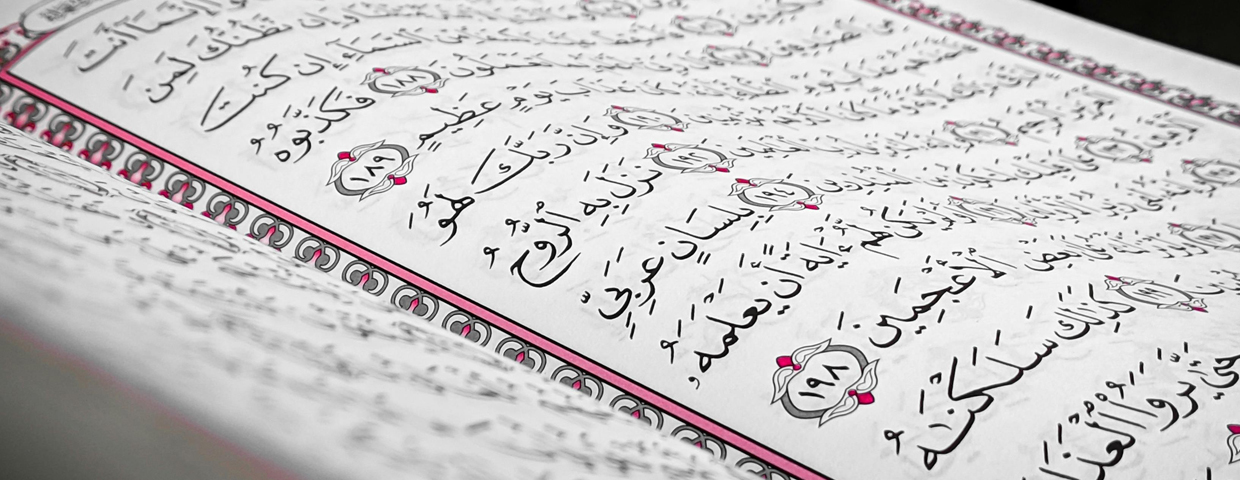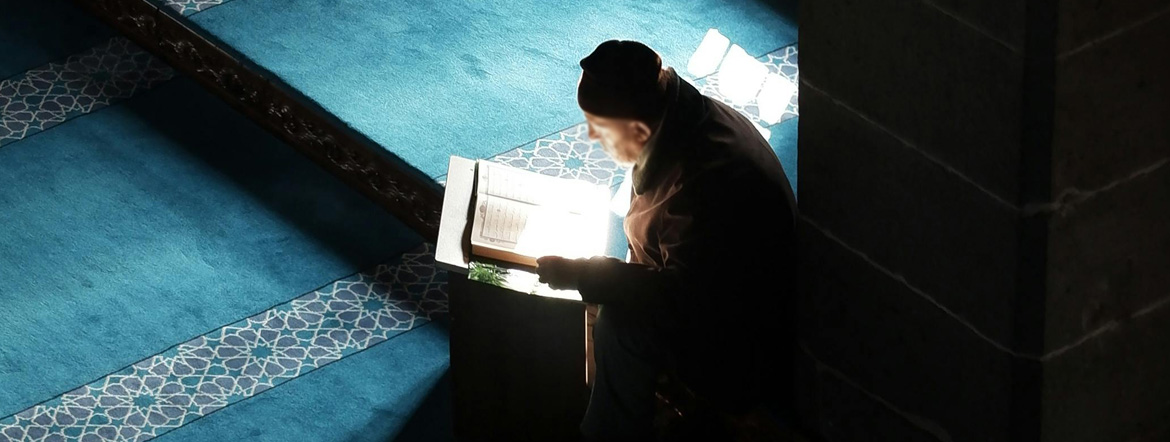دلائل النبوة من خلال الإسراء والمعراج

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
إن دلائل النبوة هي ما أكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير شرط التحدي، وإذا كان الدليل أو العلامة أو الأمارة مسميات لمعنى واحد، هو: ما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير شرط التحدي، والدليل أو العلامة أو الأمارة مسميات لمعنى واحد، وهو غير المعجزة التي هي: أمر خارق للعادة يظهر على يدي مدعي النبوة على وجه التحدي، وهذا معناه أن التحدي والعجز عن المعارضة شرطان في تسمية المعجزة، وليس الأمر كذلك في تسمية الدليل.
وقد اهتم بهذا الموضوع الدكتور فاروق حمادة في كتابه: مصادر السيرة النبوية وتقويمها[1]، ولم يفرق بين الدلائل والمعجزات[2]، في حين فرق بينهما الدكتور أحمد فكير في مقاله: من مصادر السيرة النبوية: كتب دلائل النبوة، كما تقدم بيانه، وتبين أن بين الدليل والمعجزة عموم وخصوص، فالدليل أعم والمعجزة أخص، حتى أن بعض من ألف في دلائل النبوة من المتقدمين لم يلحظوا هذا الفرق، أو لم يعتبروه، أو تجاهلوه، فعدلوا في عناوين مؤلفاتهم عن مصطلح الدليل أو ما في معناه إلى مصطلح المعجزة، كما فعل عبد الحق الإشبيلي (المتوفى عام: 580هـ) في كتابه: معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحمد اللخمي الإشبيلي (المتوفى عام: 654هـ) في كتابه: الدرر السنية في معجزات سيد البرية، وعبد الرحمن الثعالبي (المتوفى عام: 873هـ) في كتابه: الأنوار في آيات ومعجزات النبي المختار، وغيرهم[3].
هذا، وقد نبه العلماء من قبل على هذا الفرق الدقيق بين الدليل والمعجزة، فأفاد السهيلي عند حديثه عن ما بدئ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوءة: تسليم الحجر والشجر، وحنين الجذع، قائلا: "وإن كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها فيها علم على نبوته عليه الصلاة والسلام، غير أنه لا يسمى معجزة في اصطلاح المتكلمين إلا ما تحدى به الخلق فعجزوا عن معارضته"[4].
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: "لا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها اصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما . والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة ما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة"[5].
وقال ابن حجر: "العلامات جمع علامة وعبر بها المصنف، لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة، والفرق بينهما أن المعجزة أخص؛ لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأني صادق، أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذا، ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة، وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن "[6].
إن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بدلائل وعلامات نبوته، وهي مبثوثة في كتب الحديث الشريف والسيرة النبوية العطرة، وقد بوبها العلماء في تلك الكتب الجامعة، وأفردها العلماء بالتصنيف منذ القرن الثالث الهجري، إلى القرن الخامس عشر، وهي من مصادر السيرة النبوية التي اعتنى المعاصرون بجمعها[7].
إن من دلالات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: الإسراء والمعراج، وقد أثبت العلماء في كتبهم هذا الحدث، ومما خصه بالكلام في كتب الدلائل النبوية:
علي بن ربن الطبري ( كان حيا سنة 247هـ)، في كتابه: الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال رحمه الله تعالى في الباب الثالث: في آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي رددها وجحدها أهل الكتاب: "وأنا ذاكر من آياته عليه السلام ما فيه برهان لقوم ينصفون، وأبدأ في هذا الباب بما في القرآن منه لئلا يقول المخالف: إِنَّه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم آية لذُكرت فيه، كما ذُكر في التوراة والإنجيل آيات موسى وعيسى عليهما السلام. فمن آياته التي ظهرت في أيامه عليه السلام، وشهد به القرآن أنه أُسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو قول الله عز وجل: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا﴾[8]، وقد كانت العرب أنكرت ذلك أنَّى، وكيف قطع مسافة شهرين ذاهبا وجائيا في ليلة واحدة، فأتاه أبو بكر رضوان الله عليه، وسأله عن ذلك، فقال عليه السلام: نعم، ولقد مررت بعير بني فلان، وهو بوادي كذا، وقد ندَّ لهم بعير، فدللتهم عليه، ومررت بعير بني فلان، وهم نيام، فشربت من إناء لهم، وأن عيرهم الآن ترد يقدمها جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء، والأخرى برقاء. فابتدر القوم الثنية، فإذا البعير قد أقبلت والجمل الأورق يقدمها. فلم يجدوا لآيته مدفعا، وهي لعمري آية صريحة كافية موجودة في القرآن تجمع عليها أهل الإسلام طرا"[9].
وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني (المتوفى عام: 415هـ) في كتابه: تثبيت دلائل النبوة للقاضي، قال رحمه الله تعالى: "وهو أنه صلّى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد من ليلته إلى مكة، ومدة السفر في ذلك مقدار شهرين أي: ذهابا وإيابا، وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء في زمن الأنبياء، ولما عاد رسول الله صلّى الله عليه وسلم تحدث بذلك في أهله، فقالت له أم هانئ بنت أبي طالب: لا تتحدث بهذا، فو الله لا صدّقك الناس، وليكفرنّ بك من آمن بك، وليكذبنّك من صدّقك. فقال صلّى الله عليه وسلم: إن ربي أمرني أن أخبر الناس بذلك، وأن أبا بكر يصدقني ويشهد لي. فخرج وأخبر قريشا بذلك فسرّهم هذا، وقالوا: الآن يظهر كذبه وينقطع الناس عنه، قوموا بنا إلى صاحبه ابن أبي قحافة لنخبره بما قال صاحبه، وكان أبو بكر ثقيل الوطأة على قريش وأعداء رسول الله، فانه كان يدعو إلى نبوته، ويخطب بآياته، وكان وجيها في الناس، عالما بقريش، باين الفضل فيهم، فكانوا يقصدونه بالمكاره لهذه الخصال التي كانت تضرهم، وقد استدعى خيارهم ووجوههم إلى الإسلام، وأنفق ماله في نوائب الإسلام ونصرته، وكانوا يطلبون شيئا يصدّه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ويمنعه من اتباعه. فأتوه وقالوا له: يا أبا بكر، ما زال صاحبك حتى أتى بكذبة خرج بها من أقطارها، قال أبو بكر: حاشاه، وما هو؟ قالوا: زعم انه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق.
قالوا: يا أبا بكر، أتصدقه في هذا، والعير تطرد في ذهابها شهرا وفي رجوعها شهرا، أيبلغه في ليلة واحدة؟ قال أبو بكر: إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة واحدة فأصدقه، وبعد السماء عن الأرض أكثر من بعد بيت المقدس من مكة؛ قوموا بنا إليه نسأله عن ذلك. فأتوه، فقال له أبو بكر: ما شيء بلغني عنك يا رسول الله أنك أتيت بيت المقدس في ليلتك؟ فقال: نعم يا أبا بكر، صلّيت بكم في هذا الوادي، فأتاني آت، فأيقظني وأخرجني وجاء بدابته فقال: اركب فأرفصت، فقال لها جبريل: اسكني، فما حملت خيرا منه. فسارت بي، وإذا حوافرها تقع مدى بصرها، وكنت إذا أتيت صعودا قصرت قوائمها، وإذا أتيت حدورا طالت قوائمها، فأتيت بيت المقدس؛ وذكر صلاته ودخوله إليه ورجوعه.
فقال له أبو بكر: يا رسول الله، هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ فقال: نعم. فوصف مدخله والمسجد وسقوفه وما فيه شيئا شيئا، وكان إذ ذاك في أيدي الروم، وكان ملك الشام لهم وبعضه في أيدي اليهود، فقال أبو بكر: أتسمعون؟ وكان فعل أبو بكر ذلك ليعرف الناس صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيما ادّعى. فقالت قريش: فان لنا عيرا بالشام عرفت خبرها؟ فقال: نعم، مررت بهم في ذهابي، وهم في موضع كذا، وقد ندّ لهم بعير من حسّ دابتي فدللتهم عليه، ورجعت عليهم وهم نيام وقدح فيه ماء وقد خمروه، فنزلت وكشفته وشربت وخمرته.
ثم قال: وآية أخرى أنهم يردون عليكم يوم كذا وقت طلوع الشمس، وتقدم عيرهم من ثنية كذا، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما برقاء والأخرى سوداء.
فأرصدت قريش لذلك اليوم، فقال قائلهم: هذه الشمس قد طلعت، وقال آخر: وهذه العير قد أقبلت وأمامها الجمل الأورق وعليه الغرارتان كما وصف، وسألوهم عن البعير الذي ندّ، وعن القدح الذي كان فيه الماء، فأخبروهم بذلك كما وصف، وأنهم وجدوا القدح فارغا بعد أن كان فيه ماء.
فتأمل ما في هذا من الآيات والمعجزات والعلامات الواضحات البينات التي لو لم تكن إلا هذه لكفت وأغنت في الدلالة على نبوته"[10].
وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (المتوفى عام: 430هـ) في كتابه: دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: "فإن قيل: فإن سليمان سخرت له الرياح فسارت به في بلاد الله، وكان غدوها شهرا ورواحها شهرا.
قلنا: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر منه؛ لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر، وعرج به إلى ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف سنة في أقل من ثلث ليلة، فدخل السماوات سماء سماء، ورأى عجائبها، ووقف على الجنة والنار، وعرضت عليه أعمال أمته، وصلى بالأنبياء وبملائكة السماء، وخرق الحجب ودلي له الرفرف الأخضر فتدلى، وأوحى إليه رب العالمين ما أوحى، وأعطاه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، وعهد إليه أن يظهر دينه على الأديان كلها حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها إلا دينه أو يؤدون إليه وإلى أهل دينه الجزية عن صغار، وفرض عليه الصلوات الخمس، ولقي موسى وسأله عن مراجعته ربه في تخفيفه عن أمته. هذا كله في ليلة واحدة"[11].
وعلي بن محمد الماوردي (المتوفى عام: 450هـ) في كتابه: أعلام النبوة، قال رحمه الله تعالى: "ومن أعلامه: قوله في ليلة الإسراء حين أصبح: مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما، وإذا إناء فيه ماء، وقد غطوا عليه، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ورددت الغطاء كما كان، وآية ذلك أن عيرهم الآن تقبل من موضع كذا، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحدهما: سوداء والأخرى ورقاء، فابتدر القوم الثنية، فوجدوا ما وصف، وسألهم عن الإناء، فوجدوا الأمر كما قال"[12].
وأحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى عام: 458هـ) في كتابه: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، الذي أسند رحمه الله تعالى في باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما ظهر في ذلك من الآيات، حديث الإسراء بطرق متعددة[13].
وإسماعيل بن محمد قوام السنة الأصبهاني (المتوفى عام: 535هـ) في كتابه: دلائل النبوة، الذي أسند رحمه الله تعالى حديث الإسراء[14].
وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (المتوفى عام: 728هـ) في كتابه: النبوات، قال رحمه الله تعالى: " نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إنما أسري به ليرى من آيات ربه الكبرى، وهذا هو الذي كان من خصائصه: أن مسراه كان هذا؛ كما قال تعالى: ﴿أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى﴾[15]، وقال تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾[16]؛ قال ابن عباس: (هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به)[17]. فهذا الذي كان من خصائصه، ومن أعلام نبوته.
وأما مجرد قطع تلك المسافة، فهذا يكون لمن يحمله الجن، وقد قال العفريت لسليمان: ﴿أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك﴾[18]، وحمل العرش من القصر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك، و﴿قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴾[19]؛ فهذا أبلغ من قطع المسافة التي بين المسجدين في ليلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي عنده علم من الكتاب، ومن سليمان؛ فكان الذي خصه الله به أفضل من ذلك؛ وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته؛ فالخاصة أن الإسراء كان ليريه من آياته الكبرى؛ كما ﴿رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى﴾[20]، فهذا ما حصل مثله؛ لا لسليمان، ولا لغيره، والجن وإن قدروا على حمل بعض الناس في الهواء، فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء، و إراءته آيات ربه الكبرى؛ فكان ما آتاه الله محمدا خارجا عن قدرة الجن والإنس، وإنما كان الذي صحبه في معراجه جبريل الذي اصطفاه الله لرسالته، و ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس﴾[21].
وكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى، ثم يخبر به الناس، فلما أخبر به كذب به من كذب من المشركين، وصدق به الصديق وأمثاله من المؤمنين، فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس؛ كما قال: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾[22]؛ أي محنة وابتلاء للناس؛ ليتميز المؤمن عن الكافر، وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار، وهذا مما يخوفهم به؛ قال تعالى: ﴿ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا﴾[23].
والرسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الإسراء، وأنكروا أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى، فلما سألوه عن صفته، فوصفه لهم، وقد علموا أنه لم يره قبل ذلك، وصدقه من رآه منهم، كان ذلك دليلا على صدقه في المسرى، فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه، وأخبر الله تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك، بما أخبرهم به من علاماته، فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك"[24].
ونختم هذا المقال بإيراد كلام بعض العلماء المعاصرين:
عبد الحليم محمود (المتوفى عام: 1397هـ) في كتابه: دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: "إن الناس –عادة- حينما يتحدثون عن معجزة الإسراء والمعراج، يتحدثون عن جانبها الذي يتصل بقطع المسافات، وطي المكان، والعروج من سماء إلى سماء، في لحظات لا تُعادل بالأيام والشهور، وإنما بالساعات والدقائق. وما من شك فيه أن الإسراء والمعراج معجزة من هذه الزاوية، ومعجزة كبرى، ولكنها أيضا آيات ودلالات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، من زاوية أخرى: تتجه نحو الجانب الأخلاقي في تزكية النفس، واستقامة الأسرة، وإصلاح المجتمع. وكما تعبر حياة الشخص عن صدقه أو زيفه، فإن تعاليمه كذلك تعبر عن صدقه أو زيفه، وإن أصحاب الآفاق المستنيرة –كما ينظرون إلى سلوك الشخص وحياته- فإنهم ينظرون أيضا إلى تعاليمه ورسالته، حتى يكونوا على بينة من الحكم عليه، ومن أجل ذلك تحدثنا عن الإسراء والمعراج من هذه الجوانب جميعا، واستفضنا في الزاوية التي تتصل بالجانب الأخلاقي، والجانب الروحي، لنزيل ما علق بالنفوس من قصر الحديث –في الإسراء والمعراج- على الجانب الذي يتصل بطي الأرض، والعروج إلى السموات. والحديث عن الإسراء والمعراج –من هذه الجوانب جميعا- إنما هو واجب من حيث إثبات الدلائل الحسية والمعنوية، فيما يتعلق بصدق النبوة"[25].
****************
هوامش المقال:
[1]) مقال: من مصادر السيرة النبوية: كتب دلائل النبوة، موقع الرابطة المحمدية للعلماء.
[2]) مصادر السيرة النبوية وتقويمها ص: 68-69.
[3]) مقال: من مصادر السيرة النبوية: كتب دلائل النبوة.
[4]) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 2 /389.
[5]) شرح العقيدة الطحاوية 1 /140.
[6]) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 6/ 424.
[7]) انظر: مصادر السيرة النبوية وتقويمها لفاروق حمادة ص: 68_77، ومقال: من مصادر السيرة النبوية: كتب دلائل النبوة لأحمد فكير.
[8]) سورة الإسراء، الآية: 1.
[9]) الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ص: 65-66.
[10]) تثبيت دلائل النبوة 1/ 46_48.
[11]) دلائل النبوة 1 /596.
[12]) أعلام النبوة ص: 187.
[13]) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 2/ 354 فما بعدها.
[14]) دلائل النبوة 2 /723_726.
[15]) سورة النجم، الآيات: من الآية: 11 إلى الآية: 15.
[16]) سورة الإسراء، الآية 60.
[17]) رواه البخاري في صحيحه 5 /54، 6 /86، 8/ 125-126، كتاب: مناقب الأنصار، باب: المعراج، رقم الحديث: 3888، وكتاب: تفسير القرآن الكريم، باب: قوله تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾، رقم الحديث: 4716، كتاب: القدر، باب: قوله تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾، رقم الحديث: 6613.
[18]) سورة: النمل، الآية: 39.
[19]) سورة: النمل، الآية: 40.
[20]) سورة: النجم، من الآية: 13 إلى الآية: 17.
[21]) سورة: الحج، الآية: 75.
[22]) سورة: الإسراء، الآية: 60.
[23]) سورة: الإسراء، الآية: 60.
[24]) النبوات 1 /530_534 .
[25]) دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ص: 269-270.
***************
جريدة المراجع
أعلام النبوة لعلي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، اعتناء: خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 1414 /1994.
تثبيت دلائل النبوة لعبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، تحقيق: عبد الكريم عثمان، دار المصطفى، شبرا- القاهرة (د-ت).
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت-لبنان، دار المنهاج، جدة-السعودية، الطبعة: الأولى: 1422، طبعة مصورة عن الطبعة الكبرى الأميرية، بولاق- مصر، 1311.
دلائل النبوة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، تحقيق: محمد رواس قلعه جي، وعبد البر عباس، دار النفائس، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية: 1406 /1986.
دلائل النبوة لإسماعيل بن محمد بن الفضل قوام السنة الأصبهاني، مساعد بن سليمان الراشد الحميد، دار العاصمة، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى: 1412.
دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الحليم محمود، دار الكتاب المصري، القاهرة- مصر، دار الكتاب اللبناني، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 1411/ 1991.
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، دار الريان للتراث، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى: 1408 /1988.
الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن ربن الطبري، تحقيق: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: 1393 /1973.
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، مكتبة العلم بجدة، دار النصر للطباعة، دار الكتب الحديثة، دار الكتب الإسلامية، 1410-1387 /1967-1990.
شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي ابن أبي العز الدمشقي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية: 1413 /1993.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق- مصر، الطبعة الأولى: 1300-1301.
مصادر السيرة النبوية وتقويمها لفاروق حمادة، دار القلم، دمشق- سوريا، الطبعة الأولى: 1425 /2004.
مقال: من مصادر السيرة النبوية: كتب دلائل النبوة لأحمد فكير، موقع الرابطة المحمدية للعلماء.
النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، منشورات الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، أضواء السلف، الرياض- السعودية، الطبعة الثانية: 1427، مصورة عن الطبعة الأولى: 1420 /2000.
*راجع المقال الباحث: محمد إليولو، والباحثة: خديجة ابوري