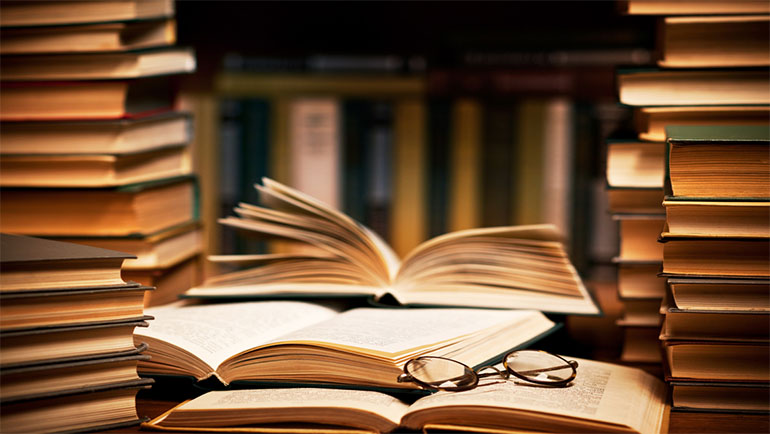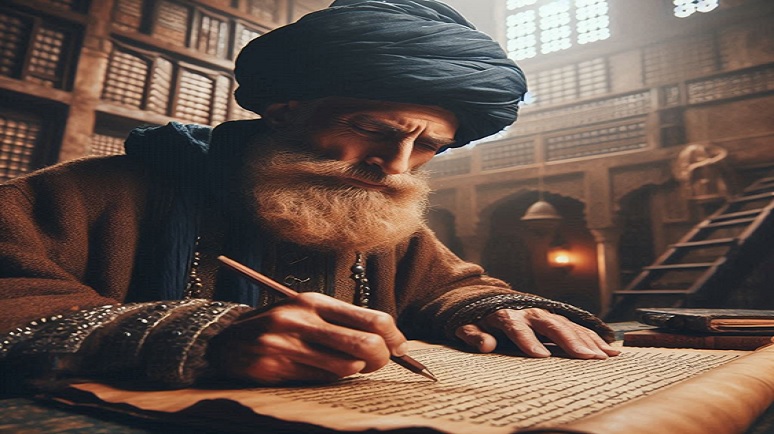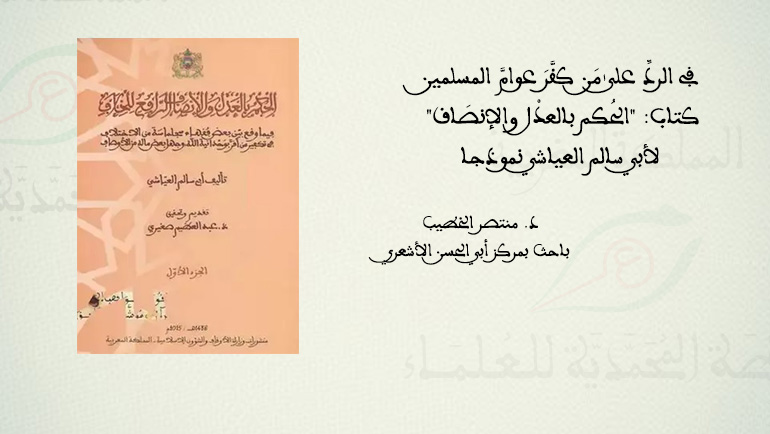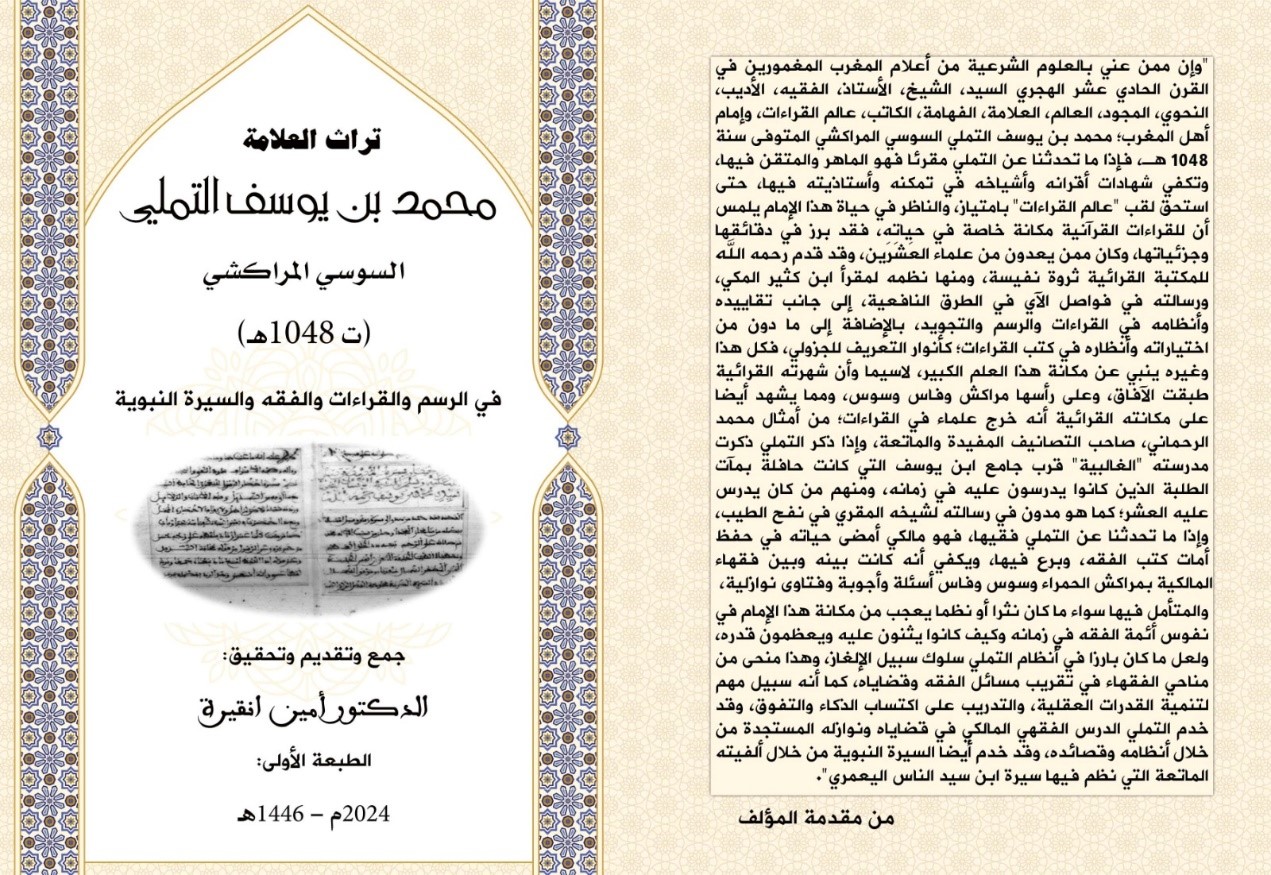أسْرارُ البَيَانِ في القُرْآن(31) البَيَانُ في تَكرَارِ(يُسْراً) نَكرَةً، وتَكرَار(العُسْر) مَعْرفةً في قولهِ تعَالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً﴾

و ذلكَ قولهُ تعَالى في سُورَة ( الشَّرْح ) ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ . فَقد تكَرَّر ( العُسْر) فيهَا مَرّتين وكذلكَ (اليُسْر). فأوَّل ما يَسبقُ إلَى الذِّهْن أنَّ هذَا منْ تَكرَار الجُمَل والعِبَارَات، وهوَ كَثيرٌ في القُرآن؛ لَعلّ أجْلَى مَظهرٍ لهُ يكونُ في تَكرَار ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ في سُورَة(الرَّحمَن)،حيثُ تَكرَّرتْ إحدَى وثَلاثينَ مرّةً. وكذلكَ تَكرارُ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ﴾ في سُورَة(المرسَلات). وإنْ كانَ في ذَلك بُعدٌ يَفصلُ بَينَ المكَرّراتِ، فقدْ وردَ ما هُوَ أقرَبُ منْ ذلكَ، كما هُو في سُورَة (الوَاقعَة) في قولهِ تعَالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْـمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْـمَيْمَنَةِ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ الْـمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْـمَشْأَمَةِ ﴾، أو قَولهِ تعَالى في سُورَة(الْـمُدّثّر): ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾.
فيَدخلُ ذلكَ في باب(التَّكْريرِ) منْ عِلمِ المعَاني. وقدْ أشارَ إلى ذلكَ بعضُ المفَسّرينَ، منهُم (الزَّمخشَريّ) في (الكَشَّاف)، إذْ قالَ عنِ الآيَة: « أنَّهُ يَحتَملُ أنْ تكونَ الجُملةُ الثَّانيةُ تَكريراً للأُولَى، كمَا كُرّر قولُه ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾، لِتَقريرِ مَعناهَا في النُّفُوس، وتَمْكينِـها في القُلُوب». وجَعلَ التَّنكيرَ في (يُسْراً)، دالّاً علَى التَّفخيمِ والتَّعظيمِ. فقالَ: «فَإنْ قلتَ: فمَا مَعنَى التَّنكِير؟ قلتُ: التَّفْخيمُ، كأنّهُ قِيلَ: إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً عَظيماً ، وأَيَّ يُسْرٍ».
لكنكَ، بشَيءٍ منَ التَّدبُّر، تجدُ أنّ في هذهِ الآيَة لَطيفةً بَيانيّةً، قدْ وقفَ عندَها كَثيرٌ منْ عُلماءِ اللّغةِ والتَفْسير ،وحتَّى الأُصُوليّونَ في دَلالاتِ الأَلفاظِ؛ ذلكَ أن ( العُسر ) تكرّرَ بالمعرفَةِ، وأنَّ (اليُسرَ) تَكرَّر بالنَّكرَة؛ والمقرّرُ منْ غالبِ ما سَارَ عليهِ العَربُ في كلَامِهم، واستَنبَطهُ منِ اسْتقرَاءِ كلامِهِم عُلماءُ البَيانِ والنَّحوِ والأُصُوليّون، منْ قوَاعِد، قاعِدةٌ تُفيدُ أنَّ النَّكرَةَ إذَا تَكرّرَتْ كانَتِ الثّانيَةُ غَيرَ الأُولى، فالاسْم الثَّاني ليسَ هُوَ الأوّلَ، بَلْ هُوَ غَيرُهُ ،فاقْتضَتِ المغايَرَة. وأنَّ المعرفَةَ إذَا تَكرّرتْ أَفادَت الثَّانيَة نفسَ المعْنَى. فالاسْمُ الثّاني هوَ الأولُ نفسُهُ، فالتّكرَار بالمعرفَة لا يَقتَضي المغَايَرَة؛ فهُوَ نفسُ الاسْمِ بنَفْس المعْنَى.
فأنتَ إذَا قُلتَ مَثلاً ( اشْتَرَيتُ الكِتَابَ، ثمَّ أَهدَيتُ الكتَابَ)، وكذَلك إذا قُلتَ: (اشْتَريْتُ كِتاباً ثُمَّ أهْدَيتُ الكِتَابَ)، فالكتَابُ هُوَ هُوَ، وَاحِدٌ ، الثَّاني هُوَ الأوّل نفسُهُ. فإذَا كَرَّرتَه بالنَّكرَة، وقُلتَ ( اشْتَريتُ كِتاباً ثمَّ أَهدَيتُ كِتاباً)، كانَا كِتابَينِ مُختَلفَينِ، فالثَّاني غيْرُ الأوّلِ. قالَ(البَغْويّ) في (تَفسِيرهِ): « قَالَ الْـمُفَسِّرُونَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ)، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرَّرَ الْعُسْرَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيُسْرَ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ، وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِذَا ذَكَرَتِ اسْمًا مُعَرَّفًا، ثُمَّ أَعَادَتْهُ كَانَ الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلَ، وَإِذَا ذَكَرَتْه نَكِرَةً ثُمَّ أَعَادَتْهُ مِثْلَهُ صَارَ اثْنَيْنِ، وَإِذَا أَعَادَتْهُ مَعْرِفَةً فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ، كَقَوْلِكَ: إِذَا كَسَبْتُ دِرْهَمًا، أَنْفَقْتُ دِرْهَمًا. فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَإِذَا قُلْتَ: إِذَا كَسَبْتُ دِرْهَمًا فَأُنْفِقُ الدِّرْهَمَ، فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ. فَالْعُسْرُ فِي الْآيَةِ مُكَرَّرٌ بِلَفْظِ التَّعْرِيفِ، فَكَانَ عُسْرًا وَاحِدًا، وَالْيُسْرُ مُكَرَّرٌ بِلَفْظ التَّنْكِيرِ، فَكَانَا يُسْرَيْنِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ».
ومنْ بَعدهِ قالَ (ابْنُ الجَوزيّ) في (زَاد الْـمَسير): « وَ (العُسْر ) مَذكورٌ في الآيَتينِ بلَفظِ التَّعريفِ . و(اليُسرُ ) مَذكورٌ بلَفظِ التَّنكِيرِ ، فدلَّ علَى أنَّ العُسرَ واحِدٌ ، واليُسرَ ٱثنَانِ». ومنْ باكرٍ قالَ(ابنُ خَالَويهِ - تــ:370هـ) في(الطَّارقِيَّة): « قالَ ابنُ عبَّاسٍ: (لا يَغلبُ عسْرٌ يُسرَيْنِ)، تَفسيرُ ذلكَ أنَّ في (أَلَمْ نَشْرَحْ)، عُسراً واحِداً، ويُسرَيْنِ، وإنْ كانَ مُكرّراً في اللَّفظِ، لأنَّ العسْرَ الثَّاني هوَ العُسرُ الأوَّل، واليُسرُ الثَّاني غَيرُ الأوَل، لأنهُ نَكرَةٌ، والنَّكرَةُ إذَا أُعيدَتْ أُعيدَتْ بأَلفٍ ولَامٍ، كقَولكَ: جَاءَني رَجُلٌ فَأكرَمْتُ الرَّجُلَ. فلمَّا ذَكرَ اليُسرَ مَرّتَينِ ولَمْ يُدخِلْ في الثَّاني أَلِفاً وَلاماً، عُلمَ أنّ الثَّانِي غَيرُ الأَوّل».
فالآيَة الكريمَة تَكرَّرتْ في السُّورَة عَلى هَذِهِ الصُّورَة، لتَحقِيقِ هَذا المعنَى : عُسْرٌ وَاحِدٌ وَمَعَهُ يُسرَانِ. ولذَلكَ فرحَ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلّمَ بهذهِ الآيَة. فقدْ ذكَر (الطبريّ) في (تَفسيرهِ)، عَن (الحَسَن) قالَ : « خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً مَسْروراً فَرحاً وهُوَ يَضحَكُ، وهوَ يَقولُ: « لَنْ يَغْلِبَ عُسرٌ يُسرَيْن، لَنْ يَغْلِبَ عُسرٌ يُسرَيْنِ؛﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾». وفي ذلكَ بُشرَى لِكلِّ مُؤْمِنٍ، فلَا يَضيقُ صَدرُهُ بالشِّدّة تُصيبُه والضَّرّاء، فَتُخبِتَ نَفسهُ، و يَظَلّ علَى رَجاءٍ منَ الفَرَج، يَحمِلُهُ إِلَيْهِ يُسرَان يدْخُلانِ مَعَ العُسْرِ حَتَّى يُخرجَاهُ.
ومنَ الآياتِ الّتي استدَلّوا بهَا علَى أنَّ النّكرَة إذَا تكَرّرَت، دلَّتْ علَى المغَايَرَة، قولهُ تعَالَى في سُورَة(سَبَأ): ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾. فبَيّنٌ أنّ مَعناهُمَا ليسَ وَاحداً. وكذلكَ تَكرَارُ كَلمَة(سَبَباً) في قولهِ تعالَى في سُورَة (الكَهفِ): ﴿فَاتَّبَعَ سَبَباً﴾ ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَباً﴾. فالثَّاني هُوَ غيرُ الأوّل. وعلَى عكْسِ ذلكَ فإذَا تَكرَّرتِ النَّكرةُ بتَعريفٍ، كانتْ هيَ نَفسُهَا، ولمْ يَختَلفِ المعْنَى، ومنْ ذلكَ ما جاءَ واضحاً جَليّاً في قَولهِ تعَالى في سُورَة(النُّور): ﴿كَمِشْكاةٍ فيهَا مِصْبَاحٌ الْـمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرّيٌّ﴾. فبَيّنٌ أنّ المصبَاحَ هُوَ هُوَ، وأنَّ الزُّجاجَةَ هيَ هيَ. وممّا اجتَمعَ فيهِ الحَالانِ جَميعاً:( نَكرَة+نَكرَة) و(نَكرَة+مَعرفَة)، قولهُ تعَالى في سُورَة(المزّمّل): ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾.
لكنْ يَبدُو أنَّ الأمرَ ليْسَ علَى إطلاقهِ، فقَدْ ذَهبَ بَعضُهُم إلَى أنّ القاعدَةَ تَحكُمُها اعْتِباراتٌ سِياقيّة، وقَرَائنُ تُقيّدُها، وتُوجِّه الدّلالَةَ فيهَا علَى غيْـر الوَجْهِ. فقدْ وردَت آياتٌ تَستلْزمُ وَقفَةً غيرَ الوَقفَةِ، ونَظراً يَختَلفُ عنِ النَّظَر. ومنهَا قَولُهُ تعَالى في سُورَة(الزُّخرُف): ﴿وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾. فقَد تَكرَّرت كَلمةُ(إِلَهٌ) مُنَكَّرَةً ، فإذَا اعتَبرنَا قاعدَةَ المغايَرةِ، كانتِ الثَّانيَة غيرَ الأولَى ،وكانَ المعنَى علَى غَير ما هوَ قائِمٌ في العَقيدَةِ، في قولهِ تعالَى: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾. فَيظهرُ منْ هذَا، أنّ هذهِ الآيَة، قدْ نَقضَت القاعدَةَ، بكوْنِ النَّكرَة فيها تَكرّرَت، لكِنْ بنَفسِ المعْنَى. وذلكَ لأنّ السّيَاق المقامِيّ يَستلزمُ ذلكَ، بمَا يُهيِّئُه منْ مُقتَضَى الحَال.
ومعَ ذلكَ يبقَى في الأمْرِ شيْءٌ منْ بَيَانٍ، وأنهُ بفَضلِ تَدبُّرٍ وَ وُسْعِ نَظَرٍ، يجُوزُ أَنْ يَحتملَ التَّكرارُ هُنا المغَايَرَةَ، وأنْ تَجري القَاعدةُ كمَا أَصّلُوا لَهَا. ذلكَ أنَّ الاسمَ (إِلَهٌ) علَى تَأويلِ الصِّفَة، بمَعنَى (مَعبُودٌ)، فهوَ تعَالى مَعبودٌ علَى وجهٍ منْ أَهْلِ السَّماءِ ومَعبودٌ علَى وَجهٍ منْ أهْلِ الأَرضِ. فالمغَايرَة وقعَتْ في الصِّفَة لا في الذَّاتِ. وذلكَ كمَا تقُولُ: (المؤْمِنُ عَدْلٌ في بَيتِهِ، عَدْلٌ معَ النَّاسِ).فالمؤمنُ ذَاتٌ وَاحدَةٌ، وإنّمَا وَقعَت المغَايرَةُ في الصِّفَة،(عَدلٌ بمَعنَى عَادلٌ). قالَ(الأَلوسيّ) في تَفسيرهِ (رُوح المعَاني): «وقالَ بعضُ الأفاضِلِ : يَجوزُ إجْرَاءُ القَاعدَةِ فيهِ، والمغَايَرَةُ بينَ الشَّيئَين أَعَمُّ منْ أنْ تَكونَ بالذَّاتِ أوْ بالوَصْفِ والاعْتِبَار، والمرَادُ هُنا الثَّاني. ولا شكّ أنَّ طريقَ عبادَة أهْلِ السَّمَاء لهُ تعَالى، غَيرُ طَريقِ عبادَة أَهل الأَرضِ، علَى ما يَشهَدُ بهِ تَتبُّعُ الآثارِ. فإذَا كانَ (إلَهٌ) بمَعنَى (مَعبُودٌ)، كانَ معنَى الآيَة، أنهُ تَعَالى مَعبودٌ في السَّمَاء علَى وجْهٍ، ومَعبودٌ في الأرضِ علَى وجْهٍ آخَرَ ». وهوَ مَا عبّر عنهُ(زَكريّا الأنصَاريّ) في تفسيرهِ(فَتْح الرَّحمَن)بقولهِ: «إنْ قلتَ : هَذا يَقتَضي تَعدُّدَ الآلهَة ، لأنَّ النَّكرَةَ إذَا أُعيدَتْ نَكرَةً تَعدَّدَتْ، كقَولكَ: أنْتِ طَالقٌ وطَالقٌ، قلتُ : الإلهُ هنَا بمَعنَى المعبُود، وهوَ تعَالى مَعبودٌ فيهمَا ، والمغايرَةُ إنّمَا هيَ بينَ مَعبُوديَّتهِ في السَّمَاء ، ومَعبوديّتهِ في الأَرضِ ، لأنّ المعبُوديّةَ منَ الأمُور الإضَافيّةِ ، فيَكفي التغَايُرُ فيهَا من أحَدِ الطَّرفَينِ ، فإذَا كانَ العابدُ في السَّمَاء غيرَ العَابدِ في الأرْضِ ، صَدقَ أنَّ مَعبُوديَّتَه في السَّماءِ غيرُ معبُوديّتهِ في الأَرضِ ، معَ أنَّ المعبُودَ واحدٌ».
وقالَ(بهاءُ الدّينِ السُّبْكي) في(عَرُوس الأفرَاح في شَرحِ تَلخيصِ المفتَاح):« إنَّ (إلَهٌ) بِمَعْنَى (مَعْبُود)، وَالِاسْمُ الْـمُشْتَقُّ إِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الصِّفَةِ؛ فَأَنْتَ إِذَا قُلْتَ: (زَيْدٌ ضَارِبُ عَمْرٍو ضَارِبُ بَكْرٍ )،لَا يُتَخَيَّلُ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوَّلُ، وَإِنْ أَخْبَرَ بِهِمَا عَنْ ذَاتٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّ الْـمَذْكُورَ حَقِيقَةً إِنَّمَا هُوَ الضَّرْبَانِ، لَا الضَّارِبَانِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الضَّرْبَــيْـــنِ مُخْتَلِفَانِ». قالَ (مُحيي الدِّين دَرويش) في(إعرَاب القُرآنِ وبَيَانه) ، وقدْ نَقلَ كَلامَ (السُّبكيّ)هَذَا، ثمَّ علَّقَ عليهِ بقولهِ: « ونَستَنتِجُ من هُنَا أنَّ النَّكرَتَينِ في الآيَةِ، لمْ يُقصَد منهُمَا سوَى الصِّفَة، وهيَ العِبادَةُ. ولا شكَّ في أنَّ العبادَتَينِ مُتغَايرَتَان؛ فالنَّكرَةُ الثَّانيَة غيرُ الأُولَى، باعْتِبار المقْصُود، وإنْ وَقعَتَا علَى ذاتٍ واحدَةٍ، فلَمْ تَخرُجِ الآيَةُ أَيضاً عنِ القَاعدَةِ».
هذَا غيضٌ منْ فَيضِ البَركاتِ النَّديّاتِ في القُرآنِ الكَريمِ، و نَفحةٌ منْ نَفحَاتِ الكَمالَات النُّورَانيّة، الّتي تَشعُّ إشرَاقاتٍ وتَتدلَّى قُطوفاً دَانيَاتِ الجَنَى طيّبَاتِ الْـمُجْتَــنَــى. وهكذَا هو الشأنُ، فَلا تَنقَضي عَجائبُ هذَا الكِتاب الحَكيمِ، ولا يَبلَى علَى كَثرَة الرَدِّ. و تَتوالَدُ فيهِ المعَاني، وتَنفَسحُ الدَّلالاتُ تَتْــرَى في مَراتع النَّظَر، ورَوضَاتِ التَّدبُّر.