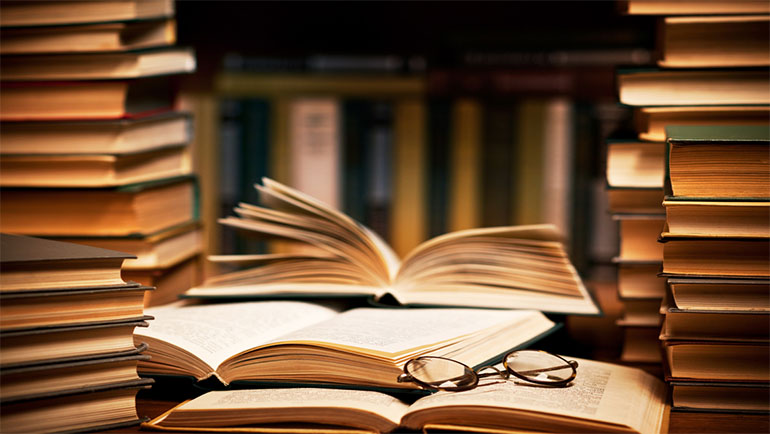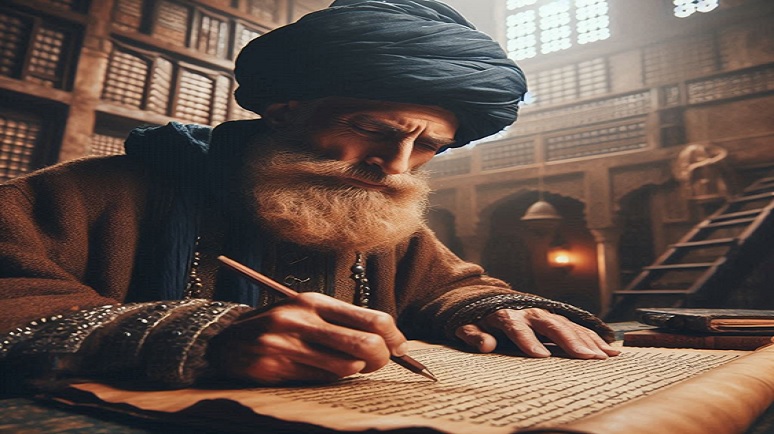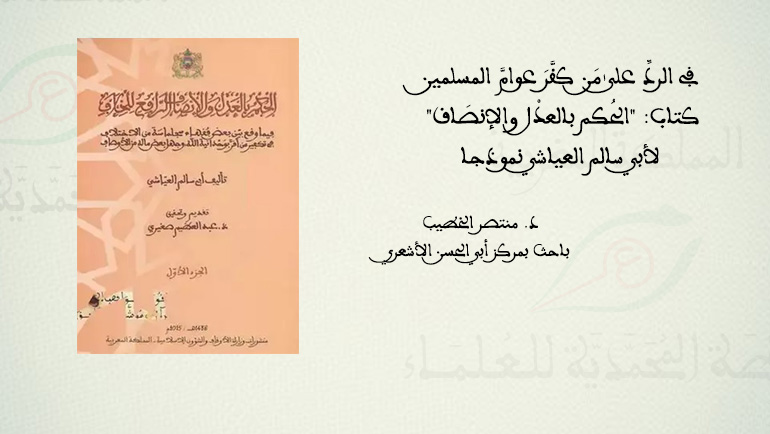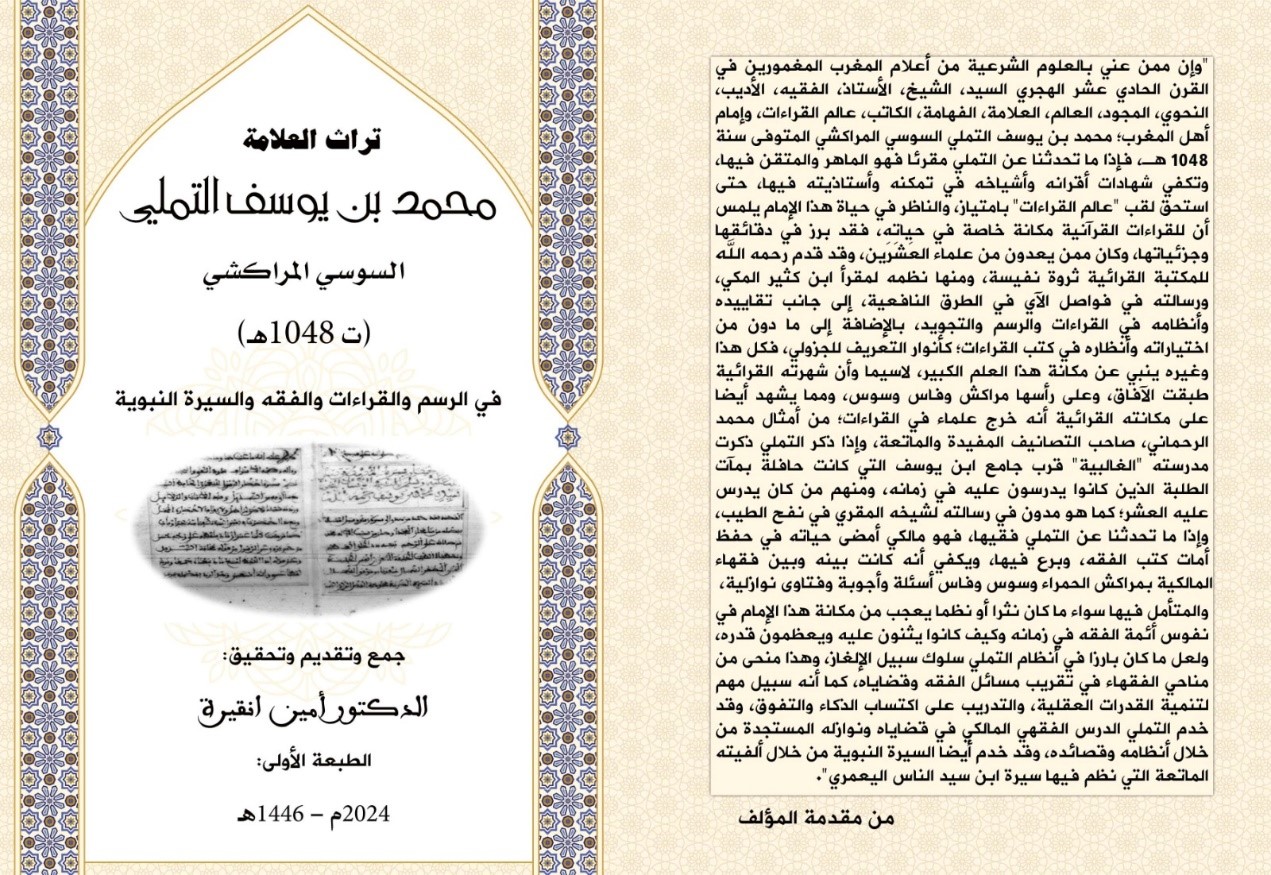الشاهد اللغوي عمدة الأديب المفسر وحجة المقرئ الموجّه
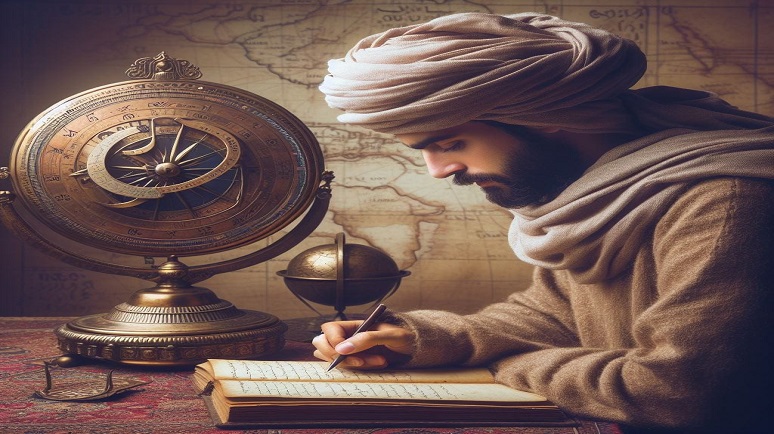
لا يخفى على الناظر المتتبع والدارس المختبر تبيُّنُ فواضل الشاهد اللغوي (شعرا ونثرا) ومزاياه بنصوصه ومثالاته في ضبط علوم الكتاب العزيز وفنونه (رسما وضبطا وأوجه أداء ... وعلم اللغة من حيث تصريفها وتركيبها وإعرابها وفقهها ودلالتها ...) بشـرائطه، وذلك لما كان الشاهد هو المعنى المفهوم الذي يساق ويذكر لإثبات القاعدة وإيصالها إلى الذهن كالآية من التنزيل أو القول المنقول عن العرب الموثوق بعربيتهم؛ مع الإسهاب في الكشف عن طبيعة المقارئ المشتهرة واكتناه مكنونات أوجه أداءاتها، وما يعتري ذلك من الاختلاف والتنوع في أوجه النص المنزل المتلو، وهو الحالُ الذي يضطرُّ مكتمل الأهلية والمدارك للنظر في ترجيح أحد المختلفات خاصة والسعي لذلك بشرطه، وأن لها اتصالا وثيقا بالعدد السبعة الذي يُضيّق من دائرة الخلف ويحصره في هذا النطاق خلافا لسائر المعارف حملا على ما قيل في تبيين المراد بالعدد السبعة وتأويل نزوله باستفراغ الوسع وبذل آخر اللبوس في اكتناه مراد الله تعالى من تحصيلات ألفاظ القرآن ودلائل أوعية وحيه وتنزيله، وذلك لأن الاختلاف في القراءات وتعيينها يبقى منضبطا بمعايير قد تطّرد ويسهل بها حصر أوجه القراءة المقبولة (صحة السند، موافقة الرسم، موافقة العربية ولو بوجه)، إلا أن أكثر هذه المعايير تشعبا وأوسعها تفرعا هو الضابط اللغوي، ولأجله أتى الشاهد الشعري لضبط منازع العربية فيه والتوجيه لأضرب الخلاف القرائي والاحتجاج لها طلبا لترجيح الأقوى معنى والأصح وجها ثم دفع الشبهة عن جانب ظواهر رسم الكتاب العزيز ونقطه وضبطه وما إليه، وذلك لمّا نبغ في الأعصر المتأخرة من يدعو إلى التحرُّر من قيود الرسم القرآني وقواعد ضبطه وزعْمه تدميث الطريق على المتعلم بكتب نص القرآن الكريم على غير صورته الأولى ووضعه القديم وما يتصل بذلك، ونسي أن الإعجاز في الكتاب العزيز إنما كان في المنطوق والمكتوب ووسائلهما جميعا.
وعليه؛ فالشاهد عموما يصطبغ بمعاني الهيمنة والشهود والاستيلاء ... فهو لذلك وغيره ذو مزية واعتبار في تبيّن القصد من طرائق اللفظ المقروء أو المتلو للدلالة على الكلام الذي أنزل الله عز وجل للإعجاز بسورة منه، وخيّر الله الأمة أن يقرؤوا بما شاءوا من تلك الطرق، إذ كلها متساو في الدلالة على الكلام المعجز على جهة التظاهر، فنقلها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة ومعارضة، كل واحد منهم نقل عنه ما لقِنه منها، ولم يلقّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بجملتها لكل واحد من الصحابة، والواقع المعلوم يدل على صحة ما ذكر، لأن الله تعالى جعلها طرائق متعددة ولحونا مُستمرَّة متوفّرة، توسعة على الأمة ورحمة منه سبحانه لهم، فحفظ كل واحد من الصحابة الوجه الذي لقنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار ينسب إليه بلفظ الحرف، فيقال حرف ابنِ مسعود وحرف أبيّ وحرف زيدِ بن ثابت ...... ، فلا يُطلب أو يلجأ إلى بابه إلا حاجةً في نفس البيان والإثبات والحجة وما شابه، ثم حاجة التوجيه أو الموجّه لأوجه القراءة وثيقة بصنعة الشعر النثر وفنونهما، إذ إنّ اعتبار نمط القراءة لأحرف التلاوة ورعْي أسلوب الأداء لأوضاع المتلو بعديد أوجهه ومتفيَّإ ظلاله وشتّى لحونه وظواهره وما إليه؛ كلها وأَشكالها ذرائع لهجية هادية وأنحاءُ صوتية مُعْرِبة متعلقة باللفظ (أصلا ووصفا) ضامنة لحقيقته وكافلة بتحقيقه وتمثيله لأنها مبنيَّة على غراس اللغة التي بها تنزَّل النص القرآني وأُوحي وراعية لجوانبه ... فهو لذلك (أي الشاهد الشعري أو النثري) أصح متن يعتمد عليه في معرفة عربي اللغة من معرّبه أودخيله من أصيله وقويّه من ضعيفه فهو ديوان أحوال العرب وترجمان أسلوبهم واستعمالهم ...، ثم الشاهد طبقات في الاحتجاج به والاعتماد عليه، ولأن التوجيه نوع تفسير وبحث عن تفهم القصد وتقريب الجهة المرادة في المقروء كثر الاهتمام به في كتب الاحتجاج والمعاني كما الشأن بالنسبة لابن خالوية وأبي علي الفارسي في حجتيهما ... وكذلك المحتسب لابن جني وصنعه في الاحتجاج للشاذ وما شاكل، ولذلك كثر الانتصار لبعض الأوجه في المقروء على مقابلها المتروك حتى اشتهرت الأولى وخملت الأخرى، ثم الموجهون منازل وطبقات رتّبها ابن مجاهد في مقدمة كتاب السبعة، ولقد أورد البغدادي في خزانة الأدب أحوال الشاهد الذي يصح اعتماده في التوجيه فجعل مراتب الشعراء على أربع طبقات (الجاهليين، المخضـرمين، الإسلاميين، المولّدين)، فالأوليان يستشهد بكلامهما إجماعا، والأخريان يستشهد بشعرهما على تفصيل، ... ولأجل ذلك نجد عند من ذُكر بعض الأمثلة من الأوجه التي ردّت القراءة بها لعدم قوة وجهها في العربية وتأخّر فصاحتها أو رَكَّتْ في معناها أو ما شابه، كما ذُكر وأن نشأة الشاهد وطريانه ارتبطت ببروز ظاهرة الاختيار والانفرادات في المقروء المنبنية على أساس من الصحة في السند أو القوة في الوجه، ولعل أبرز من جَلَّى هذا المنحى في التوجيه والحجة أبو جعفر الطبري في تفسيره، فجاء لذلك كتابا ثرّاً جامعا للأوجه ومنازلها واختيار العالي منها المستجمع لشـرائط الاحتجاج به والإشارة إلى المتروك النازل من الأوجه وما إليه.
على أن نمط القراءة والأداء بأوجهه وعديد ألوانه؛ أنحاءُ متعلقة باللفظ (أصلا ووصفا)، ثم هي – في جوهرها – مبنية على أوجه اللغة التي بها تنزَّل النص القرآني وأُوحي، ثم إن هذا التعدد في اللفظ والتنوع في التأدية والنطق إنما يستساغ فيستمرأ اعتبارا به مُلتحَداً نابضا بدواعي الإطاقة وتذييع موجبات اليسر والرحمة واتخاذه موئل قوم أميين لم يكن لهم باستظهار الشرائع وترجيع تفصيلاتها سابقةُ أنس أو بادئةُ عناية أو ما أشبه، مكافئا لسائر الفروع اللسانية وشُعب النطق ومهيمنا على ما جرت به فطرة اللغة عند العرب من الأوضاع المتصلة بالنظم والتأليف (جرْسا ومعنى ...)، فبتلك الرعاية الربانية في الوحي والتنزُّل ... وباستصفاء ما ثبت صحيحا من بعض ألفاظ القرآن عن النبي الأرأف في قراءاته وأدائه وهو الأكفل الأقعد بوجوه لغة العرب وسَنَنها في التخاطب؛ ملَك كل عربي (شيخ فانٍ، عجوز كبيرة، غلام، جارية ...) أمر حاله في تنزيل أحرف القرآن وكلمه وَفْق لحنه الجبلّي وعلى نهج ما استُرضع من لبان قومه وعشيرته، تنزيلا يتخذ من الملاءمة بين جرْس الحرف وبين طبيعة المعنى والصوت الذي يتأدّى به؛ مطيّة نظمية بيانية تنهض على اعتلاء تصاريف الأبنية اللفظية واحتمال تقلبات الهيآت اللغوية الأفصحية، بالقدر الذي يشبع الحاجة الفطرية الأدائية فيستوي سِدادا أجْدى وأنفع لكل ثغر أو صقع ... ثم يلائم خصائصه الصوتية وموسيقاه اللغوية بالذي يُضـرَبُ مثلاً في لغة العرب ومعهودهم بيانا وفصاحة، فليتأمل، ثم هذا التعدد في التأدية والتنوع في البلاغ ليس بضارّ القرآن شيئا لو نزل على لفظ واحد وهو ما هو دقة وجزالة وإحكاما وإبداعا ...، بل كل ذلك وغيره مما يَشـي بتمام معاني الإعجاز وتفيُّئ معالم الإبانة واستيلائه على جوانب الفطرة اللغوية في نفسها، فلا وربِّك لن يهدأ رُوعُك أويُفَرَّغ عن قلبك حتى تنقاد فتردّ أمر إعجاز القرآن وبراعة نظمه إلى مُولي البِرِّ العليّ الذي ركز في العرب فطرة اللغة ثم مَنَّ ففتَّق من كُنه هذه اللغة ما رجع على تلك الفطرة بالعجز والهدنة وتَصَـرُّم دواعي المعارضة أو ما أشبه، فنعْت البيان متصل أبداً بعربية القرآن مُحتبٍ بحيّزها لنْ يُزيَّل بينهما بحال وذلك في مثل قوله تعالى: (وَهَذا كِتاب مصدِّق لساناً عربيّاً) [الأحقاف/12] وقوله تعالى: (وَهَذا لِسانٌ عَربيّ مبين) [النحل/103] وما أشبه ذلك، ثم إن التعدد في الأوجه والتنوع في الأداء سمات خاصة تشكل غراس أساس البيان العربي في أدبيته التامة، فلأجله استوى القرآن مبينا معجزا، فكانت وجوه قراءاته من محاسن خِلال البيان المعجز ونازلةً على وَفق مألوف العرب وطِبْق ما كانوا يستحسنون، فهذا نبذٌ طريف مجلٍّ لميسم البيان والإعجاز الجاريين في الحد الآنف.
وعليه؛ فالأداء القرآني لا يتحقق إلا في رواياته المشهورة التي نزل عليها في أحرفه السبعة، قال العلامة مكي (ت 437 ه) في الإبانة: [إن هذه القراءات كلها التي يقرأ الناس بها اليوم وصحت روايتها عن الأئمة؛ إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووافق اللفظ بها خط المصحف، مصحف عثمان رضي الله، الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه واطّرح ما سواه مما يخالف خطه] [ص 32، تح عبد الفتاح شلبي]، فيبقى النص القرآني وحيا منزلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا على وجه التواتر ثبوتا باتا قاطعا من تطرق الريبة أو الشك أو ما شابه، خلافا للقراءات التي هي طرائق في التأدية وأوجه في التبيلغ يعتريها المتواتر والمشهور والصحيح والشاذ وما إليه، لتعلقها باللفظ والنطق لا بالتركيب والنظم، فكل من يقرأ بقراءة معتبرة فإنه يجري عليه أنه يتلو القرآن وَفق مذهب إمام معين في نظام الأداء ذي ملامح لهجية مستوفاة لسمت القرشية التي يستحسنها كل قبيل عربي من إمالة أو إدغام أو تخفيف همز أو ما شابه، فهو كلام الله ووحيه تأدّى إلينا وتُلقي بأداء نبوي أمين مصفّى صلوت ربنا وسلامه عليه وعلى آله، قال أبو شامة (ت 665 ه): [واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها؛ قد انتهت إلى السبعة القراء ...، واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لذلك وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدي بهم وعُوّل فيه عليهم، ونحن فإن قلنا: إن القراءات إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلسنا ممن يقول: إن جميع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة، بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ ... فلهذا ترى كتب المصنفين في القراءات السبع مختلفة في ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرها، والصحيح بالاعتبار الذي ذكرناه موجود في جميعها إن شاء الله تعالى، فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأنها هكذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء؛ فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه]. [المحرر الوجيز 90 - 91].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم