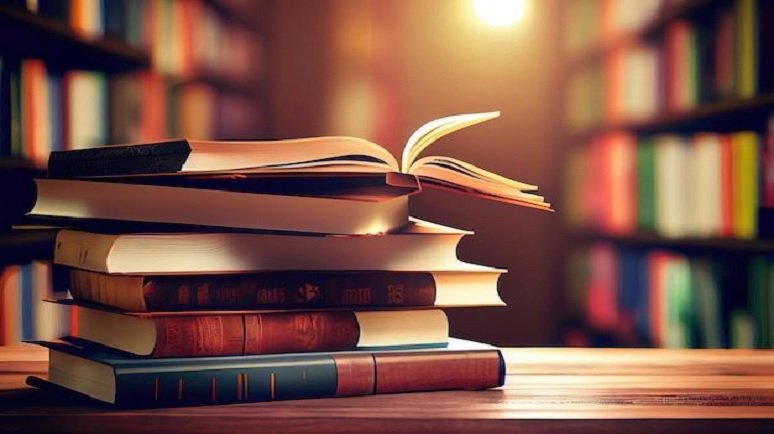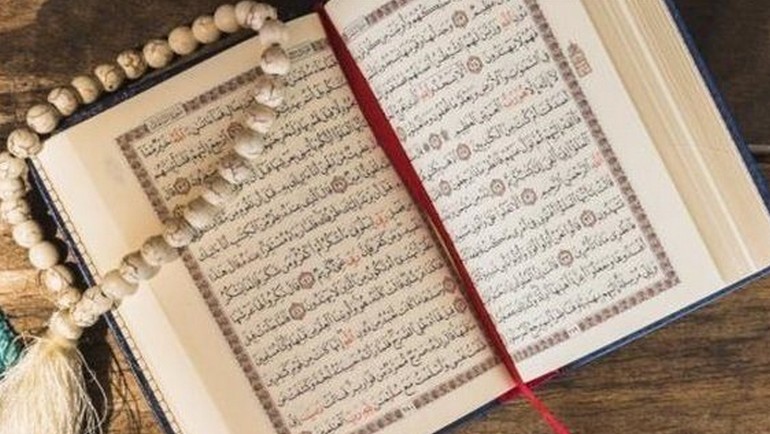هل التداولية أصلها الاستعمال عند العرب؟

هَل التداوليّاتُ أصلُها «الاستعمالُ» بالمَعْنى الذي ورَدَت به في كتُب اللغةِ قَديماً، في مُقابل «الوَضع»، وأنْ لا مكانَ للتداوليات الحَديثَة؛ وأنّ الاستعمالَ علم عربيٌّ صميمٌ، وضعَ أصولَه الخَليلُ بنُ أحمدَ الفَراهيديُّ في "كتاب العين" بنظرية التقليب الرياضي لحروف الكلمة. وإحصاء كلمة الاستعمال وما يتصرف منها في كتاب العين أمر متيسر بالحاسوب اليوم.
والرأي عندي أنّ هذا خلطٌ صريحٌ بينَ علم حديث النشأة وبينَ طرُق في النظر والتحليل في التراث؛ فالتداوليات فرع من فروع اللسانيات، نشأ عندَما عَجَزَت اللسانياتُ الصّوريّة عن الإحاطَةِ بأبعاد الظّاهرَة اللغويّة البشريّة وعناصِرِها المختلفة، واقتصَرَت على ظواهر الألفاظ والتّراكيب في معزلٍ عن القائل والمُخاطَب والسياق... أمّا الاستعمال فهو إخراج اللغة من كونها ظاهرةً معقولةً في الذهنِ مخزونةً في الذّاكرة إلى كونها إنجازاً عملياً مُحقَّقاً في أصواتٍ وتراكيبَ وبنىً صرفيّة...
ولو ادّعينا أنّ العربَ سبقوا الغربَ في مَيدان التداوليات، وطمَسْنا العلمَ نفسَه وأصولَ النشأة، وألحقْنا كلّ شيءٍ بالذّاتِ لكنّا كالذي أغمضَ عينيه عن رصيد كبيرٍ من الكتب والمصادر اللسانية التي أنجِزَت في الغربِ لرصدِ وظيفةِ اللغة في المجتمَع، رصداً علمياً فلسفياً دقيقاً ، فإنكارُ المعرفَة الإنسانيّة المُنجَزَة وإلحاقُها بما أنجزَت الذّاتُ تجنٍّ على العلم والمعرفَة.
أمّا فكرةُ التقاليب في معجَم الخَليل فهي جزءٌ صغيرٌ جدا من الأساس التداوليّ للغة، لأنّ تقسيمَ الألفاظ إلى مُهمَل نظرياً ومُستعملٍ عملياً وسماعياً ضربٌ من ضروبِ ربط اللفظِ المُفْرَد بالمَعْنى المعجميّ المُفْرَد، فلا ينبغي الخلطُ ...
أجل، يفرِضُ علينا واجبُ العلم والمعرفَةِ أن نَعقدَ حواراً بين النَّتاجِ العلميّ والفكريّ والفلسفيّ الذي أنتَجَه أسلافُنا رحمهم الله، وبينَ ما أنتجَه الباحثونَ والمفكّرونَ اليومَ، ليسَ للافتخارِ وادّعاءِ السّبْق، ولكن للازديادِ من التعلُّم والاغترافِ من مَعين المَعرفةِ الذي هو مَعينٌ إنسانيّ يخدمُ البشريّةَ ويبدّدُ ظلامَ الجهلِ والتّخلُّف
حتّى العلماءُ العرب والمسلمونَ لم يُسَمّوا أنفسهم تداوليين فنحن الذين سميناهم، أما هم فقد كانت لهم مقدمات ينطلقون منها وأولويات في العلم يُقدمونَها على غيرها وأُطُرٌ نظريةٌ ومعرفية ينطلقون منها، ولهم مفاهيمهم ومُصطلحاتهم التي تنحصر في مفاهيم علم الكلام والبلاغة وعلم المعاني والمقام والمتكلم والمخاطَب وظروف الحال وغير ذلك، فلكل قوم وضعٌ علميّ خاص بهم، ولا نُطلقُ مصطلحات أقوامٍ على عمَل أقوامِ آخَرين، بل نحترم كل المفاهيم والمصطلحات ونُجري بينها حوارا مفيدا لا نُغلِّبُ فيه قديما على حديث ولا حديثاً على قَديم.