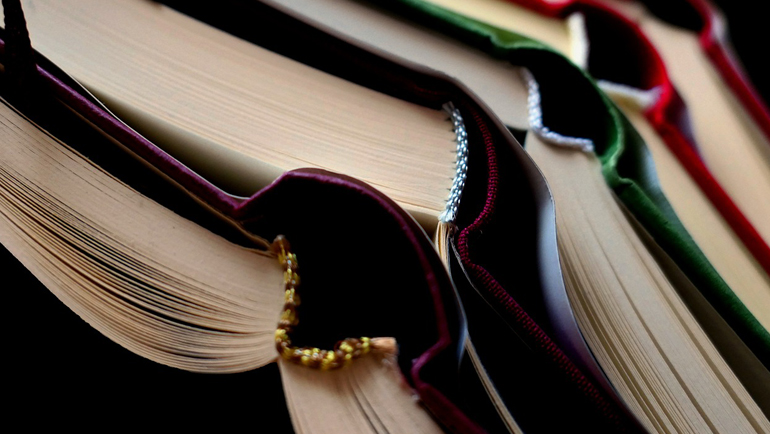وضع المظهر موضع المضمر من خلال فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للإمام العلامة شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبيّ (ت:743هـ) – الحلقة العاشرة – (تتمة)

- قوله: (وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ) [الأنعام: 124]، يقول الطيبي: «والحاصل أن قوله: (الذين أجرموا) مظهر وضع موضع المضمر، للإيذان بأن استكبارهم ذلك سبب لإيصال الذل والهوان، بالقتل والأسر يوم بدر، وإذاقة العذاب الشديد في الآخرة؛ فجمع لهم خزي الدارين»[6/238].
- قوله: (قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) [الأنعام: 150]، قال الزمخشري: « (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) من وضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنّ من كذب بآيات الله وعدل به غيره فهو مُتبع للهوى لا غير، لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحداً لله تعالى»[6/288].
- قوله: (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ) [الأعراف: 93]، فقوله (فكيف آسى) – كما قال الزمخشري - أي: كيف يشتدّ حزني على قومٍ ليسوا بأهلٍ للحزن عليهم لكفرهم واستحقاقهم ما نزل بهم، قال الطيبي: « قوله: (على قوم كافرين) إقامة للظاهر موضع المضمر، للإشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم لكفرهم»، [6/482].
- قوله: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: 204]، قال الطيبي:«(وإذا قرئ القرآن): وضعٌ للمظهر موضع المضمر، لمزيد الدلالة على العلية. يعني: إذا ظهر، أيها المؤمنون، أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين، فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال، الهادي إلى الطريق المستقيم، الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى، (فاستمعوا له)، وبالغوا في الأخذ منه، والعمل بما فيه، ليحصل المطلوب، و (لعلكم ترحمون)»[6/728].
- قوله: (ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) [الأنفال: 14]، ومعناه – كما قال الزمخشري - «ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة، فوضع الظاهر موضع الضمير»، قال الطيبي: «قوله: (فوضع الظاهر موضع المضمر): أي: فوضع (لِلْكَافِرِينَ) موضع (ذَلِكُمْ)، وفائدته: الإشعار بأن صفة الكفر هي الموجبة لإذاقة العذاب في الدارين»[7/49].
- قوله: (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)[الأنفال:43]، فلو يقل: ولكنه سلَّم من وضع المظهر موضع المضمر، قال الطيبي: «وفي وضع اسم الله تعالى موضع المضمر إشعارٌ بأن الأمر عظيم الشأن، فلا يصدرن ذلك إلا عن باهر السلطان» [7/120].
- قوله: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) [التوبة: 12] ، قال الطيبي: « ويُمكن أن يُقال: إن في وضع المظهر - وهو قوله: (أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) - إشعاراً بأن أيمانهم تلك لم تكن إلا خديعة بالمؤمنين واستهزاء، ولم تكن من الأيمان الحقيقية في شيء، ولكن لما أجري عليها حكم الأيمان الحقيقية بأن قبلت، ورفع عنهم بسببها التعرض بالقتل والنهب، وأمنوا من سائر التبعات، سميت أيماناً، ووصفت بالنكث، نحوه مر في قوله تعالى: (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة: 9]، قال المصنف: "كانت صورة صنعهم مع الله - حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر - صورة صُنع المخادع، وصورة صنع الله -حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد أخبث الكفرة - صورة صنع الخادع.
فظهر أن اعتداد الأيمان منهم وإن لم يكن حقيقة، إنما هو لأجل فوائد دينية ومصالح منوطة بها، لا أنها أيمان حقيقة، فلما أظهروا النكث ارتفع الاعتداد بها ورجعت إلى ما كانت، فقيل: (إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ)، وهكذا مبني الأيمان، فإنها لقطع الخصومات والمطالبات في الحال، لا أنها مسقطة للحق، وتحصل بها براءة الذمة في المآل»[7/188].
- قوله: (لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) [التوبة: 44]، قال الزمخشري: «(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين، وعدة لهم بأجزل الثواب»، قال الطيبي: « وأما الشهادة بالانتظام: فمن وضع المظهر موضع المضمر، وإرادة الجنس بالمتقين، فيدخلون فيه دخولاً أولياً. وأما العدة: فإن مقتضى العلم بعد ذكر أعمال العباد خيراً أو شراً، إما الوعد بالثواب أو الوعيد بالعقاب» [7/259]
- قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: 123]، قال الزمخشري: « (مَعَ الْمُتَّقِينَ) ينصر من اتقاه فلم يترأف على عدوّه»، قال الطيبي: « وقد وضع (الْمُتَّقِينَ) موضع المضمر، أي: معكم، إذا لم يوجد منكم الترأف والترحم، والله أعلم»[7/405].
- قوله: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس: 50، 51]، قال الزمخشري: «فإن قلت: فهلا قيل: ماذا تستعجلون منه؟ قلت: أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال، وهو الإجرام؛ لأنّ من حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه، ويهلك فزعا من مجيئه وإن أبطأ، فضلا أن يستعجله»، وقال الطيبي: «قوله: (أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال): يعني: وضع المُظهر - وهو (الْمُجْرِمُونَ) - موضع الضمير؛ للإشعار بالعلية، وأن من حق المجرم أن يخاف التعذيب»[7/502].
- قوله: (كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ) [الرعد: 30]، قال الطيبي:« و"الرحمن" مظهر وضع موضع المضمر لتلك الفائدة التي ذكرها، وهي أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء»[8/514].
- قوله: (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) [الرعد: 33]، قال الطيبي: «قوله: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ) من وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه، كقوله تعالى: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً) [مريم: 65]»[8/525].
- قوله: (لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) [النحل: 23]، قال الزمخشري: «(إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) يجوز أن يريد المستكبرين عن التوحيد يعنى المشركين. ويجوز أن يعمّ كل مستكبر، ويدخل هؤلاء تحت عمومه»، يقول الطيبي في بسط كلامه: « قوله: (ويجوز أن يعم كل مستكبر)، يعني: أن قوله: (الْمُسْتَكْبِرِينَ) إما من وضع المظهر موضع ضمير المشركين، ويُراد بالاستكبار: الاستكبار عن التوحيد فقط، لقرائن المقام، والمراد منه من عرف الحق أياً كان واستكبر، وتعرف النعمة فغمط وكفر، فيكون من المستكبرين مطلقاً، على منوال: فلان يُعطي ويمنع، ويدخل في هذا العام من سيق له الكلام دخولاً أولياً».[9/102].
- قوله: (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ) [النحل: 30] قال الطيبي: «و(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا) مُظهر وُضع موضع المضمر للإشعار بأنهم مستأهلون بأن يحسن إليهم دُنيا وعُقبى»[9/112].
- قوله: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (*) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) [النحل: 106، 107]، قال الطيبي: « جعل سبب وعيد من شرح بالكفر صدراً - وهم الذين ارتدوا بعدما دخلوا في الإسلام - شيئين؛ أحدهما: استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، وفيه إشارة إلى فضل ما فعل أبو عمار على عمار. وثانيهما: استحقاق خذلان الله بكفرهم، وإنما علل الخذلان بالكفر؛ لأن قوله: (لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) من وضع المظهر موضع المضمر للعلية»[9/204].
- قوله: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) [النحل: 126] يناقش الزمخشري معاد الضمير في (لهو)، ويقول: «إما أن رجع الضمير في (لَهُوَ) إلى صبرهم وهو مصدر (صبرتم). ويراد بالصابرين: المخاطبون، أي: ولئن صبرتم لصبركم خير لكم، فوضع (الصابرون) موضع الضمير؛ ثناء من الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد. أو وصفهم بالصفة التي تحصل لهم إذا صبروا عن المعاقبة. وإما أن يرجع إلى جنس الصبر - وقد دل عليه (صبرتم) - ويراد بالصابرين جنسهم، كأنه قيل: وللصبر خير للصابرين. ونحوه قوله تعالى (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)] الشورى: 40 [، (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [ البقرة: 237 ]»، قال الطيبي في بسط كلام الزمخشري: « يعني: وضع "الصابرين" موضع ضمير المخاطبين مجازاً؛ لأنهم عند الخطاب ما كانوا صابرين، فسماهم الله به، إما لمجرد المدح والثناء؛ لأن الصبر من أعم أوصاف المتقين، وإما لاكتسائهم بلباس الصبر جُعلوا صابرين ترغيباً على الصبر، وعلى أن يُراد بالصابرين الجنس لا يكون من وضع المظهر موضع المضمر، فلا يكون مجازاً بل يكون من باب الكناية، فيدخل في هذا العام المخاطبون دخولاً أولياً»[9/229].
- قوله: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ) [الكهف: 109]، قال الطيبي في معنى الآية: « والمعنى: لو فرضنا أن غير المتناهي داخلٌ تحت حكم المتناهي، وأنه نوعٌ من جنسه، لنفد قبل نفاده، فكيف وأنه ليس من جنسه؟ هيهات، أين الثريا من الثرى! ولذل مع كلماتٍ جمع قلةٍ تتميماً للمعنى، أي: إذا كان حُكمُ الكلمات بهذه المثابة، فما ظنُّكَ بالكلم، ووضعُ المظهر موضع المضمر في قوله: (قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي) إشعارٌ بالعلية، وأنها حقيقٌ بأن تكون غير متناهية»[9/556].
- قوله: (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (*) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) [مريم: 8- 9]، قال الطيبي: «قلتُ: قال: (هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ)، فوضع موضع المضمر المظهر، وهو (رَبُّكِ) للإشعار بأن قول ربك حق ووعده صدق»[9/580].
- قوله: (وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (*) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا) [مريم: 66، 67]، قال الطيبي: «إنه تعالى لما حكى عن جنس الإنسان أنه قال: (أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً) ثُم أنكر عليه بقوله: (أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ) الآية في أنه يعاند ولا يلتفت إلى البرهان القاهر، ولا يذكر خلقته من قبلُ، ووضع المُظهر وهو الإنسان موضع المضمر ليؤذن بحقارته ودناءته وأن إعادة مثله لا يؤبه بها، ولهذا صرح بقوله: (وَلَمْ يَكُ شَيْئاً)...»[10/76].
- قوله: (طه (*) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (*) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى) [طه: 1 - 3]، قال الزمخشري: «إن جعلت (طه) تعديداً لأسماء الحروف على الوجه السابق ذكره فهو ابتداء كلام. وإن جعلتها اسما للسورة احتملت أن تكون خبرا عنها وهي في موضع المبتدأ، و (الْقُرْآنَ) ظاهر أوقع موقع الضمير لأنها قرآن، وأن يكون جوابا لها وهي قسم »[10/120]، قال الطيبي في بيان مراد الزمخشري: « لأن (طه) إذا جُعل اسماً للسورة و (مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) خبره، يكون "القرآن" من وضع المُظهر موضع المضمر لما ذكرنا، وللتفخيم تعظيماً له، وأنه هو السُّلمُ في نيل كل فوزٍ وسعادة، ومن حُرم فهو الشقي الخائب الخاسر»[10/121-122].
- قوله: (قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ) [الأنبياء: 45]، قال الزمخشري: «والأصل: "ولا يسمعون إذا ما ينذرون"، فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدّهم أسماعهم إذا أنذروا. أى: هم على هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصامّ من آيات الإنذار»[ 10/ 355].
- قوله: (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (*) قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم) [الأنبياء: 68، 69] قال على إبراهيم ولم يقل (عليه)، « وذلك من وضع المُظهر موضع المضمر، أي: كرامةً لهذا المسمى، قيل: لأنه على الوجه الأول لم يكُن بردُها مخصوصاً بإبراهيم، فلا يكونُ للتخصيص بقوله (عَلَى إِبْرَاهِيمَ) وجهٌ، وفيه بحث»[10/378].
- قوله: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) [الفرقان: 32]، فقد وضع المظهر في قوله: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) موضع المضمر «إشعاراً بتوهينهم، وتحقيراً لشأنهم»[11/230].
- قوله: (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا) [الفرقان: 37]، قال الزمخشري في قوله: (لِلظَّالِمِينَ) إمّا أن يعنى بهم قوم نوح، وأصله: وأعتدنا لهم، إلا أنه قصد تظليمهم فأظهر. وإمّا أن يتناولهم بعمومه. قال الطيبي مفصلا: « أي: وضع الظاهر موضع المضمر تظليماً لهم، من: ظلمه، أي: قال له: إنك ظالمٌ، أو نسبهم إلى الظلم ليؤذن أن تعذيبهم وإغراقهم بسبب تكذيبهم الرسل، وأن لا ظلم أظهر منه »[11/236].
- قوله: (فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى....) [القصص: 48]، قال الطيبي: «ووضْعُ المُظهَرِ وهوَ {الْحَقُّ} مَوْضِعَ المُضْمَر؛ فإنّ فيهِ الإشعارَ بقطعِ الحُجّة، وأنُه المؤيّدُ بالمعجزاتِ القاهرةِ والآياتِ الباهرة، والهادي إلى ما يُزلِفُهُم إلى المقامِ الأَسنى والدرجاتِ الحُسنى، ويُبعِدُهم عما يُوقِعُهُم في وَرَطاتِ الرّدي، ونحوَها مما يدخلُ تحتَ معنى الحق. المعنى: فلمّا جاءَهُم مثلُ هذا الحقِّ الساطِعِ والنورِ اللامعِ عندما كانوا أفقرَ شيءٍ إليه؛ تعامَوْا وتصامُّوا واقترحُوا عليهِ مِنَ الآياتِ ما ظَهَرَ بهِ عِنادُهم وتمرُّدُهُم؛ فقالُوا: (لَوْلاَ أُوتِيَ مَا أُوتِيَ مُوسَى)»[12/72].
- قوله: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (*) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الشعراء: 214، 215]، قال الطيبي بعدما ذكر وجوها في تفسيره: «والذي هو أجرى على أفانين البلاغة أن يحمل الكلام على أسلوب وضع المظهر موضع المضمر، وأن الأصل: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ} منهم، فعدل إلى "المؤمنين"، ليعم وليؤذن أن صفة الإيمان هي التي تستحق أن يكرم صاحبها، ويتواضع لأجلها من اتصف بها، سواءٌ كان من عشيرتك أو من غيرهم»[11/433].
- قوله: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت: 45]، قال الزمخشري: « (وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ) يريد: وللصلاة أكبر من غيرها من الطاعات، وسماها بذكر الله كما قال: (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله)] الجمعة: 9 [وإنما قال: ولذكر الله: ليستقلّ بالتعليل، كأنه قال: وللصلاة أكبر، لأنها ذكر الله. أو: ولذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر، فكان أولى بأن ينهى من اللطف الذي في الصلاة. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته (وَالله يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ) من الخير والطاعة، فيثيبكم أحسن الثواب»، قال الطيبي في تلخيص كلامه: « تلخيصُه: أنه مِنْ وَضْعِ المُظهَرِ موضعَ المُضمَرِ من غير لفظِه السابقِ؛ للإشعار بالعِلِّيَّة، ولو جيءَ بظاهِرٍ لم يُفِدْ هذا المعنى»[12/179].
- قوله: (كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ) [الروم: 10]، قال الزمخشري: « والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار، ثم كانت عاقبتهم السوأى؛ إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر، أى: العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة، وهي جهنم التي أعدّت للكافرين»
قال الطيبي: « قال صاحب ((الفرائد)): على تقدير قراءةِ النَّصب هو الخبرُ، والاسمُ {أَن كَذَّبُوا} المعنى: كان عاقبةُ الذين فَعَلُوا الفِعْلةَ السَّوأي؛ أي: التَّكذيب؛ أي: لقّاهم شؤم أفعالهم في الكُفر؛ كقوله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ} [التوبة: 77]، فعلى هذا ليس المُظْهَرُ واقعًا مَوقِعَ المُضمَرِ، بل هو كلامٌ يَدخل فيه المَذكورون.
وقلتُ: لا بدَّ منَ القولِ بوضع المُظْهَرِ موضعَ المُضمَرِ؛ لأنَّ {ثُمَّ} هاهنا للاستبعاد؛ كقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1] يعني: أيقظناهم من غَفْلتهم بقولنا: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ} ودَلَلْناهم على طريق الإيقاظ.
والعِبْرةُ بقولنا: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً}؛ لِيُقلعوا عمّا كانوا عليه منَ العِنَاد والتَّكذيب، ثمَّ بعدَ ذلك لم يكن عاقبتُهم إلاّ الفَعْلةَ السَّوأي والتَّكذيب، والله أعلم.
قال القاضي: وُضِع الظّاهرُ مَوضِعَ المُضمَر للدَّلالة على أنَّ ما اقتَضى أن تكونَ تلك عاقبتَهم هو أفعالُهم السّوأي، بمعنى اقتَرفوا الخطيئةَ.
فعلى هذا: الإساءةُ أعمُّ من أن تكون قوليةً أو فعليةً، وعلى أن تكون ((أن)) مفسِّرة يجب أن تكونَ قوليَّةً لا فعليةً؛ ليصحَّ جَعْلُها بمعنى القولِ، وإليه الإشارةُ بقوله: ((تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء))[12/217].
- قوله: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) [الروم: 30]، قال الطيبي: «دلَّ قولُه: {لِخَلْقِ اللَّهِ} على أنَّ معنى فِطْرةَ الله: الخَلْقُ، وأنه من إقامة المُظْهَرِ موضعَ المُضْمَرِ من غير لفظِه السابقِ، وفائدتُه: الإشعارُ بأنَّ أصلَ الجِبِلَّةِ السَّليمةِ المتهيئةِ لقَبولِ الحَقِّ أن لا تُغيٍّرَ ولا تَتْرُكَ لِمَحْضِ التَّقليد، فإنه مُجاوِبٌ للعقل»[12/243].
- قوله: (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (*) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [الروم: 44، 45]، قال الطيبي: «كان من حقِّ الظاهر: (لِيَجْزِيَهم) فوُضع المُظهَرُ موضِعَ المضمَرِ إشعارًا بالعِلِّيةِ، وأنَّ الإيمانَ والعملَ آذنا بأنَّ الله وليُّ صاحبِهما حيثُ يَجزيه من فَضْله، فيكون مفهومُ {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ} الموافقُ أنَّه يُحب المؤمن الصالح، مفهومُه المخالفُ: أنَّه لا يحبُّ الكافرَ، فقولُه: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} بمَنطُوقه مقرِّرٌ لمفهوم السّابِق وبالعكس» [12/260].
- قوله: (ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) [غافر: 76]، قال الزمخشري: «{فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} عن الحق المستخفين به مثواكم، أو جهنم»، قال الطيبي: « إشارة إلى أن المخصوص بالذم هذا أو ذاك؛ لأن {الْمُتَكَبِّرِينَ} إذا كان من وضع المظهر موضع المضمر للعلية بدليل قوله: {ادْخُلُوا}، كان التقدير: فبئس المثوى مثواكم، وإذا كان عامًا ليدخلوا فيه دخولًا أوليًا كان التقدير: فبئس المثوى جهنم»[13/546].
- قوله: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.....) [الأحزاب: 50]، قال الزمخشري: «فإن قلت: لم عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: (نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ) ثم رجع إلى الخطاب؟ قلت: للإيذان بأنه مما خص به وأوثر، ومجيئه على لفظ النبي؛ للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوّة، وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته»، قال الطيبي: «يعني: دلَّ إقامةُ المُظهرِ موضعَ المُضْمرِ في قوله: {إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} على أنَّ المرأة إنما وهبَتْ نفسَها له، وجاز له ذلك دون غيره تكرِمَةً لأجل نُبوتِه، ودل تكرير ذلك في قولِه: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا} على أن الله تعالى إنما آثر إرادته في ذلك لكونه صلوات الله عليه أهلاً لذلك لأجلِ نُبوَّتِه، فظهَر أن طريقَ التعليلَيْن مختلفة، فكما أنّ نبوتَه اقتضت ذلك كذا إرادته، قال الزجاج: وإنما قيل: {لِلنَّبِيِّ}؛ لأنه لو قيل: إن وهبَتْ نفْسَها لك، كان يَجوزُ ان يُتوهَّمَ أن في الكلام دليلاً على أنه يجوز ذلك لغير النبيِّ، كما جاء في {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ} »[12/458].
- قوله: (إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) [فاطر: 14]، يعني: أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به، فـ(مثل خبير) ظاهره (مثلي)، من وضع المظهر موضع المضمرقال الطيبي: «قال مُحيي السُّنّة: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} أي: لا يُنبِّئُك أحدٌ مثلي خَبير. وقلتُ: نظيرُه ما إذا أخبرَكَ بالأمرِ مُخبرٌ صادقٌ مُتقِنٌ في الأمور، ثم قالَ بعْدَه: ما يُخبركَ به مِثْلُ خبير، أي: مثلي، يعني: أنا مُختصٌّ به فلا تسأَلْ عن غيري، فالمعنى: لا يُخْبِرُ بالأمرِ مُخبرٌ هو مثْلُ الخبيرِ العالمِ الذي لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، ولا يعزُبُ عن عِلْمِه مثقالُ ذرّة»[12/630].
- قوله: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ) [الشورى: 48]، قال الزمخشري: «والكفور: البليغ الكفران، ولم يقل: فإنه كفور؛ ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم »، قال الطيبي:« فهو من إقامة المظهر موضع المضمر؛ للإشعار بتصميمهم على الكفران، والإيذان بأنهم لا يرعوون مما هم فيه»[14/83].
- قوله: (أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُون)[الطور:42]، قال الطيبي: « فقوله: (فَالَّذِينَ كَفَرُوا) إشارة إليهمْ كما قال الزمخشري، ثم قال الطيبي: «فيكون من وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل على كفرهم، والدلالة على أنه الموجب للدمار، فالتعريف فيه للعهد، وعلى أن يراد بهم كل من كفر للجنس» [15/64].
- قوله: (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) [النجم: 10]، ظاهره (أوحى إليه)، قال الطيبي: «و(عَبْدِهِ)من إقامة المظهر موضع المضمر، لتصحيح نسبة القرب، وتحقيق معنى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا)[الإسراء: 1]»[15/86].
- قوله: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (*) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ)[الملك:3-4]، ومعنى (ينقلبب إليك البصر) – كما قال الزمخشري - : « أي: إن رجعت البصر وكررت النظر، لم يرجع إليك بصرك بما التمسته من رؤية الخلل وإدراك العيب، بل يرجع ذلك بالخسوء والحسور، أي: بالبعد عن إصابة الملتمس، كأنه يطرد عن ذلك طردا بالصغار والقماءة، وبالإعياء والكلال لطول الإجالة والترديد»[15/537]، قال الطيبي: «في كلامه إشعار بأن {البَصَرَ} الثاني في موضع المضمر، لقوله: "بل يرجع إليك"، أي: بصرك بما التمسته. الانتصاف: "معنى وضع المظهر موضع المضمر، أن الأبصار التي يدرك بما كل موجود ترجع خاسئة"»[15/538]
- قوله: (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ)[الملك: 20]، قال الطيبي:«أوقع {إنِ الكَافِرُونَ إلاَّ فِي غُرُورٍ} اعتراضًا، وضعًا للمظهر موضع المضمر تسجيلًا على غرورهم، وتجهيلًا بعد تجهيل»[15/556].
- قوله: (الْحَاقَّةُ (*) مَا الْحَاقَّةُ (*) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) [الحاقة: 1 - 3])، قال الزمخشري: «والأصل: الحاقة ما هي؟ تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأنه أهول لها»[15/607].
- قوله: (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (*) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) [الإنسان: 1، 2]، قال الطيبي: « إن {الْإِنسَانَ} الثاني مُظهر وضع موضع المضمر لإفادة الترقي، أي كان الشيء المنسي الذي لا يُلتفت إليه ولا يُذكر، فإنا قلبناه في الأطوار المتباينة والأحوال المُتخالفة، وجعلناه مما يذكر فيه ويعتبر، حيث جعلناه محلاً للمعرفة والعبادة...»[16/180].
- قوله: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (*) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 1، 2]، فظاهره: (فصل لنا)، قال الطيبي: « قولُه: (ومُعْطي ذلك كلِّه أنا إلهُ العالمين)، إيذانٌ باختيارِ قولِ ابنِ عباس: إنّ الكوثرَ الخيرُ الكثير، وبإفادةِ ضميرِ الجمعِ الدالِّ على العظمةِ والكبرياء، فإن قائلَه ليسَ إلّا إلهَ العالمين، وأنّ المُعطَى لم يكن عظيمًا، إلّا أنّ المُعطي عظيم. ولأجلِ تَيْنِك المناسبتين، رُتّبَ عليه قولُه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ}، وَوُضعَ المظهرُ موضعَ المضمر، يعني: كما أنّ المعطي والمعطي عظيمان، فأتِ أنتَ بأعظمِ ما يمكنُ من العباداتِ البدنيةِ والمالية»[16/603].