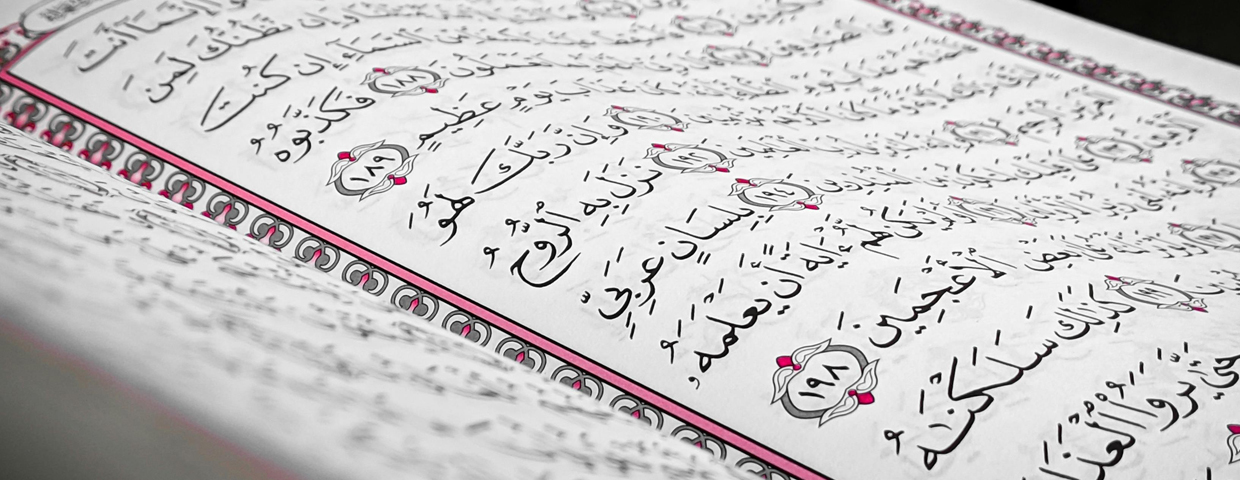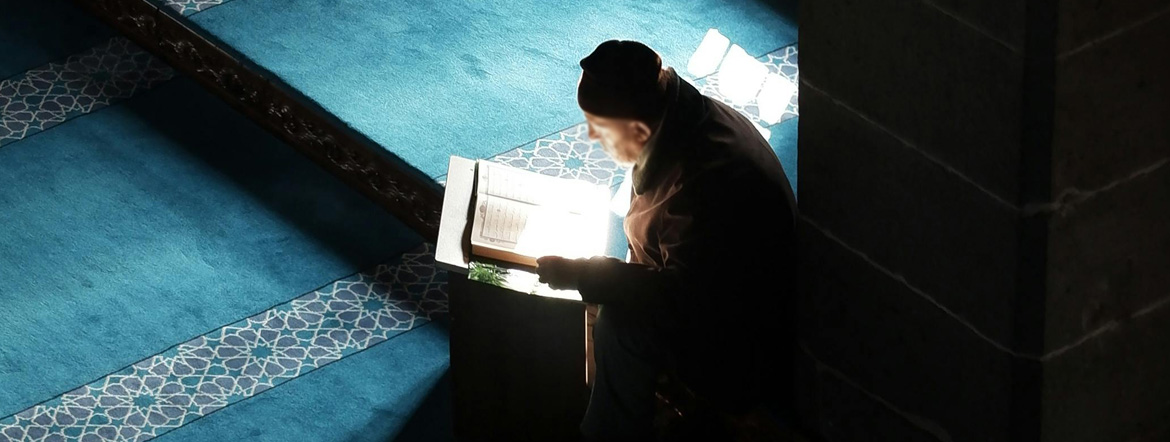الموقف الصوفي من الشأن العام القرن السادس الهجري نموذجا

عرف مشايخ التصوف اختلافا متباينا في مقاربتهم للسلطة عموما، على اعتبار أن منهم من كان يحكمه مبدأ الانقباض والاجتناب، ومن كان يحكمه مبدأ الانتقاد والاعتراض، كما أن منهم من كان لا يرى في مخالطتهم أي داع من دواعي الشبهة والاشتباه، على أن هذا الاختلاف في التعامل بين رجال التصوف ومن يمثلون السلطة السياسية، هو ما كان يحكم رجالات الصلاح منذ القرون الأولى، واستمرت هذه العقلية بتشعباتها بعد ذلك العهد أيضا بكثير؛ فأعلام السلف الأول وجد منهم من احترز من التعامل مع السلطة، كما وجد فيهم من تعامل معها بكل وضوح، فلا يمكن القول إن الصواب والمشروعية يوجدان في هذا الوقف أو ذاك [1]. وقد جاء السلطان المرابطي إلى من مراكش إلى أغمات وريكة، فزار عبد الجليل بن ويحلان وأبا محمد بن عبد الله المليجي، وبعث إلى كل واحد منهما بألف دينار، فأما عبد الجليل فأخذ وتصدق به على المساكين، وأما عبد الله فردَّه عليه، فقال له عبد الجليل: هلا تصدقت به ولم ترده عليه؟ فقال: أنت أخذت ذلك لأنك عندك من العلم ما تقبل به وتعطي، وأما أنا فما عندي من العلم ما آخذ به وما أعطي[2]. على أساس أن مشايخ التصوف تتبلور تصرفاتهم على مقتضى العلم، كما أن ما يحظى به أهل الصلاح من مميزات الذكاء الروحي يجعل الموقف الصوفي مشدودا بعناصر السداد والتوفيق، مما اقتضى من الأمير المرابطي أن يسلم لكل واحد منهم حاله، ويقر كلا منهم على موقفه. فعلى الرغم مما هو مأثور من أحوال الاعتراض والانتقاد اتجاه السلطة كما هو الأمر بالنسبة لقضية الإحياء؛ من طرف ابن حرزهم وأبي الفضل النحوي وغيرهما، فإن الأمر المؤكد هو أن هذه التجمعات الروحية بقيت على وفائها للسلطة الحاكمة في بلاد المغرب، ولم تتحول قط إلى حركات سياسية ثورية، عِلما بأن الطريق الصوفي حظي بتجمهر العديد من المتشوفين إلى المعاني الروحية، وشكلوا تكتلا وازنا داخل المجال المغربي.
الفرع الأول: سلوك النفور والابتعاد
لقد تحاشى معظم السالكين والصلحاء والزهاد مخالطة السلطة بكل تجلياتها، على اعتبار أن ذلك لا يخلو من شبهة، وأن الاشتباه في طريق السلوك هو مما يعكر صفو القرب عندهم، ويمنع من السير في مدارج الترقي، وعلى هذا الأساس تكررت في كتب المناقب والتراجم والروايات العديد من الأحداث التي تفيد اتخاذ المتصوفة لمواقف تتلخص في الإعراض عن الخلفاء وممثلي السلطة، والانزواء عنهم ومحاشاتهم وعدم مداخلتهم إلا عند الضرورة، وفي بعض الظروف الاستثنائية كظروف الجهاد بالأندلس مثلا [3]، وفي هذا الاتجاه يسرد ابن الزيات في ترجمة أحد متصوفة العهد المرابطي «أنه لم يمش في مظلمة ولا إلى باب سلطان» [4] . ومن جهته كان المتصوف أبو عبد الله المجاهد «مباعدا للملوك مع شدة رغبتهم فيه، منافرا لهم، لا يقبل منهم قليلا ولا كثيرا. وفي نفس السياق يخبرنا ابن صعد عن متصوف آخر اشتهر بشدة الزهد ومباعدة الأمراء والمترفين، كما عرف المتصوف ابن العريف أيضا بتحاشيه مجالسة الأمراء وعدم قبول هداياهم، وحسبنا أنه بعد ثبوت براءته من التهمة التي كالها له بعض الفقهاء، سعى الأمير المرابطي إلى استرضائه فسأله عن حوائجه، بيد أنه ترفع عن ذلك ولم يقبل إغراءات الأمير المذكور، وحتى المتصوفة الذين قبلوا هدايا الأمراء لم يستأثروا بها، بل وهبوها بدورهم صدقة للفقراء وذوي الحاجة[5].
ليس فيما منحته السلطة الحاكمة للصوفية من امتيازات، وخصتهم به من ظهائر، مما يدل على استقطابهم وتوظيفهم فيما يخدم السلطة، فقد عارض آل أمغار إحراق كتاب الإحياء، مخالفين في ذلك اتجاه الرياح التي كانت تسير فيه المؤسسة الحاكمة، وانعكست هذه المعارضة في عدم حضور شيخ الطريقة الأمغارية الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الأمير المرابطي قصد مناقشة مسألة إحراق كتاب الإمام الغزالي. وهو اجتماع أشبه بمؤتمر كبير ضم عددا من أقطاب التصوف بالمغرب، وشكل حدثا هاما لم تفصح المصادر عن تفاصيل عنه للأسف، رغم أهميته كمحطة من محطات الانقباض بين السلطة والمتصوفة، واكتفت بالقول: «إنه اجتمع له –علي بن يوسف-في الوقت المعين كل من اشتهر فضله وصلاحه في ذلك العصر»[6]. إن هذا التباعد والنفور من طرف الصوفية يؤشر على أن هناك توجُّها عريضا داخل هذه الدائرة الكبرى للتصوف، تنزع إلى سلوك موقف الإعراض عن السلطة، غير أن هذا الموقف الرافض ليس مما يستدعي استخلاص التشكيك في شرعية السلطة الحاكمة؛ فمعظم كتب التراجم والمناقب وغيرهما لا نجد فيها مثل هذه الأحكام والمواقف، ولذلك فقد ظل «التصوف» في هذه البلاد تجربة روحية خالصة، لم تخالطها ميولات سلطوية، ولا مصالح سياسية دنيوية، وإنما بقيت على صفائها الروحي، على أن مَن رأى منهم ممارسة الإصلاح من داخل الإطار التدبيري للدولة، كما هو الأمر بالنسبة لمن كان يزاول الخطابة أو التدريس وغير ذلك، فإنما هو تجسيد لقيم أخلاقية، وتنزيل لمعاني روحية، سعيا إلى توازن المادة والروح.
الفرع الثاني: سلوك المناصرة والانقياد
لقد أكدنا أن رجال التصوف لم يعملوا على امتلاك السلطة السياسية، بقدر ما أنهم اتجهوا إلى سياسة النفوس وتهذيبها، على اعتبار أن منشأ التصرفات البرانية موصول بالأفعال الجوانية، ليكون التصوف إذن ذلك الجانب التقويمي لما قد يخرج عن أخلاقيات الدين، وقد أُكِّدت لنا أحداث عديدة استدعت تدخل رجال الولاية من أجل تقويم تلك الأحداث. فالأمة محتاجة إلى وازع السلطان لضمان أمنها واستقرارها في الحياة العامة، كما أنها محتاجة إلى وازع الأخلاق حتى لا يجنح التدبير السياسي عن مقتضيات المكارم الفاضلة، وغالبا ما كانت عموما معتقدة ومناصرة لعدد من الصلحاء، وقد كان«علي بن يوسف متين الاعتقاد في أبي عبد الله أمغار، ينظر إليه بعين الإجلال والتوقير. هذا ما يظهر على الأقل من مبادرته إلى استشارته، ومن بعض مخاطباته له. وقد جاء في إحدى رسائله إليه: أبقاك الله وإيانا لتقواه ويسرنا وإياك للعلم بما يوافق رضاه. من حضرة مراكش حرسها الله عقب ربيع الآخر سنة 517ﻫ. وقد علمنا ما أنت عليه من الخير والدين والجري في أحوالك على نسج الصلاح المستبين. فاعتقدناك في الأولياء ورتبناك في أهل الذكاء فخاطبناك قاصدين اختصاصنا بصالح الدعاء فاقسم لنا من ابتهالك في الأوقات المرجوة» [7]. ليبرز أن التدبير السياسي لا ينبغي أن ينفصل عن الوازع الأخلاقي، الذي يمثله رجالات الأخلاق، عن طريق التماس النصح والإرشاد من الأولياء والصلحاء، فيما يخدم صلاح الأمة.
لم تقتصر علاقة التصوف بالسلطة الحاكمة على المناصرة الشكلية، بل إن رجالاتهم شاركوا في المشروعات الجهادية، على اعتبارها قضية عامة [8]، وباعتبارها أيضا متعلقة بمصير الأمة ووحدتها، وقد ثبت أن أبا يوسف «خرج إلى الغزوة الثانية سنة 592ﻫ، وهي التي كانت بعد الوقعة الكبرى التي أذل الله فيها الأدفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره -كتب قبل خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وحملهم إليه؛ فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار بين يديه، فإذا نظر إليهم قال لمن عنده: هؤلاء الجند لا هؤلاء!...ولما رجع أمير المؤمنين أبو يوسف من وجهه هذا، أمر لهؤلاء القوم بأموال عظيمة، فقبل منهم من رأى القبول وردّ من رأى الرد، فتساوى عنده ؓ الفريقان، وقال: لكلٍّ مذهب، ولم يزد هؤلاء ردُّهم ولا نقصَ أولئك قبولُهم»[9]. وقد سبق أن ذكرنا أن الخليفة المنصور كانت له علاقة متينة مع أبي العباس السبتي، حتى إنه كان يستشيره في أمور الدولة والسياسة، وقد أشار عليه بتمكين الفقراء والمساكين والضعفاء من مدخرات بيت المال، وكان الأمر كما أراد أبو العباس.
الفرع الثالث: سلوك الانتقاد والاعتراض
من المؤكد أن رجال التصوف كما عُرف منهم المناصر والمنقاد، والمجتنب والمنقبض، فقد عُرف منهم أيضا المُعترِض والمُنتقِد، باعتبار أن المرويات الصوفية أظهرت أن هناك توترا قائما بين رجال التصوف وبعض الفقهاء، على اعتبار أنهم يمثلون سلطة معرفية وازنة سواء بالنسبة للمرابطين أو الموحدين. وقد وشى بعض علماء الظاهر بأبي مدين الغوث عند أبي يعقوب المنصور، وقال: أن له شَبَهًا بالإمام المهدي، وأتباعه كثيرون بكل بلد، فوقع في قلبه وأهمه شأنه، فبعث إليه القدوم عليه ليختبره، وكتب لصاحب بجاية بالوصية به، والاعتناء به، وأن يحمل على خير محمل، فلما أخذ في السفر، شق على أصحابه وتغيروا وتكلموا، فأسكتهم وأعلمهم بعبارته الشهيرة، «أنا لا أرى السلطان ولا يراني»[10]. فكان أن اشتد مرضه في الطريق ومات قبل وصوله. وكثيرا ما كان اتهام الصوفية بالتأويل وخروجهم عن النص المؤسس، أو السنة المبينة من طرف الفقهاء، ويحضرنا في هذا السياق التهمة التي كيلت للصوفي الشهير ابن برجان، الذي «سئل عن مسائل عيبت عليه. فأخرجها على ما تحتمله من التأويل، فانفصل عما ألزمه من النقد، وهو نص يعكس أن مجرد التأويل كان يشكل صك اتهام بالنسبة للسلطة، وفي نفس المنحى حاول فقهاء المرابطين التضييق على الاتجاه الصوفي بتوجيه التهمة إلى كتاب الإحياء؛ بأنه يحتوي على مسائل منافية للسنة، واقتنعت السلطة المرابطية بصحة هذا الادعاء، فأمرت بإحراق الكتاب، ومتابعة كل من يقرأه أو يقوم بنسخه [11].
وربما أن مرجع مواجهة هؤلاء الفقهاء لرجال التصوف يكمن في إرادة امتلاك الموقف السياسي والشرعي والاجتماعي، على اعتبار أن الصوفية قد ظهر أمرهم، واشتد أثرهم داخل المجتمع. ولعل هذا النوع من الالتفاف مَا يرى فيه هؤلاء حصارا وتضييقا على مكانتهم. وهنا يبرز معطى جوهري يتجلى في كون معظم الانتقادات التي حاولت النيل من رجال التصوف لقيت إنصافا من طرف السلطة الحاكمة، مما يبين أن جوهر الخلاف الذي يظهر بين الصوفي والسلطة ليس هو مما له تعلق بالتنازع حول الحكم، بقدر ما هو نتيجة اختلالات صاحبت السلوك التدبيري لمن يمثلون السلطة العليا، كالولاة والنواب و«الشرطة» باعتبارها تمثل السلطة المباشرة داخل المجتمع؛ فقد تكلم إبراهيم الرجراجي على الناس بكلام خاف منه الجميع، فلما خرج إبراهيم من المسجد، تلقته أوامر العامل، فحُمل إلى السجن [12]. وهناك عديد من الأحداث التي تُظهر مواقف مختلفة من الجرأة على الانتقاد والاعتراض على ما يبدو من مظاهر الظلم والاستعباد، والتي واجهها الصوفية من منطلق سلطتهم الروحية، وكثيرا ما كانت «الكرامة» مظهرا من مظاهر هذه السلطة الروحية التي كانت مرجعا لذوي التظلمات الذين يلجؤون إلى أصحاب الولاية قصد رفع الظلم عنهم. وسنتطرق إلى تجليات مثل هذه المواقف الصوفية الموصولة بالسياسة الاجتماعية في المبحث اللاحق.
هــــــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــش
- عبد السلام الغرميني: الصوفي والآخر، (ص 161).
- التادلي: التشوف، (ص 145-146).
- محمد الشريف: التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي، (ص 44-45).
- التادلي: التشوف، (ص 297).
- إبراهيم بودشيش: حول محن المتصوفة المغاربة في العصر المرابطي، (ص 39-40).
- المراكشي: المعجب، (ص203).
- عبد السلام الغرميني: الصوفي والآخر، (ص: 163).
- المستفاد، (1/66).
- المراكشي: المعجب، (ص: 203).
- المقري: نفح الطيب، (7/146).
- إبراهيم بودشيش: حول محن المتصوفة، (ص 44).
- التادلي: التشوف، (ص 355-356).