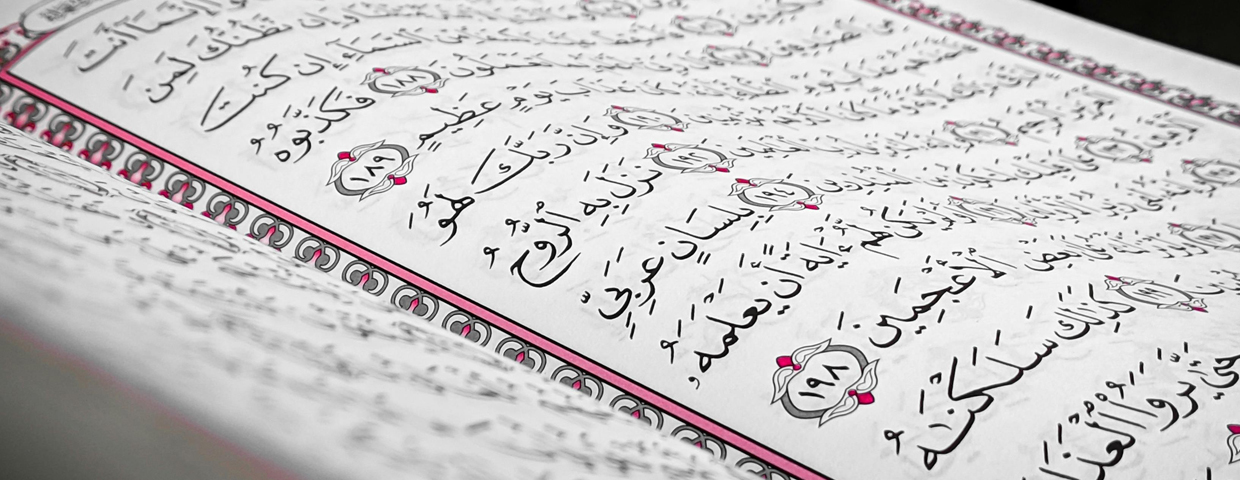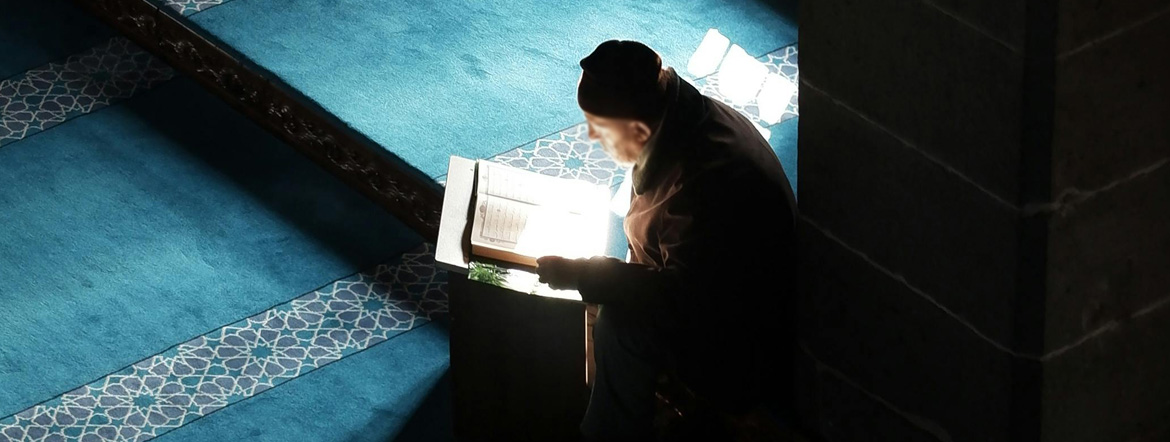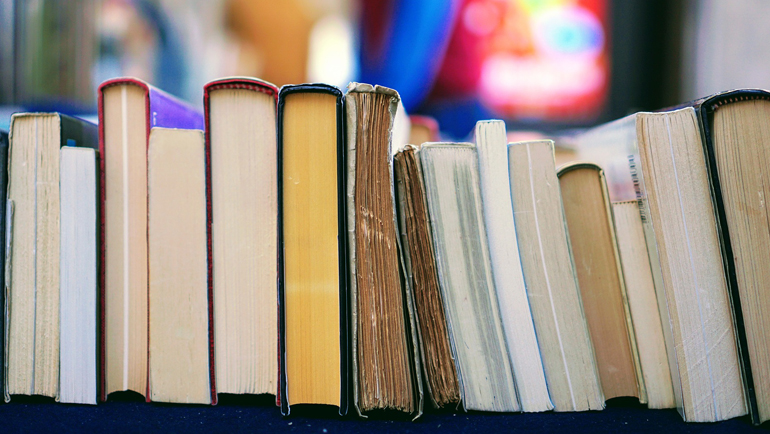
ميّز شارل موريس في كتابه: "أسس نظرية الرموز" سنة 1938م بين عناصر ثلاثة تدخل في تحديد الرمزية؛ الرمز من حيث هو علامة. والرمز من حيث هو دلالة. والرمز من حيث هو محل للتأويل من لدن المستمع. وهذا التمييز لهاتيك العناصر يمكّن من التمييز بين:
ـ المستوى الذي نقوم فيه بدراسة العلاقات الصورية بين الرموز بعضها ببعض.
ـ والمستوى الذي نعالج فيه علاقة الرموز بالموضوعات التي تدل عليها.
ـ والمستوى الذي ندرس فيه علاقات الرموز بالمؤولين لها.
وقد أطلق موريس على المستوى الأول اسم المستوى التركيبي أو التركيبيات/Syntax، وعلى المستوى الثاني اسم المستوى الدلالي أو الدلاليات/Semantics، وعلى المستوى الثالث اسم المستوى التداولي أو التداوليات/Pragmatics.
ثم انتقل هذا التقسيم الثلاثي للرمزية إلى ميدان اللغة على يد المنطقي كارناب في كتابه "مدخل إلى الدلاليات"، فتداوله اللسانيون بالدرس. وقد شملت الدلاليات أبوابا ثلاثة:
1. التداوليات الإشارية
ويبحث في أسماء الإشارة وغيرها من الضمائر التي تتغير دلالتها بتغير ظروف استعمالها أو مقامها أو زمان النطق بها أو مكانه.
2. تداوليات المعنى المفهوم
ويُعَوَّل في إدراك هذا المفهوم على جملة المعارف المشتركة بين المتكلم والمستمع وعلى قدرة المستمع على استخلاص هذا المعنى من المقام.
3. تداوليات الأفعال اللغوية
وهو يختص بدراسة أغراض الكلام من إثبات، واستفهام، وأمر ونهي، ووعد ووعيد، واعتذار، وتحذير، وغيرها.
وعلى هذا، تكون التداوليات نظرية استعمالية؛ حيث إنها تدرس اللغة في استعمال الناطقين لها، ونظرية تخاطبية؛ حيث إنها تعالج شروط التبليغ والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء هذا الاستعمال للغة.
أولا: التأصيل بين الخصوص والعموم
أما السؤال عما هو المستوى الأصلي من هذه المستويات اللغوية؛ فإذا كان المقصود بالأصل: المبدأ المنطقي، فالأصل هو المستوى التركيبي؛ وإن كان المقصود بالأصل: الحقيقة الواقعة، فالأصل هو المستوى التداولي. وعلى كل حال، فهذا التقسيم الثلاثي هو تقسيم منطقي متدرج في التوسع، فـ"الدلالة" أوسع من "التركيب" إذ تزيد عليه بعنصر المدلول، و"التداول" أوسع من "الدلالة"، إذ يزيد عليها بعنصر "الناطق"، فتقوم بين هذه المستويات علاقة "استغراق" أو "تضمُّن أقوى" بالتعبير الرياضي المجموعي[1].
1. ملاءمة المنهج التداولي لجملة الحقول المعرفية
ولا شك أن المنهج التداولي منهج مناسب للبحث في ميادين المعرفة التي تنقلها اللغة الطبيعية؛ ومن هذه الميادين: الميدان الأدبي، فنظرية تحليل الخطاب هي جزء من التداوليات؛ والميدان الحجاجي الذي استفاد كثيرا من التحليل التداولي، وخاصة نظرية الأفعال اللغوية؛ والميدان الفلسفي الذي تبادل مع التداوليات الأخذ والعطاء؛ ذلك أن المؤسسين الأوائل للتداوليات اللسانية هم أصلا فلاسفة، فـأوستين صاحب "نظرية أفعال اللغة المباشرة"؛ (أي دلالة المنطوق) فيلسوف من فلاسفة اللغة العادية الإنجليز؛ وغرايس صاحب "نظرية أفعال اللغة غير المباشرة" (دلالة المفهوم) فيلسوف هو أيضا؛ وأخيرا سورل منسق هذه النظرية في نظام متكامل فيلسوف أيضا.
وقد تلقف اللسانيون هذا الفكر الفلسفي التداولي بشغف ورتبوا قوانينه وفصلوا مسائله ووسعوا مجال تطبيقه؛ وقد أخذ اللسانيون المغاربة يعتنون به، وعلى رأسهم طه عبد الرحمن وأحمد المتوكل، حيث تخصص الثاني في التركيبيات التداولية مشغولا بإقامة أقوى شروط للنحو العربي؛ وقد استفاد الأول من الجانب التداولي في الدرس الفلسفي والكلامي، وأسهم في وضع قواعد تداولية لهذا الخطاب الفكري، وخرج فيه بنتائج بلغت من التخصيص والتدقيق درجة لا يمكن أن يؤدي إليها المنهج التاريخي الذي غلب على الدرس التراثي الإسلامي العربي وحده.
2. جدة نتائج المنهج التداولي
وتظهر جدة النتائج التي تتوصل إليها المقاربة التداولية من جهتين؛ جهة الشكل، وجهة المضمون. أما من جهة الشكل فقد تولدت هذه النتائج بطريق مضبوط ومنسق، إذ أنشئت أنموذجات خطابية مبنية بناء نظريا متكاملا وموفية بشرط الكفايتين: الأضعف وهي الكفاية الوصفية، والأقوى وهي الكفاية التفسيرية؛ بمعنى أن الأحكام والدعاوي البلاغية والأصولية في سياق التداوليات تخرج عن وصف الانعزال والتفكك والتعسف الذي كانت عليه قبل هذا السياق إلى وصف الترتيب والتعليل والتنسيق. وأما من جهة المضمون فتتصف هذه النتائج بصفات ثلاث هي:
. التحصيل؛ حيث أسهمت الأنموذجات التداولية في الكشف عن حقائق لم يسبق إليها في ميدان البلاغة والحجاج.
. التقويم؛ إذ مكنت هذه الأنموذجات من تجديد النظر في الأبحاث البلاغية والأصولية السابقة، وذلك بالوقوف عند مسائلها التي تستحق الدمج والصوغ، وبمراجعة بعض مسائلها الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من إحكام الوصف أو إحكام البناء.
. التوسيع؛ لما تعدت فائدة هذه النتائج الإطار التقليدي للبلاغة والحجاج إلى قطاع أوسع من الخطاب الطبيعي، بحيث إن الآليات البلاغية والحجاجية المثبتة في الأنموذجات التداولية ليست صالحة لوصف أساليب اصطناع التحسين الكلامي وتَعَمُّلِ بديع التأثير على مستوى معين من مستويات الخطاب فحسب، بل أيضا صالحة لوصف مختلف أساليب الإبلاغ والتبليغ ومختلف طرق الإقناع والاقتناع في كل مستوى من هذه المستويات[2].
ثانيا: علاقة النحو العربي باللسانيات بين المواكبة والتجاوز
هناك موقفان من علاقة النحو العربي باللسانيات؛ موقف يدعي تجاوز اللسانيات للنحو العربي، وإمكان الاستغناء عنه، وموقف مناقش يرى كفاية النحو، وعدم الحاجة إلى اللسانيات.
ومن المسلم به أن يؤدي ظهور اللسانيات الحديثة وتطور مناهجها النحوية إلى اتخاذ مواقف من النحو العربي في سياق هذه المستجدات اللغوية، وأن يقتضي تقويما للنتائج النظرية والعملية لكل موقف:
1. التحقق بشروط التحاكم والمعايرة بين النحو العربي واللسانيات الحديثة
وبما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصوره فرع عن وجوده، إذا استفدنا من المنطقيين، فإننا نبادر إلى القول: لئن كان للجدة من جهة، وللتنوع من جهة أخرى، بما اتصفت بهما اللسانيات الحديثة، أثرا كبيرا في استرعاء انتباه الباحثين العرب إليها؛ فمن الطبيعي أن يحاول بعضهم عرض جوانب من النحو العربي على محك هذه المناهج المستحدثة، وأن يسعى إلى تقويم آلياته الإجرائية بحسبها. لكن مشروع معايرة النحو العربي باللسانيات الحديثة يقتضي شروطا لابد من استيفائها وإلا خلا هذا المشروع من كل فائدة علمية.
ومن هذه الشروط إحاطة الباحث اللغوي إحاطة كافية بالأنموذجات النظرية اللسانية تركيبا وتصنيفا. وبالأصول النظرية، المنطقية منها والرياضية، التي قامت عليها هذه المناهج التي تتطلب تكوينا نظريا في غاية المتانة والتعمق. وعدم الاكتفاء بالمحاكاة الآلية للأنموذجات اللسانية الموجودة، بل يجب أن يكون قادرا على اصطناع أنموذجات من عنده مستوفية للشروط النظرية ومضاهية للأنموذجات المنقولة عن الغرب.
فضلا عن العلم بالنحو العربي والتمرس بأدق آلياته الوصفية والتحليلية، والتحقق من أسبابه التاريخية وشرائطه النظرية. وما لم يستجب لهذه المعايير فلا ثقة بأقواله ولا بأحكامه، لا بصدد ما ينقله على لسان الغرب، ولا بصدد ما يثبته عن لغويي العرب. وإذا التزمنا هذه المعايير في تقويم المواقف التي اتخذت من التراث النحوي، فسوف نجد أن أصحاب هذه المواقف لمّا يكتمل عندهم تحصيل هذه الشروط، كلا أو جزءا إلا قليلا.
2. التوسط بين الادعاءين
لذلك فالادعاء بأن النحو العربي قد نفدت طاقته التجديدية، وأنه يجب الاستغناء عنه باللسانيات الحديثة قول لا مسوغ له، فضلا عن أن صاحب هذه الدعوى يغفل حقيقة أن المقدرة النظرية والمنهجية التي كانت للنحاة العرب القدامى تفوق بكثير مقدرة اللغويين العرب المحدثين، على الرغم من طول الأمد بيننا وبينهم، واستحداث آليات وتقنيات متعددة في الدرس اللغوي خلال هذا الأمد الطويل.
أما الادعاء المقابل، وهو أنه يجب الاستغناء بالنحو العربي وحده والصد عن المناهج اللسانية الحديثة، فإن كان المفهوم منه هو ضرورة اجتناب تسليط أساليب اللسانيات العربية على النحو العربي، والتطبيق الأعمى للمناهج المستحدثة عليه، والخروج منهما بأحكام عامة وجازمة على التراث النحوي اللغوي، فهو مسلم به، ولا ينازع فيه إلا معاند؛ وإن أريد بهذا الادعاء أن نقف عند حدود ما وضعه النحويون القدامى، مع استبعاد كل تكوين في اللسانيات الحديثة، وكل تطلع إلى معرفة مناهجها، فهو أمر من الصعب التسليم به، لما يترتب عليه من نتائج تضر النحو العربي، منها:
أن النحو العربي لا ينصر بإنكار اللسانيات الحديثة؛ فقد لا يحصل من هذا الإنكار إلا ازدياد سوء التقدير للنحو العربي متى زعم المنكر أنه موقوف وجوده وقيمته على مثل هذا الإنكار. ذلك بأن الإبعاد الكلي للمناهج اللغوية الحديثة قد يفوت على الباحث العربي فرصة اكتساب تكوين منهجي ونظري يؤهله لتجديد الاعتبار للنحو العربي، وذلك ببيان وجوه كفاية هذا النحو الوصفية والتعليلية والتعليمية أكثر مما لو بقي يقلب وجوها من هذا النحو من غير هذا التكوين النظري.
ثم إن عدم إحاطة الباحث المناصر للتراث النحوي بإمكانات اللسانيات وحدودها يجعله غير قادر على رد التحامل على النحو العربي من لدن الخصم، وعاجزا عن تحصيل التصديق والثقة في كلامه لدى جمهور الباحثين المهتمين، ولاسيما امتياز الخصم بامتلاك الجديد من لسانيات وغيرها، مما يعتبر أقوى إغراء وفتنة للنفس من القديم، ولو كان النحوَ العربي[3].
ثالثا: قيمة التراث العربي في البلاغة والأصول
1. النهج التداولي للتراث البلاغي والأصولي
يتبين لكل من بحث في التراث البلاغي والأصولي الإسلامي العربي أنه ينهج نهجا تداوليا؛ وأشير فقط إلى السكاكي والجرجاني وغيرهما، ممن أخذ بأسباب المقام ومقتضيات الأحوال أو السياق في المقاربة البلاغية؛ وموقع العلاقات بين المتكلم والمخاطب في أصول الدين وأصول الفقه، هذه العلاقات التي اتخذت فيها شكل آليات الادعاء والاعتراض، وقد عمل طه عبد الرحمن في كتابه "في أصول الحوار وتجديد علم الكلام" على استخراج بعض القوانين التداولية لهذه الآليات؛ أما عن الوجوه السليمة في التعامل مع التراث البلاغي والأصولي، ففي رأيه أنه لابد للباحث إن شاء أن يستقيم له هذا التعامل من سلوك مراحل:
ـ التخلص من الأحكام المسبقة والجاهزة والفضفاضة التي تعود الباحثون المتساهلون إصدارها ونشرها بين جمهور المهتمين والتعلل بها كلما مالت أنفسهم إلى اتخاذ موقف ذاتي من هذا التراث، أخذا به أو نبذا له.
ـ والتخلي عن تقسيم التراث البلاغي والأصولي إلى "مناطق" أو "قطاعات" متمايزة؛ قطاع مقبول يستحق الدرس، وآخر مردود لا يستحق الدرس؛ قطاع حي نربط أسباب الحياة فيه بحاضرنا، وهلم جرا؛ نظن أن هذه النظرية التجزيئية للتراث خالية من القيمة العلمية، على الرغم من ذيوعها وانتشارها بين القراء، ومن تسليم مناصري التراث ومعارضيه معا بها؛ ولا شك أن بواعثها الحقيقية هي استعجال حاجات العمل، والرغبة في اتخاذ مواقف مذهبية من التراث؛ حتى لو سلمنا بوجود عثرات وثغرات في هذا القطاع أو ذاك، ما كان ذلك ليصد الباحث عن تحقيقه والاشتغال عليه بأقصى ما يمكن من الأدوات حتى تظهر جوانبه كاملة.
ـ وتحصيل معرفة شاملة لمناهج القدماء وتكوين كاف في مناهج المحدثين في التداوليات، وإلا سقط الباحث في أحكام قادحة أو مادحة من غير سند معقول.
ـ واستخدام أنفع الوسائل المستحدثة وأنسبها في كل قسم من أقسام هذا التراث، سواء أتواتر أم لم يتواتر تعظيم قدره؛ ولما كان التراث البلاغي والأصولي متعلقة إشكالاته بالخطاب، فأنسب المناهج هو ما كان خطابيا تداوليا، أما إقحام مناهج وضعت أصلا لموضوعات غير خطابية فيه، فهو خروج عن كمال إفادته وتمام الاستفادة منه.
2. توظيف التراث البلاغي والأصولي
أما توظيف هذا التراث البلاغي الأصولي، فممكن على وجهين متفاوتين بشرطين متميزين:
الوجه الأول؛ أن نستمد من هذا التراث بعض التصورات والقواعد، فنغني بها جهازنا التداولي المستحدث، بحيث يتم تطويره أفقيا؛ وشرط هذا الوجه أن نحدد إجرائيات هذه الأدوات المقتبسة من التراث في صورة قواعد مضبوطة لمراقبة ومتابعة اشتغال هاتيك الأدوات داخل الجهاز الجديد.
الوجه الثاني؛ أن ننشئ بوساطة مقولات وقواعد مأخوذة من التراث أنموذجا تداوليا يستوعب أحدث الأدوات التداولية مع توجيهها توجيها نظريا يتناسب مع شروط التراث اللغوية والنظرية، بحيث يشكل هذا الأنموذج تطويرا عموديا لهذه الأدوات؛ وشرط هذا الوجه أن تتوفر في هذا الأنموذج المصطنع كل الشروط النظرية المعلومة في مبحث التنظير العلمي من كفاية وتنسيق واتساق وبساطة ومناسبة. ولا شك أن هذه خطوة أعلى وأبعد في التوظيف.
رابعا: المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي
يتسع المقام ليشمل مجموع الشروط الخارجية المحيطة بإنتاج الخطاب شفويا كان أم مكتوبا؛ ولتقارن بالمعجم الموسوعي المحال عليه في الهامش[4]. وكثيرا ما ارتبط "المقام" في البلاغة العربية بزيادة شرح وتحديد؛ وذلك بالحديث عن أقدار السامعين ومقتضى أحوالهم[5]، فبمثل هذا التوضيح نرتبط ارتباطا مباشرا بالخطاب الإقناعي، وهو الخطاب المقامي بالمفهوم الضيق والمحدد للمقام.
ولجلاء الصورة نشير مبدئيا إلى أن المقام يضيق حتى يقتصر على مراعاة حال المُخَاطَبِ في لحظة محددة معلومة سلفا للخطيب. ويتسع حتى يسع المجال أو الإطار الحضاري المشترك بين الناس عامة أو داخل نسق حضاري ذي طابع متميز.
ويسمى المقام الأول؛ مقاما خاصا أو خطابيا، ويسمى الثاني؛ مقاما عاما أو مشتركا بين الشعر والخطابة. والغالب على مفهومات البلاغيين حصر المقام في المقام الخطابي.
كما إنه لابد من التمييز بين المقام والسياق وذلك بحصر الثاني في العلاقات بين الوحدات اللسانية داخل التركيب: سياق كلمة أو وحدة صوتية مثلا[6]. وقريب من السياق ما يسميه بعض البلاغيين المقام الداخلي في الأدب وهو العلاقة بين الشخصيات في العمل السردي والمسرحي تمييزا له عن المقام الخارجي المرتبط بمن يستهلك ذلك الإنتاج.
وهناك أيضا تمييز لابد منه بين المستمع والمخاطب، إذ ليس كلُّ مستمع مخاطبا، وبين الإقناع والاقتناع الذاتي (...).
ولا غرو أن دراسة المقام تسهم في كشف أوجه الترابط بين أنواع الخطاب: العلمي، والإقناعي، والفلسفي، والشعري. وقد حظي المقام بعناية كبيرة في البلاغة القديمة والجديدة، وكذا في الدراسات التداولية الحديثة.
من هنا جاء الحديث عن الدرس البلاغي في القديم والجديد والتناول التداولي[7] الحديث للمقام.
خامسا: المقام في البلاغة القديمة
1. مقامات الأجناس الخطابية عند أرسطو
حين تصدى أرسطو لتنظير الخطاب الإقناعي أو الخطابة لاحظ أنه لا يمكن تصنيفها حسب موضوعاتها؛ لأنها "تقنية" تتناول جميع الموضوعات، فهو يعرفها بقوله: "يمكن أن نحد الخطابة بأنها الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان"[8]. ولم يكن أيضا من الممكن تصنيفها مسبقا حسب بنيتها، لأنها متميزة حسب ملابسات المقامات وأحوال المخاطبين.
لهذا صنف الخطابة أو جنسها حسب المخاطبين إلى ثلاثة أجناس:
ـ خطابة قضائية: وقعت في الماضي ويكون المخاطب فيها قاضيا.
ـ خطابة استشارية: يكون المخاطب فيها عضوا في جمعية يشاوره الخطيب في القضايا السياسية المستقبلية.
ـ خطابة مَحْفَلِية: تُلقى في المحافل العامة على جمهور مختلط من الناس يُنتظر منهم الاستحسان أو الاستهجان لما يسمعون. يقول أرسطو في تفريع الخطابة حسب أحوال المخاطبين منطلقا من تصوره لأطراف المقام الخطابي: "أنواع الخطابة ثلاثة تتناسب مع السامعين، لأن كل خطبة تتألف من ثلاثة عناصر: الخطيب والموضوع الذي يتناوله والشخص الذي يوجه إليه الخطاب.
أما السامع فهو بالضرورة مجرد مشاهد قاض. والقاضي إما أن يحكم على الأمور الماضية أو الأمور المقبلة، فمثلا العضو في جمعية عمومية هو حاكم (قاض) على الأمور المقبلة، والقاضي يقضي في الأمور الماضية؛ والمشاهد يحكم على مهارة الخطيب.
2. المشورية والمشاجرية والبرهانية[9]
اعتمادا على هذه المقامات الثلاثة وأنواع المخاطبين، اقترح أرسطو وسائل الإقناع المناسبة لكل مقام أو نوع من المخاطبين[10]. في ارتباط الخطابة بالمقامات المحددة ستكون أكثر ارتباطا بالواقع، إنها تنظر فيما هو واقع فعلا أو محتمل بوجه قابل للمشابهة والتمثيل (في المشاورات السياسية خاصة). ومن هنا ربما اقتربت من التاريخ في طابعه الجزئي (في تصور أرسطو)..
في حين سيقترب الشعر (في اعتماده المحاكاة ونظره إلى المحتمل) من الفلسفة التي تهتم بالكليات. "وإنما يختلف المؤرخ والشاعر في أن أحدهما يروي ما وقع، على حين أن الآخر يروي ما يجوز وقوعه، ومن هنا كان الشعر أقرب إلى الفلسفة، وأسمى مرتبة من التاريخ، لأن الشعر أميل إلى الكليات، على حين أن التاريخ أميل إلى الجزئيات[11]. غير أن ما لا يمكن دفعه هو أن الخطابة تمتد أيضا إلى منطقة الاحتمال، وتفسح للشعر مجالا، كما تعير أدواتها للفلسفة وتتداخل معها، في منطقة واسعة يكون المخاطب فيها كونيا يسمع صوت العقل أو الحس المشترك أو الحدس.
وسيلقي البلاغيون الجدد مزيدا من الضوء على هذه القضية، التي لم يطرحها أرسطو بصورة مباشرة، بل حسمها بأن بدأ كتابه عن الشعر بالحديث عن المحاكاة (الشعر يحاكي أفعال الناس)، وبدأ حديثه عن الخطابة بالحديث عن التصديقات ووسائل الإقناع والتأثير المختلفة[12]، فالشعر يحاكي، والخطابة تطلب الإقناع في كل حالة على حدة.
وتراه يحدد وظيفة الخطيب بما يغني عن أي تعليق: "عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه وما هو ممكن على مقتضى الرجحان أو الضرورة"[13]. و"مهمة الخطابة هي البحث في الأمور التي يشاور فيها، وليس لدينا عنها قواعد منظمة، وذلك في حضرة مستمعين عاجزين عن اتخاذ نظرة في أمر ذي درجات عديدة"[14].
فالشعر يندرج في المقام العام، في حين تلتزم الخطابة بالمقام الخاص (...). وقد ظل لتصنيف أرسطو سلطة في البلاغة الغربية التقليدية، وأعيد إليه الاعتبار في الدراسات الحجاجية الجديدة. وعلى الرغم من ترجمة كتاب الخطابة إلى العربية وفهمه والاستفادة منه، فإن البلاغيين العرب لم يستثمروا تقسيم أرسطو بل نزعوا إلى تصنيف البلاغة حسب موضوعاتها كما نجد عند العسكري وابن وهب[15].
سادسا: بلاغة الخطابة وبلاغة الشعر عند العرب
لم يُتناول المخاطب في البلاغة العربية في أفق التفريق بين الشعر والخطابة، تناولا تنظيريا صرفا، بل بقيت الفروق في إطار تفاخري حول اختصاص الشعر أو الخطابة ببعض المقامات. ثم نجد ،بعد ذلك، بعض الفروق الشكلية مثل اختصاص الشعر بالوزن.
قال أبو هلال رحمة الله تعالى عليه: "ومما يعرف أيضا من الخطابة والكتابة أنهما مختصتان بأمر الدين والسلطان، وعليهما مدار الدار، وليس للشعر بهما اختصاص"[16]. ولا نهتم بحديث الفلاسفة المسلمين في هذا الصدد لأنه لم يستطع الاندماج في المشروع البلاغي العربي ولم يعان إشكالاته مثل قضية الإعجاز والبديع، ولا عكف على النص العربي، وإن ناقش الفرق بين الخطابة والشعر بعمق أحيانا[17]. غير أن المتأمل لنشأة البلاغة العربية وتطورها سيلحظ كيف أدى حضور المخاطب إلى كثير من الظواهر التي تستحق التسجيل وتدعو إلى إعادة قراءة التراث البلاغي العربي ومساءلته وتصنيفه من جديد، إذ يكتشف وجود بلاغتين متمايزتين ومتكاملتين: بلاغة الخطابة وبلاغة الشعر.
1. بلاغة الخطابة البيان
إذا كان أساس الإقناع الخطابي هو مراعاة أحوال المخاطبين عند الجاحظ، فإن البيان في معناه الواسع كما يتصوره؛ "اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجابَ دون الضمير"[18]. لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام"[19].
ولذلك اشتملت أنواع الدلالة على المعاني ما هو لفظي، وما ليس لفظيا، كالإشارة والخط والعقد[20](...).
ولا نمضي مع الجاحظ إلا صفحات في "باب التبيين" حتى ينقل الكلام إلى البلاغة كأنها مرادف للبيان، لنجد بعدُ كلمة خطيب تزاحم كلمة بليغ وتخصصها.
ويعرف البلاغة باعتبارها مراعاة لشروط الخطابة بقوله: "أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح قليل اللحظ[21].
إن هذا وما يتلوه من الاهتمام بالنصوص الخطابية وأخبار الخطباء يبين بوضوح كيف أن الغاية القُصوى عند الجاحظ هي الخطاب الإقناعي الشفوي. وهو إقناع تُقدم فيه الغاية التي هي الإقناع على الوسيلة التي هي اللغة؛ وتحدد الأولى طبيعة الثانية وشكلها حسب المقامات والأحوال.
ومن الوقائع القوية الدلالة في كتاب "البيان والتبيين" صحيفة بِشْر ابن المعتمر فهي صحيفة تركز على المقام ومراعاة الأحوال، يقول: "والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يَتَّضِعُ بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال"[22].
لقد كان اقتراح الاهتمام بالمقام من لدن بِشْرٍ بدلا للطريقة العتيقة في تدريس الخطابة القائمة على تحفيظ النصوص وشرحها، لذلك قال: "اضربوا عما قال صَفحا واطووا عنه كشحا". وقال إبراهيم عندما قرئت عليه الصحيفة: "أنا أحوج إلى هذا من هؤلاء الفتيان"[23]. وهؤلاء جميعا مثل الجاحظ كرسوا جهودهم لتطوير فن الخطابة والمناظرة فاكتشفوا مرتكزه الأساس وهو مراعاة الأحوال والمقامات.
وبعد أن بلغ الجاحظ بالمقام إلى موقع الصدارة وحكمه في البلاغة جاعلا غايتَها الإفهام المتضمن للإقناع اصطدم بواقع عصره الذي شاعت فيه عاهات لغوية كثيرة جعلت الإفهام يقتضي أحيانا كثيرة الخروج عن السليقة العربية، ولذلك يعود مستأنفا الكلام ليحدَّ من طغيان المقام على السليقة العربية: "قال أبو عثمان: والعتّابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغٌ لم يعن أن كل من أفهمنا معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون، المعدول عن جهته، المصروف عن حقه، أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان، بعد أن نكون قد فهمنا عنه. ونحن قد فهمنا معنى كلام النبطي الذي قيل له: لم اشتريت هذه الأتان؟ قال: أركبها وتَلَدُ لي. وقد علمنا أن معناه كان صحيحا[24]. والمقصود أنه فتح اللام وقد كان حقها الكسر.
وبعد أن يعدد الأمثلة الدالة على أن البلاغة لا تتحقق مع مجرد الإفهام يقول: "وإنما عنى العتّابي إفهامك حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء"[25]. وهنا نجد شرط الصحة يسير جنبا إلى جنب مع شرط الإفهام، ثم يأتي شرط الجمال في المرتبة الثالثة، وفي حدود الاعتدال ومراعاة المقادير. وتراه يقول بهذا الصدد: "ويذكرون الكلام الموزون ويمدحون به، ويفضلون إصابة المقادير ويذمون الخروج عن التعديل"[26]، والمقدار مفهوم شامل لا يختص به الخطاب: "قال جعفر بن سليمان: ليس طيب الطعام بكثرة الإنفاق وجودة التوابل، وإنما الشأن في إصابة الْقَدْر"[27]. بل يمتد إلى السلوك والحياة الاجتماعية. "إن الحياء اسم لمقدر من المقادير ما زاد على ذلك المقدار فسمِّه ما أحببتَ (...) والاقتصاد مقدار، فالبخل اسم لما فضل عن ذلك المقدار"[28].
ولفلسفة المقدار والوسط سَنَدٌ من طبيعة الدين الإسلامي في نظر الجاحظ الذي يضمن كلامه أثرا دالا حين يقول: "العي مذموم، والخطل مذموم، ودين الله بين المقصر والغالي"[29].
وهناك إشارات لطيفة عنده تستثني الفن الشعري والغناء من شرط الاعتدال. قال الجاحظ: "وإنما الكرب الذي يختصم على القلوب، ويأخذ بالأنفاس النادرة الفاترة التي لا هي حارة ولا باردة، وكذلك الشعر الوسط، والغناء الوسط، وإنما الشأن في الحارّ جدا والبارد جدا"[30]. وهنا يضع الجاحظ أصبعه على جوهر الوظيفة الشعرية وهي الانزياح ومفارقة المتواضع عليه والمعيار، سواء أكان لغويا أم اجتماعيا.
ولكنه لا ينظِّر للشعر، ولو فعل ذلك لوجد في شعر معاصريه من الشعراء ما ينمي به مبدأ الإفراط الذي تبناه بالنسبة إلى الشعر، أي البديع الذي شغل طائفة أخرى من الباحثين مثل عبد الله بن المعتز والآمدي.
وقبيل الانتقال إلى الحديث عن بلاغة الشعر لابُدَّ من الإشارة إلى الدلالة الحضارية لبناء نظرية في الإقناع يكون الجمهور المخاطب فيها موضع فهم وتفهُّم وتفهيم، وهي نظرية أرادت لتعبر عن رغبة في الانتقال من المفاخرة والمنافرة والسيف إلى المحاورة والمناظرة والإقناع والاقتناع.
2. بلاغة الشعر البديع
لن ننتظر طويلا بعد البيان والتبيين للجاحظ، حتى نلتقي بمؤلف جديد متميز في بنائه ومراميه، إنه كتاب البديع لعبد الله ابن المعتز، الخالي من حديث عن المقام أو استحضار للمخاطب فأحرى اعتبارُه مقياسا لما يُنتجُ من كلام. فـ"البديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم. فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم"[31].
وقد قصر فنون البديع هنا على الشعر رغم حرصه في أول الكتاب على إيراد ما وقع منها من النثر أيضا، وحين انتقل إلى الصنف الثاني من الصور سماه محاسن الكلام والشعر. وهو الأمر الذي يؤكد إحساسه بأن صور البديع صور شعرية أصلا. وليست في النثر كما جعل الفارق كميا والواقع أنه نوعي[32]، إذ إن الشعر يحتمل درجات من الخرق والتعقيد تفوق الوظيفة الخطابية، وقد اقتصر على إيراد الصور البديعية والتمثيل لها دون مناقشة للحدود بين الخطابين الشعري والإقناعي في معالجة هذه الصور، وتبعه أسامة بن منقذ في كتابه البديع في نقد الشعر، وابن أبي الأصبع في تحرير التحبير، وابن حجة في خزانة الأدب، وغيرهم من أصحاب البديع. وحتى محاولة تجنيس البديع عند السجلماسي كانت على أُسس بنائية داخلية.
ويمكن أن نوجز القول في أن البديع نظرية شعرية تعتمد المكونات اللغوية للخطاب بقطع النظر عن المقام وأحوال المخاطبين. وهو ما يعني أن البلاغة العربية قد تشعبت منذ نشأتها إلى شعبتين: البيان أو نظرية الإقناع القائمة على المقام. والبديع أو نظرية الشعر القائمة على البناء اللغوي دون اهتمام بأحوال المخاطبين.
وكما أنكر منظرو الخطابة الإغراب والتقعر وغير ذلك مما يعوق الوظيفة الإبلاغية واستهجنوا خروج الكلام عن مقتضى الحال، لم يبال المبدعون من الشعراء باستغراب المستغربين وعجز العاجزين عن إدراك فحوى الخطاب الشعري، فحين قيل لأبي تمام: "لماذا تقول ما لا يُفهم؟". كان جوابه: "ولماذا لا تفهم ما يُقال؟".
وبالموازاة مع بلاغة المقام طرحت حركة البديع الأسئلة الشعرية التي لم تُطرح في البلاغة الغربية إلا مع الحركة الرومانسية، لارتباط مفهوم الأدب بوصفه مؤسسة بها.
وقد أسهم التأليف في البيان وبلاغة الإقناع في نماء نظرية حوارية تراعي المخاطَب استمالة وإقناعا، في حين ارتبط البديع أو البلاغة الشعرية بالجدل بين القدماء والمحدثين في مجال الإبداع اللغوي في الشعر. وإنما طرح المتلقي؛ وليس المخاطب في الشعر من زاوية مكان الفهم والتأويل، لا من زاوية مراعاة أحواله في مجال ضيق ومحدود مما يعرف بالمقام الصغير.
وقد حاول بعض البلاغيين إدماج البلاغتين فكانت النتيجة توفيقية كما هو الحال في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري الذي جمع بين حديث المقام الجاحظي وما يُلحق به من تحديد لمفهوم البلاغة، وحديث ابن المعتز عن الصور البديعية دون أن تتوفر لديه بنية نظرية في النسق والسياق. ولذلك ظهرت محاولة قدامة بن جعفر أكثر انسجاما لاعتمادها التفاعل بين المستويات التركيبية والتداولية، لوجود الأغراض الشعرية وما يناسب كل غرض من المعاني، فضلا عن الصور البديعية والبناء العروضي؛ كلٌّ ذلك في بوتقة واحدة.
3. الجرجاني من الشعر إلى الخطاب
لا مناص هنا، يقول الباحث د. محمد العمري، من اعتبار كتاب أسرار البلاغة متقدما على دلائل الإعجاز[33]. وأساس الشعرية في الأسرار المفارقة، فَـ"لن يبعد المدى في ذلك ولا يدق المرمى إلا بما تقدم من تقرير شبه بين الأشياء المختلفة (...) وإنما الصنعة تستدعي جودة القريحة والحذق الذي يلطف ويدِق في أن يجمع أعناق المتنافرات المتباينات في رِبْقَة، ويَعْقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشُبْكَة"[34].
وهنا يظهر أن الجرجاني يرى الغموض أمرا طبيعيا، ويفرق بينه حالة كونه ناتجا عن عمق التجربة والمعاناة، وبين كونه صادرا عن اضطراب الصياغة أو القصد إلى التعمية التي لا طائل وراءها، وينتهي إلى أن الناس ليسوا جميعا مؤهلين للفهم: "فإنك تعلم، على كل حال، أن هذا الضرب من المعنى كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه، ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه، فما كل أحد يفلح في شق الصدفة، ويكون في ذلك من أهل المعرفة"[35].
حتى إذا كانت الانطلاقة مع الجاحظ من الحال لبناء الخطاب، فإن الخطاب عند الجرجاني مبني عن مؤول مؤهل ذي كفاية، حيث يسبق الخطاب الشعري المقام. إذ سلك في طريق الوصول إلى صياغة نظرية الغرابة الشعرية طريقا قائما على إقصاء المستويات الدنيا من الاستعارة الضعيفة التوليد الدلالي المفارق، فرفض الاستعارة غير المفيدة معنى زائدا لأن إفادتها واحدة مباشرة، وألحق بها الاستعارة المبتذلة، ثم رتب ما سوى ذلك في درجات حسب سلم المفارقة في النوع والجنس وطبيعة العلاقات الحسية والعقلية.
ولذلك يندرج كتاب أسرار البلاغة في هموم مُنظري نظرية الانزياح اللسانية الحديثة ذات الطابع الشكلاني. ويبدو أن بوادر التحول نحو الخطاب قد ظهرت منذ الشطر الثاني من الأسرار وخاصة في حديثه عن المجاز العقلي وما يتصل به من قضايا؛ ففي هذا القسم بدأت تظهر مفهومات خطابية. بل ترى المؤلف ينص على أنه يعتمد كلام "العارفين" بـ"علم الخطابة ونقد الشعر"[36]. كما يتحدث عن "طريقة أهل الخطابة ونقد الشعر"[37]، بعد أن وعد في أول الكتاب بالحديث عن التشبيه من زاوية "من يتكلم على الشعر"[38] فقط.
فزيادة على ما تدل عليه هذه العبارات من وعي بوجود طريقتين للكلام، حسب الجنس الأدبي شعرا ونثرا، تدل أيضا على تدرجه في الحديث من زاوية شعرية إلى إدخال مفهومات الخطابة عبر النظم الذي هو مراعاة معاني النحو حسب المقاصد. يقول في دلائل الإعجاز: "وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها (...) ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض"[39].
ولنا تعقيب نختم به الورقة نكيف به استنتاجات الأستاذ العمري ومن معه عن طريق تأطير كتابي الجرجاني بما هما أهله من حيث التسلسل والاشتمال، وليس التحكم أو الإقصاء.
4. بناء السكاكي على الجرجاني
وبهذا، يقولون، وضع الجرجاني أساس بلاغة المقاصد، وهي بلاغة التخاطب التي سيعطيها السكاكي صياغة نهائية تجعل علم المعاني مركزا لها. فيتحكم في "البيان"[40] ويقصي "البديع"[41] إلى الهامش، ويسوقون قوله دليلا: "لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، وكذا مقام الكلام ابتداءً يباين مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار (...). وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر"[42]. وهو الأمر الذي لا يفي بما إليه تقصدوا.
وعلى الرغم من الصياغة اللسانية النحوية حيث يبدو الحوار بين التراكيب ومقاصد المتكلمين، فإن هذه المقاصد إنما تحدد بالتفاعل مع الطرف الآخر، ومن هنا تصنيف الخبر إلى ابتدائي يلقى إلى من هو خالي الذهن، وطلبي يُلقى إلى متحير، وإنكاري يُلقى إلى مخالف منكر[43].
ويلحظ، هاهنا، أن الصياغة السكاكية للبلاغة العربية تنحي العناصر الشعرية العربية، وتجعلها تابعة للوظيفة التواصلية، باعتبارها مجرد حلية للمعنى بعد توفر وضوح الدلالة ومطابقة المقاصد، غير أن هذا لا ينبغي له أن ينسينا طبيعة الشعر العربي القديم، فهو ذو طبيعة خطابية[44]، في كثير من أغراضه خاصة شعر المدح والصراع السياسي والاجتماعي، وهو الذي كان مهيمنا حتى نهاية القرن الأول الهجري حين بدأت حركة البديع تطرح أسئلتها الخاصة.
سابعا: المقام في البلاغة الجديدة
يتسع مفهوم البلاغة الجديدة ويضيق حسب زاوية النظر، غير أن ما لا يثور حوله خلاف هو أنها امتداد للفلسفة المعرفية الأرسطية وإعادة استثمار لاجتهادات البلاغيين القدماء في توسيع مفهوم البلاغة وربطها بعلوم مختلفة كالفلسفة، وعلم النفس، والاجتماع، والنحو (...).
ويبرز في ما يخص المقام التياران الكبيران في البلاغة الجديدة، وهما تيار نظرية الحجاج، وتيار البلاغة العامة لاشتراكهما في الاهتمام بالجانب الإقناعي، فنظرية الإقناع تنميه وتوسعه وتطوره لتدمجه في هموم البحث التداولي الحديث، والبلاغة العامة تسترجعه بعد أن ضاع منها في ظروف تاريخية غير مواتية لتطوير نظرية بلاغية. وهي حين تعيد صياغته إلى جانب الصور البلاغية النصية تتحول، أو تطمح إلى التحول، إلى نظرية ذات بعد نصي وتداولي ودلالي. ولنضع نصب أعيننا في هذا السياق شارل بيرلمان[45] باعتباره رائدا في نظرية الإقناع، وهنريش بليت وكبدي فاركا[46].
1. نظرية الحجاج
يحدد بيرلمان ظروف التقائه مع البلاغة الأرسطية في مقدمة كتابه "إمبراطورية البلاغة". لقد كان يبحث مع زميل له هو ألبريشت تيليكا عن منطق للقيم، فقادهما عمل مضن إلى نتائج غير متوقعة بتاتا، وهي عدم وجود منطق خاص للقيم من جهة، وأن ما كانا يبحثان فيه كان القول قد فصل فيه في علم شديد القدم منسي حاليا هو بلاغة فن الإقناع عند القدماء[47].
والأسئلة التي طرحها المؤلف، بعد ذلك، منها ما هو قديم مثل العلاقة بين المخاطب في الفلسفة والعلم والمخاطب في الحجاج، ومنها ما طرحته الحضارة الحديثة مثل تداخل المستمعين بشتى وسائل الاتصال، حتى في الأسئلة القديمة يبقى الطرح والمعالجة وزاوية النظر متميزة عن طرح القدماء. ليس كل من يستمع إلى الخطيب مخاطبا، كمثل رجل الأمن داخل القاعة والتقنيين.
حتى حين يوجه الكلام إلى جهة معينة، فإن ذلك لا يعني أنها مخاطبة، أو أنها المخاطبة الوحيدة كما هو الشأن في توجيه الخطاب إلى رئيس الجلسة في العادة.
إن الذي يحسم الأمر هو قصد الخطيب. فالمخاطبون "هم مجموع الناس الذين يستهدف الخطيب التأثير فيهم باحتجاجه"[48]. وهكذا يمكن أن يتسع مجال المخاطبين المحتملين ابتداء من الخطيب نفسه، حين يحاول إقناع نفسه بقضية ما، إلى الناس جميعا حيثما كانوا، وقد اعتُبرت مخاطبة الذات والاستماع إليها عند بعض الفلاسفة طريقا إلى الحقيقة كباسكال وديكارت[49].
على أن ما يميز الخطاب الفلسفي هو أنه يفترض مخاطبا كونيا، ولذلك يلجأ إلى الحس المشترك أو الحدس أو الوضوح[50] أو البداهة. في حين أن الخطاب العلمي أكثر تخصيصا لافتراض مجموعة من المبادئ والمسلمات بين المختصين في حقل من الحقول لا يجوز تجاهلها أو حتى التذكير بها. وحسب الجمهور المخاطب يفرق بين الإقناع والاقتناع باعتبار الأول صفة للخطاب الموجه إلى مخاطب كوني، أي غرض الحجاج هو الإقناع. في حين أن الفلسفة تطلب الاقتناع الذاتي.
ولم يعرض بيرلمان للخطاب الشعري وجمهوره الواقع أو المحتمل، وإن كان من المحتمل أن يكون قد فكر فيه حين تحديده لسلم وظائف الحجاج وهي: الإقناع الفكري الخالص، والإعداد لقبول أطروحة ما، والدفع إلى الفعل[51]. خاصة حين اعتبر الجنس الاحتفالي أدخل في مجال الحجاج مستشهدا بمقام التأبين، وهو أدبي يمكن أن يكون شعرا، في الإعداد للعمل[52]. غير أن هذا يبقي السؤال: إلى من يتوجه الشاعر الحديث على وجه التحديد؟ معلقا.
2. البلاغة العامة
تشير هذه التسمية إلى استرجاع البعد التداولي المقامي للبلاغة، فهي ثورة على بلاغة مختزنة/restreinte كما أسماها جيرار جنيت[53] البلاغة المختزلة التي هي بلاغة الصور البديعية[54] وهي شبيهة بالتأليف في البديع.
ويحس رواد البلاغة العامة بنشوة لأنهم يجدون في البلاغة جميع العناصر التي يمكن أن يملأوا بها الخطاطة السيميائية الحديثة في مكوناتها الكبرى: التركيب والتداول والدلالة. كما فعل هنريش بليت في "البلاغة والأسلوبية". كما يجتهدون أحيانا في تأويل عناصر المقام الخطابي لإيجاد مقامات أدبية موازية للمقامات الخطابية على نحو ما فعل كبدي فاركا الذي نقتطف فقرة دالة من حديثه عن دور المقام في الأجناس الخطابية (القضائي والاستشاري والاحتفالي) والأدبية (الغنائي والمسرحي والملمحي): "إن الأجناس الخطابية الثلاثة تمثل مقامات اجتماعية؛ أي أنها تحدد بالنظر إلى مقاييس خارجية بالنسبة إلى الخطاب، في حين أن الأجناس الأدبية تتميز في المقام الأول اعتمادا على مقاييس داخلية. ويحدد المخاطبون اختيار جنس من أجناس الخطابة، في حين تحدد الذات اختيار الجنس الأدبي"[55].
وينتهي الباحث إلى أن الفرق بين المقام الخطابي والمقام الأدبي فرق في الدرجة فقط؛ إذ "إن الأديب، شأنه في ذلك شأن الخطيب، يتوجه إلى أحد ما"[56]، وهو الأمر الذي يقتضي صياغة مفهوم للمقام الأدبي: "فالخطيب يستهدف بخطابه التدخل مباشرة في الواقع الاجتماعي، لكون خطابه جزءا من الواقع، في حين أن الكاتب يبدع إنتاجا، ولا يتدخل في الواقع إلا بشكل غير مباشر"[57].
وبقطع النظر عن المقام الداخلي المتحقق في فنون السرد والمسرح (مقام العلاقة بين الناس داخل البناء الأدبي) فإن المقام الأدبي الخارجي؛ (أي العلاقة بين الإنتاج ومتلقيه) مشابه للمقام الخطابي، وهذا ما يسمح بدراسة التشابهات. ويستند فاركَا إلى من سبقه من البلاغيين ليُطلق الحكم بشمولية المقامات الخطابية وكفايتها في دراسة الخطاب؛ وذلك حينما قال: "وحسب الدراسات (التي تناولت البلاغة) فإن الأجناس الخطابية الثلاثة تمثل المقامات الثلاثة الممكنة، بل المقامات الوحيدة الممكنة في الخطاب، أي في التواصل الشفوي الدائر بين الخطيب والمستمع"[58].
وذهب هنريش بليت بهذا الاقتناع إلى أقصى حدوده، فألحق الأغراض الشعرية بالمقامات الخطابية، وألحق بالجنس القضائي دراما النقد الاجتماعي والهجاء والتقريظ، وألحق بالجنس الاستشاري النص الإشهاري والشعر التعليمي، والموعظة والخرافة، وألحق بالجنس الاحتفالي المدح والهجاء وأدب المناسبات وقصائد الأعراس والتأبين والكتابة على القبور[59]. منبها إلى التداخل الممكن حين التعميم بين هذه المقامات.
وينطلق هنريش بليت إلى هذه الاقتراحات من استعراض مقصديات البلاغة القديمة وطابعها التداولي حيث ينتهي إلى أن "البلاغة المعيارية يمكن أن تصبح بلاغة وصفية، بل أيضا تاريخية وتأويلية تعكس بصورة نقدية وضعية تلقي الشارح للنص. إنها مؤهلة في هذه الحالة، لتكوين أسس "نظرية تداولية للنص"[60]. بل يرى، أكثر من ذلك، أن "بوسع التداولية النصية أن تأخذ من جديد، مفهوم المقام النصي، والوظائف التي تحدد المقامات وتدمج ذلك كله في أنموذج نصي وظيفي"[61].
الهوامش
[1]. سؤال اللغة والمنطق: حوار مع طه عبد الرحمن. سلسلة رسائل طابة. رقم 1. أبو ظبي: مؤسسة طابة، الإمارات العربية المتحدة. 2010م، ص5-7.
[2]. المصدر نفسه، ص7-10.
[3]. المصدر نفسه، ص10-13.
[4]. Oswald Ducrot. Dictionnaire Encyclopédie des sciences du langage. P: 149.
[5]. الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1/116، 1/92-93، 1/88.
[6]. ديكرو Ducrot، م، س.
[7]. تنظر أعمال الدكتور محمد مفتاح خاصة في كتابه تحليل الخطاب الشعري. ودينامية النص: حيث يوجد حديث عن المقصدية والتفاعل خاصة.
[8]. الخطابة، أرسطو، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ط2، بغداد 1986م، ص29.
[9]. المصدر نفسه، ص36-37.
[10]. المصدر نفسه، ص36 وما بعدها.
[11]. أرسطو، فن الشعر، ترجمة: شكري عياد، القاهرة، 1968م، ص64.
[12]. المصدر نفسه، المقدمة. والخطابة. أرسطو، م، س، المقدمة.
[13]. فن الشعر، م، س، ص64.
[14]. الخطابة، م، س، ص32.
[15]. محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، الدار البيضاء: دار الثقافة، 1986م، المدخل.
[16]. أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين. الكتابة والشعر، تحقيق: مفيد قميحة، بيروت: دار الكتب العربية، ص105-106.
[17]. ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، لبنان: دار التنوير، 1983م، ص179.
[18]. البيان والتبيين، م، س، 1/71.
[19]. المصدر نفسه.
[20]. المصدر نفسه، 1/76.
[21]. المصدر نفسه، 1/92.
[22]. المصدر نفسه، 1/136.
[23]. المصدر نفسه.
[24]. المصدر نفسه، 1/161.
[25]. المصدر نفسه، 1/162.
[26]. المصدر نفسه، 1/227.
[27]. المصدر نفسه.
[28]. المصدر نفسه، 1/203.
[29]. المصدر نفسه، 1/203.
[30]. المصدر نفسه، 1/145.
[31]. ابن المعتز، كتاب البديع، تحقيق: كراتشقوفسكي، لندن، 1935م، ص58.
[32]. محمد العمري، اتجاهات البنية الصوتية في الشعر العربي، منشورات دراسات سال، 1990م.
[33] اعتمادا على مؤثرات كثيرة منها:
أ. كون أسرار البلاغة يحصر البلاغة في اللفظ (الاستعارة والتمثيل والتشبيه)، ثم يضاف إليها النظمُ في الدلائل.
ب. الخطاب السجالي الذي يطبع الدلائل، لا يعقل أن يغيب في الأسرار نهائيا لو تأخر عن الدلائل 9.
ج. إشارته في الدلائل إلى تناول المجاز في مكان آخر، لن يكون في نظرنا غير الأسرار. انظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، بيروت: دار المعرفة، د. ت، ص53.
د. انتقاله في قضية الصور الصوتية من التأويل إلى ما يشبه التحريم.
ﻫ. توسيع المجال لتناول الكناية في الدلائل وتجنب الوعظ الحاضر في الأسرار.
[34]. عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، بيروت: دار المعرفة، د. ت، ص127.
[35]. المصدر نفسه، ص 120-121.
[36]. المصدر نفسه، ص346.
[37]. المصدر نفسه، ص348.
[38]. المصدر نفسه، ص70.
[39]. دلائل الإعجاز، م، س، ص69. انظر كيف ميز هنا بين ما سميناه مقاما، وهو المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، والسياق وهو "موقع بعضها من بعض" ويهمنا الأول منهما؛ أي المقام.
[40]. يقول: "علم البيان شعبة من علم المعاني لا تنفصل عنه إلا بزيادة اعتبار". انظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط نعيم زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية، ص162.
[41]. خصص القسم الثالث من كتاب المفتاح للمعاني والبيان وذيله بالحديث عن البديع الذي اعتبره حلية "فلا علينا" يقول "أن نشير إلى الأعرف منها"، ص422.
[42]. مفتاح العلوم، م، س، ص163.
[43]. المصدر نفسه، ص170-171.
[44]. يقول كبدي فاركَا متحدثاً عن المقامات في الأجناس الخطابية الأدبية: "ويبدو أن ليس هناك أدب أكثر مقامية من الأدب الكلاسيكي فالأديب كان يعرف جمهوره، ويقبل معاييره. إن الأمر يتعلق بالنسبة إليه بأن يُعلم ويُمتع حسب قوانين المجتمع". (ترجمة: محمد العمري، العدد الرابع من مجلة دراسات أدبية ولسانية، ص127).
[45]. من مؤلفاته المهمة في هذا الصدد: إمبراطورية البلاغة (L’empire rhétorique) مبحث في الحجاج (Traité de l’argumentation) بالاشتراك مع أولبريشت تليكا OLBRECHTS Tyleca.
[46]. هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية. ترجمة: محمد العمري، طبع بالدار البيضاء سنة 1989م. Rhétorique et littérature. كبدي فاركا. العدد 5 من مجلة دراسات أدبية تحت عنوان "المقام في الأجناس الخطابية والأجناس الأدبية".
[47]. Perlman (Ch). Empire Rhétorique. P.9
[48]. L’Empire Rhétorique. Rhétorique et argumentation. PERLMAN (CH). P. 27.
[49]. Ibid, Idem. P. 27.
[50]. Ibid, P. 31.
[51]. Ibid, P. 26.
[52]. Ibid, P. 26.
[53]. Figure 3. GERARD Genette.Coll. Poétique. Ed. Du Seuil. Paris 1972.
Librairie Philosophique. J. VRIN. Paris 1977.
[54]. لاحظ مفارقة بين ما وقع في البلاغة العربية من تغليب المقام وتقديم علم المعاني في الصياغة النهائية التي فرضها السكاكي. وما وقع في البلاغة الغربية من تغييب علم المعاني أي البعد التداولي والاقتصار على الصور البديعية؛ أي الجانب الشكلاني.
[55]. فاركا كبدي، المقام في الأجناس الخطابية والأجناس الأدبية، ترجمة: محمد العمري، مجلة دراسات أدبية ولسانية (ع.4) 1986 من كتابه Rhétorique et littérature، ص127.
[56]. المقام في الأجناس الخطابية، م، س، ص127.
[57]. نفس المعطيات، ص128.
[58]. المعطيات نفسها، ص128.
[59]. هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية، ترجمة: محمد العمري، منشورات مجلة دراسات سيميائية، فاس، 1989م. ص19-20.
[60]. نفس المعطيات، ص19.
[61]. المعطيات نفسها، ص21.