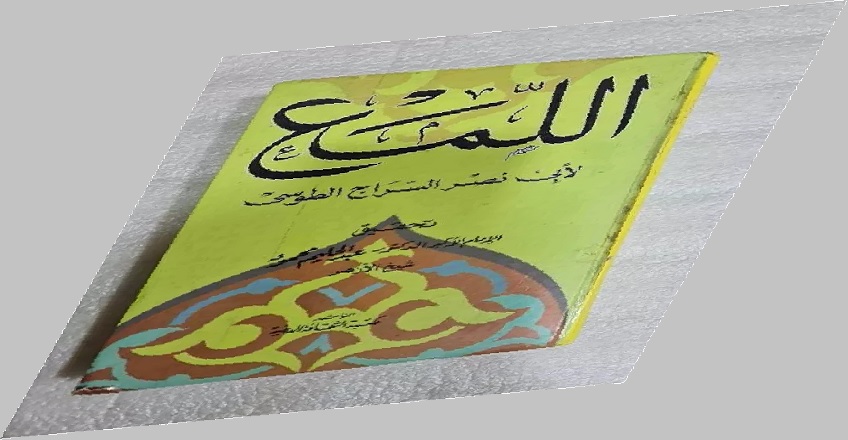تعد نظرية التلقي[1] إحدى النظريات النقدية الحديثة التي احتفت بالمتلقي احتفاء كبيرا، واعتبرته عنصرا فاعلا في عملية الإبداع الأدبي إلى جانب النص ومبدعه. فالمتلقي هو قارئ النص، وهو المستهدف به، له كتب وإليه وجه، وهو الذي يتأثر به ويتفاعل مع صوره وأخيلته، ويعيد إنتاج معانيه على ضوء قدراته الفكرية والأدبية، ومن ثم فهو ليس متلقيا فقط، وإنما هو شريك للمبدع في العملية الإبداعية.
وقولنا إن نظرية التلقي نظرية حديثة، لا يعني أن فعل التلقي يختص بالنقد والأدب الحديث دون سواه من الآداب الإنسانية الأخرى. فالتلقي فعل إنساني قديم قدم الإبداع، ولصيق به لا يفارقه، يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه، وكل عمل أدبي لا تكتمل حركته الإبداعية إلا عن طريق متلق يستقبله ويعيد إنشاءه من جديد. ولما كانت الأمة العربية قد عرفت منذ العصر الجاهلي بفصاحتها وبلاغتها، وبصناعة الأدب شعره ونثره، ولما كان التلقي لصيقا بالأدب، فإن السؤال الذي يُطرح في هذا المقام: هل عرفت ثقافتنا العربية قديما نظرية التلقي؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي خصوصية هذه النظرية في تراثنا العربي؟ وإلى أي حد اهتمت بمتلقي النص؟ وما طبيعة العلاقة التي تربط بين المتلقي والنص ومبدعه؟
في البداية أحب أن أشير إلى أنني لا أحاول من خلال هذا المقال أن ألتمس وجود هذه النظرية في تراثنا بدعوى السبق والريادة، ولكن النظرة الموضوعية إلى ما كتبه علماؤنا عند تعرضهم بالبحث والدراسة للشعر العربي والخطاب القرآني، تثبت أنهم قد عرفوا هذه النظرية، ولكن ليس بنفس مفاهيم ومصطلحات نظرية التلقي الألمانية، ولا بنفس الخلفية الفلسفية والنقدية التي ارتكزت عليها، وبحثوا قضاياها ولكن بعناوين ومسميات انبثقت من طبيعة الثقافة العربية، ومن الظرفية التاريخية التي أُنتجت فيها؛ وأنهم فعلا قد سبقوا المناهج الغربية إلى الحديث عن العلاقة الوثيقة التي تربط النص بمتلقيه[2]، وبمدى قدرة هذا المتلقي على فهم النص واستيعابه، واكتشاف ما يحمله من معان ودلالات، وما يكتنفه من قيم فنية وخصائص بلاغية. وسنحاول خلال هذا المقال أن نسلط الضوء على طبيعة هذه النظرية في التراث البلاغي العربي، والوقوف على طبيعة العلاقة التي تربط المتلقي بالخطاب وبصاحبه، سواء أكان هذا الخطاب إبداعا بشريا، أم كان كتاب الله تعالى المنزل على رسوله محمد، صلى الله عليه وسلم؛ ثم الوقوف على طبيعة هذا المتلقي الذي يوجه إليه هذا الخطاب ونخص بالذكر الخطاب القرآني الذي سعى إلى إقناع متلقيه والتأثير فيه حتى يستجيب لهديه. يقول الله تعالى: ﴿اِن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا﴾ (الإسراء: 9).
1. نظرية التلقي في التراث البلاغي العربي: البداية والتأسيس
إذا كانت الآداب الغربية القديمة قد أهملت المتلقي في تناولها للعملية الإبداعية، وأغفلت العلاقة الحميمة التي تقوم بين المتلقي ومبدع النص، والتفاعل الحاصل بين العمل الأدبي ومتلقيه، كما يذهب إلى ذلك أحد رواد نظرية التلقي الحديثة، فولفجانج إيزر حيث يقول: "بدأ التأويل في يومنا هذا باكتشاف تاريخه الخاص، ولم يكتشف حدود معاييره الخاصة فقط، بل أيضا تلك العوامل التي لم يقيض لها أن ترى النور طوال مدة سيادة المعايير التقليدية.
والعامل الأكثر أهمية من بين تلك العوامل، هو دون شك القارئ نفسه؛ أي مُخاطَبُ النص. وحيث إن نقطة الاهتمام الجوهرية كانت هي قصد المؤلف أو المعنى المعاصر النفسي والاجتماعي والتاريخي للنص، أو الطريقة التي تشكل بها النص، فإنه بدا من الصعب أن يخطر ببال النقد أن النص ليس في وسعه أن يمتلك المعنى إلا عندما يكون قد قرئ[3]"، فإنه لا يمكن أن نسقط هذا الرأي على ثقافتنا العربية القديمة، ونردد ما ذكره أصحاب هذه النظرية بأن الاهتمام بالمتلقي وقضاياه إنما هو توجه حديث، فذلك مجانب للصواب.
إن المتأمل في النقد العربي القديم والبلاغة العربية، يقف على مدى العناية التي أولاها النقاد والبلاغيون العرب للمتلقي. ولعلنا نلمس ذلك الاهتمام في أقوال العلماء المبثوثة في مؤلفات النقد والبلاغة القديمة؛ كـ"البيان والتبيين" للجاحظ، و"عيار الشعر" لابن طباطبا، و"دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني، و"منهاج البلغاء" لحازم القرطاجني. وقد تنبه هؤلاء العلماء لعدة قضايا تتعلق بالتلقي التي عالجتها نظرية التلقي الحديثة، كقضية مشاركة المتلقي المبدع في عملية إنتاج الخطاب، وقضية الأثر النفسي الذي يتركه النص في متلقيه، وكان لهم فضل السبق كما سنبين ذلك لاحقا.
ويمكن أن نقول إن نظرية التلقي في تراثنا العربي قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالخطاب القرآني؛ إذ كان لعلماء البلاغة الأوائل آراء قيمة زخرت بها كتب البلاغة ودراسات الإعجاز حول علاقة المتلقي بالإبداع عامة وبالخطاب القرآني بشكل خاص، ودوره في الكشف عن أسراره الفنية وأبعاده الجمالية، وكيفية تأثره بهذه الأسرار وتفاعله معها، ومدى استجابته لها.
لا يخفى على أحد أن القرآن الكريم كلام الله المنزل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين بلسان عربي مبين، بفضله توسعت مدارك العرب، وفي أحضانه نشأت علوم العربية خدمة له وصونا للسانه. ومن المسائل التي شغلت علماء المسلمين لاتصالها بكتاب الله العزيز، وبأصل العقيدة الإسلامية: مسألة إعجاز القرآن الكريم؛ إذ كان إثبات هذا الإعجاز هو البرهان القاطع على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
ولقد تباينت مواقف العلماء حول هذا الإعجاز: فقال بعضهم إن إعجازه يكمن في إخباره عن تاريخ الأنبياء والأمم الماضية، وفي إخباره عن أنباء الغيب التي ليست في استطاعة البشر[4]. وقال آخرون إن إعجازه يكمن في تأثيره في القلوب، واستيلائه على النفوس[5]. وذهب بعض أئمة الاعتزال إلى أنه معجز بالصرفة؛ بمعنى أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته مع قدرتهم على الإتيان بمثله[6]. وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن إعجاز كتاب الله يتحقق في بديع نظمه، وعجيب تأليفه إلى الحد الذي يعجز الخلق عن الإتيان ولو بآية واحدة تشبهه في نظمه وأسلوبه وفصاحته[7].
وقد تجند علماء المسلمين لبيان أسرار الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، فألفت التآليف والدراسات، أشهرها كتاب "النكت في إعجاز القرآن" للرماني (توفي 354ﻫ) وكتاب "بيان إعجاز القرآن" للخطابي (توفي 388ﻫ)، وكتاب "إعجاز القرآن" للباقلاني (توفي 403ﻫ) وكتاب "دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني (توفي 471ﻫ). وكلها مؤلفات وضعها أصحابها للكشف عن جمال الأسلوب القرآني، وروعة صوره، وفصاحة ألفاظه وسلامتها، وصدق معانيه وقوتها.
لقد كانت البلاغة هي الوسيلة التي استند إليها العلماء للوقوف على أسباب وأسرار الإعجاز البياني في الخطاب القرآني، ولفهم معانيه ومقاصده. وبعد أن أفاضوا الحديث عن هذه الخصائص والأسرار الفنية، توجهوا إلى الحديث عن متلقي الخطاب القرآني، وما يحدثه فيه هذا الخطاب من استجابة وأثر نفسي، كما لم يغفلوا الحديث عن أسباب هذه الاستجابة، وعن الأدوات التي يفترض توفرها لديه: من معرفة باللسان العربي وعلومه، ومن ثقافة بلاغية وخبرة جمالية؛ إذ لابد من وجود متلق بليغ ملم بأساليب البلاغة، لأن الكلام البليغ إذا ألقي إلى مخاطَب جاهل بالبلاغة لم يكن لهذا الخطاب أي تأثير لحظة تلقيه.
2. وظيفة الخطاب البلاغي: الفهم والإفهام/البيان والتبيين
العلاقة بين مبدع النص ومتلقيه علاقة وطيدة ومتينة، وهما شريكان في عملية فهم النص وإنتاج المعنى. فالمبدع ينتج النص الأدبي ويغلفه بمشاعره وأحاسيسه، وينقله إلى متلقيه بلغة موحية مؤثرة. والمتلقي يستقبل النص الأدبي، ويكشف عن أبعاده الفنية والجمالية من خلال مشاعره وأحاسيسه وبيئته الاجتماعية والثقافية. يقول فولفجانج إيزر: "إن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه، لهذا السبب نبهت نظرية الفينومينولوجيا بإلحاح إلى أن دراسة العمل الأدبي يجب أن تهتم ليس فقط بالنص الفعلي بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع النص…
ومن هنا يمكن أن نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين، قد نسميهما: القطب الفني والقطب الجمالي؛ الأول؛ هو نص المؤلف، والثاني؛ هو التحقق الذي ينجزه القارئ. وفي ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا لا للنص ولا لتحققه، بل لابد أن يكون واقعا في مكان ما بينهما... وإذا كان الموقع الفعلي للعمل يقع بين النص والقارئ، فمن الواضح أن تحققه هو نتيجة للتفاعل بين الاثنين. ولذا فالتركيز على تقنية الكاتب وحدها، أو على نفسية القارئ وحدها، لن يفيدنا الشيء الكثير في عملية القراءة نفسها[8]."
وقد تفطن علماء البلاغة العربية قديما إلى هذه العلاقة المتينة التي تجمع بين متلقي النص ومبدعه، وما تتميز به هذه العلاقة من إقناع وتأثير، وتشارك وتفاعل، وما كتبه هؤلاء العلماء من نصوص حول الأدب وأبعاده الجمالية، والقرآن وأسراره البيانية، تكشف عن وعيهم بهذه العلاقة. لقد كان هؤلاء العلماء على وعي بأن العملية الإبداعية يستوجب تحققها ثلاثة عناصر هي: المبدع والمتلقي والعمل الأدبي؛ وبمصطلح البلاغة العربية: المخاطِب والمخاطَب والخطاب الأدبي، باعتباره رسالة من المبدع (المخاطِب) إلى المتلقي (المخاطَب) في مقام أو ظرف معين، وبنظام بياني خاص هو البيان العربي.
وقد أولى علماء البلاغة اهتماما وعناية بمؤلف النص وبالمتلقي، وبينوا وظيفة كل طرف وأثره في تشكيل النص (الخطاب)، بل يمكن القول إن المتلقي في تراثنا البلاغي العربي (سواء أكان قارئا أو مستمعا) قد حظي بمكانة كبيرة فاقت مكانة المؤلف نفسه، لأن الخطاب يُكتب للمتلقي، وإليه يتوجه ويروم إفهامه وتوصيل الغرض أو القصد إليه.يقول الجاحظ: "مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام[9]."
ولحصول التأثير والإقناع والفهم والإفهام بين المبدع والمتلقي، نص علماء البلاغة على أن يأخذ المخاطِب في حسبانه إبان إنتاجه لخطابه جملة اعتبارات تتعلق بالمخاطَب والخطاب، وعلى رأسها مسألة: المقامات وما يصلح في كل مقام من خطاب، ثم مسألة المقال (الخطاب)، وما يشتمل عليه هذا المقال من لغة وأساليب وصور فنية.
أ. تصور المقام في البلاغة العربية
ومعنى المقام عند البلاغيين تلك الظروف والملابسات التي تكتنف النص ساعة أدائه، فالنص يتأثر من جهة؛ بالمبدع وبتجاربه وثقافته وما يعتريه من أحاسيس ومشاعر. ويتأثر من جهة أخرى بالمتلقي وبالظروف المحيطة به اجتماعية كانت أو سياسية أو ثقافية أو دينية. فالمبدع وهو ينتج النص يدرك أن ثمة متلق سيستقبل هذا الإبداع، وهو ملزم بمراعاة أحواله وظروفه من أجل إقناعه وإفهامه، وتوصيل المعنى المقصود إليه. يقول القزويني: "وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته[10]"؛ ويقصد القزويني بمقتضى الحال أن يخاطب المتكلم الناس على قدر عقولهم وأفهماهم، وأن يراعي في كل عمل أدبي المناسبة بين أحوال المخاطب المختلفة وموضوع الخطاب (الرسالة)، فيختار من الألفاظ أفصحها وأسهلها وأعذبها، ثم ينظمها في جمل نظما خاصا تراعى فيه قواعد النحو وأحكامه. هذه المقاييس البلاغية التي يحققها المتكلم في كلامه، هي التي تجعله بليغا فصيحا ينتهي إلى قلب المتلقي فيفهمه ويتفاعل معه.
يقول تمام حسان: "البلغاء في إطار شكلية البلاغة التي ذكرناها ربما فطنوا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية، وأنها شديدة الارتباط بثقافة الشعب الذي يتكلمها. وأن هذه الثقافة في جملتها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجتماعية المختلفة التي يسمون كلا منها (مقاما). فمقام الفخر غير مقام المدح، وهما يختلفان عن مقام الدعاء أو الاستعطاف أو التمني أو الهجاء وهلم جرا. وكان من رأي البلاغيين أن (لكل مقام مقال)؛ لأن صورة المقال تختلف في نظر البلاغيين بحسب المقام، وما إذا كان يتطلب هذه الكلمة أو تلك، وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة أو المجاز، والإخبار أو الاستفهام، وهلم جرا[11]."
وكمظهر من مظاهر الملاءمة بين المقام والمقال قسم البلاغيون الأسلوب الخبري حسب حالة المخاطب عند سماع الخبر إلى ثلاثة أنواع: ابتدائي وطلبي وإنكاري، حسب حالة المخاطَب من خلو الذهن من الحكم الذي هو مضمون الخبر، أو تردده في قبوله له، أو إنكاره له. يقول القزويني: "فإن كان المخاطَب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه، استغني عن مؤكدات الحكم، كقولك: (جاء زيد، وعمر وذاهب)، فيتمكن في ذهنه لمصادفته إياه خاليا. وإن كان متصوِّر الطرفين مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبا له، حسن تقويته بمؤكد، كقولك: (لزيد عارف) أو (إن زيدا عارف)، وإن كان حاكما بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار فتقول: (إني صادق) لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره، و(إني لصادق) لمن يبالغ في إنكاره... ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. وإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر[12]."
وكما اهتم البلاغيون بعلاقة المتلقي بالخطاب، اهتموا كذلك بمنازل المخاطَبين وأقدارهم الاجتماعية وأحوالهم الفكرية؛ لذلك وجدنا في هذا التراث دعوة صريحة لأن يكون الخطاب مناسبا لشخصية المخاطَب (المتلقي) قارئا كان أو سامعا، فلا يخاطب الطفل مخاطبة الكهل، ولا يكلم العالم بلغة الجاهل، ولا يخاطب الذكي بلغة الغبي، ولا الملوك بخطاب العامة، ولا العامة بخطاب الخاصة، فلكل فئة كلام، ولكل طبقة مقال.
يقول بشر بن المعتمر: "ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات[13]." ويقول الجاحظ: "ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والعمل عليهم على أقدار منازلهم... لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة[14]."
ولتحقيق الإبلاغ والتوصيل، أو الفهم والإفهام بين المتلقي ومبدع الخطاب، حث البلاغيون كذلك على مراعاة الحالة النفسية التي تسيطر على المتلقي لحظة استقبال الرسالة، فلا يخلط المتكلم بين أقدار الألفاظ وبين أقدار المعاني، فيتصنع الجد حيث يجب الهزل، ويدعي الفرح حيث يجب الحزن، بل لابد من تحقيق المناسبة ومراعاة الكلام للمقام الذي يرد فيه. يقول السكاكي: "لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المديح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل[15]."
ب. تصور المقال في البلاغة العربية
يرى علماء البلاغة أن بلاغة الكلام ومطابقته لمقتضى الحال الذي يرد فيه تستلزم أن يتحقق بين المبدع ومتلقي النص تناسب لغوي وبياني يسمح بتحقيق التواصل والتفاهم بينهما. فالمبدع (المخاطِب) في التراث البلاغي العربي مطالب بأن يكون فصيحا بليغا، عارفا بمقامات الكلام، وأن يخضع كلامه لجملة من المقاييس اللغوية والبلاغية، بحيث يختار موضوعاته وعباراته وألفاظه ومعانيه وأساليب نظمه، اختيارا يتناسب مع مواطن الكلام ومقتضيات الأحوال، بغية استمالة متلقيه وإقناعه. يقول بشر بن المعتمر: "وكن في ثلاث منازل: فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت. والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال[16]."
وفي المقابل فإن المتلقي (المخاطَب) مدعو أيضا بأن يكون مؤهلا لاستقبال الخطاب، بحيث يمتلك معرفة واسعة باللسان العربي ووجوه استعماله، وخبرة فنية وبلاغية تمكنه من فهم الكلام البليغ واستيعابه؛ وذلك لأن قيمة العمل الأدبي مرهونة بمدى قدرة المتلقي على فهم النص، واكتشاف ما به من أسرار فنية وجمالية يستمتع بها، ويتجاوب معها. ومن ثم فإن المخاطِب والمخاطَب في الموروث البلاغي العربي شريكان في العملية الإبداعية ويتقاسمان الفضل في إنتاج الخطاب (العمل الأدبي). يقول الجاحظ: "مدار الأمر على البيان والتبيين، وعلى الإفهام والتفهيم. وكلما كان اللسان أبين كان أحمد، كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد. والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل[17]."
وكما اعتنت البلاغة العربية بأحوال المتلقي وبأوضاعه المختلفة، اعتنت كذلك بالخطاب (العمل الأدبي). فهو يتنوع بتنوع موضوعه ومخاطَبه، ومزيته تكمن في تأثيره في نفسية متلقيه. يقول الجرجاني: "لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى، حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها[18]". وقد اشترط البلاغيون في فصاحة الكلام أن تكون ألفاظه مطابقة لموضوع الخطاب أو المعنى المقصود من الخطاب، وأن يعبر عن المعني بألفاظ تماثلها في الحسن، وتساويها في الجودة؛ فلكل نوع من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء. فسخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني، وشريف الألفاظ وكريمها، مشاكل لشريف المعاني وكريمها، والعبرة بالمعنى والمقام وأحوال المستمعين.
جاء في البيان والتبيين: "وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا ساقطا سوقيا، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا، إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم السوقي رطانة السوقي، وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات. فمن الكلام الجزل والسخيف، والمليح والحسن، والقبيح والسميح، والخفيف والثقيل، وكله عربي وبكل قد تكلموا... إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني، وقد يُحتاج إلى السخيف في بعض المواضع، وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم، ومن الألفاظ الشريفة الكريمة المعاني[19]."
وقد تنبه عبد القاهر الجرجاني إلى مستوى آخر من الملاءمة بين المقام والمقال وهو مستوى التركيب. فلكل غرض بناء لغوي يقتضيه ويستدعيه، ولكل معنى مقصود (معنى نفسي) تركيب ونظم يناسب المقام الذي يرد فيه، وطرق التعبير تختلف تبعا لاختلاف المقام ومقتضى الحال. يقول: "وإذ عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه. فاعلم أن الوجوه والفروق كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها. ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تَعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض[20].
ويوضح القزويني كلام الجرجاني وما يقصده بمطابقة النظم أو التركيب لمقتضى الحال بقوله: "فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة... وهذا، أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال، هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم حيث يقول: النظم تأخِّي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام[21]."
ج. الإبانة والإبلاغ
لما كانت غاية المرسل (المخاطِب) من الرسالة (الخطاب) إفهام المرسل إليه (المخاطَب) وإمتاعه وإقناعه، فقد حرص علماء البلاغة على أن يكون هذا الخطاب واضحا خاليا من كل تعقيد أو غموض يخل بفصاحة الكلام، ويعوق وصول الرسالة إلى المتلقي. وقد ارتبط مفهوم البلاغة عند العرب بالإبانة والإبلاغ، فبأي شيء بلغ المعنى قلب السامع وانتهى إليه وفهمه واستوعبه فتلك البلاغة. يقول الجاحظ: "فبأي شيء بلغت الأفهام، وأوضحت المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع[22]." والبلاغة عند العرب إنما سميت بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه ويستوعبه. يقول أبو هلال العسكري: "البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن[23]."
ووصول المعنى إلى القلب يعني التأثير في القلوب، واستمالة النفوس؛ ولا يكون هناك تأثير في المتلقي إلا إذا كان الكلام بليغا فصيح الألفاظ عذبا، خاليا من التكلف والتعقيد، له موقع حسن في السمع، وسهولة على اللسان؛ وهذا هو الذي عبر عنه العسكري بالصورة المقبولة والمعرض الحسن. وبهذا تتحدد وظيفة البلاغة في تراثنا العربي في كونها أداة لتوصيل وتبليغ الرسالة إلى المتلقي على نحو مقنع ومؤثر؛ وكل الأساليب البلاغية مسخرة لتوصيل هذه الرسالة والإبانة عن المعنى وتقديمه إلى المتلقي في أحسن صورة من اللفظ، ولذلك جاء تعريف الرماني للبلاغة متوافقا مع تعريف العسكري فمعناها عنده: "إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ[24]" وهو تعريف يؤكد من جهة على الوظيفة الفنية للبلاغة وقدرتها على الإبانة عن المعنى وعرضه في رداء جميل وصور بديعة، ويؤكد من جهة ثانية على الأثر النفسي الذي تتركه البلاغة في نفس المتلقي، وقدرتها على إيصال المعنى إلى قلبه وتمكينه في ذهنه. فالصورة المقبولة والمعرض الحسن شرط لفصاحة الكلام، فلا يؤلف الكلام لمجرد إفهام المعنى؛ لأنه قد يُفهم المعنى واللفظ غث مستكره ونافر متكلف، وإنما يكون الكلام بليغا لجزالة لفظه، ودقة معناه، وجودة سبكه، وحسن صياغته. يقول أبو هلال العسكري: "وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقا لم يسم بليغا وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى[25]."
وانطلاقا من هذا التصور لوظيفة البلاغة، جاء تحديد البلاغيين لعلومها. فحد علم البيان هو: "علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه[26]"، وحد علم البديع هو: "علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة[27]" من خلال هذين التعريفين نلاحظ أن الوظيفة البلاغية لعلم البيان وعلم البديع تتراوح بين تحقيق الجمالية الفنية للنص، وبين الوضوح والإبانة، وكل ذلك ليس إلا وسيلة لبلوغ غاية أساسية هي إمتاع المتلقي، وإفهامه وإقناعه.
يقول جابر عصفور: "الشرح والتوضيح خطوة أولية في عملية الإقناع... ولا يفترق ما نقصده بالشرح والتوضيح عما قصده القدماء (الإبانة) التي ردوا إليها جانبا كبيرا من بلاغة الصورة وتأثيرها، ذلك أن (الإبانة) تعني التوضيح والشرح، أو التعبير عن المعنى بطريقة تقرب بعيده، وتحذف فضوله، وتصوره في نفس المتلقي أبين تصوير وأوضحه. وذلك ما جعل البلاغيين المتأخرين من أتباع السكاكي يضعون التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز في قسم واحد من أقسام البلاغة هو علم البيان، قاصدين بذلك أن كل هذه الأنواع البلاغية للصورة إنما هي طرائق خاصة في التعبير تكسب المعاني فضل إيضاح أو بيان[28]."
وانسجاما كذلك مع هذا التصور لوظيفة البلاغة (التبليغ والإفهام)، انصرف الدرس البلاغي إلى العناية بالكلمة المفردة وبسلامة التركيب. وقد اشترط البلاغيون لفصاحة الكلمة[29] شروطا عدة منها: سلامتها من تنافر الحروف بحيث يكون تأليفها من حروف متباعدة المخارج لتكون خفيفة على اللسان وعلى السمع. وأن تكون جارية على العرف العربي الصحيح في التصريف والاستعمال: "ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من التصرف الفاسد في الكلمة[30]." وأن تكون مألوفة لدى المخَاطبين، غير متوعرة ولا وحشية بحيث لا يحتاج المتكلم إلى البحث عن مدلولها في معاجم اللغة.
أما سلامة التركيب فيتحقق بخلو الكلام من تنافر الكلمات: "فكما تكون الكلمة المؤلفة من حروف متباعدة المخارج فصيحة فكذلك التأليف. فينبغي تجنب تكرار الحروف المتقاربة في تأليف الكلام، بل إن التكرار في التأليف أقبح[31]"، ويتحقق أيضا بخلوه من ضعف التأليف، بحيث يكون الكلام جاريا على القانون النحوي العربي المشهور؛ ثم بخُلوِّه من التعقيد. ومعنى التعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به، وهو نوعان: تعقيد من جهة اللفظ، ويكون بسبب الإضمار أو تقديم الكلمات أو تأخيرها عن مكانها الأصلي، أو بسبب الفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور، ويتصل بعضها ببعض. فبكل هذه الأمور يحصل التعقيد في الكلام، ويستغلق معناه على الفهم. أما التعقيد من جهة المعنى، فهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى من المعاني فيستعمل كنايات لا يفهم المراد بها؛ أي أن انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به لا يكون ظاهرا فيلتبس الفهم على المخاطَب[32].
إن كل هذه الشروط التي وضعها البلاغيون كان القصد منها إبعاد الكلام عن الغموض والإبهام والانغلاق؛ لأن عدم وضوح المعنى وانكشافه يلغي الوظيفة الأساسية للكلام التي هي التبليغ والإفهام. يقول أبو هلال العسكري "وأجود الكلام ما يكون جزلا سهلا، لا ينغلق معناه، ولا يستبهم مغزاه، ولا يكون مكدودا مستكرها، ومتوعرا متقعرا."[33] وخلاصة القول فإن الوضوح والإبانة كانت مطلبا بلاغيا وجماليا عند البلاغيين؛ إذ كلما كانت الألفاظ عذبة وسهلة، بعيدة عن التكلف والتصنع وكان التركيب بعيدا عن الضعف والتعقيد، كلما كانت المعاني ظاهرة مكشوفة قريبة من المتلقي.
3. الخطاب القرآني وقضايا التلقي
أ. الخطاب القرآني والمتلقي
ورد مصطلح التلقي في آيات كثيرة من سور الذكر الحكيم[34]، فقد ورد إما بصيغة الفعل المبني للمعلوم (تَلَقَّى)، مثال قوله تعالى: ﴿فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ (البقرة: 36)، أو بصيغة الفعل المبني للمجهول (تُلَقَّى). مثال قوله تعالى: ﴿وإنك لتُلقى القرءان من لدن حكيم عليم﴾ (النمل: 6). وتتفق كتب معاجم اللغة على أن فعل تلقى في وضعه اللغوي يفيد: الأخذ والاستقبال والتعلم والتقبل؛ والمتلقي: المستقبل. جاء في لسان العرب: "لقي فلان فلانا لقاء ولقاءة بالمد ولُقيا ولِقيا بالتشديد... والتلقي هو الاستقبال، ومنه قوله تعالى: ﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾ (فصلت: 34) وقيل في قوله: (وما يلقاها)؛ أي ما يعلمها ويوفق لها إلا الصابر. وتلقاه أي استقبله... وقوله تعالى: ﴿اِذ تلقونه بألسنتكم﴾ (النور: 15)؛ إذ يأخذ بعضكم عن بعض... وقيل: ﴿فتلقى ءادم من ربه كلمات﴾ (البقرة: 36)؛ أي تعلمها ودعا إليها[35]."
وقد تواطأ المفسرون كذلك على تفسير مصطلح التلقي في الآيات الكريمة بمعنى الاستقبال والأخذ والتقبل والتعلم، وهي كلها مصطلحات تفيد التواصل والتفاعل بين النص والمتلقي. يفسر الطبري قوله تعالى: ﴿فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ (البقرة: 36) بقوله: "أما تأويل قوله (فتلقى آدم) فقيل إنه أخذ وقَبِل. وأصله التفعل من اللقاء، كما يتلقى الرجلُ الرجلَ مستقبِلَه عند قدومه من غيبته أو سفره. فكأن ذلك كذلك في قوله (فتلقى)، كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه أو أخبر به. فمعنى ذلك إذا: فلقَّى الله آدمَ كلمات توبة، فتلقَّاها آدمُ من ربه، وأخذها عنه تائبا، فتاب الله عليه بقِيلِه إياها، وقبوله إياها من ربه[36]."
أما قوله تعالى: ﴿وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم﴾ (النمل: 6)، فيفسره الطبري بقوله: "وإنك يا محمد لتحفظ القرآن وتعلمه من (لدن حكيم عليم) يقول: من عند حكيم بتدبير خلقه، عليم بأنباء خلقه ومصالحهم، والكائن من أمورهم، والماضي من أخبارهم والحادث منها[37]."
والمتلقِّي في الآية الكريمة (وإنك لتلقى القرآن) هو الرسول، صلى الله عليه وسلم، والمتلقَّى منه هو الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام. فالرسول، صلى الله عليه وسلم، هو المتلقي والمستقبل الأول للقرآن الكريم، وكان يملك من المؤهلات اللغوية والبلاغية ما تمكنه من تلقي الخطاب القرآني وأخذه عن الله عز وجل. يصف الجاحظ بلاغته وفصاحته، صلى الله عليه وسلم، بقوله: "وهو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة، ونزه عن التكلف... واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي... لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أوضح عن معناه، ولا أبين في فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم[38]."
لقد حرص النص القرآني منذ نزوله على قلب النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أن يخلق نوعا من التواصل والتفاعل بينه وبين متلقيه[39]، فجاء بلسان عربي مبين، وعلى معهود العرب في القول وأساليبهم في البيان. يقول الله تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون﴾ (يوسف: 2) ويقول أيضا: ﴿كتاب فصلت ـاياته قرءانا عربيا لقوم يعلمون﴾ (فصلت: 2)؛ فالغاية أن يعقلوه ويتدبروه، ويَعلموه ويفهموه حين يتلقونه بلغتهم وبلسانهم الذي يعرفون، ثم يكشفوا عن علومه وحقائقه ويظهروا بلاغته وأسرار إعجازه.
إن من يقرأ القرآن الكريم يجد أن المادة اللغوية التي يتألف منها والتي أَلِفها العرب، وأنشؤوا منها أشعارهم وخطبهم. فحروفه حروفهم، وكلماته كلماتهم، وعلى نهجهم في التأليف جاء تأليفه. لكن رغم هذا التشابه، فإن القرآن الكريم لم يكن أبدا امتدادا لكلام العرب في نظم آياته وفي اختيار ألفاظه وترتيبها، وفي التناغم والتناسب بين حروفه. فألفاظه اختيرت بدقة متناهية، ووضع كل لفظ منها الموضع الأخص والأشكل به، بحيث إذا وضع لفظ آخر مكانه جاء منه: "إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة[40]."
أما إيقاعاته الموسيقية فقد بلغت الذروة في الانسجام الصوتي سواء من حيث انسياب أجراس حروف ألفاظه، أو من حيث تناسب فقرات نظمه واتساقها مع المعاني قوة ولينا. يقول ابن قتيبة: "وجعل الله تعالى القرآن متلوا لا يُمل على طول التلاوة، ومسموعا لا تمجه الآذان، وغضا لا يخلق من كثرة الترداد[41]." أما نظمه وتأليفه فقد بلغ أرقى درجات الفصاحة والبلاغة؛ فالألفاظ القرآنية داخل الجملة أو التركيب مرتبطة بعضها ببعض في بناء متكامل يأخذ بعضه ببعض فلا يمكن "أن يؤخر ما قدم، أو يقدم ما أخر، أو يذكر ما حذف، أو يحذف ما ذكر... ولكل كلمة مع صاحبتها موقف، وكأنما لم يخلق الله لأداء تلك الدلالات غير هذه القوالب على اتساع اللغة بألفاظها وأشكالها[42]."
وهذا ما أحدث دهشة واهتزازا في نفسية المتلقي، فراح يلتمس مواطن الجمال والإعجاز في هذا الكتاب المعجز. يقول أحمد خليل: "من هنا كانت دهشة العرب عندما سمعوا القرآن ووجدوا فيه قيمة فنية لم يتح لهم أن يتصلوا بها. من هذه القيم ما يمس الصورة أو الإطار الفني الأدبي، ومنها ما يمس الفكر، ومنها ما يتصل بالتصرف في اللغة نفسها من ناحية الاشتقاق وتعدد الصيغ، ثم من ناحية التركيب واختيار الكلمات على نحو يجمع بين إثارة الوجدان والعقل معا[43]."
إن نزول القرآن الكريم بلغة العرب وبأساليبهم في البيان، ما هو إلا مظهر من مظاهر مراعاة مقام المخاطبين، فهم هدف الوحي وغايته، ومن الطبيعي أن يكون الخطاب القرآني من جنس اللغة والأساليب التي ألفها العرب. يقول الطبري: "فإذا كان كذلك وكان غير مُبين منا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطَب، كان معلوما أنه غير جائز أن يخاطِب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطَبُ، ولايرسل إلى أحد منهم رسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه. لأن المخاطَب والمرسَل إليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه فحاله، قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده، سواء؛ إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهلا[44]."
وتعد هذه المراعاة للحالة اللغوية للعرب وجها من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؛ فهو موجه لكل المخاطبين به من عامة وخاصة، ملوك وسوقة، أذكياء وأغبياء، وكل مخاطَب يفهم معانيه بقدر طاقته العلمية والفكرية واللغوية. يقول سعيد رمضان البوطي: "معاني القرآن مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على اختلاف مداركهم وثقافتهم، وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم، ومع تطور علومهم واكتشافاتهم... ولسنا نقصد أن الآية تحتمل بذلك وجهين متناقضين أو فهمين متعارضين، بل هو معنى واحد على كل حال، ولكن له سطحا وعمقا وجذورا، يتضمنها جميعا أسلوب الآية. فالعامي من الناس يفهم منه السطح القريب، والمثقف منهم يفهم معنى معينا من عمقه أيضا، والباحث المتخصص يفهم منها جذور المعنى كله[45]."
وقد اهتم الدرس البلاغي منذ نشأته ببيان العلاقة بين الخطاب القرآني ومتلقيه[46]، وما تتميز به هذه العلاقة من إمتاع وإقناع، وتأثير وتأثر؛ وما تتطلبه من معرفة بلغة العرب، وبعلوم البلاغة والبيان، مما يجعل لحظة القراءة أو الاستماع لحظة تدبر وتفكر، ولحظة تقبل واستيعاب لأسراره الإعجازية. وبناء على ذلك عد كثير من العلماء كأبي هلال العسكري، والزمخشري، وابن حمزة العلوي علم البلاغة في مقدمة العلوم التي تعين المتلقي على فهم كتاب الله، ومعرفة خصائص نظمه، وبدائع تأليفه.
يقول أبو هلال العسكري: "إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله، جل شأنه، علم البلاغة؛ إذ به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق الهادي إلى الرشد. وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة الفصاحة، لم يقم علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب، وما شحنه به من الإيجاز البديع، والاختصار اللطيف، وضمنه من الحلاوة، وجلله من رونق الطلاوة، مع سهولة كلمه وجزالتها، وعذوبتها وسلاستها، إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها، وتحيرت عقولهم فيها[47]."
وتزداد الحاجة إلى علم البلاغة كلما تباعد العهد عن الزمن الأول لمجيء الإسلام، وخاصة بعد أن كثر الأعاجم، وفشا اللحن، وضعفت السليقة العربية، يقول ابن خلدون: "وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه، وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه. فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاما في ذلك؛ لأنهم فرسان الكلام وجهابذته، والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه[48]."
لقد أدرك البلاغيون أن فهم الرسالة السماوية بعقيدتها وتشريعاتها، يتطلب تضلعا بعلوم اللغة العربية، وتذوقا مرهفا لمفرداتها وتراكيبها، وأن معرفة إعجاز القرآن، والكشف عن أسراره البيانية ودلالاته الجمالية، يحتاج إلى فطنة المتلقي وإلى خبرة أدبية، ومعرفة تامة بالبلاغة وأساليبها. ومتى توفرت هذه المعرفة، استطاع المتلقي الوقوف على التفاوت الحاصل بين الكلام الإلهي والكلام البشري شعرا كان أو نثرا.
ونتيجة لذلك عمل البلاغيون على تحليل الآيات القرآنية تحليلا فنيا وبلاغيا، يعين المتلقي على معرفة ما تفرد به النص القرآني من جمال الألفاظ، وعمق المعاني، وحسن التأليف، ودقة الصياغة والتصوير؛ إيمانا منهم بأن إدراك الإعجاز البلاغي، لا يتم إلا بواسطة استثمار المتلقي لأدواته المعرفية واللغوية من نحو وصرف وبلاغة، وبشحذ طاقته الخيالية لفهم ما توحي به الآيات القرآنية من صور فنية ودلالات بلاغية.
ولتوضيح هذا الأمر نورد نصا لعبد القاهر الجرجاني يحلل فيه قوله تعالى: ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة﴾ (البقرة: 95)، فهو يخاطب المتلقي بقوله: "إذا أنت راجعت نفسك، وأذكيت حسك، وجدت لهذا التنكير وأن قيل (على حياة) ولم يقل (على الحياة) حسنا وروعة ولطف موقع لا يُقادَر قدره، وتجدك تعدم ذلك مع التعريف، وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافها. والسبب في ذلك أن المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها، وذلك أنه لا يحرص عليه إلا الحي، فأما العادم للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة وعلى غيرها. وإذا كان كذلك صار كأنه قيل: (ولتجدنهم أحرص الناس ولو عاشوا ما عاشوا، على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهنه، حياة في الذي يستقبل)[49]."
من الواضح أن عبد القاهر الجرجاني، من خلال هذا النص، يوجه خطابه إلى متلق يفترض وجوده، ويهدف إلى التأثير فيه وإقناعه بوجهة نظره في الإعجاز القرآني الذي هو، حسب رأيه، راجع إلى النظم والتأليف[50]؛ يظهر ذلك في استعماله لضمير "أنت" (إذا أنت راجعت نفسك، وأذكيت حسك... وتجدك تعدم ذلك مع التعريف). إن الجرجاني حريص على توجيه المتلقي إلى تأمل الآية، والقرآن عموما، وإمعان النظر والفكر ليقف على أسرار الإعجاز.
فالكلام عنده سواء أكان كلام الله تعالى، أو نصوصا أدبية (شعرا أو نثرا) هو عبارة عن رسالة توجه من المرسِل إلى المرسَل إليه. وفهم الرسالة لا يتأتى إلا بتعلم البلاغة، فهو العلم الذي يمنح المتلقي القدرة على تبيُّن الفروق بين أسلوب وأسلوب، ونظم ونظم؛ وهو السبيل لفهم مواطن الإعجاز في القرآن. وقد كان عبد القاهر الجرجاني يمتلك ذوقا أدبيا رفيعا، فاستطاع أن يدرك أن امتلاك المتلقي لمؤهلات لغوية، ومهارات بلاغية لا يكفي لإدراك ما في القرآن الكريم من أبعاد فنية وخصائص جمالية، بل لابد من رجوع المتلقي إلى أريحيته وذوقه. والذوق عنده ليس عملا عفويا، بل يتحصل بطول دربة وتفكر وروية. يقول: "واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع، ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وحتى يكون ممن تحدثه نفسه بأَنَّ لِما يومئُ إليه من الحسن واللطف أصلا، وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ويُعرى منها أخرى، وحتى إذا عَجَّبته عجِب، وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كان الحالان والوجهان عنده أبدا على سواء، وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة، وإلا إعرابا ظاهرا، فما أقل ما يجدي الكلام معه. فليكن من هذه صفته عندك بمنزلة من عدم الإحساس بوزن الشعر والذوق الذي يقيمه به، والطبع الذي يميز صحيحه من مكسروه[51]."
نخلص من حديثنا عن علاقة المتلقي بالخطاب القرآني بالقول إن هذه العلاقة هي علاقة إقناع وإمتاع، وتفاعل وتشارك. فالمتلقي سامعا كان أو قارئا مدعو أن يتلقى القرآن ويتدبر آياته ويمعن النظر في معانيه ويغوص في مقاصده، ويكون له استعداد نفسي للاستجابة لأوامره، والامتثال لنواهيه. يقول جل وعلا: ﴿كتاب اَنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا ءاياته وليتذكر أولو الاَلباب﴾ (ص: 28)، ويقول أيضا: ﴿أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب اَقفالها﴾ (محمد: 25).
ب. الخطاب القرآني وعملية التأثير في المتلقي
تفطن علماء البلاغة والإعجاز منذ وقت مبكر من تاريخ البلاغة العربية إلى التأثير النفسي الكبير الذي يتركه الخطاب القرآني في نفوس متلقيه، سواء أكان هذا المتلقي قارئا أو سامعا، وسواء أكان مؤمنا به أو جاحدا، واعتبروا هذا التأثير من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. يقول محمد الخطابي: "قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا إلا قرع السمع خَلُص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور... تقشعر منه الجلود، وتنزع له القلوب، يحول بين النفوس ومضمرتها وعقائدها الراسخة فيها[52]."
إن قولة الخطابي، هذه، تضع أيدينا وتوجه أبصارنا إلى أمر مهم وهو الأثر النفسي القوي الذي يحدثه القرآن الكريم في نفوس متلقيه، حيث تنشرح له الصدور وتستبشر به، وترق له القلوب وتنقاد له صاغرة طائعة مستسلمة، وتفيض العيون بالدموع خشية منه تعالى، ورغبة فيما عنده. وكل هذه المشاعر تدل على تلك القوة الخفية والعجيبة المودعة في هذا القرآن؛ إذ تفعل فيه الكلمة والتركيب فعل السحر في نفوس المتلقين، فيذعنون لأمره ويعترفون بفضله وإعجازه.
وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن صنيع القرآن في نفوس المتلقين فقال: ﴿الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ (الزمر: 22) يصف سيد قطب تأثير القرآن الكريم في متلقيه قائلا: "إن في هذا القرآن سرا خاصا يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء، قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن. يشعر أن هناك شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير، وأن هناك عنصرا ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن، يدركه بعض الناس واضحا، ويدركه بعض الناس غامضا. ولكنه على كل حال موجود. هذا العنصر الذي ينسكب في الحس ويصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أم هي هذه العناصر كلها مجتمعة؟ ذلك سر مودع في كل نص قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء، ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله[53]."
ولقد كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، المتلقي الأول للقرآن الكريم، أكثر الناس تأثرا بهذا الكتاب المعجز؛ إذ كان يتأثر وهو يتلو القرآن، ويتأثر وهو يسمع القرآن، يظهر ذاك التأثر في تلك الطمأنينة التي كانت تداخل قلبه، صلى الله عليه وسلم، وتزيده إيمانا بربه وبرسالته، وفي تلك الدموع الغزيرة التي كانت تذرفها عيناه الشريفتان. ومن الأمثلة على تأثره وبكائه لسماع القرآن ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقرأ علي)، قلت: (أقرأ عليك وعليك أنزل؟) قال: (نعم، إني أشتهي أن أسمعه من غيري)، قال: فقرأت النساء حتى بلغت ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا﴾ (النساء: 41)، فقال لي: (كف أو أمسك)، فرأيت عيناه تذرفان[54]."
وقد كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، يدرك هذا التأثير العجيب الذي يتركه القرآن في نفوس متلقيه، فكان، عليه السلام، يحرص على قراءته على كل من يعرض عليهم الإسلام؛ لأنه السلاح الحاسم في تحويل المتلقي من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى. وتروي لنا كتب السيرة وكتب الإعجاز أن جماعة من المسلمين قد أسلموا عند سماعهم لآيات من الذكر الحكيم، وذلك كما وقع لجبير بن مطعم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما[55].
وقد استمع المشركون للقرآن الكريم، فسحرهم ببلاغته وفصاحته، وأيقنوا أن لهذا القرآن فعل السحر على نفوس متلقييه، وأن سلطانه قاهر على قلوبهم لأنهم كانوا أكثر الناس علما بأسلوبه البديع، ونظمه العجيب، فكانوا يصدون الناس عن الاستماع إليه أو الاقتراب من قارئه. وقد سجل القرآن الكريم ذلك فقال على لسان هؤلاء المشركين: ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ (فصلت: 25)؛ فالآية تصور تحير العرب، وعجزهم أمام هذا الكتاب الذي فرق جمعهم وكلمتهم، وأربك حياتهم، فاتفقوا على أن لا يسمعوا القرآن، ويمنعوا غيرهم من سماعه، خوفا من أن يستميل قلوبهم، ويستولي على نفوسهم، ويسيطر على مشاعرهم، فيؤمنوا به ويستجيبوا لهديه.
يفسر سيد قطب الآية السالف ذكرها بقوله: "كلمة كان يوصي بها الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون بها الجماهير؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير (لا تسمعوا لهذا القرآن). فهو كما كانوا يدعون يَسحرهم، ويغلب عقولهم، ويفسد حياتهم، ويفرق بين الوالد وولده، والزوج وزوجه. ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان الله بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال. كان يستخلص القلوب له، فلا تحفل بوشيجة غير وشيجته، فكان هو الفرقان. والغوا فيه لعلكم تغلبون) وهي مهاترة لا تليق، ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان[56]."
ثمة شيء يجب ألا نغفله عند حديثنا عن الخطاب القرآني وقوة تأثيره في متلقيه. فلهذا الأخير دوره البارز في مسألة التأثير هاته. فكلما كان المتلقي مؤمنا بالرسول الكريم وبرسالته، كلما كان تأثير الخطاب القرآني أقوى وأشد. وكلما كانت استعداداته النفسية مهيأة لاستقبال المؤثرات القرآنية كان ذلك أدعى للتأثر بما يسمعه أو يقرأه. ويُبين ابن قيم الجوزية أسباب استجابة المتلقي للقرآن الكريم وانتفاعه بقوله: "إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال تعالى: ﴿اِن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اَو اَلقى السمع وهو شهيد﴾ (ق: 37).
وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض، ومحل قابل، وشرط لحصول التأثير، وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه، وأدله على المراد... فقوله تعالى: (إن في ذلك لذكرى) إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله: (لمن كان له قلب) فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله... وقوله (أو ألقى السمع)؛ أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله (وهو شهيد)؛ أي شاهد القلب حاضر غير غائب...
فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو انشغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر[57]."
فكلما تفتح القلب، وارتقت حاسة الإصغاء والإنصات لكتاب الله، كلما كان التأثر والانتفاع بالقرآن أكثر وأعظم. ولا يتحقق هذا التأثر إلا إذا استشعر المتلقي حقيقة القرآن الكريم، وأنه كلام الله المنزل على رسوله محمد، صلى الله عليه وسلم، واستشعر عظمة المتكلِّم به وهو رب العالمين. فإذا استشعر المتلقي هذه المعاني اللطيفة، واستشعر الرغبة في التقرب منه تعالى، كان على أتم استعداد بقلبه وعقله وجوارحه لاستقبال القرآن وتدبره، وكان شأنه مع القرآن شأن التربة مع الغيث، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: "إن مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير[58]." فكما أن الغيث يحيي الأرض الميتة فتظهر فيها الأزهار والأشجار والكلأ والعشب الكثير، فكذلك القرآن يحيي القلوب الميتة الغافلة.
ويمكن أن نحدد بعض مظاهر تأثير القرآن الكريم في نفوس متلقيه من خلال تتبعنا لبعض آيات الذكر الحكيم التي عبرت عن ذلك وأظهرته:
أولا؛ وجل في القلوب. يقول الله تعالى: ﴿إنما المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون﴾ (الأنفال: 2). ثانيا؛ اطمئنان في القلوب. يقول الله تعالى: ﴿الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ (الرعد: 29). ثالثا؛ قشعريرة الجلود يقول الله تعالى: ﴿الله نزَّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ (الزمر: 22). رابعا؛ فيض من الدمع. يقول الله تعالى: ﴿قل ـامنوا به أو لا تومنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاَذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للاَذقان يبكون ويزيدهم خشوعا﴾ (الإسراء: 107-108).
نخلص من حديثنا عن قضية التأثير والتأثر بين الخطاب القرآني ومتلقيه بإيراد نص لسيد قطب يشرح فيه هذا التأثير الغريب، والاستحواذ العجيب للقرآن على نفوس متلقيه بقوله: "فهو التأثير الذي يلمس الوجدان، ويحرك المشاعر ويفيض الدموع، يسمعه الذين تهيؤا للإيمان، فيسارعون إليه خاشعين، ويسمعه الذين يستكبرون عن الإذعان فيقولون: ﴿إن هذا إلا سحر مبين﴾ (هود: 7) أو يقولون ﴿لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ (فصلت: 25) (فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون أو يشعرون)[59].
خاتمة
ننهي حديثنا عن نظرية التلقي في التراث البلاغي العربي بالقول إن هذا التراث يحتوي على كثير من الممارسات النقدية التي توصل إليها الدرس النقدي الحديث. وبتعميق البحث في هذا التراث ندرك أن نظرية التلقي لها جذور في تراثنا البلاغي، لكنها ليست انعكاسا لنظرية التلقي الحديثة، فهي تمثل الفهم العربي لنوعية العلاقة بين المرسل (المخاطِب) والمرسل إليه (المخاطَب) والرسالة (الخطاب). هذا الفهم الذي يستمد خصوصية من السياق التاريخي الذي أنتج هذه النظرية، ومن طبيعة النصوص التي اعتمدها البلاغيون العرب.
فإذا كانت القراءة هي المحور الاساسي عند منظري نظرية التلقي الحديثة، والنصوص التي اعتمدتها إبداعات بشرية، فإن نظرية التلقي العربية قامت على السماع أولا ثم القراءة ثانيا، ومن ثم فإن المتلقي في هذه النظرية هو القارئ والسامع على حد سواء. أما النصوص التي ارتكزت عليها فهي نصوص أدبية (شعرية ونثرية) إلى جانب الخطاب القرآني، وهو خطاب له خصوصيته التي لم يغفلها علماء البلاغة، فهو كلام الله أولا، أوحى به إلى نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو نص بلاغي ثانيا أعجز الخلق جميعا بنظمه وبلاغته التي تجاوزت كل الطاقات الأدبية البشرية.
إن حماس النقاد العرب اليوم لنظرية التلقي الغربية لا يجب أن يحجب عنا تلك الآراء النقدية الرائدة التي كانت لعلماء البلاغة قديما. فالمتلقي لم يكن أبدا غائبا عن وعي العلماء في التراث البلاغي العربي، بل كان له حضوره المتفاعل مع النص. لقد تنبه البلاغيون منذ وقت مبكر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط المتلقي بمؤلف النص، فالمؤلف ينتج النص، والمتلقي يكشف عن جمالياته ويعيد إنتاج معانيه وصوره على ضوء ثقافته وأحاسيسه. وهذا يدل على تكامل نظرة الدرس البلاغي العربي القديم إلى طرفي العملية الإبداعية، فالمبدع والمتلقي شريكان في إنتاج النص وصياغة معانيه، وكل عمل أدبي يحتاج لكي يتحقق وجوده إلى مُرسِل فصيح بليغ، عارف بمقامات الكلام، ومُرسَل إليه، له مؤهلات فنية ولغوية تمكنه من فهم النص والاستمتاع به. وبذلك تتحقق العلاقة التكاملية بين منتج الخطاب ومتلقيه.
الهوامش
[1]. ظهرت نظرية التلقي في نهاية سنوات الستين من القرن العشرين عل يد الناقدين الألمانيين: هانس روبرت ياوس (hans Robert jauss) وفولفجانج إيزر(wolfgang Iser). وتهدف هذه النظرية إلى إعادة الاعتبار إلى المتلقي(قارئ النص)، وإعطائه مكانة متميزة ضمن العملية الإبداعية، بعد أن أهمل من لدن كثير من المدارس النقدية الغربية التي جعلت السلطة الأدبية كلها للنص ومؤلفه. فالعمل الأدبي حسب هذه النظرية لا يمكن أن يتحقق له وجود دون قارئ يقرؤه ويتفاعل معه نفسيا وذهنيا.
[2]. استعمل النقد العربي القديم والبلاغة العربية خاصة مصطلح المخاطب أو السامع أو الجمهور عند حديثه عن المتلقي. لكن عدم استعمال النقاد والبلاغيين مصطلح المتلقي في خضم حديثهم عن القضايا النقدية والبلاغية المتعلقة بالمتلقي، وكيفية استقباله للنصوص الأدبية، ومدى تأثره بها، وتفاعله معها، لا ينفي وجود هذه النظرية في الموروث النقدي والبلاغي العربيين كما سنبين ذلك لاحقا.
[3]. فولفجانج إيزر، فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب (في الأدب). ترجمة: حميد لحمداني، الجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، ص11.
[4]. ينظر: علي بن عيسى الرماني: النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، مصر: دار المعارف، ط4، ص110.
[5]. ينظر: محمد الخطابي، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق، محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، مصر: دار المعارف، ط4، ص70.
[6]. ينظر: الرماني، النكت في إعجاز القرآن: م، س، ص110. وينظر أيضا: أبو عثمان الجاحظ: الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت: دار إحياء التراث العربي/لبنان. ط3، (1388ﻫ/1969م)، 4/89.
[7]. ينظر: الخطابي، بيان إعجاز القرآن، م، س، ص72. وينظر أيضا: محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن. تحقيق: أحمد صقر، مصر: دار المعرفة، ط5، ص35.
[8] . فولفجانج إيزر، فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب (في الأدب)، م، س، ص10.
[9]. أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق فوزي عطوي، بيروت: دار صعب، ط1، 1968، 1/54-55.
[10]. الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط1، (1424ﻫ/2003م)، ص20.
[11]. تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الدار البيضاء: دار الثقافة، ص337.
[12]. القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، م، س، ص28-29.
[13]. الجاحظ، البيان والتبيين، م، س، 1/ 87-88.
[14]. المصدر نفسه، 1/64.
[15]. أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، بيروت: منشورات دار الكتب العلمية/لبنان، ط1، (1420ﻫ/2000م)، ص256.
[16]. البيان والتبيين، م، س، 1/86.
[17]. المصدر السابق، 1/21.
[18]. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، م، س، ص258.
[19]. البيان والتبيين، م، س، 1/90-91.
[20]. دلائل الإعجاز، م، س، ص87.
[21]. القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، م، س، ص20.
[22]. البيان والتبيين، م، س، 1/55.
[23]. أبو هلال العسكري، الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق محمد مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، ط1، (1401ﻫ/1981م).
[24]. الرماني، النكت في إعجاز القرآن، م، س، ص75.
[25]. أبو هلال العسكري، الصناعتين، م، س، ص19.
[26]. القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، م، س، ص163.
[27]. المصدر السابق، ص255.
[28]. جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط2، 1992، ص332-333.
[29]. رد ابن سنان الخفاجي فصاحة الكلمة إلى ثمانية أمور هي: أن تؤلف الكلمة من حروف متباعدة المخارج حتى لا تثقل على اللسان، وأن نجد لتأليف اللفظ في السمع حسنا ومزية على غيرها، وأن تكون غير متوعرة وحشية، وأن تكون غير ساقطة عامية، وأن تكون جارية على العرف العربي الصحيح، وألا يكون معناها اللغوي القديم قد هجر وأصبحت تدل على شيء كريه،وأن تكون معتدلة غير كثيرة الحروف، وأن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر به فيه عن شيء لطيف. ولم يقصر ابن سنان الكلام على اللفظة المفردة، ولكنه تجاوزها إلى الحديث عن فصاحة التركيب؛ أي تركيب الكلمات داخل النظم والتأليف. ينظر: ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط1، (1402ﻫ/1982م)، ص64 وما بعدها.
[30]. عبد العزيز عبد المعطي عرفة: قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية، عالم الكتب، ط1، (1405ﻫ/1985)، ص468.
[31]. أحمد بدوي، البيان العربي: دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط3، (1381ﻫ/1961م)، ص157
[32]. القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، م، س، ص17.
[33]. أبو هلال العسكري، الصناعتين، م، س، ص81.
[34]. ينظر سورة: (ق:18)، (النور:15)، (البقرة:37)، (الفرقان:75)، (فصلت: 35)، (النمل: 6)، (القصص: 80).
[35]. أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب: مادة (لقي)، بيروت: دار صادر/لبنان، 15/253.
[36]. محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، (1420ﻫ/2000م)، 1/541.
[37]. محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، م، س، 19/426.
[38]. الجاحظ، البيان والتبيين، م، س، 2/221.
[39]. ما يميز نظرية التلقي الحديثة أنها تركز على عملية القراءة، ومن ثم فالمتلقي هو قارئ النص. أما ظاهرة التلقي عند العرب فهي ظاهرة قامت على السماع أولا ثم القراءة ثانيا. ولذلك فعندما نتحدث عن متلقي القرآن فإننا نقصد القارئ والسامع معا. فالسامع يستمع إلى القرآن يرتل، فيتأثر به ويستجيب له كما قال الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (الأعراف: 204). فالقراءة والاستماع طريقتان في التلقي لازمتا النص القرآني منذ نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
[40]. محمد الخطابي، بيان إعجاز القرآن، م، س، ص27.
[41]. أبو محمد مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: أحمد صقر، القاهرة: دار التراث، طذ2، (1393ﻫ/1973م).
[42]. أحمد جمال العمري، مفهوم الإعجاز القرآني حتى نهاية القرن السادس الهجري، مصر: دار المعارف، 1984 ص295.
[43]. السيد أحمد خليل، دراسات في القرآن، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر/لبنان، 1969، ص35.
[44]. الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، م، س، 1/11.
[45]. سعيد رمضان البوطي، أحسن الحديث، الناشر: المكتب الإسلامي دمشق، السنة: 1968، ص101.
[46]. لم تغفل البلاغة العربية الإشارة إلى أن النص القرآني هو وحي من الله، وهو كلام الله أولا ونص بلاغي ثانيا، له خصوصياته الفنية التي لا تضاهيها نصوص أدبية أخرى. فمصدر الرسالة هو الله تعالى، ومتلقيها هو الإنسان، وهذا الإنسان مدعو أن يقرأ القرآن ويستمع إليه و ويتعرف على إعجازه. وهذه المعرفة هي السبيل إلى الإيمان بالله تعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
[47] أبو هلال العسكري، الصناعتين، م، س، ص9. وينظر أيضا: جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الناشر: بيروت: دار الكتاب العربي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طبع سنة، 1407ﻫ، 1/1. وينظر أيضا: يحيى بن حمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ( 1400ﻫ/1980م)، 1/22.
[48]. عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، المقدمة، بيروت: دار الجيل/لبنان، مؤسسة خليفة للطباعة، ص611.
[49]. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، م، س، ص288.
[50]. ربط عبد القاهر الجرجاني الإعجاز بالنظم، والنظم عنده هو توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم. يقول: "اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها" دلائل الإعجاز، م، س، ص81.
[51]. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، م، س، ص291.
[52]. محمد الخطابي، بيان إعجاز القرآن، م، س، ص70.
[53]. سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط10، (1401ﻫ/1981م)، 6/3399
[54]. رواه البخاري في صحيحه، باب: البكاء عند قراءة القرآن، برقم 4768/4769
[55]. محمد الخطابي، بيان إعجاز القرآن، م، س، ص70.
[56]. سيد قطب، في ظلال القرآن، م، س، 5/ 3120.
[57]. ابن قيم الجوزية، الفوائد، تحقيق: حامد أحمد الطاهر، القاهرة: دار الفجر للتراث القاهرة، ط2، (1431ﻫ/2010م)، ص9-10.
[58]. رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب: (بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، برقم: 2282. والبخاري في كتابه: العلم، باب: (ضل من علم وعلم) برقم: 79.
[59]. سيد قطب: التصوير الفني في القرآن، بيروت: دار الشروق، طبعة (1412ﻫ/1992م)، ص16.