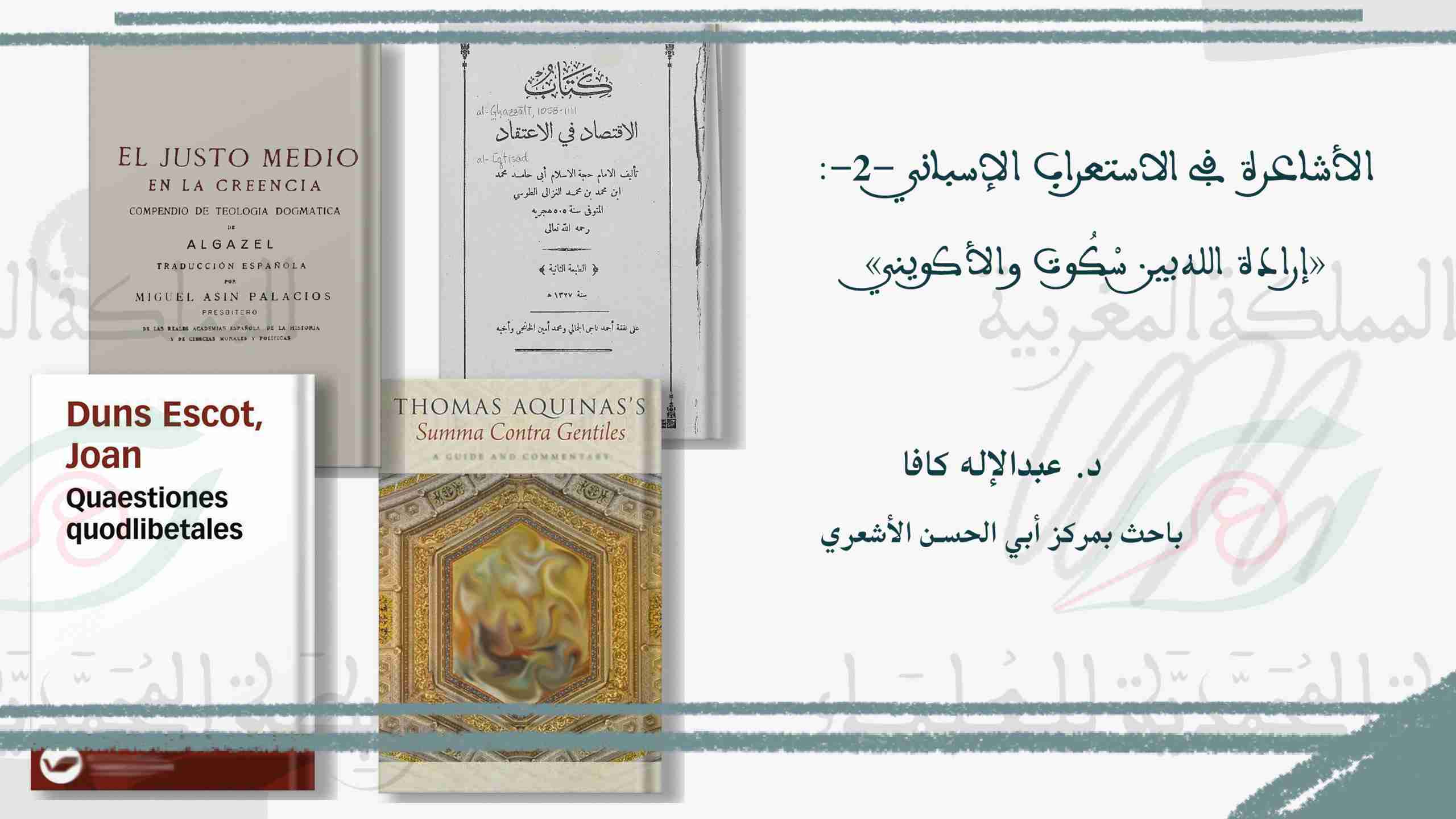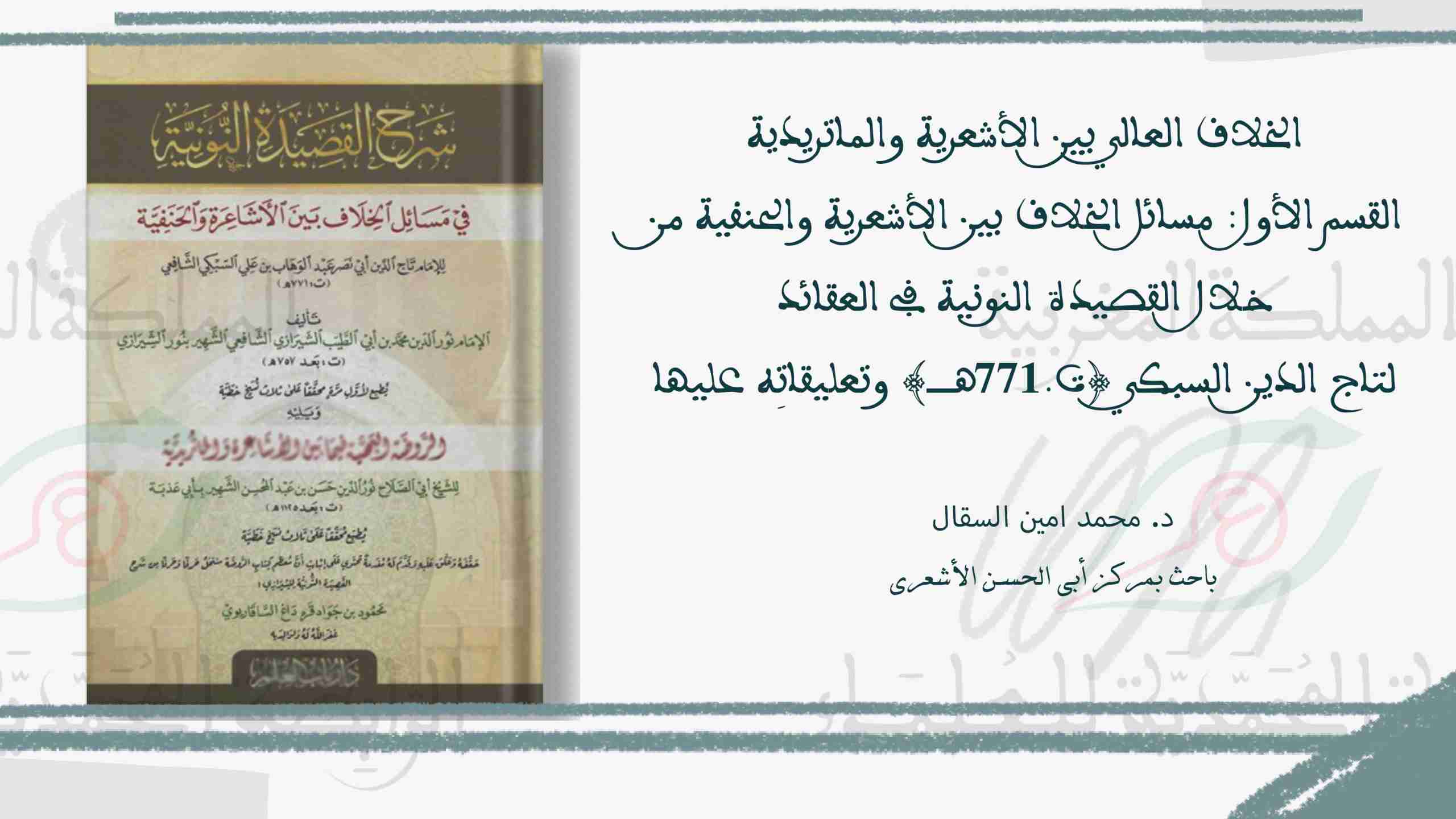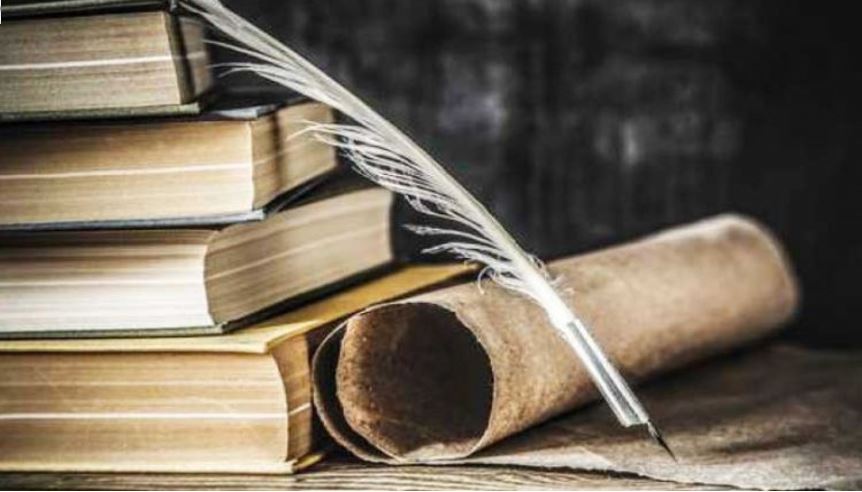منذ عقود عديدة كَثُرَ في الخطاب الإسلامي المعاصر الكلام عن ضرورة التجديد ووجوبه. ولهذا الحديث دلالة لابد من الوعي بها وإبصار قيمتها ومستلزماتها؛ إذ إن هذا الحديث عن الحاجة إلى التجديد دليل على أن مألوفنا في التفكير لم يعد يتناسب مع احتياجاتنا اليوم، ولا هو كفيل بالتفاعل باقتدار مع التحديات الحالية. لكن الملاحظة التي نريد تسجيلها ابتداء هي أنه على رغم هذا الإكثار في الحديث عن التجديد، وعلى رغم كثرة الكتب التي تناولته بقصد إنجازه، إلا أن الوعي الإسلامي المعاصر لا يزال في مرتبة القول والمناداة بوجوب التجديد ولم ينتقل بعد إلى مستوى إنجازه وتحقيقه!
والدليل على ذلك هو حالة الفكر والثقافة الإسلامية الآن! فما سبب هذا العجز عن الإنجاز؟ وما هي عوائق تجديد الوعي الإسلامي ونظام خطابه؟
ثمة عائق أزعم أننا لو استطعنا تخطيه أمكننا الخروج من تلك الدائرة المقفلة، دائرة تكرار المناداة بوجوب التجديد، إلى التأسيس لإنجازه. وأقصد بهذا العائق:
العائق المنهجي، فالمزلق الأكبر لمحاولات تجديد الخطاب الإسلامي أنها اقتصرت على نقد النتاج ولم تتناول نقد الآلة التي تنتج ذلك النتاج. بينما لو أردنا تجديد الخطاب الإسلامي نحتاج إلى تجديد في الآلة المنهجية التي يصدر عنها، لا الاقتصار على تحويل أو نقد أو تجديد في نتاجات تلك الآلة.
فلو كان لدينا آلة صناعة الثوب، وكانت تلك الآلة تخرج لنا قطعا من الثوب فيها خرق، فإنه من العبث الجلوس لترقيع تلك القطع المثقوبة؛ لأنه مهما رقعنا فإن الآلة ستنتج من بعد قطعا ثوبية مخروقة، ولذا فالصائب هو الذهاب إلى مصدر الإنتاج؛ أي الآلة لإصلاحها، لا الاقتصار على إصلاح منتوجها. وكذلك الحال في الخطاب الإسلامي المعاصر، فبدل نقد فكرة هنا، وترقيع أخرى هناك، ورفض ثالثة بين هذا وذاك، ينبغي أن نضع أيدينا على الآلة المنهجية التي تنتج تلك الأفكار الجامدة، التي لم تعد تتناسب مع زمننا ولا تشبع احتياجاتنا العقلية والنفسية والمجتمعية، ليتم تجديد الآلة أو إصلاحها أو تغييرها.
لذا نؤكد هنا أن الخطاب الإسلامي المعاصر يحتاج إلى نقلة منهجية، ولن يتحقق التجديد ما لم تتحقق تلك النقلة بمدلولها المنهجي. ودليلنا على ذلك آت من استقراء لحظات التحول الكبرى المنجزة في تاريخ الفكر الإنساني.
فلو رجعنا إلى الإغريق، مثلا، سنلاحظ أن النقلة الكبرى التي أنجزتها فلسفات طاليس وأنكسيمنس وأنكسيمندر وفيثاغورس.. لم تكن تبديلا في الأفكار، بل كانت تبديلا في منهج التفكير؛ فالثقافة التي كانت سائدة في مرحلة الأسطورة/الميثوس كانت ثقافة سردية تتلقى بالتسليم، ولما جاء طاليس حدثت نقلة نوعية في التعامل مع المفاهيم والأفكار المؤسسة لتلك الثقافة، حيث دخل عامل منهجي جديد هو وجوب الاستدلال. فبدل طرح الرؤية إلى العالم طرحا أسطوريا عبر منهج السرد والحكي، الذي يتم التعامل معه بحس التلقي، أصبحت تلك الرؤية تطرح بمنهج البرهنة والحجاج.
وقد كان أحد كبار المتخصصين في الفلسفة الإغريقية؛ أقصد "جون بيير فرنان"، قد وقف عند لحظة الانتقال من الأسطورة/الميثوس إلى اللوغوس فلاحظ أن مفهوم المقدس مشترك بينهما، لذا حاول البحث عن الاختلاف فوجده في ظهور منهج الاستدلال والحجاج.
صحيح أنه لم يقف عند دلالة هذا الاختلاف كما نقف نحن هنا؛ لأنه لم يكن يفكر في سؤال التجديد وشرائطه، إنما شاهدنا هنا هو هذا الاختلاف الذي وضع يده عليه، حيث نراه نحن اختلافا في منهج التفكير أكثر منه اختلافا في الفكرة. وهذا ما يؤكد أطروحتنا السابقة القائلة إن التحول التجديدي لا يتم إلا بتحول في منهج التفكير.
ثم لو انتقلنا من لحظة الفلاسفة الأوائل إلى اللحظة السقراطية؛ (أي لحظة سقراط وأفلاطون وأرسطو) سنلاحظ أيضا أن التحول تم في المنهج. حيث أبدع سقراط مفهوم الحد الماهوي كمطلب للتفكير بقصد الوقوف في وجه موجة الشك السوفسطائية، ومفهوم الحد الماهوي هو الذي سيكون نقطة الارتكاز للفكر الفلسفي الإغريقي مع أفلاطون الذي سيجعل الماهيات وجودا أنطلوجيا في عالم المثل، وجعل الطريق إلى طلبها أو إيضاحها هو الجدلين الصاعد والنازل. والحد الماهوي أيضا كان هو أساس الفلسفة الأرسطية، أليس أرسطو هو القائل في كتاب "الميتافيزيقا" "لا علم إلا بالكلي؟" أليس منطق أرسطو منطق حدود كلية؟
ثم لو انتقلنا من سياق الثقافة الأوروبية إلى سياق ثقافتنا الإسلامية سنلاحظ أن النقلات الكبرى التي انبجست داخل الصيرورة التاريخية لهذه الثقافة كانت تستند إلى نقلات منهجية، بل إن الإسلام، ككل، أنجز في رسالته القرآنية تحولا نوعيا وهائلا في الجزيرة العربية، ولم يكن هذا الإنجاز راجعا إلى تغيير في أفكار، بل كان تغييرا في منهج التفكير ذاته، وذلك بتأسيس مفهوم التوحيد، وتحديد الوحي كمرجعية للتفكير. فلم يشغل النبي، صلى الله عليه وسلم، نفسه بتهديم الأصنام الحجرية، بل هدم منهج التفكير الوثني الذي يؤسس لطبيعة الرؤية إلى الصنم. وهو قلب منهجي.
ولو دققنا النظر في علم آليات الاجتهاد؛ أي علم الأصول، سنلاحظ أن مكانة الشافعي لم تكن راجعة إلى أفكار أو فتاوى، بل ترجع إلى تأصيله وتحديده لمنهج إنتاج الأفكار واستنباط الفتاوى، حيث كان مشروعه المنهجي في كتاب "الرسالة" النقلة المنهجية الكبرى في سياق التفكير الإسلامي في نهاية القرن الثاني الهجري. وقس على هذا باقي النقلات النوعية التي شهدها تاريخنا الثقافي.
نستنتج مما سبق أن النقلات الثقافية النوعية كانت في مبتدئها تحولاتٌ منهجية، وقد أعطينا مثالا على ذلك بالنقلة التي شهدتها ثقافة الإغريق مع طاليس، ثم مع سقراط وأفلاطون وأرسطو. كما أوضحنا ذلك أيضا من خلال الوقوف عند دلالة التغيير الإسلامي الذي قاده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشرنا إلى الدلالة المنهجية للمبحث الأصولي في تأسيسه مع الشافعي. وقد لاحظنا بناء على استقراء هذه النماذج التغييرية كلها أن أساسها كان تغييرَ منهج التفكير، وليس فقط تغييرا لتفاريق من الأفكار.
واستمرارا في هذا الاستقراء التاريخي المؤكد على أولوية التغيير المنهجي نقول:
لو نظرنا إلى العصر الحديث سنلاحظ أيضا أن كل النقلات الفكرية الكبرى كانت تتأسّس على نقلات منهجية، ودليلنا على ذلك:
أن الفلسفة الديكارتية التي يعد مؤسسها "أب الفلسفة الحديثة"، كان نجاح مشروعها، الذي أحدث تحولا هائلا في الفكر الأوروبي بدءًا من القرن السابع عشر، راجعا إلى وعي ديكارت بأن التجديد لن يحصل إلا بإحداث نقلة منهجية. وهذا هو دلالة حرصه على تخصيص تآليف كثيرة لبحث المسألة المنهجية، بل وعنونتها باستحضار لفظ المنهج:
فمعلوم أن كتابه الأشهر كان هو "خطاب حول المنهج"، وثمة كتاب منهجي آخر لم يكمل صياغته كان عنوانه "قواعد لقيادة العقل"، كما أن كتابه "تأملات ميتافيزيقية" هو صيرورة تفكير تأملي بناء على وعي منهجي حصيف وصارم.
وشخصيا عند تقييمي للفلسفة الديكارتية كنت دائم التساؤل:
ما سبب هذه القيمة الكبرى المعطاة لديكارت في الفلسفة الحديثة، إلى درجةٍ جعلت هيغل يرى بأن كل النقاشات التي هيمنت على الوعي الفلسفي الحديث جرت على أرض ديكارتية؟
من حيث الجرأة على نقد الأفكار الجامدة؛ لم نجد لديكارت ما يعلو به على فلاسفة ومفكرين آخرين عاشوا قبله أو زامنوه. فعندما نقرأ لبرونو أو راموس، أو حتى للفلسفة الاسمية، سنلاحظ أنهم كانوا أجرأ منه، وأكثر قوة في نقد الجمود الفكري السائد. بل حتى من حيث العمق الفكري، فشخصيا أرى كثيرا من الأفكار التي سطرها في كتابيه "خطاب في المنهج" و"تأملات ميتافيزيقية" لا تخلو من سطحية في الطرح، بل إننا نستطيع القول إن العمق الفلسفي الذي نجده في نصوص "دان سكوت" وفلاسفة النزعة الاسمية أكبر بكثير مما نجده في نصوص ديكارت.
إذاً؛ مكانة "أب الفلسفة الحديثة" وقوّته كامنة في شيء آخر، إنها ليست في الفكرة، بل في آلة إنتاجها، أي في منهجية التفكير.
فالعبقرية الديكارتية ترجع إلى كونه لم يشغل نفسه، كما فعل برونو، بالارتطام بالأفكار والأوثان المقدسة، بل تقصّد سحب الأساس المنهجي للبناء الفكري السائد، فانهار من تلقاء نفسه. باختصار؛ إن قيمة ديكارت وقوته في تجديد الفكر الفلسفي آتية من وعيه المنهجي.
هذا على مستوى المفكّر الفرد، أما على مستوى التقويم الإجمالي لمراحل الفكر، فإننا نلاحظ أن الفكر الفلسفي الحداثي لم يتم تأسيسه فعليا إلا في القرن السابع عشر. ونحن لو قارنا هذا القرن بما سبقه لا نجده يعلو عليه من حيث الأفكار، بل علوه آت من المنهج. فالقرن السابع عشر لم يكن قرن تحوّلٍ وانتقال إلا لكونه وعى ضرورة نقد المنهج والتأسيس لآلة تفكير بديلة.
وهذا ما نلاحظه بوضوح في عناوين الكتب والمشروعات الفلسفية التي أُنتجت أثنائه. فإذا كان ديكارت كتب "قواعد لقيادة العقل" و"خطاب حول المنهج"؛ فإن فيلسوفا آخر من فلاسفة القرن السابع عشر، هو "فرنسيس بيكون" سيكتب "الأورغانون الجديد"، و"أورغانون" كلمة إغريقية تعني الآلة، وحرْص بيكون على وسم آلته المنهجية المقترحة بنعت الجديد، توكيدٌ على إدراكه بأن الثقافة الأوروبية لم تعد في حاجة إلى المنهج الأرسطي، بل لابد من تأسيس منهج جديد؛ وهو المطلب الذي سيعمل على تحقيقه بتقعيد المنهج الاستقرائي كبديل للمنهج القياسي الصوري. كل هذا وذلك يثبت:
أن الوعي الفلسفي في القرن السابع عشر كان يضع التفكير في مسألة المنهج في مرتبة الأولوية، وهذا ما جعله ينجز تلك النقلة الكبرى في الفلسفة والثقافة الأوروبية، ويشكّل في سياق صيرورتها مرحلة التأسيس الفلسفي للحداثة.
كما أن فلسفة ما بعد - الحداثة ما كانت لتكون نقلة وتحوّلا إلا لكونها نقدت الأساس المنهجي للحداثة، أي الكوجيتو الديكارتي، مستبدلة إياه بمرجعيات وأسس منهجية بديلة، سواء مع الفرويدية أو البنيوية.
عود على بدء؛ إن التجديد الفعلي لا يحصل إلا بتجديد منهجي. لذا نرى أن المزلق الأكبر للفكر الإسلامي المعاصر، ولكثير من مشروعات التجديد كامنةٌ في انحصارها في نقد مِزَقِ من الأفكار وتفاريق من الآراء والفهوم، ولم تتقصّد نقد الأساس المنهجي الذي يؤسسها، ولذا ظل سؤال التجديد الفعلي عالقا ينتظر الإجابة.
لذا ندعو إلى توجيه الفكر التجديدي نحو دراسة الآليات المنهجية لفعل التفكير وعدم الاقتصار على نقد نتاجاتها. والله أعلى وأعلم.